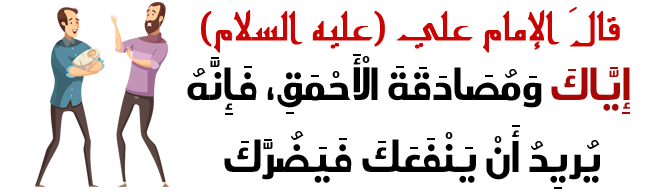
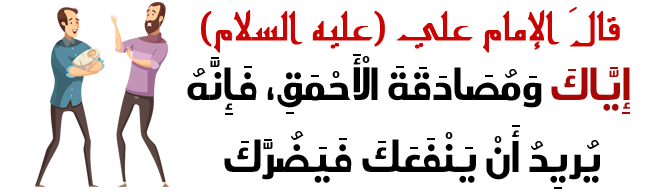

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
التاريخ: 10-8-2016
التاريخ: 1-9-2016
التاريخ: 4-9-2016
|
...ذهب جماعة إلى أنّ العبد مجبور في أعماله ، وهم على طائفتين ، طائفة من الالهيين ، وطائفة اخرى من المادّيين.
والالهيّون ذهبوا إلى أنّ أفعال العباد تتحقّق بإرادة الله ، أي عند إرادة العبد لفعل معين تؤثّر إرادة الله في تحقّقه ولا أثر لإرادة العبد نفسه ، بل إنّما هو مكتسب في البين ، أي الفاعل إنّما هو الله تعالى فقط وأمّا العبد فهو يوجد الفعل عند إرادته.
وكلامهم هذا لا يختصّ بالأفعال الاختياريّة للإنسان بل يأتي في جميع العلل والمعلولات ، فكلّ علّة تؤثّر في معلولها بإرادة الله تعالى ، فالنار مثلاً لا تحرق بل إرادته محرقة مقارنة لإلقاء شيء في النار.
وبعبارة اخرى : عادة الله جرت على إيجاد كلّ معلول عند وجود علّته ، وبعبارة ثالثة : صدور الفعل من الله يقترن دائماً بإرادة الإنسان ، فالإحراق هو فعل الله مباشرةً ولكنّه يقترن بنحو الصدفة الدائمية بالنار.
والمادّيون يقولون : أنّ فعل الإنسان معلول كسائر المعلولات في عالم الطبيعة يتحقّق في الخارج جبراً وقهراً من دون أن يكون اختياريّاً ، والاختيار مجرّد توهّم وخيال يرجع في الواقع إلى عدم تشخيص العلل الخفيّة المؤثّرة في وجود الفعل كالمحيط والوراثة والغريزة.
وهذه مسألة لها جذور تاريخية قديمة بل هي من أقدم المسائل التاريخية ، تمتد إلى حيث بداية الإنسان ، فإنّ الإنسان من بدو وجوده كان يرى نفسه متردّداً بين الأمرين ، فمن جانب كان يرى عدّة من العوامل الخارجيّة تؤثّر في أفعاله وإرادته ، ومن جانب اخرى يرى فرقاً بينه وبين الحجر الذي يسقط من الفوق على الأرض ، فقال قوم بالاختيار ، وقال قوم بالجبر.
استدلّ الطائفة الاولى من الجبريين على مذهبهم بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّه لا شكّ في أنّ الله تعالى مريد ، وإرادته نافذة في كلّ الأشياء ، ولا حدّ لإرادته، ولا يوجد شيء في عالم الوجود من دون إرادته ، ومن جملة الأشياء جميع أفعال العباد، فهي أيضاً تحت نفوذ إرادته ، وإلاّ يلزم تخلّف إرادته عن مراده أو خروج أفعال العباد عن سلطانه ، فإذا تعلّقت إرادته بعصيان العبد أو اطاعته لا يمكن للعبد التخلّف عنه فإنّه إذا أراد الله شيئاً فإنّما يقول له كن فيكون ، ولا يقال أنّ هذه إرادة تشريعيّة له ، بل إرادته التكوينيّة نافذة في كلّ شيء ومحيطة على كلّ شيء ولا يوجد شيء في هذا العالم إلاّ بهذه الإرادة.
هذا ملخّص كلامهم في الدليل الأوّل الذي يمكن تمسيته باسم توحيد الإرادة وشمولها.
والجواب عنه : أنّا ننكر نفوذ إرادته تعالى في جميع الأشياء ، بل نقول أنّ من الأشياء التي تعلّقت مشيئته وإرادته بها هو كون العبد مختاراً في أفعاله ، فهو أراد واختار أن يكون العبد مريداً ومختاراً ، وحينئذٍ لازم عدم كون الإنسان مختاراً تخلّف إرادته عن مراده وعدم نفوذ إرادته ومشيّته في جميع الأشياء ، وهو خلف.
وبعبارة اخرى : المؤثّر في تحقّق الأفعال في الخارج ارادتان : إرادة العبد وإرادة الله ، ولكن إرادة العبد في طول إرادة الله ، فلا تنافي إطلاق سلطنته ونفوذ مشيّته في جميع الأشياء ، فالله يريد كون العبد مختاراً في أفعاله ، والعبد يريد الفعل باختياره وإرادته.
الوجه الثاني : ما يشبه الدليل الأوّل ، ولكنّه من طريق آخر وهو وصف الخالقية ، ببيان إنّ الله تعالى خالق لكلّ شيء ، ولا شريك له في خالقيته لجميع الأشياء التي فالله أفعال العباد هو الخالق لأفعال الإنسان لا أنّ الإنسان هو خالق لها ( وهذا دليل عموم الخلقة وتوحيدها ).
والجواب عنه : يشبه الجواب عن الوجه السابق ، وهو أنّ خلق العبد أفعاله أيضاً يكون ناشئاً من إرادته وخالقيته ، فإنّه تعالى خلق للعبد إرادة خالقة وجعله قادراً على الخلق والإيجاد في أفعاله ، فخلق العبد في طول خلق الله ، وقدرته على الخلق في طول قدرته ، فالله تبارك وتعالى خالق بالذات ومستقلاً ، والعبد خالق بالغير وفي طول خلقه ، وخلقه مستند إلى خلقه ، وهذا لا يعدّ شركاً بل هو عين التوحيد.
الوجه الثالث : دليل العلم ، وبيانه أنّ الله تعالى كان عالماً بأفعال العباد خيرها وشرّها وطاعتها ومعصيتها بتمام خصوصّياتها من الأزل ولا بدّ من وقوعها مطابقة لعلمه ( سواء كان علمه علّة لها أو كاشفاً عنها ) وإلاّ يلزم أن يصير علمه جهلاً ، فنحن مجبورون في أفعالنا حتّى لا يلزم هذا المحذور الفاسد ( وهذا ممّا ظهر في لسان بعض الأشعار كقول الشاعر الفارسي : « گر مى نخورم علم خدا جهل شود » أي لو لم أشرب الخمر لكان علمه تعالى جهلاً لأنّه كان يعلم من الأزل أنّي أشرب الخمر!
والجواب عنه أيضاً واضح ، لأنّه تعالى كان يعلم من الأزل أنّ العبد يصدر منه الفعل باختياره وإرادته ( أي إرادة العبد ) فلو صدر منه الفعل جبراً لزم صيرورة علمه تعالى جهلاً ، لأنّه كان يعلم بصدوره عن اختياره ، ولذا قال الشاعر الفارسي العالم الخبير في الجواب عن الشعر السابق « علم ازلى علت عصيان گشتن ـ نزد عقلا ز غايت جهل بود » ، وهذا نظير نسخة المريض التي يكتبها الطبيب لرفع مرضه مع أمره باجتنابه عن بعض المأكول أو المشروب ، فلو فرضنا أنّ الطبيب علم من بعض القرائن عدم امتثاله وارتكابه لما نهى عنه وبالنتيجة دوام مرضه وموته ، فهل يمكن حينئذٍ أن يستند موت المريض إلى علم الطبيب؟ وهكذا إذا علم الاستاذ الممتحن عدم نجاح تلميذه في الامتحان من بعض القرائن من قبل ، فهل يصحّ أن يستند عدم نجاحه إلى علم الاستاذ؟ أو فرضنا اختراع آلة ينعكس فيها جميع أفعال العباد والحوادث الآتية فهل يجوز استناد جميع تلك الحوادث إلى تلك الآلة؟ كلاّ ، فإنّ علم الباري تعالى بأفعال عباده من هذا الباب.
والإنصاف أنّ هذا الدليل أشبه شيء بالمغالطة ، وسيأتي أنّ الميل إلى مذهب الجبر ليس له دليل فلسفي برهاني ، بل له جذور أخلاقيّة أو اجتماعيّة أو نفسانيّة ، وأنّ الإنسان يميل إليه ويلتزم به لأن يكون مستريحاً في المعاصي في مقابل وجدانه القاضي بعصيانه والحاكم باستحقاقه للمذمّة والعقاب ، وقد قال الله تعالى في حقّ منكري القيامة : {بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ} [القيامة: 5] وهكذا حال منكري الاختيار المتمسّكين بمذهب الجبر.
هذا كلّه ما استدلّ به الجبريون المعتقدون بالله.
وهناك وجوه اُخرى للقول بالجبر يشترك فيها كلتا الطائفتين الالهيّون والمادّيون:
الوجه الأوّل: برهان التكرار:
وهو أنّه لو كنّا مختارين في أعمالنا لوجب القدرة على تكرار الأعمال بعينها، فإذا ألقينا حجراً في موضع خاصّ وكان هو معلولا لاختيارنا وإرادتنا فلنكن قادرين على إلقائه في نفس ذلك الموضع في المرّة الثانيّة مع أنّه نتخلّف عنه غالباً، بل قد يقع على نفس الموضع السابق صدفة.
وأجاب عنه المحقّق الطوسي(رحمه الله): بوجهين ولنا جواب ثالث لعلّه أدقّ منهما:
الأوّل: فهو النقض بأنّه قد يصدر عنّا أعمال تكراريّة متشابهة كحركة اليد والأصابع.
الثاني: (هو جواب حلّي منه (رحمه الله)) فهو إنّا غير عالمين بتفاصيل العمل وإلاّ لو علمنا به تفصيلا لكنّا قادرين على تكراره بعينه، فمثلا لو علمنا بمقدار الماء في الاغتراف الأوّل لاستطعنا أن نغترف منه بنفس ذلك المقدار في المرّة اللاّحقة.
وأمّا الجواب الثالث فهو أن نقول: إنّ الاختياري من العمل في المثال المزبور إنّما هو أصل إلقاء الحجر فحسب، وهو ممّا يمكن تكراره بعينه بلا إشكال، وأمّا خصوصّياته وجزئياته فلا بأس بكونها خارجة عن الاختيار.
وبعبارة اُخرى: ههنا عدّة من العوامل الجبريّة تكون دخيلة في عمل الإلقاء كبعض ارتعاشات اليد ومقدار القوّة الموجودة في اليد في كلّ مرّة ولكنّها لا تنافي اختياريّة أصل العمل كما لا يخفى.
الوجه الثاني: برهان العلم بالتفاصيل:
وبيانه أنّ اختياريّة العمل تستلزم العلم بتفاصيله وهو مفقود بالوجدان كما في حركة الساهي أو النائم وانقلابه من جنب إلى جنب وفي الأعمال الاعتياديّة، فلا يعلم الإنسان بكميّة عمله وكيفيته (في المثال الأوّل) كما لا يعلم بعدد خطواته وكيفيتها (في المثال الثاني وفي الأعمال الاعتياديّة) فإن كانت هذه الأعمال اختياريّة له فكيف لا يكون عالماً بتفاصيلها؟
وأجاب عنه المحقّق الطوسي(رحمه الله): بما يخصّ بالمثال الأوّل بأنّ ملاك اختياريّة العمل إنّما هو صدوره عن علم والتفات، وهما منفيان في حال النوم أو السهو، فلا يكون العمل في هذا الحال اختياريّاً.
وأمّا في المثال الثاني وهو الأعمال الاعتياديّة فيمكن أن يقال: أنّها معلومة إجمالا لأنّها قبل أن تصير اعتياديّة كانت تصدر من الإنسان عن علم والتفات تفصيلي، وبعد تحقّق العادة أيضاً تصدر عن علم والتفات، ولكن على نحو الإجمال، ولا دليل على اعتبار العلم التفصيلي في اختياريّة الأعمال.
الوجه الثالث: برهان العلّية أي «قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد»:
بيانه: أنّه لا إشكال في أنّ كلّ معلول ما لم تتحقّق علّته التامّة لم يوجد، بل يمتنع وجوده، فإذا تحقّقت علّته التامّة فلابدّ من تحقّق المعلول، ولا يمكن تخلّفه عنها، فكلّ فعل عند تحقّق علّته واجب وجوده، وعند عدم تحقّق علّته ممتنع وجوده، فأمره دائماً دائر بين الوجوب والامتناع، أي أنّه إمّا ضروري الوجود، أو ضروري العدم، وهذا هو معنى الجبر، فلا اختيار في البين.
والجواب عنه: أنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار كما أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافيه أيضاً
وتوضيحه: إنّا نقبل قاعدة «إنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد» ولكن نقول أيضاً: إنّ الجزء الأخير للعلّة التامّة في الأفعال الاختياريّة هو الإرادة والاختيار، ولا إشكال في أنّ الوجوب الذي ينشأ من العلّة التي يكون جزؤها الأخير الاختيار لا ينافي الاختيار، بل يؤكّد الاختيار.
الوجه الرابع: برهان الإرادة:
(الذي أدرجه بعض في برهان العلّية ولكن ينبغي إفراده عنه لما فيه من خصوصيّة التبيين) وهو عبارة عن «أنّ اختياريّة العمل إنّما تكون بالإرادة، فننقل الكلام إلى الإرادة ونقول: هل الإرادة أيضاً إراديّة واختياريّة، أو لا؟ فإن لم تكن إراديّة لزم، كون الفعل الذي ينتهي إليها غير ارادي أيضاً، وإن كانت إراديّة فلابدّ أن تكون تلك بإرادة اُخرى، ثمّ ننقل الكلام إلى تلك الإرادة، فإن كانت إراديّة فيلزم التسلسل وإلاّ لزم الجبر، فيدور الأمر بين قبول التسلسل وقبول مذهب الجبر، وحيث إنّ الأوّل باطل فيتعيّن الثاني.
وهذا هو من أهمّ أدلّتهم، وهو الذي بالغ فيه أمام المشكّكين حتّى توهّم أنّه لو اجتمع الثقلان لم يأتوا بجوابه.
ولكن اُجيب عنه بوجوه عديدة:
الوجه الأوّل: ما أجاب عنه المحقّق الخراساني(رحمه الله) وحاصله: أنّ الثواب والعقاب يترتّبان على الإطاعة والمعصية، وهما تنشئان من الإرادة، والإرادة أيضاً تنشأ من مقدّماتها الناشئة من الشقاوة والسعادة الذاتيتين، والذاتي لا يعلّل، والسعيد سعيد في بطن اُمّه والشقي شقي في بطن اُمّه والناس معادن كمعادن الذهب والفضّة كما في الخبر.
وقد نقل عنه (رحمه الله) أنّه عدل عن هذه المقالة بعد ذلك.
وكيف كان، يرد عليه:
أوّلا: أنّ كلامه هذا يوجب إراديّة الفعل في مقام التسمية فحسب لا الواقع، وهو لا يوافق مذهب الاختيار والأمر بين الأمرين حقيقة كما هو ظاهر.
ثانياً: إذا كانت الشقاوة ذاتيّة وتكون هي المنشأ الأصلي للعصيان فكيف يؤاخذ الله العاصي بما هو ذاتي له؟ فهل هو إلاّ ظلم فاحش (تعالى الله عنه علوّاً كبيراً)؟
وأمّا ما استشهد به من الرّوايتين فالحقّ أنّ الثاني منهما (وهو قوله (صلى الله عليه وآله)الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة) على خلاف مقصوده أدلّ، لأنّه يقول: أنّ جميع الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة، فهم على تفاوتهم واختلاف درجاتهم (كتفاوت درجات معادن الذهب والفضّة) حسن السريرة بحسب ذواتهم وسعداء بحسب فطرتهم الأوّليّة فلا شقاوة ذاتيّة لهم.
الأوّل: منهما وهو قوله (صلى الله عليه وآله): «السعيد سعيد في بطن اُمّه والشقي شقي في بطن اُمّه» فقد فسّر بتفسيرين:
أحدهما: أنّ الله تبارك وتعالى يعلم أنّ المولود الفلاني يصير سعيداً أو شقيّاً. (كما في الخبر).
وثانيهما: حمله على المقتضيات الذاتيّة، فيكون المراد منه أنّ بعض الناس أقرب إلى السعادة بحسب اقتضائه الذاتي واستعداده الفطري، وبعض آخر أقرب إلى الشقاوة كذلك من دون أن يكون هذا القرب أو البعد علّة تامّة للطاعة أو العصيان، بل الجزء الأخير هو إرادة واختيار الإنسان نفسه.
إن قلت: هذا وإن كان يرفع الجبر ولكن أليس هو تبعيض قبيح عند العقل؟
قلنا: أنّه كذلك إذا كانت مجازاتهما بنسبة واحدة، مع أنّه ليس كذلك، لأنّ كلّ إنسان يجازى على عمله بملاحظة الشرائط والمساعدات الذاتيّة والعائلية والوراثيّة والاجتماعيّة، فيكون الميزان في الثواب والعقاب نسبة العمل مع مقدار الإمكانات والعلم والاستعداد، فمن كانت قدرته ومكنته أكثر، ينتظر منه سعي أكثر وعمل أوفر، ومن هذا الباب يقال حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين، وقوله تعالى لنساء النبي (صلى الله عليه وآله): {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ...} [الأحزاب: 30] وقوله تعالى للحواريين بعد طلبهم نزول المائدة من السماء: {إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ } [المائدة: 115].
الوجه الثاني: ما مرّ من المحقّق النائيني (رحمه الله) في البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة (واستحسنه بعض أعاظم تلامذته في هامش تقريراته وزاده توضيحاً ومثالاً وقال: ما أفاد شيخنا الاُستاذ هو محض الحقّ الذي لا ريب فيه) وقد وعدنا أن نجيب عن ما يرتبط من كلامه بمبحث الجبر والاختيار في هذا المقام.
فنقول: كان كلامه ذاك مركّباً من خمس مقدّمات:
الاُولى: إنّ الإرادة عبارة عن الشوق المؤكّد، ولكن هناك أمر آخر متوسّط بين الإرادة وحركة العضلات يسمّى بالطلب، وهو عبارة عن نفس الاختيار وتأثير النفس في الحركة.
الثانيّة: إنّ النفس مؤثّرة بنفسها في حركات العضلات من غير سبب خارجي وواسطة في البين.
الثالثة: إنّ قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» مختصّة بالأفعال غير الاختياريّة.
الرابعة: إنّ الاحتياج إلى المرجّح في وجود الفعل من ناحية فاعله (وهو النفس) إنّما هو من جهة خروج الفعل عن العبثية وإلاّ فيمكن للإنسان إيجاد ما هو منافر لطبعه فضلا عن إيجاد ما لا يشتاقّه لعدم فائدة فيه.
الخامسة: إنّ المرجّح المخرج للفعل عن العبثية هي الفائدة الموجودة في نوعه، دون شخصه بداهة أنّ الهارب والجائع يختار أحد الطريقين وأحد القرصين مع عدم وجود مرجّح في واحد بالخصوص، ويعلم من ذلك عدم وجود أمر إلزامي إجباري يوجب صدور الفعل حتّى يهدم أساس الاختيار، وأمّا الاختيار فهو فعل النفس وهي بذاتها تؤثّر في وجوده، والمرجّحات التي تلاحظها النفس إنّما هي لخروج الفعل عن كونه عبثاً لا أنّها موجبة للاختيار.
أقول: يرد على الاُولى: مناقشة لفظيّة وهي أنّ الإرادة عند المشهور ليست عبارة عن مجرّد الشوق المؤكّد فحسب بل إنّما هي الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات.
وعلى الثانيّة: أنّ كون النفس علّة تامّة للفعل أو الترك ينافي تسويتها بالنسبة إلى كلّ من الفعل والترك وأنّها إن شاءت فعلت وإن شاءت تركت، أي ينافي حالة اختيارها، لأنّ كونها علّة تامّة للفعل أو الترك يستلزم دوران الأمر بين الوجوب والامتناع بمقتضى قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، وإنكاره جريان هذه القاعدة في الأفعال الاختياريّة (وهي المقدّمة الثالثة) يساوق إنكار قانون العلّية والتسليم بالصدفة كما لا يخفى.
وعلى الرابعة والخامسة: أنّ كفاية المرجّح النوعي إنّما هي في رفع العبثية، وأمّا إذا كان المرجّح مؤثّراً في تكوّن العلّة التامّة وتحقّقها فلا يكفي بل لا بدّ من المرجّح الشخصي، لأنّ المرجّح النوعي قد تكون نسبته إلى الفعل والترك على السواء، نعم إنّ كلامه صحيح بناءً على مبناه من عدم جريان قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» في الأفعال الاختياريّة.
وأمّا مثال الهارب والعطشان فإنّا ننكر عدم وجود مرجّح شخصي فيهما بل ندّعي وجود مرجّح خاصّ فيهما قطعاً كقرب أحد الإنائين أو سبق النظر إلى أحدهما من الآخر، وإلاّ لو لم يلتفت إلى مرجّح خاصّ لتوقّف في المشي أو الشرب، ولكن هذا مجرّد فرض، فتلخّص أنّ حلّ مشكلة الإرادة من هذا الطريق غير ممكن وإن كان بعض ما ذكره من المقدّمات صحيح، وعمدة ما يرد عليه هو ما ذكره في استثناء الأفعال الاختياريّة من قاعدة: الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإنّه مساوق لإنكار قانون العلّية كما لا يخفى.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق العراقي(رحمه الله) في المقام وإليك نصّ كلامه: «إنّ عوارض الشيء على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما يعرض على الشيء وليس بلازم لوجوده ولا لماهيته كالبياض للجسم مثلا.
ثانيها: ما يعرض الشيء ويكون لازماً لماهيته (كزوجيّة الأربعة).
ثالثها: ما يعرض الشيء ويكون لازماً لوجوده كالحرارة للنار، أمّا القسم الأوّل فلا ريب في أنّ جعل المعروض (بمعنى إيجاده) لا يستلزم جعل عارضه، بل يحتاج العارض إلى جعل مستقلّ، وأمّا القسمان الأخيران فما هو قابل لتعلّق الجعل به هو المعروض وهو المجعول بالذات، وأمّا لازم كلّ من القسمين المذكورين فيحقّق قهراً بجعل نفس ملزومه ومعروضه بلا حاجة إلى جعل مستقلّ، فإرادة المعروض تكفي في تحقّقه عن تعلّق إرادة أزليّة اُخرى به.
ثمّ قال: إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ أوصاف الإنسان على قسمين:
أحدهما: إنّه يكون من عوارض وجوده وليس بلازم لوجوده أو ماهيته كالعلم والضحك ونحوهما، وقد عرفت أنّ هذا النحو من العوارض يحتاج إلى جعل مستقلّ يتعلّق به.
ثانيهما: أنّ يكون الوصف من لوازم وجوده كصفة الاختيار للإنسان، فإنّه من لوازم وجوده ولو في بعض مراتبه، وقد عرفت أنّ هذا النحو من الأوصاف لا يحتاج في تحقّقه إلى جعل مستقلّ غير جعل معروضه، فالإنسان ولو في بعض مراتب وجوده مقهور بالاتّصاف بصفة الاختيار، ويكفي في تحقّق صفة الاختيار للإنسان تعلّق الإرادة الأزليّة بوجود نفس الإنسان.
ثمّ قال: لا ريب في أنّ كلّ فعل صادر من الإنسان بإرادته، له مباديء كعلم بفائدته وكشوق إليه وقدرة عليه واختياره في أن يفعله وأن لا يفعله وإرادته المحرّكة نحوه، وعليه يكون للفعل الصادر من الإنسان نسبتان:
إحداهما: إليه باعتبار تعلّق اختياره به الذي هو من لوازم وجود الإنسان المجعولة بجعله لا بجعل مستقلّ.
والاُخرى: إلى الله تعالى باعتبار إيجاد العلم بفائدة ذلك الفعل في نفس فاعله وإيجاد قدرته عليه وشوقه إليه إلى غير ذلك من المباديء التي ليست من لوازم وجود الإنسان، وحينئذ لا يكون الفعل الصادر من الإنسان بإرادته مفوّضاً إليه بقول مطلق ولا مستنداً إليه تعالى كذلك ليكون العبد مقهوراً عليه، ومعه يصحّ أن يقال: لا جبر في البين لكون أحد مباديء الفعل هو اختيار الإنسان المنتهى إلى ذاته، ولا تفويض بملاحظة كون مبادئه الاُخرى مستندة إليه تعالى ولا مانع من أن يكون ما ذكرنا هو المقصود بقوله (عليه السلام): لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين»(1).
ويمكن تلخيص مجموع كلامه هذا في ثلاث مقدّمات:
الاُولى: أنّ الاختيار من لوازم وجود الإنسان وذاته ولا يحتاج إلى جعل مستقلّ عن جعل ذاته.
الثانيّة: أنّ الاختيار غير الإرادة فإنّه صفة كامنة في النفس وموجود فيها بالفعل وعند تحقّق الفعل يصير بالفعل.
الثالثة: أنّ الفاعل للفعل هو الإنسان بوصف كونه مختاراً والباقي شروط ومعدّات.
ولكن يرد على المقدّمة الاُولى: أنّه لا حاجة إليها لأنّه وإن كان الاختيار مجعولا بجعل مستقلّ فمع ذلك لا يضرّ بكون العمل اختياريّاً، لأنّه على أيّ حال: خلق مختاراً، أي تكون أصل قوّة الاختيار جبريّاً وقهريّاً، وهذا لا ينافي أن يكون الفعل المستند إلى هذه القوّة اختياريّاً كما لا يخفى.
وعلى الثانيّة: أنّها مبهمة من جهة أنّه لا يعلم أنّ مراده ما ذكره المحقّق النائيني، من أنّ الاختيار نفس الطلب والطلب غير الإرادة، أو غير ذلك، فإن كان الأوّل فقد عرفت الكلام فيه، وإن كان غير ذلك فليبيّن حتّى يبحث عنه.
وأمّا الثالثة: فلا مانع من المساعدة عليها، لكن يبقى الكلام في أنّ الإنسان المختار متساوي النسبة إلى وجود الفعل وعدمه فكيف يصدر الفعل منه دون عدمه فإن كان هو من جهة تخصيص قاعدة الوجوب فيعود الإشكال الذي ذكرناه في كلام المحقّق النائيني (رحمه الله) أو شيء آخر فما هو؟
المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار:
الحقّ في المسألة أن يقال: إنّ هناك أمرين:
1 ـ صفة الاختيار وقوّته التي تكون ذاتيّة للإنسان، ومقتضى هذه الصفة هي كون الإنسان بالنسبة إلى أفعاله على نحو سواء بحيث إنّ شاء فعل وإن شاء ترك.
2 ـ الاختيار الفعلي، وهو نفس الإرادة والانتخاب في الخارج والتصدّي للعمل.
فإنّه بعد تصوّر الإنسان لفعل وتصديق الفائدة فيه وحصول الشوق المؤكّد له ترد صفة الاختيار في ميدان العمل وتنتخب الفعل أو الترك.
وإن شئت قلت: ترد النفس في ميدان العمل بصفة الاختيار وقوّته التي تكون من شؤونها وذاتياتها فتريد الفعل أو الترك وتنتخب أحدهما.
ولازم هذا أن تكون الإرادة نفس الاختيار، ولكن ـ الاختيار الفعلي لا صفة الاختيار أي الاختيار بالقوّة.
توضيح ذلك: أنّ الإنسان يكون بفطرته وذاته طالباً للمنفعة ودافعاً للضرر، أي من غرائزه الفطريّة الجبلية غريزة طلب المنفعة ودفع الضرر، وبمقتضى هذه الغريزة إذا لاحظ شيئاً والتفت إلى منفعة أو ضرر، أي إذا تصوّر أحدهما وصدّقه يحصل في نفسه شوق إلى تحصيل المنفعة أو دفع الضرر، ومع ذلك يرى نفسه قادراً على الجلب وعدمه، أو على الدفع وعدمه، وأنّ له أن يتحرّك ويجلب المنفعة أو يدفع الضرر، وله أن يجلس ويتحمّل الضرر أو يحرم نفسه عن المنفعة ويشتري المذمّة والملامة، فإذا اختار الفعل وانتخبه وأراده ورجّحه على الترك تتحرّك عضلاته نحو العمل فيفعله ويحقّقه في الخارج.
وبهذا يظهر أنّ التصوّر والتصديق والشوق كثيراً ما تكون جبريّة غير اختياريّة، فإنّ التصوّر كثيراً ما يحصل للإنسان جبراً بمعونة حواسّه وادراكاته، ويترتّب عليه التصديق فيكون التصديق أيضاً جبريّاً غالباً ويترتّب على التصديق الشوق أو الكراهة بمقتضى غريزة جبريّة وهي غريزة جلب المنفعة ودفع الضرر.
ثمّ تصل النوبة بعد هذه إلى أعمال النفس واختيارها وارادتها بمقتضى سلطانه الذاتي وقوّة الاختيار وقدرة الانتخاب التي جعلها الله تعالى لذاتها، فلها أن تختار وتنتخب، ولها أن لا تختار ولا تنتخب.
ثمّ إذا اختارت وانتخبت تصل النوبة إلى حركة العضلات نحو العمل، والإرادة عين هذا الاختيار الفعلي والانتخاب الخارجي، هذا أوّلا.
وثانياً: ظهر أنّ الإرادة ليست في طول الشوق المؤكّد بلا تخلّل شيء، بل صفة الاختيار متخلّلة بينهما، والشاهد على ذلك أنّ الإنسان كثيراً ما يتصوّر شيئاً ذا منفعة وفائدة ويصدّق فائدته ويشتاق إليه، ولكن مع ذلك لا يتصدّى له في الخارج ولا تترشّح من النفس إرادة العمل لما يكون لها من صفة الاختيار وقوّته، وحينئذ نشاهد تخلّل صفة الاختيار بين الشوق والإرادة.
وبهذا تنحلّ مشكلة عدم اختياريّة الإرادة، فإنّه إذا كانت الإرادة عبارة عن الاختيار الخارجي الفعلي والتصدّي في الخارج بمقتضى صفة الاختيار الذاتيّة للإنسان كانت إراديّة، وإراديتها إنّما تكون بذاتها لا بقوّة اختياريّة اُخرى حتّى يتسلسل.
وإن شئت قلت: إنّ إراديّة كلّ فعل إنّما هي بالإرادة، وإراديّة الإرادة إنّما هي بصفة الاختيار الكامنة في النفس، وإراديّة صفة الاختيار واختياريتها إنّما هي بذاتها فإنّ كلّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وذلك مثل أنّ المعلوم يكون معلوماً بتعلّق العلم به، والعلم معلوم بذاته لا يتعلّق علم آخر به.
يبقى الكلام في توضيح نكتة أنّ الإرادة كيف تترشّح وتنشأ من صفة الاختيار الكامنة في النفس وأنّ النفس تخلقها وتوجدها بذاتها وبلا وسائط اُخرى خارجيّة، فنذكر في هذا المجال ما أفاده في رسالة الطلب والإرادة، ونعم ما أفاد، فإنّه جدير بالدقّة والتأمّل وإليك نصّ كلامه: «اعلم أنّ الأفعال الاختياريّة الصادرة من النفس على نوعين:
النوع الاوّل: ما يصدر منها بتوسّط الآلات الجرمانيّة كالكتابة والصياغة والبناء ففي مثلها تكون النفس فاعلة الحركة أوّلا وللأثر الحاصل منها ثانياً وبالعرض، فالبنّاء، إنّما يحرّك الأحجار والأخشاب من محلّ إلى محلّ ويضعها على نظم خاصّ وتحصل منه هيئة خاصّة بنائيّة وليست الهيئة والنظم من فعل الإنسان إلاّ بالعرض، وما هو فعله هو الحركة القائمة بالعضلات أوّلا وبتوسّطها بالأجسام، وفي هذا الفعل تكون بين النفس المجرّدة والفعل وسائط ومباد من التصوّر إلى العزم وتحريك العضلات.
النوع الثاني: ما يصدر منها بلا وسط أو بوسط غير جسماني كبعض التصوّرات التي يكون تحقّقها بفعّاليّة النفس وإيجادها لو لم نقل جميعها كذلك، مثل كون النفس خلاّقة للتفاصيل، ومثل اختراع نفس المهندس صورة بديعة هندسيّة، فإنّ النفس مع كونها فعّالة لها بالعلم والإرادة والاختيار لم تكن تلك المباديء حاصلة بنحو التفصيل كالمباديء للأفعال التي بالآلات الجسمانيّة، ضرورة أنّ خلق الصور في النفس لا يحتاج إلى تصوّرها والتصديق بفائدتها والشوق والعزم وتحريم العضلات، بل لا يمكن توسيط تلك الوسائط بينها وبين النفس بداهة عدم إمكان كون التصوّر مبدئاً للتصوّر بل نفسه حاصل بخلاّقيّة النفس، وهي بالنسبة إليه فاعلة بالعناية بل بالتجلّي لأنّها مجرّدة، والمجرّد واجد لفعليات ما هو معلول له في مرتبة ذاته، فخلاّقيتة لا تحتاج إلى تصوّر زائد بل الواجدية الذاتيّة في مرتبة تجرّدها الذاتي الوجودي تكفي للخلاّقيّة، كما أنّه لا يحتاج إلى إرادة وعزم وقصد زائد على نفسه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ العزم والإرادة والتصميم والقصد من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبّة من الاُمور الانفعاليّة، فالنفس مبدأ الإرادة والتصميم، ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجرمائيّة بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون بل لا يمكن أن يكون بينه وبينها إرادة زائدة متعلّقة، به بل هي موجدة له بالعلم والاستشعار الذي في مرتبة ذاتها، لأنّ النفس فاعل إلهي واجد لأثره بنحو أعلى وأشرف»(2) (انتهى).
إن قلت: إن كانت النفس علّة تامّة وفاعلة للفعل باختيارها من دون دخالة شيء آخر من الخارج فلماذا صدر الفعل الفلاني منها في اليوم دون الأمس مع أنّ المعلول لا ينفكّ عن علّته التامّة؟
قلنا: المفروض أنّ النفس بما لها من صفة الاختيار تكون علّة تامّة للفعل، ولا إشكال في أنّ هذه الصفة تقتضي بذاتها تخصيص الفعل بوقت دون وقت، وهذا نظير ما يقال به في باب صفات الباري من أنّه تعالى مختار واختياره عين ذاته، ولازمه تخصيص فعله (وهو خلق حادثة فلانيّة كخلق الشمس والقمر) بزمن خاصّ لا من الأزل.
والحاصل: أنّه يمكن قياس فعل العبد من هذه الجهة على فعل الله، فهل العالم قديم؟ لا إشكال في حدوثه، فهل العلّة التامّة لوجوده هو ذات الباري بما له من الإرادة والاختيار بل
الإرادة والاختيار عين ذاته، فلماذا حصل الخلق وحدث بعد أن لم يكن؟ فهل كانت هناك علّة من الخارج؟ والمفروض أنّه لم يكن هناك شيء فما العلّة في تخصيص حدوثه بوقت دون وقت؟
والجواب: أنّ ذاته تعالى بما له من الاختيار كان سبباً وعلّة، وهكذا الكلام في أفعال العباد من هذه الجهة وإن كان يتفاوت مع أفعاله تعالى من جهات اُخرى.
ثمّ إنّ لبعض المعاصرين (قدّس سرّهم الشريف) هنا كلاماً لا يخلو ذكره عن فائدة، فإنّه قال في حلّ مشكلة الإرادة وقاعدة «إنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد» إنّ هذه القاعدة لو كانت قاعدة عقليّة لم يكن هناك معنى للالتزام بالتخصيص فيها، لكن الصحيح أنّها ليست قاعدة عقليّة مبرهنة بل هي قاعدة وجدانيّة، إذن فلابدّ من الرجوع في هذه القاعدة إلى الفطرة السليمة، والفطرة السليمة تحكم أنّ هناك صفة في النفس وهي السلطنة، وينتزع منها مفهوم الاختيار، ومعناها إنّه حينما يتمّ الشوق المؤكّد في أنفسنا نحو عمل لا نقدم عليه قهراً ولا يدفعنا إليه أحد بل نقدم عليه بالسلطنة، ونسبتها إلى الوجود والعدم وإن كانت متساوية لكنّها كافية في إيجاد المطلوب بلا حاجة إلى ضمّ شيء آخر إليها لأجل تحقّق أحد الطرفين، فلا يجري فيه قاعدة «إنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد» وإلاّ لزم الخلف، لأنّ السلطنة لو وجدت لا بدّ من الالتزام بكفايتها(3). (انتهى ملخّصاً).
وفيه: إنّا لا نجد فرقاً بين مفهوم السلطنة والاختيار، وما ذكره ليس أمراً جديداً فقد عبّر بالسلطنة بدل الاختيار كما عبّر بعض آخر بهجوم النفس (فإنّه عبارة اُخرى عن إعمال الاختيار أي الاختيار الفعلي) أو الطلب الموجود في النفس فلو لم يكن وجود الاختيار كافياً في حلّ هذه المشكلة فالتعبير عنه بعبارة اُخرى لا يفيد في حلّها أيضاً فإنّه يبقى السؤال في أنّ هذه السلطنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فترجيح أحد الطرفين يحتاج إلى مرجّح.
وإن شئت قلت: إنّ السلطنة كانت موجودة في النفس من الأوّل، فلو كانت كافية بذاتها للوجود بلا ضمّ شيء إليها فلابدّ أن توجد الأفعال كلّها من قبل ولا معنى لتخصيص فعل بزمان دون زمان، فلا يبقى طريق لحلّ هذه المشكلة إلاّ ما عرفت سابقاً.
أدلّة القائلين بالاختيار:
وأمّا القائلون بالاختيار فاستدلّوا لمقالتهم بوجوه أيضاً:
الوجه الأوّل: ما هو مشترك بين الإلهيين والمادّيين وهو الرجوع إلى الوجدان، فإنّ الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا على تعبير المحقّق الطوسي (رحمه الله)(والمراد من الضرورة في كلامه ضرورة الوجدان لا ضرورة دليل العقل).
وتوضيحه: أنّ الوجدان على نوعين: الوجدان الفردي والوجدان العمومي، أمّا الوجدان الفردي فهو قاض بوجود الفرق الواضح بين أفعالنا نظير ضربان القلب وجريان الدم في العروق وحركة يد المرتعش، وبين أفعال اُخرى لا تصدر من الإنسان إلاّ بعد التصوّر والتصديق والإرادة سواء صدرت من الإنسان بلا تأمّل ومشقّة وبمجرّد تعلّق الإرادة والمشيّة عليه كحركة اليد غير المرتعش فإنّها تتحقّق بمجرّد الإرادة، أو لا تتحقّق بمجرّد الإرادة بل تحتاج إلى حصول مقدّمات ومباد كسيلان الدموع، فلا إشكال في أنّ الوجدان حاكم على عدم اختياريّة القسم الأوّل كما لا إشكال في أنّه يقضي باختياريّة القسم الثاني والثالث، بل لو اُقيمت صورة الف برهان على العكس نعلم إجمالا بوجود اختلال في بعض مقدّماته، لأنّه لا يقاوم الوجدان.
وأمّا الوجدان العمومي فلا إشكال أيضاً في أنّ جميع العقلاء من الإلهي والمادّي حتّى القائلين بمذهب الجبر يحكمون بأنّ المسؤول في الجرائم والتخلّفات والجنايات إنّما هو الإنسان نفسه، فيذمّونه ويجعلون لشخص المتخلّف غرامة معيّنة، والقول بالجبر يستلزم كون جميع المحاكم القضائيّة ظالمة ويستلزم أن يكون جميع المجازات ظلماً.
وبعبارة اُخرى: أنّ أصل المجازاة واستحقاق الظالم لها وجداني وإن كانت كيفيتها وخصوصّياتها اعتباريّة ومجعولة من قبل المقنّن المشرّع.
وهذا ممّا يقضي به الجبريون أيضاً بوجدانهم، والمنكر إنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، نظير إنكار السوفسطائي لأصل الوجود والمثالي للوجود الخارجي، فلا إشكال في أنّ القائلين بهذه المقالات يعترفون في مقام العمل بوجود الأعيان الخارجيّة كالنار والماء والهواء والسيارات والطيّارات فيطلبونها ويركبونها كسائر الناس من دون أي فرق.
كذلك العالم الجبري إذا قام في ميدان العمل ورأى نفسه في المجتمع البشري يلوم من غصبه حقّه ويشكو منه ويرى تعزيره وسجنه عدلا بينما تكون جميع هذه الاُمور على اعتقاده ظلماً وجوراً.
ويؤيّد ما ذكرنا من قضاء الوجدان بالاختيار ما رواه في اُصول الكافي عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه كان جالساً بالكوفة منصرفة من صفّين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه، ثمّ قال له: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أجل يا شيخ، ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر» فقال له الشّيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين؟ فقال له: «مه ياشيخ فوالله لقد عظّم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرّين» فقال له الشّيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرّين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له: «وتظنّ أنّه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً؟ إنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر
والنهي والزجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب، تلك مقالة اُخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان، وقدريّة هذه الاُمّة مجوسها، إنّ الله تبارك وتعالى كلّف تخييراً ونهى تحذيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يُعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً ولم يملّك مفوّضاً ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشّرين ومنذرين عبثاً، ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار».
فأنشأ الشّيخ يقول:
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته *** يوم النجاة من الرحمن غفرانا
أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً *** جزاك ربّك بالإحسان احسانا(4)
وفي نقل آخر(5) رواه العلاّمة المجلسي في البحار بعد ذكر ما مرّ: ثمّ تلا عليهم (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ) وفي نقل ثالث في البحار(6) أيضاً بعد عدّه (عليه السلام)الموارد العشرة من قضاء الله تعالى وقدره قال: «كلّ ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا».
وهذا الحديث الذي هو من غرر الأحاديث ومحكمات الأخبار المأثورة عن المعصومين (عليهم السلام) الذي تلوح عليه آثار الصدق ناظر إلى تفسير القضاء والقدر بالقضاء والقدر التشريعيين (كما ورد في ذيله) ثمّ تمسّك لإثبات بطلان مقالة الجبريين والقدريين بالوجدان الصريح من عشرة وجوه: أحدها: الثواب والآخر: العقاب والثالث: الأمر الرابع: النهي ... إلى آخر ما ذكره (عليه السلام) فإنّه لا يجتمع الثواب مع الجبر على الطاعة ولا العقاب مع الجبر على المعصية كما أنّه لا معنى للأمر على فرض الجبر على الطاعة لأنّه تحصيل للحاصل، ولا في فرض الجبر على المعصية فإنّه تكليف بما لا يطاق، وهكذا مسألة اللائمة والمحمدة والسؤال والعتاب كلّ ذلك لغو أو ظلم على القول بالجبر، وهو أمر واضح لكلّ أحد.
الوجه الثاني: ما يختصّ بالإلهيين وهو «دليل العدالة» وهو أنّ الجبر ينافي عدله تعالى كما أنّ القول بالتفويض ينافي التوحيد ويلزم منه خروجه تعالى عن سلطنته، وقد نصّ على هذا
المعنى أبو الحسن الرضا في عبارة وجيزة لطيفة وقد سأل عنه الراوي وقال: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعزّ من ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: «الله أعدل وأحكم من ذلك»(7).
وقد أجاب عنه الأشاعرة بوجهين:
أحدهما: من طريق إنكار الحسن والقبح العقليين وإنّ الظلم ليس قبيحاً على الباري تعالى.
ثانيهما: أنّه لو سلّمنا وقبلنا الحسن والقبح عند العقل إلاّ أنّه لا يصدق الظلم على أفعاله تعالى حتّى يحكم العقل بقبحه لأنّها تصرّفات في ملك نفسه وله أن يتصرّف في ملكه بما يشاء كيف يشاء لا يسأل عمّا يفعل.
ويجاب عن الوجه الأوّل: بأنّه سفسطة مخالفة للوجدان، مضافاً إلى أنّه مستلزم لانهدام أساس المذهب وهو معرفة الباري لأنّها مبنية على قبول وجوب التحقيق عن وجوده تعالى،
وهو مبني على وجوب شكر المنعم ووجوب دفع الضرر المحتمل وقبح تركهما، وكذلك معرفة النبي(صلى الله عليه وآله) لأنّها أيضاً متوقّفة على قبح اعطاء الله تعالى المعجزة بغير النبي الصادق الصالح لمقام النبوّة وإلاّ لو لم يكن اعطائه بالشيطان مثلا قبيحاً لم تثبت النبوّة والرسالة ولم يحكم العقل بوجوب النظر إلى دعوى من يدّعي النبوّة ومعجزته.
وعن الوجه الثاني: بأنّه لا دليل على جواز تصرّف الإنسان مثلا في مملوكاته مطلقاً بما شاء وكيف يشاء، فلا يجوز له مثلا إحراق أمواله بل العقل يحكم بخلافه وبجواز التصرّفات غير القبيحة، كذلك بالنسبة إلى أفعال الباري تعالى فإنّ تصرّفاته لا تكون إلاّ عن مصلحة، ومن المعلوم أنّ ما ذكر قبيح مخالف للمصلحة.
الوجه الثالث: «دليل الحكمة» فإنّ القول بالجبر يلازم كون بعث الرسل وانزال الكتب لغواً، لأنّه أمّا أن الله تعالى أراد طاعة عبده وأنّ ذات العبد مقتضية للطاعة فبعثه وزجره تحصيل للحاصل، وإمّا أن لا تكون ذاته مقتضية للطاعة بل لها اقتضاء العصيان فيكون بعثه أو زجره تكليفاً بما لا يطاق وكلاهما ينافيان حكمة الباري تعالى.
وهذا الوجه تامّ حتّى بناءً على إنكار الحسن والقبح العقليين، لأنّ كونه تعالى حكيماً ثابت بالنقل.
نعم أنّه وارد على مقالة من يقول: بأنّ الجبر في أفعال الإنسان ينشأ من إرادة الله تعالى ومشيّته الأزليّة، ولا تدفع قول من يرى أنّه ناش من عوامل اُخرى أمّا نفسانيّة ذاتيّة للإنسان كعامل الوراثة، أو خارجيّة عن ذاته كعامل الطبيعة والمجتمع إذا كانت قابلة للتغيير ولو جبراً.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) أورد مسألة الجبر والاختيار في مبحث التجرّي أيضاً، ثمّ ذكر هذا الوجه تحت عنوان «إن قلت» وأنّه ما فائدة انزال الكتب وإرسال الرسل؟ وأجاب عنه بأنّ فائدة انزال الكتب وإرسال الرسل هو انتفاع من حسنت سريرته منها وتكامله بها، وإتمام الحجّة بالنسبة إلى من خبثت سريرته.
أقول: هذا البيان مثله من مثله بعيد جدّاً لأنّه لا معنى للانتفاع أو إتمام الحجّة بناءً على العلّية التامّة في مقام الذات، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ مقصوده من العلّية إنّما هو الاقتضاء لا العلّية التامّة، ولكن هذا عدول عن ظاهر كلامه ومن يقول بمقالته ويحذو حذوه. هذا تمام الكلام في الأدلّة العقليّة لمذهبي الجبر والاختيار.
الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار :
وأمّا الأدلّة النقليّة : من الآيات والرّوايات فهي كثيرة لكلّ من الطرفين ، فالجبريّون استدلّوا بطوائف خمسة من الآيات التي تدلّ بظاهرها على أنّ الفاعل إنّما هو الباري تعالى فقط ( ولعلّ من مناشيء القول بالجبر هو ظاهر هذا القبيل من الآيات مع الجمود على ظواهرها من دون ملاحظة سائر الآيات والقرائن العقليّة ) :
الطائفة الاولى : ما تدلّ على أنّه تعالى خالق لكلّ شيء كقوله تعالى : {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ} [الأنعام: 102] وقوله تعالى : {أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } [الرعد: 16] وقوله تعالى : {فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ * قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 94 - 96].
والجواب عنها : أمّا الآيتان الأوّليان فالمراد من « كلّ شيء » فيهما إنّما هو الذوات والأعيان الخارجيّة بقرينة أنّ الكلام فيهما وفيما قبلهما من الآيات إنّما هو في خلق السموات والأرض وبقرينة أوائل الآية الثانيّة وهو قوله تعالى : {قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا } [الرعد: 16] فإنّه وارد في ما اتّخذوه شركاء لله تعالى وليست ناظرة إلى أفعال الإنسان كما لا يخفى.
وأمّا الآية الثالثة فهي أيضاً ناظرة إلى أوثانهم بما هي أوثان وذوات خارجيّة لا بما هي أعمال ، والشاهد على ذلك قوله تعالى « ما تنحتون » فإنّ كلمة « ما » هنا موصولة لا مصدريّة ، وبالجملة يستفاد من مجموع هذه القرائن أنّ هذا القبيل من الآيات منصرفة إلى الأعيان والذوات الخارجيّة ، كما يشهد على ذلك كلمة « شيء » حيث إنّها أيضاً تنصرف إلى خصوص الأعيان غالباً ولا يطلق على العمل.
هذا ـ ولو سلّمنا عموم هذه الآيات بالنسبة إلى الأفعال أيضاً ، لكن قد عرفت أنّ إسناد العمل إلى الله تعالى لا يمنع عن إسناده إلى الإنسان نفسه ، لأنّ أحدهما في طول الآخر ، وهو معنى الأمر بين الأمرين كما سيأتي تفصيلاً إن شاء الله.
الطائفة الثانيّة : الآيات التي تدلّ على نفي المشيّة عن العبد نحو قوله تعالى : {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } [الإنسان: 30].
والجواب عنها : أنّ مقتضى مذهب الأمر بين الأمرين عدم استقلال مشيّة العبد عن مشيّة الله تعالى وإن كانت إرادة العبد واختياره في طول ارادته وإنّ الله أراد أن يختار العبد ويريد الفعل الفلاني كما سيأتي في توضيح الأمر بين الأمرين مزيد بحث لذلك ، فمشيّة العبد حينئذ لا تنفكّ عن مشيّة الله أبداً ، وهذا لا ينافي الاختيار كما لا يخفى.
الطائفة الثالثة : الآيات التي تدلّ على نفي الفعل عن العباد كقوله تعالى : {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17].
ويمكن الجواب عنها بوجهين :
الجواب الأوّل : أنّ المراد منه نفي استقلال العبد في التأثير وكون الفاعل المستقلّ هو الله تعالى. وبعبارة اخرى : كما أنّ الوجود بالأصالة مختصّ بذاته تعالى ، وغيره موجود بإرادته ، فكذلك الأفعال الإنسانيّة منسوبة إلى الله تعالى بالأصالة ومنسوبة إلى العباد بسبب أنّ الله تعالى أعطاهم القدرة والاختيار والقوّة.
الجواب الثاني : أنّ هذا التعبير وارد في شأن غزوة بدر التي تختصّ بالإمدادات الغيبية ونزول الملائكة حيث
إنّ القتل إمّا أن يكون قد تحقق بأيدي الملائكة ، فسلب القتل عن المقاتلين لا بأس به ، وإمّا أن يكون قد صدر من المقاتلين مع نصرة من الملائكة فكذلك يمكن سلب القتل عنهم بهذا الاعتبار ، أي لولا الامداد الغيبي ونصرة الملائكة لم تقدروا على شيء ، وحينئذ يصدق قوله تعالى : {وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ }.
هذا بالنسبة إلى الفقرة الاولى ، وأمّا الفقرة الثانيّة فالمراد منها أنّ تأثير الرمي كان من الله تعالى، أي وما رميت إذ رميت رمياً مؤثّراً ، والشاهد على هذا وجود إسنادين في الآية ، فكما أنّه تعالى يسند الرمي إلى نفسه يسنده إلى رسوله أيضاً ، وهذا يشهد على أنّ المقصود من الرمي الأوّل إنّما هو رمي التراب أو الحصى ، ومن الرمي الثاني تأثيرها في قبض عيون الناظرين كما في الرّوايات (8) ، وبالجملة الفقرتين كلتيهما تفسّران بالقرينة المقاميّة الموجودة في الآية.
الطائفة الرابعة : ما تدلّ على أنّ الإيمان والعمل بجعل الله تعالى وبمساعدته نحو قوله تعالى : {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ} [إبراهيم: 40] وقوله تعالى : {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ } [المجادلة: 22].
والجواب عنها أوضح من الجواب عن الطائفة السابقة عليها ، فإنّها من قبيل التعبير الرائج بيننا من أنّ التوفيق بيد الله ، والتوفيق عبارة عن تهيئة أسباب الخير ومقدّمات العمل الصالح على حدّ الاقتضاء والاعداد لا العلّية التامّة كما لا يخفى ، وأمّا المراد من كتابة الإيمان فهو إثبات الإيمان واستقراره في القلب ، والمستفاد من الآية بقرينة الآيات السابقة عليها أنّ الحبّ في الله والبغض في الله يوجب ثبوت الإيمان ورسوخه في القلب ، فهو بمنزلة الجزاء والنتيجة لعمل اختياري صالح للإنسان ، أي التولّي والتبرّي في الله ، فلا ينافي كونه اختياريّاً ، فإنّ ما يكون بعض مقدّماته اختياريّاً اختياري.
الطائفة الخامسة : آيات الهداية والضلالة والتي تسندهما إلى الله تعالى وهي كثيرة :
منها : قوله تعالى : {فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [إبراهيم: 4].
ومنها : قوله تعالى : {وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [النحل: 93].
ومنها : قوله تعالى : {مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الأنعام: 39].
ومنها : {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: 56].
ومنها : {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا} [الأنعام: 125].
والجواب عنها أيضاً واضح ، ولكن قبل بيان الجواب الأصلي والمختار ننقل هنا ما قاله بعض الأعلام في مقام الجواب عنها ، وهو أنّ الهداية على معانٍ ثلاثة :
المعنى الأوّل : أنّ الهداية بمعنى إرائة الطريق ومنه قوله تعالى : {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [الشورى: 52].
المعنى الثاني : أنّها بمعنى الإيصال إلى المطلوب ، ومنه ما مرّ آنفاً من قوله تعالى : {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } فإنّ ما على النبي صلى الله عليه وآله إنّما هو إراءة الطريق فقط لا الإيصال إلى المطلوب ( والمراد من الإيصال اعداد المقدّمات والتوفيق الموصل إلى المقصود ).
الثالث : أنّها بمعنى ترتّب الثواب على العمل ، وتقابلها الضلالة بمعنى حبط الأعمال ، ومنه قوله تعالى : {وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 8].
أقول : إن كان مراده تفسير الضلالة بالمعنى الأخير كما يظهر من بعض كلماته فهو واضح الإشكال ، فإنّ كثيراً من آيات الضلالة لا تلائم هذا المعنى ولا دخل لها بمسألة الثواب والعقاب، وإن كان المراد إنّ كلاً من هذه المعاني الثلاثة للهداية تقابله الضلالة فهو حقّ لا ريب فيه ، فإنّ كثيراً من آيات الضلالة بمعنى سلب التوفيق وعدم اعداد المقدّمات نحو المطلوب كما ذكره كثير من المحقّقين ، وهذا أيضاً أمر اختياري ، لأنّ التوفيق وكذا سلبه من قبل الله لا يكون بلا دليل بل هو ناشٍ عن بعض أعمال الإنسان الحسنة أو السيّئة أو نيّاته وصفاته الحسنة والخبيثة.
والمختار في الجواب ـ عن مسألة الهداية والضلالة في القرآن ـ هو ما يستفاد من نفس الآيات الكريمة ، تارةً : على نحو الإجمال واخرى : على نحو التفصيل :
فالجواب الإجمالي : ما جاء في ذيل بعض الآيات المزبورة وهو قوله تعالى : {فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4] فإنّ قوله « وهو العزيز الحكيم » إشارة إجماليّة إلى أنّ مشيّة الله وإرادته ضلالة بعض العباد وهداية بعض آخر تنشأ من حكمته وعزّته ، فإنّ قدرته وعزّته متقاربة مع حكمته ومندرجة فيها ، ومشيّته ناشئة من كلتيهما معاً لا من القدرة فقط ، فإذا علمنا بأنّ إرادته تنشأ من الحكمة فإضلاله أو هدايته مبنية على ما يصدر من العباد أنفسهم من الأعمال السيّئة أو الحسنة ، وعلى أساس ما اكتسبوه من الاستحقاق أو عدم الاستحقاق للهداية والضلالة.
وأمّا الجواب التفصيلي : فهو ما تصرّح به كثير من الآيات من أنّ الهداية أو الضلالة تنشأ ممّا كسبته أيدي العباد وقدّمته أيديهم ، فبالنسبة إلى الهداية نظير قوله تعالى :
1 ـ {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].
2 ـ {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11].
3 ـ {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الكهف: 13، 14].
4 ـ {قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ } [الرعد: 27].
5 ـ {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2].
والمراد من التقوى هنا ظاهراً هو حالة قبول الحقّ وعدم اللجاج.
وبالنسبة إلى الضلالة نظير قوله تعالى :
1 ـ {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} [البقرة: 26].
2 ـ {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [البقرة: 258].
3 ـ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [الزمر: 3].
4 ـ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} [غافر: 28].
5 ـ {كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ} [غافر: 34].
6 ـ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [المائدة: 67].
فالمستفاد من الطائفة الأخيرة من الآيات أنّ أسباب الضلالة عبارة عن الفسق والظلم والكذب والكفر والاسراف والريب والاصرار على الكفر ، وهي بأجمعها امور اختياريّة تصدر من الإنسان وتوجب سلب توفيقه وقدرته على الهداية ، فيضلّ عن طريق الحقّ بسوء اختياره ، ولا إشكال في أنّ الآيات المطلقة التي تسند الهداية أو الضلالة إلى الله تعالى مطلقاً تقيّد بهذه الآيات طبقاً لقاعدة الإطلاق والتقييد وتفسّر بها ، ويستنتج أنّ هدايته فيض من جانبه يفاض على النفوس المستعدّة والقلوب المطهّرة بالأعمال الصالحة ، كما أنّ الضلالة عبارة عن قطع الفيض والاستعداد والتوفيق عن النفوس غير المساعدة وذلك بسبب الأعمال السيّئة والنيّات الخبيثة الصادرة عنهم ، فهذه الآيات مضافاً إلى أنّها غير دالّة على مذهب الجبر ، ظاهرة بل كالصريحة في مذهب الاختيار ، لأنّها بعد ضمّ بعضها إلى بعض تدلّ على أنّ الهداية والضلالة ناشئتان من الإنسان نفسه وإن كان ذلك بتسبيب إلهي من باب أنّ الأسباب تستمد قوتها من ساحته المقدّسة ، ومن هنا تنسب المسبّبات إليه تعالى أيضاً حقيقة.
الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر :
ثمّ إنّ هناك آيات كثيرة تدلّ على الاختيار بصراحتها أو ظهورها ، وهي على طوائف عديدة :
الطائفة الاولى : ما ينطق بمذهب الاختيار بالصراحة : نحو قوله تعالى {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا } [الإنسان: 3] فإنّه يدلّ بوضوح على الاختيار خصوصاً بملاحظة ما قبله من الآية : {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [الإنسان: 2] (والمشيج بمعنى الخليط ) فإنّه يستفاد منه أنّ الإنسان بحسب الفطرة مخلوط ومعجون من أسباب الهداية والضلالة ولذلك يكون في موقف الابتلاء والامتحان بإرائة الطريق وهداية السبيل ، فهو إمّا يشكر فيهتدي ، وإمّا يكفر فيضلّ. وهو مجموع ما يستفاد من الآيتين ، ونحو قوله تعالى : {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29].
وقوله تعالى : {إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} [المزمل: 19].
وقوله تعالى : {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [التكوير: 27، 28].
الطائفة الثانيّة : ما يدلّ على أنّ الإنسان رهين لأعماله ، ولازمه كونه مختاراً وإلاّ لا يكون مرتهناً بها :
منها : قوله تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38].
ومنها : قوله تعالى : {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21].
ومنها : قوله تعالى : {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } [البقرة: 286].
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على حسرة أهل النار وتمنّيهم الرجوع إلى الدنيا لجبران ما فاتهم من الإيمان والأعمال الصالحة ، فلو كانوا مضطرّين في أعمالهم لم ينفعهم الرجوع إلى الدنيا ولو ألف مرّة.
منها : قوله تعالى : {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ } [المؤمنون: 99، 100].
ومنها قوله تعالى : {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} [فاطر: 37].
ومنها قوله تعالى : {لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الزمر: 58].
وكيف ينطق إنسان بذلك إذا لم ير نفسه مختارة؟
الطائفة الرابعة : جميع الآيات الدالّة على ترتّب الثواب والعقاب والمدح والذمّ والسؤال والعتاب على أعمال العباد ، فإنّها مع القول بالجبر لا معنى لها ولا تكون مقبولة لدى العقل السليم بل تكون خطابات غير معقولة وكلمات مزوّرة باطلة ( العياذ بالله ).
الطائفة الخامسة : جميع الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب الكريم الدالّة على تكليف الناس ، فإنّ لازم مذهب الجبر خلوّها عن المغزى والمحتوى ولغويّة تبليغ الأنبياء وجميع معلّمي الأخلاق ، لأنّها إمّا أن تكون تحصيلاً للحاصل أو تكليفاً بالمحال كما لا يخفى على أرباب النهى.
الطائفة السادسة : جميع الآيات الدالّة على الامتحان والاختيار كقوله تعالى : {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} [العنكبوت: 2].
الطائفة السابعة : مجموع الآيات الدالّة على إسناد الأفعال إلى العباد حقيقة وهي كثيرة جدّاً كقوله تعالى : {الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} [الناس: 5، 6] فإنّ نسبة إيجاد الوسوسة في صدور الناس إلى الجنّ والانس دليل على أنّها مستندة إليهم حقيقة لا مجازاً ، والقرآن مشحون بمثل هذه الآيات.
وبها نجيب عن طائفة من الجبريين الذين يقولون : بأنّ إسناد الأفعال إلى العباد في الآيات الكريمة إسناد مجازي وإنّ عادة الباري تعالى جرت على أعمال إرادته عند إرادة الإنسان وإنّ العلّة التامّة إنّما هو إرادة الله فقط ، فإنّ هذا ينافي ظهور هذه الإسنادات بكثرتها في الحقيقة ، فإنّ حملها كلّها على المجاز مجازفة جدّاً.
__________________________
1. بدائع الأفكار: ج1، ص204 ـ 205.
2. رسالة الطلب والإرادة للإمام الخميني(قدس سره): ص108 ـ 109.
3. راجع، ج2، من تقريرات المحقّق الشهيد محمّد باقر الصدر(رحمه الله)، ص36.
4. اُصول الكافي: ج1، ص155.
5. بحار الأنوار: ج5، ص95 طبع بيروت.
6. بحار الأنوار: ج5، ص125 طبع بيروت
7. اُصول الكافي: ج1، ص157.
8. فقد ورد في الرّوايات أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام : « ناولني كفّاً من حصى وناوله ورمى به في وجوه قريش فما بقي أحد إلاّ امتلأت عيناه من الحصى » (تفسير البرهان ذيل الآية 17 من سورة الأنفال ) وفي الدرّ المنثور ذيل نفس الآية : « أخذ رسول الله قبضة من تراب فرمى بها ».



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|