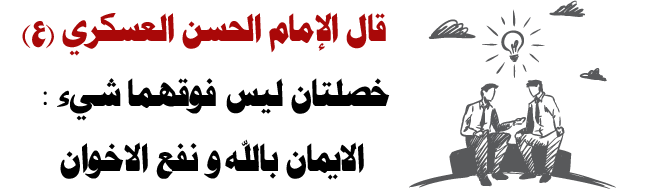
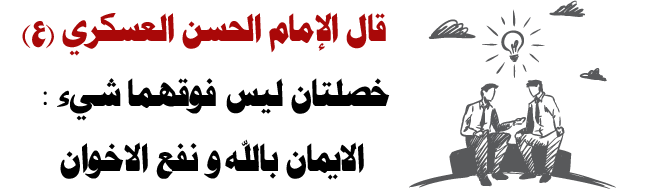

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2018
التاريخ: 20-2-2019
التاريخ: 25-4-2018
التاريخ: 30-4-2018
|
تبين المعطيات اللغوية ان حروف الجر لا تيتسعمل لوصف حقل الفضاء فحسب بل نجدها في العبارات الدالة على الملكية وفي العبارات الدالة على الزمن وفي العبارات الدالة على الاتصاف او التعيين (identification)، والفاسي الفهري (1986) ان العلاقات الفضائية المادية التي حللناها اعلاه تسقط في هذه الحقول الشهب – فضائية وتعمم عليها. وبذلك توصف هذه الحقول من خلال مفهومي الحلول والمسار. ويعتمد هذا الإسقاط على افتراضين: افتراض العلاقات المحورية الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق وافتراض التلاقح عبر الحقول الذي يقتضي ان تستجيب الحقول لتمثيل تحتي متجانس.
حقل الملكية
لننظر الى الجملتين التاليتين:
(14) أ- باع زيد الكتاب لعمرو
ب- ا عطى زيد الكتاب لعمرو
نعبر بواسطة هاتين الجملتين عن انتقال في ملكية الكتاب من مالك قديم (" زيد " الى مالك جديد ("عمرو"). والمالك الجديد يكون مفعولا لحرف اللام (أو " الى " في حالات أخرى ). وقد يرد المالك الجديد بدون حرف غير ان هذا المالك يكون هدفا للانتقال. والجملتان كتلتاهما تستلزمان انتقال ملكية الكتاب من " زيد " الى " عمرو ".
غير ان البنيتين (14) لا تعبران سوى عن جزء من انتقال المليكة.وتعبر الجملتان (15) عن الجزء الثاني من انتقال الملكية:
(15) أ- اشترى عمرو الكتاب من زيد
ب- تلقى عمرو الكتاب من زيد
بحيث نرى ان المالك الجديد يكون فاعل الجملة ؛ أما المالك القديم فيكون مفعولا للحرف " من ". وبهذا فالجملتان (14) تممثلان فكرة " الانتقال الى "، فيما تمثل البنيتان (15) فكرة " الانتقال من ". وهذه الاستعمالات كلهيا استعمالات حركية لارتباطها بأفعال تفيد الحركة(1). غير أننا نجد استعمالات غير حركية تعبر عن المليكة، وتكون دالة على وضع استقراري، ويكون مفعول الحرف هو المالك:
ص121
(16) أ- كان لي امل
ب- كانت لي ثروة هائلة
ونلاحظ ان الجملتين (16) يمكن أن نفسرهما بالجملتين: " كنت أملك أملا"، و " كنت أملك ثروة هائلة "، تباعا.
ومن استعمالات الملكية غير الحركية، التي تتسم بظهور الحرف " في "، المثالان التاليان:
(17) أ- كان في جاه ومال
ب- إنه في غنى يحسد عليه
ونستخلص ان الجمل (14-17) تستخدم العلاقتين الفضائيتين الأساسيتين (الحلول المسار) في الدلالة على الملكية، من خلال اعتمادها على الحروف الفضائية التي حللناها أعلاه، وبعبارة أخرى، فالعلاقات الفضائية تبنين حقل الملكية. ولكن، كيف يتم ذلك ؟
حين نستعمل العلاقات الفضائية للدلالة على الفضاء المادي، يكون مفعول الحرف عبارة عن مكان، وحين نستعملها للدلالة على الملكية، لا يكون مفعول الحرف مكانا، وإنما شخصا. وبهذا يكون الانتقال، في الملكية، من شخص الى شخص، ويكون الحلول للشخص في الشيء المملوك.ولهذا تعتبر الملكية شبه – فضاء.
والملاحظ ان حقل الملكية حقل مغاير للحقل الفضائي، ذلك أن الملكية تتشكل من أسرة من الحقول، بحيث توجد مفاهيم متعددة للملكية. ولعل أهم تمييز داخل حقل الملكية ذلك التمييز بين الملكية الثابتة، مثل أمتلاك الفرد لأنفه أو ليده، والملكية غير الثابتة، مثل امتلاك الفرد لكتاب أو لسيارة وما شابههما(2). ويمكن أن نسمي الملكية الأولى ملكية انعكاسية، والملكية الثانية ملكية متعدية. وتتعدى الثانية الى شيء ليس جزءاً من المالك، أما الأولى فعلاقة الملكية فيها بين المالك والمملوك علاقة جزء بكل.
ومهما تكن الملكية التي نتحدث عنها، فالملاحظ أن المالك فيها يسلك سلوك عنصر المكان في الحقل القضائي. ويكمن التوازي بين الملكية غير الثابتة (التي اعتمدناها في الأمثلة السابقة) والمكان في أن عبارة الملكية: " س يملك ص " هي الموازي التصوري للعبارة الفضائية: " ص يوجد في س ".
ص122
ومن خصائص الملكية، التي تميزها عن الفضاء، ان الانتقال في الملكية انتقال متقطع، بحيث ان الشيء المملوك ينتقل مباشرة الى نهاية المسار (المالك الجديد). ونعلم ان الانتقال في القضاء يتطلب أن يقطع المحور كل النقط الفضائية الفاصلة بين بداية المسار ونهايته.
وتمثل الجمل (18) لأهم الأفعال التي تندرج في حقل الملكية:
(18) أ- يملك زيد سيارة
ب- تلقى زيد هدية
جـ- أضاع الأمير مُلكه
د- فقد ماله
هـ - أعطت هندا قميصا لعمرو
و- صانت هند متاعها
ز- حافظت على مالها
ح- باعت الأستاذة كتبها لزيد
ط- اشترى زيد الكتب من الأستاذة
ي- بقي الكتاب في حوزته
ونجد ان بعض الافعال مشتركة بين حقل الفضاء وحقل الملكية(3)، ومنها " مكث " و " بقي "، إذ نقول:
(19) أ- بقي زيد في البيت طول النهار
ب- مكث الطفل على مقعده
وهذان الفعلان استقراريان، ولذلك ترد معهما حروف حلولية، ولا يمكن ان ترد معهما حروف مسارية:
(20) أ- * بقي زيد من / الى البيت طول النهار
ب- * مكث الطفل من / الى مقعده
ويسري هذا القيد على عبارات الملكية، بحيث لا يمكن ان نقول، عوض (18 ي)، الجملة (21):
(21) * بقي الكتاب من / الى حوزته
ص123
واذا كان التركيب مصدر – هدف، الذي يتخذ الشكل " من أ الى ب"، واردا في التعبير عن الفضاء، فإننا نجده في حقل الملكية كذلك. ويستعمل هذا المركب، في حقل الفضاء للدلالة على انتقال المكون الحامل للدور الدلالي المحور بين مكانين (مصدر وهدف). أما في حقل الملكية فيستعمل للدلالة على الانتقال بين شخصين. ولعل أكبر دليل على توازي العلاقات التي في الحقلين التباسُ جمل مثل (23) بين تأويل الملكية والتأويل الفضائي، أما الجملة (22) فلا يظهر فيها التباس رغم أنها مبنية بنفس الشكل:
(22) انتقل الكتاب من زيد الى عمرو
(23) انتقل خالد من زيد الى عمرو
وما يميز بين هاتين الجلتين هو نوعية المحور (" الكتاب " في الأولى، و " خالد " في الثانية). فكل من " زيد " و " عمرو" في الجملتين في مكان (مكان بداية الحركة ومكان نهايتها، على التوالي). وما يتميز به المحور في (22) أنه [- حي ]، في حين ينتمي المحور في (23) الى ما كان [+ حي]. وهذا هو أصل الالتباس، بحيث لا نعرف هل انتقال المحور في (23) انتقال على اساس الملكية، أم انتقال على أساس الفضاء. وهذا الالتباس غير حاصل في (22) لأن المحور فيها لا يمكن أن ينتقل إلا ملكيا، أما محور (23) فقد ينتقل فضائيا، وقد ينتقل ملكيا.
لنعد الى المثالين الواردين في (14)، من أجل الوقوف على بعض خصوصيات حقل الملكية التي تميزه عن حقل الفضاء. هناك فرق بين (14 أ) و (14 ب)، بحيث تصف الجملة الاولى انتقال ملكية مكلفاً، وتصف الجملة الثانية انتقال ملكية غير مكلف، والفرق بين المكلية المكلفة والملكية غير المكلفة أن الأولى تعبر تصوريا عن انتقالين: انتقال المحور وانتقال مقابله من مال وما أشبهه (انتقال وانتقال معاكس)، فيما تعبر الثانية عن انتقال واحد فحسب، ولا نجد في حقل الفضاء ما يقابل الانتقال في بنية الملكية المكلفة الذي نمثل له بواسطة (24):
(24) انتقال الملكية المكلّف (= " باع " ):
أ- ينتقل المحور من (أ) الى (ب)
ب- ينتقل المقابل من (ب) الى (أ)
ومن نتائج هذا الانتقال المزدوج ازدواج الدور المسند الى كل من (أ) و (ب). فالمكون (أ) يكون مصدرا للمحور وهدفا للمقابل، والمكون (ب) يكون هدفا للمحور ومصدراً للمقابل (4).
ص124
حقل الزمن
تشير الأدبيات الى أن هناك تماثلا كليا بين الحروف الدالة على الفضاء والحروف الدالة على الزمن. وترتبط المركبات الحرفية بجملها بالكيفية نفسها التي ترتبط بها المركبات الحرفية الفضائية بجملها. والمعطيات (25-27) تثبت ذلك ؛ بحيث تمثل (25) مركبات حرفية زمنية، وتمثل (26) ما يقابلها من مركبات حرفية فضائية ؛ ونلاحظ في (27) التماثل الحاصل في ارتباط كل نوع من المركبات الحرفية بالجملة:
(25) أ – في الساعة العاشرة
ب- من الأربعاء الى الجمعة
جـ - في سنة 1976.
(26) أ- في الغرفة
ب – من الكلية الى البيت
جـ - في فاس
(27) أ – كتبتُ مذكراتي في 1976
تناولت العشاء في الثامنة
يتضح من هذه المعطيات ان العبارات الزمنية تعبر عن شبه – فضاء ذي بعد أحادي، وهذا البعد الأحادي يتمثل فيما يسمى بالخط الزمني. وهنا يكمن الفرق الجوهري بين الزمن والفضاء (5).
وللنظر في عمق التماثل بين الحقلين، نشير الى ان نماذج الجمل والأفعال التي ترد صحبة عبارات الفضاء المادي تظهر صحبة عبارات الزمن. لنقارن بين المجموعة (28)، التي تعبر عن علاقات زمنية، والمجموعة (29) التي تعبر عن علاقات فضائية:
ص125
(28) أ- الاجتماعُ في العاشرة
ب- نقلنا الاجتماعَ من الأربعاء الى الجمعة
جـ- رغم أنشغالاتنا، أبقينا الاجتماع في العاشرة
(29) أ- النافورةُ في الساحة الكبرى
ب- نقلنا النافورة من الساحة الى الحديقة
جـ- أبقينا النافورة في الساحة
فهاتان المجموعتان من الجمل تبنيان قوة التوازي الحاصل بين الحقلين. فعندما نريد التعبير عن وضع استقراري (أو حالة) نستعمل الجملة الاسمية، كما في (28 أ) و (29 أ)، التي تعبر عن هذا النوع من الأوضاع. وحين نريد التعبير عن التغيير تتماثل أفعال الحركة المعبرة عن الحقلين، وهذا واضح في (28 ب – ج) و (29 ب – ج). ونلاحظ الشيء ذاته في الدلالة على الامتداد، إذ يوازي الامتداد الزمني الامتداد الفضائي. ولنقارن، في هذا الخصوص، بين (30 أ) و (30 ب):
(30) أ – امتد الخطاب من الثانية الى الرابعة
ب- تمتد الطريق من فاس الى مراكش
للتدقيق في قوة هذا التوازي، علينا النظر في التداخل الحاصل بين العبارات الفضائية والعبارات الزمنية التي تقابلها. فالفعل الدال على الامتداد في (30 ب) يحول شيئا ومساراً فضائيا الى حالة استقرارية، ويفيد ان الشيء (وهو " الطريق ") يحتل كل نقطة في المسار. وفي الامتداد الزمني، الذي تعبر عنه (30 أ)، نجد أن الفعل الدال على الامتداد يحول حدثا (وهو " الخطاب " ) ومساراً زمنيا الى حالة، ويفيد ان الحالة تحتل كل النقط الزمنية الموجودة داخل المسار الزمني.
إن الفعل " نقل "، في (28 ب)، يفقد معنى العبور غير المتقطع الذي يفيده في الفضاء (انظر (29 ب))، فهو يفيد أنه في بداية الحدث الذي يصفه كان الاجتماع في الأربعاء، وفي نهايته في الجمعة. فإذا كان المسار الفضائي غير متقطع من حيث تصوره، فإن المسار الزمني قد يُتصور متقطعا.
وليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي قد يُتصور بها الزمن. هناك صيغة أخرى يكون فيها الزمن محورا يتحرك أو يحل في مكان، عوض أن يكون مفعولاً للحرف، لنقارن بين (31) و (32):
ص126
(31) أ- يقترب الإثنين بسرعة
ب- كان مستقبلنا امامنا
(32) أ- كان القطار يقترب بسرعة
ب- كانت الحقول أمامنا
فالمراحل الزمنية هنا تُتصور كما لو كانت تتحرك في علاقتها بالمتكلم الذي يعتبر مُعانيا لها (experiencer). وهذا المعاني يصير هو الكيان المحيل. وينبغي أن نلاحظ سلوك هذا النوع من الزمن باعتبار ما قلناه سابقا. فهذه العبارات تبدو دائما أكثر حركية بالمقارنة بما سبق، ويبدو أن السبب كامن في أن هذه العبارات ترتبط بتجربة الزمن ومعاناته، خلافا للأمثلة السابقة التي تجعل الزمن مجردا من المعاناة، ولا تتنبأ بإمكان جعل الفرد يعيش الزمن كمراحل مختزلة تتحرك داخل الأحداث، لا أن تتحرك الأحداث داخلها (6).
ومن خصوصيات حقل الزمن في العربية التعبير عن المصدر الزمني بحرف مخ صوص، وهو الحرف " منذ ". ومن خصائص " منذ " إفادته لابتداء الغاية، شأنه في ذلك شان الحرف " من ". غير أنه، إذا كان " من " يستعمل في كل الحقول، فإن " منذ " لا يستعمل إلا في حقل الزمن. ويكون مفعول الحرف اسما دالا على الزمن، كما في:
(33) يكتب زيد الشعر منذ صباه
وما دخل عليه " منذ " ولم يكن دالا على الزمن، يؤول على الزمن، وليس على شيء آخر:
(34) لم أره منذ حادثة الغاز المشؤومة
ومعناه: منذ حصول تلك الحادثة. كما أن الجملة التالية لا يمكن أن تؤول إلا على الزمن خلافا لما يُعتقد:
(35) لم يحدثني منذ الرباط وما ودعني بعد الوصول الى فاس
تصف هذه البنية المعقدة، من بين ما تصفه، مسارا يبدو فضائيا لأول وهلة (من الرباط الى فاس)، غير ان هذا المسار مسار زمني محدد بواسطة اسمي مكان (ومعناه: " منذ زمن وجودنا بالرباط، إلخ " ).
ص127
للمسار الفضائي قطبان هما عبارة عن المصدر وعبارة الهدف، وعلى القطبين أن ينسجما، بحيث ينبغي أن ينتميا الى نفس الحقل. ويسمى هذا القيد انسجام قطبي المسار. وتخضع كل الحقول لهذا القيد، بما فيها حقل الزمن. والمعطيات (36-37) تؤكد ذلك:
(36) أ- سافرتُ من فاس الى مراكش (مسار فضائي)
ب- حاضرتُ من الساعة الثالثة الى الساعة الخامسة (مسار زمني)
(37) أ- * سافرت من فاس الى الساعة الخامسة
ب- * حاضرتُ من الساعة الثالثة الى مراكش
والمسارات الواردة في (36-37) مسارات تامة، تتضمن القطبين معا. ومن خصائص " منذ " أنها ترد في مسار غير تام، بحيث لا يرد بعدها مركب من نوعها دال على الهدف. ولهذا لا نجد معطيات من قبيل:
(38) أ- * اشتريتُ هذا الكتاب منذ صغري الى سن الأربعين
ب- * نام منذ ثلاث ساعات الى الآن
إذن يختلف الحرف "منذ" عن "من" في كونه يستعمل في حقل الزمن فحسب، وفي كونه يرد في مسار غير تام. غير أن عدم تمام المسار لا يعني أن القطب الثاني (وهو الهدف) ليس وارداً من ناحية التأويل. فبروز الهدف مع " منذ " يفيد نهاية الحدث، والحال أن "منذ" يُستعمل لإفادة المصدر وإفادة هدف مقتضى تقديره، مع فعل ماض، " الى الآن". لذلك كانت الجملتان (38) لا حنتين، لأنهما لا تقتضيان هدفا، وإنما تحققانه. وعلاوة على هذا، فإنه إذا كان المسار الزمني فضاء يمتد عليه الحدث، فإن الجملة (38 أ) لا تفيد امتداداً زمنيا للفعل " اشترى "، وإنما تفيد حدثا حصل وانقطع، ولا يمكن لهذا الحدث أن يتردد عبر مسار معين.
حقل التعيين
نكون بصدد حقل للتعيين حين يُسبغ وصف ما (أو خاصية) على موضوع داخل الجملة. وأهم ما يمكن أن نسجله في هذا الحقل أن التحلي بخاصية ما يقوم بدور الفضاء في الحقل الفضائي، والتحلي بصفة معينة إما أن يكون ثابتا على الموضوع، وإما أن يكون متغيراً.
لننظر الى الأمثلة (39):
(39) أ- محمد رسام
ب- تحولت هند الى مُغامرة
جـ- تحول سلوك المديرة من الرزانة على عدم المسؤولية
ص128
فالتعيين في (39 أ) يعني التحلي بصفة " رسام "، وترجمتها بالتعبير الفضائي هي: " الصفة " رسام " توجد في الموضوع " محمد " ". غير أن الحالات النفسية ترد بعكس هذا المعنى، بحيث يكون الموضوع في صفته:
(40) أ- إنه في حيرة من أمره
ب- خالد في حيص بيص
جـ - إنه في حالة من الحزن والغم
أما المسار الجزئي الموجود في (39 ب) والمسار التام الموجود في (39 ج) فيقدمان الصفة بوصفها مصدرا وهدفا يتنقل بينهما الموضوع الموصوف.
أما الجمل التي تكون من قبيل (41):
(41) بقي زيد وزيرا
فتعني استمرار التحلي بصفة معينة، وتتضمن حرفا تحتيا هو [في]، شأنها في ذلك شأن (39 أ). وهذا الحرف لا يتحقق إلا جزئيا، كما في (40). غير أن الانتقال التعييني يتطلب حروفاً متحققة سطحاً (كما في (39 ب – ج)). فإذا كان التعيين حلوليا، وكان الموضوع في الصفة، لم يظهر الحرف الحلولي " في " بالضرورة، لكون التعيين القائم يمعجم هذا المعنى داخل الفعل، بخلاف الاستعمال الفضائي. ولعل الدليل على وجود الحرف " في " وعدم تحققه في هذه البنى وجوده في بنى مشابهة:
(42) أ- في هذا الرجل مكر
ب- في وزير كم استكبار
إن " المكر " و "الاستكبار " في (42 أ – ب) صفات نضفيها على الموضوعين ("رجل " و " وزير كم " ن تباعا). ونلاحظ الشيء ذاته في العربية المغربية:
(43) أ- احمد فيه الكذوب (حرفيا: " أحمد فيه الكذب" )
ب- مليكة فيها النعاس (حرفيا: " مليكة فيها النوم" )
فالصفات تسند الى الموصوفات فضائيا. ذلك أن الكيانات، في تصورنا، عبارة عن فضاءات تحل فيها الأوصاف، وتنتقل الكيانات عبر هذه الأوصاف.
ومن مميزات هذا الحقل توظيف حرف الجر " الكاف " لوسم ما يسمى بالتعيين الحلولي. ولا نعثر على هذا الاستعمال في اللغة العربية القديمة، ولربما تسلل الى العربية في إطار اقتراض معين. ولا يفيد هذا الاستعمال التشبيه، وإنما التعيين:
ص129
(44) أ- كنت أعمل كمدرس
ب- كمواطن، من حقي إبداء رأيي
و" الكاف " عبارة عن حرف حلولي، شأنه في ذلك شأن " في ". وقد ترد مقابلات وصفية للمركبات التي يرد فيها " الكاف " بدون هذا الحرف:
(45) كنت أعمل مدرسا
ص130
________________
(1) تحدثنا، في الجزء الثاني من الفصل الثالث، عن العلافة بين افعال من قبيل " اشترى " و " باع "، او " اعطى " و " تلقى". وسمينا هذه العلاقة علاقة توارد. ويعني ذلك أن القيود الانتقائية المفروضة على أحد التركيبين تكون مفروضة على التركيب الذي يقابله. وقد أدت هذه العلاقة الى افتراض شكل تحتي يجمع بين التركبين المتعالقين بالتوارد، انظر غروبر (1965)، الفصل الأول بالخصوص.
(2) انظر ميلر وجونسن – ليرد (1976) في تفعيل أسرة حقول الملكية.
(3) انظر الفاسي الفهري (1985)، الفصل الثامن، والفاسي الفهري (1986) الفصل الأول.
(4) واضح أن للعنصرين (أ) و (ب) وظيفتين أو دورين دلاليين، وهذا يناقض المقياس المحوري الذي دافع عنه شومسكي (1980)، والذي يفترض أن كل مكون يتلقى دورا دلاليا واحدا، وأن كل دور دلالي يسند الى مكون واحد فقط. ويعتمد جاكندوف (1983) على هذه المعطيات لإفراغ الجزء الأول من المقياس المحوري من محتواه التجريبي.
(5) يمكن الفرق بين الزمن والفضاء في كوننا لا نتصور الفضاء باعتباره خطا واحدا، بل نتصوره متعدد الخطوط والابعاد. أما الأزمنة فلا يمكن أن نتصورها إلا منظمة في خط واحد يتدفق عبره الزمن، ولا يمكن للأزمنة أن تتموقع خارج الخط، سواء أكانت أزمنة دقيقة أم مراحل زمنية.
(6) يذهب لايكوف وجونسن (1980) الى ان هذا التصور الزمني عبارة عن تنظيم استعاري للزمن، بحيث إننا نتصور الزمن في الجملة (31 أ) كيانا متحركاً. وتعتبر اللغات الزمن شيئاً يتحرك باتجاهنا، ولذلك نتصور الماضي وراءنا والمستقبل أمامنا. ويمكن فهم هذا من خلال لفظي " الماضي" و " المستقبل ": الماضي هو ما مضى (أي تحرك في اتجاه يتافينا)، والمستقبل هو ما يأتي في اتجاهنا فنكون له مسقبلين، غير ان هذا التنظيم ليس التنظيم الوحيد للزمن في اللغة. وانظر لا يكوف وجونسن (1980) من 59-62.
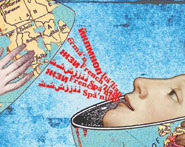
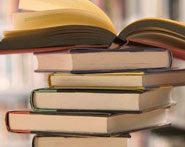

|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|