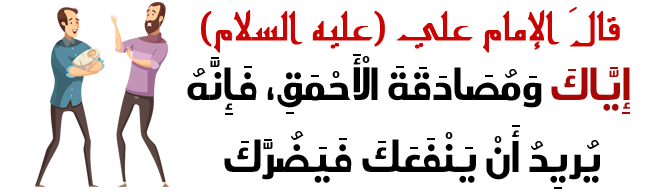
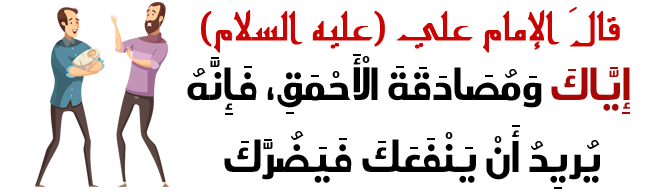

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2016
التاريخ: 5-10-2016
التاريخ: 31-8-2022
التاريخ: 5-10-2016
|
الجاه ملك القلوب بالطاعة والانقياد لاعتقاد الاتصاف بكمال حقيقي أو وهمي، فحبّه إن كان لحب الغلبة والاستيلاء كان من رذائل الغضبية وإن كان لحب الحظوظ النفسانية والمشتهيات البهيمية حيث يتوصل به إليها كان من رذائل الشهوية وإن كان من الجنسين كان من رذائلهما معاً، وهو الغالب في حدوثه، والآيات والأخبار في ذمه ممّا لا تحصى.
قال الله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83].
وعن النبي صلى الله عليه وآله: «حبّ المال والجاه ينبتان النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل» (1).
وقال الصادق عليهالسلام: «فوالله ما خفقت النعال خلف رجل الا هلّك وأهلك» (2).
وقال عليهالسلام: «ملعون من ترأّس، ملعون من همّ بها، ملعون من حدّث بها نفسه» (3).
وقال عليهالسلام: «والله إنّ شراركم من أحبّ أن يوطأ عقبه» (4) وغير ذلك ممّا لا يحصى.
وممّا يوضح قول الرسول صلى الله عليه وآله أنّه ينبت النفاق هو أنّ من ابتلي بهذه الخصلة قصرت همّته على مراعاة الخلق والتودّد إليهم ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم وذلك بذر النفاق، ويؤدّي إلى التساهل في العبادات واقتحام المحظورات للتواصل بها إلى اقتناص القلوب، فإنّ النفاق مخالفة الظاهر للباطن قولاً أو فعلاً، والطالب للمنزلة في قلوب الناس مضطرّ إليها وإلى التظاهر بخصال حميدة هو عار عنها، وهو عين النفاق.
ثم الباعث لحدوث هذه الخصلة الذميمة والحرص على ازديادها إمّا دفع ألم الخوف الناشئ عن سوء الظنّ وطول الأمل حيث إنّه لطول أمله يقدّر تلف ما يحتاج إليه في معيشته ودفع ضرورته من الأقوات والأموال، وحدوث بعض الحوادث والمصائب والأذياب، فيحتاج إلى الاستعانة في تحصيل ما يحتاج إليه ودفع ما يريد الاجتناب عنه بتسخير قلوبهم له في ذلك، وربما يزداد حرصه في ذلك كما يزداد حرصه في جمع الأموال بالتقديرات البعيدة من حدوث حادث يزعجه عن وطنه، أو يزعج أهل الأمصار البعيدة عن أوطانهم إلى البلد الذي هو فيه، فيحتاج إليهم في جلب نفع أو دفع ضرر، فيطلب تسخير قلوبهم لذلك وهكذا، فيحصل له بذلك أمن من الخوف الناشئ له من تلك التقديرات الناشئة من سوء الظنّ بالله (عزّ وجلّ) وطول أمله.
وإمّا ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ النفس الانسانية لتجرّدها تشبه المبدأ في ميلها إلى صفات الربوبية كالعلم والقدرة والكبر والعزّ والاستعلاء، فإنّ مقتضاها التمامية، أي التفرّد بالوجود والكمال وما هو فوقها أعني رجوع كل وجود وكمال إليه، فكما أنّ الكمال للشمس بوجودها وحدها فلو كان معها شمس أخرى كان نقصاً في حقّها إذ لم يتحقّق فيها كمال الشمسية، وهذا وكمالاته إليه تعالى فلا يوجب حصولها نقصاً في كماله، كما أنّ إشراق الشمس في الأقطار لا يعد نقصاً في حقها، وإنّما يتحقّق نقصانها بوجود شمس أخرى مساوية لها في الرتبة، بل تعدّ كمالاً له لكونها من إشراق نور القدرة الالهية، الا أنّ ذلك لا يوجب زوال حبّه وتعشّقه للكمال، لكونه محبوباً بالذات فيطلب الممكن في حقّه أي حصول نوع من الاستيلاء له على الموجودات إمّا بالعلم والمعرفة خاصّة فيما لا يقبل التغيير (5) كذات الواجب وصفاته وعالم المجرّدات، أو فيما لا يقبله ولا يتمكّن من التصرفّ فيه كالسماوات وما فيها لما عرفت من أنّه نوع استيلاء، بل هو أعظم من ملكيّة الأعيان، أو به وبالقدرة بالتصرّف فيه كيف يشاء فيما يقبله ويتمكّن منه كالأراضي وأجزائها بالحيازة والضبط أو الزرع والغرس والركوب والحمل والرفع والوضع والإعطاء والمنع وكنفوس بني آدم بالتسخير والتصرّف فيها بالأمر والنهي والمحبّة والاطاعة والانقياد، ولذا يطلب استرقاق العبيد واستعباد العباد ولو قهراً، فالنفس تحبّ الكمال بالعلم والقدرة لذاته، وإنّما تحبّ المال والجاه لكونها (6) من أسباب القدرة، ولكونها غير متناهية لا تكاد تقف النفس في طلبهما إلى حدّ وتلتذّ على حسب ما تدركه وتطلب ما هو عادم له ممّا يتصوّر إمكانه في حقّه، لكن حبّها للجاه أكثر من المال؛ لأنّ المال معرّض للتلف، ومطمع الظلمة والسارقين، فيحتاج إلى الحفظ والحراسة، ويتطرّق إليه أخطار (7) كثيرة بخلاف القلوب؛ لاحتفاظها من الآفات الا بتغيّر الاعتقاد؛ ولأنّ التوصّل به إليه أيسر من العكس؛ لأنّ الأموال مسخّرة للقلوب، فتسخير القلوب يستلزم تسخيرها بطريق أولى، بخلاف صاحب المال اللئيم الخسيس العاري عن الكمال، حيث إنّه لا يمكن له التوصّل به إلى الجاه؛ ولأنّ سرايته وازدياده لا يحتاج إلى مزيد كلفة وتعب بخلاف المال، حيث يحتاج استنماؤه إلى مقاساة شديدة ونصب.
ثم إنّ علاج هذه الرذيلة الموبقة مركّب من علم وعمل، فالعلمي أن يتفكّر في أنّه وإن كان صادقاً فيما تصوّره كمالاً من العلم والقدرة وحبّه لهما الا أنّه اشتبه الأمر عليه بإغواء الشيطان في كون الكمال الحقيقي في الاستيلاء على الملك الذي لا زوال له، والتمكّن من العزّ الذي لا ذلّ معه، والحياة الأبديّة التي لا فناء يعتريها، والسعادة الحقيقية التي لا قصور فيها، فإنّ كمال المعلول في التشبّه بمبدئه، فكلّما كان عن التغيّر بالعوارض أبعد كان إليه تعالى أقرب، وهذا ممّا لا يحصل للعبد الا بالعلم بحقائق الأشياء سيّما ما لا يكون قابلة للتغيّر والانقلاب، كالعلم بالله سبحانه وصفاته وأفعاله على نهج أجلى وأوضح وأتقن وأوفق للمعلوم، فإنّه الاستيلاء الحقيقي الذي تترتّب عليه تأثيرات بعض النفوس في موادّ الكائنات بأنواع التأثيرات بقدر مراتبها كما أشرنا إليه مراراً، بل يبقى تأثيرها بعد الموت أيضاً كما تشهد به التجربة الحاصلة من الاستغاثة بالأموات وبالتحلّي بسائر فضائل الملكات حتى توجب صفاء للنفس مؤدّياً إلى الاستخلاص عن أسر الشهوات وعبوديّة قواها الشهوية والغضبية واستيلائها عليها تشبّهاً بالملائكة المقدّسين عن القوّة البهيمية والسبعيّة.
على أنّه قد يقال بعدم ثبوت قدرة للعبد بحيث يكون له كمالاً حقيقياً، فإنّ حقيقتها لله تعالى وما يحدث عقيب إرادة حادثة بإحداثه تعالى (8) فتأمّل.
وأمّا الاستيلاء على الأعيان بالملك والتصرّف وعلى القلوب والنفوس بالطاعة والانقياد فهو من الزائلات الفانية، وهو في الحقيقة عجز للنفس وعبودية بالنسبة إلى قواها الشهوية والغضبية، مضافاً إلى كونها مبعّدة عن الله تعالى بعيدة عن كمالاته الدائمية وقدرته النافذة الحقيقية، ولو تأمّلت في الحقيقية عرفت أنّ التمكّن من لذّات الدنيا بأسرها ليس تمكّناً حقيقياً لك منها، بل هو تمكّن لها منك وتسلّط لها عليك، فما أشدّ اغترارك حيث تظن العجز قدرة والنقص كمالاً.
نعم لابدّ من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، كما أنّه لا بدّ من أدنى مال لضرورتها. فكما لا يستغني عن طعام يتناوله ويجوز حبّه للتوصّل به إلى بقاء خادم النفس أعني البدن وحبّه لما يتوصّل به إليه أعني المال، فكذا لا يستغني عمّن يخدمه ويعينه في قضاء حوائجه ويحرسه عن شرّ الأشرار وظلمهم، فحبّ ما يحصل بسببه في قلب الخادم ما يدعوه إلى الخدمة، وفي قلب الرفيق ما يحسن بسببه الرفاقة، وفي قلب السلطان ما يدفع به الشرّ عن نفسه ليس مذموماً، فلا فرق بينهما في كون كلّ منها وسيلة إلى الأغراض، فكما يحتاج الانسان إلى المبرز لقضاء حاجته ولو فرض استغناؤه عنه كرهه، فكذا حبّهما لأجل التوصّل بهما إلى ضروريات المعيشة ليس مذموماً كما أشرنا إليه سابقاً، وإنّما المذموم حبّهما لذاتهما وفيما يجاوز الضرورة لتوهّم كونهما من الكمالات الحقيقة.
ولا يذهب عليك أنّ الذمّ في اصطلاحنا هذا أعمّ ممّا يوجب الفسق والعصيان في ظاهر الشريعة، فلا يحصل الثاني الا إذا حمله الحبّ لمزبور على مباشرة المعاصي أو اكتسابهما بكذب وتلبيس وغيرهما كأن يظهر للناس قولاً أو فعلاً يورث اعتقادهم فيه ما ليس فيه كالعلم والورع والنسب ونحوه العبادة، إذ التوصّل إليها بها يؤول إلى الرياء الحرام، كما يأتي.
نعم يستباح اكتسابهما بصفة يكون متّصفة بها كما قال يوسف عليهالسلام: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55] وكذا بستر عيوبه ومعاصيه حتى لا يزول اعتقادهم فيه بعلمهم بها، فإنّ حفظ الستر عن القبائح واجب وليس تلبيساً، بل سدّ لطريق العلم الذي لا فائدة فيه نعم إظهار الورع مع الاتّصاف بها كذب وتلبيس.
فإذا تفكّر فيما ذكر علم خطأه فيما دعاه إلى حبّ الجاه، وانّه لو سجد له كلّ من في الأرض كان آخره الموت، فلا يترك العاقل ما به تحصل الحياة الدائمية لمثل ذلك، كما قال الله تعالى: {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [الأعلى: 16، 17] ثم إذا تفكّر فيما يستهدف لها أرباب الجاه والاعتبار من المهالك والمتاعب والأخطار كحسد الناس وقصدهم له بأنواع الأذى وخوفه دائماً على جاهه بانقلاب اعتقادهم فيه؛ لأنّ اضطراب قلوب الناس وشدّة تغيّرها أكثر من القدر في غليانه، فمن يسكن إليها ويبني أمره عليها فكما يبني على أمواج البحار، واشتغاله بما يشغله عن الله ويبعده عنه من مراعاة قلوب العباد ودفع كيد الأعداء والحسّاد ويشغله عن الله ويبعده عنه من مراعاة قلوب العباد ودفع كيد الأعداء والحساد ويشغله عن لذّاته البدنيّة فضلاً عن النفسية كما يعلم ن التجربة والعيان علم أنّ ذلك كلّه هموم عاجلة مكدّرة لجميع لذّاته الدنيوية عموماً ولذّة جاهه خصوصاً، وصار سبباً لسلب اعتقاده بما توهّمه لذّة وفتور رأيه فيما كان يسعى في طلبه وقوي إيمانه ونفذت بصيرته في تحصيل اللذّات الحقيقية الدائمية وترك الالتفات إلى هذه اللذّات الدنية الدنيوية. وكلّ من أحب الله وأنس به وعرفه أحبّ الخمول واستوحش من انتشار الصيت والقبول.
وأمّا العملي فالسعي في رفع الجاه الحاصل له بتحصيل ضدّه أعني الخمول والعزلة عن مصاحبة الخلق المؤدّية إلى الغفلة، والهجرة إلى المواضع التي لا يعرفه أهلها.
ولمّا كان الباعث العمدة له الطمع فيما عند الناس كان علاج الطمع المذكور سابقاً أنفع شيء في علاجه والمواظبة على ملاحظة ما ورد في ذمّه من الآيات والأخبار، وما دلّ على مدح ضدّه الخمول منها ومن الآثار.
فعن النبي صلى الله عليه وآله: «انّ الله يحبّ الأتقياء الأصفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإذ حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى... الحديث» (9).
وعنه صلى الله عليه وآله: «إنّ أهل الجنّة كلّ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، الذين إذا استأذنوا على الأمر لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصب لهم.. لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لو سعهم» (10).
وفي بعض الأخبار: «انّ الله سبحانه يقول في مقام الامتنان على بعض عباده: ألم أنعم عليك؟ ألم أسترك؟ ألم أخمل ذكرك؟» (11).
ومن تتبّع كتب السير والأخبار وتفحّص عن حال الأكابر والسلف الأخيار واطّلع على إيثارهم الذلّ والخمول مع تمكّنهم من الجاه والاشتهار أيقن بكون الخمول من صفات المؤمنين الأبرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المحجة البيضاء: 6 / 112.
(2) الكافي: 2 / 297، كتاب الإيمان والكفر، باب طلب الرئاسة، ح 3.
(3) لكافي: 2 / 298، كتاب الإيمان والكفر، باب طلب الرئاسة، ح 4.
(4) الكافي: 2 / 299، كتاب الإيمان والكفر، باب طلب الرئاسة، ح 8، وفيه: «بلى والله، وإن ...».
(5) كذا، والظاهر: التغيّر.
(6) كذا، والظاهر: لكونهما.
(7) في ج: خطا.
(8) المحجة البيضاء: 6 / 123.
(9) المحجة البيضاء: 6 / 110، وفيه: «الأتقياء الأخفياء».
(10) المحجة البيضاء: 6 / 110.
(11) المحجة البيضاء: 6 / 111 نقلاً عن الفضيل.



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|