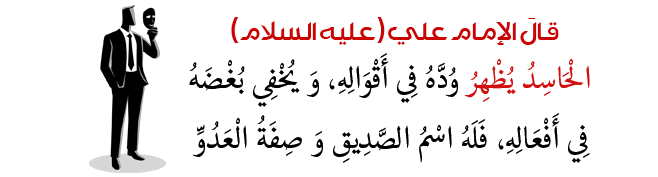
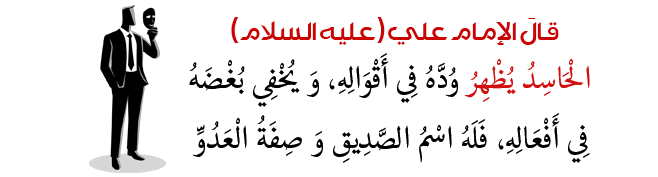

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-5-2020
التاريخ: 23-8-2016
التاريخ: 23-8-2016
التاريخ: 26-5-2020
|
الاستصحاب ... في اللغة: طلب الصحبة. واطلق بالعناية على إبقاء ما كان . وفي كونه عبارة عن: المعاملة مع الشيء معاملة بقائه تعبدا كي يكون فعل المكلف أو عبارة عن: الحكم ببقائه كذلك كي يكون من الأحكام الشرعية التعبدية، أو التصديق الظني بالبقاء الحقيقي كي يكون من الأحكام العقلية غير المستقلة، وجوه. ويناسب الأول سائر اشتقاقاته وأن المستصحب - بالكسر - هو المكلف لا الحاكم. ويناسب الثاني عدهم الاستصحاب من الأحكام الظاهرية قبال سائر الاصول. ويناسب الثالث جعل القدماء إياه في زمرة الأدلة العقلية التي هي عبارة عن الأحكام الظنية العقلية غير المستقلة كالقياس والاستحسان. ولا يضر الاختلاف في الأخيرين - بحسب الحقيقة - بوحدة المفهوم في إبقاء ما كان بعد ظهور الهيئة في نحو [إبقائه] عملا. وكذلك [الأولين]، كما لا يخفى.
ثم اعلم: أن القائل بحجية الاستصحاب من باب الظن ظاهر كلامه هو الظن الشخصي. ولكن يوهنه استلزامه حصول الظن بطرفي النقيض في شخص المورد بمحض اختلاف حالته السابقة مثل الماء البالغ إلى حد خاص يكون مستصحب القلة تارة والكثرة اخرى حسب اختلاف حاليه سابقا. وهو في غاية البعد. مع أنه على هذا لا معنى لإطلاق التعارض على الاستصحابات المتعارضة ولا الحكومة على الاستصحابات السببية، بل هو تابع فعلية الظن في أي طرف جعل. كما أن الموهن لجعله من باب الظن النوعي به لا دليل على حجيته إلا السيرة. وهو على فرض تماميته يوجب دخول الاستصحاب في أدلة السيرة، نظير ظواهر الألفاظ. فلا يناسب حينئذ جعله من الأدلة العقلية. نعم على هذا التقدير يدخل البحث عن أصل وجوده وحجيته في المسائل الاصولية، [لوقوعه] في طريق إثبات الأحكام الكلية، بمعنى اقتضائه قيام العلم بالحكم الواقعي تعبدا كسائر المباحث الاصولية المنتهية إلى استنتاج العلم بالحكم من دليل تتميم كشفه. وأما بناء على الاحتمال الآخر فلا يكاد ينتهي إلى العلم بالحكم الواقعي، بل نتيجة القياس على وجه هو الحكم التعبدي الشرعي، [و] على وجه آخر هو الحكم العقلي الظني المنتهي إلى حكم عقلي قطعي بوجوب اتباعه بمناط الانسداد. [فإدخاله] حينئذ في المسائل الاصولية فرع تعميم مسائله لما ينتهي إليه المجتهد عند عدم وصوله إلى الواقع أيضا. ولقد أشرنا في أول مباحث القطع إلى اختلاف الوظائف المجعولة، فمنها ما كان بلسان تتميم الكشف، ومنها ما كان بلسان إثبات وظيفة في ظرف عدم الانكشاف. ومن المعلوم أن تنقيح هذه الجهات شأن الاصولي، لأن أصل وضع علم الاصول لبيان هذه الجهات وتنقيح مبادئ هذه الحيثيات، فحينئذ مسائله قهرا راجعة إلى صنفين: منها: ما هو مهذب لاستنباط الأحكام الشرعية الواقعية ومنتج للعلم بها بتوسيط قياس واحد أو قياسين أو أزيد، بمعنى جعل [نتيجة] الأول صغرى لقياس آخر منتج للعلم المزبور بلا واسطة قياس آخر كذلك. ومنها: ما ليس شأنها ذلك بل كانت مما ينتهي إليه المجتهد عند عدم وصوله إلى الواقعيات وحينئذ فجعل الاستصحاب من الصنف الأول أو الثاني مبني على جعله من الأدلة الشرعية أو من الاصول العملية - شرعية محضة أو عقلية - منهية إلى مقدمات الانسداد على الحكومة.
[المراد بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة]:
ثم إن الظاهر إطباق [الطرق] المختلفة - في شرح الاستصحاب - في لا بدية اتحاد القضية [المتيقنة] مع المشكوكة. وإنما الكلام في المراد من الوحدة المزبورة من أنه مجرد وحدتهما ذاتا وحقيقة وإن [اختلفتا] وجودا ومرتبة، أو وحدتهما وجودا أيضا وإن [اختلفتا] مرتبة، أو وحدتهما مرتبة أيضا. فإن كان المراد من الوحدة بالمعنى الأخير فيلزم اختلاف زماني اليقين والشك، وينطبق الاستصحاب حينئذ على قاعدة اليقين، وهو باطل بالضرورة. ولذا أطبقوا في باب الاستصحاب على إلغاء هذا المعنى من الوحدة. كما أن الوحدة بالمعنى الأول أيضا غير [كافية] في الاستصحاب. كيف! وإلا يلزم جريان الاستصحاب عند اليقين بوجود فرد والشك في بقاء فرد آخر [من نفس] الحقيقة وهو أيضا باطل بتا. فلم يبق في البين إلا الوحدة بحسب الحدود الخارجية، ومثل هذا المعنى فرع تحقق [القضيتين] ولو بمنشأ انتزاعهما في الخارج كي يصدق على القضية المشكوكة [أنها] بقاء المتيقنة خارجا، و[متحدتان] حدا خارجيا. وحينئذ لازم اعتبار هذا المعنى من الوحدة عدم جريان الاستصحاب في القضايا الطبيعية والعمومية عند عدم تحقق مصداقهما في الخارج أصلا، مثل: ما لو شك في الآن الثاني بحرارة طبيعة النار أو سواد طبيعة الجسم الفلاني عند القطع بهما في الزمان السابق مع فرض عدم وجود مصداق للقضيتين ولا منشأ انتزاع للعنوانين، إذ [ليست] الوحدة فيهما إلا [ذاتية] محضا. ولقد عرفت عدم [إثمارها]. ويمكن حل هذا الإشكال بأن مدار الاستصحاب على الوحدة الخارجية، لكن أعم من الخارجية الفعلية أو الفرضية. وعمدة الوجه في ذلك هو أن أمثال هذه القضايا بعد ما كانت قضايا حقيقية شاملة للأفراد الفعلية والفرضية، فكما أن وحدة مصداقهما فعلا في الخارج [توجب] صدق البقاء الفعلي لهما في الخارج، كذلك وحدة مصداقهما في الوجود الفرضي [توجب] صدق البقاء الفرضي على مثلها. وهذا نحو من الوحدة بين [القضيتين] غير الوحدات الثلاثة المزبورة. ويكفي في الاستصحاب هذا المقدار من الوحدة الخارجية الفرضية ومرجعه في الحقيقة إلى اتحاد مصاديقهما في الخارج بنحو يكون المصداق متصفا بالخارجية سابقا. فإن كان اتصافه بها اتصافا فعليا [فالوحدة] الخارجية أيضا [فعلية]، وإن كان اتصافه بها فرضيا فوحدته أيضا فرضية بلا احتياج - حينئذ في صدق البقاء على القضية المتيقنة - إلى الوحدة الخارجية الفعلية. نعم لو لم تشمل القضية الأفراد الفرضية وكانت مختصة بالوجودات الفعلية لا يكفي في صدق البقاء على القضية المتيقنة مجرد الوحدة الفرضية، بل يحتاج إلى وحدة خارجية فعلية، وذلك المقدار بالنسبة إلى القضايا غير الشرعية ظاهر واضح. نعم هنا إشكال آخر في القضايا الشرعية التكليفية بأن في مثلها لما كان ظرف عروض محمولاتها ذهنيا وإن كان ظرف اتصافها خارجيا، ربما لا يتصور لموضوعها وحدة خارجية لا فعلية ولا فرضية، لأن الخارج أجنبي عن صقع عروض هذه المحمولات، بل [ليست] موضوعاتها إلا مجزومات ذهنية، ومن البديهي أن في المجزومات الذهنية - حيث [إن] وحدتها ليست إلا ذاتية ورتبية بلا تصور وحدة خارجية فيها ولو فرضية، والمفروض أن الوحدة الذاتية غير [كافية] في الاستصحاب، والرتبية غير معتبرة فحينئذ - من أين يتصور البقاء والارتفاع في موضوع القضايا الشرعية التكليفية؟ ولكن يمكن حل هذه الجهة أيضا: تارة بأن ظرف عروضها وإن كان [الذهن] وبالإضافة إلى المجزومات الذهنية لا يتصور بقاء وارتفاع خارجي، ولكن ظرف اتصافها [الخارج]. ومن المعلوم أن في هذه المرتبة [نتصور] الوحدة الخارجية بين [القضيتين]، غاية الأمر أعم من الفعلية والفرضية. وحيث إن مدار تشخيص الوحدة بين [القضيتين] على الأنظار العرفية، وكان نظرهم في القضايا الشرعية [مقصورا على] مرحلة اتصافها كما في غير الشرعيات، يكفي هذا المقدار من الوحدة أيضا في صدق البقاء والنقض في موضوع القضايا الشرعية. واخرى بأن الوحدة الخارجية في نفس العارض [كافية] في [صدق] البقاء والنقض في الشرعيات، ومن المعلوم أن موضوعات هذه القضايا وإن كانت ذهنية ولكن محمولاتها خارجية. وإذا صدق بقاء المحمول خارجا على ما هو موضوعه في ظرف عروضه [كفى] ذلك في وحدة [القضيتين] خارجا، وهو المدار التام أيضا في الاستصحاب. بل في مثل هذه القضايا لا يحتاج إلى توسعة البقاء إلى الفرضي، بخلافه في القضايا غير الشرعية، إذ بقاء محمولاتها [تابع] وجود موضوعاتها في الخارج. فما لم يوسع البقاء إلى الفرضي لا يكاد يتم فيها أمر الاستصحاب. نعم في بعض المحمولات في غير الشرعيات أيضا ليس لموضوعها خارج ولا لنفسها أيضا وجود خارج. وإنما الخارج ظرف منشأ اعتبارهما، نظير وجود المهيات كوجود الإنسان وأمثاله، فالوحدة الملحوظة فيها أيضا ليست إلا بلحاظ وحدة المنشأ الخارجي حدا ولو فرضيا، لا أن المدار فيه أيضا على مجرد الوحدة الذاتية والطبيعية، كما لا يخفى وذلك ظاهر.
ثم إن في استصحاب الأحكام إشكالا آخر ناش عن خيال رجوع قيود الحكم فيها أجمع إلى الموضوع، يلازمه كون الشك في بقاء الحكم الشرعي ناشئا عن الشك في بقاء موضوعه، إما للشك في بقاء قيده المعلوم قيديته [للحكم]، أو [لفقد] ما شك في قيديته. وعلى أي تقدير يلازم مثل هذه عدم جريان الاستصحاب للجزم باعتبار الوحدة بين [القضيتين] على وجه نجزم في الآن الثاني ببقاء موضوع القضية المتيقنة. وهذا المعنى لا يناسب مع الشك المزبور. ولكن لا يخفى ما فيه من فساد الخيال الذي أوضحناه في بحث مقدمة الواجب في شرح الواجبات المشروطة، وأن قيود الحكم من قبيل الجهات التعليلية له، الموجبة لضيق فرضي في الذات المانع عن إطلاقه وسعة دائرته عن حكمه، لا أنه يقيد بها، لاستحالة تقيد الموضوع بحكمه وبما هي من [علله] و[غاياته]. وعليه فالموضوع في الأحكام المشروطة هو نفس الذات البحت البسيط القابل للبقاء في الآن الثاني حتى مع القطع بانتفاء قيد حكم من الأحكام فضلا عن الشك [فيه]. ولئن اغمض عن هذه الجهة أيضا أمكن دعوى كفاية الوحدة العرفية بين القضتين، ولو من جهة تخيلهم بحسب ارتكاز أذهانهم في أحكام عرفية اخرى كون القيد المزبور من التعليلات غير المكثرة للذوات بحدودها، أو كون الموضوع في ارتكاز أذهانهم هو نفس الذات، غاية الأمر يشك في دخله في الخطابات الشرعية بخصوصها أو من جهة كون الذات [محفوظة] في ضمن موضوع الأحكام وذلك المقدار يكفي في إجراء ماله من الحكم الضمني الثابت لنفس الذات بحتا، كما لا يخفى. وذلك كله بضميمة كون عموم حرمة النقض [مسوقا إلى أنظارهم]، بل وفي الفرض الأخير لا يحتاج إلى هذه الجهة، بل الأصل المزبور يجري حتى ولو كان العام مسوقا [إلى الأنظار] الدقيقة كما هو ظاهر. ثم من هذه البيانات ظهر حال جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية على القول بالملازمة المعروفة. وتوهم عدم تصور الشك في بقاء الحكم الشرعي المنكشف من قبل الحكم العقلي بخيال: أن مناطها حدوثا وبقاء [عين] مناط الحكم العقلي. ومن المعلوم أن أمر مناط الأحكام دائر بين الجزم [بتحققه] [و] الجزم [بانتفائه]، لاستحالة حكم العقل بحسن شيء أو قبحه بلا إحراز مناطه فيه بقاء وحدوثا، ولذا لا يبقى مجال الشك في بقاء الحكم العقلي، ولم يتوهم أحد جريان الاستصحاب فيه. مدفوع غاية الدفع بأن إحراز مناط حكم العقل بقبح شيء كما أنه قد يكون تفصيليا قد يكون اجماليا أيضا. وفي مثله لا بأس بالشك في بقاء مناطه حتى مع الجزم بانتفاء بعض ماله دخل في العلم بوجوده إجمالا. وفي مثل هذه الصورة وإن [كنا] نجزم بانتفاء نفس الحكم العقلي، لأنه فرع دركه المنوط بوجود جميع ماله دخل في علمه ولو إجمالا، ولكن ذلك المقدار لا ينافي الشك [في] بقاء مناطه المستتبع [للشك] في بقاء الحكم الشرعي واقعا، لأن الأحكام الشرعية [تابعة] للمناطات العقلية ثبوتا وإن كانت تابعة لنفسها أيضا [إثباتا]، ولكن ذلك المقدار لا يقتضي استتباع عدمها عدم الأحكام الشرعية في مقام الثبوت وإن [كان مستتبعا له إثباتا]، وهو غير مضر باستصحابها، بل بمثله يتحقق موضوعه كما لا يخفى. هذا كله، مع أنه على فرض تسليم تبعية الحكم العقلي لإحراز [مناطه] تفصيلا نقول: إن غاية الأمر لا يتصور الشك فيه من جهة الشك في قيدية شيء فيه، وأما الشك في بقاء المناط من جهة الشك في بقاء ما هو معلوم القيدية فهو في غاية الإمكان وكثير الوقوع، كالشك في بقاء الصدق على مضريته أو الكذب على نافعيته، ففي مثل هذه الصور وإن لم يتصور بقاء نفس الحكم العقلي أيضا، لكن بالنسبة إلى ما هو مناطه المستتبع للحكم الشرعي كان للشك في بقائه كمال مجال لولا الشبهة السابقة في إرجاع قيود الحكم طرا إلى الموضوع. ولقد عرفت أيضا جوابه بما لا مزيد عليه. وعليه فما يظهر عن شيخنا العلامة من استشكاله في استصحاب الأحكام [الشرعية] المستكشفة عن [العقلية] بشبهة الشك في بقاء الموضوع وتسليم جريانه لو كان مثل هذا الحكم ثابتا بلسان دليل لفظي (1) لا يكاد يتم إلا على تخيل كون سوق لا ينقض بلحاظ الأنظار العرفية في تشخيص الموضوع في لسان دليله، إذ حينئذ أمكن دعوى الفرق بين لساني الدليل لفظيا وعقليا، إذ في اللفظي ربما كان الموضوع هو ذات الصدق إذا كان ضارا أو الكذب إذا كان نافعا، وهذا بخلاف موضوع حكم العقل، فإن لسان مثله ليس إلا قبح المضار وحسن المنافع [المشكوكتين] بقاء على الفرض. وإلا فلو كان سوقه بلحاظ ما يشخصونه على طبق ارتكازاتهم في [نظائره] من أحكامهم العرفية فلا يبقى مجال التفرقة بين كون دليل الحكم لفظيا أم عقليا. مع أن في العقليات أيضا ربما يكون بعض القيود من قبيل التعليل بالنسبة إلى موضوع الحكم بالقبح والحسن، نظير المضرية والنافعية [فإنهما] أيضا علل لطرو الحكم على نفس الذات، وأن ما هو قبيح هو علة الضرر، وما هو حسن هو علة النفع، وان عنوان النافعية والمضرية من العناوين المشيرة إلى الذوات الخاصة، كعنوان المقدمية، غاية الأمر ليس [له] إطلاق يشمل حال فقدهما، لا أنه مقيد بمثلها، وذلك ظاهر لمن تدبر في نظائرها.
[أدلة حجية الاستصحاب]:
ثم اعلم أنه قد تكاثرت الأقوال في حجية الاستصحاب مطلقا، وعدمه كذلك، أو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، أو بين الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية، إلى غير ذلك من التفاصيل المذكورة في المطولات، بحيث لا يهمنا ذكرها بل المهم تنقيح ما هو المختار بإقامة الدليل على حسب النظر القاصر، فنقول وعليه التكلان:
إن في مثل هذه المسألة التي هي معركة الآراء خلفا عن سلف لا يبقى مجال توهم إجماع على ثبوتها أو نفيها، كما لا مجال للتشبث ببناء العقلاء في مثلها تعبدا، أو من جهة توهم إفادة سبق الحالة السابقة الظن ببقائها شخصيا أم نوعيا، لإمكان منع ذلك. كيف! ومع استقراره لا يبقى مجال مثل هذا البحث العظيم بين الأعاظم الذين هم بوحدتهم بمثابة ألف عاقل. نعم مع فرض ثبوت البناء المزبور لا مجال للتشبث - في ردعهم - بالعمومات الناهية عن العمل بغير العلم، إذ مثل هذا البناء وارد على الآيات الناهية (2)، لأن [نتيجته] إثبات العلم بالأحكام الخارجة عن موضوع النواهي تخصصا لا تخصيصا. ولقد شرحنا وجه عدم صلاحية الآيات الناهية للرادعية في بحث حجية خبر الواحد [الجاري] في المقام أيضا حرفا بحرف فراجع. اللهم أن يقال: إن ذلك إنما يتم بناء على كون المراد من لا تقف ما ليس لك به علم (3) عدم العلم بمطلق الوظيفة أعم من الواقعية والظاهرية، وإلا فلو كان عدم العلم بالواقع فيمكن الفرق بين المقام وباب حجية [خبر] الواحد ببناء العقلاء، لأن دليل حجية الخبر [يرفع] الشك بالواقع وهنا لا يرفع إلا الشك [في حكم] الشك، فالشك [في الواقع] الذي هو موضوع لا تقف باق بحاله، فيشمل العموم، فيردع بناءهم. ولكن ذلك بناء على كون بنائهم على الاستصحاب من باب الأصل وإلا فعلى [الأمارية] فحاله حال خبر الواحد، كما لا يخفى. وأيضا لا مجال للتشبث بالحكم العقلي الظني ببقاء ما ثبت بضميمة إدخاله في صغريات مقدمات الانسداد ولو بالنسبة إلى خصوص الأحكام في دائرتها، إذ مثل ذلك أيضا ممنوع صغرى وكبرى. كيف! وقد صار جواب مثل هذه الشبهة من قبيل البديهيات الأولية لاشتهار أن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم. وما ترى من ديدن الحيوانات في مقام [رجوعها] إلى [محالها] فليس ذلك من جهة حكم عقولها ببقاء [محالها] ظنا بضميمة [حكمها] باتباع هذا الظن، بل من جهة [غفلتها] عن الجهات المزاحمة، لقصور أنفسها عن درك مثل هذه الجهات، فلا جرم [تكون باقية] على [قطعها بمحالها] الموجب للحركة على وفقه [بتخيلها]، نظير [خوفها] من المحسوسات. فهذه الحركات غير مرتبطة بعالم القوة العاقلة المخزونة في النفوس الإنسانية الموجبة لترجيح [بعض] الاحتمالات على بعض. فلا مجال حينئذ لجعل حركة الحيوانات بحسب الظاهر على الحالات السابقة مقياس بناء الإنسان عليها، وجعله من [العقليات الارتكازية] أو الجبليات الطبيعية غير القابلة للردع أبدا. وحينئذ لم يبق في البين دليل إلا الأخبار الخاصة المشتملة على بعض التعليلات الموجبة للتعدي إلى غير موردها. فينبغي حينئذ عطف عنان [القلم] إلى ذكرها، إذ هي العمدة في الباب، ثم التكلم في مقدار دلالتها إطلاقا و[تقييدا]، فنقول: إن من جملتها مضمرة زرارة، قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن. فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر... (4).
ووجه الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا ظهور قوله فإنه على يقين... في كونه علة لقوله لا حتى يستيقن أو الجزاء المحذوف لقوله وإلا المستفاد من قوله لا، حتى يستيقن . وقضية العلية مناسبة لتعميم اليقين غير المنقوض لكل يقين. مضافا إلى ظهور [التعبير] في كونه في مقام إعطاء الشكل الأول من القياس المناسب لكلية الكبرى بالنسبة إلى مغزاه الذي هو من جزئياته غالبا بضميمة ظهور الصغرى [في بيان] حكم كلية اليقين بالوضوء، لا خصوص وضوئه الشخصي، لظهور أمثال هذه الخطابات في إلغاء أمثال هذه الخصوصيات. مع أن المناسب لعدم ناقضية الشك هو الاستحكام المخصوص في مطلق اليقين بشيء، لا خصوص ما يضاف إلى وضوئه، لبداهة أن هذه الإضافة أجنبية عن ردع الشك عن الناقضية، لعدم [دخلها] في استحكامه المانع عن انتقاضه به. مع أن هذا التعبير وقع في كبرى لصغريات متعددة من مثل الطهارة الحدثية تارة، والخبثية تارة اخرى، وركعات الصلاة ثالثة، وهكذا... ومثل هذه من شواهد عدم اختصاص مثل هذه الكبرى بباب دون باب. وبهذه الوجوه ربما يرتفع توهم كون اللام في اليقين في الكبرى للعهد، كي يفيد ضرب قاعدة في خصوص اليقين بالوضوء، مع أن لازم هذا المعنى عدم التعدي عن الوضوء إلى غيره حتى بقية الطهارات الثلاث، والحال أن بناء الأصحاب على التعدي إليها قطعا خلفا عن سلف، ولم يستشكل في حجية الاستصحاب في خصوصها أحد من الصدر الأول وإنما التشكيك تمامه في حجيته في غيرها من سائر الموضوعات والأحكام، فمثل ذلك من [موهنات] حمل اللام على العهد. اللهم [إلا] أن يدعى أن وجه تعديتهم اشتراك حكمها في الغالب كما هو الشأن في تعديتهم في الاعتناء بالشك حال العمل إلى الغسل والتيمم من النص الوارد في خصوص الوضوء وغير ذلك. وحينئذ لم يبق موهن للعهدية عدا الوجوه السابقة، فإن تمت فيصلح بمثلها البناء على مخالفة القدماء من الأصحاب المنكرين لكلية الاستصحاب مع تسليمهم حجيته في خصوص الطهارة الحدثية، إذ عمدة نظرهم إلى هذه الشبهة من عهدية اللام، وإلا فبناء جلهم على عدم الاعتناء بخصوصية المورد [إذا] كان الحكم فيه بلسان العلة. فحينئذ ليس وجه عدم تعديتهم عدم الإطلاق في القضية [الطبيعية] ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب، لأن مثل هذه الجهة إنما يراعى في غير ما سيق بلسان التعليل كما هو ظاهر. وبالجملة نقول: إن العمدة في المقام رفع شبهة عهدية اللام ولقد تقدم منا وجوه في وهنها. نعم قد يظهر من بعض الأساطين في كفايته (5) استظهار العموم في الكبرى حتى على عهدية اللام بتقريب تعلق قوله: من وضوئه [بمدلول] على يقين ، لا نفس اليقين، وأن المراد أنه من طرف وضوئه على يقين، فيكون الأصغر في القياس المزبور أنه على يقين، لا خصوص اليقين بالوضوء، فلا تضر حينئذ عهدية اللام أيضا بعموم اليقين لكل يقين. ولكن نقول: - مضافا إلى ظهور رجوع المجرور إلى نفس اليقين - إن مرجع هذا التوجيه إلى إخراج من وضوئه عن الجهات التقييدية إلى التعليلية. ومن البديهي أن دائرة اليقين الناشئ من قبل الوضوء يستحيل أن يكون [لها] عموم يشمل حال فقد علته فقهرا يراد من اليقين في الصغرى معنى مهملا لا يتعدى عن دائرة اليقين بالوضوء وإن لم يكن مقيدا به، كما هو الشأن في جميع المعاليل بالإضافة إلى عللها وفي الموضوعات بالنسبة إلى محمولاتها، فالناشئ عن العلة هو نفس الذات لا بقيد نشوئه عنها، ولكن مثل هذا الذات لا يكون له إطلاق أيضا يشمل ما لا ينشأ منها. نعم قد يجعل عنوان النشوء عن العلة الخاصة من عبارته المشيرة إلى مثل هذه الذات البحت المهملة العارية عن القيد والإطلاق، وبعد ذلك نقول: إن عهدية اللام في الكبرى توجب الإشارة به إلى هذا اليقين المهمل المشار إليه بكونه ناشئا عن الوضوء. ومثل هذا المعنى كيف يكون له عموم يشمل كل يقين، فعموم مثل هذه الكبرى لا يكاد يتم إلا بجعل اللام للجنس ولو بالقرائن المشار إليها سابقا، وبعد ذلك لا يضر بعموم الكبرى جعل من وضوئه من قيود اليقين، لا من علله كما هو ظاهر. هذا. ومنها: مضمرة اخرى لزرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني... (إلى قوله) قلت: فإن ظننته أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: فلم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك، فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إلى أن قال: قلت: رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء اوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك... الخ (6).
ولا يخفى شهادة فقرتي الرواية صدرا وذيلا على المدعى وتطبيق القاعدة المزبورة على المورد في الفقرة الأخيرة [ظاهر] من جهة إبداء الإمام احتمال وقوع نجاسة جديدة من حين حدوث يقين السائل بالرطوبة، فإنه مع هذا الاحتمال يكون المورد مورد تطبيق الاستصحاب المقتضي لعدم الإعادة، لأنها حينئذ نقض [ليقينه] السابق بالطهارة بالشك في بقائها إلى حين علمه بالرطوبة، وحينئذ فهذه الفقرة شاهدة حمل قوله: وإن لم تشك على عدم حدوث الشك في [الموضع] مع العلم بأصله، كما هو المراد من قوله: إذا شككت في [موضع] منه ثم رأيته المحكوم فيه بنقض الصلاة وإعادتها. وأما تطبيق هذه القاعدة على مورد [السؤال] في الفقرة السابقة ففيه شوب إجمال لاحتمال أن يكون مراده من النجاسة المرئية هي المظنونة سابقا، فإنه حينئذ [لا تكون] الإعادة نقض يقين بالشك بل هو نقض يقين بيقين. وعليه فلا محيص من حمل هذه الفقرة أيضا على فرض رؤيته النجاسة [المحتمل] وقوعها من حين الرؤية ولو بقرينة الفقرة الأخيرة، وأن فارقهما [محض الرؤية] بعد الصلاة أو حينها مع شركتهما في سائر الجهات. ويؤيد ذلك [تغيير] اسلوب العبارة في هذه الفقرة والفقرة السابقة [عليها] بقوله وجدته في الاولى، و رأيت - بلا ضمير يحكي عن سبق العهدية - في الثانية، فله حينئذ كمال الملائمة مع كون المرئي النجاسة المحتمل وقوعها في الحين، لا أنه هو المظنون سابقا كي يجئ الإشكال السابق، هذا. ولكن ربما يوهن مثل هذه الجهة سؤال السائل عن التفرقة بين الفرعين بقوله: لم ذلك؟ ، إذ بناء على هذا الاحتمال لا يبقى مجال الاستيحاش للسائل مع ارتكازية الاستصحاب في ذهنه بظهور قوله: لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ، فليس ذلك المسؤول [عنه] إلا [دليلا] على كون مراده من النجاسة النجاسة المطنونة سابقا. [و] عليه فيشكل أمر تطبيق مثل هذه القاعدة على المورد بالتقريب السابق، خصوصا مع ظهور التعليل في أن تمام المناط في عدم الإعادة هو الاستصحاب لا أنه جزء [المناط] ومقدمة لكبري [هي] العلة من مثل قاعدة الاجتزاء في الأمر الظاهري أو شرطية نفس الطهارة الإستصحابية في خصوص المورد واقعا، إذ بعد عدم ارتكاز ذهنه بمثل هذه التعبديات المحضة لا يبقى مجال التعليل بمثل الاستصحاب الذي بحسب ارتكاز ذهنه لا يفيد شيئا في المقام، ولا مجرى له فيه ابدا. وتوهم أن التعليل بالاستصحاب في مثل هذا المورد يلازم إنا كفاية الطهارة الظاهرية في الشرطية أو في عدم الإعادة، [فكانت] دلالة مثل هذا التعليل على المدعى [المبنية] على كبرى اخرى من باب دلالة الإيماء الحاصل من ضم كلام غير مرتبط بكلام آخر، كدلالة الآيتين على أقل الحمل، مدفوع بأن ذلك كذلك لو كان لسان التعليل جريان الاستصحاب في المورد تعبدا لا بلسان [أن] جريانه في المقام على حسب ارتكاز ذهنه، إذ مثل هذا المعنى متفرع على كون الكبرى الاخرى أيضا [ارتكازية]، وإلا فللسائل أن يقول بأن الاستصحاب في المقام مع الجزم بمخالفته للواقع غير مفيد كما أشرنا إليه سابقا. وعلى هذا فربما [تقع] المعارضة بين هذا الظهور الموجب لحمل النجاسة في المقام أيضا على ما هو محتمل وقوعه من الحين - نظير الفرع الآتي - وبين الظهور الثاني الموجب لحملها على المظنونة سابقا، فحينئذ لا [تخلو] الرواية عن شوب إجمال من جهة تهافت بين الاحتمالين. نعم قد يتوهم رفع إجمال الرواية باستحالة جريان الاستصحاب في المورد في ظرف عدم ترتب أثر على الطهارة الواقعية، فلا محيص من حمل الرواية على النجاسة [المحتمل وقوعها] من الحين ورفع اليد عن إشعار استيحاش السائل عن التفرقة بين الفرعين. وقد يجاب عنه تارة بكفاية شرطيتها فيها اقتضاء، واخرى بكونه من قيود إحرازها. ويكفي هذا المقدار في جريان الأصل لكونه قيد [القيد] في الموضوع وهو مثل قيده. ولكن لا يخفى ما في الجوابين من [النظر]، إذ مجرد اقتضائه الشرطية ما لم [يبلغ] الاستصحاب إلى مرتبة الفعلية لا يكاد يترتب عليه أثر عملي وبدونه لا يجري الأصل وإن كان شرطا شرعيا اقتضائيا. وأما كونه قيدا للإحراز ففيه: أن ما هو قيده هو وجوده الاعتقادي المقوم للاعتقاد المنعدم جزما بانعدام اعتقاده. وأما وجوده الواقعي المشكوك ولو حين الصلاة فهو لم يكن قيدا أصلا. مع أنه على فرض قيديته يلزم في المقام بطلان صلاته أيضا، للجزم بانعدامه حسب الفرض، كما لا يخفى. ونظير هذا الجواب في الاختلال دعوى كون الشرط [هو] الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، إذ من المعلوم أن شرطية الجامع لا تقتضي جريان الاستصحاب في خصوص [طهارة] كما هو الشأن في صورة ترتب الأثر على الإنسان، فإنه لا يوجب جريان الأصل في شخص زيد. وعليه فلا [تكون] في البين طهارة استصحابية كي [بها] يتحقق أحد فردي الجامع. نعم قصارى ما يتخيل في حل هذه الجهة من الإعضال هو أن يدعى [كفاية] شرعية الطهارة في [نفسها] لجريان الاستصحاب فيها ولو بلحاظ [نفسها]، ثم يدعى أن الطهارة المستصحبة ولو بلحاظ [نفسها] شرط واقعي للصلاة.
ولكن لا يخفى أن هذه الجهة أيضا فرع كونها من الأحكام الشرعية الوضعية، وإلا فعلى [كونها] من الامور الواقعية المكشوفة بنظر الشارع لا يبقى مجال [استصحابها] بعد فرض عدم ترتب أثر [عليها] غير صحة هذه الصلاة. وعليه فلا محيص في دفع المحذور المزبور إلا الالتزام بأن ما هو شرط في الصلاة ليس إلا الطهارة الواقعية وأن استصحابها في مقام العمل يوجب تدارك مرتبة من مصلحتها وتفويت محل تدارك البقية، وأن منشأ عدم الإعادة من جهة فوت محل التدارك لا من جهة حصول [شرطها]. فإذا قلت: إن ظاهر الرواية أن عدم [اعادتها] من جهة تحصيل الصلاة وصحة المأتي به ولو من جهة وفائه بمرتبة من مراتب غرضه لا من جهة فوت محل تدارك تمام الصلاة رأسا، وحينئذ فنقول: إن قضية وفاء الطهارة ولو بمرتبة من المصلحة كونها في عرض الطهارة الواقعية في الوفاء بهذه الجهة، فحينئذ إما أن نلتزم بوفاء كل منهما - بخصوصيتهما - [بذلك] أو بجامعهما. فعلى الأول يلزم صدور الواحد من المتكثر مع أن البرهان قاض بخلافه. وعلى الثاني يلزم كون الشرط هو الجامع بينهما، فلا تنتهي النوبة إلى الطهارة المستصحبة، كما عرفت. قلت: إن هذه الشبهة مبنية على توهم كون الشرائط الشرعية أيضا من المؤثرات الحقيقية ولذا استوحشوا في تصوير الشرائط المتأخرة واحتاجوا إلى توجيه ما ورد في الشرع بهذا المساق. وإلا فبناء على ما حققناه - في بحث الشرط المتأخر - من رجوع الشرائط الشرعية إلى مالها دخل في خصوصية الماهية التي بهذه الخصوصية كانت قابلة للوجود [بنفسها] وإنما [هي] ذات مصلحة ويعبر عنها [بمعطيات] القابلية في الرتبة السابقة على الوجود، فهي غير [مرتبطة] بالمؤثرات الوجودية. وفي [مثلها] كما يصح تقدمها على المشروط بها أو تأخرها زمانا كذلك، لا بأس بالالتزام بدخل كل واحد منهما بخصوصهما في الأثر: إما مجتمعا كالتستر والقبلة أو بنحو التبادل مثل ما نحن فيه، لعدم وفاء البرهان المزبور بشيء في مثل المقام. وعلى هذا فلا بأس بالالتزام بشرطية كل منهما بخصوصه، غاية الأمر بنحو ترتب الثاني على عدم الأول كما هو ظاهر. وعلى ذلك فلا يبقى مجال [الشبهة] في الرواية من هذه الجهة، ولازمه ما ذكرنا من تزاحم الاحتمالين السابقين الموجب لإجمال الرواية في مرحلة تطبيق مثل هذه القاعدة على المورد، وإن كان هذا المقدار غير مضر بعموم أصل الكبرى وكونها من مرتكزات مثل زرارة حيث قال (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك . وتقريب التعدي عن موردها من الطهارة الخبثية إلى غيرها بعين ما ذكرنا سابقا. ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: وإن لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة اخرى ولا شيء عليه ولا تنقض اليقين بالشك... (7). وتقريب الاستدلال كما تقدم واضح، إنما الإشكال فيه في تطبيق الأصل على الركعة المشكوكة مع أنه خلاف بناء الأصحاب والإمامية من عدم البناء فيها على وفق الاستصحاب الموجب للحمل على الأقل، لما ورد فيه من وجوب البناء فيها على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة بتكبيرة مستقلة وسلام بعد السلام [من] الركعة المشكوكة، مخيرا في ذلك أيضا بين الركعتين جالسا [و] ركعة قائما.
ولكن يمكن أن يقال: إن مجرد الإشكال في مرحلة التطبيق - ولو من جهة حمله على التقية - غير مضر بالاستدلال وبمشروعية أصل الكبرى كما هو الشأن في حديث الرفع، حيث طبقه الإمام (عليه السلام) تقية على الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة بما يملك (8)، ومع ذلك لم يضر ذلك في مشروعية أصل الكبرى. وتوهم أن احتمال التقية في مرحلة التطبيق معارض [باحتمالها] في أصل الكبرى بعد الجزم بإعمال تقية في البين. [فكيف يصح] التمسك بالكبرى؟ مدفوع بأنه كذلك لو [كانت] أصالة الجهة في [طرفه]، ومعه لم ينطبق حتى مع فرض كون الكبرى تقية مما [لا] يترتب عليه أثر عملي. وإلا فلا مجال لجريان أصالة الجهة فيه فيبقى الأصل المزبور في أصل الكبرى بلا معارض بلا إحراز العلم الإجمالي بوجود التقية في البين، كما لا يخفى. ثم لو اغمض عن تلك الجهة يمكن بطريق آخر [توجيه] الاستدلال بالرواية على وفق مذهب الخاصة بأن مجرد [تطبيق الأصل] المزبور على صرف إتيان الركعة بضميمة تخصيص عموم الأصل بالنسبة إلى مانعية التشهد والسلام والتكبير في البين بخصوص الا اعلمك لا يكون تقية، غاية الأمر يقتضي ذلك - بعلاوة التخصيص المزبور - تعبدا في نظر التنزيل بلحاظ بعض مراتب الطلب الجامع مع التخيير أيضا بقرينة ما ورد من دليل التخيير [بينها] وبين الركعتين جالسا كما هو [ظاهر]. ولكن الإنصاف أن اقتضاء الاستصحاب بهذا البيان إتيان الركعة المندكة في ضمن الهيئة الاتصالية ينافي الركعات منفصلا عنها مما لا يساعد [عليه] العرف وإن لم يكن في تطبيقه بحسب الدقة العقلية قصور.
ولئن شئت قلت: إن وجوب ذات الركعة بعدما كان في ضمن وجوب ترك التشهد والسلام والتكبير [فإتيانها] مستقلا عن سائر الوجوبات الاخر بل وعن بعض مراتبها بالأصل المزبور من قبيل إثبات بعض مراتب الطلب المندك في ضمن الشديد دقة المباين معه عند الاستقلال عرفا، وفي مثله لا يجري الاستصحاب جدا كما لا يخفى. ومنها: قوله (عليه السلام): كل من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين... (9). والتقريب كما تقدم إلا أنه قد يستشكل فيه باحتمال [رجوع] الضمير في الكلام المستند فيه إلى متعلق اليقين دقة لا مسامحة ومعه لا يرتبط بالاستصحاب، ولا جامع بينهما كما هو واضح، لأن قوام الكلام بإرجاع شخص الضمير في مقام تعلق الشك بما تعلق به اليقين دقة أم مسامحة، ومع الاحتمال المزبور يبطل الاستدلال، ولا يرفع هذه الجهة من الاحتمال إلا دعوى ظهور مثل تلك العبارة - بقرينة سائر الروايات المعلوم مرادها بقرينة مواردها - في الاستصحاب [المعروف] فإن تم ذلك فهو، وإلا - ولو من جهة عدم صلاحية القرينة المنفصلة لرفع الإجمال [في] كلام آخر - لا مجال للتشبث بمثله. ومجرد تنزيل مغايرة زمان الشك مع اليقين في صدره على الغالب أو على [سبق المراتب] (10) لا يوجب ظهورا في الاستصحاب غاية الأمر رافع لظهوره في دخل مغايرة الزمانيين في الحكم، وهذا المقدار لا يجدي في دفع الاحتمال الطارئ من جهة اخرى، كما هو ظاهر. ومنها: خبر الصفار عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية (11). وتقريب الاستدلال بحمل اليقين فيه على وجود شعبان أو على عدم وجود رمضان وجريان الاستصحاب [فيهما]. ولكن لا يخفى أن الاستصحاب الجاري في المقام - وجوديا أو عدميا - منحصر باستصحاب مفاد كان التامة و ليس التامة ، وإلا فاستصحاب مفاد كان الناقصة الموجبة لإثبات كون المشكوك من شعبان أو عدم كونه من رمضان فغير جار قطعا، لعدم إحراز الحالة السابقة. والغرض أن بقاء شعبان أو عدم وجود [رمضان] أيضا غير مثبت لكون الزمان المشكوك من [أيهما] فكان من قبيل كرية الماء الموجود [غير] المحرز باستصحاب وجود الكر في الحوض. فإذا كان كذلك فنقول: إن الاستصحابين المزبورين إنما يثمران على فرض ترتب الأثر على مفاد كان التامة من [عدم] وجود رمضان أو وجود شعبان، وليس الأمر كذلك، كيف! وعدم وجوب الصوم هو من آثار كون الزمان من شعبان أو عدم كونه من رمضان لا من آثار مجرد بقاء وجود شعبان في العالم أو عدم وجود رمضان كذلك. وحينئذ فكيف يثمر [الاستصحابان]؟ وعليه فلا مجال لتطبيق مثل هذا المقام على مفاد الاستصحاب، بل من الممكن كونه ضرب قاعدة مستقلة دالة على [ترتب] وجوب الصوم على اليقين بالرمضانية لا عدمه على بقية الشعبانية وإلى ذلك أيضا نظر الطوسي في الكفاية (12). ومنها: قوله: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام . (13) بتقريب أن كلمة حتى تدل على استمرار الحلية إلى زمان العلم تعبدا. ولا نعني من الاستصحاب إلا ذلك. أقول: لا يخفى أن تلك القضية إن كانت في مقام الحكاية عن الإنشاءات الواقعية - ولو بقرينة التطبيق في [ذيلها] على مورد اليد وغيرها من الأمارات والاصول الموضوعية غير [المناسبة] مع كون القضية بنفسها في مقام صرف جعل الحلية بعنوان مشكوك الحكم - فلا غرو في استفادة القواعد المتعددة من [مثلها]. منها: جعل الحلية للشيء بعنوانه.
ومنها: جعل الحلية الظاهرية له في مرتبة متأخرة عن الشك [في] حكمه. ومنها: جعل استمرار تلك الحلية إلى زمان العلم. كل ذلك بمقتضى إطلاق الحلية المحكوم فيها للأعم من الواقعي والظاهري بضميمة إطلاق الاستمرار الظاهري بالنسبة إلى الحلية الواقعية، فارغا عن ثبوته بالنسبة إلى الظاهرية، بمعنى [جعلها جارية مستمرة] في نظر واحد، إذ لا قصور في القضية المزبورة في مقام الحكاية عن هذه الإنشاءات المختلفة من دون لزوم محذور فيه من مثل: اجتماع اللحاظين في [مفادها]، كما لا يخفى. ومن هنا ظهر أيضا أن في استفادة الحكم الواقعي والظاهري من المغيا يكفي مجرد إطلاق المحمول بالنسبة إلى أثر مجعول في رتبة سابقة [على] الشك [فيه] أو
لاحقة [له] مع حفظ ظهور الشيء في خصوص العنوان الأول للمحكوم عليه المستتبع لجعل التشكيك [في] حكمه من الجهات التعليلية للحكم الظاهري لا [التقييدية] بلا احتياج فيه إلى تعميم الشيء للعناوين الظاهرية أيضا أو التعميم لذات ملازم للشك [في] حكمه فيتعدى إلى غيره أيضا بعدم القول بالفصل، كي يرد على الأول عدم صلاحية الشيء لمثل ذلك التعميم، كيف! وإلا فيلزم كون مجمع العناوين المتعددة أشياء متعددة، وهو كما ترى. ويرد على الثاني أن مجرد [ملازمة] الشيء لعنوان مشكوك الحكم لا يقتضي كون الحكم الثابت بعنوان ذاته حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي محض، كما لا يخفى. نعم بناء على ما ذكرنا: لا يكاد يستفاد من الرواية الاستصحاب بالمعنى المشهور ب إبقاء ما كان ، وسيأتي إن شاء الله في محله الإشارة إلى عدم صلاحية هذا المعنى للحكومة على سائر الاصول الشرعية ولا حكومة الأصل السببي منه على المسببي، وإنما الشؤون المزبورة مرتبة على التعبد بإبقاء اليقين بما كان عند الشك وأن النقض - في اعتبار نقض اليقين - متعلق بنفس اليقين بملاحظة ما يترتب عليه من الآثار العملية بلا جعله طريقا لإيصال [النقض] إلى المتيقن واقعا، فانتظر لشرح تلك الجهة في طي التعرف لوجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول. وأما لو كانت القضية المزبورة في مقام بناء الحكم بالحلية المستمرة إلى زمان العلم ففي استفادة القواعد الظاهرية - علاوة على إشكال تطبيق الإمام إياه على مورد الأمارة والاصول الموضوعية - إشكال، وذلك لأن من المعلوم أن الحلية بعد فرض كونها مجعولة بهذا الكلام يستحيل أن يكون [لها] عموم شامل للواقعية والظاهرية، لأن قضية وحدة الجعل كون المجعولين في رتبة واحدة، والمفروض أن جعل الحكم الظاهري بعد الفراغ عن ثبوت حكم واقعي من جهة أخذ الشك [فيه] في موضوع الحكم أو جهة تعليلية له. وبهذا الوجه أيضا نقول: بأن الحكم باستمرار الشيء ظاهرا أيضا لابد وأن يكون في ظرف الفراغ من حدوثه واقعا ولذا يستحيل أن يكون الاستصحاب أيضا مجعولا بعين جعل مستصحبه وفي ضمنه، بل لابد وأن يتعلق به جعل مستقل في ظرف الفراغ عن وجود مستصحبه واقعا وجعله. وعليه فنقول: إن في مثل تلك القضية المشتملة على المغيا والغاية وإن أمكن [اشتمالها] على الجعلين المستقلين، أحدهما متعلق بذات المغيا والآخر بالغاية بضم كون الغاية في طول جعل [مغياها]، ولكنه خلاف ظاهر القضية من جهتين: [إحداهما] أن ظاهر أمثال تلك القيود المأخوذة في الكلام ملحوظة تبعا للمعنى أعم من أن [تكون] الجملة في مقام الحكاية عن الواقع أو في مقام إيقاع نفس المعنى وإنشائه، فلا جرم يكون القيد المأخوذ في الجملة الإنشائية متعلق إنشائية المقيد به ضمنا، وليس متعلق إنشاء مستقل. وحينئذ فجعل مثل تلك الغاية بحسب إنشاء مستقل في طول إنشاء مغياه خلاف الظاهر. وثانيتهما أنه لو كان مثل تلك الغاية في مقام إنشاء استمرار المغيا فلابد وأن يكون المراد استمراره الإدعائي لاستحالة بقاء الشيء حقيقة في الرتبة المتأخرة عن الشك [في] نفسه، فلا محيص من جعل استمراره ادعائيا، وهو أيضا خلاف الظاهر. وحينئذ فحفظ ظهور الغاية من الجهتين لا يمكن إلا بجعل المغيا حلية ظاهرية كي يكون بوجودها الخاص المستمر مجعولا بجعل واحد متعلق بالمغيا والقيد ضمنا، ولازمه عدم إفادة القضية إلا مفاد [قاعدة] الحلية ليس إلا، بلا استفادة حكم واقعي ولا استصحابه من [مثلها] أصلا. نعم ما ذكرنا في عالم الإمكان [يقيني]، ولكن أنى لنا بإثباته؟ كما أن ما هو ممكن أيضا هو خصوص الحكم الواقعي واستصحابه أو مفاد القاعدة واستصحابها عند الشك في بقائها. أما الأول فهو واضح كما عرفت تقريبه. وأما الثاني ف [بأن] يراد من الحلية المجعولة خصوص المجعول في مرتبة متأخرة عن الشك [في الواقع] بنحو الإجمال فيه بلا إطلاق فيه وبلا احتياج في ظاهريته إلى رجوع الغاية إليه، بل اريد من الغاية الحكم باستمرارها مستقلا إلى زمان العلم بالنجاسة بحيث يكون العلم المزبور رافعا لموضوع المستصحب وكان غاية لاستصحابه أيضا من جهة استلزامه الجزم بانتفاء المستصحب الشخصي وإن كان الشك في بقاء الحلية للطبيعة المشكوكة باقيا حتى مع العلم بالقذارة الشخصية، وأن غاية استصحابه ليس إلا العلم بنسخه، لكن يكفي - لجعل العلم بالقذارة أحيانا غاية الاستصحاب المزبور - ملاحظة شخص القضية الحاكية عن فعلية الحلية الظاهرية في شخص المشكوك حكمه، فإنه لو شك في بقاء مثل هذا الحكم في الآن الثاني والثالث وهكذا لا بأس باستصحابه ما لم يقطع زوال المستصحب ولو بزوال موضوعه أو علته. وعليه فلا بأس بإمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في مدلول هذه القضية بلا لزوم محذور فيه من اجتماع النظرين في مفاد القيد، إذ ذلك إنما يلزم لو كان وجه ظاهرية الحلية المجعولة في صدر القضية إرجاع الغاية [إليها] ثم ملاحظتها مستقلا في مقام استصحابها، إذ حينئذ يلزم كون قيد واحد ملحوظا فيها ضمنا واستقلالا في طي إنشائه وهو محال. وأما بناء على تقريبنا من جعل قوام ظاهرية الحلية ملاحظتها في مرتبة متأخرة [من] الشك [في الواقع] بلا ارجاع القيد [إليها] في مقام [انشائها]، بل كان القيد المزبور متعلق إنشاء مستقل به في مرتبة متأخرة عنه، فلا يرد محذور فيه أصلا، غير أنه خلاف ظاهر القضية من الحيثيتين السابقتين. نعم في استفادة القواعد الثانية من جعل الحلية الواقعية والظاهرية واستصحابهما كمال إشكال، وذلك أيضا لا من جهة اجتماع اللحاظين في طرف القيد، بل من جهة استحالة إطلاق المحمول الواحد المأخوذ في طي إنشاء واحد لمرتبتي الواقع والظاهر كما عرفت وجهه. ومن هنا ظهر أيضا بطلان استفادتهما ولو من ناحية إطلاق الموضوع بالنسبة إلى العناوين الطارية أو إطلاقه بالنسبة إلى شخص ذات ملازم للشك في حكمه، إذ مثل هذا الاطلاق مستحيل في عرضية واحدة الانشاء وطولية المنشأ (14). مضافا إلى منع إطلاق الأول وإلا يلزم ان يكون الواحد المجمع للجهات أشياء متعددة، وعدم إثمار الثاني، لأن الحكم الثابت للذات الملازم مع الشك [في] حكمه لا يخرج عن واقعيته، كما لا يخفى. ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر تقريب الاستدلال بعموم كل شيء طاهر (15) إلا أن فيه شبهة اخرى حتى على فرض خبريته حيث إن الطهارة الظاهرية لا [تكون] حقيقية من جهة محذور اجتماع الضدين أو المثلين حتى مع اختلاف الرتبتين، بل لابد وأن [تكون] ادعائية. وبعد ذلك لا [تصلح] مقدمات الإطلاق [لإثباتها]. نعم بناء على كونهما انتزاعيين عن الحلية والحرمة فلا يكاد حينئذ [يرد]
مثل هذا الإشكال أيضا، لعدم التضاد بين الحرمة الواقعية مع الحلية والترخيص الحقيقي الظاهري، كما لا يخفى على من راجع كلامنا في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. هذا كله مضافا إلى اختصاص مثل هذه الرواية بظهور [كونها] في مقام إنشاء الحكم الآبي من [استفادة] غير مفاد القاعدة [منه] بخلاف مفاد كل شيء لك حلال ، فإنه بقرينة تطبيقها على الأمثلة في [ذيلها] لا يمكن تصحيحها إلا بجعل القضية في مفاد الحكاية عن إنشاءات عديدة [للعناوين] المتعددة، وبعد ذلك فلا غرو في استفادة تبعية القواعد المعهودة أيضا من إطلاقها. وتوهم أن استفادة الاستصحاب منها أيضا فرع كون الاستمرار ادعائيا، لعدم قصور حقيقته بالنسبة إلى الحكم الواقعي بالإضافة إلى مرتبة الظاهر وهو لا يناسب مع كونه بمعناه الحقيقي واستمرارا حقيقيا بالنسبة إلى الحكم الظاهري مدفوع ب [أنه] بعد فرض إطلاق المعنى للحكم الواقعي والظاهري يكفي ذلك قرينة على كيفية تطبيق الاستمرار في مورده الادعائي والحقيقي، ولا قصور في ذلك بعدما كان من باب الدالين. وما استشكلناه سابقا في استفادة الفردين المزبورين من الإطلاق إنما هو في صورة عدم وجود قرينة خارجية على كيفية تطبيق العنوان على الفردين، وقلنا بأن مجرد الإطلاق [بمقدماته] لا يقتضي مثل [تلك] التوسعة في عالم التطبيق، كما لا يخفى على من له نظر دقيق.
_____________
(1) راجع فرائد الاصول: 650 - 651.
(2) منها ما وردت في سورة يونس الآية: 36 وفي سورة الاسراء الآية: 36 وغيرهما من الآيات.
(3).
(4) الوسائل 1: 174، باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.
(5) راجع كفاية الاصول: 442.
(6) التهذيب 1: 421، الحديث: 1335، والوسائل 2: 1061، الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث 1، والصفحة: 1065، الباب 44 من الأبواب، الحديث 1.
(7) الوسائل 5: 321، الباب 10 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3.
(8) راجع الوسائل 16: 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 12.
(9) المستدرك 1: 228، الباب الأول من نواقض الوضوء، الحديث 4.
(10) جاء في الأصل على الغالب أو على كسب المرآت لأن مرتبته لا يوجب... وانما عدلنا إلى ما أثبتناه بالنظر إلى ما جاء في تقريراته (رحمه الله) راجع نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الرابع: 64.
(11) الوسائل 7: 184، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.
(12) راجع كفاية الاصول: 452.
(13) الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
(14) الظاهر انه يريد أن يقول: إن مثل هذا الاطلاق يستحيل أن يكون في عرض واحد مع الانشاء وفي طول المنشأ أيضا .
(15) المستدرك 2: 583، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 4.



|
|
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|