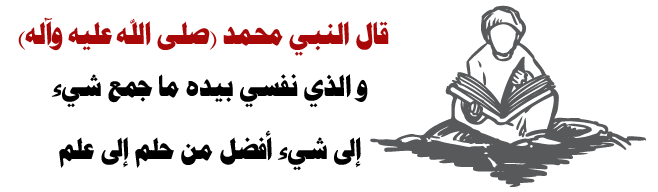
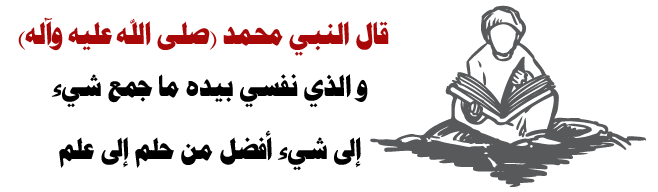

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
التاريخ: 4-9-2016
التاريخ: 4-9-2016
التاريخ: 4-9-2016
|
الكتاب لغة (1) يتناول كلّ مكتوب ، وخصّ شرعا بالقرآن. وقد عرّف القرآن بتعريفات لا يتمّ واحد منها :
منها : أنّه كلام منزل للإعجاز بسورة منه (2).
والإيراد عليه بوجوه :
الأوّل : أنّه دوريّ ؛ لأنّ القرآن مأخوذ في تعريف السورة ، كما يجيء (3).
الثاني : أنّه ليس تعريفا بالحدّ ولا بالرسم ؛ لأنّ الأوّل يكون بالأجزاء ، والثاني باللوازم البيّنة ، وكونه للإعجاز ليس كذلك.
الثالث : أنّه لا يتناول البعض ؛ لأنّ لفظة « من » للتبعيض ، والضمير عائد إلى الكلام ، و «منه » في موضع الحال ، وقوله : « بسورة » يفيد العموم ، كما هو شأن كلّ نكرة مقارنة للوحدة وإن كانت في سياق الإثبات ، كقولهم : « تمرة خير من جرادة » فيصير المعنى أنّه كلام (4) منزل للإعجاز بكلّ سورة حال كون كلّ سورة جزءا من هذا الكلام » والكلام الذي كلّ سورة جزء منه هو مجموع القرآن دون أبعاضه. فعلى هذا لا يكون القرآن صادقا على بعضه ، وهو لا يلائم غرض الاصولي ؛ لأنّه إذا قال : دليل هذا الحكم القرآن ، إنّما يريد منه بعضه.
ويمكن أن يدفع ذلك بتقدير مضاف (5) ، بأن اريد « بسورة من جنسه » في العلوّ والبلاغة ، وحينئذ يصير المعنى أنّ كلّ سورة من جنس هذا الكلام.
ولا يخفى أنّه يصدق على كلّ بعض « أنّ كلّ سورة من جنسه في البلاغة والعلوّ » فيكون القرآن اسما لمفهوم كلّي صادق على المجموع ، وعلى كلّ بعض منه ، إلاّ أنّ هذا خلاف الظاهر ، والاجتناب عن أمثاله في الحدود لازم.
ومنها : أنّه ما نقل بين دفّتي المصحف تواترا (6).
وهو أيضا دوريّ ؛ لأنّ معرفة المصحف تتوقّف على معرفة القرآن ؛ لأنّه ما كتب فيه القرآن ، ولو لم يتميّز المصحف عن سائر الكتب بكتابة القرآن فيه ، لصدق التعريف على سائر الصحف أيضا.
ويرد عليه الإيراد الثاني (7) أيضا ؛ لأنّ النقل المذكور ليس من أجزاء القرآن ، ولا من لوازمه البيّنة.
ومنها : أنّه كلام لا يصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه (8).
ويرد عليه الإيراد الثالث (9) ، وينتقض طردا بمثل التشهّد.
ومنها : أنّه كلام يحرم مسّ خطّه محدثا (10).
ومنها : أنّه كلام بعض نوعه معجز ، أو كلام الله المنزل للإعجاز (11).
ويرد على هذه الثلاثة الإيراد الثاني ، مع أنّه يرد على الأوّل ، أنّ حرمة المسّ ممّا وقع فيه الخلاف.
قيل : الحقّ أنّ هذه التعريفات لفظيّة ، والمراد منها تصوير مفهوم اسم القرآن بذكر بعض أحكامه العارضة ، وليس المراد منها التحديد ولا التمييز ، وحينئذ تكون التعريفات بأجمعها صحيحة ؛ لعدم اعتبار الانعكاس والاطّراد ، وكونه بالجزء أو اللازم البيّن في التعريف اللفظي (12).
أقول : يمكن تصحيح التعريف الآخر بأن يقال : الإنزال للإعجاز لا يصدق على غير القرآن ، فلا يصدق على سائر المعجزات حقيقة بأنّها معجزات منزلة ، فالإنزال للإعجاز بيّن الثبوت للقرآن ، بيّن الانتفاء عن غيره ، فلا ينتقض التعريف.
ولو لا وقوع الخلاف في حرمة مسّ القرآن ومسّ غيره من أسماء الله وأنبيائه ، لأمكن تصحيح التعريف الرابع أيضا بنحو ما ذكر ، فالصواب هو التعريف الأخير ، ويدخل فيه كلّ بعض من القرآن وإن كان نحو « قل » و « افعل » ؛ فإنّه من حيث الجزئيّة ، واعتباره مع السابق واللاحق يكون منزلا للإعجاز ، ويصدق عليه القرآن ، ولذا يحرم مسّه على القول بحرمة مسّ القرآن.
ويتفرّع عليه أيضا ثبوت جميع الأحكام اللازمة للقرآن لكلّ بعض منه.
ويظهر الفائدة أيضا في الأيمان ، والتعليقات ، وأمثالهما.
ثمّ إنّه قيل لتأييد أنّ هذه التعريفات لفظيّة : إنّ القرآن اسم علم شخصي ، فلا يعرّف ؛ لأنّ التعريف إنّما يكون للحقائق الكلّيّة دون الأعلام الشخصيّة (13).
أقول : بناء هذا القائل على أنّ القرآن اسم لهذا المؤلّف الحادث القائم بأوّل محلّ أوجده الله فيه ، والقائم بالمحالّ الآخر ليس عينه ، بل مثله ، فيكون القرآن شخصا واحدا. وهذا مذهب ضعيف.
والتحقيق : أنّه اسم لهذا المؤلّف من دون تعيين المحلّ ، فيكون مفهوما كلّيّا صادقا على ما ثبت في أيّ محلّ كان ، سواء كان ذوات الملائكة ، أو صدور الحفّاظ ، أو متون الصحف ، أو غير ذلك. ولو لا ذلك لم يصدق القرآن حقيقة على ما يقرأه القرّاء وما ثبت في الصحف ، ويلزم منه عدم ترتّب الأحكام الثابتة للقرآن عليه (14) ، وهو واه.
تتمّة:
عرّف السورة بأنّها البعض المترجم أوّله وآخره توقيفا (15).
واورد عليه : بأنّه يدخل فيه الآية ؛ إذ لا معنى للمترجم إلاّ المبيّن ، وبيان أوّل الآية وآخرها بالتوقيف (16).
وقيل : هي طائفة من القرآن مصدّرة بالبسملة ، أو البراءة (17).
ونقض طرده بالآية التي بعد البسملة والبراءة. فأضيف إليه « متّصل آخرها بالبسملة ، أو البراءة » فنقض عكسه بالسورة الأخيرة. فأضيف إليه « أو غير متّصل بشيء منهما » (18) فنقض طرده بسورتين (19) وببعض سورة النمل.
وقيل : هي الطائفة المترجمة ، أي المسمّاة باسم خاصّ (20).
ونقض طرده بآية الكرسيّ (21) ، وآية المباهلة (22) ، والمداينة (23).
واجيب : بأنّ المراد من التسمية تسمية الشارع ، ولم يثبت تسمية الآيات المذكورة من الشارع ، بل يجوز أن تكون من النبيّ أو غيره ، بخلاف تسمية السور ؛ فإنّها من الله تعالى.
والأولى أن يراد من الترجمة ما يكتب في عنوان السور بالحمرة ؛ فإنّ الترجمة قد تطلق على ما يكتب في عنوان المكاتيب من اسم المرسل إليه وأمثاله.
ولو أريد التخلّص عن هذا التوجيه أيضا ، فيجب أن تعرّف بـ « أنّها طائفة من القرآن يكتب ترجمتها في عنوانها بالحمرة » وحينئذ لا يرد عليه نقض ، ولا يحتاج إلى تكلّف التوجيه.
ووحدة سورة « والضحى » و « ألم نشرح » وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ـ على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب (24) ـ لم تثبت. والأخبار (25) التي استدلّوا بها عليها غير دالّة على مطلوبهم ، وبعض الأخبار (26) يدلّ صريحا على التعدّد.
__________
(1) المصباح المنير : 524 ، « ك ت ب ».
(2) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 45 ، ومختصر المنتهى : 109.
(3) في « ب » : « سيجيء ». وسيجيء في ص 186.
(4) في « ب » : « كلامه ».
(5) والمراد المضاف إلى الضمير في « منه » والمضاف هو لفظ « جنس ».
(6) قاله الغزالي في المستصفى : 81 ، ونسبه القاضي عضد الدين إلى قوم في شرح مختصر المنتهى 1 : 109.
(7 ـ 9) راجع المصدر.
(10) قاله المطيعي في سلّم الوصول ، المطبوع مع نهاية السؤل 2 : 3.
(11) قاله الأسنوي في نهاية السؤل 2 : 3.
(12) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 45 ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 109 ، وراجع : الإحكام في أصول الأحكام 1 : 211 و 212 ، وذكرى الشيعة 1 : 44 و 45 ، وإرشاد الفحول 1 : 85 و 86.
(13) قاله القاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 109.
(14) راجع المصدر.
(15) قاله القاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 109.
(16 و17) راجع المصدر.
(18) في هامش « أ » : الظاهر سقوط لفظة « منهما » إذ معها يبقى نقض الطرد بحاله ؛ لأنّه يصدق على صدور السور أنّه طائفة من القرآن مصدّرة بالبسملة ، وآخره غير متّصل بشيء من البسملة وبراءة. أمّا لو اسقطت لفظة « منهما » ، لم يصدق عليه ؛ فإنّ آخره متّصل بشيء وهو آية اخرى. ولا بدّ من زيادة لفظة « فيه » بعد « متّصل » حتّى لا يخرج السورة الأخيرة لو اتّصل آخره بالتأريخ ؛ إذ التأريخ ليس من القرآن. « نصرآبادي ».
(19) والمراد بهما سورتا « والضحى » و « ألم نشرح » وسورتا « الفيل » و « لإيلاف قريش ».
(20) نسبه السيوطي إلى غير الجعبريّ في الإتقان 1 : 52.
(21) البقرة (2) : 255. وهي قوله تعالى : ( اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .... )
(22) آل عمران (3) : 61. وهي قوله تعالى : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ .... )
(23) البقرة (2) : 282. وهي قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ .... )
(24) منهم : الشيخ في التبيان 10 : 371 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام 1 : 273 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 262.
(25) منها : صحيحة زيد الشحّام ، المرويّة في تهذيب الأحكام 2 : 72 ، ح 266 ، ورواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان 10 : 544 ، ورواية أبي العبّاس عن أحدهما (عليهما السلام) ، المرويّة في مجمع البيان 10 : 544.
(26) وهي رواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان 10 : 544. وجه الدلالة على التعدّد أنّ الاستثناء فيها متّصل ، واستثناء عن سورتين « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش ».



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|