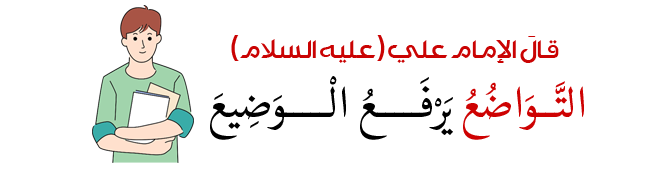
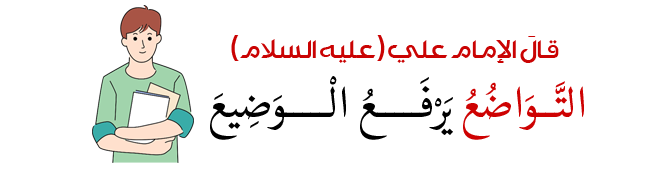

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2021
التاريخ: 2024-10-28
التاريخ: 25-4-2021
التاريخ: 7-10-2016
|
المحبة ودورها في حياة الإنسان
الحبّ من الميول الفطرية المودعة في كلّ إنسان، وهو كامنٌ في نفوس الجميع، ولا يمكن أن يخلو منه أيّ إنسان، وحقيقة الحبّ عبارة عن التعلّق الخاص والانجذاب المخصوص بين المرء وكماله. وكل واحدٍ منّا يعلم حضوراً بوجود تعلّقٍ وانجذابٍ في قلبه، وإن اختلف هذا المتعلّق بين شخصٍ وآخر، فالثابت والمشترك بين الجميع هو أنهم يتعلّقون بالكمال أو الكامل الذي يرونه بحسب اعتقادهم وتصوّرهم.
أمّا دور الحبّ فهو لا ينحصر فقط في طمأنينة الباطن وسكينته، بل للحب دور آخر أكثر أهميّة. إنّ هذا الحبّ هو المسؤول عن جميع توجهات البشر وتحركاتهم، لأنّ الحبّ كما يعرّفه العلامة نصير الدين الطوسي: "هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة العاشق لنفس المعشوق في الجوهر، وهو يجعل النفس لينة شيقة ذات وجد ورقّة منقطعة عن الشواغل الدنيوية"[1].
فالمحب سوف يسعى على الدوام إلى مشاكلة محبوبه في صفاته وشمائله وأفعاله، فإذا كان المحبوب كاملاً تامّاً، وشمائله عظيمةً رفيعة، اتّجه وجوده وصفاته نحو المشاكلة التامّة.
فلا يبقى بينه وبين المحبوب أي فارق، فلا يعصيه ولا يخالف له أمراً، ذلك لأنّ الحبّ الذي لا ينطلق من الأنا وحب النفس (وهذا هو الحبّ الحقيقي)، هو عبارةٌ عن النظر إلى المحبوب وإلى ما يريده وما يرتضيه.
القلب أمير البدن
من هنا كان الحبّ من أهم العوامل التي تسهّل سبيل الطاعة، بل بإمكاننا القول أيضاً إنّ الطاعة ليست سوى أحد لوازم الحبّ، فبمقدار الحبّ تكون الطاعة، ذلك لأنّ القلب هو أمير البدن كما في حديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): "... إنّ الله تعالى ما فرض الإيمان على جارحة من جوارح الإنسان إلا وقد وُكِلَت بغير ما وُكِّلَت به الأخرَى فمنها قلبه الذي يعقل به ويفقه ويفهم ويحلّ ويعقد ويريد وهو أمير البدن"[2]، وكل الأعمال التي تصدر عن الأعضاء والجوارح، إنّما تكون بإمرة القلب، وليس العقل كما يتصوّر أحياناً، فعقولنا ليست سوى مصباح، يضيء لنا طريقنا، أما المحرّك الواقعي والمسؤول الحقيقي عن أيّة حركة وفعل مهما كان بسيطاً فهو القلب، وإذا أردنا أن نعرف كيفيّة صدور العمل عن الإنسان ينبغي الالتفات إلى المراحل التالية:
1- مرحلة التصوّر: عندما يستحضر صورة العمل مستعيناً بالخيال، ويتصوره في نفسه.
2- مرحلة التصديق: فيقوم العقل بتحليل هذا العمل ومدى فائدته، فإذا كان العقل أسير الأهواء فسوف يبقى معطلاً، فتكون الأهواء هي الحاكمة وفق ما تراه ودون الأخذ بعين الاعتبار رضا الحقّ سبحانه أو موافقة شريعته.
3- مرحلة التعلّق: وهنا يأتي دور القلب، حيث ينظر إلى العمل ويزنه على أساس ما يحبّ. فإذا كان حبّ الدنيا مسيطراً على القلب، فإنّ القلب سيتعلّق به، ويحرّك البدن باتجاهه. وإذا كان القلب متعلّقاً بالله، فلن يتعلّق القلب بهذا العمل، بل سينفر منه لأنّه سيبعده عن محبوبه، ولن تتحرّك الأعضاء نحو العمل المذكور.
4- مرحلة التنفيذ: وهي مرحلة ظهور العمل بواسطة الآلات والجوارح في الخارج.
من نحبّ واقعاً؟
كما لاحظنا سابقاً إنّ للقلب الدور المركزيّ في صدور الأفعال كافّة. وهذا الدور مرتبطٌ بالشيء المحبوب الذي تعلّق القلب به. ولهذا إذا صلح القلب صلح الإنسان بصلاح أعماله واستقامتها. ومن هنا نعرف معنى كلام الإمام الصادق (عليه السلام): "وهل الدين إلَّا الحبّ"[3]، ونقترب من جواب الإمام الباقر (عليه السلام) لسائل سأله إذا كان فيه خيرٌ أم لا، فقال (عليه السلام) له: "إذا أردت أنّ تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك..."[4]، وسيكون من نتائج هذا الفهم وضوح أحد معاني الآية الكريمة: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾[5].
فالحبّ بدوره المركزي أضحى أحد أهمّ مميّزات الإسلام. والتركيز على الحبّ ودوره في حياة الإنسان ومصيره ليس أمراً هامشياً أو عبثياً، لأنّ الإسلام أراد إصلاح الإنسان من خلال إصلاح مركز وجوده ومعدنه، هذا الإصلاح يتحقّق عندما يتعلّق القلب بالكمال الحقيقي الذي تعشقه الفطرة الإنسانية وتميّل إليه.
فقلب الإنسان بحسب الفطرة التي فطر عليها لا يمكن أن يتعلّق بالنقص أو بما يسبّب له الضرر، بل ولا يمكن أن يتعلّق بالكمال المحدود والفاني، ففي أعماق كل إنسان فطرةٌ ينبثق منها هذا الحبّ، وهي لا تريد ولا تطلب سوى الكمال المطلق اللامتناهي، وقد أرسل الله تعالى الأنبياء إلى النّاس، ليس لأجل وضع الفطرة فيهم أو إنشائها في بواطنهم، بل من أجل هدايتهم إلى ما تصبو إليه هذه الفطرة الكامنة فيهم، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكّروهم مَنسِيّ نعمته، ويحتجّوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول"[6].
بعبارةٍ أخرى بُعثوا ليدلّوهم على المصداق الواقعي للكمال الذي ينشدونه، وهو الحق جلّ وعلا، حتى إذا سيطرت محبته على القلب زالت كل التعلّقات الأخرى وعلى رأسها حبّ الدنيا على قاعدة "عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم"[7]، فيزول الانجذاب والتعلّق بالكمال الزائل الفاني، ولا تتعلّق قلوبهم إلَّا بما يرتبط بمحبوبهم.
أهل البيت هم مظاهر الحبّ الواقعي
ولكن لأنّ طبيعة الناس ونفوسهم مستغرقةٌ في عالم الدنيا والظاهر، ولا يمكنهم في البداية أن يتعرّفوا إلى المصداق الحقيقي للكمال المطلق وهو الله، فقد أنزل الحقّ تعالى إليهم مظاهر هذا الكمال بجلباب البشرية لكي يتعرّفوا إليه من خلالها، فكان أعظم ما في هذا الوجود هو خلق هذا الخليفة لله بصورة البشر ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ﴾[8] فكان هذا الخليفة الواقعي هو المظهر والممثّل الحقيقي للمستخلف، أي مظهر إرادة الحق وكمالاته المطلقة في هذا العالم، ولهذا كان خلق أهل البيت عليهم السلام حيث يشاهد الناس أمامهم بشراً يمشون في الأسواق، ويأكلون الطعام، وينامون، ويتزوّجون، ومع ذلك فهم مظاهر تامّة للكمال الإلهي اللامتناهي، وهذا مما سيلهب وجدانهم ويزيد من شوقهم ويلقي الحجّة التامّة عليهم.
فعن الإمام الباقر (عليه السلام): "إذا أردت أنَّ تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك. فإذا كان يحب أهل طاعة الله، ويبغض أهل معصيته، ففيك خيرٌ، والله يحبك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله، ويحب أهل معصيته، فليس فيك خيرٌ، والله يبغضك، والمرء مع من أحب"[9].
وفي رواية أخرى أنّ رجلاً يُدعى أبا عبد الله دخل على أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له الإمام: "يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عزّ وجلّ ﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ * وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قال: بلى يا أمير المؤمنين، فقال الإمام (عليه السلام): "الحسنة معرفة الولاية، وحبنا أهل البيت، والسيّئة إنكار الولاية، وبغضنا أهل البيت"[10].
وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال لأصحابه: "أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم الصلاة، وقال بعضهم الزكاة، وقال بعضهم الحج والعمرة، وقال بعضهم الجهاد في سبيل الله، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لكلّ ما قلتم فضلٌ وليس به، ولكن أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله، والبغض في الله، وتولّي أولياء الله والتبرّي من أعداء الله"[11].
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): "لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنّه قضي فانقضى على لسان النبي الأميّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: يا عليّ لا يبغضك مؤمنٌ، ولا يحبك منافق"[12].
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: "من رزقه الله حبّ الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة. فلا يشكّن أحدٌ أنّه في الجنة. فإنّ في حبّ أهل بيتي عشرين خصلة، عشر منها في الدنيا، وعشر في الآخرة، أمّا في الدنيا فالزهد، والحرص على العمل، والورع في الدين، والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت، والنشاط في قيام الليل، واليأس مما في أيدي الناس، والحفظ لأمر الله (عزّ وجلّ) ونهيه والتاسعة بغض الدنيا، والعاشرة السخاء، أمّا في الآخرة: فلا ينشر له ديوان، ولا ينصب له ميزانٌ، ويُعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من النّار، ويبيّض وجهه، ويكسى من حلل الجنّة، ويشفّع في مئة من أهل بيته، وينظر الله عزّ وجلّ إليه بالرحمة، ويتوّج من تيجان الجنّة، والعاشرة يدخل الجنّة بغير حساب"[13].
[1] أبو علي سينا، الإشارات والتنبهيات، ج 4، ص 602، تحقيق وشرح نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، شرح الشرح للعلّامة قطب الدين محمد بن محمد أبي جعفر الرازي، الناشر نشر البلاغة – قم، مطبعة القدس – قم، 1383ش، الطبعة 1.
[2] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 66، ص73.
[3] الشيخ الكليني، روضة الكافي، ج8، ص79.
[4] الشيخ الكليني، أصول الكافي، ج2، ص126.
[5] سورة الشعراء، الآيتان: 88 – 89.
[6] نهج البلاغة، ج 1، ص 23.
[7] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 64، ص 315.
[8] سورة البقرة، الآية: 30.
[9] الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص126.
[10] م. ن، ج1، ص185
[11] م.ن، الكافي، ج2، ص125.
[12] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج34، ص50.
[13] م. س، ج27، ص78.



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|