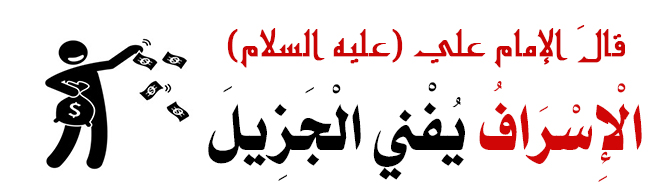
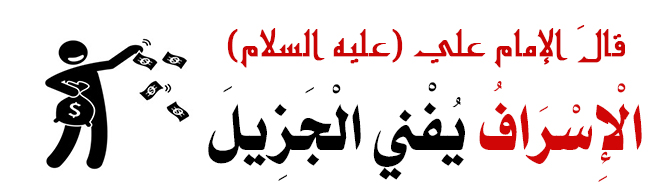

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-08
التاريخ: 10-4-2016
التاريخ: 17-8-2022
التاريخ: 21-9-2021
|
بالرغم من صعوبة تحديد مفهوم المالية العامة (1) في الإسلام، لكن يمكن الإشارة اليه بالخطوط العامة في هذا الموضوع اشتمل بيت المال في الإسلام على الإيرادات الدورية ( كالزكاة والخراج )وإيرادات أخرى غير دورية لا تتكرر سنوياً ( كخمس الغنائم والفيء والتركة التي لا وارث لها ... ) وعلى النفقات العامة والخاصة .
ففي أخريات خلافة عمر (رضي الله عنه) الذي أمر بإنشاء (دیوان بیت المال) (2) قد نظم الإيرادات في عدة بيوت أهمها :
البيت الأول : خاص (بالزكاة)
يعتبر هذا البيت مورداً لا ينضب لاحتوائه على الهدف الديني (الدنيوي والأخروي) وعلى الهدف المالي والاجتماعي والاقتصادي .
فالزكاة فريضة تعبدية يلتزم الفرد المسلم بأداء قدر فائض عن حاجته الخاصة وذلك لتطهر الفرد وتزكيه (3) فهي حق الله في أموال الأغنياء وليست تبرعاً أو إحساناً، فتأدية الفرد للزكاة إنما يطلب الثواب والإيمان لتحقيق العبودية الله مساهمة منه في تحقيق الأهداف الأخرى للزكاة.
أما الهدف المالي للزكاة فيتحقق من خلال كونها فريضة تعبدية، فهي أيضاً فريضة حكومية لتمويل بيت مال الدولة (4) فالفرد مجبر على دفعها وأدائها انطلاقاً من إستفادة وتمتعه بهذا المال الذي هو الله تعالى وأن هذا الفرد مستخلف، فعليه أن يؤدي ما عليه من نسبة مقابل استخدامه وتمتعه بمال الله هو( "" وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ....."" ) فلا بد من أن يساهم هذا الفرد في تحمل الأعباء المالية الدولة وأن يشارك في الحفاظ على النظام الإسلامي وديمومته . وكذلك كما ذكرنا للزكاة أهداف اجتماعية واقتصادية من خلال كونها أداة اقتصادية لإعادة توزيع الدخول والثروات بين الأغنياء والفقراء وأحداث التوازن بينهما. وتعتبر الزكاة وسيلة فعالة للتضامن الاجتماعي وتكافل أفراد المجتمع الواحد ومساعدة بعضهم البعض بهدف بناء نظام إجتماعي يقوم على مفهوم الأخوة والتعاون بين أفراد الدين الواحد والنظام الشامل لكافة المسلمين غنيهم وفقيرهم . إن الهدف الاجتماعي للزكاة هو متمم ومكمل للهدف الاقتصادي من خلال أن الزكاة أداة اقتصادية تساهم في تمويل اقتصاد الدولة وفي محاربة الاكتناز والاستغلال من جمعه وفي تحريك رؤوس الأموال المعطلة وتوجيهها في تحقيق الاستقرار والرفاهية الاقتصادية .
فللزكاة أهداف متعددة اقتصادياً واجتماعياً في كافة مجريات النشاط الاقتصادي والإجتماعي للمجتمع، ولكي تؤدي الزكاة أهدافها وآثارها المطلوبة دنيوياً وأخروياً لابد من الاهتمام بدراستها بالقدر الكاف لما تعطيه من آثار في حياة الأفراد والدولة وعلى صعيد أوجه النشاط المختلفة .
ولم تكن الزكاة قاصرة على مجرد كونها فريضة تعبدية بل لتحقيق التوازن الاقتصادي والإجتماعي وعلاجاً فعالاً للأزمات ولزيادة إيرادات الدولة مما يسمح بزيادة حجم الإنفاق العام وبالتالي تحسين مستوى الخدمات للمواطنين في جميع المجالات .
إن نجاح الزكاة في تحقيق أهدافها كان ثمرة تعاون بين الدولة والأفراد، حيث أدت إلى إحداث التغيرات اللازمة لإقامة نظام متكامل في تنمية الفرد دنيوياً وأخروياً .
البيت الثاني : خاص (بالخراج والجزية والعشور)
فالخراج ضريبة عينية على الأرض الزراعية التي فتحت صلحاً أو قهراً دون النظر إلى شخص مكلف بدفعها (5) .
أما الجزية فهي فريضة مالية تفرض على رؤوس أهل الذمة وتسقط بإسلام الشخص، فتفرض على كل رجل عاقل بالغ مع مراعاة ظروفه وقدرته الاقتصادية حيث تتغير نسبتها مع يسر المكلف وعسره (6) .
وتعتبر العشور من الفرائض المالية التي تفرض على بضائع التجار من أهل الذمة وغير المسلمين التي يقدمون بها إلى البلاد الإسلامية ولا تفرض على التجارة بين الدول الإسلامية تشجيعاً لها بين الدول الإسلامية (7) .
والعشور نظام مالي يعكس الحماية الاقتصادية للتجارة في الدول الإسلامية ويؤكد على الوحدة الاقتصادية لهذه الدول، ويتضمن دقة في القاعدة الاقتصادية التجارية والتضامن بين أفراد المجتمعات الإسلامية الواحدة، فهذه الحماية التجارية تنادي بها اليوم الدول المتقدمة اقتصادياً وتجارياً وذلك بعد مرور أكثر من ألف سنة، كان الإسلام قد أخذ بها وتعامل في ضوءها .
البيت الثالث : خاص بالغنائم والفيء والركاز
إن إيرادات الغنائم والفيء والركاز وإن كانت إيرادات غير دورية إلا أنها تعكس آنذاك التصنيف الدقيق والتوزيع في إيرادات الدولة، حيث كان تخصيص هذه الموارد لإنفاقها على منافع وخدمات عامة وهي موجهة لتغطية النفقات العسكرية والحربية وتوزيع الباقي أو الفائض من هذه الإيرادات إلى عدة أسهم محددة بآيات قرآنية، فما يأخذونه من غنائم عنوة وجبراً وبالقتال يوزع بحسب الأسهم. وكذلك الفيء، الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال وعن طريق الهدنة، وتقسيمه محدد بآيات قرآنية أيضاً . أما الركاز فهو المال الذي يعثر عليه في باطن الأرض كنزاً أو معدناً وأن حكمه يشبه إلى حد كبير حكم أموال الغنائم (8) .
البيت الرابع : خاص (بالإيرادات الأخرى)
ويقصد بها أموال المصادرة وأموال المرتدين والضوائع التي لا صاحب لها ولا يعرف مالكها أو وارثها فجميعها تشكل إبرادات لبيت المال (9)
يبقى أمامنا تقسيمات الإنفاق العام بعد أن أخذنا فكرة عن إيرادات «بيت المال».
فقد قسم الإنفاق في الإسلام على نوعين هما الإنفاق الحكومي والإنفاق الأهلي (10).
أـ الإنفاق الحكومي وفيه يقسم الإنفاق الى نفقات بحسب طبيعة الإيراد وبحسب حاجة الدولة، ففي الحالة الأولى توزع النفقة ضمن دائرة إيراد معين، أو بمعنى آخر أن كل إيراد ينفق على جهة معينة، مثلاً الإيراد الخاص بالزكاة ينفق ضمن ما هو محدد في الآية الكريمة ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )
يتبين من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد تولى قسمتها ولم يتركها للاجتهاد، فقد جاء توزيع إيرادات الزكاة على سبيل الحصر والقطع، وبذلك يلتزم المسؤول عن إنفاقها أو ما يسمى بولي الأمر بأن يصرفها بموجب الأصناف الثمانية (11) .
وبحسب مقتضيات المصلحة العامة، ويقاس ذلك على الإيرادات الأخرى حيث يخصص إنفاقها إما بموجب الآيات القرآنية أو السنة النبوية .
والحالة الثانية هو تقسيم النفقة بحسب حاجة الدولة وما تمر به من ظروف عرضية واستثنائية، يشبه التقسيم المالي الحديث الذي يقسم النفقات إلى عدة تقسيمات منها ما يسمى بالنفقات العرضية والاستثنائية، فغالباً ما تخصص الإيرادات الضرورية والاستثنائية لسد حاجة الدولة لنفقات طارئة وعرضية وهي نفقات مخصصة للإصلاحات المستعجلة واللازمة ضرورات تمر بها الدولة. ويلاحظ أن الإسلام قد أخذ وعمل بها آنذاك، واليوم تأخذ بها الميزانيات في كثير من الدول
ب - الإنفاق الأهلي، وهو إنفاق تعرفه الأنظمة المالية - الاقتصادية للدول الحديثة ولا يوجد ما يقابله في ميزانياتنا الحالية. يستند هذا الإنفاق على مبدأ وقاعدة التكافل أو التضامن الإقتصادي - الإجتماعي الذي لم تعرفه الأنظمة المالية الحديثة، بل جاء به النظام الإسلامي ولذلك ينفرد به ويشكل خصوصية ذات فوائد إجتماعية اقتصادية إضافة إلى الهدف المالي للدولة إن الإنفاق الأهلي والذي أوجبه الله تعالى على الفرد الميسور الحال، يدخل في دائرة الواجبات التي يقوم عليها أبناء المجتمع في إطار التكافل الديني وفي دائرة التضامن الاجتماعي داخل المجتمع الإسلامي الواحد (12) فهذا الإنفاق يقوم به الفرد أما بشكل تعبدي - ذاتى (13)، أو يقوم به الفرد بالإضافة إلى ذلك بهدف اقتصادي اجتماعي (14)
إن نصاب الإنفاق الأهلي غير مقيد ولا محدد بنسبة معينة، إنما متروك أمر القيام والعمل بدفعه للفرد وحسب إيمانه ودرجة إلزامه وفاءً لإيمانه وتحقيقاً للعدالة
الإجتماعية وتقليل الفوارق والتفاوت الاقتصادي والطبقي قدر الإمكان .
وإن من أنواع الإنفاق الأهلي (الصدقة الحسنة) والكفارة والوصية والوقف فهي إنفاقات متممة ومكملة للترابط الإسلامي والإجتماعي والاقتصادي.
أولاً - أساس الفرائض المالية والإنفاق في الإسلام
إن الفرائض المالية في الإسلام متعددة، فبعضها حددها القرآن الكريم كالزكاة والغنائم والفيء، والبعض الآخر جاءت بإقرار من رسول الله (ص) وأفعاله، ومنها ما جاءت باجتهادات الخلفاء رضوان الله عليهم. ولذلك فإن هذه الفرائض أساسها قائم على النظام المالي الإسلامي .
فمن هذه الفرائض ما يعتمد أساسها على قوله تعالى (( والله ملك السموات والأرض وما بينهما ....)) وقوله تعالى (( وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض .... ))وغيرها من الآيات التي تؤكد أن المال الذي بين أيدي البشر إنما هو الله تعالى، وأن الأفراد خلفاء لا أصلاء، وأن الأساس في هذه الفرائض المالية قائم على مفهوم الاستخلاف تمشياً . مع قوله تعالى ((وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )).
إن هذه الفرائض تدفع من الفرد بنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع ... أهمة في الاتكالية . والأعباء العامة للمجتمع من جهة، وتضامناً لحق الاخوة في المجتمع الإسلامي من جهة أخرى. وبذلك فإن دفعها من قبل الفرد يستند إلى الرحمة والشكر للمالك فضلاً عن أنها تعطى للفرد الزاماً بعقيدته وتطبيقاً لإيمانه. إضافة إلى أنها ترهيب وتخويف من سخط الله وعذابه .
ثانياً : القواعد التي تحكم جباية الإيرادات والإنفاق في الإسلام (15)
لقد جاء النظام المالي الإسلامي بعدة قواعد ومبادىء في حقلي الإيراد والإنفاق تشبه ما تأخذ به التشريعات المالية التقليدية والحديثة .
ففي جباية الإيرادات كانت تجبى وتدفع الفرائض المالية بشكل يتناسب ويتلائم مع القدرة المالية للفرد ومع مقدرته الاقتصادية. فقد كان المكلف يدفع الفريضة المالية سواء كانت هذه الفريضة زكاة أو خراج أو غير ذلك من الفرائض المالية المترتبة - من الله - على كل مسلم كي يساهم بماله ضمن العدالة وأن يتساوى في المعاملة المالية مع نظيره في اليسير .
واليوم تأخذ التشريعات الضريبية بقاعدة جباية الضريبة تسمى «بقاعدة العدالة». ويقصد بها المساواة في تحمل ودفع الأعباء المالية بشكل يتلاءم والقدرة المالية للأفراد في دفع الضرائب. وبمعنى آخر وبموجب هذه القاعدة فإن جميع الخاضعون للضريبة عليهم دفع الضريبة المالية بشكل متساو ومن دون محاباة أو تفضيل في الوقت والمبلغ، كما ويستفيد الجميع من الإعفاءات والسماحات
ومن القواعد المالية الأخرى التي جاء بها النظام المالي الإسلامي «قاعدة اليقين» التي نادى بها النظام الضريبي الحديث في وقت لاحق، وتتضمن هذه القاعدة أن على كل فرد وجوب العلم والدراية بما سيدفعه من فريضة ومقدارها المالي ونصابها ووقتها .
وذات الشيء بالنسبة «القاعدة الملاءمة في الأداء ومحتواها أن تتم جباية الإيرادات في وقت يلائم ويناسب ظروف المكلف المالية أي أن تحديد الوعاء الخاضع للضريبة يتم بحيث لا يرهق المكلف الضريبي .
وأكد الإسلام على ضرورة تنظيم جباية الإيرادات وعدم التبذير والإسراف في الصرف والنفقات عند قيام المسؤول الإداري بجباية الفرائض المالية، وبمعنى آخر أن لا تكون نفقات الجباية وما يدفع من رواتب الموظفي الجباية هي أكثر مما سيحصل عليه من إيرادات الفرائض وحتى لا نكون أمام هدر في المال العام وضياع الهدف من جباية الإيرادات ((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً)) (16) . وقد نادى النظام الضريبي الحديث بما يشبه هذا المفهوم، وأطلق على تطبيقه قاعدة «الاقتصاد في الإنفاق»، حيث تعمل بهذه القاعدة الماليات والأنظمة الضريبية الحديثة إن النظام المالي الإسلامي ركز على ضرورة تنظيم الفرائض وتحديد الأهداف من خلال تحديد الوعاء الخاضع للضريبة المالية فعامل الدخل معاملة ضريبية ومالية مختلفة عن رأس المال، وبهذا يكون النظام الإسلامي قد أخذ بما يشبه مفهوم تعدد الضرائب السائد في الوقت الحاضر فالدخل المتأتى من العمل له سعر ضريبي وتصاعد في الشرائح يختلف عن الدخل المتأتي من رأس المال الثابت أو المنقول، وكذلك راعى الإسلام الظروف الاقتصادية والعائلية للمكلف الخاضع للضريبة المالية وهذا ما تعمل به التشريعات الضريبية الحديثة، حيث تعطي بعض الإعفاءات والسماات الاقتصادية والعائلية للمكلف الضريبي .
وإذا كانت التشريعات المالية والضريبية الحديثة قد حددث أهدافاً إقتصادية وإجتماعية فإن النظام المالي الإسلامي قصد من فرض بعض الفرائض المالية كالزكاة، والعشور، والخراج لتشجيع الاستثمار وحث رؤوس الأموال المعطلة، ومحاربة الاكتناز، كما وهدفت إلى تحقيق التضامن والتكافل الإجتماعي .
وفي حقل الإنفاق العام، فكما لاحظنا أن الإسلام جاء بتقسيمات للنفقات العامة تتماشى وأهداف الدولة الإسلامية وما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع. فجانب كبير من النفقات كان ينفق على جهات محددة بالقرآن والسنة النبوية، وبحسب حاجة الدولة وما تمر به من ظروف مالية - اقتصادية، فكانت هنالك النفقات ذات الأغراض العسكرية، والإصلاحية والعامة والإعمارية، أي بحسب مصالح الجماعة. فمثلاً تقسيم بعض النفقات جاء تحت باب في سبيل الله وهي تلك الموجهة للنفع العام والمصلحة العامة تشبه النفقات الإجتماعية حسب التقسيم الحديث .
وإن إحترام ضابط الاقتصاد في النفقات وعدم تبذيرها وإسرافها يؤكد على أهمية وضرورة النفقات وكيفية صرفها بقدر يتناسب وأوجه الحاجة والنشاط في البلد
ثالثاً : خصوصية النظام المالي الإسلامي
لقد انفرد النظام المالي الإسلامي بفرائض مالية تحمل عدة أهداف منها ما هو "دنيوي" مساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية وبناء الدولة الإسلامية (17)، وفيها ما هو (أخروي) يؤديها الفرد ثواباً وإيماناً لتحقيق العبودية لله تعالى. وعند عدم أداء هذه الفرائض المالية فيكون أمام عقوبات (دنيوية) و(أخروية). أي يكون الفرد محاسب في الدنيا والآخرة لقوله تعالى (( فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير )) (18)، ومن لم يؤد الفريضة فيعاقب لقوله تعالى (( وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)) (19) وقوله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) (20) .
جميع هذه الآيات وغيرها تعطي وتعكس إهتمام الإسلام بالمال، لدرجة أن هذا المال قدم على النفس والأولاد ((المال والبنون زينة الحياة الدنيا )) (21) وما هو ضروري في الحياة وذلك في أكثر من ست وسبعين آية قرآنية، وإن الانسان مسؤول عما بين يديه من مال لا يضر به الغير بل أن ينتفع به المجتمع ككل. فالمال في الإسلام ليس غاية بل وسيلة يستعين به الفرد المسلم وعلى المسؤول أن ينفق هذا المال ضمن ضوابط تخدم مجتمعه دون المساس بحدود الله .
كذلك من خصوصية الفراض المالية في الإسلام أنها تستند على "مبدأ الاستخلاف" وأن المال الله تعالى والفرد مستخلف فيه يستخدمه وينتفع به ضمن الحدود التي رسمها الإسلام، فالزكاة من الفرائض المالية وعلى الفرد المسلم أن يدفع ما عليه من مبلغ مالي انطلاقاً من استفادته وتمتعه بهذا المال فهذه الخصوصية أيضاً انفرد بها الإسلام .
كما انفرد الإسلام بخصوصيات أخرى حيث أن أغلب فرائضه الإيرادية والإنفاقية الهية تشتمل على الدقة والعظمة في نصابها وتوزيعها وهذا ما تفتقر إليه التشريعات المالية الوضعية الحديثة .
وأيضاً من خصوصية الفرائض المالية في الإسلام أن فيها ما هو من الفرائض إجباري، وفيها ما هو تعبدي يتعلق بجهد وإيمان الفرد في الأداء سواء ما يتعلق بالزكاة أو بالإنفاق الأهلي .
وكذلك فإن التشريع المالي الإسلامي جاء بخصوصية في تقسيم وتبويب النفقات العامة كما لاحظنا عند تقسيمها إلى نفقات تخص بيت المال حكوميه وإلى نفقات أهلية فجميعها تحقق أهداف اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى الهدف الديني الذي يشمل المجتمع الإسلامي ككل .
كما أخذ التشريع المالي الإسلامي أيضاً بالقرض لمساعدة الآخرين وللتخلص من
الاستغلال والربا والاكتناز لقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً )، فالقرض جائز في الإسلام، على أن لا يكون مشروطاً أو حاملاً لنفع يعود على المقرض، لأن الرسول (ص) قد نهى عن القرض الذي يجر نفعاً، ولأن المال الله تعالى فلا يجوز للمقرض أن يطلب لنفسه الفائدة أو النفع (الربا) مهما كان شكل القرض ونوعه لقوله تعالى ( وآتوهم من مال الله الذي أتاكم ... ) (22)، كما لا يجوز «المستخلف» صاحب المال أن يفرض الشروط في القرض .
إن دقة النظام المالي الإسلامي تتجسد أيضاً في فرض الزكاة على الأموال المكتنزة ليس إلا دليل يؤكد على محاربة الاكتناز ولن يحمل المقرض دفع الزكاة عما أقرضه من المال، بل على المقترض أن يدفع الزكاة مقابل انتفاعه بمبلغ القرض واعتبر أن دفع الزكاة هي لفائدة الفقراء وليس إلى المقرض المكتنز، لأن المال أصلاً لله تعالى، ولا يجوز للمقرض المكتنز الحق في أخذ أية فائدة مقابل مالاً لا يعود أصلاً له، كما أنه لا يستحق المقابل لعدم بذله أي جهد أو عملاً يستحق عليه هذا المقابل .
_____________
1- للتفصيل أكثر في موضوع المال في الإسلام انظر : فضيلة الشيخ محمد مصطفى شلبي : المدخل في تعريف الفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود 1964، الطبعة الثانية، ص 238 - 239
وانظر أيضاً : محمود الدفراوي: الرقابة المالية في الإسلام الإسكندرية 1938 ، ص 35وأنظر أيضاً : د. عبد القادر عودة : المال والحكم في الإسلام، دار الكتاب العربي، ص27
2- د. عبد الكريم الخطيب : السياسة المالية في الإسلام، 1968، بغداد، ص 50
3- سورة المعراج آية 24 - 25 سورة التوبة أية .103 والتفصيل اكثر : د. محمود الدفراوي الرقابة المالية في الإسلام، الإسكندرية 1983، ص 35. وأيضاً : د. يوسف القرصناوي : «فقه الزكاة - الجزء الأول 1977. ص 194 و 428. وانظر أيضاً : : د. أعاد علي حمود : التشريع المالي الإسلامي، مجلة القانون المقارن، العدد 19، 1987، ص 111
4- د. محمد عبدالله العربي : الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر»، مجلة الأزهر، المؤتمر الثالث، 1966، ص 231
5- للتفصيل أكثر في حكم الخراج : كتاب الخراج، لأبي يوسف، 1968، ص 24 و28 .
6- سورة التوبة آية 62
7- إن أول من وضع عشور التجارة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للتفصيل أكثر انظر كتاب الخراج، لأبي يوسف، 1968 ، ص 122
8- انظر في تفصيل هذا النوع من بيت المال د. مصطفى السباعي: «اشتراكية الإسلام»، الدار القومية 1960، ص 81 .
9- للتفصيل أكثر أنظر د. أعاد علي حمود : النظام المالي الإسلامي المصدر السابق، ص 112 .
10- انظر آية رقم (7) من سورة الحشر : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ...)
11- د. ابراهيم الطماوي : الاقتصاد الإسلامي الجزء الأول 1974، ص 380 .
12- سورة البقرة آية (219) و (271) سورة الحديد، آية (7) سورة الطلاق آية (7)
13- ومن أنواع الإنفاق الأهلى : الصدقة الحسنة الكفارة الوصية ... الخ. انظر : د. أعاد علي حمود المالية والتشريع المالي.. ص24
14- سورة المائدة آية (217) سورة الانعام آية (15) سورة الذاريات آية (1) .
15- انظر مؤلفنا : المالية والتشريع المالي الكتاب الأول 1989، ص 25
16- سورة النساء آية (5) .
17- د. ابراهيم الطماوي : الاقتصاد الإسلامي الجزء الأول 1974 ، ص 363 .
18- سورة الحديد، آية (7) .
19- سورة هود آية (19) .
20- سورة التوبة آية (34) .
21- سورة الكهف آية (46) .
22- سورة النور، آية (33).



|
|
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|