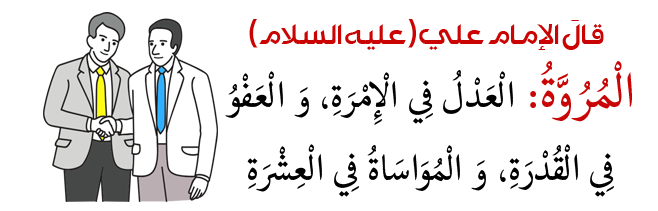
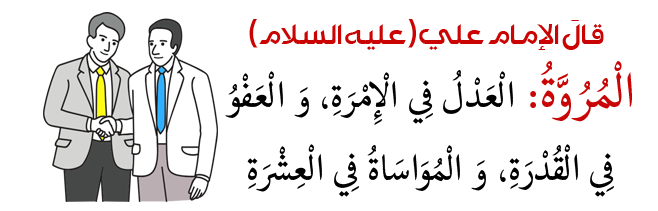

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-07-2015
التاريخ: 20-11-2014
التاريخ: 7-08-2015
التاريخ: 20-11-2014
|
ذهب جماهير أهل العدل إلى أنّه تعالى لا يريد شيئا من القبائح و الفواحش و المعاصي و لم يحبّها و لم يرض بها، بل كرهها، كما لا يفعلها. و ذهبت المجبّرة إلى أنّه تعالى أراد كلّ ما وجد في العالم من الفواحش و المعاصي، و لم يرد ما لم يوجد من الطاعات التي أمر المكلّفين بها. وذهبت الأشعريّة إلى أنّه تبارك و تعالى أحبّ وجود الفساد و رضي بوجود الكفر.
والدّليل على أنّه تعالى لا يريد شيئا من القبائح، أنّ
الإرادة إن كان المرجع بها إلى الداعي...، فلا شكّ في أنّه لا داعي له إلى شيء من
القبائح، و كذا لا داعي له إلى حثّ للعبد و بعثه على القبيح بالعقل أو الشّرع،
فصحّ أنّه لا يريد شيئا من القبائح. و إن كان المرجع بالإرادة إلى أمر زائد على
الداعي: فإن كان تعالى مريدا بإرادة حادثة لا في محلّ- على ما يقوله أصحابنا- لم
يجز أيضا أن يريد القبيح، لأنّه لو اراده لأراده بإرادة حادثة يفعلها، و إرادة
القبيح قبيحة، فيكون فاعلا للقبيح و كان يلزم أيضا أن يكون على صفة نقص، إذ المريد
للقبيح منقوص، ألا ترى أنّ العقلاء، يستحسنون ذمّ من أراد الفواحش و القبائح، كقتل
الأنبياء و الصالحين و انتهاك حرمهم، و يستنقصون من أراد ذلك، و لا يستنقصون من
اشتهى قبيحا و لم يفعله و لم يعزم عليه. و هذا كما يدلّ على أنّه لا يجوز أن يريد
القبيح بإرادة محدثة، يدلّ على أنّه لا يجوز أنّ يريده
لنفسه أو بإرادة قديمة، لأنّ المريد للقبيح يستنقصه العقلاء قبل البحث عمّا به كان
مريدا.
و بعد فلا شكّ في أنّ اللّه تعالى أمر بالطاعات كلّها، و
نهي عن المعاصي كلّها، و الأمر بالشيء حثّ و بعث عليه، و النهي عن الشيء صدّ و
صرف عنه، و الحكيم لا يصدّ الغير و لا يصرفه عمّا يريد منه و لا يحثّه و لا يبعثه
على ما لا يريد منه بل يكرهه.
و بعد لو أراد المعصية من العاصي و كره منه الطاعة، لكان
قد أمره بالطاعة ليتركها و نهاه عن المعصية ليفعلها، و هذا لا يعقل. و القرآن يشهد
بأنّ اللّه تعالى أمر بالطّاعة لتفعل، لا لتترك، و إن كان المأمور غير مطيع، قال
اللّه تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا } [الإسراء: 41] فأخبر أنّه صرّف في القرآن، ليتذكّر من لم يتذكّر، وقال
تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ } [البينة: 1] إلى قوله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة:
5] ، فأخبر تعالى أنّه ما أمر
المشركين الذين لم يخلصوا العبادة إلّا ليخلصوا له العبادة، وقال عزّ و جل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:
56].
و بعد فكان يلزمهم أن يكون الكافر مطيعا للّه تعالى بفعل
الكفر، لأنّه قد صار إلى غرضه ومراده، و من صار إلى غرض غيره، و مراده فقد أطاعه،
فلا يجوز أن يذمّه و يعاقبه، مع أنّه قد صار إلى غرضه. و أيضا لو أراد المعصية
لكان محبّا لها راضيا بها، لأنّ من أراد شيئا من غير أن يكون مكرها محمولا على
إرادته فقد أحبّه، فلا يلزم على هذا أن يكون المريد لشرب الدّواء البشع محبّا له،
لأنّه محمول على إرادته، و من أراد من
غيره ما وقع منه و لم يكن محمولا على إرادته، كان راضيا به، و أجمع المسلمون على
كفر من قال إنّ اللّه يحبّ الكفر والمعاصي و يرضى بها.
فإن قيل: كيف تدّعون الإجماع في ذلك؟ و قد ذكرتم في صدر
المسألة أنّ الأشعريّ يقول: بأنّ اللّه تعالى يحبّ وجود الفساد و يرضى بوجود
الكفر.
قيل: إنّما يقول ذلك مقيدا بتعليق المحبّة و الرضا
بالوجود. و لو قيل له:
أ تقول بأنّ اللّه يحبّ الفساد و يرضى بالكفر من دون تقييد
بالوجود و الحدوث؟
لامتنع منه و لم يتجاسر على القول به، وقد قال تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ } [البقرة: 205] ، {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ } [الزمر:
7] ، {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ } [غافر: 31] ، و {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ}
[آل عمران: 108]. احتجّت
المجبّرة في هذه المسألة بوجوه:
منها: قولهم: لو وقع ما لم يرده اللّه تعالى ولم يقع ما
أراده لدلّ على عجزه و ضعفه تعالى عن ذلك. كالملك في الشاهد، فانّه إذا وقع من
رعيّته ما لا يريده بل يكرهه أو لم يقع ما أراده منهم، دلّ على عجزه و ضعفه.
والجواب عن ذلك أن نقول: أليس الملك إذا لم يوجد ما أمر
به جنده، و ما أحبّه منهم بل وجد ما لم. يأمر به و لم يحبّه و لم يرضه دلّ على
ضعفه و نقصه ثمّ فقد ما أمر اللّه تعالى به وأحبّه ورضيه لا يدلّ على ضعفه وعجزه؟
فكذلك لم لا يجوز أن يدلّ فقد مراد الملك على عجزه وضعفه، وإن لم يدلّ فقد مراد
اللّه تعالى على عجزه وضعفه.
فإن قالوا: فقد ما أمر به الملك إنّما يدلّ على عجزه وضعفه،
لأنّه يكشف عن أنّه يتقوّى بطاعة جنده. وهذا في اللّه تعالى محال.
قلنا:
فقولوا مثله في فقد مراده و فقد مراد اللّه تعالى، لأنّه تبارك و تعالى لا يتقوى
بطاعة عباده له و يقدر على قهرهم و جبرهم على الطاعة لو أراده، و الملك إذا لم يقع
مراده من جنده في دفع عدوّه عنه دلّ على أنّه لا يقدر على قهرهم و جبرهم على
الطاعة، فكذلك دلّ فقد مراده على ضعفه.
فإن قالوا: فقد ما أمر الملك به إنّما دلّ على ضعفه
لأنّه تضمّن فقد مراده من حيث أنّه لا يأمر إلّا بما يريد، فهناك أيضا فقد المراد
هو الدال على الضعف و العجز، دون فقد المأمور به.
قلنا: على ما قرّرتم فقد ما أمرهم به و ما أراده منهم،
فلم قلتم: إنّها لحق الملك الضعف بفقد الطاعة، لأنّه لم يوجد مراده دون أن يكون
الضعف إنّما لحقه، لأنّه لم يوجد ما أمر به. وبعد، فانّ من مذهبهم أنّ الإنسان قد
يأمر بما لا يريده لغرض من الأغراض، فمن أين إنّ الملك لا يأمر إلّا بما يريده؟
ثم يقال لهم: من اراد شيئا إمّا أن يريد أن يفعله هو و
إمّا أن يريد من غيره الفعل. فإن أراد أن يفعله هو فانّما أراده لأنّه الداعي قد
دعاه إليه. وإذا دعاه الداعي إلى الفعل و أراده فلم يقع، دلّ على انّه لا يتمكّن
من الفعل، إمّا لفقد قدرته أو علمه أو غير ذلك، و يكون ذلك نقصا في حقّه. وإن أراد
من غيره الفعل، فأمّا أن يريده منه على أن يفعله باختياره من دون أن يقهره عليه
وإمّا أن يريده قهرا وجبرا فإن أراده على الوجه الأوّل لم يدلّ فقده على عجزه و
ضعفه. و إن أراد على الوجه الثاني، فإذا لم يقع انكشف أنّه ما قدر على أنّ يفعل ما
به يصير الغير مقهورا على الفعل فيدلّ على عجزه و نقصه، و الدالّ على نقصه هو فقد
مراده عن نفسه الذي هو ما يصير الغير به مقهورا.
و الذي يبيّن ذلك أنّ سلطان الإسلام يريد من اليهوديّ
الضعيف المنّة الاختلاف إلى المساجد وترك
الاختلاف إلى البيع و الكنائس، ثمّ لا يقع منه ما أراده السلطان، بل يقع خلافه، و
لم يدلّ على عجز السلطان من حيث لم يرد السلطان قهره على ذلك بل أراد أن يفعله
باختياره. كذلك القول في مسألتنا، فانّ اللّه تعالى ما أراد الطاعة من العباد قهرا
و جبرا، و إنّما أراد أن يطيعوه و يفعلوا الخير باختياره، ليستحقّوا عليها ثوابا،
فإذا لم يقع لم يلحقه تعالى عجز و نقص.
يبيّن ما ذكرناه- من الفرق بين إرادة الشيء من الغير
على سبيل الإكراه، و بين إرادته منه على سبيل الاختيار في الدلالة على العجز و
الضعف-: أنّ الملك لو أراد ان ينهزم عدوّه الذي يحاربه، فلم يوجد ذلك لدلّ على
عجزه، لأنّه يريد إكراهه على الهزيمة فإذا لم يقع انكشف أنّه لم يقدر على إكراهه
على الهزيمة فاتضح بما ذكرناه الفرق بين الإرادتين.
و منها أن قالوا: قد علم اللّه تعالى من حال الكافر أنّه
لا يؤمن، و من العاصي أنّه لا يطيع، و الحكيم لا يريد ما يعلم أنّه لا يكون.
و الجواب عن ذلك أن نقول: هذا أصل غير مسلّم لم قلتم:
إنّ الحكيم لا يريد ما يعلم أنّه لا يكون؟ أليس لو اخبر نبي صادق أحدنا بأنّ زيدا
يشتمه و يذمه و يسيء القول فيه، و لا يمدحه و لا يقول فيه الجميل؟ فانّه لا يريد
أن يشتمه زيد و لا أن يسيء القول فيه؟ و يريد أن يمدحه و يقول فيه الجميل و لم
يكن ذلك منه سفها و خلاف الحكمة؟ و كذلك فانّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله قد أراد
الإيمان من جميع الكفّار مع إعلام اللّه تعالى له بانّ قوما منهم لا يؤمنون و لم
يكن ذلك مخالفة الحكمة.
و منها: تمسّكهم بالسمع من قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99] وقوله تعالى : {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149].
قالوا: فدلّ ذلك على أنّه تعالى لا يشاء الإيمان من جميع العباد. و ذلك
بخلاف مذهبكم.
و الجواب عن ذلك: أنّ المراد بالمشيّة في الآيتين مشيّة
الإكراه و الإلجاء.
و على ذلك أوّلها المفسّرون. قال الكلبيّ في تفسير هذه
المشيّة: إنّها مشيّة حتم.
يبيّن ما ذكرناه ما ذكره تبارك و تعالى، في قوله: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا
آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} [الأنعام: 148]. حكى مذهب المجبّرة في المشيّة و كذّبهم فيه بقوله
تعالى «وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
تَخْرُصُونَ» و الخرص هو الكذب، فدلّ ذلك على
أنّه تعالى ما شاء منهم الشرك. وإذا قال ذلك و بيّنه في هذه الآية و قال في
الآيتين الأخيرتين أنّه لا يشاء إيمانهم وجب التلفيق بين الآيات، فدفع التّناقض
بينهما. ولا يتمّ ذلك إلّا بحمل المشيّة في الآيتين المذكورتين على مشيّة الإكراه.
فإن قالوا: إنّما كذّبهم، لأنّهم قالوا ما قالوه على
طريق الاستهزاء.
قلنا: ليس في الآية ما يدل على أنّ هذا القول صدر عنهم
على طريق الاستهزاء، ثمّ و من يقول حقّا على طريق الاستهزاء، فانّه لا يكذب في ذلك
القول، بل يذمّ على انّه قال ذلك على طريق الهزء.
و منها قولهم: لو أراد تعالى من الكافر الإيمان، و من
العاصي الطاعة- و معلوم أنّ إبليس أراد كفر الكافر و معصية العاصي- لكان يصحّ
القول و يحسن بأنّه ما كان ما شاء اللّه و كان ما شاء إبليس، و على العكس، بأن
يقال: ما شاء إبليس كان، و ما شاء اللّه لم
يكن، وهذا بخلاف ما أجمع عليه المسلمون من قولهم «ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم
يكن».
و الجواب عن ذلك أن نقول: أ ليس بالاتفاق ما كان ما أمر
اللّه تعالى به الكافر و العاصي من الإيمان و الطاعة و كان ما أمرهما به إبليس
بطريق الوسواس أفيصح أن يقال: ما أمر به إبليس كان وما أمر اللّه به لم يكن؟ و
كذلك أو ليس اللّه تعالى ما أحبّ الكفر و المعصية و ما رضي بهما، و إبليس أحبهما و
رضي بهما، و لا يقال: كان ما أحبّه إبليس ورضيه و لم يكن ما أحبه اللّه تعالى و
رضيه، و إنّما لا يقال ذلك في هذه الصور لأنّ ذلك يقتضي المغالبة و القهر و أنّه
تعالى قد قهر و غلب.
فأمّا إذا ازيل الإبهام في جميع ذلك بأن يقال ما أراده
تبارك و تعالى و أحبّه و أمر به و رضيه لو وقع من العبد على طريق الاختيار لا على
طريق الإكراه ما حصل من العبد بسوء اختياره لنفسه، و ما أراده إبليس ممّا وافقت
إرادته إرادة العبد من المعاصي التي يشتهيها، وقع لشهوته لها لصحّ ذلك القول و حسن
من حيث لم يكن فيه إيهام المغالبة، على أنّ التشنيع الذي ألزموناه منقلب عليهم بأن
يقال لهم: على قولكم وافقت إرادة إبليس إرادة اللّه تعالى، لأنّه أراد من الكافر
الكفر ومن العاصي المعصية واللّه تعالى أرادهما على مذهبكم، و إرادة النبيّ خالفت
إرادة اللّه تعالى، لأنّه عليه السلام لم يرد من الكافر والعاصي الكفر و المعصية.
فأمّا قول المسلمين: «ما شاء اللّه كان وما لم يشاء لم
يكن» لو سلّمنا حصول الإجماع فيه، لكان المراد به: «ما شاء اللّه من فعل نفسه او
من فعل غيره على سبيل الإكراه كان، و ما لم يشاء من مقدور نفسه أو من غيره على
سبيل الإكراه لم يقع. و ذلك لأنّ غرض من يطلق هذا القول مدحه تعالى و الثناء عليه،
و إنّما يحصل هذا الغرض بأن يقول معناه ما ذكرناه، لدلالته على أنّه تعالى ممّن لا
يغلب و لا يقهر، و إلّا فأي مدحة في أن ما يكون ما شاءه من سوء الثناء عليه، وسبّ
أنبيائه و أوليائه و قتلهم على قول الخصم هذا بأن يكون نقصا و ذمّا أولى من أن
يكون مدحا.
ثمّ يقال لهم: كما أنّ هذا القول مشهور فيما بين الامّة،
فكذلك قولهم، لا مردّ لأمر اللّه مشهور. ومع ذلك فمعلوم أنّ الكافر و العاصي قد رد
أمر اللّه تعالى، و لا يقال ذلك إلّا على وجه يزيل الإبهام، أو بأن يحمل أمره على
غير التكليف.
و يقال لهم أيضا: أليس قد اشتهر فيما بين المسلمين
قولهم: «نستغفر اللّه من جميع ما كره اللّه»، وهذا يقتضي أنّ اللّه تعالى قد كره
المعاصي، لأنّه لو كان المراد به غير المعاصي، لما حسن الاستغفار عنه.
ومنها أن قالوا: أراد اللّه تعالى جميع الطاعات، لكان قد
أراد قضاء الدين ممّن عليه دين تمكّن من أدائه فكان يجب إذا قال لغزيمه «و اللّه
لأقضينّ دينك غدا إن شاء اللّه»، ثمّ جاء الغد ولم يقض أن يحنث، لأنّ الشرط الذي
اعتبره حاصل متحقق على قولكم و هو مشيّة اللّه تعالى بقضاء دينه، و معلوم بالإجماع
أنّه لا يحنث.
و الجواب عن ذلك أن نقول: هذا الإجماع أولا يمكن أن
ينازع فيه، فقد روى ابن أبي حبّة في كتاب من قال بالعدل عن محمد بن شجاع، قال:
حدّثني قاسم العبقري عن إسماعيل بن عيّاش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ بن
جبل، عن النبيّ عليه السلام أنّه قال: «إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء
اللّه فليست بطالق. و إذا قال لعبده: أنت حرّان شاء اللّه. فهو حرّ» و هذا الخبر
يقتضي الفصل بين الطاعة و المعصية في مشيّة اللّه تعالى، و يقتضي أن يكون اللّه
تعالى قد شاء قضاء الدين و أن يحنث هذا الحالف الذي قدّره السائل.
ثمّ و يمكن أن يقال بعد ترك المنازعة في الإجماع إنّ
قوله: «ان شاء اللّه» يقتضي مشيّة مستقبلة، وعندنا أنّ اللّه تعالى قد شاء جميع
الطاعات عند أمره بها وليس يتجدّد
منه تعالى مشيّة لها في كلّ حالة.
فعلى هذا، الشرط الذي اعتبره لم يوجد، وهو تجدّد مشيّة
قضاء الدين بعد حلفه. ولو قال: «واللّه لأقضينّ دينك غدا إن كان اللّه قد شاء ذلك
منّي»، فانّه لا نصّ في ذلك عن الأمّة، حتّى يدّعى فيه الإجماع.
على انّ قوله: «إن شاء اللّه» يقتضي إيقاف الكلام عن
النفوذ و ليس هو شرطا، من حيث انّ المخالف لا يقصد به الاشتراط و إنّما يقصد به
انّه غير قاطع فيما قال.
يبيّن ذلك أنّ هذه المشيّة يصحّ دخولها في الماضي، فيقول
القائل لغيره:
«قد فعلت ما أمرتك به أمس إن شاء اللّه». ومعلوم أنّ
الشّرط لا يدخل في الماضي.
ولهذا قال الشافعيّ: من قال: انّي صائم غدا إن شاء
اللّه، لا يكون بهذا القول ولا بإضمار معناه ناويا، ولا يصحّ صومه، لأنّ قوله: «إن
شاء اللّه» يقتضي الإيقاف، ونفي العزم والقطع والثبات.



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|