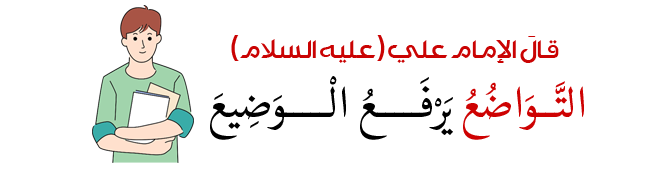
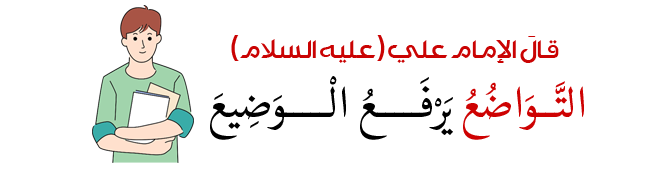

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-5-2020
التاريخ: 29-5-2020
التاريخ: 31-5-2020
التاريخ: 31-5-2020
|
قال تعالى : {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة : 15 - 22]
تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآيات (1)
أخبر سبحانه عن حال المؤمنين فقال {إنما يؤمن ب آياتنا} أي يصدق بالقرآن وسائر حججنا {الذين إذا ذكروا بها} تذكروا واتعظوا بمواعظها بأن {خروا سجدا} أي ساجدين شكرا لله سبحانه على أن هداهم بمعرفته وأنعم عليهم بفنون نعمته {وسبحوا بحمد ربهم} أي نزهوه عما لا يليق به من الصفات وعظموه وحمدوه {وهم لا يستكبرون} عن عبادته ولا يستنكفون من طاعته ولا يأنفون أن يعفروا وجوههم صاغرين له .
ثم وصف سبحانه المؤمنين المذكورين في الآية المتقدمة فقال {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} أي ترتفع جنوبهم عن مواضع اضطجاعهم لصلاة الليل وهم المتهجدون بالليل الذين يقومون عن فرشهم للصلاة عن الحسن ومجاهد وعطا وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) وروى الواحدي بالإسناد عن معاذ بن جبل قال بينما نحن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في غزوة تبوك وقد أصابنا الحر فتفرق القوم فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أقربهم مني فدنوت منه فقلت يا رسول الله أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان قال وإن شئت أنبأتك بأبواب الخير قال قلت أجل يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله ثم قرأ هذه الآية {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} .
وبالإسناد عن بلال قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة الداء عن الجسد وقيل هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة قال أنس نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا ترجع إلى رحلنا حتى نصلي العشاء الآخرة مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وقيل هم الذين يصلون ما بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الأوابين عن قتادة وقيل هم الذين يصلون العشاء والفجر في جماعة .
{يدعون ربهم خوفا} من عذاب الله {وطمعا} في رحمة الله {ومما رزقناهم ينفقون} في طاعة الله وسبيل ثوابه ووجه المدح في هذه الآية أن هؤلاء المؤمنين يقطعهم اشتغالهم بالصلاة والدعاء عن طيب المضجع لانقطاعهم إلى الله تعالى فأمالهم مصروفة إليه واتكالهم في كل الأمور عليه .
ثم ذكر سبحانه جزاءهم فقال {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} أي لا يعلم أحد ما خبىء لهؤلاء الذين ذكروا مما تقربه أعينهم قال ابن عباس هذا ما لا تفسير له فالأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسيره وقد ورد في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال أن الله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله(2) ما أطلعتكم عليه اقرءوا إن شئتم {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} رواه البخاري ومسلم جميعا .
وقد قيل في فائدة الإخفاء وجوه ( أحدها ) أن الشيء إذا عظم خطره وجل قدره لا تستدرك صفاته على كنهه إلا بشرح طويل ومع ذلك فيكون إبهامه أبلغ ( وثانيها ) أن قرة العيون غير متناهية فلا يمكن إحاطة العلم بتفاصيلها ( وثالثها ) أنه جعل ذلك في مقابلة صلاة الليل وهي خفية فكذلك ما بإزائها من جزائها ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال ما من حسنة إلا ولها ثواب مبين في القرآن إلا صلاة الليل فإن الله عز اسمه لم يبين ثوابها لعظم خطرها قال {فلا تعلم نفس} الآية وقرة العين رؤية ما تقر به العين يقال أقر الله عينك أي صادف فؤادك ما يرضيك فتقر عينك حتى لا تطمح بالنظر إلى ما فوقه وقيل هي من القر أي البرد لأن المستبشر الضاحك يخرج من شؤون عينيه دمع بارد والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حار ومنه قولهم سخنت عينه وهو قرير العين وسخين العين وإنما أضاف القرة إلى الأعين على الإطلاق لا إلى أعينهم تنبيها على أنها غاية في الحسن والكمال فتقر بها كل عين .
{جزاء بما كانوا يعملون} من الطاعات في دار الدنيا {أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا} هذا استفهام يراد به التقرير أي أ يكون من هو مصدق بالله على الحقيقة عارفا بالله وبأنبيائه عاملا بما أوجبه الله عليه وندبه إليه مثل من هو فاسق خارج عن طاعة الله مرتكب لمعاصي الله ثم قال {لا يستوون} لأن منزلة المؤمن درجات الجنان ومنزلة الفاسق دركات النيران .
ثم فسر ذلك بقوله {أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى} يأوون إليها {نزلا بما كانوا يعملون} أي عطاء بما كانوا يعملون عن الحسن وقيل ينزلهم الله فيها نزلا كما ينزل الضيف يعني أنهم في حكم الأضياف {وأما الذين فسقوا فمأويهم} الذي يأوون إليه {النار} نعوذ بالله منها {كلما أرادوا أن يخرجوا منها} أي كلما هموا بالخروج منها لما يلحقهم من ألم العذاب {أعيدوا} أي ردوا {فيها} وقد مر بيانه في سورة الحج .
{وقيل لهم} مع ذلك {ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون} أي لا تصدقون به وتجحدونه وفي هذا دلالة على أن المراد بالفاسق هنا الكافر المكذب قال ابن أبي ليلى نزل قوله {أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا} الآيات في علي بن أبي طالب (عليه السلام) ورجل من قريش وقال غيره نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) والوليد بن عقبة فالمؤمن علي والفاسق الوليد وذلك أنه قال لعلي (عليه السلام) أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا فقال علي (عليه السلام) ليس كما تقول يا فاسق قال قتادة لا والله ما استووا لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخرة .
ثم أقسم سبحانه في هذه الآية فقال {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} أما العذاب الأكبر فهو عذاب جهنم في الآخرة وأما العذاب الأدنى في الدنيا واختلف فيه فقيل إنه المصائب والمحن في الأنفس والأموال عن أبي بن كعب وابن عباس وأبي العالية والحسن وقيل هو القتل يوم بدر بالسيف عن ابن مسعود وقتادة والسدي وقيل هوما ابتلوا به من الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والكلاب عن مقاتل وقيل هو الحدود عن عكرمة وابن عباس وقيل هو عذاب القبر عن مجاهد وروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) والأكثر في الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أن العذاب الأدنى الدابة والدجال .
{لعلهم يرجعون} أي ليرجعوا إلى الحق ويتوبوا من الكفر وقيل ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم {ومن أظلم ممن ذكر ب آيات ربه} أي لا أحد أظلم لنفسه ممن نبه على حجج الله التي توصله إلى معرفته ومعرفة ثوابه {ثم أعرض عنها} جانبا ولم ينظر فيها {إنا من المجرمين} الذين يعصون الله تعالى بقطع طاعاته وتركها {منتقمون} بأن نحل العقاب بهم .
______________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج8 ، ص105-111 .
2- قال ابن الاثير ، في حديث نعيم الجنة : ((ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه : بله من اسماء الافعال بمعنى : دع واترك ، والمعنى : دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة ، وعرفتموه من لذاتها . وثقل في اللسان عن ابن الاحمر انه قال : بله بمعنى كيف ، ومعناه : كيف ما اطلعتم عليه .
تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنية في تفسير هذه الآيات (1)
{إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} .
المراد بالمؤمنين هنا الذين يعرفون الحق ، ويعملون به ، ويضحون من أجله ، ويعبدون اللَّه في ليلهم ونهارهم ثقة به وإخلاصا له وحده لا شريك له ، أما التسبيح والركوع والسجود بدافع الكسب والتجارة بالدين فهو نفاق لا عبادة ، وزندقة لا ايمان {وهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} أي ان المؤمنين يرحبون بالحق ، ويتخلون من أجله عن مصالحهم الشخصية لأنه هو دينهم ومصلحتهم . ويجب أن يسجد للَّه من قرأ هذه الآية أو استمع إليها ، وقيل : من سمعها أيضا من غير قصد .
{تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وطَمَعاً} . المضاجع كناية عن النوم . وإذا عطفنا هذه الآية على قوله تعالى : رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وإِقامِ الصَّلاةِ - 37 النور وجمعنا الآيتين في كلام واحد يكون المعنى ان المؤمنين لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا نوم عن عبادة اللَّه التي تعكس خوفهم من عذابه ، وطمعهم بثوابه . وهذه العبادة هي التي عناها اللَّه بقوله :
{إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ والْمُنْكَرِ} وفي الحديث : (ان قيام العبد قربة إلى اللَّه ، ومنهاة عن الإثم ، وتكفير للسيئات ، ومطردة للداء عن الجسد) . أما صلاة التجار المراءين ، فإنها تأمر بالفحشاء والمنكر لأن السيئة تقود إلى مثلها ، وكذلك الحسنة {ومِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ} عبدوا اللَّه بالقلوب والأجسام والأموال .
{فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ} . المراد بالنفس أية نفس كانت وتكون في الأرض أوفي السماء ، والمعنى لا أحد يعلم حقيقة ما أعد اللَّه للمؤمنين العاملين من الأجر والثواب الذي يغتبطون به ويفرحون .
وفي الحديث الصحيح : (يقول اللَّه تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بله ما أطلعتكم عليه ، اقرأوا ان شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) .
{أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ} . جاء في كثير من التفاسير ، منها جامع البيان للطبري ، والبحر المحيط للأندلسي ، وروح البيان لحقي : ان هذه الآية نزلت بالمدينة في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط ، ونختار النص الذي جاء في تفسير الطبري : (كان بين الوليد وبين علي كلام ، فقال الوليد : أنا أبسط منك لسانا ، وأحدّ منك سنانا ، وأرد منك لكتيبة .
فقال علي : اسكت فإنك فاسق . فأنزل اللَّه فيهما {أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ} . . لا واللَّه ، ما استووا في الدنيا ، ولا عند الموت ، ولا في الآخرة) .
{أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلًا بِما كانُوا يَعْمَلُونَ} .
هذا بيان للفرق بين المؤمنين الأتقياء والمجرمين الأشقياء ، وانه تماما كالفرق بين الطيب والخبيث ، والخير والشر ، والجنة التي أعدها اللَّه للمتقين ، والنار التي أعدها للمجرمين {وأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} للمؤمنين جنات النعيم ، وللفاسقين نار الجحيم ، وتقدم مثله في الآية 22 من سورة الحج ج 5 ص 320 .
{ولَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} . المراد بالعذاب الأدنى عذاب الدنيا كالقحط والوباء وما إليهما ، ينذر اللَّه به وبالحجج البالغة الغافلين والمتشاغلين بالباطل عن الحق ليتعظوا ويرتدعوا ، وإلا أخذهم بالعذاب الأكبر : {جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ ولَعَنَهُمُ اللَّهُ ولَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ} - 68 التوبة .
وتجدر الإشارة إلى أن القادة والولاة هم المصدر الأول للفساد والشقاء ، وفي بعض الروايات : إذا كذب الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة .
{ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} .
من رأى العظة ولم يتعظ فهو أعظم جرما من كل مجرم ، وقد وعظهم اللَّه سبحانه بلسان أنبيائه ، ثم بالبأساء والضراء ، فقست قلوبهم وتمادوا في الظلم والفساد ، فانتقم اللَّه منهم ، واللَّه عزيز ذو انتقام .
______________
1- التفسير الكاشف ، جلد محمد جواد مغنية ، ج6 ، ص ١٨٢-184 .
تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآيات (1)
الآيات تفرق بين المؤمنين بحقيقة معنى الإيمان وبين الفاسقين والظالمين وتذكر لكل ما يلزمه من الآثار والتبعات ثم تنذر الظالمين بعذاب الدنيا وتأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بانتظار الفتح وعند ذلك تختم السورة .
قوله تعالى : {إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون} لما ذكر شطرا من الكلام في الكفار الذين يجحدون لقاءه ويستكبرون في الدنيا عن الإيمان والعمل الصالح أخذ في صفة الذين يؤمنون بآيات ربهم ويخضعون للحق لما ذكروا ووعظوا .
فقوله : {إنما يؤمن بآياتنا} حصر للإيمان بحقيقة معناه فيهم ومعناه أن علامة التهيؤ للإيمان الحقيقي هو كذا وكذا .
وقوله : {الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا} ذكر سبحانه شيئا من أوصافهم وشيئا من أعمالهم ، أما ما هومن أوصافهم فتذللهم لمقام الربوبية وعدم استكبارهم عن الخضوع لله وتسبيحه وحمده وهو قوله : {إذا ذكروا بها} أي الدالة على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وما يلزمها من المعاد والدعوة النبوية إلى الإيمان والعمل الصالح {خروا سجدا} أي سقطوا على الأرض ساجدين لله تذللا واستكانة {وسبحوا بحمد ربهم} أي نزهوه مقارنا للثناء الجميل عليه .
والسجدة والتسبيح والتحميد وإن كانت من الأفعال لكنها مظاهر لصفة التذلل والخضوع لمقام الربوبية والألوهية ، ولذا أردفها بصفة تلازمها فقال : {وهم لا يستكبرون} .
قوله تعالى : {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون} هذا معرفهم من حيث أعمالهم كما أن ما في الآية السابقة كان معرفهم من حيث أوصافهم .
فقوله : {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} التجافي التنحي والجنوب جمع جنب وهو الشق ، والمضاجع جمع مضجع وهو الفراش وموضع النوم ، والتجافي عن المضاجع كناية عن ترك النوم .
وقوله : {يدعون ربهم خوفا وطمعا} حال من ضمير جنوبهم والمراد اشتغالهم بدعاء ربهم في جوف الليل حين تنام العيون وتسكن الأنفاس لا خوفا من سخطه تعالى فقط حتى يغشيهم اليأس من رحمة الله ولا طمعا في ثوابه فقط حتى يأمنوا غضبه ومكره بل يدعونه خوفا وطمعا فيؤثرون في دعائهم أدب العبودية على ما يبعثهم إليه الهدى وهذا التجافي والدعاء ينطبق على النوافل الليلية .
وقوله : {ومما رزقناهم ينفقون} عمل آخر لهم وهو الإنفاق لله وفي سبيله .
قوله تعالى : {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} تفريع لما لهم من الأوصاف والأعمال يصف ما أعد الله لهم من الثواب .
ووقوع نفس وهي نكرة في سياق النفي يفيد العموم ، وإضافة قرة إلى أعين لا أعينهم تفيد أن فيما أخفي لهم قرة عين كل ذي عين .
والمعنى : فلا تعلم نفس من النفوس - أي هو فوق علمهم وتصورهم - ما أخفاه الله لهم مما تقر به عين كل ذي عين جزاء في قبال ما كانوا يعملون في الدنيا .
قوله تعالى : {أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون} الإيمان سكون علمي خاص من النفس بالشيء ولازمه الالتزام العملي بما آمن به والفسق هو الخروج عن الالتزام المذكور من فسقت التمرة إذا خرجت عن قشرها ومآل معناه الخروج عن زي العبودية .
والاستفهام في الآية للإنكار ، وقوله : {لا يستون} نفي لاستواء الفريقين تأكيدا لما يفيده الإنكار السابق .
قوله تعالى : {أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون} المأوى المكان الذي يأوي إليه ويسكن فيه الإنسان ، والنزل بضمتين كل ما يعد للنازل في بيت من الطعام والشراب ، ثم عمم كما قيل لكل عطية ، والباقي ظاهر .
قوله تعالى : {وأما الذين فسقوا فمأواهم النار} إلى آخر الآية ، كون النار مأواهم لازمه خلودهم فيها ولذلك عقبه بقوله : {كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها{ ، وقوله : {وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون} دليل على أن المراد بالذين فسقوا هم منكرو المعاد وخطابهم وهم في النار بهذا الخطاب شماتة بهم وكثيرا ما كانوا يشمتون في الدنيا بالمؤمنين لقولهم بالمعاد .
قوله تعالى : {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون} لما كان غاية إذاقتهم العذاب رجوعهم المرجو والرجوع المرجو هو الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة كان المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا النازل بهم للتخويف والإنذار ليتوبوا دون عذاب الاستئصال ودون العذاب الذي بعد الموت وحينئذ المراد بالعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة .
والمعنى : أقسم لنذيقنهم من العذاب الأدنى أي الأقرب مثل السنين والأمراض والقتل ونحو ذلك قبل العذاب الأكبر يوم القيامة لعلهم يرجعون إلينا بالتوبة من شركهم وجحودهم .
قيل : سمي عذاب الدنيا أدنى ولم يقل : الأصغر ، حتى يقابل الأكبر لأن المقام مقام الإنذار والتخويف ولا يناسبه عد العذاب أصغر ، وكذا لم يقل دون العذاب الأبعد حتى يقابل العذاب الأدنى لعدم ملاءمته مقام التخويف .
قوله تعالى : {ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون} كأنه في مقام التعليل لما تقدم من عذابهم بالعذاب الأكبر بما أنهم مكذبون فعلله بأنهم ظالمون أشد الظلم بالإعراض عن الآيات بعد التذكرة فيكونون مجرمين والله منتقم منهم .
فقوله : {ومن أظلم} إلخ تعليل لعذابهم بأنهم ظالمون أشد الظلم ثم قوله : {إنا من المجرمين منتقمون} ، تعليل لعذاب الظالمين بأنهم مجرمون والعذاب انتقام منهم ، والله منتقم من المجرمين .
_____________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج16 ، ص212-214 .
تفسير الامثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآيات (1)
جوائز عظيمة لم يطّلع عليها أحد !
إنّ طريقة القرآن هي أنّه يبيّن كثيراً من الحقائق من خلال مقارنتها مع بعضها ، لتكون مفهومة ومستقرّة في القلب تماماً ، وهنا أيضاً بعد الشرح والتفصيل الذي مرّ في الآيات السابقة حول المجرمين والكافرين ، فإنّه يتطرّق إلى صفات المؤمنين الحقيقيين البارزة ، ويبيّن اُصولهم العقائدية ، وبرامجهم العملية بصورة مضغوطة ضمن آيتين بذكر ثمان صفات(2) ، فيقول أوّلا : {إنّما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجّداً وسبحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون} .
التعبير بـ (إنّما) الذي يستعمل عادةً لإفادة معنى الحصر ، يبيّن أنّ كلّ من يتحدّث عن الإيمان ويتمشدق به ، ولا يمتلك الخصائص والصفات التي وردت في هذه الآيات ، فإنّه لا يكون في صفّ المؤمنين الواقعيين ، بل هو شخص ضعيف الإيمان .
لقد بيّنت في هذه الآية أربع صفات :
1 ـ أنّهم يسجدون بمجرّد سماعهم آيات الله ، والتعبير بـ (خرّوا) بدل (سجدوا) إشارة إلى نكتة لطيفة ، وهي أنّ هؤلاء المؤمنين ينجذبون إلى كلام الله لدى سماعهم آيات القرآن ويهيمون فيها بحيث يسجدون لا إرادياً (3) .
نعم . . إنّ أوّل خصائص هؤلاء هوالعشق الملتهب ، والعلاقة الحميمة بكلام محبوبهم ومعشوقهم .
لقد ذكرت هذه الصفة والخاصية في بعض آيات القرآن الاُخرى كأحد أبرز صفات الأنبياء ، كما يقول الله سبحانه في شأن جمع من الأنبياء العظام : {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم : 58] .
وبالرغم من أنّ الآيات هنا ذكرت بصورة مطلقة ، ولكن من المعلوم أنّ المراد منها غالباً الآيات التي تدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك .
2 ـ 3 ـ علامتهم الثّانية والثالثة تسبيح الله وحمده ، فهم ينزّهون الله تعالى عن النقائص من جهة ، ومن جهة اُخرى فإنّهم يحمدونه ويثنون عليه لصفات كمالهُ وجماله .
4 ـ والصفة الاُخرى لهؤلاء هي التواضع وترك كلّ أنواع التكبّر ، لأنّ الكبر والغرور أوّل درجات الكفر والجحود ، والتواضع أمام الحقّ والحقيقة أُولى خطوات الإيمان !
إنّ الذين يسيرون في طريق الكبر والعُجب لا يسجدون لله ، ولا يسبّحونه ولا يحمدونه ، ولا يعترفون بحقوق عباده ! إنّ لهؤلاء صنماً عظيماً ، وهو أنفسهم!
ثمّ أشارت الآية الثّانية إلى أوصاف هؤلاء الاُخرى ، فقالت : {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} (4) فيقومون في الليل ، ويتّجهون إلى ربّهم ومحبوبهم ويشرعون بمناجاته وعبادته .
نعم . . إنّ هؤلاء يستيقظون ويحيون قدراً من الليل في حين أنّ عيون الغافلين تغطّ في نوم عميق ، وحينما تتعطّل برامج الحياة العادية ، وتقلّ المشاغل الفكرية إلى أدنى مستوى ، ويعمّ الهدوء والظلام كلّ الأرجاء ، ويقلّ خطر التلوّث بالرياء في العبادة ، والخلاصة : عند توفّر أفضل الظروف لحضور القلب ، فإنّهم يتّجهون بكلّ وجودهم إلى معبودهم ، ويطأطئون رؤوسهم عند أعتاب معشوقهم ، ويخبرونه بما في قلوبهم ، فهم أحياء بذكره ، وكؤوس قلوبهم طافحة بحبّه وعشقه .
ثمّ تضيف : {يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً} . وهنا تذكر الآية صفتين اُخريين لهؤلاء هما : «الخوف» و«الرجاء» ، فلا يأمنون غضب الله عزّوجلّ ، ولا ييأسون من رحمته ، والتوازن بين الخوف والرجاء هو ضمان تكاملهم وتوغّلهم في الطريق إلى الله سبحانه ، والحاكم على وجودهم دائماً ، لأنّ غلبة الخوف تجرّ الإنسان إلى اليأس والقنوط ، وغلبة الرجاء تغري الإنسان وتجعله في غفلة ، وكلاهما عدو للإنسان في سيره التكاملي إلى الله سبحانه .
وثامن صفاتهم ، وآخرها في الآية أنّهم {وممّا رزقناهم ينفقون} .
فهم لا يهبون من أموالهم للمحتاجين وحسب ، بل ومن علمهم وقوّتهم وقدرتهم ورأيهم الصائب وتجاربهم ورصيدهم الفكري ، فيهبون منها ما يحتاج إليه الغير .
إنّهم ينبوع من الخير والبركة ، وعين فوّارة من ماء الصالحات العذب الصافي الذي يروي العطاشى ، ويغني المحتاجين بحسب إستطاعتهم .
نعم . . إنّ أوصاف هؤلاء مجموعة من العقيدة الرصينة الثابتة ، والإيمان القويّ والعشق الملتهب لله ، والعبادة والطاعة ، والسعي والحركة الدؤوبة ، ومعونة عباد الله في كلّ المجالات .
ثمّ تطرّقت الآية التالية إلى الثواب العظيم للمؤمنين الحقيقيين الذين يتمتّعون بالصفات المذكورة في الآيتين السابقتين ، فتقول بتعبير جميل يحكي الأهميّة الفائقة لثوابهم : {فلا تعلم نفس ما اُخفي لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون} .
التعبير بـ (فلا تعلم نفس) وكذلك التعبير بـ (قرّة أعين) مبيّن لعظمة هذه المواهب والعطايا التي لا عدّ لها ولا حصر ، خاصّة وأنّ كلمة (نفس) قد وردت بصيغة النكرة في سياق النفي ، وهي تعني العموم وتشمل كلّ النفوس حتّى ملائكة الله المقرّبين وأولياء الله .
والتعبير بـ (قرّة أعين) من دون الإضافة إلى النفس ، إشارة إلى أنّ هذه النعم الإلهيّة التي خصّصت كثواب وجزاء للمؤمنين المخلصين في الآخرة ، في هيئة تكون معها قرّة لعيون الجميع .
(قرّة) مادّة القَرّ ، أي البرودة ، ومن المعروف أنّ دموع الشوق باردة دائماً ، وأنّ دمع الغمّ والحسرة حارّ محرق ، فالتعبير بـ (قرّة أعين) يعني في لغة العرب الشيء الذي يسبّب برودة عين الإنسان ، أي أنّ دموع الشوق والفرح تجري من أعينهم ، وهذه كناية لطيفة عن منتهى الفرح والسرور والسعادة .
وفي حديث عن النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) : «إنّ الله يقول : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا اُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر» (5) .
وثمّة سؤال طرحه المفسّر الكبير العلاّمة «الطبرسي» في (مجمع البيان) وهو : لماذا اُخفي هذا الثواب والجزاء ؟
ثمّ يذكر ثلاثة أجوبة لهذا السؤال :
1 ـ أنّ الاُمور المهمّة والقيّمة لا يمكن إدراك حقيقتها بسهولة من خلال الألفاظ والكلام ، ولذلك فإنّ إخفاءها وإبهامها يكون أحياناً أكثر تحفيزاً ، وأبعث على النشاط ، وهوأبلغ من ناحية الفصاحة .
2 ـ أنّ الشيء الذي يكون قرّة للأعين ، يكون عادةً مترامي الأطراف إلى الحدّ الذي لا يصل علم ابن آدم إلى جميع خصوصياته .
3 ـ لمّا كان هذا الجزاء قد جعل لصلاة الليل المستورة ، فإنّ المناسب أن يكون ثواب هذا العمل عظيماً ومخفيّاً أيضاً . وينبغي الإلتفات إلى أنّ جملة {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} في الآية السابقة إشارة إلى صلاة الليل .
وفي حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) : «ما من حسنة إلاّ ولها ثواب مبين في القرآن ، إلاّ صلاة الليل ، فإنّ الله عزّ إسمه لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها ، قال : فلا تعلم نفس ما اُخفي لهم من قرّة أعين» (6) .
وبغضّ النظر عن كلّ ذلك ، فإنّ عالم القيامة ـ وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً ـ عالم أوسع من هذا العالم سعةً لا تحتمل المقارنة ، فهو أوسع حتّى من الحياة الدنيا بالقياس إلى حياة الجنين في رحم الاُمّ ، وأبعاد ذلك العالم لا يمكن إدراكها عادةً بالنسبة لنا نحن السجناء داخل الجدران الأربعة للدنيا ، ولا يمكن تصوّره من قبل أحد .
إنّنا نسمع كلاماً عنه فقط ، ونرى شبحه من بعيد ، لكنّنا ما لم ندرك ولم نر ذلك العالم ، فإنّ من المحال إدراك أهميّته وعظمته ، كما أنّ إدراك الطفل في بطن الاُمّ لنعم هذه الدنيا ـ على فرض إمتلاكه العقل والإحساس الكامل ـ غير ممكن .
وقد ورد نفس هذا التعبير في شأن الشهداء في سبيل الله ، ذلك أنّ الشهيد عندما يقع على الأرض تقول له الأرض : مرحباً بالروح الطيّبة التي خرجت من البدن الطيّب ، أبشر فإنّ لك ما لا عين رأت ، ولا اُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر (7) .
وتبيّن الآية التالية المقارنة التي مرّت في الآيات السابقة بصيغة أكثر صراحة ، فتقول : (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً) .
لقد وردت الجملة بصيغة الإستفهام الإنكاري ، ذلك الإستفهام الذي ينبعث جوابه من عقل وفطرة كلّ إنسان بأنّ هذين الصنفين لا يستويان أبداً ، وفي الوقت نفسه ، وللتأكيد ، فقد أوضحت الآية عدم التساوي بصورة أوضح بذكر جملة : (لا يستوون) .
لقد جعل «الفاسق» في مقابل «المؤمن» في هذه الآية ، وهذا دليل على أنّ للفسق مفهوماً واسعاً يشمل الكفر والذنوب الاُخرى ، لأنّ هذه الكلمة أخذت في الأصل من جملة (فسقت الثمرة) إذا خرجت من قشرها ، ثمّ أطلقت على الخروج على أوامر الله والعقل وعصيانها ، ونعلم أنّ كلّ من كفر ، أو إرتكب معصية فقد خرج على أوامر الله والعقل .
وممّا يجدر ذكره أنّ الثمرة ما دامت في قشرها فهي سالمة ، وبمجرّد أن تخرج من القشر تفسد ، وبناءً على هذا فإنّ فسق الفاسق كفسق الثمرة ، وفساده كفسادها .
ونقل جمع من المفسّرين الكبار ففي ذيل هذه الآية أنّ «الوليد بن عقبة» قال يوماً لعلي (عليه السلام) : أنا أبسط منك لساناً ، وأحدّ منك سناناً! إشارة إلى أنّه ـ بظنّه ـ يفوق علياً في الفصاحة والحرب ، فأجابه علي (عليه السلام) : «ليس كما تقول يا فاسق» ، إشارة إلى أنّك أنت الذي اتّهمت بني المصطلق بوقوفهم ضدّ الإسلام في قصّة جمع الزكاة منهم ، فكذّبك الله وعدّك فاسقاً في الآية (6) من سورة الحجرات : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . . . } [الحجرات : 6] (8) .
وأضاف البعض هنا بأنّ آية : {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً} نزلت بعد هذه المحاورة ، لكن يبدو من ملاحظة أنّ السورة مورد البحث (سورة السجدة) نزلت في مكّة ، وقصّة الوليد وبني المصطلق وقعت في المدينة ، فهذا من قبيل تطبيق الآية على مصداق واضح لها .
وبناءً على ما ذهب بعض المفسّرين من أنّ الآية أعلاه والآيتين بعدها مدنية ، لا يبقى إشكال من هذه الجهة ، ولا مانع من أن تكون هذه الآيات الثلاث قد نزلت بعد المحاورة أعلاه .
وعلى كلّ حال ، فلا بحث ولا جدال في إيمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) العميق المتأصّل ، ولا في فسق الوليد ، حيث اُشير في آيات القرآن لكلا الإثنين .
وتبيّن الآية التالية عدم المساواة هذه بصورة أوسع وأكثر تفصيلا ، فتقول : {أمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنّات المأوى (9)} ثمّ تضيف الآية بأنّ هذه الجنّات قد أعدّها الله تعالى لإستقبالهم في مقابل أعمالهم الصالحة : {نزلا بما كانوا يعملون} .
إنّ التعبير بـ «نزلا» ، والذي يقال عادةً للشيء الذي يهيّئونه لإستقبال وإكرام الضيف ، إشارة لطيفة إلى أنّ المؤمنين يُستقبلون ويُخدمون دائماً كما هو حال الضيف ، في حين أنّ الجهنّميين ـ كما سيأتي في الآية الآتية ـ كالسجناء الذين يأملون الخروج منها في كلّ حين ، ثمّ يعادون فيها!
وما ورد في الآية (102) من سورة الكهف : { إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا } [الكهف : 102] فانّه من قبيل (فبشّرهم بعذاب أليم) وهو كناية عن أنّه يُعاقب ويعذّب هؤلاء بدل إكرامهم ، ويهدّدون مكان بشارتهم .
ويعتقد البعض أنّ «النزل» أوّل شيء يستقبل به الضيف الوارد لتوّه ـ كالشاي والعصير في زماننا ـ وبناءً على هذا فإنّه إشارة لطيفة إلى أنّ جنّات المأوى بتمام نعمها وبركاتها هي أوّل ما يستقبل به ضيوف الرحمن ، ثمّ تتبعها المواهب في بركات اُخرى لا يعلمها إلاّ الله سبحانه .
والتعبير بـ (لهم جنّات) لعلّه إشارة إلى أنّ الله سبحانه لا يعطيهم بساتين الجنّة عارية ، بل يملّكهم إيّاها إلى الأبد ، بحيث لا يعكّر هدوء فكرهم إحتمال زوال هذه النعم مطلقاً .
وتطرّقت الآية التالية إلى النقطة التي تقابل هؤلاء ، فتقول : {وأمّا الذين فسقوا فمأواهم النار} فهؤلاء مخلّدون في هذا المكان المرعب بحيث أنّهم {كلّما أرادوا أن يخرجوا منها اُعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذّبون} .
مرّة اُخرى نرى هنا العذاب الإلهي قد جعل في مقابل «الكفر والتكذيب» ، والثواب والجزاء في مقابل «العمل» ، وهذا إشارة إلى أنّ الإيمان لا يكفي لوحده ، بل يجب أن يكون حافزاً وباعثاً على العمل ، إلاّ أنّ الكفر كاف لوحده للعذاب ، وإن لم يرافقه ويقترن به عمل .
وقوله تعالى : {وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الاَْدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الاْكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الُْمجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ}
عقوبات تربوية :
بعد البحث الذي مرّ في الآيات السابقة حول المجرمين وعقابهم الأليم ، فإنّ الآيات مورد البحث تشير إلى أحد الألطاف الإلهية الخفيّة وهي موارد العذاب الخفيف في الدنيا ليتّضح أنّ الله سبحانه لا يريد أن يبتلى عبد بالعذاب الخالد أبداً ، ولذلك يستخدم كلّ وسائل التوعية لنجاته ، فيرسل الأنبياء ، وينزل الكتب السماوية ، ينعم ويبتلي بالمصائب ، وإذا لم تنفع أيّة وسيلة منها فليس إلاّ نار الجحيم .
تقول الآية : {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون} .
من المسلّم أنّ «العذاب الأدنى» له معنى واسعاً يتضمّن أغلب الإحتمالات التي كتبها المفسّرون بصورة منفصلة :
فمن جملتها ، أنّ المراد المصائب والآلام والمشقّة .
أو القحط والجفاف الشديد الذي دام سبع سنين وابتلي به المشركون في مكّة حتّى اضطروا إلى أكل أجساد الموتى!
أو الضربة القاصمة التي نزلت عليهم في غزوة بدر ، وأمثال ذلك .
أمّا ما احتمله البعض من أنّ المراد عذاب القبر ، أو العقاب في الرجعة فلا يبدو صحيحاً ، لأنّه لا يناسب جملة (لعلّهم يرجعون) أي عن أعمالهم .
من البديهي أنّ العذاب موجود في هذه الدنيا أيضاً ، بحيث إذا نزل اُغلقت أبواب التوبة ، وهو عذاب الإستئصال ، أي العذاب والعقوبات التي تنزل لفناء الأقوام العاصين حينما لا تنفع ولا تؤثّر فيهم أيّ وسيلة توعية وتنبيه .
وأمّا «العذاب الأكبر» فيعني عذاب يوم القيامة الذي يفوق كلّ عذاب حجماً وألماً .
وهناك التفاتة أشار إليها بعض المفسّرين في أنّه لماذا جعل «الأدنى» في مقابل «الأكبر» ، في حين أنّه يجب إمّا أن يقع الأدنى مقابل الأبعد ، أو الأصغر في مقابل الأكبر؟
وذلك أنّ لعذاب الدنيا صفتين : كونه صغيراً ، وقريباً ، وليس من المناسب التأكيد على صغره عند التهديد ، بل يجب التأكيد على قربه . ولعذاب الآخرة صفتان أيضاً : كونه بعيداً وكبيراً ، والمناسب في شأنه التأكيد على كبره وعظمته لا بعده ـ تأمّلوا جيداً ـ .
وتقدّم أنّ التعبير بـ (لعلّ) في جملة (لعلّهم يرجعون) بسبب أنّ الإحساس بالعقوبات التحذيرية ليس علّة تامّة للوعي واليقظة ، بل هو جزء العلّة ، ويحتاج إلى أرضيّة مهيّأة ، وبدون هذا الشرط لا يحقّق النتيجة المطلوبة ، وكلمة (لعلّ) إشارة إلى هذه الحقيقة .
وتتّضح من هذه الآية إحدى حكم المصائب والإبتلاءات والآلام التي تعتبر من المسائل الملحّة والمثيرة للجدل في بحث التوحيد ومعرفة الله وعدله .
وليس في هذه الآية فحسب ، بل اُشير في آيات اُخرى من القرآن إلى هذه الحقيقة ، ومن جملتها في الآية (94) من سورة الأعراف {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ} [الأعراف : 94] .
ولمّا لم تنفع أيّة وسيلة من وسائل التوعية والتنبيه ، حتّى العذاب الإلهي ، لم يبق طريق إلاّ إنتقام الله من هؤلاء القوم الذين هم أظلم الناس ، وكذلك تقول الآية التالية : {ومن أظلم ممّن ذكّر بآيات ربّه ثمّ أعرض عنها إنّا من المجرمين منتقمون} .
فلم تؤثّر فيهم النعمة الإلهيّة ، ولا العذاب والإبتلاءات التحذيرية ، وعلى هذا فلا أحد أظلم منهم ، وإذا لم يُنتقم من هؤلاء فمّمن الإنتقام ؟
من الواضح ـ وبملاحظة الآيات السابقة ـ أنّ المراد من «المجرمين» هنا هم منكرو المبدأ والمعاد الذين لا إيمان لهم .
وقد وصف جماعة من الناس في آيات القرآن مراراً بأنّهم (أظلم) من الباقين ، وبالرغم من تعبيراتها المختلفة إلاّ أنّها تعود جميعاً إلى أصل الكفر والشرك ، وبناءً على هذا فإنّ معنى (أظلم) الذي يعتبر صيغة تفضيل يتطابق مع هذه المصاديق .
والتعبير بـ (ثمّ) في الآية ، والذي يدلّ عادةً على التراخي ، لعلّه إشارة إلى أنّ أمثال هؤلاء يُعطون فرصة ومجالا كافياً للتفكير والبحث ، ولا تكون معاصيهم الإبتدائية سبباً لإنتقام الله أبداً ، إلاّ أنّهم سيستحقّون إنتقام الله عزّوجلّ بعد إنتهاء الفرصة اللازمة .
ويجب الإلتفات إلى أنّ التعبير بـ «الإنتقام» يعني العقوبة في لسان العرب ، ومع أنّ معنى الكلمة أصبح في المحادثات اليومية يعني تشفّي القلب وإبراد الغليل من العدو ، إلاّ أنّ هذا المعنى لا وجود له في الأصل اللغوي ، ولذلك فإنّ هذا التعبير قد إستعمل مراراً في شأن الله عزّوجلّ في القرآن المجيد ، في حين أنّه سبحانه أسمى وأعلى من هذه المفاهيم ، فهولا يفعل شيئاً إلاّ وفق الحكمة .
____________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج10 ، ص298-309 .
2 ـ ينبغي الإلتفات إلى أنّ الآية الاُولى هي اُولى السجدات الواجبة في القرآن الكريم ، وإذا ما تلاها أحد بتمامها ، أو سمعها من آخر فيجب أن يسجد . طبعاً لا يجب فيها الوضوء ، لكن يجب الإحتياط في وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
3 ـ يقول الراغب في المفردات : (خرّوا) في الأصل من مادّة الخرير ، أي صوت الماء وأمثاله حين إنحداره من مرتفع إلى منخفض ، وإستعماله هذا التعبير في شأن الساجدين إشارة إلى أنّ هؤلاء ترتفع أصواتهم بالتسبيح في لحظة هويّهم إلى الأرض للسجود .
4 ـ «تتجافى» من مادّة «جفا» ، وهي في الأصل بمعنى القطع والحمل والإبعاد ، و(الجنوب) جمع جنب ، وهو الجانب ، و(المضاجع) جمع مضجع ، وهو محل النوم ، وإبعاد الجانب عن محلّ النوم كناية عن النهوض من النوم والتوجّه إلى عبادة الله في جوف الليل .
5 ـ نقل هذا الحديث كثير من المفسّرين ، ومن جملتهم الطبرسي في مجمع البيان ، والآلوسي في روح المعاني ، والقرطبي في تفسيره . وقد أورده المحدّثان المشهوران البخاري ومسلم في كتبهما أيضاً .
6 ـ مجمع البيان . ذيل الآيات مورد البحث .
7 ـ مجمع البيان ، ج2 ذيل الآية (171) من آل عمران ، والتّفسير الأمثل ، ذيل نفس الآية .
8 ـ أورد هذه الرواية العلاّمة الطبرسي في مجمع البيان ، والقرطبي في تفسيره ، والفاضل البرسوئي في روح البيان . وممّا يستحقّ الإنتباه أنّنا نقرأ في كتاب (اُسد الغابة في معرفة الصحابة) أنّه لا خلاف بين المطلعين على تفسير القرآن والعالمين به في أنّ آية (إن جاءكم فاسق بنبأ) قد نزلت في حقّ الوليد بن عقبة في قصّة بني المصطلق .
9 ـ «المأوى» من مادّة (أوى) بمعنى إنضمام شيء إلى شيء آخر ، ثمّ قيلت للمكان والمسكن والمستقرّ .



|
|
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|