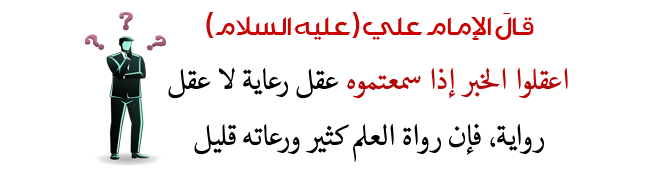
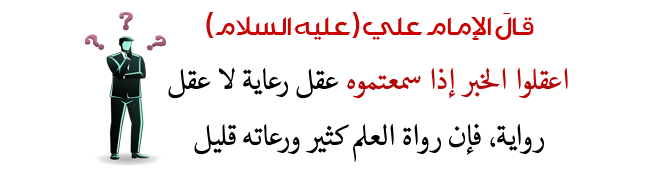

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
التاريخ: 11-9-2016
التاريخ: 11-9-2016
|
أفاد المحقّق النائيني رحمه الله في مقام بيان الفرق بين الرفع والدفع ما حاصله :
أنّ الرفع بمعنى نفي الشيء وإعدامه بعد أن كان متقرّرا وموجودا في عالمه المناسب له ، فحينما يكون الشيء موجودا فعلا فإنّ إعدامه يكون رفعا لوجوده سواء كان هذا الشيء من قبيل الوجودات العينيّة المتأصّلة أو كان من قبيل الاعتبارات الشرعيّة.
فإعدام الشجرة بعد أن كانت موجودة يسمّى رفعا ، ونفي الوجوب عن الصلاة مثلا بعد أن كان ثابتا لها يسمّى رفعا أيضا ، غايته أنّ الرفع في كلّ منها يناسب وعاء وجوده.
وأمّا الدفع فهو بمعنى المنع عن تأثير المقتضي لأثره ، أي المنع عن وجود الشيء بعد أن كان واجدا لمقتضيه.
فحينما يكون الشيء مؤهّلا للوجود بعد تماميّة أجزاء علّته ـ سوى عدم المانع ـ فإنّ الحيلولة دون إيجاده يسمّى دفعا أي فإنّ الحيلولة دون تأثير علّته في إيجاده يسمّى دفعا.
فعند ما تهيّأ النار وتقرّب منها الخشبة فإنّ الاحتراق يصبح بذلك مؤهّلا للوجود إلاّ أنّه عند ما يوضع عازلا فوق الخشبة فإنّ ذلك يكون مانعا عن وجود الاحتراق ، هذا المانع يسمّى دفعا كما يسمّى مانعا.
وهكذا عند ما يكون الفعل واجدا للملاك المقتضي لجعل الوجوب عليه إلاّ أنّ ثمّة مانع منع من أن يؤثّر هذا المقتضي في إيجاد جعل الوجوب على الحكم كما لو افترضنا اشتمال صلاة الليل على الملاك المقتضي لجعل الوجوب عليها إلاّ أنّه منع من إيجابها ملاك التسهيل فإنّ هذا المانع يسمّى دفعا.
وبذلك اتّضح الفرق بين الرفع والدفع وأنّ الرفع ناف للوجود الثابت في زمان سابق أو رتبة سابقة ، وأنّ الدفع مانع عن تحقّق الوجود في مورد يكون الشيء واجدا لمقتضي الوجود.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه الله بعد أن أفاد ما بينّاه عالج ما ينتجه هذا الفرق من إشكاليّة استعمال الرفع في معنى الدفع في حديث الرفع ـ والذي هو أحد أدلّة البراءة ـ حيث لا يبعد أن يكون المراد من الرفع هو الدفع بالمعنى المذكور ، فرفع ما لا يعلمون معناه أنّ المقتضي لجعل الأحكام على المكلّفين في ظرف الجهل ، وعدم العلم وإن كان موجودا إلاّ أنّ مصلحة البراءة منعت من أن يؤثّر هذا المقتضي أثره في جعل الحكم على المكلّفين في ظرف الجهل وعدم العلم.
فإذا كان الرفع قد استعمل في معنى الدفع فلا بدّ وأن يكون هذا الاستعمال مجازيّا ، وهو ما يفتقر إلى قرينة.
لذلك أفاد المحقّق النائيني رحمه الله أنّ الرفع قد استعمل في معناه وهو نفي الوجود بعد أن كان متقرّرا ، وذلك يتّضح بالالتفات إلى أنّ وجود الشيء كما يفتقر في أصل وجوده إلى علّة كذلك هو يفتقر في استمرار وجوده إلى علّة ، فحينما يكون ثمّة مانع من تأثير المقتضي لأثره في استمرار وجود الشيء فإنّ هذا المانع يكون في الحقيقة نافيا للوجود لأنّه يكون نافيا لاستمراره ، فوجود الشيء في عمود الزمان ينحلّ إلى وجودات متعدّدة بعدد آنات الزمان ، وكلّ وجود منها يحتاج إلى مفيض وعلّة ، فحينما يمنع مانع عن الوجود الثاني فهذا في واقع الأمر نفي وإعدام للوجود الثاني.
فالرفع إذن وإن كان بمعنى نفي الوجود وإعدامه إلاّ أنّه يتصادق مع الدفع بمعنى المنع ، لأنّ الرفع ـ بمعنى الإعدام ـ من جهة الاستمرار يكون بالمنع من تأثير المقتضي لاستمرار الوجود من أن يؤثر أثره في استمراره.
وبالنتيجة يكون استعمال الرفع بمعنى الدفع ليس مجازيا بعد اتّحاده معه من جهة أنّ الرفع وإعدام الوجود يكون بواسطة المنع من تأثير المقتضي لأثره في استمرار الموجود.



|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
عوائل الشهداء: العتبة العباسية المقدسة سبّاقة في استذكار شهداء العراق عبر فعالياتها وأنشطتها المختلفة
|
|
|