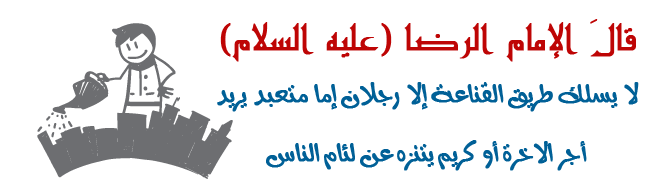
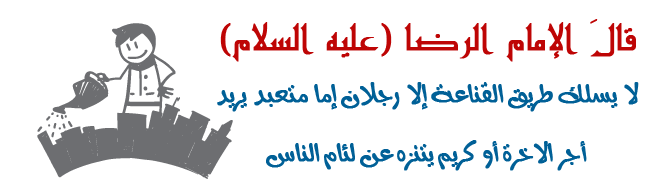

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2022
التاريخ: 2024-05-26
التاريخ: 24-8-2020
التاريخ: 2024-02-03
|
تنويه :
إنّ أوّل صفة من الصفات الأخلاقية الذميمة وأوّل رذيلة نقرأها في تاريخ الأنبياء وبداية خلقة الإنسان ، وكما يعتقد أكثر علماء الأخلاق أنّها أُمّ المفاسد والرذائل الأخلاقية وأصل جميع أنواع الشقاء الإنساني ، هي (التكبّر والاستكبار) والّتي وردت في قصة إبليس عند ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة وكذلك إبليس بالسجود له.
هذه القصة المثيرة والمعبّرة هي قصة محذرة ومليئة بالعبر لجميع الأفراد والمجتمعات البشرية ، والجدير بالذكر أنّ النتائج والعواقب الوخيمة للتكبّر والاستكبار لا تتجلّى في قصة خلق آدم فحسب ، بل نراها متجلية على طول الخط في سيرة الأقوام السالفة من تاريخ الأنبياء ومدى الدور المخرب والمدّمر لهذه الصفة الذميمة في حركة الإنسان والمجتمع البشري.
واليوم نرى أنّ مسألة الإستكبار لها الدور الأوّل في خلق الأجواء الفاسدة وزيادة المفاسد الأخلاقية والاجتماعية في العالم والمجتمعات البشرية المعاصرة وتعد بحقّ البلاء الكبير على واقع الإنسانية المعاصرة والحضارة البشرية الفعلية والّتي لا نجد صدىً واسعاً وتجاوباً من قِبل المفكّرين والمصلحين في إصلاح هذا الخلل الكبير الّذي يتعرض له المجتمع البشري من جراء هذه الصفة الرذيلة.
وبهذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم لنستوحي من آياته الشريفة ما يرشدنا ويُلقي بالضوء على هذا البحث ، أي الآيات المتعلّقة بسيرة آدم إلى سيرة نبيّنا الأكرم في دائرة آثار ودوافع هذه الصفة الأخلاقية الذميمة.
1 ـ (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ)([1]).
2 ـ (قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ)([2])
3 ـ (وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً)([3]).
4 ـ (فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ)([4]).
5 ـ (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ)([5]).
6 ـ (وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ)([6])
7 ـ (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)([7]).
8 ـ (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ* ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ* فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ)([8]).
9 ـ (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ)([9]).
10 ـ (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)([10]).
11 ـ (سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ)([11]).
12 ـ (لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ)([12]).
13 ـ (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً).
14 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)([13]).
البلاء العظيم على طول التاريخ البشري :
إنّ الآيات القرآنية الكريمة مليئة ببيان مفاسد الاستكبار والعواقب الوخيمة المترتبة على التكبّر وكذلك المشكلات البشرية الّتي تزامنت وترتبت على هذه الصفة الذميمة على طول التاريخ البشري وتأثير هذه الصفة الرذيلة السلبي في تقدّم وتكامل الإنسان في أبعاده المعنوية والمادية حيث لا تخفى على أحد ، وما قرأنا في الآيات أعلاه إنّما هو في الحقيقة ناظرٌ إلى هذا الموضوع.
«الآية الاولى والثانية» تتحدّث عن إبليس والقصة المعروفة لسجود الملائكة عند ما أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم تعظيماً له وقد كان إبليس في ذلك الوقت في صف الملائكة بسبب علوّ مرتبته ومقامه ، وقد سجد جميع الملائكة إلّا إبليس لأنّه آثر عصيان الأمر الإلهي وتكبّر على الحقّ وعلى الله ، وبالتالي تمّ طرده من ذلك المقام السامي بسبب رفضه الصريح للسجود وحتّى اعتراضه على أصل الأمر الإلهي له ، ولذلك أمره الله تعالى بالخروج من ذلك المقام وتلك المرتبة إلى أسفل السافلين حيث تقول الآية : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ)([14]). (قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ)([15]).
وفي الحقيقة أنّ هذه أوّل معصية وقعت في عالم الوجود هذه المعصية هي الّتي أدّت بمخلوق مثل إبليس والّذي كان قد عبد الله ستة ألاف سنة (كما ورد في الخطبة القاصعة لأمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة) وأُخرج من ذلك المقام بسبب تكبّر ساعة فحبطت أعماله وعباداته وطاعاته وسقط من ذلك المقام الّذي كان يُعدّ فيه مع الملائكة حيث يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذ احبط عمله الطويل وجهده الجهيد ، وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة ... عن كبر ساعة واحدة ([16]).
وفي هذه القصة المثيرة والمعبّرة نقرأ دقائق ونكات مهمّة جداً حول عواقب التكبّر ونستوحي منها أنّ هذه الصفة الرذيلة يمكن أن تؤدي إلى واقع الكفر والخروج من الإيمان تماماً كما ورد في الآيات محل البحث (أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ)([17]).
وهكذا يتجلّى في هذه القصة أنّ إبليس وبسبب حجاب الكِبر والغرور قد تعامل مع الواقع من موقع الجهل التامّ حيث خاطب الله تعالى من موقع الاعتراض والرفض للأمر الإلهي وقال: (قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ)([18]).
في حين أنّ من الواضح أن شرف آدم لم يكن لأنّه مخلوق من الطين بل بسبب تلك النفخة الإلهية والروح الإلهي الّتي نفخها الله تعالى في آدم : (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ)([19]) ، وحتّى إبليس لم يكن ليدرك افضلية التراب على النار ، التراب الّذي صار مصدر جميع البركات في واقع الخِلقة وظهور الحياة وأنواع المعادن والذخائر الطبيعية من الماء والنباتات وسائر المواد الاخرى الّتي تتولد منها النار ولذلك قال بمنتهى الغرور (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)([20]).
مضافاً إلى أنّ الكثير من الأشخاص الّذين يقعون في الخطيئة والزيغ فإنّهم قد يعودون إلى مسارهم الفطري والسليم بعد أن يدركوا خطئهم ويتحركوا من موقع إصلاح الخلل والتوبة، ولكن حالة التكبّر والاستكبار هي من الامور الّتي لا تفسح المجال للإنسان المخطئ في سلوك طريق التوبة بعد الانتباه وإدراك الخطأ ، ولهذا السبب فإنّ الشيطان عند ما التفت إلى خطئه لم يتب منه ، لأنّ الكبر والغرور لم يسوّغ له أن يتحرك من موقع التسليم والتعظيم لجوهر الخلقة (أي الإنسان) بل إنّه زاد من تكبره وعناده وأقسم على إضلال جميع الناس (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) وطلب من الله تعالى العمر المديد ليستمر في غيّه ونصب شراكه وفخاخه لبني آدم ليضلهم عن سبيل الله وعن سلوك طريق الحقّ.
وبهذا فإنّ التكبّر والأنانية والعجب وأمثال ذلك تعدّ مصدراً من مصادر الحالات السلبية والصفات الذميمة الاخرى من قبيل الحسد ، الكفر ، الإفساد ، ارتكاب الفحشاء والمنكر.
وبهذا يكون الشيطان كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة القاصعة قد وضع أساس التكبّر والتعصب في الأرض وعمل على التصدي للقدرة الإلهية المطلقة من موقع العناد واللجاجة : فعدو الله امام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز ، وخلع قناع التذلل ([21]).
وبسبب هذه الحالة الدنيئة والفعل الدنيء فإنّ الله تعالى قد جعل الشيطان ذليلاً وألبسهُ لباس الهوان والحقارة كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الخطبة : الا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا ، واعد له في الآخرة سعيرا ([22]).
والخلاصة أنّه كلّما تدبّرنا في قصة إبليس وافرازات التكبّر والغرور فإننا نستجلي دقائق مهمّة وكثيرة عن أخطار التكبّر والاستكبار.
«الآية الثالثة» تتحرك حول استعراض قصة نوح أول أنبياء اولي العزم وصاحب الشريعة ، هذه القصة توضح لنا أنّ المصدر الأساسي للكفر وعناد قوم نوح مع نبيّهم يمتد إلى حيث صفة التكبّر والاستكبار. فعند ما نقرأ الشكوى الّتي تقدّم بها نوح إلى الله تعالى من قومه نجد أنّه يؤكد على هذه المسألة وهي أنّ مخالفتهم نابعة من شدّة استكبارهم حيث تقول الآية : (وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً)([23]).
فهنا نرى أيضاً أنّ التكبّر ورؤية الذات من موقع الغرور والعجب والتفوق على الآخرين يمثل منبع الكفر والعناد مع الحقّ.
لقد كان تكبّرهم إلى درجة أنّهم لم يتحملوا حتّى سماع كلام الحقّ والّذي يمكن أن يؤثر في تنبّههم وإيقاظهم من ضلالهم ولذلك كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم على رؤوسهم لكي لا يصل إليهم صوت نوح ويتأثروا بهذا الكلام الإلهي الصادر من أعماق الفطرة الإنسانية ، فهذا العداء وهذه الكراهية لكلام الحقّ ليس لها مسوّغ ودافع سوى حالة التكبّر الشديد الّذي كان يعيشه هؤلاء القوم الظالمون.
هؤلاء كانوا يتعرضون لنوح ودعوته ويتساءلون من موقع الاعتراض أنّ نوح كان يحيط به الأراذل من الناس والفقراء والمساكين وأبناء الطبقات الضعيفة من المجتمع ، فلذلك قرروا عدم الاقتراب من نوح والجلوس معه ما دام هؤلاء الأراذل والضعفاء بحسب تعبيرهم مع نوح.
أجل فإنّ التكبّر والأنانية العجيبة الّتي كان يعيشها هؤلاء الناس كانت قد أحرقت الفضائل الأخلاقية في واقعهم وحوّلتها إلى رماد.
وفي الحقيقة فإنّ هذه الرذيلة الأخلاقية وهي التكبّر تعدّ عاملاً أساسياً لعنادهم وإصرارهم على الكفر إلى درجة أنّهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويغطّون رؤوسهم بثيابهم خوفاً من تأثير كلام نوح في أنفسهم.
ومن الملفت للنظر أنّ هذا العمل إنّما يدلّ على أنّهم كانوا يعترفون في قرارة أنفسهم بحقّانية دعوة نوح ويعتقدون به ويدل على ذلك وضعهم أصابعهم في آذانهم وتغطيتهم رؤوسهم بثيابهم.
ويُحتمل أيضاً أنّهم كانوا يغطون رؤوسهم بثيابهم لكيلا يروا نوح ولا يراهم نوح فلعلّ رؤيتهم له توجب الأُنس به والرغبة والميل لسماع كلماته.
وأخيراً فإنّ حالة العجب والغرور ورّثتهم الجهل وعدم سماع انذارات نوح (عليه السلام) في آخر لحظات العمر حيث كانت هناك فرصة للنجاة فلم يكونوا يحتملون صدقه في هذا الانذار لذلك عند ما كان نوح (عليه السلام) يصنع السفينة فإنّ هؤلاء القوم الظالمين كانوا يمرّون عليه ويهزؤون به ويسخرون منه ولكن نوح كان قد حذّرهم بقوله : (... إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ)([24]) ، ولكن في ذلك اليوم سوف لا تكون لكم فرصة للتنبّه حيث تحيط بكم أمواج البلاء والطوفان فلا ملجأ.
وأساساً فإنّ أحد علامات المستكبرين هو أنّهم لا يتعاملون مع المسائل الّتي لا تدور في دائرة مصلحتهم ومنفعتهم من موقع الجديّة بل يتخذونها وسيلة للعب واللهو ويتحركون دائماً من موقع الاستهزاء والسخرية بالمستضعفين حيث يمثل ذلك جزءاً من سلوكهم وديدنهم في حياتهم ، وكم رأينا أنّهم في مجالسهم ينطلقون للعثور على مؤمن مستضعف ليجعلونه محور سخريتهم وضحكهم ، وبذلك يكون هذا السلوك منشأ للترفيه عن أنفسهم ، فهؤلاء وبسبب هذه الروح الاستكبارية يرون أنّهم العقل الكلّي ويتصورون أنّ الثروة الّتي اكتسبوها من الطريق الحرام هي علامة وآية لذكائهم ولياقتهم الّتي تبيح لهم أن يتعاملوا مع الآخرين من موقع التحقير والتهميش.
وفي «الآية الرابعة» نتجاوز عصر نوح (عليه السلام) لنصل إلى عصر (قوم عاد) ونبيّهم هود (عليه السلام) ، وهنا نرى أنّ السبب الأساس لشقاء هؤلاء القوم الظالمين هو عامل التكبّر وروح الاستكبار المترسخة في نفوسهم حيث تقول الآية : (فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ)([25]).
وهنا نرى أيضاً أنّ هذه الصفة الأخلاقية الذميمة وهي صفة التكبّر والاستكبار كانت سبباً بأن يتصوّروا أنفسهم أقوى الموجودات في عالم الخلقة وحتّى أنّهم نسوا قدرة الله تعالى وبالتالي تعاملوا مع الآيات الإلهية من موقع الإنكار وأوجدوا جداراً سميكاً بينهم وبين الحقّ.
والملفت للنظر أنّ الآية الّتي تليها (الآية 16 من سورة فصلت) تشير إلى أنّ الله تعالى ولأجل تحقير هؤلاء المتكبرين المعاندين قد سلط عليهم اعصاراً شديداً ومهولاً في أيّام نحسات بحيث جعلت من أجسادهم كالرماد المبثوث وكالريشة في مهب الريح.
أجل فإنّ التكبّر يعدّ حجاباً على بصيرة الإنسان يمنعه من رؤية أيّة قدرة فوق قدرته حتّى أنّه لا يرى قدرة الله تعالى على نفسه وأفعاله.
وتعبير «بغير الحقّ» هو في الواقع قيد توضيحي ، لأنّ التكبّر والاستكبار بالنسبة للإنسان هو بغير حقّ دائماً وبأيّة حالة ، فلا يليق بالإنسان أن يتصرّف من موقع التكبّر ويلبس هذا الرداء الّذي لا يليق إلّا بالقدرة الإلهية المطلقة.
«الآية الخامسة» تتحدّث عن زمان شعيب وقومه ، وهنا نرى أيضاً أنّ السبب الأساسي لشقاء قوم شعيب وضلالهم هو الاستكبار حيث تقول الآية : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ)([26]).
لماذا يجب على شعيب والّذين آمنوا معه وسلكوا طريق التقوى والانفتاح على الله أن يخرجوا من ديارهم ومدنهم؟ هل هناك دليل آخر غير تحرّك الأثرياء والمتكبّرين من قوم شعيب في التصدي للدعوة الإلهية والرسالة السماوية ونظرتهم إلى الّذين آمنوا من موقع الاستصغار والاستحقار وبالتالي الانطلاق في سبيل إلغائهم ونفيهم وإبعادهم عن ديارهم؟
أما قولهم (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) فلا يعني أنّ الّذين آمنوا مع شعيب كانوا على ملّة هؤلاء المستكبرين ودينهم ، بل بسبب أنّهم كانوا منسوبين إليهم وإلى هذه المدينة ، ونعلم أنّ التكبّر وحبّ الذات يوجب على الإنسان المتصف بهذه الصفة أن يرى كلّ شيء متعلّقاً به ومن ممتلكاته.
«الآية السادسة» ناظرة إلى عصر موسى وفرعون وقارون ، حيث تتحدّث هذه الآية عن قصة هؤلاء وترى أنّ العامل الأساس لانحراف وضلال وشقاء قوم فرعون هو حالة التكبّر فتقول : (وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ)([27]) ، ولهذا السبب فإنّهم لم يذعنوا للحقّ وبالتالي فقد أصابهم عذاب الله وأهلكهم ولن يستطيعوا الفرار منه.
(قارون) ذلك الرجل الثري الّذي كان يرى أنّ ثروته العظيمة دليلاً على مقامه ومنزلته السامية عند الله تعالى وكان يرى أنّ هذه الثروة العظيمة إنّما حصل عليها بسبب لياقته وذكائه ، ولذلك تملّكه الغرور والفرح والفخر ، فكان يخرج على قومه من فقراء بني إسرائيل بعظيم الزينة ومظاهر الثروة إصراراً منه على تحقيرهم وإذلالهم ، وكلّما نصحوه بأن يستخدم هذه الثروة لنيل الدرجات العليا في الآخرة والسعادة المعنوية في حركة الحياة والمجتمع ، فإنّ هذه النصائح لن تؤثر فيه وذهبت أدراج الرياح ، لأنّ الغرور والتكبّر منعه من إدراك حقائق الامور وصدّه عن دفع هذه الأمانة الإلهية الّتي بيده لأيّام معدودة لأصحابها الواقعيين.
أمّا «فرعون» الّذي جلس على عرش السلطنة والقدرة فإنّه قد أصابه الغرور والتكبّر بأشد من صاحبه حتّى أنّه لم يقنع من الناس بعبوديتهم له بل كان يرى نفسه أنّه (ربّهم الأعلى).
أمّا «هامان» الوزير المقرّب لفرعون والّذي كان شريكاً له في جميع جرائمه ومظالمه بل إنّ جميع إدارة امور المملكة كانت بيده فإنّ القرآن الكريم صرّح أيضاً بأنّه ابتلي بالكبر والغرور الشديد.
هؤلاء الثلاثة اتّحدوا في مقابل موسى (عليه السلام) ودعوته الإلهية وانطلقوا في الأرض فساداً وأمعنوا فيها اضلالاً للناس وإذلالاً لهم إلى أن شملهم العذاب الإلهي الشديد ، فأغرق فرعون وهامان في أمواج النيل الهادرة حيث كانوا يعدون النيل مصدراً لقدرتهم وأساساً لملكهم ، أمّا قارون فقد ابتلعته الأرض بكنوزه وثرواته الطائلة.
«الآية السابعة» تتحدّث عن قوم عيسى بن مريم (عليه السلام) والفرق بينهم وبين اليهود حيث تقول : (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)([28]).
ثمّ تذكر الدليل والعلّة لهذا التفاوت والفرق بين هاتين الطائفتين وتقول : (ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ).
ومن هذه العبارة يتضح جيداً أنّ أحد العوامل الأصلية لعداء اليهود للّذين آمنوا هو حالة التكبّر والاستكبار تجاه الحقّ في حين أنّ أحد أدلّة تعامل النصارى مع المؤمنين من موقع المحبّة واللطف هو عدم وجود هذه الصفة الذميمة في أنفسهم.
إنّ الأشخاص الّذين يعيشون التكبّر والاستكبار يريدون أن يقف الآخرون أمامهم موقف الذلّة والحقارة والعجز ، ولهذا السبب فإنّهم إذا رأوا يوماً نعمة قد أنعم الله بها على الآخرين فإنّهم يجدون في أنفسهم عداءً وكراهية شديدة تجاه هؤلاء الّذين أنعم الله عليهم ، أجل فإنّ الاستكبار هو سبب الحسد والحقد والعداء تجاه الحقّ والناس.
صحيح أنّ هذه الآية لا تتحدّث عن جميع النصارى بل ناظرة إلى النجاشي وقومه في الحبشة الّذين استقبلوا المسلمين المهاجرين إليهم أحسن استقبال ولم يلتفتوا إلى وساوس أزلام قريش الّذين أرسلتهم قريش ليحركوا النجاشي على طرد المسلمين من الحبشة وتسليمهم إلى المشركين ، وهذا الأمر هو الّذي تسبّب في أن يجد المسلمون في أرض الحبشة ملجأً وملاذاً لهم من شر المشركين الّذين كانوا ينصبون لهم أشد العداوة والكراهية ، ولكن الآية على أيّة حال تقرر أنّ الاستكبار هو العامل الأساس للعداوة والبغضاء للحقّ وأهل الحقّ في حين أنّ التواضع يُعد أساساً للمحبّة وتعميق أواصر العلاقة والعاطفة مع أهل الإيمان والخضوع مقابل الحقّ.
«الآية الثامنة» تتحرّك من موقع التأكيد على هذا المعنى وتقرير هذه الحقيقة المهمّة ، وهي أنّ الاستكبار هو سبب (الكفر والعناد وعدم المرونة مقابل الحقّ) ، وهنا تستعرض الآية حالة (الوليد بن المغيرة المخزومي) الّذي كان يعيش في عصر نزول القرآن وتصف حالته في مقابل الحقّ والآيات القرآنية وتقول : (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ* ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ* فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ)([29]).
كلمة «سحر» توضح جيداً أنّ الوليد قد أقرّ واذعن بهذه الحقيقة وهي أنّ القرآن الكريم له تأثير عجيب على الأفكار والقلوب ويتمتع بجاذبية كبيرة لعواطف الناس ، فلو أنّ الوليد نظر إلى هذه الآيات نظر المنصف والطالب للحقّ فإنّه سوف يعد هذا التأثير الغريب للقرآن دليلاً على إعجازه ، وبالتالي سوف يؤمن به ، ولكن بما أنّه كان ينظر إليه من خلال حجاب الغرور والتكبّر فإنّه كان يرى فيه سحراً كبيراً كسحر الأقوام السالفة ، أجل فكلّما تراكم حجاب التكبّر على بصيرة الإنسان وقلبه فإنّه سينظر إلى آيات الحقّ بنظر الباطل وينقلب الباطل في نظره إلى حقّ.
والمشهور أنّ الوليد كان يعيش الغرور إلى درجة أنّه كان يقول : انا الوحيد بن الوحيد ، ليس لي في العرب نظير ، ولا لأبي نظير! في حين أنّ الوليد كان يُعتبر بالنسبة إلى الناس في ذلك الزمان رجلاً عالماً وقد أدرك عظمة القرآن جيداً وقال فيه عبارة عجيبة مخاطباً بني مخزوم : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وان أعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق ، وانه ليعلو ولا يعلى عليه.
هذا التعبير يقرب بوضوح إلى أنّ الوليد أدرك عظمة القرآن أكثر من أيّ شخص آخر من قومه ولكن التكبّر والغرور منعه من رؤية شمس الحقيقة والإذعان لنور الحقّ.
وتأتي «الآية التاسعة» لتستعرض في سياقها خطاب مؤمن آل فرعون لقومه ويحتمل أن تكون هذه الآية جزءاً من خطابه أو جملة مستقلة معترضة من الآيات القرآنية الكريمة حيث نقرأ فيها قوله تعالى : (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ)([30]).
«يطبع» من مادّة «طبع» وتأتي في هذه الموارد بمعنى الختم ، وتشير إلى عمل تم في الماضي والحال ويراد به الشيء الّذي يُراد بقائه دون استخدام وتصرف فيغلق عليه ويُسد بابه ويوضع عليها مادّة لاصقة إما من الطين أو الشمع أو ما شابه ذلك ويختم عليها بختم معين بحيث إذا أراد شخص فتحه سيضطر إلى كسر هذا الختم وبالتالي سيتّضح ويتبين أنّه تصرّف فيه فيحال إلى المحكمة.
وعلى هذا الأساس فإنّ عملية الطبع والختم على قلوب المتكبرين يشير إلى أن عناد هؤلاء وعدائهم للحقّ قد أسدل على قلوبهم وأفكارهم حجاباً ظلمانياً بحيث لا يقدرون معه على إدراك حقائق عالم الوجود ، ولا يرون سوى أنفسهم ومصالحهم وأهوائهم النفسية ونوازعهم الدنيوية ، فكانت أذهانهم وعقولهم بمثابة ظروف مغلقة لا يمكن معها من إفراغ محتواها الفاسد ولا ملئها بالمحتوى السليم والفكر الصحيح ، وهذا في الواقع هو نتيجة التكبّر وحالة الجبارية الّتي يعيشها هؤلاء الاشخاص ، وفي الواقع فإنّ الصفة الثانية متولدة من الصفة الاولى لأنّ (جبار) تأتي في هذه الموارد بمعنى الشخص الّذي يعاقب وينتقم من مخالفيه من موقع الغضب الشديد والنقمة لا من موقع العقل والحكمة ، وبعبارة اخرى : أنّ الجبّار هو الشخص الّذي لا يرى إلّا نفسه وأهوائه ولا يرى للآخرين محلاً من الإعراب سوى أنّهم اتباع له.
وبالطبع فإنّ هذه المفردة «الجبّار» تطلق أحياناً على الله تعالى أيضاً ويراد بها مفهومٌ خاص وهو الشخص الّذي يُجبر نقائص الآخرين ويصلحها.
وتنطلق «الآية العاشرة» لتشير إلى أصل كلي لا يختصّ بطائفة معيّنة ، وهو أنّ الكافرين عند ما يقتربون من حافة جهنم يُقال لهم إنّ هذا العذاب هو بسبب أنّكم تتصفون بصفة التكبّر فتقول الآية : (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)([31]).
وشبيه هذا المعنى قد ورد في آيات متعددة اخرى من القرآن الكريم منها ما ورد في الآية 60 من سورة الزمر : (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ).
ومن الملفت للنظر أنّ من بين جميع الصفات الأخلاقية الذميمة لأصحاب النار قد أكدت الآية على مسألة التكبّر ممّا يقرر هذه الحقيقة ، وهي أنّ هذه الصفة الذميمة هي الأساس في سقوط هؤلاء في هذا المصير المؤلم بحيث تكون جهنم هي مقرّهم النهائي ومصيرهم الخالد.
وممّا يلاحظ في هذه الآية أنّ كلمة «مثوى» من مادّة «ثوى» تعني المحل الدائم والمقر الّذي يستقر فيه الإنسان في نهاية المطاف ، وهو إشارة إلى أنّ هؤلاء لا نجاة لهم من العذاب الأليم في الآخرة.
«الآية الحادية عشر» تتحدّث أيضاً عن المتكبّرين بشكل عام وتقول : (سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ)([32]).
هذه العبارات المثيرة الواردة في هذه الآية الكريمة تخبر عن عمق المصيبة الّتي يبتلي بها هؤلاء المتكبرون ، فإنّ الله تعالى سيجازي هؤلاء الأشخاص ويعاقبهم من موقع أنّهم لا يجدون في أنفسهم قبولاً للحقّ بحيث إنّهم لو رأوا جميع آيات الله ومعجزاته المتنوعة فإنّهم لا ينفتحون على الإيمان ولا يسلكون خط الصلاح والهدى ، ولو أنّهم وجدوا الصراط المستقيم مفتوحاً أمامهم فإنّهم لا يسلكونه بل إذا وجدوا طريق الغي والضلال فإنّهم يسلكونه من فورهم ويتحركون في خط الضلالة والباطل والانحراف.
وعبارة «بغير الحقّ» هي في الواقع قيد توضيحي لأنّ العظمة والكبرياء مختصان بالله تعالى وقدرته المطلقة ، وأمّا بالنسبة للإنسان الّذي ليس سوى ذرّة صغيرة من ذرات عالم الوجود الواسع ، فإنّ رداء العظمة والكبرياء بالنسبة له ليس حقّاً وليس من حقّه أن يرتدي هذا الرداء.
بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ هذا القيد هو قيدٌ احترازي وقالوا : إنّ التكبّر على قسمين : تكبّر في مقابل أولياء الله فهو (بغير الحقّ) وفي مقابل ذلك التكبّر في مقابل أعداء الله وهو (بالحقّ) ولكن مع الالتفات إلى جملة (يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ) يتّضح جيداً أنّ هذا التفسير غير منسجم مع سياق الآية لأنّ التكبّر في الأرض وفي مقابل البشر جميعاً هو خلقٌ مذموم وقبيح بصورة مطلقة.
وعلى أيّة حال فإنّ الآية الشريفة تشير في سياقها إلى أهم آثار وعواقب التكبّر الوخيمة ، وهي أنّ مثل هذا الإنسان لا يذعن أمام آيات الحقّ ولا يؤمن بها بل على العكس من ذلك ، فإنّه وبسبب هذه الصفة الذميمة سيدخل أبواب الضلالة ، ويسلك سبيل الغي لدى مشاهدته فوراً.
أجل فإنّ صفة الكبر والغرور تمثل حجاباً على قلب الإنسان وروحه ممّا يتسبّب أن يرى الحقّ باطلاً والباطل حقّاً ، وبذلك يحجب عن الإنسان أبواب السعادة والنجاة ويفتح له أبواب الضلالة وعلى أساس أنّها أبواب السعادة ، فما أعظم شقاء الإنسان الّذي لا يرى علائم الحقّ ويتغافل عنها ويسلك طريق الضلالة والزيغ والانحراف ويتصور أنّ هذا المسير هو الّذي يؤدي به إلى السعادة والنجاة!!
«الآية الثانية عشر» تقول : (لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ)([33]).
وقد ورد ما يشبه هذا المعنى في القرآن الكريم مرّات عديدة من قبيل قوله :
(وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)([34]).
(وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)([35])
(إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)([36])
(إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)([37])
(إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ)([38])
(إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)([39])
ويقول في الآية محل البحث : (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ).
إنّ التدقيق في مثل هذه العبارات يوضح وجود رابطه خاصة بين هذه الامور المذكورة في هذه الآيات ، بحيث يمكن القول أنّ القدر المشترك بين الصفات الرذيلة في هذه الآيات السبعة المذكورة آنفاً هو حبّ الذات والغرور والعجب أو التكبّر الّذي يعد منبعاً للظلم والفساد والإسراف والفخر على الآخرين.
وهنا تقول الآية : إنّ الله تعالى لا يحب أيّاً من هذه الطوائف السبعة ، ومفهومها أنّ من يتصف بهذه الصفات ويكون مصداقاً لأحد هذه الطوائف فإنّه مطرود من ساحة الربوبية والرحمة الإلهية الواسعة ، لأنّه متصف بأخطر الرذائل الأخلاقية ، وهي التكبّر المانع من القرب إلى الله تعالى.
«الآية الثالثة عشر» من الآيات محل البحث وكما ورد في الروايات في شأن نزولها أنّها تتحدّث عن طائفة من نصارى نجران وتقول : «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً» ([40]).
وتقول الآية الّتي تليها مؤكدة على أصل مهم ومصيري في حياة الإنسان والمجتمع البشري : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً)([41]).
هذه الآيات ناظرة إلى دعوى واهية لطائفة من النصارى الّذين ذهبوا إلى إلوهية المسيح وتصوّروا أنّهم لو أنزلوا المسيح من هذا المقام وأنّه عبد الله فإنّ ذلك سيكون هتكاً لحرمته وإهانة لساحته ومقامه السامي.
وأمّا القرآن فيقول لهم أنّه ليس المسيح ولا أي واحد من الملائكة أو من المقرّبين له هذا المقام، ولا يتصوّر أحد منهم ذلك بل يرون أنفسهم عباد الله ويذعنون أمام هذه الحقيقة الناصعة ، ويأتون بطقوس العبودية له ، ثمّ يذكر القرآن أصلاً كليّاً ويقول : إذا تحرّك أي واحد من المخلوقين حتّى الأنبياء الإلهيين أو الملائكة المقرّبين مبتعداً عن خط العبودية ومتلبساً بلباس الاستكبار أمام الحقّ تعالى واستنكف عن عبادته وتكبر فإنّه سوف لا يستطيع انقاذ نفسه من العذاب الإلهي ولا يستطيع أحد انقاذه من خالق العقاب الأليم المقرّر له.
والملفت للنظر أنّ الآية الأخيرة تقرّر أنّ الإيمان والعمل الصالح يقعان في النقطة المقابلة ، للاستكبار والأنانية ورؤية الذات أعلى من الواقع ، وبالتالي يمكننا أن نستوحي منها هذه النتيجة ، وهي أنّ من يسلك طريق الاستكبار وينطلق في فكره وسلوكه من موقع التكبّر فليس له إيمان حقيقي ولا عمل صالح.
«الاستنكاف» في الأصل من مادّة «نكف» على وزن «نصر» وهي في الأصل بمعنى مسح قطرات الدموع على الوجه بالأصابع ، وعليه فيكون الاستنكاف من عبودية الله تعالى يعني الابتعاد عنه وذلك بسبب أحد العوامل المختلفة من قبيل الجهل أو الكسل وحب الراحة وغير ذلك ، ولكن عند ما وردت جملة (اسْتَكْبَرُوا) بعد هذه العبارة فإنّ ذلك يشير إلى الاستنكاف الّذي يقع من موقع الكبر والغرور ويكون معلولاً لهما ، وبذلك يكون ذكر هذه الجملة بعد تلك العبارة في الواقع إشارة إلى هذه النكتة الدقيقة.
وعلى أيّة حال فإنّ التعبيرات المثيرة في هذه الآيات تدلّ على أهمية هذه المسألة وأنّ هذه الصفة الذميمة وهي الاستكبار تنتج هذه العواقب الوخيمة لدى كلّ إنسان يتصف بها.
وفي «الآية الرابعة عشر» والأخيرة من الآيات محل البحث نقرأ نتيجة اخرى من النتائج الخطيرة والأليمة المترتبة على حالة الاستكبار حيث تقول الآية : (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)([42]).
ففي هذه الآية الشريفة ورد أوّلاً (التكذيب بآيات الله) إلى جانب (الاستكبار) وكما ذكرنا سابقاً أنّ أحد العلل المهمّة لإنكار آيات الله والتصدي لدعوة الأنبياء هي حالة الاستكبار الّتي يعيشها الأقوام البشرية ، فأحياناً كانوا يقولون : ما هو امتياز هذا النبي عنا؟ ولما ذا نزلت عليه آيات الله دوننا؟ ويقولون أحياناً اخرى : إن الاراذل والفقراء من الناس التفوا حوله ونحن أعلى شاناً من أن نكون كأحدهم ، ولو أنّ هذا النبي قد طرد هؤلاء المؤمنين به من حوله فسوف يفسح لنا المجال للدخول في مجلسه والمشاركة في الاستماع لكلماته ومواعظه ، وهكذا من خلال هذه التبريرات والذرائع الواهية كانوا يعرضون عن الإيمان بالله والتحرّك في خط المسؤولية.
عبارة : (وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) والّتي وردت في القرآن الكريم في هذه الآية فقط هي تأكيد واضح على عظمة هذه الخطيئة وهذا الاتصاف السلبي والخطير في حركة الإنسان في الحياة ، أي كما أنّ عبور الجمل (أو طبقاً لتفسير آخر : الحبل الضخم) غير ممكن ومستحيل من ثقب إبرة فإنّ دخول المتكبّرين إلى الجنّة والنعيم الإلهي محال أيضاً ، ولعلّ ذلك يشير إلى أنّ طريق الجنّة إلى درجة من الدقّة بحيث يشبه ثقب الإبرة ولا يمر من خلاله إلّا من تحلّى بصفة التواضع ورأى نفسه من واقع حاله.
وجملة : (لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ) هي إشارة إلى ما ورد في الأحاديث الإسلامية أيضاً ، وهو أنّ المؤمنين عند ما ينتقلون من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الاخرى أنّ روحهم وأعمالهم تصعد إلى السماء وتفتح لهم أبواب السماء ويستقبلهم الملائكة ، ولكن عند ما يصعد بروح الكفّار والمتكبّرين وأعمالهم إلى السماء فسوف توصد أبواب السماء أمامهم ويناد المنادي أنّه أذهبوا بها إلى جهنم وبئس المصير.
النتيجة النهائية :
ونستنتج من مفهوم الآيات المذكورة آنفاً أنّ القرآن الكريم يعتبر(التكبّر والاستكبار) من أقبح الصفات والأعمال على مستوى السلوك البشري ، وأنّ هذه الصفة الذميمة يمكنها أن تكون مصدراً للكثير من الذنوب العظيمة وحتّى أنّها قد تورث الإنسان حالة الكفر بالله تعالى ، والأشخاص الّذين يعيشون هذه الحالة لا يتسنّى لهم إدراك معنى السعادة الحقيقية والطريق إلى مرتبة القرب الإلهي موصد أمامهم ، وعليه فإنّ على السالكين طريق الحقّ لا بدّ لهم قبل كلّ شيء من تطهير أنفسهم وقلوبهم من تلوثات هذه الصفة الأخلاقية القبيحة بأن لا يروا لأنفسهم تفوّقاً في وجودهم على الآخرين ولا ينطلقوا في تعاملهم مع الناس من موقع التكبّر والأنانية ، فإنّ هذه الحالة من أكبر موانع الوصول إلى الله تعالى والقرب المعنوي من الكمال المطلق.
[1] سورة البقرة ، الآية 34.
[2] سورة الأعراف ، الآية 13.
[3] سورة نوح ، الآية 7.
[4] سورة فصلت ، الآية 15.
[5] سورة الأعراف ، الآية 88.
[6] سورة العنكبوت ، الآية 39.
[7] سورة المائدة ، الآية 82.
[8] سورة المدثر ، الآية 22 ـ 24.
[9] سورة المؤمن ، الآية 35.
[10] سورة الزمر ، الآية 72.
[11] سورة الأعراف ، الآية 146.
[12] سورة النحل ، الآية 23.
[13] سورة الأعراف ، الآية 40.
[14] سورة البقرة ، الآية 34.
[15] سورة الأعراف ، الآية 13.
[16] نهج البلاغة ، الخطبة 192.
[17] سورة البقرة ، الآية 34.
[18] سورة الحجر ، الآية 33.
[19] سورة الحجر ، الآية 29.
[20] سورة الأعراف ، الآية 12.
[21] نهج البلاغة ، الخطبة 192.
[22] المصدر السابق.
[23] سورة نوح ، الآية 7.
[24] سورة هود ، الآية 38.
[25] سورة فصلت ، الآية 15.
[26] سورة الأعراف ، الآية 88.
[27] سورة العنكبوت ، الآية 39.
[28] سورة المائدة ، الآية 82.
[29] سورة المدثر ، الآية 22 ـ 24.
[30] سورة المؤمن ، الآية 35.
[31] سورة الزمر ، الآية 72.
[32] سورة الأعراف ، الآية 146.
[33] سورة النحل ، الآية 23.
[34] سورة آل عمران ، الآية 140.
[35] سورة المائدة ، الآية 64.
[36] سورة المائدة ، الآية 87.
[37] سورة الأنعام ، الآية 141.
[38] سورة الأنفال ، الآية 58.
[39] سورة القصص ، الآية 76.
[40] سورة النساء ، الآية 172.
[41] سورة النساء ، الآية 173.
[42] سورة الأعراف ، الآية 40.



|
|
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|