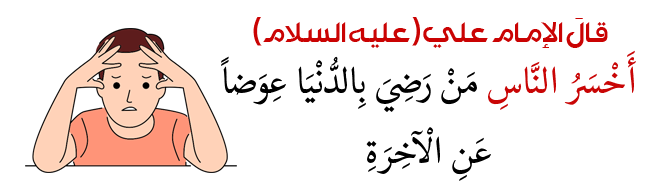
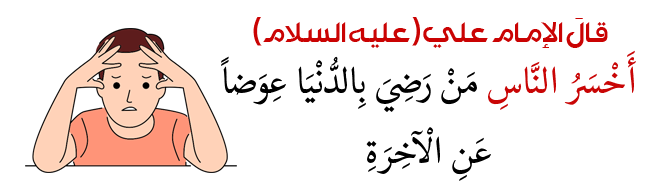

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-27
التاريخ: 12-2-2021
التاريخ: 11-6-2022
التاريخ: 30-3-2021
|
«الميل» جاذب داخليّ في الإنسان، فهو يجذب الإنسان ويشدّه نحو الأشياء الخارجيّة؛ فالجائع يشعر داخليّاً بالميل والرغبة في الطعام، فهذا الميل قوّة جاذبة، تجذب الإنسان إلى الطعام، أو قل: إنّ في الغذاء قوّةً تجذب الإنسان إليه. وبتعبير أوضح، يمكن القول: إنَّ «الميل» هو الرابط بين الإنسان والعالَم الخارجيّ.
حين يجوع الإنسان أو الحيوان، فإنّه يميل تلقائيّاً للأطعمة، وحين يعطش يميل للمشروبات، ومن حيث الغريزة الجنسيّة -أيضاً- يميل للجنس الآخر، وحين يتعب يرغب في الراحة. فهذه الميول كلّها تُحرّك الإنسان لتحصيل شيء ما، حتّى عاطفة الأمومة والعواطف الإنسانيّة -أيضاً- هي ميول؛ لذلك نرى الإنسان إذا صادف ورأى فقيراً، يميل لمدّ يد المساعدة والنجدة إليه، هذا ما يرجع إلى «الميل».
أمّا «الإرادة»، فهي تتعلّق بذات «المريد» وباطنه، ولا تمثّل علاقة جذب بينه وبين العالَم الخارجيّ؛ فالإنسان حين يُفكّر في موضوع ما، ويضع حساباته حوله، وينظر بعيداً لرؤية العواقب المترتّبة على خطواته، ومن ثمّ يقارن بين المصالح والمفاسد بواسطة عقله، ويقايس بينها، يستطيع -عندئذٍ- تشخيص الخطوة الأصلح والأفضل، ثمّ يعمل ويأتمر بما يُمليه عليه العقل، ولا يتمكّن «الميل» من جذبه وجرّه إليه.
نحن نرى في كثير من الأوقات، أنّ إرادة الإنسان تتعلّق بما يدرك العقل مصلحته، ومن ثمّ ينجزه استناداً إلى فتواه، وإن كان ذلك ضدّ «الميل» النفسيّ الموجود لديه؛ فمَن يتّبع نظاماً غذائيّاً خاصّاً مثلاً، تدعوه شهوته لتناول الأطعمة اللذيذة والأطباق الشهيّة الموضوعة أمامه على المائدة، وبما أنّ هذا الإقدام يضرّه، فإنَّنا نرى العقل يردعه ويقول له: إن أكلتَ هذا الطعام، فستنتابك عوارض مؤلمة، وستقع فريسة سهلة للمرض؛ فإن كان عاقلاً، ترك ميله واتّبع عقله.
ومثل ذلك -أيضاً- ما يحدث للمريض؛ إذ إنّ طبعه ينفر من الدواء، فهو ليس فقط لا «ميل» لديه نحوه، بل إنّه يشعر بالتقزّز منه، لكنّه حينما يُفكّر ويرجع إلى عقله، يجده يقول له: سلامتُك وعافيتُك تُوجِبان عليك أن تتناول الدواء، وإن كان مرّاً. وبناءً على حكم العقل هذا، يُصمّم المريض على تناوُل الدواء، وإنْ خالف ذلك ميلَه النفسيّ. «الخوف» خلاف «الميل»، فإنّه يعني النفور والفرار، لكنّ «الإرادة» تقاوم هذا الخوف وتنفخ في القلب روح الشجاعة.
إلى هنا، اتّضح أنّ معنى «الإرادة» هو: وضع الميول النفسيّة المرغوب فيها وعنها تحت نظام مراقبة صارم، بحيث تكون في خدمة «المصلحة» وما يحكم به العقل. وعلى هذا، يكون مؤدَّى هذه النظريّة أنّ «الأخلاق» تعني انبثاق الفعل من «المصلحة» و«الإرادة»، وليس من أحد الميول المتسلّطة.
العاطفة الإنسانيّة كذلك؛ أي إنّ حدودها يجب أن تكون ضمن حدود العقل، وبِيَدِه تعيينها، لا أن تُترَك بلا رقيب. في كثير من الموارد، تُصدِر العاطفة حُكماً معيّناً، والعقل يُصدِر حُكماً مغايراً. العاطفة تعني رقَّة القلب والإحساس بالرأفة، لكن لا ينبغي الانسياق وراءها، بل يجب جعل العقل والإرادة حاكمَين عليها، وقد صرَّح القرآن الكريم بهذا في الآية المتعلّقة بالزاني، يقول تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِد مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَة فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَة مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾[1].
القرآن في هذه الآية، يريد لفت نظر المخاطَب لقضيَّة، وهي أنّ المؤمنين حينما يريدون معاقبة أحد الجناة، ترقّ قلوب كثير من الأفراد، رأفةً به وحنوّاً عليه، ويقولون: حبّذا لو عُفِيَ عنه وصُرِفَ النظر عن معاقبته، وهذا إحساسٌ آنيّ، إلّا أنّ صاحب هذا الإحساس يغيب عن باله أمرٌ آخر، وهو أنّه إذا كان الغرض العفو عن كلّ جانٍ ومجرم، فإنّ هذا سيؤدّي إلى حدوث جناية تلو الأخرى، وستأخذ الجرائم بِيَد بعضها، حتّى تطوّق المجتمع وتخنقه. إنّ العاطفة تقول: لا تعاقِب، والعقل والمصلحة يقولان: عاقِب؛ فـ«العاطفة» في مثل هذه الموارد لا تُعَدّ «محبَّة»، بل هي في ذاتها ليست كذلك، لكن لبُعدها عن المنطق والفكر السليم، تمسك يد الإنسان، وتقول له: لا تقم بهذا العمل. أمّا العقل والمصلحة، فيجيزان له الاستعانة بالعنف، ويقولان للعاطفة: أنتِ قصيرة النظر، ولا ترين المستقبل البعيد إذ تُصدِرين حكمك بالكفّ. وعليه، فإذا رأيتم العدالة الإلهيّة تأخذ مجراها المقرَّر لأجل المصلحة البشريّة العامّة، فلا تذهب أنفسُكم حسرات، ولا تأخذكم الرحمة والرأفة، يقول «سعدي»:
الرحمة بالنمر ظلمٌ للأغنام
الرحمة والرأفة بالنمر، بلحاظ العاطفة، وبصرف النظر عن المنطقة والمصلحة والعقل، عملٌ خاطئ. أجل، لو لم يكن في الدنيا غير هذا النمر، لكان ذلك عملاً صائباً، لكنّ الأمر ليس كذلك؛ فالإنسان حينما يفتح عينَيه، يرى أنّ الدنيا أوسع أُفُقاً من مجرّد «نمر»، وسيفهم أنّ الرأفة به تساوي القسوة على مئات «الأغنام» البريئة. العاطفة -طبعاً- لا تدرك هذه المساواة، لكنّ العقل والمصلحة -إذ يقيسان الأمور وينظران المصالح والمفاسد- يريان من خلف العاطفةِ القسوةَ الكامنةَ في الشفقة على الحيوان المفترس؛ ولذلك يَحُولان دون العمل وفقها.
وما يقوله «العاطفيّون» حول جلد الزاني، يَرِد أيضاً على قطع يد السارق، فيُقال: قطعُ يد السارق قسوةٌ ووحشيّة، وعملٌ يندى له جبين الإنسانيّة! فهؤلاء لا يرون أبعد من مواطئ أقدامهم، ولا يدركون أنّ تنفيذ القانون وقطع يد السارق كفيل باجتثاث السرقة من أصولها، وتخليص المجتمع منها. وما نراه اليوم من انتشار السرقات والجرائم الّتي تترافق مع قتل النفوس وفقدان الأمن، إنّما هو من جملة آثار تعطيل هذا القانون الإلهيّ.
على هذا الأساس، ترى هذه النظريّة أنّ معيار «الأخلاقيّة» ومِلاكها هما: «العقل» و«الإرادة»، دون «العاطفة»، وعلى هذه أن تأتمر بأوامرهما وتستنير بهديهما. ولو أطلقنا سراح «العاطفة» وأوكلنا إليها القيادة، لانقلبت الآية، ولارتدَت الأعمالُ «غير الأخلاقيّة» لباسَ «الأعمال الأخلاقيّة»، وتسمَّت باسمها.
ومن المسائل المُسَلَّمة والمعتمَدة لدى علماء الإسلام وفلاسفته، هي مسألة اعتماد الأخلاق واتّكائها على قوّة العقل ووعي الإرادة. فالأخلاق الكاملة -بنظرهم- هي الأخلاق المستندة إلى العقل، حيث تكون الميول الفرديّة والنوعيّة منضوية تحت مظلّة العقل والإرادة. فـ «الإنسان ذو الخُلُق الكامل» هو مَن يكون العقل والإرادة حاكمَين على وجوده وسلوكه، ومهيمنَين على نزعاته وميوله.
طبعاً، توجد في أعماق الإنسان عواطف جيّاشة غير فرديّة، وهي بمثابة منابع دافئة تغمر وجود الإنسان، وبإرشادات العقل ومعونة الإرادة، تُوظَّف هذه العواطف لِما فيه المصلحة الحقيقيّة. مثلُ هذا الإنسان الكامل، تكون ردود فعله غاية في الرقّة والعطف والنبل، ولو قُدِّر لنا رؤيةُ روحِه، لوجدناها أنعم مِن خميلة[2] الورد، وألطف من نسيم السحر. إلّا أنّ هذه الرقّة لا تمنعه من العنف والبأس إذا لزم الأمر؛ إذ لديه الشدّة ما لا تبلغه الجبال الرواسي، ويمتلك من قوّة القلب ما تخوّله لقطف مئة من الرؤوس دفعة واحدة، كما لو أنّها رؤوس أغنام أو ما هو أهوَن منها، من دون أن يضطرب له قلب، أو يقشعرّ له بدن، أو تطرف له عين. هذا النمط نراه -برؤيته لمشهدٍ ما- ترتعد فرائصه، وتأخذه رجفة تُفقِده السيطرة. ومن أظهر مصاديق هذا النمط من البشر، هو عليّ بن أبي طالب (عليه السلام).
الحاصل أنّ العاطفة عمياء لا عيون لها، وبلهاء لا منطق لديها، والإنسان المنقاد لها، الواضع نفسه في خدمتها، ستدلُّه على بيت الخراب حتماً ودائماً، في الموارد الحسنة والقبيحة على حدّ سواء. وبخلاف ذلك، مَن يضع عواطفه تحت تصرُّف عقله وإرادته؛ إذ تكون روحُه مظهراً للّطافة والرقّة والعظمة في حال، ومظهراً للقوّة والبأس في حال آخر، حسبما يقتضيه الموقف وتتطلّبه الظروف. وهذا هو الإنسان الكامل في الإسلام.
نحن إذ نقول إنّ هذه نظريّة فلاسفة المسلمين، لا يعني هذا أنّ نظريّة الإسلام هي هذه قطعاً؛ لأنّ الفلاسفة المسلمين ليس باستطاعتهم الإحاطة بواقع المسائل الإسلاميّة كلّها. نعم، هم كشفوا بعضاً من الحقيقة، وجانباً منها.



|
|
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
|
|
اختتام المراسم التأبينية التي أهدي ثوابها إلى أرواح شهداء المق*ا*و*مة
|
|
|