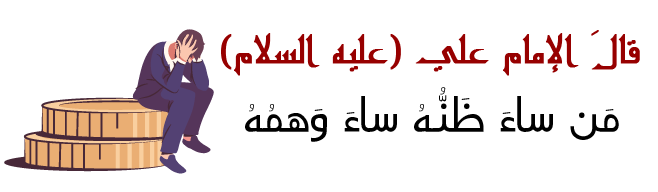
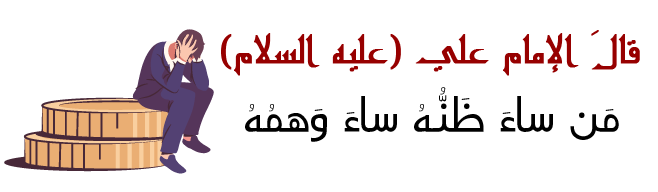

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2017
التاريخ: 17-10-2017
التاريخ: 20-10-2017
التاريخ: 28-2-2017
|
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [المائدة : 67] .
أمر سبحانه نبيه بالتبليغ ، ووعده العصمة والنصرة ، فقال {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ} ، وهذا نداء تشريف وتعظيم {بَلِّغْ} أي : أوصل إليهم {مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} . أكثر المفسرون فيه الأقاويل فقيل : إن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة ضاق بها ذرعا ، وكان يهاب قريشا ، فأزال الله بهذه الآية تلك الهيبة ، عن الحسن . وقيل يريد به إزالة التوهم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الوحي للتقية ، عن عائشة . وقيل غير ذلك .
وروى العياشي في تفسيره بإسناده عن ابن عمير ، عن ابن أذينة ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، قالا : أمر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصب عليا عليه السلام للناس ، فيخبرهم بولايته ، فتخوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا : حابى ابن عمه ، وأن يطعنوا في ذلك عليه ، فأوحى الله إليه هذه الآية ، فقام بولايته يوم غدير خم وهذا الخبر بعينه قد حدثناه السيد أبو الحمد ، عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني ، بإسناده عن ابن أبي عمير في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل . وفيه أيضا بالإسناد المرفوع إلى حيان بن علي الغنوي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في علي عليه السلام ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده عليه السلام ، فقال : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " . وقد أورد هذا الخبر بعينه أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره بإسناده مرفوعا إلى ابن عباس ، قال : نزلت هذه الآية في علي عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ فيه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي عليه السلام ، فقال : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخلف عليا عليه السلام ، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره الله بأدائه .
والمعنى : إن تركت تبليغ ما أنزل إليك ، وكتمته ، كنت كأنك لم تبلغ شيئا من رسالات ربك في استحقاق العقوبة . وقال ابن عباس : معناه إن كتمت آية مما أنزل إليك فما بلغت رسالته أي : لم تكن ممتثلا بجميع الأمر {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} أي : يمنعك من أن ينالوك بسوء {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} قيل فيه قولان أحدهما : إن معنى الهداية هنا أنه سبحانه لا يهديهم بالمعونة ، والتوفيق ، والألطاف إلى الكفر ، بل إنما يهديهم إلى الإيمان ، لان من هداه إلى غرضه ، فقد أعانه على بلوغه عن علي بن عيسى ، قال : ولا يجوز أن يكون المراد لا يهديهم إلى الإيمان ، لأنه تعالى هداهم إلى الإيمان ، بأن دلهم عليه ، ورغبهم فيه ، وحذرهم من خلافه والآخر إن المراد لا يهديهم إلى الجنة والثواب ، عن الجبائي .
وفي هذه الآية دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحة نبوته من وجهين أحدهما : انه وقع مخبره على ما أخبر به فيه وفي نظائره ، فدل ذلك على أنه من عند عالم الغيوب والسرائر . والثاني : انه لا يقدم على الإخبار بذلك إلا وهو يأمن أن يكون مخبره على ما أخبر به ، لأنه لا داعي له إلى ذلك إلا الصدق . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لما نزلت هذه الآية ، قال لحراس من أصحابه ، كانوا يحرسونه ، منهم سعد وحذيفة : الحقوا بملاحقكم ، فإن الله تعالى عصمني من الناس .
_____________________________
1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 382-383 .
يدل ظاهر الآية على ان هناك أمرا هاما نزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد أمره اللَّه بتبليغه إلى الناس ، فضاق النبي به ذرعا ، لأنه ثقيل على أنفسهم ، فتريث يتحين الظروف والمناسبات تجنبا للاصطدام مع المنحرفين . . ولكن اللَّه سبحانه حثه على التبليغ حالا ، ودون أن يحسب حسابا لأي اعتبار ، واللَّه سبحانه يتولى حمايته وعصمته من كل مكروه .
وتسأل إن قوله تعالى {وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ} لا يفيد شيئا يحسن السكوت عليه ، حيث جعل جواب الشرط عين فعله ، تماما مثل قول القائل :
إن لم تفعل فما فعلت ، وإن لم تبلغ فما بلغت . . فما هو الوجه ؟
الجواب : إن قوله تعالى : { فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ } يشعر بأن هذا الأمر الذي تريث النبي ( صلى الله عليه وآله ) في تبليغه خوفا من الناس قد بلغ من الأهمية حدا يوازي تبليغه تبليغ الرسالة كلها ، بحيث إذا ترك تبليغه فكأنما ترك تبليغ جميع الأحكام ، تماما كما تقول لمن كان قد أحسن إليك : إذا لم تفعل هذا فما أنت بمحسن إليّ إطلاقا ، وعليه يكون المعنى إن لم تبلغ هذا الأمر فكأنك لم تؤد شيئا من رسالتي ، وجازيتك جزاء من كتم جميع أحكامها .
سؤال ثان : ما هو هذا الأمر الذي بلغ من العظمة هذا المبلغ ، حتى أناط اللَّه تبليغ الرسالة جميعا بتبليغه ، وجعل الرسول يتوقف أو يتربث في تبليغه ، وهو الحريص على أن يصدع بأمر اللَّه مهما كانت النتائج ؟
الجواب : بعد أن اتفق المفسرون الشيعة منهم والسنة على تفسير الآية بالمعنى الذي ذكرناه ، بعد أن اتفقوا على هذا اختلفوا في تعيين هذا الأمر الذي تريث النبي ( صلى الله عليه وآله ) في تبليغه ، والذي لم يذكره اللَّه صراحة .
قال الشيعة : إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب ، وان هذا الأمر الهام هو ولايته على الناس ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) تريث في التبليغ لا خوفا على نفسه ، كلا ، فلقد جابه صناديد قريش بما هو أعظم ، فسفه أحلامهم ، وسب آلهتهم ، وعاب أمواتهم ، وهم الأشداء الأقوياء ، وأهل العصبية الجاهلية . . أقدم النبي على هذا ، ولم يخش فيه لومة لائم يوم لا حول للإسلام ولا طول ، فكيف يخشى من تبليغ حكم من الأحكام بعد أن أصبح في حصن حصين من جيش الإسلام ومناعته ؟ وإنما خاف النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا نص على علي بالخلافة أن يتهم بالمحاباة والتحيز لصهره وابن عمه ، وأن يتخذ المنافقون والكافرون من هذا النص مادة للدعاية ضد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والتشكيك في نبوته وعصمته . . وبديهة ان مثل هذه الدعاية يتقبلها البسطاء والسذج .
هذا ملخص ما قاله الشيعة ، واستدلوا عليه بأحاديث رواها السنة في ذلك ، ونقل بعضها الرازي وصاحب تفسير المنار .
أما السنة فقد اختلفوا فيما بينهم ، فمن قائل : إن النبي سكت عن بعض الأحكام التي تتعلق باليهود ، ومن قائل : إن الحكم الذي سكت النبي عنه يتصل بقصة زيد وزينب بنت جحش ، وقال جماعة من السنة ان الآية نزلت في فضل علي بن أبي طالب ، لا في خلافته ، ونقل هذا القول الرازي وصاحب تفسير المنار .
قال الرازي : « العاشر - أي القول العاشر - : نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب ، ولما نزلت هذه الآية أخذ النبي بيد علي ، وقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر فقال : هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي » .
صاحب المنار وأهل البيت :
وقال صاحب تفسير المنار : « أما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد رواه أحمد في مسنده ، والترمذي ، والنسائي ، والضياء في المختار ، وابن ماجة ، وحسّنه بعضهم ، وصححه الذهبي بهذا اللفظ ، ووثّق سند من زاد فيه : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ » ، وفي رواية انه خطب الناس ، فذكر أصول الدين ، ووصى بأهل بيته ، فقال : « إني قد تركت فيكم الثّقلين : كتاب اللَّه ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، اللَّه مولاي ، وأنا ولي كل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي وقال - الحديث - أي من كنت مولاه فعلي مولاه .
ثم أطال صاحب تفسير المنار الكلام ، وقال فيما قال : المراد بالولاية في الحديث ولاية النصرة والمودة (2) . . ولكنه أتبع هذا التفسير بقوله : « إن مثل هذا الجدل فرق بين المسلمين ، وأوقع بينهم العداوة والبغضاء ، وما دامت عصبية المذاهب غالبة على الجماهير فلا رجاء في تحريهم الحق في مسائل الخلاف » . هذا صحيح يقره كل عاقل ، ولو لا التعصب للباطل لم يقع الخلاف بين المسلمين ، وعلى افتراض حصوله فإنه لا يستمر هذا الأمد الطويل ، ولم تؤلف عشرات الكتب في مسألة واحدة .
ثم قال صاحب تفسير المنار : « أما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فنحن نهتدي به ، ونوالي عليا المرتضى ، ونوالي من والاهم ، ونعادي من عاداهم ، ونعد ذلك كموالاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ، ونؤمن بأن عترته ( صلى الله عليه وآله ) لا تجتمع على مفارقة الكتاب الذي أنزله اللَّه عليه ، وأن الكتاب والعترة خليفتا الرسول ، فقد صح الحديث بذلك في غير قصة الغدير ، فإذا أجمعوا على أمر قبلناه واتبعناه ، وإذا تنازعوا في أمر رددناه إلى اللَّه والرسول » .
_________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 96-99 .
2. انظر تفسير الآية 55 من هذه السورة .
معنى الآية في نفسها ظاهر فإنها تتضمن أمر الرسول صلى الله عليه وآله بالتبليغ في صورة التهديد ، ووعده صلى الله عليه وآله بالعصمة من الناس ، غير أن التدبر في الآية من حيث وقوعها موقعها الذي وقعت فيه ، وقد حففتها الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب وذمهم وتوبيخهم بما كانوا يتعاورونه من أقسام التعدي إلى محارم الله والكفر بآياته. وقد اتصلت بها من جانبيها الآيتان ، أعني قوله : {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} (الآية) ، وقوله تعالى : {قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} (الآية).
ثم الإمعان في التدبر في نفس الآية وارتباط الجمل المنضودة فيها يزيد الإنسان عجبا على عجب.
فلو كانت الآية متصلة بما قبلها وما بعدها في سياق واحد في أمر أهل الكتاب لكان محصلها أمر النبي صلى الله عليه وآله أشد الأمر بتبليغ ما أنزله الله سبحانه في أمر أهل الكتاب ، وتعين بحسب السياق أن المراد بما أنزل إليه من ربه هو ما يأمره بتبليغه في قوله : { قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } (الآية) .
وسياق الآية يأباه فإن قوله : {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} يدل على أن هذا الحكم المنزل المأمور بتبليغه أمر مهم فيه مخافة الخطر على نفس النبي صلى الله عليه وآله أو على دين الله تعالى من حيث نجاح تبليغه ، ولم يكن من شأن اليهود ولا النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وآله أن يتوجه إليه من ناحيتهم خطر يسوغ له صلى الله عليه وآله أن يمسك عن التبليغ أو يؤخره إلى حين فيبلغ الأمر إلى حيث يحتاج إلى أن يعده الله بالعصمة منهم إن بلغ ما أمر به فيهم حتى في أوائل هجرته صلى الله عليه وآله إلى المدينة وعنده حدة اليهود وشدتهم حتى انتهى إلى وقائع خيبر وغيرها .
على أن الآية لا تتضمن أمرا شديدا ولا قولا حادا ، وقد تقدم عليه تبليغ ما هو أشد وأحد وأمر من ذلك على اليهود ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ ما هو أشد من ذلك كتبليغ التوحيد ونفي الوثنية إلى كفار قريش ومشركي العرب وهم أغلظ جانبا وأشد بطشا وأسفك للدماء ، وأفتك من اليهود وسائر أهل الكتاب ، ولم يهدده الله في أمر تبليغهم ولا آمنه بالعصمة منهم .
على أن الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب معظم أجزاء سورة المائدة فهي نازلة فيها قطعا ، واليهود كانت عند نزول هذه السورة قد كسرت سورتهم ، وخمدت نيرانهم ، وشملتهم السخطة واللعنة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فلا معنى لخوف رسول الله صلى الله عليه وآله منهم في دين الله ، وقد دخلوا يومئذ في السلم في حظيرة الإسلام وقبلوا هم والنصارى الجزية ، ولا معنى لتقريره تعالى له خوفه منهم واضطرابه في تبليغ أمر الله إليهم ، وهو أمر قد بلغ إليهم ما هو أعظم منه ، وقد وقف قبل هذا الموقف فيما هو أهول منه وأوحش .
فلا ينبغي الارتياب في أن الآية لا تشارك الآيات السابقة عليها واللاحقة لها في سياقها ، ولا تتصل بها في سردها ، وإنما هي آية مفردة نزلت وحدها .
والآية تكشف عن أمر قد أنزل على النبي صلى الله عليه وآله (إما مجموع الدين أو بعض أجزائه) وكان النبي صلى الله عليه وآله يخاف الناس من تبليغه ويؤخره إلى حين يناسبه ، ولو لا مخافته وإمساكه لم يحتج إلى تهديده بقوله : { وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ } كما وقع في آيات أول البعثة الخالية عن التهديد كقوله تعالى : { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } إلى آخر سورة العلق ، وقوله : { يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ } : [المدثر : 2] ، وقوله : (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ) : [حم السجدة : 6] ، إلى غير ذلك.
فهو صلى الله عليه وآله كان يخافهم ولم يكن مخافته من نفسه في جنب الله سبحانه فهو أجل من أن يستنكف عن تفدية نفسه أو يبخل في شيء من أمر الله بمهجته فهذا شيء تكذبه سيرته الشريفة ومظاهر حياته ، على أن الله شهد في رسله على خلاف ذلك كما قال تعالى : { ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً } : [الأحزاب : 39] وقد قال تعالى في أمثال هذه الفروض : { فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } : [آل عمران ـ 175] ، وقد مدح الله سبحانه طائفة من عباده بأنهم لم يخشوا الناس في عين أن الناس خوفوهم فقال : {الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} : [آل عمران : 173] .
وليس من الجائز أن يقال : إنه صلى الله عليه وآله كان يخاف على نفسه أن يقتلوه فيبطل بذلك أثر الدعوة وينقطع دابرها فكان يعوقه إلى حين ليس فيه هذه المفسدة فإن الله سبحانه يقول له صلى الله عليه وآله : { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ } : آل عمران : 128 ، لم يكن الله سبحانه يعجزه لو قتلوا النبي صلى الله عليه وآله أن يحيي دعوته بأي وسيلة من الوسائل شاء ، وبأي سبب أراد.
نعم من الممكن أن يقدر لمعنى قوله : { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يخاف الناس في أمر تبليغه أن يتهموه بما يفسد به الدعوة فسادا لا تنجح معه أبدا فقد كان أمثال هذا الرأي والاجتهاد جائزا له مأذونا فيه من دون أن يرجع معنى الخوف إلى نفسه بشيء.
ومن هنا يظهر أن الآية لم تنزل في بدء البعثة كما يراه بعض المفسرين إذ لا معنى حينئذ لقوله تعالى : { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يماطل في إنجاز التبليغ خوفا من الناس على نفسه أن يقتلوه فيحرم الحياة أو أن يقتلوه ويذهب التبليغ باطلا لا أثر له فإن ذلك كله لا سبيل إلى احتماله.
على أن المراد بما أنزل إليه من ربه لو كان أصل الدين أو مجموعة في الآية عاد معنى قوله : { وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ } إلى نحو قولنا : يا أيها الرسول بلغ الدين وإن لم تبلغ الدين فما بلغت الدين .
وأما جعله من قبيل قول أبي النجم :
أنا أبو النجم وشعري شعري.
كما ذكره بعضهم أن معنى الآية : وإن لم تبلغ الرسالة فقد لزمك شناعة القصور في التبليغ والإهمال في المسارعة إلى ايتمار ما أمرك به الله سبحانه ، وأكده عليك كما أن معنى قول أبي النجم : إني أنا أبو النجم وشعري شعري المعروف بالبلاغة المشهور بالبراعة.
فإن ذلك فاسد لأن هذه الصناعة الكلامية إنما تصح في موارد العام والخاص والمطلق والمقيد ونظائر ذلك فيفاد بهذا السياق اتحادهما كقول أبي النجم : شعري ، شعري أي لا ينبغي أن يتوهم على متوهم أن قريحتي كلت أو أن الحوادث أعيتني أن أقول من الشعر ما كنت أقوله فشعري الذي أقول اليوم هو شعري الذي كنت أقوله بالأمس.
وأما قوله تعالى : { وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ } فليس يجري فيه مثل هذه العناية فإن الرسالة التي هي مجموع الدين أو أصله على تقدير نزول الآية في أول البعثة أمر واحد غير مختلف ولا متغير حتى يصح أن يقال : إن لم تبلغ هذه الرسالة فما بلغت تلك الرسالة أو لم تبلغ أصل الرسالة فإن المفروض أنه أصل الرسالة التي هي مجموع المعارف الدينية.
فقد تبين أن الآية بسياقها لا تصلح أن تكون نازلة في بدء البعثة ويكون المراد فيها بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله مجموع الدين أو أصله ، ويتبين بذلك أنها لا تصلح أن تكون نازلة في خصوص تبليغ مجموع الدين أو أصله في أي وقت آخر غير بدء البعثة فإن الإشكال إنما ينشأ من جهة لزوم اللغو في قوله تعالى : { وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ } كما مر .
على أن قوله : { يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } لا يلائم النزول في أي وقت آخر غير بدء البعثة على تقدير إرادة الرسالة بمجموع الدين أو أصله ، وهو ظاهر .
على أن محذور دلالة قوله : { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخاف الناس في تبليغه على حاله.
فظهر أن ليس هذا الأمر الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وأكدت الآية تبليغه هو مجموع الدين أو أصله على جميع تقاديره المفروضة ، فلنضع أنه بعض الدين ، والمعنى :بلغ الحكم الذي أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته { إلخ } ، ولازم هذا التقدير أن يكون المراد بالرسالة مجموع ما حمله رسول الله صلى الله عليه وآله من الدين ورسالته ، وإلا فالمحذور السابق وهو لزوم اللغو في الكلام على حاله إذ لو كان المراد بقوله : { رِسالَتَهُ } الرسالة الخاصة بهذا الحكم كان المعنى : بلغ هذا الحكم وإن لم تبلغه فما بلغته ، وهو لغو ظاهر.
فالمراد أن بلغ هذا الحكم وإن لم تبلغه فما بلغت أصل رسالته أو مجموعها ، وهو معنى صحيح معقول ، وحينئذ يرد الكلام نظير المورد الذي ورده قول أبي النجم : ( أنا أبو النجم وشعري شعري ) .
وأما كون هذا الحكم بحيث لو لم يبلغ فكأنما لم تبلغ الرسالة فإنما ذلك لكون المعارف والأحكام الدينية مرتبطة بعضها ببعض بحيث لو أخل بأمر واحد منها أخل بجميعها وخاصة في التبليغ لكمال الارتباط ، وهذا التقدير وإن كان في نفسه مما لا بأس به لكن ذيل الآية وهو قوله : {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ} لا يلائمه فإن هذا الذيل يكشف عن أن قوما كافرين من الناس هموا بمخالفة هذا الحكم النازل أو كان المترقب من حالهم أنهم سيخالفونه مخالفة شديدة ، ويتخذون أي تدبير يستطيعونه لإبطال هذه الدعوة وتركه سدى لا يؤثر أثرا ولا ينفع شيئا وقد وعد الله رسوله أن يعصمه منهم ، ويبطل مكرهم ، ولا يهديهم في كيدهم.
ولا يستقيم هذا المعنى مع أي حكم نازل فرض فإن المعارف والأحكام الدينية في الإسلام ليست جميعا في درجة واحدة ففيها التي هي عمود الدين ، وفيها الدعاء عند رؤية الهلال ، وفيها زنى المحصن وفيها النظر إلى الأجنبية ، ولا يصح فرض هذه المخافة من النبي صلى الله عليه وآله والوعد بالعصمة من الله مع كل حكم حكم منها كيفما كان بل في بعض الأحكام .
فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم لعدم تبليغ غيره من الأحكام إلا لمكان أهميته ووقوعه من الأحكام في موقع لو أهمل أمره كان ذلك في الحقيقة إهمالا لأمر سائر الأحكام ، وصيرورتها كالجسد العادم للروح التي بها الحياة الباقية والحس والحركة ، وتكون الآية حينئذ كاشفة عن أن الله سبحانه كان قد أمر رسوله صلى الله عليه وآله بحكم يتم به أمر الدين ويستوي به على عريشة القرار ، وكان من المترقب أن يخالفه الناس ويقلبوا الأمر على النبي صلى الله عليه وآله بحيث تنهدم أركان ما بناه من بنيان الدين وتتلاشى أجزاؤه ، وكان النبي صلى الله عليه وآله يتفرس ذلك ويخافهم على دعوته فيؤخر تبليغه إلى حين بعد حين ليجد له ظرفا صالحا وجوا آمنا عسى أن تنجح فيه دعوته ، ولا يخيب مسعاه فأمره الله تعالى بتبليغ عاجل ، وبين له أهمية الحكم ، ووعده أن يعصمه من الناس ، ولا يهديهم في كيدهم ، ولا يدعهم يقلبوا له أمر الدعوة.
وإنما يتصور تقليب أمر الدعوة على النبي صلى الله عليه وآله وإبطال عمله بعد انتشار الدعوة الإسلامية لا من جانب المشركين ووثنية العرب أو غيرهم كأن تكون الآية نازلة في مكة قبل الهجرة ، وتكون مخافة النبي صلى الله عليه وآله من الناس من جهة افترائهم عليه واتهامهم إياه في أمره كما حكاه الله سبحانه من قولهم : { مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ } : [الدخان : 14] .
وقولهم : {شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ} [الطور : 30] : وقولهم : {ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} [الذاريات : 52] وقولهم : { إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً } [الإسراء : 47] وقولهم : { إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ } [ المدثر : 24 ] وقولهم : {أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } [ الفرقان : 5 ] وقولهم : { إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} [ النحل : 103 ] وقولهم : { أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ } : [ ص : 6] إلى غير ذلك من أقاويلهم فيه صلى الله عليه وآله.
فهذه كلها ليست مما يوجب وهن قاعدة الدين ، وإنما تدل ـ إذا دلت ـ على اضطراب القوم في أمرهم ، وعدم استقامتهم فيه على أن هذه الافتراءات والمرامي لا تختص بالنبي صلى الله عليه وآله حتى يضطرب عند تفرسها ويخاف وقوعها فسائر الأنبياء والرسل يشاركونه في الابتلاء بهذه البلايا والمحن ، ومواجهة هذه المكاره من جملة أممهم كما حكاه الله تعالى عن نوح ومن بعده من الأنبياء المذكورين في القرآن .
بل إن كان شيء ـ ولا بد ـ فإنما يتصور بعد الهجرة واستقرار أمر الدين في المجتمع الإسلامي والمسلمون كالمعجون الخليط من صلحاء مؤمنين وقوم منافقين أولي قوة لا يستهان بأمرهم ، وآخرين في قلوبهم مرض وهم سماعون ـ كما نص عليه الكتاب العزيز ـ وهؤلاء كانوا يعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله ـ في عين أنهم آمنوا به واقعا أو ظاهرا ـ معاملة الملوك ، ومع دين الله معاملة القوانين الوضعية القومية كما يشعر بذلك طوائف من آيات الكتاب قد تقدم تفسير بعضها في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب (2) .
فكان من الممكن أن يكون تبليغ بعض الأحكام مما يوقع في الوهم انتفاع النبي صلى الله عليه وآله بتشريعه وإجرائه يستوجب أن يقع في قلوبهم أنه ملك في صورة النبوة وقانون ملكي في هيئة الدين كما ربما وجد بعض شواهد ذلك في مطاوي كلمات بعضهم (3) .
وهذه شبهة لو كانت وقعت هي أو ما يماثلها في قلوبهم ألقت إلى الدين من الفساد والضيعة ما لا يدفعه أي قوة دافعة ، ولا يصلحه أي تدبير مصلح فليس هذا الحكم النازل المأمور بتبليغه إلا حكما فيه توهم انتفاع للنبي صلى الله عليه وآله ، واختصاص له بمزية من المزايا الحيوية لا يشاركه فيها غيره من سائر المسلمين ، نظير ما في قصة زيد وتعدد الأزواج والاختصاص بخمس الغنائم ونظائر ذلك .
غير أن الخصائص إذا كانت مما لا تمس فيه عامة المسلمين لم يكن من طبعها إثارة الشبهة في القلوب فإن الازدواج بزوجة المدعو ابنا مثلا لم يكن يختص به والازدواج بأكثر من أربع نسوة لو كان تجويزه لنفسه عن هوى بغير إذن الله سبحانه لم يكن يمنعه أن يجوز مثل ذلك لسائر المسلمين ، وسيرته في إيثار المسلمين على نفسه في ما كان يأخذه لله ولنفسه من الأموال ونظائر هذه الأمور لا تدع ريبا لمرتاب ولا يشتبه أمرها لمشتبه دون أن تزول الشبهة .
فقد ظهر من جميع ما تقدم أن الآية تكشف عن حكم نازل فيه شوب انتفاع للنبي صلى الله عليه وآله ، واختصاصه بمزية حيوية مطلوبة لغيره أيضا يوجب تبليغه والعمل به حرمان الناس عنه فكان النبي صلى الله عليه وآله يخاف إظهاره فأمره الله بتبليغه وشدد فيه ، ووعده العصمة من الناس وعدم هدايتهم في كيدهم إن كادوا فيه.
وهذا يؤيد ما وردت به النصوص من طرق الفريقين أن الآية نزلت في أمر ولاية علي عليه السلام ، وأن الله أمر بتبليغها وكان النبي صلى الله عليه وآله يخاف أن يتهموه في ابن عمه ، ويؤخر تبليغها وقتا إلى وقت حتى نزلت الآية فبلغها بغدير خم ، وقال فيه : من كنت مولاه فهذا علي مولاه .
وكون ولاية أمر الأمة مما لا غنى للدين عنه ظاهر لا ستر عليه ، وكيف يسوغ لمتوهم أن يتوهم أن الدين الذي يقرر بسعته لعامة البشر في عامة الأعصار والأقطار جميع ما يتعلق بالمعارف الأصلية ، والأصول الخلقية ، والأحكام الفرعية العامة لجميع حركات الإنسان وسكناته ، فرادى ومجتمعين على خلاف جميع القوانين العامة لا يحتاج إلى حافظ يحفظه حق الحفظ ؟ أو أن الأمة الإسلامية والمجتمع الديني مستثنى من بين جميع المجتمعات الإنسانية مستغنية عن وال يتولى أمرها ومدبر يدبرها ومجر يجريها؟ وبأي عذر يمكن أن يعتذر إلى الباحث عن سيرة النبي الاجتماعية؟ حيث يرى أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى غزوة خلف مكانه رجلا يدير رحى المجتمع ، : وقد خلف عليا مكانه على المدينة ـ عند مسيره إلى تبوك فقال : يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وآله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ـ إلا أنه لا نبي بعدي ؟.
وكان صلى الله عليه وآله ينصب الولاة الحكام في ما بيد المسلمين من البلاد كمكة والطائف واليمن وغيرها ، ويؤمر رجالا على السرايا والجيوش التي يبعثها إلى الأطراف ، وأي فرق بين زمان حياته وما بعد مماته دون أن الحاجة إلى ذلك بعد غيبته بالموت أشد ، والضرورة إليه أمس ثم أمس .
قوله تعالى : {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} خاطبه صلى الله عليه وآله بالرسالة لكونها أنسب الصفات إلى ما تتضمنه الآية من الأمر بالتبليغ لحكم الله النازل فهو كالبرهان على وجوب التبليغ الذي تظهره الآية وتقرعه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله فإن الرسول لا شأن له إلا تبليغ ما حمل من الرسالة فتحمل الرسالة يفرض عليه القيام بالتبليغ .
ولم يصرح باسم هذا الذي أنزل إليه من ربه بل عبر عنه بالنعت وأنه شيء أنزل إليه ، إشعارا بتعظيمه ودلالة على أنه أمر ليس فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله صنع ، ولا له من أمره شيء ليكون كبرهان آخر على عدم خيرة منه صلى الله عليه وآله في كتمانه وتأخير تبليغه ، ويكون له عذرا في إظهاره على الناس ، وتلويحا إلى أنه صلى الله عليه وآله مصيب في ما تفرسه منهم وتخوف عليه ، وإيماء إلى أنه مما يجب أن يظهر من ناحيته صلى الله عليه وآله وبلسانه وبيانه.
قوله تعالى : { وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ } المراد بقوله : { رِسالَتَهُ } وقرئ (رسالاته) كما تقدم مجموع رسالات الله سبحانه التي حملها رسوله صلى الله عليه وآله ، وقد تقدم أن الكلام يفيد أهمية هذا الحكم المرموز إليه ، وأن له من المكانة ما لو لم يبلغه كأن لم يبلغ شيئا من الرسالات التي حملها .
فالكلام موضوع في صورة التهديد ، وحقيقته بيان أهمية الحكم ، وأنه بحيث لو لم يصل إلى الناس ، ولم يراع حقه كان كأن لم يراع حق شيء من أجزاء الدين فقوله : {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ} جملة شرطية سيقت لبيان أهمية الشرط وجودا وعدما لترتب الجزاء الأهم عليه وجودا وعدما.
وليست شرطية مسوقة على طبع الشرطيات الدائرة عندنا فإنا نستعمل ( إن ) الشرطية طبعا فيما نجهل تحقق الجزاء للجهل بتحقق الشرط ، وحاشا ساحة النبي صلى الله عليه وآله من أن يقدر القرآن في حقه احتمال أن يبلغ الحكم النازل عليه من ربه وأن لا يبلغ ، وقد قال تعالى : {اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ} [الأنعام ـ 124] .
فالجملة أعني قوله : {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ} (إلخ) ، إنما تفيد التهديد بظاهرها وتفيد إعلامه عليه السلام وإعلام غيره ما لهذا الحكم من الأهمية ، وأن الرسول معذور في تبليغه .
قوله تعالى : {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ} قال الراغب : العصم (بالفتح فالسكون) الإمساك والاعتصام الاستمساك ـ إلى أن قال ـ والعصام (بالكسر) ما يعتصم به أي يشد ، وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا بما خصهم به من صفاء الجوهر ، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية ، ثم بالنصرة وبتثبيت أقدامهم ، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق قال تعالى : {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} .
والعصمة شبه السوار ، والمعصم موضعها من اليد ، وقيل للبياض بالرسغ عصمة تشبيها بالسوار ، وذلك كتسمية البياض بالرجل تحجيلا ، وعلى هذا قيل : غراب أعصم ، انتهى .
وما ذكره من معنى عصمة الأنبياء حسن لا بأس به غير أنه لا ينطبق على الآية {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} بل لو انطبق فإنما ينطبق على مثل قوله : {وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً} [ النساء : 113] .
وأما قوله : { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } فإن ظاهره أنها عصمة بمعنى الحفظ والوقاية من شر الناس المتوجه إلى نفس النبي الشريفة أو مقاصده الدينية أو نجاح تبليغه وفلاح سعيه ، وبالجملة المعنى المناسب لساحته المقدسة.
وكيف كان فالمتحصل من موارد استعمال الكلمة أنها بمعنى الإمساك والقبض فاستعماله في معنى الحفظ من قبيل استعارة اللازم لملزومه فإن الحفظ يلزمه القبض.
وكان تعليق العصمة بالناس من دون بيان أن العصمة من أي شأن من شئون الناس كتعدياتهم بالإيذاء في الجسم من قتل أو سم أو أي اغتيال ، أو بالقول كالسب والافتراء ، أو بغير ذلك كتقليب الأمور بنوع من المكر والخديعة والمكيدة وبالجملة السكوت عن تشخيص ما يعصم منه لإفادة نوع من التعميم ، ولكن الذي لا يعدو عنه السياق هو شرهم الذي يوجب انقلاب الأمر على النبي صلى الله عليه وآله بحيث يسقط بذلك ما رفعه من أعلام الدين.
والناس مطلق من وجد فيه معنى الإنسانية من دون أن يعتبر شيء من خصوصياته الطبيعية التكوينية كالذكورة والأنوثة أو غير الطبيعية كالعلم والفضل والغنى وغير ذلك. ولذلك قل ما ينطبق على غير الجماعة ، ولذلك أيضا ربما دل على الفضلاء من الإنسان إذا كان الفضل روعي فيه وجود معنى الإنسانية كقوله تعالى : {إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ} أي الذين وجد فيهم معنى الإنسانية ، وهو ملاك درك الحق وتمييزه من الباطل .
وربما كان دالا على نوع من الخسة وسقوط الحال ، وذلك إذا كان الأمر الذي يتكلم فيه مما يحتاج إلى اعتبار شيء من الفضائل الإنسانية التي اعتبرت زائدة على أصل معنى النوع كقوله : { وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } [ الروم : 30 ] وكقولك : لا تثق بمواعيد الناس ، ولا تستظهر بسوادهم نظرا منك إلى أن الوثوق والاستظهار يجب أن يتعلقا بالفضلاء من الإنسان ذوي ملكة الوفاء بالعهد والثبات على العزيمة لا على من ليس له إلا مجرد صدق اسم الإنسانية ، وربما لم يفد شيئا من مدح أو ذم إذا تعلق الغرض بما لا يزيد على أصل معنى الإنسانية كقوله تعالى : { يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ } [الحجرات : 13] .
ولعل قوله : { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } أخذ فيه لفظ الناس اعتبارا بسواد الأفراد الذي فيه المؤمن والمنافق والذي في قلبه مرض ، وقد اختلطوا من دون تمايز ، فإذا خيف خيف من عامتهم ، وربما أشعر به قوله : { إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ } فإن الجملة في مقام التعليل لقوله : { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } وقد تقدم أيضا أن الآية نزلت بعد الهجرة وظهور شوكة ، الإسلام وكان السواد الأعظم من الناس مسلمين بحسب الظاهر وإن كان فيهم المنافقون وغيرهم .
فالمراد بالقوم الكافرين قوم هم في الناس مذكوري النعت ممحوي الاسم وعد الله سبحانه أن يبطل كيدهم ويعصم رسوله صلى الله عليه وآله من شرهم .
والظاهر أيضا أن يكون المراد بالكفر الكفر بآية من آيات الله وهو الحكم المراد بقوله : { ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } ، كما في قوله في آية الحج : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ } [آل عمران : 97] ، وأما الكفر بمعنى الاستكبار عن أصل الشهادتين فإنه مما لا يناسب مورد الآية البتة إلا على القول بكون المراد بقوله : { ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } مجموع رسالات الدين ، وقد عرفت عدم استقامته.
والمراد بعدم هدايته تعالى هؤلاء القوم الكافرين عدم هدايته إياهم في كيدهم ومكرهم ، ومنعه الأسباب الجارية أن تنقاد لهم في سلوكهم إلى ما يرومونه من الشر والفساد نظير قوله تعالى : { إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ } [المنافقون : 6] ، وقوله تعالى : { وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [البقرة : 258] ، وقد تقدم البحث عنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب .
وأما كون المراد بعدم الهداية هو عدم الهداية إلى الإيمان فغير صحيح البتة لمنافاته أصل التبليغ والدعوة فلا يستقيم أن يقال : أدعهم إلى الله أو إلى حكم الله وأنا لا أهديهم إليه إلا في مورد إتمام الحجة محضا.
على أن الله سبحانه قد هدى ولا يزال يهدي كثيرين من الكفار بدليل العيان ، وقد قال أيضا : { وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ } [البقرة : 213] .
فتبين أن المراد بعدم هداية الكافرين عدم تخليتهم لينالوا ما يهمون به من إبطال كلمة الحق وإطفاء نور الحكم المنزل فإن الكافرين وكذا الظالمين والفاسقين يريدون بشامة أنفسهم وضلال رأيهم أن يبدلوا سنة الله الجارية في الخلقة وسياقة الأسباب السالكة إلى مسبباتها ويغيروا مجاري الأسباب الحقة الظاهرة عن سمة عصيان رب العالمين إلى غايتهم الفاسدة مقاصدهم الباطلة والله رب العالمين لن يعجزه قواهم الصورية التي لم يودعها فيهم ولم يقدرها في بناهم إلا هو .
فهم ربما تقدموا في مساعيهم أحيانا ونالوا ما راموه أوينات واستعلوا واستقام أمرهم برهة لكنه لا يلبث دون أن يبطل أخيرا وينقلب عليهم مكرهم ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، وكذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الباطل فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .
وعلى هذا فقوله : { إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ } تفسير قوله : {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} بالتصرف في سعة إطلاقه ، ويكون المراد بالعصمة عصمته صلى الله عليه وآله من أن يناله الناس بسوء دون أن ينال بغيته في تبليغ هذا الحكم وتقريره بين الأمة كأن يقتلوه دون أن يبلغه أو يثوروا عليه ويقلبوا عليه الأمور أو يتهموه بما يرتد به المؤمنون عن دينه ، أو يكيدوا كيدا يميت هذا الحكم ويقبره بل الله يظهر كلمة الحق ويقيم الدين على ما شاء وأينما شاء ومتى ما شاء ، وفيمن شاء قال تعالى : {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً} : [ النساء : 133].
وأما أخذ الآية أعني قوله : { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } بإطلاقه على ما فيه من السعة والشمول فمما ينافيه القرآن والمأثور من الحديث والتاريخ القطعي ، وقد نال صلى الله عليه وآله من أمته أعم من كفارهم ومؤمنيهم ومنافقيهم من المصائب والمحن وأنواع الزجر والأذى ما ليس في وسع أحد أن يتحمله إلا نفسه الشريفة ، وقد قال صلى الله عليه وآله ـ كما في الحديث المشهور ـ : ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط .
________________________
1. تفسير الميزان ، ج6 ، ص 35-45 .
2. كآيات قصة أحد في صورة آل عمران ، والآيات ال 105 ـ 126 من سورة النساء .
3. كما يذكر عن أبي سفيان في كلمات قالها في مجلس عثمان حينما تم له أمر الخلافة .
اختيار الخليفة مرحلة انتهاء الرسالة:
إنّ لهذه الآية نفسا خاصا يميزها عمّا قبلها وعمّا بعدها من آيات ، إنّها تتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده وتبيّن له واجبة ، فهي تبدأ بمخاطبة الرّسول :(ياأَيُّهَا الرَّسُولُ) وتأمره بكل جلاء ووضوح أن {بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (2) .
ثمّ لكي يكون التوكيد أشد وأقوى ـ تحذره وتقول : (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ} .
ثمّ تطمئن الآية الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ـ وكأن أمرا يقلقه ـ وتطلب منه أن يهدئ من روعه وأن لا يخشى الناس : فيقول له : {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} .
وفي ختام الآية إنذار وتهديد بمعاقبة الذين ينكرون هذه الرسالة الخاصّة ويكفرون بها عنادا ، فتقول : {إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ} .
أسلوب هذه الآية ، ولحنها الخاص ، وتكرر توكيداتها ، وكذلك ابتداؤها بمخاطبة الرّسول {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ} التي لم ترد في القرآن الكريم سوى مرّتين ، وتهديده بأنّ عدم تبليغ هذه الرسالة الخاصّة إنّما هو تقصير ـ وهذا لم يرد إلّا في هذه الآية وحدها ـ كل ذلك يدل على أنّ الكلام يدور حول أمر مهم جدا بحيث أن عدم تبليغه يعتبر عدم تبليغ للرسالة كلها.
لقد كان لهذا الأمر معارضون أشداء إلى درجة أنّ الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قلقا لخشيته من أنّ تلك المعارضة قد تثير بعض المشاكل بوجه الإسلام والمسلمين ، ولهذا يطمئنه الله تعالى من هذه الناحية.
هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي ـ مع الأخذ بنظر الإعتبار تأريخ نزول هذه الآية ـ وهو قطعا في أواخر حياة الرّسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : ترى ما هذا الموضوع المهم الذي يأمر الله رسوله ـ مؤكّدا ـ أن يبلّغه للناس؟
هل هو ممّا يخص التوحيد والشرك وتحطيم الأصنام ، وهو ما تمّ حله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين قبل ذلك بسنوات؟
أم هو ممّا يتعلق بالأحكام والقوانين الإسلامية ، مع أنّ أهمها كان قد سبق نزوله حتى ذلك الوقت؟
أم هو الوقوف بوجه أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، مع أنّنا نعرف أنّ هذا لم يعد مشكلة بعد الانتهاء من حوادث بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وخيبر وفدك ونجران؟
أم كان أمرا من الأمور التي لها صلة بشأن المنافقين ، مع أنّ هؤلاء قد طردوا من المجتمع الإسلامي بعد فتح مكّة ، وامتداد نفوذ المسلمين وسيطرتهم على أرجاء الجزيرة العربية كافة ، فتحطمت قوتهم ، ولم يبق عندهم إلّا ما كانوا يخفونه مقهورين؟
فما هذه المسألة المهمّة ـ يا ترى ـ التي برزت في الشهور الأخيرة من حياة رسول صلى الله عليه وآله وسلم بحيث تنزل هذه الآية وفيها كل ذلك التوكيد؟
ليس ثمّة شك أنّ قلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لخوف على شخصه وحياته ، وإنّما كان لما يحتمله من مخالفات المنافقين وقيامهم بوضع العراقيل في طريق المسلمين.
هل هناك مسألة تستطيع أن تحمل كل هذه الصفات غير مسألة استخلاف النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعيين مصير مستقبل الإسلام؟!
سوف نرجع إلى مختلف الرّوايات الواردة في الكثير من كتب السنة والشيعة بشأن هذه الآية ، لكي نتبيّن إن كانت تنفعنا في إثبات الاحتمال الذي أوردناه آنفا ، ثمّ نتناول بالبحث الاعتراضات والانتقادات التي أوردها بعض المفسّرين من السنة حول هذا التّفسير.
________________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص576-577 .
2. عبارة «بلّغ» كما يقول الراغب في «المفردات» أكثر توكيدا من «أبلغ».



|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|