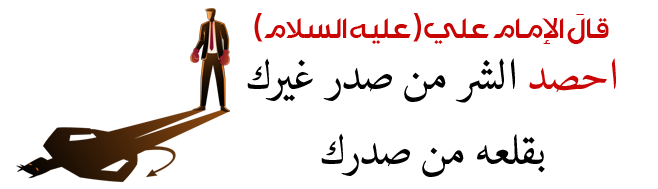
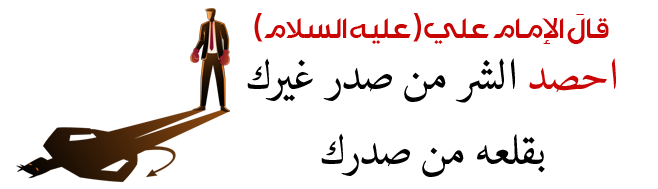

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-11-2016
التاريخ: 27-2-2017
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 22-2-2017
|
قال تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء : 135-136] .
لما ذكر سبحانه أن عنده ثواب الدنيا والآخرة ، عقبه بالأمر بالقسط ، والقيام بالحق ، وترك الميل والجور ، فقال : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} أي : دائمين على القيام بالعدل ، ومعناه : ولتكن عادتكم القيام بالعدل في القول والفعل . {شُهَدَاءَ لِلَّهِ} : وهو جمع شهيد ، أمر الله تعالى عباده بالثبات والدوام على قول الحق ، والشهادة بالصدق ، تقربا إليه وطلبا لمرضاته ، وعن ابن عباس :
" كونوا قوالين بالحق في الشهادة على من كانت ، ولمن كانت ، من قريب أو بعيد " {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} أي : ولو كانت شهادتكم على أنفسكم {أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} أي : على والديكم ، وعلى أقرب الناس إليكم ، فقوموا فيها بالقسط والعدل ، وأقيموها على الصحة والحق ، ولا تميلوا فيها لغنى غني ، أو لفقر فقير ، فإن الله قد سوى بين الغني والفقير فيما ألزمكم ، من إقامة الشهادة لكل واحد منهما بالعدل .
وفي هذا دلالة على جواز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، وعليه وشهادة كل ذي قرابة لقريبه ، وعليه وإليه ، ذهب ابن عباس في قوله : أمر الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحق ، ولو على أنفسهم ، أو آبائهم ، ولا يحابوا غنيا لغناه ، ولا مسكينا لمسكنته . وقال ابن شهاب الزهري : كان سلف المسلمين على ذلك ، حتى دخل الناس فيما بعدهم ، وظهرت منهم أمور ، حملت الولاة على اتهامهم ، فتركت شهادة من يتهم . وأما شهادة الإنسان على نفسه ، فيكون بالإقرار للخصم ، فإقراره له شهادة منه على نفسه ، وشهادته لنفسه لا تقبل . {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا} معناه : إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا ، أو المشهود له غنيا أو فقيرا ، فلا يمنعكم ذلك عن قول الحق ، والشهادة بالصدق ، وفائدة ذلك أن الشاهد ربما امتنع عن إقامة الشهادة للغني على الفقير ، لاستغناء المشهود له ، وفقر المشهود عليه فلا يقيم الشهادة شفقة على الفقير ، وربما امتنع عن إقامة الشهادة للفقير على الغني ، تهاونا للفقير ، وتوقيرا للغني ، أو خشية منه ، أو حشمة له ، فبين سبحانه بقوله {فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} أنه أولى بالغني والفقير ، وأنظر لهما من سائر الناس ، أي : فلا تمتنعوا من إقامة الشهادة على الفقير شفقة عليه ، ونظرا له ، ولا من إقامة الشهادة للغني لاستغنائه عن المشهود به ، فإن الله تعالى أمركم بذلك مع علمه بغناء الغني ، وفقر الفقير ، فراعوا أمره فيما أمركم به ، فإنه أعلم بمصالح العباد منكم .
{فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى} : يعني هوى الأنفس في إقامة الشهادة ، فتشهدوا على إنسان لإحنة (2) بينكم وبينه ، أو وحشة ، أو عصبية ، وتمتنعوا الشهادة له ، لأحد هذه المعاني ، وتشهدوا للإنسان بغير حق ، لميلكم إليه ، بحكم صداقة أو قرابة {أَنْ تَعْدِلُوا} أي : لأن تعدلوا يعني لأجل أن تعدلوا في الشهادة . قال الفراء : " هذا كقولهم لا تتبع هواك لترضي ربك " . أي كيما ترضي ربك . وقيل : إنه من العدول :
الذي هو الميل والجور . ومعناه : ولا تتبعوا الهوى في أن تعدلوا عن الحق ، أو لأن تعدلوا عن الحق {وَإِنْ تَلْوُوا} أي تمطلوا في أداء الشهادة ، {أَوْ تُعْرِضُوا} عن أدائها ، عن ابن عباس ، ومجاهد . وقيل : إن الخطاب للحكام أي : وإن تلووا أيها الحكام في الحكم لأحد الخصمين ، على الآخر ، {أَوْ تُعْرِضُوا} عن أحدهما إلى الآخر ، عن ابن عباس ، والسدي . وقيل معناه : ان تلووا أي تبدلوا الشهادة ، أو تعرضوا ، أي تكتموها ، عن ابن زيد ، والضحاك ، وهو المروي عن أبي جعفر .
{فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} معناه : إنه كان عالما بما يكون منكم من إقامة الشهادة ، أو تحريفها ، والأعراض عنها .
وفي هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وسلوك طريقة العدل في النفس والغير . وقد روي عن ابن عباس في معنى قوله {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} إنهما الرجلان ، يجلسان بين يدي القاضي ، فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما عن الآخر .
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء : 136] .
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها :
وهو الصحيح المعتمد عليه ، إن معناه : يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار بالله ورسوله ، آمنوا في الباطن ، ليوافق باطنكم ظاهركم ، ويكون الخطاب للمنافقين الذين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون . {وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ} ، وهو القرآن {وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ} هو التوراة والإنجيل ، عن الزجاج . وغيره .
وثانيها : أن يكون الخطاب للمؤمنين على الحقيقة ، ظاهرا وباطنا ، فيكون معناه اثبتوا على هذا الإيمان في المستقبل ، وداوموا عليه ، ولا تنتقلوا عنه ، عن الحسن ، واختاره الجبائي قال : " لان الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى ، وإنما يستمر بأن يجدده الإنسان حالا بعد حال " وثالثها : إن الخطاب لأهل الكتاب ، أمروا بأن يؤمنوا بالنبي والكتاب الذي أنزل عليه ، كما آمنوا بما معهم من الكتب ، ويكون قوله {وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ} إشارة إلى ما معهم من التوراة والإنجيل ، ويكون وجه أمرهم بالتصديق بهما ، وإن كانوا مصدقين بهما أحد أمرين :
إما أن يكون لأن التوراة والإنجيل فيهما صفات نبينا ، وتصديقه ، وتصحيح نبوته ، فمن لم يصدقه ولم يصدق القرآن ، لا يكون مصدقا بهما ، لان في تكذيبه تكذيب التوراة والإنجيل . وإما أن يكون الله تعالى أمرهم بالإقرار بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالقرآن ، وبالكتاب الذي أنزل من قبله ، وهو الإنجيل ، وذلك لا يصح إلا بالإقرار بعيسى أيضا ، وهو نبي مرسل ، ويعضد هذا الوجه ، ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال : " إن الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب ، عبد الله بن سلام ، وأسد ، وأسيد ، ابني كعب ، وثعلبة بن قيس ، وابن أخت عبد الله بن سلام ، ويامين بن يامين ، وهؤلاء من كبار أهل الكتاب ، قالوا : نؤمن بك ، وبكتابك ، وبموسى ، وبالتوراة ، وعزير ، ونكفر بما سواه من الكتب ، وبمن سواهم من الرسل . فقيل لهم : بل آمنوا بالله ورسوله الآية {فآمنوا كما أمرهم الله} . {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ} أي : يجحده ، أو يشبهه بخلقه ، أو يرد أمره ونهيه {وَمَلَائِكَتِهِ} أي : ينفيهم ، أو ينزلهم منزلة لا يليق بهم ، كما قالوا إنهم بنات الله . {وَكُتُبِهِ} فيجحدها ، {وَرُسُلِهِ} فينكرهم ، {وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} أي : يوم القيامة . {فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} أي : ذهب عن الحق ، وبعد قصد السبيل ذهابا بعيدا .
وقال الحسن : " الضلال البعيد : هو ما لا ائتلاف له " ، والمعنى : إن من كفر بمحمد ، وجحد نبوته ، فكأنه جحد جميع ذلك ، لأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق بشيء مما أمر الله به إلا بالإيمان به ، وبما أنزل الله عليه .
وفي هذا تهديد لأهل الكتاب ، وإعلام لهم أن إقرارهم بالله ، ووحدانيته ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، لا ينفعهم مع جحدهم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكون وجوده وعدمه سواء .
____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 212-215 .
2 . الإحنة : الحقد والغضب .
بين الدين وأهل الدين :
ما رأيت آية في كتاب اللَّه تتصل بالدين إلا وأحسست بالبعد والتفاوت بين الدين كما حدده اللَّه في كتابه ، والدين كما نمارسه في سلوكنا . . نحن نتحدث عن الدين ، وندعو إليه على انه من اللَّه ، وانه ليس لنا من أمره شيء ، واننا عبيد له ، تماما كما نحن عبيد للَّه . . هذا ما أعلمناه وجهرنا به . . ولكن بين الدين كما أعلمناه ودعونا إليه ، وبين سلوكنا الذي وصفناه بالدين - بون شاسع ، وتضاد واضح . . وان دل هذا على شيء فإنما يدل على انّا في حقيقة الأمر والواقع منافقون ، سواء أشعرنا بذلك ، أم لم نشعر .
ولو فسرنا الدين بأن اللَّه فوّض تشريع الحلال والحرام إلى الهيئة الدينية ، كما يزعم بعض أهل الأديان ، لكان بينه وبين سلوكنا شيء من الانسجام ، أما ان نقول : ان الدين للَّه ، ومن اللَّه ، ثم لا ننسجم معه في سلوكنا فهو النفاق بعينه .
قال تعالى : {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ ولَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ} . وفي الآية 152 من سورة الأنعام : {وإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ولَوْ كانَ ذا قُرْبى وبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} ومعناه ان الدين حاكم علينا وعلى آبائنا وأبنائنا ، وانه إذا تصادمت المصلحة الشخصية مع الدين فعلينا ان نؤثر الدين ، ولو أدى ذلك إلى ذهاب النفس والنفيس ، تماما كما فعل سيد الشهداء الحسين بن علي (عليه السلام) . . ولو قارن واحد من الناس هذه الحقيقة القرآنية مع سلوكنا لأنتهي إلى إننا نؤثر مصالحنا ومصالح ذوينا على الدين ، وإذا حقق ودقق في البحث آمن بأن المصدر الأول والأخير للدين عندنا هو المصلحة والمنفعة ، لا كتاب اللَّه ، ولا سنة رسول اللَّه .
هذا هو واقعنا ، أو واقع أكثرنا ، أو واقع الكثير منا . . ولكن لا نشعر بهذا الواقع ، ولا ننتبه إليه ، لأن الأنانية قد طغت على عقولنا ، وفصلتنا عن واقعنا وعن أنفسنا ، وأعمتنا عن الحق ، وأوهمتنا ان دين اللَّه هو مصلحتنا بالذات ، وما عداها فليس بشيء .
أقول هذا ، لا حقدا على أحد ، ولا بدافع الحاجة والحرمان . . فاني بفضل اللَّه في غنى عن خلقه . . ولكن هذا ما أحسه في أعماقي ، ويحس به كثيرون غيري من العارفين المنصفين ، ولا بد لهذا الإحساس من واقع يعكسه - فيما أعتقد - كما اعتقد انه لا دواء لهذا الداء إلا أن نتهم أنفسنا ، ونعتقد انّا عاديون كغيرنا ، لنا ميول وأهواء يجب أن نحذرها ونخالفها . . أقول هذا ، وأنا على علم بأنه صرخة في واد ، لأنه شكوى من أنفسنا لأنفسنا التي هي أعدى أعدائنا .
{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما} . في كل فرد من أفراد الإنسان استعداد لتقبل الخير والشر ، وهو في الوقت نفسه مفطور على تخير الأول دون الثاني ، بحيث لو خلي وفطرته لفعل ما يعتقد انه خير ، ولا ينحرف عنه إلا لعلة خارجة عن ذاته وفطرته . . ومما استدل به علماء الكلام على هذه الحقيقة ان العاقل لو خيّر بين ان يصدق ويعطى دينارا ، وبين أن يكذب ويعطى دينارا ، ولا ضرر عليه فيهما لاختار الصدق على الكذب .
إذن ، العاقل لا يكذب إلا لعلة ، كالخوف أو الطمع ، أو هوى مع قريب ، أو كراهة لعدو ، أو رحمة بفقير ، أو مجاملة لغني ، وما إلى ذلك . . وقد نهى سبحانه عن الامتناع من الشهادة على الغني خوفا أو طمعا أو مجاملة ، وعن الامتناع منها على الفقير لفقره ومسكنته ، وقال ، عظم من قال : { إِنْ يَكُنْ } - المشهود عليه - { غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما } . أي أنه أرحم بالفقير منا ، وأعرف بمصلحته ومصلحة الغني ، وما علينا نحن إلا أن نقول الحق ، سواء أكان لهما ، أم عليهما .
ولم يذكر سبحانه من الدوافع الموجبة للزيغ والانحراف إلا مجاملة الغني ، والرحمة بالفقير . . ولكن السبب عام ، فالحق يجب أن يقال في كل موطن ، والعدل يجب أن يتبع حتى مع أعداء الدين .
{فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا} . أي لكي تعدلوا ، والمعنى على هذا إنكم تصيرون من أهل العدل بترك الهوى ومخالفته . وقيل : التقدير كراهة ان تعدلوا ، أي إنكم تتبعون الهوى كرها بالعدل ، وان اللَّه نهاهم عن ذلك . والأول أقرب .
العدالة :
واختلف الفقهاء في معنى العدالة ، وأطالوا الكلام ، فمنهم من قال : إنها ظاهر الإسلام ، مع عدم ظهور الفسق . وقال آخر : إنها ملكة راسخة في النفس تبعث على فعل الواجب ، وترك المحرم . وثالث : إنها الستر والعفاف . ورابع إنها ترك الكبائر ، مع عدم الإصرار على الصغائر .
وفي قوله تعالى : {فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا} إيماء إلى أن العدالة هي مخالفة الهوى . ووصف علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أخا له في اللَّه فيما وصف انه « كان إذا بدهه - أي فجأة - أمران نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه » .
وقال : « كان أول عدله نفي الهوى عن نفسه » .
وقال حفيده الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه .
{ وإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهً كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً } . الليّ هو المطل والتسويف ، والمعنى لا تسوفوا في أداء الشهادة ، ولا تعرضوا عنها . . ثم هدد وتوعد بأن من يفعل ذلك يعلم به اللَّه ، ويعاقبه عليه .
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ} . قد يؤمن الإنسان بالخالق المكون ، وينكر النبوة والكتب السماوية ، وقد يعترف بنبوة بعض الأنبياء دون بعض ، وببعض الكتب دون بعض ، أو ينكر وجود الملائكة ، أو اليوم الآخر . وقد بينت هذه الآية أركان الإيمان التي يجب أن يعترف بها كل من ترك الشرك والإلحاد ، ويؤمن بها ككل لا يتجزأ ، وهي الإيمان باللَّه وجميع رسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر .
وعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا هم الذين تركوا الشرك والإلحاد ، وبآمنوا الثانية الإيمان الحقيقي ، لا الدوام والثبات على الإيمان كما قال المفسرون ، وبرسوله محمد (صلى الله عليه وآله) ، وبالكتاب الذي نزل على رسوله القرآن ، وبالكتاب الذي أنزل من قبل كل كتاب سماوي نزل قبل بعثة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) . {ومَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً} .
هذه الآية دليل واضح على ان الإيمان بالغيب ركن من أركان الإسلام ، وان من لا يؤمن به فليس بمسلم . . وسبق نظير هذه الآية ، مع تفسيرها في المجلد الأول ص 455 الآية 285 من سورة البقرة .
_________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 457-461.
قوله تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ } القسط هو العدل ، والقيام بالقسط العمل به والتحفظ له ، فالمراد بالقوامين بالقسط القائمون به أتم قيام وأكمله ، من غير انعطاف وعدول عنه إلى خلافه لعامل من هوى وعاطفة أو خوف أو طمع أو غير ذلك.
وهذه الصفة أقرب العوامل وأتم الأسباب لاتباع الحق وحفظه عن الضيعة ، ومن فروعها ملازمة الصدق في أداء الشهادة والقيام بها.
ومن هنا يظهر أن الابتداء بهذه الصفة في هذه الآية المسوقة لبيان حكم الشهادة ثم ذكر صفة الشهادة من قبيل التدرج من الوصف العام إلى بعض ما هو متفرع عليه كأنه قيل. كونوا شهداء لله ، ولا يتيسر لكم ذلك إلا بعد أن تكونوا قوامين بالقسط فكونوا قوامين بالقسط حتى تكونوا شهداء لله.
وقوله { شُهَداءَ لِلَّهِ } اللام فيه للغاية أي كونوا شهداء تكون شهادتكم لله كما قال تعالى : { وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ } : ( الطلاق : 2 ) ومعنى كون الشهادة لله كونها اتباعا للحق ولأجل إظهاره وإحيائه كما يوضحه قوله { فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا }. قوله تعالى . { وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } أي ولو كانت على خلاف نفع أنفسكم أو والديكم أو أقربائكم فلا يحملنكم حب منافع أنفسكم أو حب الوالدين والأقربين أن تحرفوها أو تتركوها ، فالمراد بكون الشهادة على النفس أو على الوالدين والأقربين أن يكون ما تحمله من الشهادة لو أدى مضرا بحاله أو بحال والديه وأقربيه سواء كان المتضرر هو المشهود عليه بلا واسطة كما إذا تخاصم أبوه وإنسان آخر فشهد له على أبيه ، أو يكون التضرر مع الواسطة كما إذا تخاصم اثنان وكان الشاهد متحملا لأحدهما ما لو أداه لتضرر به نفس الشاهد أيضا ـ كالمتخاصم الآخر ـ .
قوله تعالى : { إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما } إرجاع ضمير التثنية إلى الغني والفقير مع وجود « أو » الترديدية لكون المراد بالغني والفقير هو المفروض المجهول الذي يتكرر بحسب وقوع الوقائع وتكررها فيكون غنيا في واقعة ، وفقيرا في أخرى ، فالترديد بحسب فرض البيان وما في الخارج تعدد ، كذا ذكره بعضهم ، فالمعنى أن الله أولى بالغني في غناه ، وبالفقير في فقره : والمراد ـ والله أعلم ـ : لا يحملنكم غنى الغني أن تميلوا عن الحق إليه ، ولا فقر الفقير أن تراعوا حاله بالعدول عن الحق بل أقيموا الشهادة لله سبحانه ثم خلوا بينه وبين الغني والفقير فهو أولى بهما وأرحم بحالهما ، ومن رحمته أن جعل الحق هو المتبع واجب الاتباع ، والقسط هو المندوب إلى إقامته ، وفي قيام القسط وظهور الحق سعادة النوع التي يقوم بها صلب الغني ، ويصلح بها حال الفقير.
والواحد منهما وإن انتفع بشهادة محرفة أو متروكة في شخص واقعة أو وقائع لكن ذلك لا يلبث دون أن يضعف الحق ويميت العدل ، وفي ذلك قوة الباطل وحياة الجور والظلم ، وفي ذلك الداء العضال وهلاك الإنسانية.
قوله تعالى : { فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا } ، أي مخافة أن تعدلوا عن الحق والقسط باتباع الهوى وترك الشهادة لله فقوله { أَنْ تَعْدِلُوا } مفعول لأجله ويمكن أن يكون مجرورا بتقدير اللام متعلقا بالاتباع أي لأن تعدلوا.
قوله تعالى : { وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً } اللي بالشهادة كناية عن تحريفها من لي اللسان. والإعراض ترك الشهادة من رأس.
وقرئ { وَإِنْ تَلْوُوا } بضم اللام وإسكان الواو من ولي يلي ولاية ، والمعنى : وإن وليتم أمر الشهادة وأتيتم بها أو أعرضتم فإن الله خبير بأعمالكم يجازيكم بها.
قوله تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ } ، أمر المؤمنين بالإيمان ثانيا بقرينة التفصيل في متعلق الإيمان الثاني أعني قوله { بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ } (إلخ) وأيضا بقرينة الإيعاد والتهديد على ترك الإيمان بكل واحد من هذا التفاصيل إنما هو أمر ببسط المؤمنين إجمال إيمانهم على تفاصيل هذه الحقائق فإنها معارف مرتبطة بعضها ببعض ، مستلزمة بعضها ببعض ، فالله سبحانه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصفات العليا ، وهي الموجبة لأن يخلق خلقا ويهديهم إلى ما يرشدهم ويسعدهم ثم يبعثهم ليوم الجزاء ، ولا يتم ذلك إلا بإرسال رسل مبشرين ومنذرين ، وإنزال كتب تحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ، وتبين لهم معارف المبدأ والمعاد ، وأصول الشرائع والأحكام.
فالإيمان بواحد من حقائق هذه المعارف لا يتم إلا مع الإيمان بجميعها من غير استثناء ، والرد لبعضها مع الأخذ ببعض آخر كفر لو أظهر ، ونفاق لو كتم وأخفى ، ومن النفاق أن يتخذ المؤمن مسيرا ينتهي به إلى رد بعض ذلك ، كأن يفارق مجتمع المؤمنين ويتقرب إلى مجتمع الكفار ويواليهم ، ويصدقهم في بعض ما يرمون به الإيمان وأهله ، أو يعترضوا أو يستهزءون به الحق وخاصته ، ولذلك عقب تعالى هذه الآية بالتعرض لحال المنافقين ووعيدهم بالعذاب الأليم.
وما ذكرناه من المعنى هو الذي يقضي به ظاهر الآية وهو أوجه مما ذكره بعض المفسرين أن المراد بقوله { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا } ، : يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار بالله ورسوله آمنوا في الباطن ليوافق ظاهركم باطنكم. وكذا ما ذكره بعضهم أن معنى { آمَنُوا } اثبتوا على إيمانكم ، وكذا ما ذكره آخرون أن الخطاب لمؤمني أهل الكتاب أي يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن.
وهذه المعاني وإن كانت في نفسها صحيحة لكن القرائن الكلامية ناهضة على خلافها ، وأردأ الوجوه آخرها.
قوله تعالى : { وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً } لما كان الشطر الأول من الآية أعني قوله { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ـ إلى قوله ـ مِنْ قَبْلُ } دعوة إلى الجمع بين جميع ما ذكر فيه بدعوى أن أجزاء هذا المجموع مرتبطة غير مفارق بعضها بعضا كان هذا التفصيل ثانيا في معنى الترديد والمعنى : ومن يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أي من يكفر بشيء من أجزاء الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا.
وليس المراد بالعطف بالواو الجمع في الحكم ليتم الجميع موضوعا واحدا له حكم واحد بمعنى أن الكفر بالمجموع من حيث إنه مجموع ضلال بعيد دون الكفر بالبعض دون البعض. على أن الآيات القرآنية ناطقة بكفر من كفر بكل واحد مما ذكر في الآية على وجه التفصيل .
_______________________
1. تفسير الميزان ، ج5 ، ص 94-97 .
العدالة الاجتماعية :
على غرار الأحكام التي وردت في الآيات السابقة حول تطبيق العدالة مع الأيتام والزوجات تذكر الآية الأخيرة ـ موضوع البحث ـ مبدأ أساسيا وقانونا كليا في مجال تطبيق العدالة في جميع الشؤون والموارد بدون استثناء ، وتأمر جميع المؤمنين بإقامة العدالة {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ...}.
ويجب الانتباه إلى أنّ كلمة «قوامين» هي جمع لكلمة «قوّام» وهي صيغة مبالغة من «قائم» وتعني «كثير القيام» أي أن على المؤمنين أن يقوموا بالعدل في كل الأحوال والأعمال وفي كل العصور والدهور ، لكي يصبح العدل جزءا من طبعهم وأخلاقهم، ويصبح الانحراف عن العدل مخالفا ومناقضا لطبعهم وروحهم .
والإتيان بكلمة «القيام» في هذا المكان ، يحتمل أن يكون بسبب أنّ الإنسان حين يريد القيام بأي عمل ، يجب عليه أن يقوم على رجليه بصورة عامّة ويتابع ذلك العمل ، وعلى هذا الأساس فإن التعبير هنا بالقيام كناية عن العزم والإرادة الرّاسخة والإجراء لإنجاز العمل ، حتى لو كان هذا العمل من باب حكم القاضي الذي لا يحتاج إلى القيام لدى ممارسة عمله.
ويمكن أن يكون التعبير بالقيام جاء لسبب آخر ، وهو أنّ كلمة «القائم» تطلق عادة على شيء يقف بصورة عمودية على الأرض دون أن يكون فيه انحراف إلى اليمين أو الشمال ، وعلى هذا فإن المعنى المراد منه في الآية يكون تأكيدا لضرورة تحقيق العدالة دون أقل انحراف إلى أي جهة كانت.
ولتأكيد الموضوع جاءت الآية بكلمة «الشهادة» فشددت على ضرورة التخلي عن كل الملاحظات والمجاملات أثناء أداء الشهادة ، وأن يكون هدف الشهادة بالحق هو كسب مرضاة الله فقط ، حتى لو أصبحت النتيجة في ضرر الشاهد أو أبيه أو أمه أو أقاربه {شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...}.
وقد شاع هذا الأمر في كل المجتمعات ، وبالأخص المجتمعات الجاهلية ، حيث كانت الشهادة تقاس بمقدار الحبّ والكراهية ونوع القرابة بين الأشخاص والشاهد ، دون أن يكون للحق والعدل أثر فيما يفعلون.
وقد نقل عن ابن عباس حديث يفيد أنّ المسلمين الجدد كانوا بعد وصولهم إلى المدينة يتجنبون الإدلاء بالشهادة لاعتبارات القرابة والنسب ، إذا كانت الشهادة تؤدي إلى الإضرار بمصالح أقربائهم ، فنزلت الآية المذكورة محذرة لمثل هؤلاء (2) .
ولكن ـ وكما تشير الآية الكريمة ـ فإنّ هذا العمل لا يتناسب وروح الإيمان ، لأنّ المؤمن الحقيقي هو ذلك الشخص الذي لا يعير اهتماما للاعتبارات في مجال الحق والعدل ، ويتغاضى عن مصلحته ومصلحة أقاربه من أجل تطبيق الحق والعدل.
وتفيد هذه الآية أنّ للأقارب الحق في الإدلاء بالشهادة لصالح ـ أو ضد ـ بعضهما البعض ، شرط الحفاظ على مبدأ العدالة (إلّا إذا كانت القرائن تشير إلى وجود انحياز أو تعصب في الموضوع) .
وتشير الآية بعد ذلك عوامل الانحراف عن مبدأ العدالة ، فتبيّن أنّ ثروة الأغنياء يجب أن لا تحول دون الإدلاء بالشهادة العادلة ، كما أنّ العواطف والمشاعر التي تتحرك لدى الإنسان من أجل الفقراء ، يجب أن تكون سببا في الامتناع عن الأدلاء بالشهادة العادلة حتى ولو كانت نتيجتها لغير صالح الفقراء ، لأنّ الله أعلم من غيره بحال هؤلاء الذين تكون نتيجة الشهادة العادلة ضدهم ، فلا يستطيع صاحب الجاه والسلطان أن يضرّ بشاهد عادل يتمتع بحماية الله ، ولا الفقير سيبيت جوعانا بسبب تحقيق العدالة ، تقول الآية في هذا المجال: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما}.
وللتأكيد أكثر تحكم الآية بتجنّب اتّباع الهوى ، لكي لا يبقى مانع أمام سير العدالة وتحقيقها إذ تقول الآية : {فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا} (3) .
ويتّضح من هذه الجملة ـ بجلاء ـ أن مصدر الظلم والجور كلّه ، هو اتّباع الهوى ، فالمجتمع الذي لا تسوده الأهواء يكون بمأمن من الظلم والجور.
ولأهمية موضوع تحقيق العدالة ، يؤكّد القرآن هذا الحكم مرّة أخرى ، فيبيّن أنّ الله ناظر وعالم بأعمال العباد ـ فهو يشهد ويرى كل من يحاول منع صاحب الحق عن حقّه ، أو تحريف الحق ، أو الأعراض عن الحق بعد وضوحه ، فتقول الآية : {وَإِنْ تَلْوُوا (4) أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً}.
وجملة {إِنْ تَلْوُوا} تشير ـ في الواقع ـ إلى تحريف الحق وتغييره ، بينما تشير جملة «تعرضوا» إلى الامتناع عن الحكم بالحق ، وهذا هو ذات الشيء المنقول عن الإمام الباقر عليه السلام (5) .
والطريف أن الآية اختتمت بكلمة {خَبِيراً} ولم تختتم بكلمة «عليما» لأنّ كلمة «خبير» تطلق بحسب العادة على من يكون مطلعا على جزئيات ودقائق موضوع معين ، وفي هذا دلالة على أن الله يعلم حتى أدنى انحراف يقوم به الإنسان عن مسير الحق والعدل بأي عذر أو وسيلة كان ، وهو يعلم كل موطن يتعمد فيه إظهار الباطل حقا ، ويجازي على هذا العمل.
وتثبت الآية اهتمام الإسلام المفرط بقضية العدالة الاجتماعية ، وإن مواطن التأكيد المتكررة في هذه الآية تبيّن مدى هذا الاهتمام الذي يوليه الإسلام لمثل هذه القضية الإنسانية الاجتماعية الحساسة ، وممّا يؤسف له كثيرا أن نرى الفارق الكبير بين عمل المسلمين وهذا الحكم الإسلامي السامي ، وإن هذا هو سرّ تخلف المسلمين.
* * *
أنّ الكلام في الآية موجه إلى جمع من مؤمني أهل الكتاب الذين قبلوا الإسلام ، ولكنهم لعصبيات خاصّة أبوا أن يؤمنوا بما جاء قبل الإسلام من أنبياء وكتب سماوية غير الدين الذي كانوا عليه ، فجاءت الآية توصيهم بضرورة الإيمان والإقرار والاعتراف بجميع الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية ، لأنّ هؤلاء جميعا يسيرون نحو هدف واحد ، وهم مبعوثون من مبدأ واحد (علما بأن لكل واحد منهم مرتبة خاصّة به ، فكل واحد منهم جاء ليكمل ما أتى به النّبي أو الرّسول الذي سبقه من شريعة ودين).
ولذلك فلا معنى لقبول البعض وإنكار البعض الآخر من هؤلاء الأنبياء والرسل، فالحقيقة الواحدة لا يمكن التفريق بين أجزائها ، وأنّ العصبيات ليس بإمكانها الوقوف أمام الحقائق ، لذلك تقول الآية الكريمة : {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ...}.
وبعض النظر عن سبب النّزول المذكور ، فإنّنا لدى تفسيرنا لهذه الآية نحتمل أن يكون الخطاب موجها فيها لعامّة المؤمنين ، أولئك الذين اعتنقوا الإسلام إلّا أنّه لم يتغلغل بعد في أعماق قلوبهم ، ولهذا السبب يطلب منهم أن يكونوا مؤمنين من أعماقهم.
كما يوجد احتمال آخر ، وهو أنّ الكلام في هذه الآية موجه لجميع المؤمنين الذين آمنوا بصورة إجمالية بالله والأنبياء ، إلّا أنّهم ما زالوا لم يتعرفوا على جزئيات وتفاصيل العقائد الإسلامية .
ومن هذا المنطلق يبيّن القرآن أنّ المؤمنين الحقيقيين يجب أن يعتقدوا بجميع الأنبياء والكتب السماوية السابقة وملائكة الله ، لأن عدم الإيمان بالمذكورين يعطي مفهوم إنكار حكمة الله ، فهل يمكن أن يترك الله الحكيم الملل السابقة بدون قائد أو زعيم يرشدهم في حياتهم ؟! وهل أنّ الملائكة المعنيين بالآية هم ملائكة الوحي ـ فقط ـ الذين يعد الإيمان بهم جزءا لا يتجزأ من الإيمان الضروري بالأنبياء والكتب السماوية ، أو أنّهم جميع الملائكة؟ فكما أن بعض الملائكة مكلّفون بأمر الوحي والتشريع ، يلتزم جمع آخر منهم بتدبير وإرادة عالم الكون والخليقة ؛ وإن الإيمان بهم في الحقيقة جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقد بيّنت الآية ـ في آخرها ـ مصير الذين يجهلون هذه الحقائق ، حيث قالت : {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً}.
وفي هذه الآية اعتبر الإيمان واجبا وضروريا بخمسة مبادئ ، فبالإضافة إلى ضرورة الإيمان بالمبدأ والمعاد ، فإن الإيمان لازم وضروري بالنسبة إلى الكتب السماوية والأنبياء والملائكة.
إنّ عبارة «ضلال بعيد» عبارة دقيقة ، وتعني أنّ الذين لا يؤمنون بالمبادئ الخمسة المارة الذكر ، قد انجرفوا خارج الصراط أو الطريق المبدئي ، وأن عودتهم إلى هذا الطريق لا تتحقق بسهولة .
__________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 323-337 .
2. تفسير المنار ، الجزء الخامس ، ص ٤٥٥.
3. يمكن أن تكون عبارة «تعدلوا» اشتقاقا إمّا من مادة «العدالة» أو من مادة «العدول» فإن كانت من مادة «العدالة» يكون معنى الجملة القرآنية هكذا : فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا أي لكي تستطيعوا تحقيق العدل ، وأما إذا كانت من مادة «العدول» يكون المعنى هكذا : فلا تتبعوا الهوى في أن تعدلوا أي لا تتبعوا الهوى في سبيل الانحراف عن الحق .
4. إن عبارة «تلووا» مشتقة من المصدر «لي» على وزن «طي» وتعني المنع والإعاقة وقد وردت في الأصل بمعنى اللي والبرم .
5. تفسير التبيان ، الجزء الخامس ، ص ٣٥٦.



|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|