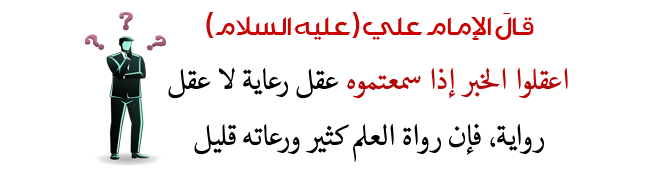
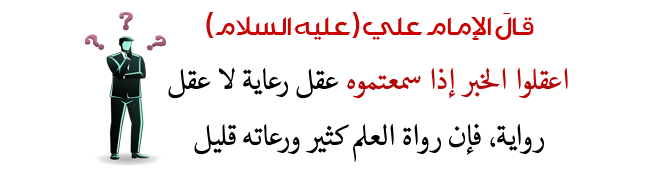

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017
التاريخ: 24-2-2017
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 3-2-2017
|
قال تعالى : { فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} [النساء : 88-90] .
عاد الكلام إلى ذكر المنافقين فقال تعالى : {فما لكم} أيها المؤمنون صرتم {في} أمر هؤلاء {المنافقين فئتين} : أي فرقتين مختلفتين ، فمنكم من يكفرهم ، ومنكم من لا يكفرهم {والله أركسهم بما كسبوا} : أي ردهم إلى حكم الكفار ، بما أظهروا من الكفر ، عن ابن عباس . وقيل : معناه أهلكهم بكفرهم ، عن قتادة . وقيل : خذلهم فأقاموا على كفرهم ، وترددوا فيه ، فأخبر عن خذلانه إياهم بأنه أركسهم ، عن أبي مسلم {أتريدون أن تهدوا} : أي تحكموا بهداية {من أضل الله} أي حكم الله بضلاله ، وسماه ضالا . وقيل : معنى أضله الله : خذله ولم يوفقه ، كما وفق المؤمنين ، لأنهم لما عصوا وخالفوا ، استحقوا هذا الخذلان ، عقوبة لهم على معصيتهم : أي أتريدون الدفاع عن قتالهم ، مع أن الله حكم بضلالهم ، وخذلهم ، ووكلهم إلى أنفسهم . وقال أبو علي الجبائي ، معناه : أتريدون أن تهدوا إلى طريق الجنة من أضله تعالى عن طريق الجنة والثواب . وطعن على القول الأول بأنه لو أراد التسمية والحكم ، لقال من ضلل الله . وهذا لا يصح ، لان العرب تقول أكفرته وكفرته ، قال الكميت :
وطائفة قد أكفروني بحبكم * وطائفة قالوا مسيء ومذنب
وأيضا فإنه تعالى ، إنما وصف بهدايتهم ، بأن سماهم مهتدين ، لأنهم كانوا يقولون إنهم مؤمنون ، فقال تعالى : لا تختلفوا فيهم وقولوا بأجمعكم إنهم منافقون .
{ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا} معناه : ومن نسبه الله إلى الضلالة ، فلن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته ، كما يقال : من جرحه الحاكم ، فلا ينفعه تعديل غيره .
وقيل : معناه من يجعله الله في حكمه ضالا ، فلن تجد له في ضلالته حجة ، عن جعفر بن حرث قال : ويدل على أنهم هم الذين اكتسبوا ما صاروا إليه من الكفر ، دون أن يكون الله تعالى اضطرهم إليه قوله على أثر ذلك : {ودوا لو تكفرون كما كفروا} فأضاف الكفر إليهم .
ثم بين تعالى أحوال هؤلاء المنافقين فقال {ودوا} : أي ود هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم في أمرهم ، يعني تمنوا {لو تكفرون} أنتم بالله ورسوله {كما كفروا} هم {فتكونون سواء} : أي فتستوون أنتم وهم ، وتكونون مثلهم كفارا ، ثم نهى تعالى المؤمنين أن يوادوهم ، فقال {فلا تتخذوا منهم أولياء} : أي فلا تستنصروهم ، ولا تستنصحوهم ، ولا تستعينوا بهم في الأمور {حتى يهاجروا} : أي حتى يخرجوا من دار الشرك ، ويفارقوا أهلها المشركين بالله {في سبيل الله} : أي في ابتغاء دينه ، وهو سبيله ، فيصيروا عند ذلك مثلكم ، لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، وهذا قول ابن عباس . وإنما سمي الدين سبيلا وطريقا ، لان من يسلكه أداه إلى النعمة ، وساقه إلى الجنة {فإن تولوا} : أي أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله ، عن ابن عباس {فخذوهم} أيها المؤمنون {واقتلوهم حيث وجدتموهم} : أي أين أصبتموهم من أرض الله من الحل والحرم . {ولا تتخذوا منهم وليا} : أي خليلا {ولا نصيرا} : أي ناصرا ينصركم على أعدائكم .
لما أمر تعالى المؤمنين بقتال الذين لا يهاجرون عن بلاد الشرك ، وإن لم يوالوهم ، استثنى من جملتهم فقال : {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق} معناه : إلا من وصل من هؤلاء إلى قوم بينكم وبينهم موادعة ، وعهد ، فدخلوا فيهم بالحلف أو الجوار ، فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم ، واختلف في هؤلاء : فالمروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المراد بقوله تعالى {قوم بينكم وبينهم ميثاق} هو هلال بن عويمر السلمي ، واثق عن قومه رسول الله ، فقال في موادعته :
"على أن لا تحيف يا محمد من أتانا ، ولا نحيف من أتاك " .فنهى الله أن يتعرض لأحد عهد إليهم ، وبه قال السدي ، وابن زيد .وقيل : هم بنو مدلج ، وكان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ، جاء إلى النبي بعد أحد ، فقال : أنشدك الله والنعمة .وأخذ منه ميثاقا أن لا يغزو قومه ، فإن أسلم قريش أسلموا ، لأنهم كانوا في عقد قريش .فحكم الله فيهم ما حكم في قريش ، ففيهم نزل هذا ، ذكره عمر بن شيبة ، ثم استثنى لهم حالة أخرى ، فقال : {أو جاؤوكم حصرت صدورهم} : أي ضاقت قلوبهم من {أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم} يعني من قتالكم ، وقتال قومهم ، فلا عليكم ولا عليهم ، وإنما عني به (2) أشجع ، فإنهم قدموا المدينة في سبعمائة ، يقودهم مسعود بن دخبلة ، فأخرج إليهم النبي أحمال التمر ضيافة ، وقال : " نعم الشيء الهدية أمام الحاجة " وقال لهم : " ما جاء بكم " ؟ قالوا : " لقرب دارنا منك ، وكرهنا حربك ، وحرب قومنا " يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهد ، لقلتنا فيهم ، فجئنا لنوادعك .فقبل النبي ذلك منهم ، ووادعهم ، فرجعوا إلى بلادهم .
ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره ، فأمر الله تعالى المسلمين ، أن لا يتعرضوا لهؤلاء {ولو شاء الله لسلطهم عليكم} بتقوية قلوبهم ، فيجترئون على قتالكم . وقيل : هذا إخبار عما في المقدور ، وليس فيه أنه يفعل ذلك بأن يأمرهم به ، أو يأذن لهم فيه ، ومعناه أنه يقدر على ذلك لو شاء ، لكنه لا يشاء ذلك ، بل يلقي في قلوبهم الرعب ، حتى يفزعوا ، أو يطلبوا الموادعة ، ويدخل بعضهم في حلف من بينكم وبينهم ميثاق {فلقاتلوكم} : أي لو فعل ذلك لقاتلوكم {فإن اعتزلوكم} يعني : هؤلاء الذين أمر بالكف عن قتالهم ، بدخولهم في عهدكم ، أو بمصيرهم إليكم ، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم {فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم} يعني : صالحوكم ، واستسلموا لكم ، كما يقول القائل : ألقيت إليك قيادي ، وألقيت إليك زمامي ، إذا استسلم له ، وانقاد لأمره . والسلم : الصلح .
{فما جعل الله لكم عليهم سبيلا} يعني إذا سالموكم ، فلا سبيل لكم إلى نفوسهم وأموالهم .قال الحسن وعكرمة : نسخت هذه الآية والتي بعدها ، والآيتان في سورة الممتحنة : {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} إلى قوله {الظالمون} الآيات الأربع بقوله {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية .
__________________________
1. مجمع البيان ، ج3 ، ص 150-153 .
2. لعل السياق يقتضي إضافة " بنو " ، وهي محذوفة من الأصل .
{ فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ } . نزلت هذه الآيات في خصوص المنافقين الذين بقوا في دار الكفر ، ولم يهاجروا إلى المدينة بدليل قوله تعالى : { حَتَّى يُهاجِرُوا } لأن الهجرة إنما تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام ، وقبل فتح مكة كانت المدينة هي الدار الوحيدة للإسلام . . وظاهر هذه الآيات صريح في أن حكم من نافق ، وبقي في دار الكفر غير حكم من نافق وهو مقيم في دار الإسلام ، لأن اللَّه سبحانه أمر بقتل أولئك وأسرهم ، دون هؤلاء . . وقبل أن ينزل هذا الأمر من السماء اختلف الصحابة ، وانقسموا فئتين في حكم المنافقين الذين بقوا في دار الكفر : فئة ترى مقاطعتهم وعدم الاستعانة بهم في شيء ، بل وإعلان الحرب عليهم ، تماما كمن جاهر بالشرك وعداء المسلمين . وفئة ترى التساهل والتسامح ، وان يعاملوا معاملة المسلمين .
ويظهر ان النبي (صلى الله عليه وآله) سكت عن هذا الخلاف ، حتى حسمه اللَّه بقوله :
{ فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ } أي لا ينبغي أن تختلفوا في أمرهم ، بل عليكم أن تجمعوا قولا واحدا على عدم التساهل معهم بحال ، وبيّن سبحانه السبب الموجب بقوله : { واللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا } أي رد حكمهم إلى حكم الكفار المحاربين من جواز قتلهم وسبيهم ، لأنهم كالكافر المحارب ، أو أشد ضررا بسبب بقائهم في دار الشرك الذي لا يستفيد منه إلا عدو الإسلام والمسلمين .
الإضلال من اللَّه سلبي لا إيجابي :
{ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ } . هذا يشعر بأن الفئة المتسامحة من المسلمين كانت تأمل أن يعود هؤلاء المنافقون إلى الهداية ، فقطع اللَّه أملهم بقوله :
{ ومَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا } . وتسأل : لقد أخبر أولا ، عظمت كلمته ، انه أركس أولئك المنافقين بسبب كسبهم وسوء اختيارهم للبقاء في دار الكفر . . ثم قال سبحانه : انه هو الذي أضلهم . . فأضاف إضلالهم إليه بعد ان أضافه إليهم ، فما هو وجه الجمع ؟ .
الجواب : ليس المراد بمن أضل اللَّه ويضلل اللَّه خلق الإضلال فيهم . .
كلا ، وإنما المراد ان من حاد عن طريق الحق والهداية بإرادته ، وسلك طريق الباطل والضلال باختياره فإن اللَّه يعرض عنه ، ويدعه وشأنه . . وليس من شك ان من أوكله اللَّه إلى نفسه لا يجد سبيلا إلا الضلال ، والجور عن القصد ، وهذا المعنى ينسجم مع قوله تعالى : { واللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا } كل الانسجام .
وبتعبير أوضح : كل من سلك طريق الحق فإن اللَّه يشمله بعنايته ، ويرعاه بتوفيقه : { إِنَّ اللَّهً مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل : 28] . وهذه العناية من اللَّه بالمتقين تسمى هداية وتوفيقا وولاية ووكالة من اللَّه ، وما إلى ذلك . .
وكل من سلك طريق الباطل فإن الله يعرض عنه ، ولا يرده إلى الهداية قسرا ، ويلجئه إليها إلجاء . وهذا الإعراض منه تعالى يسمى إضلالا وخذلانا واركاسا ، وما إليه . . وبكلمة واحدة ان الإضلال من اللَّه معناه سلبي ، لا إيجابي ، ومعنى الهداية منه إيجابي بنحو من اللطف والتدبير .
ولا بد من التنبيه إلى ان حكمة اللَّه سبحانه تستدعي ان يلطف بعبده ، ولا يتخلى عنه ، تماما كما لا تتخلى الوالدة عن وليدها إلا إذا كان العبد هو السبب الموجب لتخلي اللَّه عنه لولوجه في العصيان والتمرد كما تتخلى الأم عن ابنها الذي أوغل في العقوق .
{ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً } . كل إنسان يود أن يكون جميع الناس على شاكلته . وسبق تفسيره في المجلد الأول ص 173 الآية 109 من سورة البقرة .
{ فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } . بعد أن هاجر رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة أوجب سبحانه الهجرة إليها على كل من أسلم إلا إذا عجز عنها ، أو أذن له الرسول لبقاء لمصلحة تعود على المسلمين . . ومن الآيات التي حث اللَّه بها على الهجرة قوله تعالى : {والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا} [الأنفال : 72] . والسر - كما يبدو لنا - ان المسلمين كانوا قلة قبل فتح مكة ، فإذا تفرقوا هنا وهناك ضعفوا وطمع بهم العدو ، وإذا اجتمعوا في مكان واحد حول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قويت شوكتهم ، وهابهم من يطمع بهم وهم متفرقون . . هذا إلى فوائد كثيرة تترتب على الاجتماع والانضمام . . وبقيت الهجرة إلى المدينة واجبة ، حتى فتح النبي مكة ، ونصره اللَّه على أعدائه ، ودخل الناس في دين اللَّه أفواجا ، ولم يبق للهجرة من سبب . . قال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) : « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية » .
{ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } . أي ان أولئك المنافقين إذا لم يتركوا دار الكفر ويهاجروا إلى المدينة ، وينضموا إلى الرسول والمسلمين فخذوهم أي أأسروهم ، واقتلوهم أينما ظفرتم بهم { ولا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا ولا نَصِيراً } . المراد بالوالي هنا الحليف ، والنصير معروف ، والقصد ان يعرضوا عنهم إعراضا كليا ، فلا يستنصحوهم ولا يستنصروهم ولا يستعينوا بهم في شيء .
وتسأل : ان الإسلام دين الحرية والتسامح مع جميع الطوائف وأهل الأديان ، وشريعته تحافظ على حياة الناس ، كل الناس ، وحقوقهم المعنوية والمادية ، بصرف النظر عن آرائهم ومعتقداتهم . . فما باله هنا يأمر بأسر المنافقين وقتلهم أينما وجدوا ؟ .
الجواب : فرق بعيد بين الطوائف وأهل الأديان ، بل والملحدين الذين أعلنوا عقائدهم وآراءهم على الملأ ، ولم يضمروا العداء لإنسان ، ولا غدروا ولا تآمروا ولا ناصروا مبطلا على محق ، فرق بعيد بين هؤلاء الذين لزموا جانب الحياد ، وبين المنافقين الذين أظهروا الإسلام ، وتستروا بكلمته ، وبقوا في دار الكفر بقصد الكيد للمسلمين ، والتآمر عليهم ، ومناصرة أعدائهم . . إذن : الأمر بأسر هؤلاء وقتلهم كان جزاء على عدائهم للإسلام في حين أنهم أظهروا الإيمان به وأضمروا الكيد للنبي والمسلمين والغدر بهم ، والتآمر عليهم . . أما تسامح الإسلام مع بقية الطوائف وأهل الأديان فهو انسجام مع مبدأه في حماية الحرية لكل فرد ، وعدم الإكراه في الرأي والعقيدة حقا كانت أو باطلا ، ما دام وزرها على صاحبها فحسب ، والناس في أمن منها ومنه .
سؤال ثان : وشى به الجواب عن السؤال السابق ، وهو ان الإسلام يتسامح مع المنافقين ، تماما كما يتسامح من غيرهم من الطوائف وأهل الأديان بدليل ان اللَّه أمر نبيه بتجاهلهم والأغضاء عنهم ، كما سبق في الآية 63 من هذه السورة :
{ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وعِظْهُمْ وقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً } ؟ .
الجواب : ان هذه الآية أي 63 نزلت في المنافقين الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وآله) بالمدينة ، ولم يكن في وسع هؤلاء أن يتعاونوا مع المشركين لبعدهم عنهم وقربهم من الرسول وقوة المسلمين ، والآية التي نحن بصددها ، أي 89 نزلت في المنافقين الذين أصروا على البقاء في دار الشرك للكيد والغدر بالمسلمين . . هذا ، إلى أن اللَّه أمر نبيه بالإغضاء عن المنافقين حين كان الإسلام ضعيفا قليل الأنصار ، ثم أمره بقتلهم بعد أن أصبح قويا كثير الأنصار ، تماما كما أمره بالصبر في مكة ، والجهاد في المدينة .
وبعد ان أمر اللَّه بالتنكيل بأولئك المنافقين الأعداء الألداء استثنى منهم صنفين :
وأشار إلى الصنف الأول بقوله : { إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ } . يريد بهذا جل وعلا ان من يلتجئ من أولئك المنافقين إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد في المهادنة وترك القتال ، ان هذا اللاجئ يترك لا يؤسر ولا يقتل ، لأنه - والحال هذه - يكون مسالما للمسلمين ، تماما كالذين التجأ إليهم ، فيعامل معاملتهم في عدم التعرض له . . ومن المفيد أن ننقل ما قاله الرازي - هنا - :
« اعلم ان هذا يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان ، لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ إلى من التجأ إلى المسلمين فبالأولى أن يرفع العذاب في الآخرة عمن التجأ إلى محبة اللَّه ومحبة رسوله » .
وليس من شك ان محبة أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله) هي محبة للَّه وللرسول ، لقوله تعالى : { قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى} [ الشورى : 23 ] .
وأشار إلى الصنف الثاني بقوله : { أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ } . أي ان الذين يتحرجون أن يحاربوا المسلمين مع قومهم المشركين ، أو يحاربوا قومهم مع المسلمين ، وجاؤا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يطلبون منه الرضا بالوقوف على الحياد ، لا معه ولا عليه ، ان هؤلاء يتركون أيضا ، لا يقتل ولا يؤسر أحد منهم ، لأنهم غير محاربين . وخير مثال يفسر هذه الآية ما جاء في مجمع البيان ان جماعة من أشجع جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ، وقالوا له : ان دارنا قريبة من دارك ، وقد كرهنا حربك ، وحرب قومنا ، وأتينا لنوادعك ، فقبل منهم ، ووادعهم . فرجعوا إلى بلادهم .
ولا شيء أقوى وأصدق من هذا في الدلالة على ان الإسلام سلم لمن سالمه ، وحرب على من حاربه .
{ ولَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ } . ان اللَّه سبحانه لا يتدخل بمشيئته التكوينية (2) في شيء من أمور الناس ، وإنما أراد بقوله هذا ان يذكّر المسلمين بفضله عليهم . . وانه كان من الممكن أن ينضم هؤلاء إلى أعداء المسلمين ، ولكن اللَّه سبحانه صرفهم عن ذلك بوقوفهم على الحياد ، فقوله : {ولَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ} معناه لجرأهم عليكم ، ولم يجعل لكم هيبة في نفوسهم تبعثهم على طلب الموادعة والمتاركة . . وليس هذا من باب المشيئة التكوينية ، بل من المشيئة التوفيقية ، ان صح التعبير .
{ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا } .
{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ويَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى : 42 ] . . وأيضا قال عز من قائل : {لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة : 8] . .
وقال جلت حكمته : { وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها } [الأنفال : 62 } . إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى المحبة والأخوة والمساواة ، والتعاون على كل ما فيه صلاح للناس بجهة من الجهات . . وأروع ما في الإسلام انه يعتبر الأعمال الإنسانية من صميم الدين وصلبه ، بل يعتبرها السبيل الوحيد إلى اللَّه .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 399-402 .
2. تكلمنا عن إرادة اللَّه التكوينية والتشريعية عند تفسير الآية 26 - 27 من سورة البقرة ، فقرة التكوين والتشريع ، المجلد الأول ، ص 27 .
قوله تعالى : { فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ } (الآية) الفئة الطائفة ، والإركاس الرد .
والآية بما لها من المضمون كأنها متفرعة على ما تقدم من التوطئة والتمهيد أعني قوله { مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً } (الآية) ، والمعنى : فإذا كانت الشفاعة السيئة تعطي لصاحبها كفلا من مساءتها فما لكم أيها المؤمنون تفرقتم في أمر المنافقين فئتين ، وتحزبتهم حزبين : فئة ترى قتالهم ، وفئة تشفع لهم وتحرض على ترك قتالهم ، والإغماض عن شجرة الفساد التي تنمو بنمائهم ، وتثمر برشدهم ، والله ردهم إلى الضلال بعد خروجهم منه جزاء بما كسبوا من سيئات الأعمال ، أتريدون بشفاعتكم أن تهدوا هؤلاء الذين أضلهم الله؟ ومن يضلل الله فما له من سبيل إلى الهدى.
وفي قوله « وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً » التفات من خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله إشارة إلى أن من يشفع لهم من المؤمنين لا يتفهم حقيقة هذا الكلام حق التفهم ، ولو فقهه لم يشفع في حقهم فأعرض عن مخاطبتهم به وألقى إلى من هو بين واضح عنده وهو النبي صلى الله عليه وآله.
قوله تعالى : { وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً } (إلخ) هو بمنزلة البيان لقوله { وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ } ، والمعنى : أنهم كفروا وزادوا عليه أنهم ودوا وأحبوا أن تكفروا مثلهم فتستووا .
ثم نهاهم عن ولايتهم إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فليس عليكم فيهم إلا أخذهم وقتلهم حيث وجدتموهم ، والاجتناب عن ولايتهم ونصرتهم ، وفي قوله { فَإِنْ تَوَلَّوْا } . دلالة على أن على المؤمنين أن يكلفوهم بالمهاجرة فإن أجابوا فليوالوهم ، وإن تولوا فيقتلوهم .
قوله تعالى : {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} استثنى الله سبحانه من قوله {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ} ، طائفتين : (إحداهما) { الَّذِينَ يَصِلُونَ} (إلخ) أي بينهم وبين بعض أهل الميثاق ما يوصلهم بهم من حلف ونحوه ، و ( الثانية ) الذين يتحرجون من مقاتلة المسلمين ومقاتلة قومهم لقتلهم أو لعوامل أخر ، فيعتزلون المؤمنين ويلقون إليهم السلم لا للمؤمنين ولا عليهم بوجه ، فهاتان الطائفتان مستثنون من الحكم المذكور ، وقوله {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} ، أي ضاقت .
_________________________
1. تفسير الميزان ، ج5 ، ص 27- 28.
قال تعالى : { فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ....} .
هذه الآية تخاطب في البداية المسلمين وتلومهم على انقسامهم إلى فئتين ، كل فئة تحكم بما يحلو لها بشأن المنافقين ، حيث تقول : {فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ ...} (٢) وتنهي المسلمين عن الاختلاف في أمر نفر أبوا أن يهاجروا معهم ، وتعاونوا مع المشركين ، وأحجموا عن مشاركة المجاهدين ، فظهر بذلك نفاقهم ، ودلت على ذلك أعمالهم ، فلا يجوز للمسلمين أنّ ينخدعوا بتظاهر هؤلاء بالتوحيد والإيمان ، كما لا يجوز لهم أن يشفعوا في هؤلاء ، وقد أكّدت الآية السابقة أن : {مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها} .
وتبيّن الآية بعد ذلك : إنّ الله قد سلب من هؤلاء المنافقين كل فرصة للنجاح ، وحرمهم من لطفه وعنايته بسبب ما اقترفوه وإنّ الله قد قلب تصورات هؤلاء بصورة تامّة فأصبحوا كمن يقف على رأسه بدل رجليه : {... وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا ...}(٣) .
وتدل عبارة «بما كسبوا» على أنّ كل ارتداد أو خروج عن جادة الحقّ وطريق الهداية والسعادة والنجاة ، إنّما يتمّ بعمل الإنسان وفعله ، وحين ينسب الإضلال إلى الله سبحانه عزوجل ، فذلك معناه أنّ الله القدير الحكيم يجازي كل إنسان بما كسبت يداه ويثيبه بقدر ما يستحق من ثواب.
وفي الختام تخاطب الآية أولئك البسطاء من المسلمين الذين انقسموا على أنفسهم وأصبحوا يدافعون لسذاجتهم عن المنافقين ، فتؤكد لهم أنّ هداية من حرمه الله من لطفه ورحمته بسبب أفعاله الخبيثة الشنيعة أمر لا يمكن تحقيقه ، لأنّ الله قد كتب على هؤلاء المنافقين ما يستحقونه من عذاب وضلال وحرمان من الهداية والنجاة {أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً}.
إذ أنّ عمل كل شخص لا ينفصل عنه ... وهذه سنة إلهية ... فكيف يؤمل في هداية أفراد امتلأت أفكارهم وقلوبهم بالنفاق ، واتجهت أعمالهم إلى حماية أعداء الله؟! إنّه أمل لا يقوم على دليل (4) .
قال تعالى : { وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ..} .
هذه الآية تبيّن أنّ المنافقين لفرط انحرافهم وضلالتهم يعجبهم أن يجروا المسلمين إلى الكفر كي لا يظلوا وحدهم كافرين : {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً} .
ولهذا السبب فإنّ المنافقين أسوأ من الكفار ، لأنّ الكافر لا يحاول سلب معتقدات الآخرين ، والمنافقون يفعلون هذا الشيء ويسعون دائما لإفساد المعتقدات ، وهم بطبعهم هذا لا يليقون بصحبة المسلمين أبدا ، تقول الآية الكريمة : {فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ ...} إلّا إذا غيروا ما في أنفسهم من شرّ ، وتخلوا عن كفرهم ونفاقهم وأعمالهم التخريبية .
ولكي يثبتوا حصول هذا التغيير ، ويثبتوا صدقهم فيه ، عليهم أن يبادروا إلى الهجرة من مركز الكفر والنفاق إلى دار الإسلام (أي يهاجروا من مكّة إلى المدينة) فتقول الآية : {حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ...} أمّا إذا رفضوا الهجرة فليعلم المسلمون بأن هؤلاء لا يرضون لأنفسهم الخروج من حالة الكفر والنفاق ، وإن تظاهرهم بالإسلام ليس إلّا من أجل تمرير مصالحهم وأهدافهم الدنيئة ومن أجل أن يسهل عليهم التآمر والتجسس على المسلمين.
وفي هذه الحالة يستطيع المسلمون أن يأسروهم حيثما وجدوهم ، وأن يقتلوهم إذا استلزم الأمر ، تقول الآية الكريمة : {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .
وتكرر هذه الآية التأكيد على المسلمين أن يتجنّبوا مصاحبة هؤلاء المنافقين وأمثالهم فتقول : {لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً} .
والقرآن في هذا الحكم يؤكّد حقيقة مصيرية للمجتمع ، هي أنّ حياة أي مجتمع تمرّ بمرحلة إصلاحية لا يمكن أن تستمر بصورة سليمة ما لم يتخلص من جراثيم الفساد المتمثلة بهؤلاء المنافقين أو الأعداء الذين يتظاهرون بالإخلاص ، وهم في الحقيقة عناصر مخربة هدامة تعمل في التآمر والتجسس على المجتمع ومصالحه العامّة.
والطريف هنا أنّ الإسلام ـ مع اهتمامه برعاية أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم ومنعه الظلم والعدوان عنهم ـ نراه يشدد كثيرا في التحذير من خطر المنافقين ، ويرى ضرورة التعامل معهم بعنف وقسوة ، ورغم تظاهرهم بالإسلام يصرح القرآن بأسرهم ، بل حتى بقتلهم إن استلزم الأمر .
وما هذا التشديد إلّا لأنّ هؤلاء يستطيعون ضرب الإسلام تحت ستار الإسلام، وهذا ما يعجز عن أدائه أي عدو آخر .
سؤال :
قد يرى البعض أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحاشى قتل المنافقين كي لا يتهمه الأعداء بأنّه يقتل أصحابه ، أو أنّه لم يقتلهم حتى لا يستغل الآخرون هذا الأمر فيقتلون كل من يعادونه بدعوى أنّه منافق ، فكيف يتلاءم هذا الموقف مع الآية الشريفة.
الجواب :
الحقيقة أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم اتّبع هذا الأسلوب مع منافقي المدينة الذين لم يظهروا العداء الصريح له أو للإسلام ، بينما اتّبع مع منافقي مكّة الذين جهروا بعدائهم للمسلمين وساعدوا الكفار عليهم أسلوبا غير هذا .
قال تعالى : { إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ...} .
التّرحيب باقتراح السّلم :
بعد أن أمر القرآن الكريم المسلمين في الآيات السابقة باستخدام العنف مع المنافقين الذين يتعاونون مع أعداء الإسلام ، تستثني هذه الآية من الحكم المذكور طائفتين :
١ـ من كانت لهم عهود ومواثيق مع حلفائكم {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} .
٢ـ من كانت ظروفهم لا تسمح لهم بمحاربة المسلمين ، كما أنّ قدرتهم ليست على مستوى التعاون مع المسلمين لمحاربة قبيلتهم {أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ} .
ومن الواضح أنّ أفراد الطائفة الأولى يجب أن يكونوا مستثنين من هذا القانون احتراما للعقود والعهود ، وأمّا المجموعة الثانية ـ وإن لم تكن معذورة ، بل عليها أن تستجيب للحق بعد معرفته ـ فقد أعلنت حيادها ، ولذلك فمجابهتها يتعارض مع مبادئ العدالة والمروءة .
ولكي لا يستولي الغرور على المسلمين إزاء كل هذه الانتصارات الباهرة ، وكي لا يعتبروا ذلك نتيجة قدرتهم العسكرية وابتكارهم ، ولا تستفز مشاعرهم تجاه هذه المجموعات المحايدة تقول الآية : {وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ} .
وهذا تذكير للمسلمين بعدم نسيان الله في كل انتصار ، وأن يتجنّبوا الغرور والعجب حيال ما لديهم من قوّة ، وأن لا يعتبروا العفو عن الضعفاء خسارة أو ضررا لأنفسهم .
وتكرر الآية في ختامها التأكيد بأنّ الله لا يسمح للمسلمين بالمساس بقوم عرضوا عليهم الصلح وتجنبوا قتالهم ، وإن المسلمين مكلفون بأن يقبلوا دعوة الصلح هذه، ويصافحوا اليد التي امتدت إليهم وهي تريد الصلح والسلام {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} .
يلفت النظر أنّ القرآن في هذا الموضع ومواضع أخرى يذكر مقترح السلام بعبارة «إلقاء السلام» وقد يكون ذلك إشارة إلى التباعد بين الجانبين المتنازعين قبل الصلح ، حتى أنّ أحد الجانبين يطرح اقتراحه باحتياط وعن بعد ليلقيه على الجانب الآخر .
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 240- 245 .
2. في هذه الجملة ، جملة أخرى محذوفة تتضح لدى الإمعان في الأجزاء الاخرى من الآية والتقدير : «فما لكم تفرقتم في المنافقين فئتين ...».
3. «أركسهم» : من ركس وهو قلب الشيء على رأسه ، وتأتي أيضا بمعنى ردّ أوّل الشيء إلى آخره.
4. في المجلد الأول من هذا التّفسير بحث عن الهداية والضلالة ، فراجعه.



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|