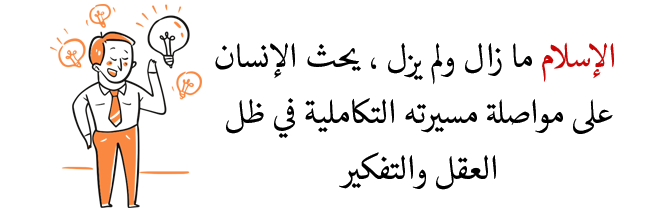
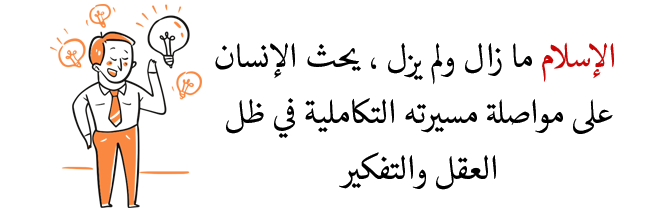

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
التاريخ: 5-11-2014
التاريخ: 18/12/2022
التاريخ: 5-11-2014
|
غير خفيّ أنّ ما يذكره تعالى حكاية عن أُمم سالفين إنما هو نقل بالمعنى ، ولا سيّما فيما يحكيه من أقوالهم ومحاججاتهم ، حيث كانت بلغة غير عربية وناقل المعنى في سعة من اللفظ حيث يشاء وحيث يتناسب مع مقصوده من الكلام ، ينقله تارةً طوراً وأخرى طوراً آخر ، وقد ينقل بعضه ويترك البعض ، حسب ما يراه من مناسبة المقام ، ومِن ثَمّ فهو في فسحة من النقل والحكاية .
قال الاسكافي : إنّ ما أخبر الله به من قصّة موسى وبني إسرائيل وسائر الأنبياء لم يقصد به حكاية الألفاظ بأعيانها ، وإنّما قصد اقتصاص معانيها ، وكيف لا يكون كذلك واللغة التي خوطبوا بها غير العربية ، فحكاية اللفظ إذاً زائلة ، وتبقى حكاية المعنى ، ومَن قصد حكاية المعنى كان مخيّراً بأيّ لفظ أراد ، وكيف شاء مِن تقديم وتأخير بحرف لا يدلّ على الترتيب كالواو . وعلى هذا يقاس نظائره في القرآن (1) .
وللكرماني (2) تصنيف لطيف في بيان ما لكل موضع من الآيات المكرّرة نكتة ظريفة ، استقصى فيها جميع ما في القرآن من التكرار ، قال ـ في مقدّمته ـ : هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات ( المتماثلات ) التي تكرّرت في القرآن وألفاظها متّفقة ، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان أو تقدم أو تأخير أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك ممّا يوجب اختلافاً بينها ... وأُبيّن السبب في تكرارها والفائدة في إعادتها ، والحكمة في تخصيص آية بشيء دون أُخرى ... .
نقتطف من أزهاره ما يلي :
1 ـ قوله تعالى في سورة البقرة : {يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا} [البقرة : 35] بالواو ، وفي سورة الأعراف : {فَكُلَا} [الأعراف : 19] بالفاء .
لأنّ ( اسكن ) في سورة البقرة يراد به الإقامة بالمكان ، وذلك يستدعي زماناً ممتداً ، فلم يصلح إلاّ بالواو ؛ لأنّ المعنى : اجمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها ، ولو كانت بالفاء لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة ؛ لأنّ الفاء للترتيب والتعقيب .
والذي في سورة الأعراف بمعنى اتخاذ السكنى ؛ لأنّه يقابل خطاب إبليس بالأمر بالخروج {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا} [الأعراف : 18] ، فكان خطاب آدم ( اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ) بمعنى اتخاذها مسكناً ، واتخاذ السكنى الآنيّ لا يستدعي زماناً ممتداً ، فكان الفاء أَولى ، أي كلا منها عقيب اتخاذها مسكناً ، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل ، بل يقع الأكل عقيب الاتخاذ (3) .
2 ـ ونظير ذلك أيضاً قوله في سورة البقرة {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ} [البقرة : 58] بالفاء ، وفي سورة الأعراف : {وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ } [الأعراف : 161] بالواو ؛ لأنّ الأكل لا يكون إلاّ بعد الدخول ، ولكنه يجتمع مع السكون بمعنى الإقامة في المسكن (4) .
3 ـ وزيد ( رغداً ) في البقرة ( 35 و58 ) ، ولم يرد في الأعراف ( 19و161 ) ؛ لأنّ الآيتين في البقرة بدئتا بقوله : ( قلنا ) فناسب التعظيم زيادة تشريف وتكريم ؛ ومِن ثَمّ كان زيادة ( رغداً ) .
أمّا في الأعراف فبُدئت الآية ( 19 ) بقوله : ( قال ) مفرداً ، والآية ( 161 ) بقوله : ( وإذ قيل ) من غير تشريف .
4 ـ وجاء في سورة الأنعام {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام : 151] ، وفي سورة الإسراء {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} [الإسراء : 31] ؛ لأنّ في الأنعام : ( من إملاق ) بكم ، وفي الإسراء : ( خشية إملاق ) يقع بهم (5) .
أي كان قتل الأولاد في سورة الأنعام مستنداً إلى فقر ومسكنة كان قد أقدع بهم فعلاً ، أمّا في سورة الإسراء فكان مستنداً إلى خوف المجاعة والفقر قد يعرضهم بسبب الأولاد .
5 ـ وجاء في سورة التوبة ـ خطاباً مع المنافقين ـ : {وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ } [التوبة : 94] ، ثمّ في آية أُخرى ـ خطاباً مع المؤمنين ممّن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً ـ : {فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ } [التوبة : 105] .
لأنّ المنافقين لا يطّلع على ضمائرهم إلاّ الله وما أخبر به رسوله ، كما في قوله : {قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ} [التوبة : 94].
أمّا المؤمنون فطاعاتهم وأعمالهم ظاهرة مكشوفة يراها سائر المؤمنين أيضاً .
وجاء بشأن المنافقين ( ثُمَّ تُرَدُّونَ ) ، وبشأن المؤمنين ( وَسَتُرَدُّونَ ) ؛ لأنّ الأُولى وعيد ، فهو عطف على الأًوّل ، وأمّا الثانية فهو وعد ، فبناه على ( فَسَيَرَى اللَّهُ ) (6) .
6 ـ قوله تعالى في سورة الكهف : {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف : 22].
قالوا : لِمَ زيدت الواو في ( وثامنهم ) ؟
قال بعض النحويّين : السبعة نهاية العدد ، ولهذا كثُر ذِكرها في القرآن والأخبار ، والثمانية تجري مجرى استئناف كلام ، ومِن هنا لقّبه جماعة من المفسّرين بواو الثمانية .
واستدلّوا بقوله تعالى : {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } [التوبة : 112] ، فقد جيء بالواو عندما زيدت الأوصاف على السبعة .
وبقوله تعالى : {مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا } [التحريم : 5] ، فلمّا بلغ الثامن جيء بالواو .
وبقوله تعالى : {وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} [الزمر : 73] ؛ لأنّ أبواب الجنة ثمانية (7) .
وهذا الوجه لم يرتضِه المصنّف ؛ ومِن ثَمّ ردّ عليه بقوله : ولكل واحد من هذه الآيات وجوه ذكرتها في موضعها .
أمّا الآية في سورة التوبة فلم يذكر لها شيئاً .
والآية في سورة التحريم قال فيها : ثُمّ ختم بالواو ، فقال ( وَأَبْكَاراً ) ؛ لأنّه استحال العطف على ثيّبات فعطفها على أَول الكلام ، ويحسن الوقف على ( ثَيّبَاتٍ ) ؛ لمّا استحال عطف ( َأَبْكَاراً ) عليها ، وقول مَن قال : إنّها واو الثمانية بعيد (8) .
وذكر في آية الزمر أنّها واو الحال (9) ، أي وقد فُتحت بتقديره ( قد ) .
وفي قوله تعالى من سورة القلم {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} [القلم : 10 - 13] قال : أوصاف تسعة ، ولم يُدخل بينها واو العطف ولا بعد السابع ، فدلّ على ضعف القول بواو الثمانية (10) .
قلت : هذا على تقدير أن يكون ( حلاّف ) وصفاً أَوّلاً ، في حين أنّه الموصوف ، والأوصاف إنما تَبتدئ من ( مهين ) .
وعليه فالأوصاف ثمانية وقد فُصل بين الثامن وما قبله بقوله ( بعد ذلك ) الذي هو بمنزلة الواو هنا .
7 ـ قوله في سورة الكهف : {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا} [الكهف : 71] ، وفي آية أُخرى {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا} [الكهف : 74] .
لأنّ الإمر هو الأمر العَجَب ، والعجب كل أمر خالف المألوف سواء أكان خيراً أم شراً .
وأمّا النُكر فهو الأمر المُنكر الذي يستقبحه العقل .
والآية الأُولى جاءت بشأن خرق السفينة ، بما لا يستلزم غرقها وإهلاك أهلها ... فلعلّ في ذلك سرّاً وحكمة ، لكنه خلاف المألوف ، فأثار العجب .
والآية الثانية جاءت بشأن قتل الغلام ، وهو طفل لا يعقل شيئاً ولم يرتكب إثماً ، فهو بظاهره قتل نفس محترمة ، وهو الأمر المنكر الذي يستقبحه العقل (11) .
8 ـ قوله : {أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ } [الكهف : 72] ، لكنه بعد ذلك قال : {أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ } [الكهف : 75] زيادةً في الإنكار عليه بزيادة توجيه الخطاب والعتاب إليه .
9 ـ قوله : {فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا} [الكهف : 79] ـ أَولاً ـ
وقوله : {فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ} [الكهف : 81] ـ ثانياً ـ
وقوله : {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا} [الكهف : 82] ـ ثالثاً ـ
ففي الأَول نسب ما ظاهره الإفساد إلى نفسه ؛ تنزيهاً لمقام قدسه تعالى عن نسبة الإفساد إليه .
وفي الثاني خليط من الإفساد والإنعام ؛ ومِن ثَمّ نسبه إلى نفسه مع غيره وهو الله تعالى .
لكن الثالث كان محص إنعام ؛ ومِن ثَمّ نسبه إلى الله خالصاً .
كل ذلك من أدب الكلام ، فتفهّم (12) .
10 ـ قوله تعالى في سورة الرحمن : {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ } [الرحمن : 7 - 9] .
كُرّر لفظ الميزان ثلاث مرات مع قرب الفاصلة ، وكان حقه حسب الظاهر الإضمار بعد ذكره أَوّلاً .
قيل : لأنّه في كل موضع بمعنى غير معناه الآخر ، فوجب الإظهار ؛ ليكون كل واحد مستقلاً بالإفادة ، وإلاّ لاحتاج إلى الاستخدام .
فالميزان الأَوّل هو النظام الكوني الحاكم على كل موجودات العام ، والثاني هو نظام الشريعة الحاكم على أفعال العباد وتصرّفاتهم ، والثالث هي آلة الوزن المعروفة (13) .
11 ـ قوله تعالى : { فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} كُرّرت إحدى وثلاثين مرّة :
ثمانية منها ذُكرت عقيب آيات فيها تعداد عجائب الخلق وبدائع الصنع ، والمبدأ والمعاد .
وسبعة منها عقيب آيات العقاب والنار وشدائد نقمته تعالى .
ثُمّ ثمانية منها عقيب وصف الجنّات ونعيمها .
وثمانية أخرى بعدها للجنتين وما حوتا عليه من نِعَم كبار (14) ، رزقنا الله التنعّم بنعمها الجسام العظام .
أما التذكير بالآلاء عقيب ذكر العقاب والنار فلأنّه أيضاً من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان ؛ لأنّ تكوين الشخصية المعتدلة ذو عاملين أساسيين ، عامل الخوف وعامل الرجاء ، فكما أنّ الوعد يُؤثّر في تربية النفس ترغيباً في الثواب ، كذلك الوعيد مؤثّر في التربية ترهيباً عن العقاب ، فكلاهما من الآلاء والنعم الإلهية لهذا الإنسان في سيبل تربيته .
قال الطبرسي : فأمّا الوجه لتكرار هذه الآية في هذه السورة فإنّما هو التقرير بالنعم المعدودة والتأكيد في التذكير بها كلّها . فكلّما ذَكر سبحانه نعمةً أنعم بها قرّر عليها ووبّخ على التكذيب بها ، كما يقول الرجل لغيره : أَما أحسنت إليك حين أطلقت لك مالاً ؟ أَما أحسنت إليك حين ملّكتك عقاراً ؟ أَما أحسنت إليك حين بنيت لك داراً ؟ ... فيحسن فيه التكرار ؛ لاختلاف ما يقرّره .
قال : ومثله كثير في كلام العرب وأشعارهم ، ثُمّ جعل ينشد أبياتاً قالها مهلهل بن ربيعة (15) يرثي أخاه كليباً ، وقصيدة ليلى الأخيليّة ترثي توبة بن الحمير ، وأبياتاً للحارث بن عبّاد ، قال : وفي أمثال هذا كثرة .
قال : وهذا هو الجواب بعينه بشأن التكرار في سورة المرسلات ، قوله تعالى : ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) ... عشر مرّات (16) .
12 ـ قوله : ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) مكرّر عشر مرّات في سورة المرسلات .
إذ من عادة العرب التكرار والإطناب ، كما في عادتهم الاقتصار والإيجاز ؛ ولأنّ بسط الكلام في الترغيب والترهيب أدعى إلى إدراك البغية من الإيجاز (17) .
13 ـ التكرار في سورة ( الكافرون ) (18) .
قيل : هذا التكرار اختصار في الكلام وهو إعجاز ؛ لأنّ الله نفى عن نبيّه عبادة الأصنام فيما مضى والحال وفيما يأتي . ونفى عن الكفّار ـ وهم رهط من قريش مخصوصون ؛ لأنّ اللام للعهد الخارجي ـ عبادة الله في الأزمنة الثلاثة أيضاً ، فكان من حقّ الكلام أن يأتي بست فقرات تدلّ على هذه الأُمور الستة ، لكنّه اختصر في العبارة المذكورة الموجزة .
قوله تعالى : ( لا أَعبدُ ما تعبدونَ ) نُفي في الحال وما يأتي ، أي لا أعبد اليوم ولا بعد اليوم ما تعبدون اليوم .
( ولا أَنتُم عابدونَ ما أعبدُ ) كذلك ... أي لا تعبدون اليوم ولا بعد اليوم ما أعبد اليوم .
( ولا أَنا عابدٌ ما عبدتُم ) نُفي في الماضي وتعليل لِما تقدّمه ؛ لأنّ اسم الفاعل يصلح للأزمنة الثلاثة ، أي لم أعبد ما عبدتم قبل اليوم ، فكيف ترجون عبادتي اليوم لما عبدتم وتعبدونه ؟!
( ولا أَنتم عابدونَ ما أَعبدُ ) أي ولا أنتم عبدتم ما أعبد اليوم .
وبذلك افترق المعنى في الآية ، تلك للنفي في الحال والآتي ، وهذه للنفي في الماضي (19) .
* * *
وقال الفرّاء ـ في وجه التكرار ـ : إنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب كلامهم ومحاوراتهم ، ومن عادتهم تكرير الكلام ؛ للتأكيد والإفهام ، فيقول المجيب : بلى ، بلى . ويقول الممتنع : لا ، لا .
قال : ومثله قوله تعالى : {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر : 3، 4].
وأنشد :
وكائنٌ وكم عندي لهُم مِن صنيعةٍ أيـادي ثـنّوها عـليَّ iiوأَوجبوا
وأيضاً :
كَم نعمْ كانتْ لكم كَـمْ كَـمْ iiوكَـمْ
وقال آخر :
نَعَق الغرابُ ببين ليلى غدوةً كمْ كمْ وكم بفراقِ ليلٍ iiيَنعقُ
وأيضاً :
هلاّ سألتَ جُموعَ كِندَةَ يـومَ وَلّـوا أَينَ أَينا
وقوله :
أردتُ لنفسي بعضَ الأُمورِ فـأَولى لـنفسي أَولى لها
قال : وهذا أَولى المواضع بالتأكيد ؛ لأنّ الكافرين أَبدأوا في ذلك وأعادوا .
فكرّر سبحانه ؛ ليؤكّد إياسهم وحسم أطماعهم بالتكرير (20) .
__________________________________
(1) درة التنزيل : ص17 ، هامش أسرار التكرار : ص28 .
(2) هو العلاّمة الأديب محمود بن حمزة بن نصر الكرماني . قال ياقوت : كان حدود سنة خمسمِئة وتوفي بعدها .
(3) أسرار التكرار : ص25 ـ 26 رقم 11 .
(4) أسرار التكرار : ص28 رقم 17 .
(5) أسرار التكرار : ص75 رقم 115 .
(6) أسرار التكرار : ص100 رقم 178 .
(7) أسرار التكرار : ص132 رقم 283 .
(8) أسرار التكرار : ص206 رقم 526 .
(9) المصدر : ص186 رقم 445 .
(10) أسرار التكرار : ص207 رقم 530 .
(11) أسرار التكرار : ص134 رقم 287 .
(12) أسرار التكرار : ص134 رقم 289 .
(13) أسرار التكرار : ص198 .
(14) أسرار التكرار : ص198 .
(15) هو خال امرؤ القيس ، قيل : هو أَول من قصّد القصائد .
(16) راجع مجمع البيان : ج9 ص199 .
(17) أسرار التكرار : ص213 .
(18) أسرار التكرار : ص226 .
(19) راجع الكشّاف للزمخشري .
(20) مجمع البيان : ج10 ص552 .

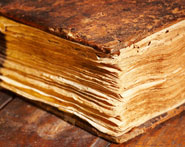
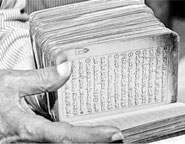
|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|