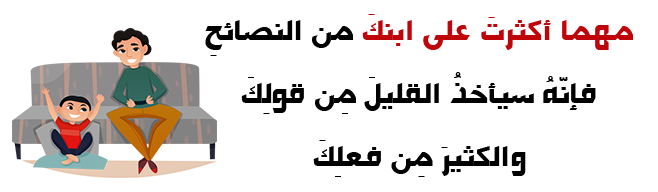
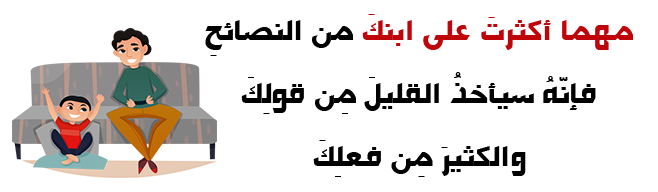

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
التاريخ: 20-9-2016
التاريخ: 20-9-2016
التاريخ: 20-9-2016
|
ومن القواعد المشهورة الفقهيّة قاعدة « الصلح جائز بين المسلمين أو النّاس » كما في بعض الروايات.
فمنها : قوله تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [النساء: 128] , ومنها : قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ } [الأنفال: 1] ومنها : قوله تعالى {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] ومنها : قوله تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}[الحجرات:10] ومنها : قوله تعالى {فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} [الحجرات: 9] ومنها : قوله تعالى {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114] .
وهذه الآيات صريحة في إمضاء الشارع الأقدس الصلح المتعارف بين أهل العرف والعقلاء ، وتدلّ على حسنه ومطلوبيّته عنده ، سواء كان إيقاعه بعقد الصلح ، أو كان بعمل ، أو قول ليس بعقد.
وبعبارة أخرى : حقيقة الصلح عبارة عن التراضي والتّسالم والموافقة على أمر ، سواء كان ذلك الأمر مالا من الأموال ، عروضا كان ذلك المال أو كان من النقود على أقسامها ، أو كان ذلك الأمر الذي اتّفقا فيه وتسالما وتراضيا عليه من الأعمال ، أو كان غير ذلك ، وسواء أنشأ ذلك التسالم بصيغة عقد الصلح أو بغير ذلك ، وسواء كان مسبوقا بالخصومة أو ملحوقا بها أو كان متوقّعا حصولها ؛ ففي جميع هذه الموارد المذكورة يصدق إطلاق « الصلح » عليها إطلاقا حقيقيّا ، لا عنائيّا مجازيّا.
وسنذكر إن شاء الله عدم دخالة هذه الأمور في تحقّق الصلح وإطلاقه من ناحية هذه القيود.
إذا عرفت ما ذكرنا تعرف دلالة جميع الآيات المذكور على صحّة الصلح ، وإمضاء الشارع الأقدس لما عليه بناء العقلاء في باب الصلح من اختصاصه بصنف دون صنف وقسم دون قسم.
الثاني : من مداركها الروايات :
منها : النبوي الذي رواه العامّة والخاصّة : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » (1) .
ومنها : ما روى حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الصلح جائز بين الناس ». (2) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في باب الصلح وهي كثيرة.
وعقد في الوسائل بابا لفضله ، بل وفي استحبابه ، بل مفاد بعضها أنّه أفضل من عامة الصلاة والصيام. وروى ذلك في الوسائل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه واله : إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » (3) .
الثالث : من مدارك هذه القاعدة ، هو الإجماع المحصّل من جميع طوائف المسلمين ، بل قيل : إنّه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، ولم ينكر أحد من الفقهاء شرعيّته بل حسنه واستحبابه.
الرابع : العقل. ولا شكّ في استقلال العقل بحسنه ؛ لأنّ الإصلاح والموافقة والتراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط حقّ أو ثبوته أو غير ذلك بين شخصين أو أزيد قد يكون بالعقد أو بغير العقد ، مقابل الإفساد والاختلاف والسخط والتخاصم ، فكما أنّ العقل حاكم بقبح الأمور الأخيرة ، فكذلك حاكم بحسن المذكورات أوّلا التي تكون الصلح عين تلك الأمور ، فبقاعدة الملازمة يثبت مشروعيّته ومطلوبيّته وإن كانت استحبابيّة.
الجهة الثانية
في بيان مفادها وشرح حقيقتها :
أقول : إنّ الصلح ـ كما عرّفه جماعة من الفقهاء ـ عقد شرّع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. ولكن أنت عرفت وذكرنا أنّه ليس من شرط تحقّق الصلح سبق خصومة وتنازع في البين ، بل ولا توقّع وجودهما فيما بعد ، وهكذا ليس منحصرا ومختصّا بما أنشأ بالعقد.
فهذا تعريف بالأخصّ للصلح لاختصاصه بما ينشأ بالعقد في مورد التخاصم والتنازع.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ جعل رفع التنازع وقطع التجاذب غاية لتشريعه ، يكون من باب حكمة التشريع لا علّته كي يكون شرعيّته دائرا مدار وجود هذه العلّة ، فإذا لم يكن تنازع وتخاصم بين المتسالمين على أمر مالي أو غير مالي لا يصدق عليه الصّلح ؛ وذلك من جهة الفرق بين حكمة التشريع وعلّته ، ففي الأوّل لا يكون الحكم وما شرّع وجوده دائرا مدار حكمة التشريع. وأمّا في الثاني ـ أي علّة التشريع ـ يكون وجود الحكم دائرا مدار وجودها ، فمثل استبراء الرحم حكمة لتشريع العدّة ، ولذلك لو كانت المرأة في سنّ من تحيض ولم يكن زوجها لا مسها منذ زمان طويل لمرض أو سفر أو غير ذلك يجب عليها الاعتداد ، مع أنّ الرحم لا يحتاج إلى الاستبراء ؛ وهكذا بالنسبة إلى تشريع وجوب القصر والإفطار في السفر ، حيث أنّ في تشريعهما حكمة هي المشقّة ، وفي كثير من الأسفار لا مشقّة ، خصوصا في هذه الأزمان والسفر مع الطيّارة ، ومع ذلك عند عدم وجود هذه الحكمة الحكم لا ينعدم.
فليكن فيما نحن فيه أيضا كذلك ، أي لا ينافي عدم وجود نزاع في البين ومع ذلك يكون الصلح موجودا ؛ فيكون التنازع حكمة تشريع الصلح ، لا علّة تشريعه.
ثمَّ إنّ ها هنا أمورا يجب أن نذكرها :
[ الأمر ] الأوّل : أنّ الصلح معاملة مستقلّة ، وليس من فروع البيع تارة ، والإجارة أخرى ، والعارية ثالثة وهكذا كما توهّم.
وجه التوهّم : أنّ الصلح على عين متموّل بعوض مالي يفيد فائدة البيع ؛ لأنّ البيع تمليك عين متموّل بعوض مالي ، والصلح على العين المتموّل بعوض مالي يكون عين ذلك الذي ذكرنا ، غاية الأمر بصيغة الصلح فهو بيع ، والاختلاف في اللفظ فقط.
وهكذا الصلح على منفعة معلومة بعوض معلوم يكون تمليك منعفة معلومة بعوض معلوم ، وهذا عين الإجارة غاية الأمر بلفظ الصّلح. وإن كان تمليك المنفعة بلا عوض يكون عارية بلفظ الصلح ؛ فليس الصلح عقدا برأسه ومعاملة مستقلّة ، بل في كلّ باب يكون من فروع ذلك الباب.
هذا غاية ما توهّموا.
ولكن أنت خبير بأنّه أوّلا : قد يوجد مورد للصلح حسب النصوص الواردة في باب الصلح لا ينطبق لا على البيع ، ولا على الإجارة ، ولا على العارية ، ولا على الهبة كما روى : إذا كان رجلان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » (4).
فهذا ليس ببيع ؛ لأنّ العوضين مجهولان من حيث المقدار ، ولا هبة ؛ لأنّه ليس إعطاء مجان بل لكلّ واحد منهما عوض ، ولا عارية وليس بإجارة ؛ لأنّه تمليك عين لا منفعة ، ولا ينطبق على أيّ واحد من عناوين المعاملات ؛ فلا بدّ وأن يكون عقدا مستقلاّ ، إذ لا يمكن أن يكون من فروع أيّ عقد آخر ومعاملة أخرى ؛ هذا أوّلا.
وثانيا : أنّ المنشأ في عقد الصلح عنوان التسالم والموافقة ، وفي سائر العقود عناوين أخر. وصرف الاشتراك في الأثر لا يخرج الشيء عمّا وقع عليه ، وحيث أنّ المنشأ فيه مختلف مع المنشأ في سائر العقود والمعاملات ، فلا يصحّ إطلاق البيع أو الإجارة أو العارية أو الهبة عليه ؛ فالقول بأنّه في كلّ باب يعدّ من فروع ذلك الباب لا أساس له ، وإن نسب في الجواهر هذا القول إلى الشيخ رحمة الله عليه (5) .
وثالثا : ثمرة هذا البحث تظهر في الآثار المترتّبة على هذه العناوين ، مثلا إذا قلنا بأنّ صلح الأعيان المتموّلة بعوض مالي بيع يثبت فيه خيار المجلس ، وإلاّ فلا بناء على اختصاص هذا الخيار بالبيع وعدم ثبوته في غيره من المعاملات.
ولكن يرد عليه : أنّ الأحكام الشرعيّة تلحق العناوين التي جعلت موضوعات لها في ألسنة أدلّتها ، فإذا قال الشارع : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فهذا الحكم جعل موضوعه في لسان دليله عنوان البيّعين ، وعنوان البيّعين غير عنوان المتصالحين والمتسالمين أو المتوافقين وأمثالها ، فلا يترتّب على هذا البحث هذه الثمرة. فإذا كان الغرض من القول بأنّ الصلح في كلّ باب من فروع ذلك الباب ترتيب هذه الثمرة فلا سبيل إلى ذلك.
وخلاصه الكلام في هذا المقام : أنّ الآثار والأحكام المختصّة بكلّ عنوان لا يترتّب إلاّ على نفس ذلك العنوان ، لا على ما يفيد فائدته ، ولا شكّ في أنّ عنوان الصلح والبيع والإجارة والهبة والعارية مختلفات لا يلحق حكم أحدها للآخر ، وإن كانت نتيجة الاثنين وفائدتهما واحدة.
[ الأمر ] الثاني : أنّ الصلح يصحّ مع الإقرار والإنكار ، أي مع إقرار المدّعى عليه بما يدّعيه المدّعي ، وإنكاره لما يدّعيه.
أمّا مع إقراره فوجهه أوضح ؛ وذلك من جهة إقراره يثبت عليه ما يدّعي المدّعي ، فلا مانع من أن يصالح المدّعي عن حقّ ثابت بمال.
وأمّا مع إنكاره فإن كان كاذبا في إنكاره فيكون من حيث صحّة الصلح مثل إقراره ؛ لأنّه في الواقع عليه شيء إمّا عينا أو دينا ، فيكون المصالحة على ذلك المال الذي عنده أو على ما في ذمّته ، والصلح صحيح واقعا.
وأمّا إن كان صادقا في إنكاره ولم يكن عليه شيء ، لا في ذمّته ولا عنده عين مال المدّعي ، فحيث لا يكون شيء في البين يقع الصلح عليه ، فهذا الصلح صحّته يكون ظاهريّة ، ويجب ترتيب آثار الصحّة عليه ما لم ينكشف الحال وأنّ المدّعي دعوا كاذبة. كما هو الحال في جميع الأحكام الظاهريّة من مؤدّيات الأصول والأمارات ، حيث يجب ترتيب الآثار عليهما ما لم ينكشف الخلاف.
وعلى كلّ حال صحّة هذا الصلح مع الإقرار والإنكار إجماعيّ لا خلاف فيها عندنا ، غاية الأمر في الصورة الثانية أي صورة إنكار المدّعى عليه لا بدّ من القول بالتفصيل المتقدّم ، وأنّه إن كان صادقا في إنكاره فصحّة ذلك الصلح ظاهريّة لا واقعيّة ، ويجب على المدّعي ردّ ما أخذ بعنوان مال المصالحة ، ويكون ما أخذ من المقبوض بالعقد الفاسد ، فعليه الضمان ؛ لأنّ المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب عند المحصّلين إلاّ في الإثم إذا كان جاهلا بالفساد فإنّه حينئذ لا إثم له وهو معذور.
هذا ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري (6) عن ابن إدريس ، (7) وكلامه هذا حسن وصحيح. ولا فرق في عدم صحّة الصلح واقعا بين أن يكون المدّعي كاذبا في تمام ما يدّعيه أو في بعضه ، مثلا لو كان المدّعي يدّعي أنّ الدار التي في يدك تمامها لي ، وفي الواقع نصفها له ونصفها الآخر لنفس ذي اليد ، فأنكر المدّعى عليه كون تمام الدار له ، ولم يكن له طريق لردّ دعواه الكاذبة في النصف الذي لا يملكه ، فاضطرّ للصلح معه على تمام الدار ، فهذا الصلح أيضا فاسد واقعا ويكون صحّته ظاهريّة ومن باب أصالة الصحّة والجهل بالحال ؛ ولذلك متى انكشف الحال وعلم أنّه كاذب في دعواه وأنّ تمام الدار له ، لا يجب ترتيب آثار الصحّة على هذا الصلح.
ثمَّ إنّ هاهنا كلاما : وهو أنّه هل يجب على المدّعي الكاذب ردّ تمام ما أخذ بعنوان مال المصالحة لفساد هذا الصلح ، أو ردّ نصف ما أخذ لصحّة الصلح بالنسبة إلى النصف الذي كان يملكه ، أو لا يجب ردّ شيء ممّا أخذ لصحّة هذا الصلح وإن كانت صحّته باعتبار وقوعه مقابل ذلك النصف الذي يملكه لا مقابل تمام الدار؟ وجوه واحتمالات.
والحقّ بطلان هذا الصلح الواحد البسيط ، فيجب ردّ تمام ما أخذ بعنوان مال المصالحة ويرجع إليه نصف الدار الذي كان يملكه. ومرادنا بقولنا : يرجع إليه نصفه الذي يملكه ، أي بحسب الظاهر والحكم بصحّة ذلك الصلح ظاهرا ، وإلاّ فبحسب الواقع لم يخرج عن ملكه كي يرجع.
ولا يتوهم : أنّه يمكن تصحيحه في النصف الذي يملكه من باب تبعّض الصفقة ، والفقهاء يلتزمون بذلك في البيع ويقولون : لو باع تمام الدار فتبيّن أنّ نصفها ليس له ، فالبيع صحيح بالنسبة إلى النصف الذي يملكه ، غاية الأمر أنّه يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة. فليكن ها هنا أيضا كذلك ، فيكون الصلح صحيحا بالنسبة إلى النصف الذي يملكه ، غاية الأمر يكون الخيار للمصالح له ، فالنتيجة أن لا يكون الواجب على المدّعي الكاذب ردّ تمام مال المصالحة ، بل الواجب عليه ردّ النصف إلاّ أن يعمل المصالح خياره ويفسخ الصلح ، فيجب عليه ردّ تمام مال المصالحة ويرجع نصف الدار إليه بالمعنى الذي ذكرنا للرجوع .
ودفع هذا التوهم : بأنّ باب الصلح على الأعيان الخارجيّة غير باب بيعها ؛ وذلك لأنّ التسالم على كون عين خارجيّة ملكا لشخص وهو أحد المتسالمين لا يتبعّض ، ولم يقع التسالم والاتّفاق على كون كلّ جزء من هذه العين الخارجية ملكا للمصالح له بإزاء ما يساويه من مال المصالحة بحسب المقدار أو القيمة ، وهذا بخلاف باب البيع فإنّ حقيقة البيع جعل كلّ واحد من العوضين بدلا عن الآخر في مقام الملكيّة ، والبدليّة تسرى إلى كلّ جزء من العوضين ، فكلّ جزء منها مقابل الجزء الذي يساويه بحسب المقدار أو بنسبة إلى قيمة قيمة المجموع .
وهذا معنى الانحلال في باب تبعّض الصفقة. وأمّا هذا المعنى فلا يأتي في الصلح ؛ لأنّ المنشأ فيه التسالم ، وهو بسيط لا يتبعّض ، فبناء على هذا إذا وقع الصلح على عين يدّعيها المدّعي ، فكما أنّه لو لم يكن المدّعي صادقا في دعواه ولم يكن شيء من تلك العين فصالح المدّعى عليه بمال عن تلك العين مع المدّعي يكون الصلح بحسب الواقع باطلا ، فكذلك الصلح يكون باطلا لو لم يكن بعضها له.
ولا وجه للقول بصحّة الصلح بالنسبة إلى البعض الذي يملكه ، وبطلانه بالنسبة إلى البعض الذي لا يملكه ، فيصير من باب تبعّض الصفقة ؛ لما ذكرنا من أنّ الصلح الواقع على عين خارجيّة لا يتبعّض بالنسبة إلى أجزائه أو كسورة كالنصف والثلث والربع وأمثالها ، فتأمّل.
فظهر ممّا ذكرنا : أنّ الأصحّ من الاحتمالات الثلاث التي ذكرناها هو الاحتمال الأوّل ، وهو وجوب ردّ تمام ما أخذه المدّعي الكاذب في بعض ما ادّعاه ؛ وذلك لفساد الصلح. ولا فرق فيما ذكرنا من فساد الصلح لو تبيّن عدم كون تمام ما يصالح عنه له بين أن يكون الكاذب هو المدّعي أو المدّعى عليه.
ثمَّ إنّ هاهنا روايتين تدلاّن على عدم صحّة الصلح واقعا ، وعدم ذهاب الحقّ بالمرّة فيما إذا لم يقع الصلح بين ما هو الحقّ الواقعي وبين ما يعطيه المصالح مع خفاء المقدار الواقعي على صاحب المال الذي يريد أن يصالح معه من بيده المال.
إحديهما : ما رواه عليّ بن حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات إلى أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال عليه السلام : « لا يجوز حتّى تخبرهم » (8) .
والأخرى : ما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام : « إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ، ثمَّ صالح ورثته على شيء ، فالذي أخذه الورثة لهم ، وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وفإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه ، فهو كلّه للميّت يأخذه به » (9) .
فالرواية الأولى تدلّ على أنّ المصالحة على مال مع جهل صاحب المال بمقداره لا يجوز ولا أثر لها. والرواية الثانية تدلّ على أنّ المصالحة مع صاحب المال بأقلّ منه لا يوجب براءة ذمّته عن الجميع مع جهل صاحب المال ، بل تؤثّر في المقدار الذي أعطاه فقط والباقي باق في ذمّته ، وإن لم يصالح مع صاحب المال أصلا حتى مات ، ولا مع ورثته حتى هلكوا فجميع المال يبقى في ذمّته.
وهذا الأخير هو مقتضى القواعد الأوّلية أيضا ، أي ولو لم تكن هذه الرواية في البين كان الحكم هكذا وكما ذكرنا.
والمقصود من ذكر هاتين الروايتين أنّ صحّة هذا الصلح حكم ظاهريّ ، ولا يحلّ للمدّعي الكاذب التصرّف فيما أخذه بعنوان مال المصالحة ، إلاّ فيما إذا أحرز رضا من يعطي المال وطيب نفسه على كلّ حال ؛ لما ذكرنا وتقدّم من أنّ ما يأخذه بعنوان مال المصالحة يكون من المقبوض بالعقد الفاسد واقعا ، وإن كان بحسب الظاهر صحيحا.
[ الأمر ] الثالث : أنّ الصلح نافذ وجائز بين الناس فيما إذا لم يكن أحلّ حراما كاسترقاق الحرّ ، أو استباحة المحرّمات كبضع المحارم وشرب الخمر وغير ذلك من المحرّمات ، أو حرّم حلالا كما أنّه لو صالحا وتسالما على أن لا يطأ حليلته أو لا يأكل اللحم أو لا ينتفع بماله وأمثال ذلك ممّا أحلّه الله له.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه واله : « الصلح جائز بين الناس إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » .
فالصلح الذي أحلّ حراما ، أي كان مفاده لزوم ارتكاب محرّم ، والصلح الذي حرّم حلالا ، أي كان مفاده لزوم ترك ما هو حلال ، وهذا هو معنى تحريم الحلال وتحليل الحرام ، وإلاّ فالحلال لا يصير محرّما واقعا إلاّ بتبديل الحكم من طرف الشارع ، فالمراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال هو أن يكون مفاد الصلح هو أحد الأمرين : إمّا لزوم فعل محرّم وهذا هو تحليل الحرام ، أو لزوم ترك مباح أو ما هو راجح فعله وهذا تحريم الحلال ، فمفاد الاستثناء هو عدم نفوذ مثل هذا الصلح الذي يحرّم حلالا أو يحلّل حراما ، وأنّه ليس بجائز. وهذا واضح جدّا.
[ الأمر ] الرابع : في أنّ الصلح صحيح وجائز مع علم الطرفين ومع جهلهما بالمقدار الذي يقع الصلح عنه ، فإذا كان أحد الوارثين أو أحد الشريكين المقدار الذي يملكه من المال المشترك غير معلوم لنفسه ولا لشريكه ، فيجوز أن يصطلحا على حصّته من ذلك المشترك مع جهل الطرفين ، كما أنّه يجوز الصلح عن حصّته مع علمهما أيضا.
وهذا الحكم إجماعيّ ، ويدلّ عليه قبل الإجماع ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه عليه السلام قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » .
فهذه الرواية صريحة في صحّة الصلح مع جهلهما بمقدار ما يصالحان عنه ويصطلحان عليه ؛ لأنّ مورد الحكم بعدم البأس هو عدم علم المصطلحين بمقدار ما يصطلحان عليه ؛ لأنّ المورد حسب تصريح الراوي وفرضه هو أنّه كلّ واحد منهما لا يدري كم له عند صاحبه.
هذا ، مضافا إلى شمول المطلقات مثل قوله تعالى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] ومثل قوله صلى الله عليه واله : « الصّلح جائز بين المسلمين » (10) ـ أو « النّاس » كما في رواية أخرى (11) ـ لكلتا حالتي علمهما وجهلهما ؛ لأنّ الصلح في كلتا الحالتين صلح ، وكلّ صلح خير بإطلاق الآية ، وهكذا كلّ صلح جائز ونافذ بإطلاق الحديث ، فعدم الصحّة في صورة جهلهما أو علمهما يحتاج إلى دليل مخصّص للعمومات أو مقيّد للإطلاقات.
ثمَّ إنّه كما أنّ جهلهما بالمقدار لا يضر بصحّة الصلح ، كذلك لا يضر جهلهما بجنس ما يصطلحان عليه ؛ للإجماع والإطلاقات.
[ الأمر ] الخامس : أنّ الصلح عقد لازم لا ينحلّ إلاّ بالإقالة من الطرفين ؛ وذلك لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ولا شكّ في أنّ الصلح من العقود العهديّة ، وقد ذكرنا تفصيل شمول ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) للعقود العهديّة ودلالتها على اللزوم في قاعدة أصالة اللزوم في العقود ، وذكرنا سائر الأدلّة أيضا هناك من قبيل : « الناس مسلّطون على أموالهم » (12) وقوله صلى الله عليه واله : « لا يحل مال امرء مسلم إلاّ بطيب نفسه » (13) وقوله عليه السلام : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » (14) واستصحاب بقاء أثر العقد بعد النسخ .
وأمّا انحلاله بالإقالة فلا ينافي لزومه ؛ وذلك من جهة أنّ اللزوم ها هنا حقّي ، بمعنى أنّ التزام كلّ واحد من الطرفين بالبقاء عند هذا العقد والعهد والوفاء بمضمونه الذي هو مدلول التزامي للعقد ـ ولذلك قلنا بعدم هذا الالتزام في المعاطاة ، لعدم كون الالتزام بالوفاء بمضمون المعاملة مدلولا التزاميّا للعمل وإنّما هو مدلول التزامي للعقد ـ ملك للطرف الآخر ومن حقوقه.
وهذا معنى اللزوم الحقي مقابل اللزوم الحكمي كما في باب النكاح ؛ وذلك لأنّ اللزوم الحكمي في النكاح عبارة عن حكم الشارع بأنّ هذا العقد لازم لا يقدر أحد على حلّه إلاّ الزوج بالطلاق ، وهو أيضا ليس فسخا أو انفساخا ، بل هو عبارة عن رفع العلاقة التي أوجدها بعقد النكاح ، فكما أنّ عقد النكاح سبب لوجودها يكون الطلاق سببا لارتفاعها ؛ ولذلك لا يأتي الخيار ولا الإقالة في النكاح ؛ لأنّ الحكم الشرعي لا يرتفع إلاّ برفع الشارع تخصيصا أو نسخا ، على إشكال في الأوّل من حيث التعبير بالرفع في التخصيص ؛ لأنّ التخصيص يدلّ على أنّ الحكم في مورد الخاصّ من أوّل الأمر لم يكن ، لا أنّه كان وارتفع بالتخصيص.
وعلى هذا المبنى قلنا في باب النكاح إنّ الخيار في الموارد السبعة ليس من الخيار بمعناه الحقيقي ، بل هو تخصيص في اللزوم الذي حكم الشارع به في باب النكاح.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ في كلّ مورد كان اللزوم حقّيا ، أي كان التزام كلّ واحد من الطرفين ملكا وحقّا للآخر يأتي الإقالة ؛ لأنّ حقيقة الإقالة رفع اليد عن حقّه وما ملكه بالعقد من التزام طرفه له ، فإذا رفع اليد عن حقّه لا يبقى محلّ لالتزام طرفه ؛ لأنّ هذا الالتزام كان رعاية لحقّه ولمراعاته ، لا أنّ الملتزم مجبور من طرف الشارع بالبقاء عند التزامه ، وإلاّ لو كان كذلك كان اللزوم حكميّا ـ أي بحكم الشارع ـ لا حقّيا ولمراعاة طرفه ؛ ففي اللزوم الحقّي إذا رفع كلاهما يدهما كلّ واحد عمّا التزم له صاحبه فلا يبقى مانع عن الفسخ.
وأمّا في اللزوم الحكمي فلا تأتي الإقالة ؛ لأنّ اللزوم حكم شرعي ليس مربوطا بالطرفين كي يقيل كلّ واحد منهما صاحبه ؛ ولذلك لا تأتي الإقالة في باب النكاح.
وبعد أن ثبت أنّ الصلح من العقود اللازمة العهديّة التي لزومه حقّي لا حكميّ ، فلا مانع من ثبوت الإقالة فيه وتأثيرها في جواز فسخ كلّ واحد من المصطلحين له. وحيث ثبت أنّ الإقالة على مقتضى القواعد الأوّلية ، فثبوتها في كلّ معاملة بالخصوص لا يحتاج إلى دليل خاصّ في تلك المعاملة بالخصوص ، فكذلك في باب الصلح لا يحتاج إلى وجود دليل على صحّة الإقالة ، بل هي مقتضى القواعد الأوّليّة.
[ الأمر ] السّادس : صلح الشريكان قال في الشرائع : إذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صحّ (15) .
والدليل على صحّة هذا الصلح أوّلا شمول الإطلاقات له ، فإنّ قوله صلى الله عليه واله « الصلح جائز بين المسلمين ـ أو الناس ـ إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » يشمل مثل هذا ؛ لأنّ هذا صلح ولم يحرّم حلالا ولم يحلّل حراما ، فيكون من مصاديق الصلح الصحيح.
وثانيا : هو الإجماع.
وثالثا : روايات ، منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ، وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى. فقال : « لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ » (16).
وقد روي هذه الرواية بعدّة طرق آخر كما هو مذكور في الوسائل ، ودلالتها على ما نقلناه عن الشرائع واضح لا يحتاج إلى البيان.
ثمَّ إنّه هل مفاد هذه الرواية وغيرها من الروايات الواردة في خصوص المقام هو صحّة هذا الصلح بالنسبة إلى الربح والخسران المتقدّم كي يكون به انتهاء الشركة ويكون هذا الصلح في مقام التقسيم ، أو لا بل صحّته مطلقا ، سواء كان في أوّل الشركة أو في وسطها أو في آخرها؟
اختار المحقّق الثاني الأوّل حيث يقول : هذا إذا انتهت الشركة وأريد به فسخا وكان بعض المال دينا لصحيحة أبي الصباح (17) ثمَّ ذكر الرواية التي نقلناه عن الحلبي. وكذلك الشهيد الثاني في المسالك حمل الرواية على ما اختاره المحقّق الثاني (18) .
والإنصاف : أنّ صدر الرواية ظاهر في ما ذكراه ؛ لأنّ قوله عليه السلام : « لا بأس » ظاهر في نفي البأس عمّا سأل عنه الراوي وعن فرضه ، وفرضه في حصول ربح لهما بعد حصول الاشتراك ، فكأنّه قال بعد أن اشتركا في مال واتّجرا به فحصل ربح من كسبهما فيه : إنّ لي رأس مالي والباقي لك ، فصالح بهذه العبارة أنّه صالح جميع حقّه في هذا المال المشترك بمقدار رأس ماله ، وما سوى مقدار رأس ماله للآخر ، سواء كان زائد على رأس مال الآخر فيكون الرّبح له ، أو كان أقلّ منه فيكون التوى ـ أي الخسارة ـ عليه.
فيظهر من هذا الكلام أنّه إذا اصطلحا على أن يكون مقدار رأس مال أحدهما له ، والباقي أي مقدار كان للآخر ، سواء كان زائدا على رأس مال الآخر أو كان أقلّ أنّ بهذا الصلح ينتهي الشركة. وهذا شبه تقسيم بالمصالحة ورضا الطرفين ، ولكن حيث قيّد عليه السلام نفي البأس بقوله : « إذا اشترطا » فربما يخرج الصدر عن ظهوره في انتهاء الشركة ؛ لأنّ المراد بالاشتراط إمّا الاشتراط في عقد الشركة ، أي لا بأس بهذا الصلح إذا كانا اشترطا في عقد الشركة أن يكون رأس مال أحدهما له ، والباقي قليلا كان أم كثيرا للآخر.
فهذا الشرط في عقد الشركة إن كان مرجعه إلى أن لا يكون ربح المال له ولا خسارته عليه ، بل يكون ربحه لشريكه وخسارته أيضا على شريكه يكون باطلا ؛ لأنّه خلاف مقتضى أصل العقد ، لا أنّه خلاف مقتضى إطلاق العقد كي يكون صحيحا ، فلا يمكن أن يكون تقييده عليه السلام عدم البأس بالاشتراط بهذا المعني ، أي بالاشتراط بالشرط الباطل.
وحيث قيّده به فلا بدّ وأن يكون بمعنى آخر يلائم مع هذا التقييد ، وهو أن يكون إنشاء هذا المعنى ، أي كون رأس ماله له والباقي لطرفه بعقد لازم كنفس الصلح ، أو يكون في ضمن عقد لازم آخر كي يكون لازما وواجب الوفاء ، لا وعدا ابتدائيّا أو صرف قول ومذاكرة من دون عقد وعهد كي لا يكون واجب الوفاء ، بل لا يصير ملكا للطرف لعدم خروج الربح عن ملكيّة صاحب المال الرابح بصرف هذا القول.
وكذلك الأمر في الخسارة تتبع المال ، وبصرف القول والمذاكرة لا يصير خسارة مال شخص على شخص آخر ، خصوصا مع فرض سكوت الطرف الآخر وعدم إظهار رضاء ، كما هو ظاهر الرواية.
فلا بدّ وأن نفرض المقام أنّ صاحب أحد المالين اللذين حصل الاشتراك بينهما إمّا بعقد الشركة أو بمزجهما أو بخلطهما ـ فيما يحصل الاشتراك بالخلط ـ صالح ماله للطرف الآخر بمقداره بدون زيادة ولا نقيصة في ذمّته. ونتيجة مثل هذا الصلح هي صيرورة تمام المال ملكا للطرف الآخر ، فقهرا يكون الربح له والخسارة عليه ، غاية الأمر تكون ذمّته مشغولة للمصالح المذكور ، فلو خسر تمام المال المشترك ولم يبق له شيء ، يكون عليه تفريغ ذمّته بإعطاء جميع رأس المال الذي تعلّق بذمّته.
وأمّا الإشكال بأنّ الشرط والاشتراط لا يطلق على مثل هذا الصلح.
ففيه : ما ذكرنا تفصيله في أصالة اللزوم : أنّ الشرط والاشتراط يطلق على كلّ عقد لازم من العقود العهديّة.
إذا ظهر لك ما ذكرنا ، تعرف أنّ هذا المعنى ـ أي الصلح بالصّورة المذكورة ـ يمكن أن يقع في ابتداء حصول الشركة وفي وسطه وفي انتهائه ، ولا يجب أن يكون عند القسمة ويكون عند انتهاء الشركة.
ولكن أنت خبير بأنّ لازم هذا الوجه في معنى الاشتراط أيضا انتهاء الشركة ، غاية الأمر يحصل الانتهاء بنفس الصلح المذكور ويبطل الشركة ؛ إذ لا يعقل بقاء الشركة مع تعلّق مال أحد الشريكين بذمّة الآخر وصيرورة تمام المال له ، نعم إحداث هذا الصلح يمكن أن يكون في ابتداء حصول الشركة ، ويمكن أن يكون في وسطها ، ويمكن أن يكون بعد انتهائها وفسخها ، وعلى كلّ حال به ينتهي الشركة. اللهمّ إلاّ أنّ المراد من الاشتراط نفس الصلح ـ كما ذكرنا ـ بناء على صحّة إطلاقه على العقود العهديّة الضمنيّة ، والصلح في هذا المورد يكون على استحقاق أحدهما من المال المشترك مقدار رأس ماله ، والباقي أيّ مقدار كان للآخر ، ربح أو خسر.
وهذا المعنى ليس فيه إشكال ؛ لأنّ الصلح عبارة عن التسالم على أمر كما تقدّم ، ولا مانع من تسالمهما على مثل هذا الأمر ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، وليس هذا التسالم موجبا لتحريم حلال أو تحليل حرام كي يكون موجبا لبطلانه كما هو مفاد النّص ، وليس من باب معاوضة حقّه بما يساوي مقدار رأس ماله في ذمّة الآخر كي يكون تمام مال المشترك للآخر ، فيكون بهذه المصالحة انتهاء الشركة.
وهذا المعنى بعد أن فرغنا عن صحّته وشمول إطلاقات الصلح له ، لا ينافي بقاء الشركة بعد هذا الصلح ؛ لأنّ المفروض أنّ مفاد كون حق المصالح في هذا المال المشترك مقدار رأس ماله وإن بقي الاشتراك بعد ذلك سنين ، فيجوز هذا الصلح في ابتداء الشركة وفي أوساطها وعند انتهائها ، وليس مختصا بحال القسمة ولا يحصل به الفسخ ، بل يمكن بقاء المال على الاشتراك ؛ لشمول الإطلاقات لمثل هذا الصلح ، بل لا يبعد أن يكون ظاهر الروايات الخاصّة أيضا هذا المعنى ، بناء على أن يكون المراد من قوله عليه السلام : « إذا اشترطا فلا بأس » هو نفس عقد الصلح ؛ لصحّة إطلاق الشرط والعهد على العقود اللازمة العهديّة.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ تقييد كلمة « صحّ » التي في المتون بقيد « هذا إذا انتهت : أي الشركة » كما في جامع المقاصد (19) و« عند انتهائها » كما في المسالك (20) ليس كما ينبغي. وكذلك ما أفاده الشهيد في الدروس (21) بقوله : ولو جعلا ذلك ـ أي الصلح المذكور ـ في ابتداء الشركة فالأقرب المنع لمنافاته مع موضوعها ، أي الشركة وقبل هذه العبارة يحكم بصحّة هذا الصلح إذا كان عند إرادة الفسخ.
وأنت عرفت ما في كلامه هذا ، وما في كلام غيره ممّا يشابه هذا الكلام.
وخلاصة الكلام : أنّه إن كان المراد من قوله عليه السلام : « إذا اشترطا » أي في ضمن عقد الشركة ، فلا بدّ وأن نقول : على فرض صحّة السند وحجّية تلك الروايات الخاصّة أنّ هذا حكم تعبّديّ ؛ إذ لا يمكن تصحيحه بالقواعد المقرّرة ، بل مقتضى القواعد بطلان هذا الشرط ؛ لأنّه مناف لمقتضى ذات العقد لا لإطلاقه. وأمّا إذا كان المراد منه هو الصلح كما هو ظاهر عبارة المتون فلا إشكال في صحّة مثل هذا الصلح ، سواء كان في ابتداء الشركة أو في أوساطها أو في انتهائها.
[ الأمر ] السابع : لو ظهر وبان أنّ أحد العوضين ممّا وقع الصلح عليهما إمّا للغير أي ليس للطرف في عقد المصالحة ، وإمّا ممّا لا يملك كالخمر والخنزير.
والنتيجة في كلا الشقين أنّه لا يملكه الذي هو طرف المصالحة ؛ إمّا لأنّه ملك الغير ، أو لعدم ماليّته عرفا ، كالأشياء الخسيسة التي لا يعتبرها العقلاء كالخنفساء مثلا ؛ أو لإسقاط الشارع ماليّته العرفيّة ، كالخمر والخنزير وآلات الملاهي وأدوات القمار كأدوات النرد والشطرنج ؛ فيبطل الصلح قطعا.
وذلك من جهة أنّ حقيقة المعاوضة في أيّ عقد معاوضيّ كانت عبارة عن تبديل المالين في عالم الاعتبار ، فقوام المعاوضة بهذا الأمر ، فلا بدّ وأن يكون كلّ واحد منهما مالا كي يكون قابلا للعوضيّة في عالم الاعتبار ، وأن يكون كلّ واحد من طرفي عقد المعاوضة ـ موجبا أو قابلا ـ له السلطنة على المعاوضة ، فهذان ركنان في كلّ معاوضة ، وبفقد أيّ واحد منهما لا يتحقّق المعاوضة.
فإن كان ممّا لا يملك ، أي أسقط الشارع ماليّته العرفية ، كالخمر والخنزير وأمثالهما ، أو لم يكن مالا حتّى عرفا لخسّته كالخنفساء ، فينتفي الركن الأوّل وإن كان مستحقّا للغير ، سواء كان ملك الغير أو كان متعلّقا لحقّ الغير ، فلا يكون طرف المعاوضة مسلّطا عليه ، فينتفي الركن الثاني. وعلى كلا التقديرين لا يبقى مجال للمعاوضة ، فيبطل الصلح لو بان أنّ أحد العوضين مستحقّ للغير أو ليس له ماليّة.
وهذا الحكم جار في جميع المعاوضات. ولا شبهة ولا خلاف فيما إذا كان جميع أحد العوضين كذلك. أمّا لو كان بعض أحد العوضين المعيّنين في الخارج ، أي كان بعض العين الخارجيّة التي وقعت عوضا في الصلح للغير ، أو كان ممّا لا يملك كالعبد الذي نصفه حرّ أو للغير ، فهل الصلح باطل في المجموع ، أو صحيح في المجموع ، أو يبعض وصحيح في النصف الذي له وباطل في النصف الآخر الذي ليس له ، أو يكون متعلّق حق الغير؟ وجوه.
قد تقدّم في الأمر الثاني أنّ الأرجح هو بطلان الصلح في المجموع ، حتّى في النصف الذي يملكه الطرف ، وذكرنا برهانه هناك فلا نعيد.
وربما يتوهّم الفرق بين العقود المعاوضيّة وبين الصلح ، بأنّ العقود المعاوضيّة كالبيع ـ مثلا ـ حيث أنّ المنشأ فيها هو المبادلة بين المالين ، فمع عدم ماليّة أحد العوضين أو عدم كونه له لا يتحقّق حقيقة المبادلة التي لا بدّ منها في تلك العقود.
وأمّا الصلح الذي عبارة عن التسالم والموافقة على أمر لم يؤخذ فيه كونه بعوض ، بل يمكن أن يقع بلا عوض ومجانا ، فإذا كان الأمر كذلك فكما يمكن أن يقع من أوّل الأمر مجّانا وبلا عوض ، فلا يضرّ بصحّته صيرورته كذلك ـ أي مجانا ـ بعد ظهور أنّ العوض المذكور ليس بمال ، أو ليس له وإن كان مالا.
لكنّه توهّم عجيب ؛ لأنّ الصلح وإن لم يؤخذ في حقيقته كونه ذا عوض ويمكن أن يقع مجانا وبلا عوض ، ولكن إذا إنشاء التسالم والموافقة على أمر بعوض يصل إلى المصالح ، فإذا لم يصل إليه شيء إمّا لأجل أنّه ليس بمال ، أو ليس له ، فقد تخلّف ما وقع عمّا هو مقصود الطرفين ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود.
فكما أنّ التمليك لم يؤخذ في حقيقته أن يكون بعوض ، ولذلك قد يكون بلا عوض كالهبة الغير المعوضة ، ولكن إذا أنشأ بعوض كالبيع مثلا ولم يكن العوض للطرف ، بعد العقد بان أنّه ليس له أو ظهر أنّه ليس بمال عرفا أو شرعا وإن كان مالا عند العرف لكن الشارع أسقط ماليّته ، فذلك العقد باطل.
فكذلك فيما نحن فيه ـ أي الصلح ـ وإن لم يؤخذ في حقيقته العوض ، لكن إذا أنشأ بعوض ، يكون العوض من أركان ذلك العقد، ومع فقده يبطل ذلك العقد.
وأمّا النقض بالنكاح بأنّ المهر المعيّن في عقده إذا بان أنّه ملك للغير أو متعلّق حقّ الغير كأن يكون مرهونا مثلا فجعله مهرا بدون إذن المرتهن ، أو كان غير مال شرعا كالخمر والخنزير ، فلا يبطل العقد بل يرجع إلى بدله أو إلى مهر المثل أو غير ذلك ممّا قيل في تلك المسألة ، فلا ينبغي أن يتوهّم ؛ لأنّ المرأة ليست عوضا عن المهر ولا المهر عوض منها. وقوله عليه السلام : « إنّما يشتريها بأغلى الثمن » (22) من باب التشبيه بالبيع ، وإلاّ فذات المرأة حرّة لا أمة ليتقدّر بمال والبضع من منافعها ، وليست عينا كي يصحّ بيعه.
وبعبارة أخرى : النكاح ليس من العقود المعاوضيّة ، بل لزوم المهر فيه حكم شرعي ، ولذلك لو عقد على امرأة ولم يذكر المهر أصلا لا يبطل العقد ، ولكن يرجع إلى مهر المثل تعبّدا ؛ لأنّ البضع لا تستباح مجّانا.
ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه » (23).
وفيما رواه زرارة قال : « لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله صلى الله عليه واله وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلاّ بمهر » (24).
والروايات على لزوم المهر في النكاح كثيرة ، وما ذكرنا كلّه كان فيما إذا كان العوض عينا شخصيّا ، فإذا بان أنّه مستحقّ للغير أو ليس قابلا لأن يملك شرعا أو عرفا فالصلح باطل.
وأمّا لو كان في الذمّة فدفع ما كان كذلك ، فلا وجه للبطلان ، بل يجب عليه أن يدفع غيره من مصاديق ما في الذمّة ممّا يكون مالا عرفا ، ولا يكون متعلّقا لحقّ الغير ، ولا يكون للغير ، ولم يسقط الشارع ماليّته أيضا.
وأمّا إذا ظهر في عوض الصلح عيب ونقص فلا يوجب البطلان ولا الخيار.
أمّا عدم البطلان لأنّه ليس بلا عوض ، وتلك العين الشخصيّة التي جعلت عوضا للعقد موجودة ، ولذلك لا يوجب البطلان حتّى في البيع الذي هو الأصل في باب المعاوضات ، وحقيقته تبديل العين المتموّل بعوض.
وأمّا عدم إيجابه الخيار ، فلأنّ عمدة دليل الخيار إذا ظهر عيب ونقص في المبيع الشخصي أو الثمن الشخصي ، هو الشرط الضمني ، أي بناء البائع على بيع هذه العين الموجودة بما يساويها في القيمة ، أي هذا الثمن الموجود في الخارج. وكذلك الأمر في طرف المشتري ، أي يشتري هذه العين التي تساوي هذا الثمن بحسب القيمة بهذا الثمن.
وهذا الشرط من الطرفين ـ البائع والمشتري ـ ارتكازيّ لا يحتاج إلى الذكر أو البناء خارجا ؛ ولذلك لو أتى شخص غير المتبايعين وقال : هذا المبيع لا يساوي هذا الثمن يتأذّى البائع وربما يترك المشتري هذه المعاملة لو سمع هذه المقالة. وكذلك الأمر في طرف الثمن.
فمن هذا يعلم أنّ كليهما ـ أي البائع والمشتري ـ بنائهما على تساوي العوضين ، وأنّهما بلا عيب ونقص ، وبفقد الشرط الضمني الأوّل أي التساوي في القيمة يثبت خيار الغبن ، وبفقد الثاني أي السلامة عن العيب والنقص يأتي ويثبت خيار العيب.
هذا في البيع أو سائر المعاوضات التي بناء المتعاقدين فيها على تساوي العوضين.
وأمّا في الصلح فليس الأمر كذلك ، بل بناء المتعاقدين فيها على التسامح ؛ لأنّه شرّع في الأصل لقطع المنازعات ، وقطع المنازعات لا يمكن غالبا إلاّ بالتسامح ، وإلاّ لو كان بناؤهما على المداقّة ، فلا يحصل الصلح غالبا.
وهذا في خيار الغبن واضح ، وأمّا خيار العيب إذا وقعت المصالحة على عين خارجي ، فالإنصاف أنّ بناءهما على صحّتها وسلامتها ، فلا يبعد إتيان خيار العيب في الصلح إذا ظهر مال المصالحة معيبا ، ولكن بالنسبة إلى حقّ الفسخ لا أخذ الأرش ، وإنّما هو حكم تعبّدي في خصوص البيع للإجماع والروايات.
ولكن الروايات لا تدلّ على التخيير بين الردّ وأخذ الأرش ابتداء ، بل دلالتها على أخذ الأرش بعد عدم إمكان الرّد لوجود تغيّر في المعيب بعد تسلّمه من صاحب المبيع المعيب مثلا ، وعلى كلّ حال التخيير بين الردّ والأرش مختصّ بالبيع ؛ للإجماع والرواية ، وإلاّ فصرف تخلّف الشرط الضمني لا يوجب إلاّ الخيار ، فالخيار يثبت في الصلح إذا كان العوض معيبا ، وأمّا الأرش فلا.
[ الأمر ] الثامن : يصحّ الصلح على عين بعين أو منفعة ، وعلى منفعة بعين أو منفعة.
والدليل على صحّة المذكورات هي العمومات وإطلاقات أدلّة الصلح ، فقد تقدّم أنّ الصلح عبارة عن التسالم والموافقة على أمر بشيء ، سواء كان ذلك الأمر عينا أو دينا أو منفعة أو حقّا على نقل هذا الأخير أو إسقاطه ، وحيث أنّ كلّ حقّ قابل للإسقاط حتّى عرّف بذلك مقابل الحكم ، فإنّه غير قابل للإسقاط ؛ فكلّ حقّ قابل لأن يقع الصلح عليه ، سواء كان على نقله أو على إسقاطه.
وعمومات الصلح وإطلاقاته كقوله ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ، وقوله صلى الله عليه واله : « الصلح جائز بين الناس إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » يشمل جميع ما يقع التسالم والتوافق عليه ، ولو كان إسقاط حقّ أو نقله فيما كان قابلا للنقل ؛ إذ بعض الحقوق غير قابل للنقل ، كحقّ البضع والمضاجعة وأمثالهما من الحقوق القائمة بشخص خاصّ.
هذا إذا علم أنّه قابل للنقل ، وأمّا إذا شكّ في أنّه قابل للنقل ، فهل يصحّ الصلح على نقله ، أو يحتاج إلى الإحراز؟
الظاهر عدم الصحّة ولزوم الإحراز ؛ وذلك من جهة أنّه لا بدّ من إحراز مشروعيّة متعلّقه ؛ وذلك للاستثناء الذي في قوله صلى الله عليه واله : « إلاّ صلحا أحلّ حراما » فبعد هذا الاستثناء يقيد موضوع ما هو جائز ونافذ بالصلح على أمر مشروع ، فإذا شككنا أنّ الحقّ الفلاني مشروع نقله أم لا ، فلا يجوز التمسّك لجوازه ونفوذه بإطلاقات أدلّة الصلح.
فلو شككنا في أنّ حقّ السبق في الوقف في الأوقاف العامّة ـ كما إذا سبق شخص إلى مكان في أحد المساجد ، أو في الحرم الشريف ، أو إلى مكان في خانات الوقف بين الطرق على المسافرين ، أو غير ذلك ـ هل قابل للنقل أم قائم بشخص السابق ، فالصلح على نقل مثل ذلك الحقّ مشكل ، ولا يشمله عمومات وإطلاقات أدلّة الصلح لمكان ذلك الاستثناء. نعم لا مانع من وقوع الصلح على إسقاط كلّ حقّ بناء على أنّ كلّ حقّ قابل للإسقاط ، فالإسقاط خاصّة شاملة للحقّ.
الجهة الثالثة
في بيان بعض فروع هذه القاعدة :
أي قاعدة « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا » :
فمنها : أنّه لو كان هناك درهمان ورجلان ، فادّعى أحدهما الاثنين والآخر أحدهما ، قال في الشرائع : لمدّعي الاثنين درهم ونصف ، والباقي ـ أي نصف الدرهم ـ للآخر (25).
ولا بدّ فرض المسألة فيما إذا كان الدرهمان في يدهما جميعا ، أو كانا مطروحين في مكان مباح ليس له مالك ولم يكن لأحد يد عليه وإلاّ لو كانا في يد مدّعي الاثنين يحكم له بهما مع حلفه أو نكول الطرف المدعي لواحد ، كما أنّه لو كانا في يد مدّعي الواحد يعطى واحد لمدعي الاثنين ؛ لأنّه مدّع بلا معارض ، والدرهم الآخر يعطى لذي اليد مع يمينه أو نكول مدعي الاثنين.
ولا بدّ أن يحمل صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : بيني وبينك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنّه لصاحبه ، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين » (26) على ما قلنا من أنّ الدرهمين إمّا لا يد لأحد عليهما ، وإمّا في يد الاثنين جميعا ، كما أنّ ظاهر الرواية هو الأخير ؛ لفرض الراوي أنّ الدرهمين كان معهما أي في يد كليهما.
ففي هذه الصورة ما أجاب به الإمام عليه السلام هو مقتضى القواعد الأوّليّة أيضا ، وحكمه عليه السلام بتقسيم الدرهم الثاني بينهما الظاهر في التقسيم بالسويّة هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف التي استعملها الفقهاء في موارد كثيرة ، فيكون ما ذكره في الشرائع مطابقا لما هو مضمون الرواية ، وكون الدرهم ونصفه لمدّعي الاثنين أيضا مقتضى قاعدة الإقرار من مدّعي الواحد ، فإنّه نفى عن نفسه ، وقاعدة سماع قول المدّعي بلا معارض بدون تكليفه بالبيّنة.
وما ذكره جمع من الأساطين كالعلامة في التذكرة (27) ، والشهيد في الدروس (28) من حلف كلّ واحد منهما ، فيحلف مدّعي الاثنين لمدّعي الواحد بأنّ نصف الدرهم ممّا صار بيدي ليس لك ، ولو نكل يؤخذ منه ويعطى لمدّعي الواحد ، ويحلف مدّعي الواحد على الإشاعة لمدّعي الاثنين أنّ هذا النصف الذي صار بيدي ليس لك ، ولو نكل يعطى لمدعي الاثنين.
والسرّ في ذلك : أنّ كلّ واحد منهما مدّع ومنكر ، فمدّعي الواحد مدّع للنصف من الدرهم الذي صار في يد مدّعي الاثنين ، وهو منكر ؛ ومدّعي الاثنين مدّع للنصف الذي يعطى لمدعي الواحد على الإشاعة ، وهو منكر ؛ فيجب إجراء القاعدة المعروفة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » فهاهنا مدّعيان ومنكران ، وحيث أنّ المفروض عدم وجود بيّنة في المقام ، فيجب أن يحلف كلّ واحد منهما للآخر ، فلو لم يحلف أحدهما لا يعطى ذلك النصف المتنازع فيه ، كما أنّه لو ردّ كلّ واحد من المنكرين الحلف إلى الطرف الذي هو مدّع وهو نكل ، فلا يستحقّ ذلك النصف ، ولو حلفا جميعا أو نكلا جميعا أيضا ، يقسّم بينهما بالسوية ؛ لقاعدة العدل والإنصاف المذكورة.
وخلاصة الكلام : أنّ من بيده النصف مدّع للنصف الآخر ، ومن بيده الدّرهم والنصف منكر ، ومن بيده الدرهم والنصف مدّع للنصف الآخر الذي بيد طرفه ، وهو منكر ؛ فيكون الأمر كما ذكرنا.
هذا ما ذكره هؤلاء الأساطين مع اختلاف بين ما ذكروه ، وهو تخصيص الحلف بالثاني أي مدّعي الواحد إذا ادّعى مشاعا.
ولكن التحقيق أنّه لا فرق في صيرورة كلّ واحد منهما مدّعيا ومنكرا في المفروض ، أي فيما إذا كان لكليهما اليد على الدرهمين بين أن يكون دعوى المدّعي الواحد على الإشاعة أو على التعيين.
وتوضيح ذلك موقوف على بيان مقدّمة ، وهي أنّه لا شكّ في أنّ ذا اليد منكر لو ادّعى المال من ليس له يد على المال ، وليس له حجّة أخرى على أنّ المال له. وذلك الآخر الذي ليس له يد على المال يكون مدّعيا ، إن لم يكن له حجّة أخرى على أنّ المال المتنازع فيه له. فبناء على هذا يكون ذو اليد منكرا ومقابله يكون مدّعيا.
ثمَّ إنّ ذا اليد لو كان شخصا واحدا ، فالذي يدّعيه يكون مدّعيا ويكون ذو اليد منكرا. وأمّا لو كان ذو اليد متعدّدا كما إذا ادّعى أحد غير هؤلاء الذين لهم اليد على المال أيضا يكون مدّعيا ، وذوو الأيدي يكونون منكرين إن لم يصدّقوه.
وأمّا إن كان مدّعي لجميع ما في يدهم أحدهم ، فيكون مدّعيا بالنسبة إلى البعض ومنكرا بالنسبة إلى بعض آخر.
بيان ذلك : أن ذا اليد على مال واحد إن كان متعدّدا ، فلا يمكن أن تكون يد كلّ واحد منهم يدا تامّة مستقلّة ؛ وذلك لأنّ اليد التامّة المستقلّة كما أنّ لها التصرّفات المشروعة في المال ، كذلك له المنع عن تصرّف الغير. وفي الأيدي المتعدّدة ليس لها المنع عن تصرّفات سائر الأيادي ؛ ولذلك لا يحسبها العرف يدا مستقلّة ، بل يعتبرون اليد الناقصة المستقلّة على المجموع يدا مستقلة على البعض بنسبة عدد الأيادي.
مثلا لو كان شريكان ، لكلّ واحد منهما يد على مال ، فحيث أنّ يد كلّ واحد منهما غير تامّة ، فالعرف يعتبرونها تامّة بالنسبة إلى البعض بنسبة عدد الأيدي ، وحيث أنّ ذا اليد اثنين فيد كلّ واحد منهما الناقصة على جميع المال يعتبر يدا تامّة على نصف المال ، وإن كان ذوو الأيدي والشركاء ثلاثة يعتبر يد كلّ واحد منهم الناقصة يدا تامّة على ثلث المال ، وهكذا.
إذا تبيّن ما ذكرنا ، فنقول :
إذا ادّعى أحدهما أنّ أحد هذين الدرهمين بالخصوص لي وعيّنه ولم يكن دعواه بنحو الإشاعة ، فهذا المدّعي بالنسبة إلى نصف هذا الواحد المعيّن مدّع ، وبالنسبة إلى نصفه الآخر منكر.
بيان ذلك : أنّ مفروض المسألة إن كليهما لهما اليد على هذا الدرهم الذي يدّعيه أحدهما ، وحيث أنّ يد كلّ واحد منهما على مجموع هذا الدرهم غير تامّة وناقصة ، وفي اعتبار العرفي وبنظرهم يد كلّ واحد منهما على المجموع حيث أنّها ناقصة تكون بمنزلة اليد التامّة على نصف ذلك الدرهم ، فتكون أمارة على ملكيّة نصف ذلك الدرهم.
وذلك لأنّ اليد التي هي أمارة الملك هي اليد التامّة المستقلّة غير الناقصة ، فإذا كان الأمر كذلك فالمدّعي لهذا الدرهم المعيّن يكون بالنسبة إلى النصف الذي تحت يد مدّعي الاثنين مدّع ، ومدّع الاثنين بالنسبة إلى هذا النصف الذي تحت يده منكر ، كما أنّ مدّعي الاثنين بالنسبة إلى النصف الذي تحت يد مدّعي الواحد المعين مدّع ، وهو أي مدعي الواحد منكر.
فكلّ واحد منهما مدّع ومنكر ، ويجري في حقّهما قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » وحيث أنّ المفروض عدم البيّنة في المقام ، فيجب حلف كلّ واحد منهما لردّ دعوى الآخر ، فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا يسقط كلا الدعويين ، ويقسّم ذلك الواحد المعيّن بينهما بالسويّة ؛ لقاعدة العدل والإنصاف.
وأمّا إن حلف أحدهما دون الآخر ، فيكون الدرهم المتنازع فيه للذي حلف.
وكذلك الأمر في مدّعي الشركة مثل المدّعي للواحد المعيّن في وجوب الحلف على كلّ واحد منهما.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ يد المدّعي للشركة تامّة بالنسبة إلى ما يدّعيه أي الشركة وملك النصف أي الدرهم الواحد مشاعا ، فالذي يدّعي الجميع يكون مدّعيا ، لأنّ يده على الجميع ليست تامّة كما ذكرنا. ومدّعي الشركة منكر ؛ لما ذكرنا من أنّ يده تامّة بالنسبة إلى ادّعائه الشركة ، فهو منكر ووظيفة المنكر هو الحلف ، فيختصّ الحلف بالثاني ، أي المدّعي الواحد إذا كان يدّعيه إشاعة أي الشركة بالمناصفة.
وهذا الحكم جار في كلّ من يدّعي الشركة في مال مقابل المدّعي لمجموع ذلك المال مع كون ذلك المال بيدهما جميعا ، كما ذهب إليه الشهيد في الدروس (29) . وقال في جامع المقاصد إنّه متّجه (30).
والإنصاف أنّ العرف مساعد لكون يد كلّ واحد من الشخصين اللذين لهما اليد على مال أمارة الشركة ، فيكون من يدّعي جميع الدرهمين بالنسبة إلى أحد الدرهمين من قبيل المدّعي بلا معارض ؛ لأنّ الآخر لا يدّعيه ، بل هو مقرّ بأنّه له. وأمّا بالنسبة إلى الدرهم الآخر يكون مدّعيا بلا حجّة ، في مقابل دعوى الشركة من الآخر ؛ لأنّ يده أمارة على الشركة ، لا على أنّ جميع المال له.
فقوله : إنّ جميع المال له ، مخالف للحجّة الفعليّة ، وهو يد من يدّعي الشركة. وقد حقّقنا في كتاب القضاء أنّ المدّعي هو من يكون قوله مخالفا للحجّة الفعليّة ، والمنكر مقابله وهو من يكون قوله موافقا للحجّة الفعليّة ، وفي المقام حيث يكون قول من يدّعي الشركة موافقا للحجّة الفعليّة ، ومن يدّعي الجميع مخالفا لها ، فيكون الأوّل ـ أي من يدّعي الشركة ـ منكرا ، ومن يدّعي الجميع مدّعيا ، فيكون المدّعي للشركة وظيفته الحلف ، والآخر ـ أي مدّعي الجميع ـ وظيفته البيّنة. وهذا الحكم جار في جميع موارد مدّعي الشركة مع مدّعي الجميع ، ولعلّ هذا ما أراده الشهيد في الدروس.
وعلى كلّ حال ، الحكم في هذه المسألة ما أفتى به المشهور ، من كون أحد الدرهمين للذي يدّعيهما جميعا ، وتنصيف الآخر بينهما ، فيكون درهم ونصف لمن يدّعيهما ، ونصف درهم للذي ادّعى الواحد ، سواء كان دعوى الأخير على نحو الاشتراك ، أو كان يدّعي واحدا معيّنا ؛ وذلك للنصّ المتقدّم ، وهو صحيح عبد الله بن المغيرة المذكور آنفا.
والتمسّك بهذه القواعد للاحتياج إلى الحلف والعمل بميزان القضاء ، يكون من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ ، وهذا ممّا يطعن به على المتمسّك مع أنّ هذا الحكم ليس مخالفا للقواعد المقرّرة في كتاب القضاء.
بيان ذلك : أنّه حيث أنّ مفروض المسألة فيما يكون لكلّ واحد من المدّعيين يد على المتنازع فيه ، أو مطروح في مكان ليس لأحدهما يد عليه ، ولا فرق بين الصورتين فيما هو المهمّ في المقام ، وهو أنّه ليس هاهنا مدّع ومنكر في البين ، بل هاهنا مدّعيان ليس لهما حجّة على ما يدّعيان إمّا من أوّل الأمر ، كما إذا كان مطروحا وليس لأحدهما يد عليه ، أو من جهة سقوط كلا المدركين بالتعارض ، وذلك فيما كان لكلّ واحد منهما يد على المال المتنازع فيه ، فتتعارض اليدان وتتساقطان. وعلى كلّ واحد من التقديرين دعويان بلا مستند لكلّ واحد منهما ، وليس المورد مورد المدّعي والمنكر والمال بينهما ، فلا بدّ من تنصيف محلّ النزاع ولو لم يكن تلك الصحيحة ؛ لقاعدة العدل والإنصاف التي يجريها الفقهاء في كلّ مورد يكون المال بينهما وليس لأحدهما مدرك وليس مدّع ومنكر في البين.
فلا يمكن قطع نزاعهما بموازين القضاء ، ولا بدّ من قطع الخصومة ، فيقطع بتطبيق هذه القاعدة بالتنصيف أو بالتثليث أو بالتربيع. وهكذا بنسبة عدد المدّعين ، فلو كان عشرين كلّ واحد منهم يدّعي تمام المال الذي ليس لأحدهم يد عليه ، ولا لغير هم عليه يد ، وليس لأحد منهم مدرك آخر أنّ هذا المال له ، فلا بدّ وأن يقسّم بينهم بقاعدة العدل والإنصاف عشرين ، لكلّ واحد منهم واحد من ذلك العشرين.
ومما ذكرنا يظهر لك أنّ ما أفتى به المشهور من أنّه « لو وادعه إنسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع ثمَّ تلف درهم ، يعطى لذي الدرهمين درهم من الدرهمين الباقيين ، وينصّف الدرهم الباقي » فتواهم على طبق القاعدة ، وهي قاعدة العدل والإنصاف ؛ لأنّ الاثنين لا يد لهما على الدرهم ، أمّا يد الودعي فليست أمارة الملكيّة ، وأمّا المدّعيان فلا يد لأحدهما على المتنازع فيه ، واليد السابقة على الإيداع متعلّقها غير معلوم ، وليس المقام مقام المدّعي والمنكر ، فلا يمكن العمل بموازين القضاء ، ولا يمكن قطع الخصومة إلاّ بتطبيق قاعدة العدل والإنصاف بتنصيف المنازع فيه ؛ لأنّهما اثنان ، ولو كان عدد المدّعين أكثر ، كان التقسيم بعددهم كما عرفت.
وهذا ربما يسمّى بالصلح القهري ، ووجه التسمية واضح ، ولعلّ هذه التسمية صارت سببا لذكر هذه الفروع في كتاب الصلح ، فهذا الحكم على طبق القواعد ، ويؤيّده ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام في رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منها قال عليه السلام : « يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين » (31).
أقول : هذا أحد الاحتمالات في هذه المسألة وقد افتى به المشهور.
وهاهنا احتمالات أخر :
منها : أن يصير المال ـ أي الدراهم ـ مشتركة بينهما بواسطة الاختلاط والاجتماع في مكان واحد ، أو بواسطة عدم التمييز الحاصل عن الاختلاط والاجتماع في محلّ واحد ، خصوصا إذا كانت من الدراهم المسكوكة بسكّة واحدة وبوزن واحد وشكل واحد.
ومنها : أن يكون موردا للقرعة ؛ لأجل أنّ القرعة لكلّ أمر مجهول أو مشتبه ، وها هنا اشتبه الدرهم الضائع ، ولا يعلم أنّه لصاحب الدرهم الواحد كي يكون الدرهمان الباقيان لصاحب الدرهمين ، أو أنّه لصاحب الدرهمين كي يكون الباقي أحدهما لهذا والآخر لذاك.
ومنها : الصلح القهري ؛ حيث لا يمكن معرفة صاحب المال الموجود ، فلا بدّ للحاكم أن يجبرهما على الصلح لرفع الخصومة وقطع النزاع ، فلا بدّ للفقيه أن ينظر إلى هذه الوجوه ، ويرى أنّ أيّها أوجه وبالقواعد أوفق.
أقول : أمّا احتمال الاشتراك بواسطة الاختلاط وعدم الامتياز ، وإن أثره هو أن يكون من كلّ درهم ثلثه لصاحب الدرهم الواحد وثلثاه لصاحب الدرهمين ، فإذا ضاع واحد الثلاثة وبقي اثنان ، يكون لصاحب الدرهم الواحد ثلث من كلّ واحد من من الدرهمين الباقيين ، وثلثان من كلّ واحد منهما لصاحب الاثنين ؛ فمجموع حصّة صاحب الدرهم الواحد ثلثا درهم ، ومجموع حصّة صاحب الاثنين أربعة أثلاث ، أي درهم وثلث درهم.
فبناء على حصول الاشتراك يصير حصّة صاحب الدرهمين أقلّ ممّا في الرواية وأيضا ممّا أفتى به المشهور ، وهو درهم ونصف ؛ لأنّ حصّته بناء على ما في رواية السكوني وفي فتوى المشهور أربعة أثلاث ونصف ثلث ، بناء على الاشتراك أربعة أثلاث فقط من دون نصف ثلث ، ويصير حصّة صاحب الدرهم الواحد أزيد ممّا في الرواية وممّا أفتى به المشهور ؛ لأنّه بناء على الاشتراك يكون نصيب صاحب الدرهم الواحد نصفا ونصف ثلث ، وبناء على مفاد الرواية وفتوى المشهور يكون نصف درهم فقط من دون نصف الثلث.
فمرجوح جدّا أوّلا : من جهة أنّ وجود المناط في حصول الشركة القهريّة ـ التي لا بدّ أن يكون هو المراد في المقام في مثل الدراهم والدنانير ـ في غاية الإشكال.
وثانيا : الحكم بوقوع الشركة في المفروض مع وجود رواية عمل بها الأصحاب وصارت معتبرة ولو من هذه الجهة على خلافها لا يخلو من نظر وتأمّل.
وأمّا الاحتمال الثاني : أي كون المسألة موردا للقرعة من جهة قوله عليه السلام : « القرعة لكلّ أمر مشكل » وفي بعض الروايات : « لكلّ أمر مشتبه » وفي بعضها الآخر : « لكلّ أمر مجهول » (32) ، والمورد مشكل ومشتبه مجهول.
أمّا كونه مشكلا ؛ من جهة العلم بأنّ المتنازع فيه إمّا لصاحب الدرهم الواحد وإمّا لصاحب الاثنين ، ولا طريق إلى معرفة صاحبه كي يردّ إليه. وأمّا كونه مجهولا ؛ فصاحبه مجهول ، وأمّا كونه مشتبها ؛ فلأنّ مالكه مشتبه يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون الآخر.
ففيه : أنّه أوضحنا في قاعدة القرعة أنّ الأخذ بعموم « كلّ أمر مجهول أو مشتبه » ممّا يقطع بخلافه.
وأمّا الأمر المشكل في الأحكام فهو أيضا ممّا يعلم بعدم اعتبار القرعة ، وقلنا إنّ المستفاد من أدلّة القرعة هو أن يكون المورد معلوما بالإجمال ، ويكون في الشبهة الموضوعيّة لا الحكميّة ، ولا يمكن الاحتياط أو يكون الاحتياط حرجيّا أو ضرريا.
فالأوّل كما إذا طلّق إحدى زوجاته فاشتبهت عليه المطلّقة. والثاني كما لو علم أنّه نذر زيارة الرضا عليه السلام أو زيارة الأئمّة المدفونون في البقيع عليهم السلام .
والثالث كما لو علم بأنّ في قطيع غنمه موطوءا ، فالاحتياط بالاجتناب عن جميع غنمه ضروريّ قطعا ، وفوق ذلك كلّه يكون قد عمل بها الأصحاب في ذلك المورد ، ومعلوم أنّه في هذا المورد لم يعمل بها الأصحاب ؛ لأنّ فتوى المشهور على التنصيف ، فلم يعملوا بها قطعا مضافا إلى أنّ مع وجود الرواية المعمول بها عند الأصحاب لا يبقى إشكال ولا جهل ولا اشتباه في حكم المورد ؛ فليس ما نحن فيه موردا للقرعة.
وأمّا الصلح القهريّ مع وجود تلك الرواية المعمول بها فلا وجه له ولا تصل النوبة إليه ، فالمتّجه هو الاحتمال الأوّل ، والعمل بالرواية والأخذ بفتوى المشهور.
ومنها : أي من فروع هذه القاعدة : لو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم مثلا ، فصالحه بأقلّ من قيمته أو بأزيد ، فهذا الصلح صحيح وإن قلنا بأنّ الربا المعامليّ يدخل في الصلح ، وليس مختصا بالبيع ، كما هو الصحيح عندنا ، وذكرنا وجهه في قاعدة « لا رباء إلاّ في المكيل والموزون » لأنّ الصلح وقع عن الثوب على أقلّ من قيمته أي درهم واحد ، أو على أزيد منه ، ولم يقع عن نفس القيمة على الأقلّ أو الأكثر منه كي يلزم الرباء.
وادّعى في الدروس أنّ صحّة هذه المعاملة على الوجه الذي ذكرنا هو المشهور.
وقد يقال إنّ صحّته وفساده دائر بين أن يكون التلف في القيميّات في اليد الغير المأذونة ، أو إذا أتلف كما هو المذكور في عنوان المسألة هل يوجب اشتغال الذمّة بقيمة التالف أو بمثله ، ويكون أداؤه بالقيمة ، أو التالف بنفسه بوجوده الاعتباريّ في الذمة ويكون أداؤه بالقيمة.
فإن قلنا بالأوّل ، أي حين التلف في اليد الغير المأذونة ، أو حين الإتلاف تشتغل الذمّة في القيميات بالقيمة ، فيكون واقعا عن القيمة على الأقلّ منه أو على الأكثر منها ، فيكون من الربا الباطل.
وأمّا إن قلنا إنّ الذمّة تشتغل بمثل التالف أو بنفسه بوجوده الاعتباريّ ، وإنّما يكون أداؤه بالقيمة ، أي الدرهم أو الدينار ، فالصلح صحيح ؛ لأنّ الصلح وقع عن نفس التالف الذي ليس من المكيل والموزون كالثوب كما هو المفروض ، وإنّما أداؤه بالدرهم أو الدينار ، فلا رباء ، أو وقع من مثل التالف الذي اشتغلت ذمّته به ، وإنما أداؤه بالقيمة ؛ ففي هذا الفرض أيضا لا رباء ؛ ففي هذين الوجهين لا إشكال في صحّة الصلح.
هذا في مقام الثبوت ، وأمّا في مقام الإثبات فالظاهر أنّ ما يأتي في الذمّة بواسطة التلف في اليد الغير المأذونة ، أو بواسطة الإتلاف مطلقا في القيميّات هي القيمة ، كما حقّقناه في قاعدة اليد ، (33) فصحّة هذا الصلح إذا كان التالف من القيميّات في غاية الإشكال.
اللهمّ إلاّ أن يقال : على فرض القول في ضمان القيميّات أنّه تشتغل الذمّة من حين التلف أو الإتلاف بالقيمة لا بنفسه بوجوده الاعتباريّ ولا بمثله ، ولكن القيمة التي تشتغل الذمّة بها ليست خصوص النقدين المعروفين ، أي الدرهم والدينار ، بل المراد منها ماليّة التالف ، سواء قدر بالنقدين المعروفين أي الدرهم والدينار ، أو قدر بالأجناس الأخر التي لا يكال ولا يوزن ، كما إذا كانت من المعدودات ، أو ممّا يباع بالذراع والامتار ، أو كانت ممّا يباع بالمشاهدة كأنواع الحيوانات كالغنم والإبل وغيرهما.
فلو صالحه ، أي صالح الذي أتلف عليه عن متاعه الذي من القيميّات على مبلغ أزيد أو أقلّ من تلك القيمة الكلّية القابلة للانطباق على النقدين وعلى غيرهما ممّا لا يكال ولا يوزن ، فلا يكون من الربا الباطل ؛ لأنّ ذلك الكلّي ليس من الأجناس الربويّة ، لأنّه قابل للانطباق على الأجناس الغير الربويّة.
وخلاصة الكلام : أنّه بناء على هذا الذي ذكرنا كما أنّه لو كان التالف مثليّا الصلح عنه على الأقلّ أو الأزيد منه لا يكون من الربا الباطل ، كذلك لو كان من القيميّات ، وإن قلنا باشتغال ذمّته بالقيمة من حين التلف ، وذلك لأنّ المراد من القيمة ليس خصوص النقدين المعروفين ، بل المراد مطلق الماليّة.
ومنها : أنّه لو كانت دار مثلا في يد شخص ، وادّعاها اثنان بسبب مشترك بينهما كالإرث مثلا ، وقالا : ورثنا هذه الدار من أبينا ، فكلّ واحد يدّعي نصف تلك الدار وأنّه له بسبب مشترك وهو الإرث من أبيهما ، فصدّق المتشبث ـ أي ذو اليد ـ أحدهما دون الآخر ، بمعنى أنّه أقرّ لأحدهما المعيّن بأنّ نصف هذه الدار لك ، وصالحه عن ذلك النصف المقرّ به له على مال ، فتارة يجيز الآخر هذا الصلح بعد وقوعه أو يأذن قبله ؛ فهذا الصلح صحيح في تمام نصف الدار ، ويكون المال مشتركا بينهما ؛ لأنّ كلّ واحد من المدّعيين مقرّ بأنّ النصف الذي وقع الصلح عنه على ذلك المال مشاع بينهما ، فبعد الإذن أو إجازة الشريك الآخر وصحّة الصلح ، يكون العوض لهما على الإشاعة.
وأخرى : لا يمضى الآخر ولا يقبله ، فيكون الصلح في نصف ذلك النصف ـ أي الربع ـ صحيحا ، وفي الربع الذي للآخر فضوليّا وباطلا ؛ لردّه وعدم إمضائه.
هذا كلّه فيما إذا اتّفقا على وحدة سبب استحقاقهما ، وأمّا إذا لم يتّفقا في ذلك ، بل ادّعى أحدهما أنّ نصف هذه الدار مشاعا لي من جهة اشترائي من فلان ، والآخر أيضا ادّعى أنّ نصفها المشاع لي بسبب آخر ، كإرثه من أبيه ، أو اتّهابه من فلان ، أو اشترائه وأمثال ذلك من أسباب التمليك غير سبب ملكيّة الآخر ، فلو صالح أحدهما عن نصفه مثلا على مال يكون الصلح في تمام حصّته صحيحا ، ويكون تمام العوض له ، وهذا واضح جدّا.
وأمّا لو كان شراؤهما لتلك الدار معا ، بمعنى أنّ صاحب الدار قال لهما : بعتكما هذه الدار فقبلا دفعة ، أو قبل وكيلهما عنهما أو اتّهابها معا ، وكذلك قبضهما دفعة ومعا.
فهل هذا مثل كون ملكهما عن سبب واحد ، فإذا أقرّ ذو اليد لأحدهما بنصف الدار مثلا ، وصالح المقرّ له عن ذلك النصف على مال ، يكون نصف مال المصالحة لذلك الآخر الذي هو شريك مع هذا الذي صالحه إن أذن في الصلح قبلا ، أو أجاز بعد وقوعه ، وإن لم يأذن ولم يجز ، فالصلح باطل في حصّته وصحيح في نصف ذلك النصف الذي وقع الصلح عنه ، أي في ربع الدار المفروض ويرجع نصف مال المصالحة إلى مالكه قبل وقوع الصلح أي المصالح المذكور ، أولا؟ بل يكون ملحقا بما إذا كان ملكيّة الشريكين من سببين متغايرين ، فيكون الصلح صحيحا في تمام حصّة المقرّ له ، ولا دخل للشريك الآخر في هذا الصلح ، وليس لإمضائه ولا لردّه أثر في صحّة هذا الصلح ، ولا في بطلانه؟
ربما يقال : بأنّ ذا اليد لو أقرّ بملكيّة أحدهما مرجعه إلى وقوع الاتّهاب أو الابتياع بالنسبة إليه ، ولا يمكن التفكيك بين وقوع الاتّهاب أو الابتياع بالنسبة إلى المقرّ له دون الآخر ؛ لأنّ المدّعيين متّفقان في وحدة سبب ملكيّتهما وهو الاتّهاب مع القبض منهما دفعة ، فيكون الآخر غير المقرّ له مقرّا ومعترفا بأنّ كلّ نصف من الإنصاف المتصوّرة في هذه الدار يكون له وللآخر ، فإذا كان ذو اليد يعلم فلازم إقراره لأحدهما إقراره لكليهما. نعم يمكن لذي اليد دعوى أنّ الاتّهاب والابتياع لم يقع إلاّ في نصف هذه الدار.
وأمّا الشريكان فالمفروض اتّفاقهما على أنّ هذه الدار جميعها ـ ابتياعا بصيغة واحدة ، أو اتّهابا بقبول واحد وقبض واحد ـ مشاع بينهما ، فإذا رفع الغاصب يده عن نصف الدار فقهرا يكون ذلك النصف لكليهما لا لأحدهما ، فيكون الصلح مع أحدهما عن نصف الدار فضوليّا بالنسبة إلى نصف ذلك النصف ، أي ربع تلك الدار موقوفا على إجازة المالك ، وهو الشريك الآخر غير المقرّ له.
ولكن التحقيق : أنّ الإقرار لأحد الشريكين إذا كان سببها ـ أي الشركة ـ واحدا لا ينصرف إلى حصّة المقرّ له وحده ، بل الغاصب لما رفع اليد عن نصف مال المغصوب من الشريكين يكون لهما ، ولا وجه لاختصاصه بأحد الشريكين وإن أقرّ بأنّه لأحدهما.
هذا في الإقرار وأمّا بالنسبة إلى البيع والصلح ، فإن باع أحد الشريكين النصف المشاع من المال المشترك الذي يملكه ، فإن صرّح بأنّ المبيع هو نصف نفسه أو نصف شريكه يكون هو المبيع ؛ لأنّه عيّن المبيع ، وأمّا إن أطلق ، فالظاهر أنّه ينصرف إلى نصف نفسه ، وقد حقّقنا هذه المسألة في مسألة من باع نصف الدار وله ملك نصفها ينصرف إلى ما يملكه من نصفها المشاع.
وبعبارة أخرى : تارة يعيّن في مقام البيع حصّة شريكه ، أي يبيع نصف الدار لشريكه ، وأخرى : النصف المشاع الذي يملكه هو ، فيقع البيع عمّن قصده نفسه أو شريكه ، وثالثة يطلق ، لا يقصد بيع نصف نفسه ، ولا نصف شريكه.
ولعلّ هذه الصورة صارت محلّ البحث في مسألة من باع نصف الدار وله ملك نصفها ، فالمدّعى أنّ الظاهر في هذه الصورة انصراف البيع إلى ما يملكه ، لا أن يبيع مال غيره ، بدون ذكره والانتساب إليه.
هذا حال البيع ، وكذلك الصلح إذا وقع عن حصّة مشاعة بين من يصالح معه وبين غيره ، فالظاهر أنّه ينصرف إلى حصّة من يصالح معه ، فيكون الصلح بالنسبة إلى تمام ما يصالح عنه وهي الحصّة المشاعة التي لمن يصالحه صحيحا ، ويكون تمام المال المصالحة له ، ولا يستحقّ شريكه شيئا منه.
قال في جامع المقاصد (34) في مقام ترجيح صحّة الصلح المذكور في تمام ما صالح عنه ، ووقوعه عن تمام حصّة المصالح معه ، وبعبارة : كونه كالصلح عن مال غير مشاع مشخّص معيّن ، أو المشاع بسبب غير سبب الحصّة التي للشريك.
قال : ولقائل أن يقول : لا فرق بين تغاير السبب وكونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة ؛ لأنّ الصلح إنّما هو على استحقاق المقرّ له ، وهو أمر كلّي يمكن نقله عن مالكه إلى آخر ، ولهذا لو باع أحد الورثة حصّته من الإرث صحّ ولم يتوقّف على رضا الباقين.
ثمَّ اعلم أنّ الفروع التي ذكرها الفقهاء في كتاب الصلح كثيرة ، ولكن البحث عنها غالبا يرجع إلى قواعد أخر غير قاعدة « الصلح جائز بين المسلمين » ولذلك تركنا ذكرها لكي يكون البحث عنها في كتاب الصلح كما هو ديدن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم.
والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً.
_______________
(*) « عناوين الأصول » عنوان 41 ؛ « مناط الأحكام » ص 197.
(1) « الفقيه » ج 3 ، ص 32 ، باب الصلح ، ح 3267 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 164 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 3 ، ح 2 ؛ « عوالي اللئالي » ج 2 ، ص 257 ؛ « مستدرك الوسائل » ج 13 ، ص 443 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 3 ، ح 2.
(2) « الكافي » ج 5 ، ص 259 ، باب الصلح ، ح 5 ؛ « التهذيب » ج 6 ، ص 208 ، ح 479 ، باب الصلح بين الناس ، ح 10 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 164 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 3 ، ح 1.
(3) « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 163 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 1 ، ح 6 ؛ « ثواب الأعمال » ص 178 ، ح 1.
(4) « الكافي » ج 5 ، ص 258 ، باب الصلح ، ح 2 ؛ « الفقيه » ج 3 ، ص 33 ، باب الصلح ، ح 3268 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 206 ، ح 470 ، باب الصلح بين الناس ، ح 1 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 165 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 5 ، ح 1.
(5) « جواهر الكلام » ج 26 ، ص 212.
(6) « المكاسب » ص 104.
(7) « السرائر » ج 2 ، ص 326.
(8) « الكافي » ج 5 ، ص 259 ، باب الصلح ، ح 6 ؛ « الفقيه » ج 3 ، ص 33 ، باب الصلح ، 3269 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 206 ، ح 472 ، باب الصلح بين الناس ، ح 3 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 166 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 5 ، ح 2.
(9) « الكافي » ج 5 ، ص 259 ، باب الصلح ، ح 8 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 6 ، 208 ، ح 480 ، باب الصلح بين الناس ، ح 11 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 166 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 5 ، ح 4.
(10) « الفقيه » ج 3 ، ص 32 ، باب الصلح ، ج 3267 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 164 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 3 ، ح 2.
(11) « الكافي » ج 5 ، ص 259 ، باب الصلح ، ح 5 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 164 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 3 ، ح 1.
(12) « عوالي اللئالي » ج 1 ، ص 222 ، ح 99 ؛ وص 457 ، ح 198 ؛ وج 2 ، ص 138 ، ح 383.
(13) « عوالي اللئالي » ج 1 ، ص 222 ، ح 98 ؛ وص 113 ، ح 309 ؛ وج 2 ، ص 240 ، ح 6.
(14) « عوالي اللئالي » ج 3 ، ص 473 ، ح 4.
(15) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 99.
(16) « الكافي » ج 5 ، ص 258 ، باب الصلح ، ح 1 ؛ « الفقيه » ج 3 ، ص 229 ، باب المضاربة ، ح 3848 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 207 ، ح 476 ، باب الصلح بين الناس ، ح 7 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 165 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 4 ، ح 1.
(17) « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 413.
(18) « المسالك الافهام » ج 4 ، ص 265.
(19) « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 413.
(20) « مسالك الأفهام » ج 4 ، ص 265.
(21) « الدروس » ج 3 ، ص 333.
(22) « الكافي » ج 5 ، ص 365 ، باب النظر لمن أراد التزويج ، ح 1 ؛ « وسائل الشيعة » ج 14 ، ص 59 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب 36 ، ح 1.
(23) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 357 ، ح 1452 ، باب المهور والأجور ... ، ح 15 ؛ « الاستبصار » ج 3 ، ص 220 ، ح 779 ، باب انّه يجوز الدخول بالمرأة ... ، ح 2 ؛ « وسائل الشيعة » ج 15 ، ص 12 ، أبواب المهور ، باب 7 ، ح 1.
(24) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 364 ، ح 1478 ، باب المهور والأجور ... ، ح 41 ؛ « وسائل الشيعة » ج 15 ، ص 28 ، أبواب المهور ، باب 19 ، ح 1.
(25) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 99.
(26) « الفقيه » ج 3 ، ص 35 ، باب الصلح ، ح 3274 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 208 ، ح 481 ، باب الصلح بين الناس ، ح 12 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 169 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 9 ، ح 1.
(27) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 191.
(28) « الدروس » ج 2 ، ص 333.
(29) « الدروس » ج 3 ، ص 333.
(30) « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 436.
(31) « الفقيه » ج 3 ، ص 37 ، باب الصلح ، ح 3278 ؛ « وسائل الشيعة » ج 13 ، ص 171 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 12 ، ح 1.
(32) « الفقيه » ج 3 ، ص 92 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3389 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 240 ، ح 593 ، باب البينتين يتقابلان أو ... ، ح 24 ؛ « النهاية » ص 346 ؛ « وسائل الشيعة » ج 18 ، ص 189 ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب 13 ، ح 11 و18.
(33) راجع « القواعد الفقهية » ج 1 ، ص 131.
(34) « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 434.



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|