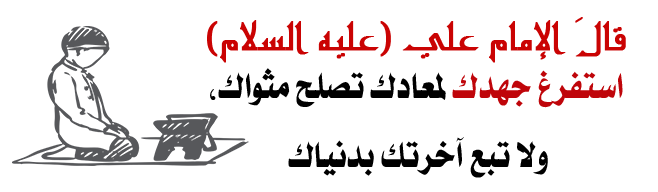
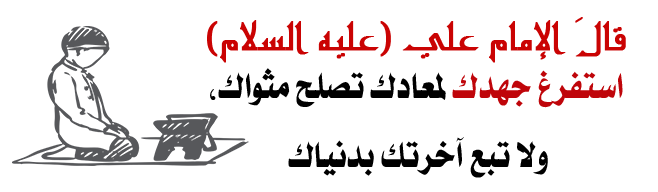

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017
التاريخ: 1-9-2019
التاريخ: 9-6-2016
التاريخ: 18-1-2023
|
تأكيداً لمكانة مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي في الاثبات فقد حاولت معظم التشريعات أن تتبناه في قوانينها، فقد نص على هذا المبدأ أول الأمر في المادة (372) من قانون الجرائم والعقوبات الفرنسي، كذلك نص عليه قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الصادر عام 1808 في المادة (342) منه، وبصدور قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي عام 1958 الذي نص على هذا المبدأ واكد عليه وذلك في المادة (353) منه على أن ( لا يطلب القانون من القضاة حساباً بالإدلة التي اقتنعوا بها ولا يفرض قاعدة خاصة تتعلق بتمام وكفاية دليل ما وإنما يفرض عليهم أن يتسألوا في صمت وتدبر وإن يبحثوا في صدق ضمائرهم، أي تأثير قد احدثته الادلة الراجحة ضد المتهم ووسائل دفاعة وإن القانون لا يوجه لهم سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل حدود واجباتهم هل لديكم اقتناع داخلي)(1)، ان المشرع الفرنسي في هذا النص قد أعطى للقاضي الحرية التامة في تكوين اقتناعه من أي دليل يراه مناسباً على أن يكون القاضي بتمام الاطمئنان عندما يسند هذه القناعة لدليل ما محكماً ضميره وعقله عندها يكون الحكم موافقاً للعدالة.
أيضاً تنص المادة (304) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1958 على أن (يحلف المحلفون يميناً بأن يحكموا تبعاً لأدلة الاتهام ووسائل الدفاع، وبناءً على ضمائرهم واقتناعهم الداخلي مع الحياد أو النزاهة والحزم الذي يتصف به انسان حر ومستقيم ) ، ومما سبق يتبين أن مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي يكمن أساسه القانوني بشكل واضح في ما اوردته النصوص التشريعية الفرنسية.
كذلك أشارت مدونة القضاء الإداري الفرنسي الصادرة بتاريخ 4 ايار لسنة 2000، والتي دخلت حيز النفاذ في كانون الثاني 2001 في الجزء التشريعي منها، وذلك في المادة (L231/1) على أن (يقوم قضاة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بأداء وظيفتهم بالاستقلال الكامل والكرامة والحياد والنزاهة والصدق وأن يتصرفوا بشكل يقي من إثارة أي شك مشروع ضدهم. وعليهم أن يمتنعوا عن اي عمل أو تصرف ذي طابع عام يتعارض مع التحفظ الذي تفرضه عليهم وظائفهم....)(2) ومن هذه النصوص يتضح أن المشرع الفرنسي أراد النص على استقلال السلطة القضائية المتمثلة بالقاضي الإداري والذي يتمتع بالاستقلالية التامة، وعدم التحيز لأي من طرفي الدعوى، وان له من الصفات المتمثلة بالصدق والنزاهة، وإنّه ليس بمحل للشك أو أي شكل من أشكال الظن الخاطئ، لأن القاضي الإداري يمثل الشخص المؤتمن على الدعوى الذي يفترض فيه التنزه عن كل ما لا يليق به.
أما ما سار عليه المشرع المصري في تبنيه لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري فيبدوا أنه لا يختلف عما انتهجه نظيره الفرنسي، إذ نص في قانون الاجراءات على أن ( يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة...) (3) ، ويتضح من هذا النص عند التمحيص فيه أن المشرع المصري قد أجاز للقاضي أن يحكم في الدعوى بحسب ما يتكون من قناعة لديه من الأدلة المطروحة في الدعوى، على أن هذه القناعة ليست متحرره من الضوابط، وإنما حددت هذه المادة الحدود التي يجب على القاضي اتباعها، وهي أن تكون الأدلة قد طرحت ونوقشت في الدعوى، وأن ليس للقاضي أن يبنى حكمة على أي دليل لم يطرح في الجلسة وليس لأطراف الدعوى أي علم به.
إن تبني المشرع المصري لهذا المبدأ لا يعني أنه قد أجاز للقاضي أن يحكم في القضية وفقاً لهواه أو أن يحتكم في قضائه لمحض عاطفته أو أن يعتمد على أسلوب تفكير بدائي، وانما يقع علية واجب أن يتحرى المنطق الدقيق في التفكير الذي قاده إلى تكوين اقتناعه (4).
وفي نفس الوقت أشار قانون الاثبات المصري إلى هذا المبدأ في المادة (30) إذ نصت على أن ( إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطة أو امضاءه أو ختمه أو بصمة أو انكر ذلك خلفة أو نائبة وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شان صحة الخط أو الامضاء أو الختم...)، أيضاً نصت المادة (52) من نفس القانون على أن (اذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق) (5).
إن القراءة الدقيقة للنصوص التي أوردها المشرع المصري في قانون الاثبات تعطي صورة واضحة على أن المشرع اعطى للقاضي الحرية الكاملة في أن يصل إلى اقتناعه من أي دليل يراه منتجاً في الدعوى، فإذا كانت الأدلة المطروحة من قبل الخصوم غير كافية لتكوين هذه القناعة فإنَّه يأمر بمزيد من الإجراءات التي تدعم ما يريد أن يصل اليه القاضي من هدف رسمه في ذهنه يراه هو الأصح والأنسب، والذي يترتب عليه في النهاية إصدار الحكم في الدعوى.
وفي ذات السياق والنهج المتبع من قبل التشريعات (الفرنسي المصري) ، فقد نهج المشرع العراقي المسار نفسه ونص على مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي في بعض القوانين، ولعدم وجود نصوص قانونية في قانون مجلس الدولة العراقي تنظم مسألة الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري بشكل خاص واجراءات الترافع أمام القاضي الإداري بشكل عام، ولكون قانون مجلس الدولة أشار إلى أن قانون المرافعات وقانون الاثبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية يحق للقاضي الإداري الرجوع إليها وبما يتلاءم وطبيعة الدعوى الإدارية في حال عدم وجود نص في قانون مجلس الدولة، لذا فقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في المادة (213/أ) على أنه (تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً) (6) ، أورد المشرع في هذا النص إنّ القاضي الذي ينظر الدعوى يصدر حكمه فيها حسب ما يتكون لديه من اقتناع استنبطه من دراسته للأدلة في الدعوى، وعليه فالاقتناع الذاتي المتولد لدى القاضي جاء نتيجة طبيعية لتظافر مجموعة من الأدلة أدت في مجموعها إلى تكوين عقيدة لدى القاضي صدر على إثرها حكمة في الدعوى.
كذلك أشار قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل لمبدأ الاقتناع وذلك في المادة (2) منه إذ نص على أن إلزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته من الدراسة المعمقة لما أورده قانون الاثبات العراقي في هذه المادة يتضح أن القاضي يعمل ما في وسعه لكي يتحرى الوقائع ويستقصي الحقائق من أجل أن يستكمل اقتناعه بما يعرض عليه من أدلة في الدعوى، إذ يعود للقاضي تقدير قيمة كل دليل من الأدلة، وفي كل الأحوال على القاضي أن لا يقف الموقف السلبي في الدعوى إذ يتوجب عليه أن يكمل الأدلة الناقصة بشرط أن لا يضر هذا الأمر بالحقوق المفروضة للخصوم في الدفاع، أما إذا لم يعمل كل ما في وسعه فإنه لا يصل الى حقيقة الأمر ويصبح حكمه عرضة للنقض.
أيضاً نصت المادة (128) من القانون نفسه على أن ( للمحكمة العدول عن قرارها بأجراء المعاينة إذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رأيها على أن تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة )، يظهر من هذا النص إن المشرع اعطى للهيئة القضائية الصلاحية الكاملة في أن ترجع عن قرار اتخذته من قبل في الدعوى إذ كان هنالك ما يكفي من الأدلة التي تعمل على اقتناع القاضي لهذا الرجوع، على أن ذلك مشروط بأن يبين القاضي سبب ذلك في مضبطة الجلسة حتى يكون في مأمن من التعرض لأي شبهة قد تؤثر على سمعته أو مسيرته المهنية.
خلاصة ما تقدم فإن الدستور وهو أعلى وثيقة قانونية في الدولة، قد ضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية التي تعد الحصن الحامي للحقوق والحريات في المجتمع، وهذا يؤدي إلى الاطمئنان الكامل للقاضي الإداري في بناء قناعته، وبما يحقق الغاية من الدعوى الإدارية، ومن هذه النقطة انطلقت القوانين كقانون المرافعات وقانون الاثبات الذي أقر مبدأ الاثبات الحر)، في منح القاضي الإداري الصلاحيات التي تتناسب مع دوره الايجابي في الدعوى الإدارية وسلطته في تحقيق التوازن بين أطرافها .
___________
1- طه خضير القيسي حرية القاضي في الاقتناع، ط1 ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2001، ص 47.
2- مدونة القضاء الاداري الفرنسي / القسم التشريعي ترجمة د. كمال جواد كاظم الحميداوي، دار السنهوري، بيروت، 2020، ص 69 - 70.
3- ينظر: المادة (302) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم (189) لسنة 2020.
4- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط4 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 849.
5- ينظر: قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل، نشر في الجريدة الرسمية بالعدد (22) في 1968/5/30
6- ينظر: قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971المعدل، نشر في الوقائع العراقية بالعدد ( 2004) في 1971/5/31.



|
|
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
|
|
الطلبة المشاركون: مسابقة فنِّ الخطابة تمثل فرصة للتنافس الإبداعي وتنمية المهارات
|
|
|