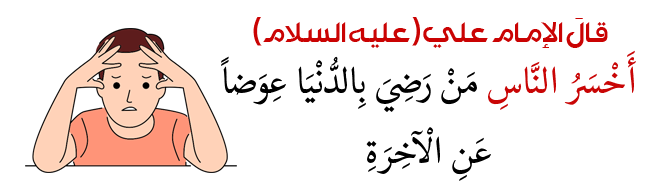
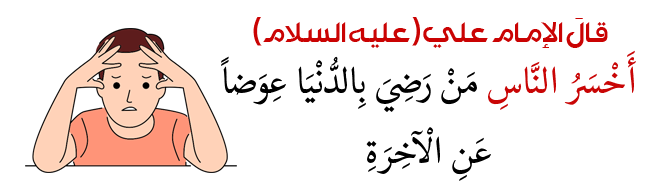

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-04
التاريخ: 2023-11-06
التاريخ: 2024-09-05
التاريخ: 2025-04-14
|
المفاوضة في اللغة ، مصدر فاوض ، وهي مفاعل ةٌ من التفويض ، ك أن كل واحد رد ما عنده إلى صاحبه (1) ، فهي الاشتراك في شيء ، وتعني المساواة والمشاركة والمجاراة في الأمر ، وفوض إليه الأمر تفويضا ، أي رده وسلمه إليه (2) ، اما في المعنى الاصطلاحي ، تعني اجتماع طرفين أو أكثر لإجراء مباحثات تهدف الى التوصل الى اتفاق حول مسألة معينة ، أو بالأحرى هي عملية تفاعل بشري غرضها الوصول الى اتفاق معين (3).
ومن اهم التعاريف التي قدمها فقهاء القانون الدولي العام للتفاوض ، كان تعريف الدكتور علي صادق ابو الهيف، الذي عدها " تبادل الرأي بين اشخاص القانون الدولي فيما يتعلق بين دولتين أو أكثر بقصد الوصول الى تسوية نزاع بينهما "(4)، ومما يؤخذ على هذا التعريف انه اقتصر وسيلة المفاوضة على حسم النزاع فقط ، في حين ان التفاوض يشمل معرى واسعاً ، إذ يشمل جميع القضايا التي تهم المجتمع الدولي بأسره .
وعرف الدكتور احمد ابو الوفا المفاوضة ، بأنها : " تبادل وجهات النظر حول مسألة معينة ، او موضوع معين ، وهو يفترض وجود طرفين على الأقل أو أكثر، فهو نوع من الاتصال والترابط ، أو التبادل ، أو الاجتماع الذي يفترض بطبيعة الاشياء وجود اكثر من طرف "(5).
فيما عرفها الدكتور محمد علي جواد بانها : " حوار يجري بين متعاقدين دولتين أو أكثر، من اجل البحث عن امكانية ايجاد توافق لإرادة الاطراف اتجاه الحقوق والالتزامات التي تمثل محل الاتفاق " (6).
وعلى أساس التعاريف المتقدمة ، يمكن ان نعرف المفاوضة بأنها : عملية إرادية اختيارية تقوم على أساس تبادل وجهات النظر بين ممثلين دولتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ، بغية التوصل إلى هدف معين في إطار العلاقات الدولية ، وفقا لقواعد القانون الدولي العام .
وعادة يشترط في المفاوض لإنجاز التفاوض بأكمل صورة عدة شروط لغرض اتمام هذه العملية ، وهذه الشروط هي :-
1- أهلية الاشتراك في المفاوضات -- لإضفاء الصفة القانونية على عملية التفاوض ، يشترط ان يكون المفاوض أهلاً لإجراء التفاوض ، إذ يجب إن يكون القائمون بالتفاوض من أشخاص القانون الدولي (7).
2- اوراق التفويض (8) : إن الخطوة التي تقوم بها الدولة المفاوضة هي تعيين الأشخاص الذين يقومون بالتفاوض ، والشخص المفاوض يجب أن يكون معتمدا لدى الدولة الأخرى ، ومزودا بتلك الأوراق التي تبين وصفه وفداً رسمي للدولة المتفاوضة ، وله الحق في الحضور في المفاوضات ، وربما التوقيع على الاتفاقيات الدولية مع التحفظ عليها أو بدون ذلك ، ويتحقق ذلك عن طريق وثيقة التفويض التي تجعل ممثل الدولة على ثقة تامة من الطرف الآخر (9).
ويجب إن يكون المفاوض مزوداً بأوراق التفويض ، إلا إذا كان رئيسا للدولة، أو رئيسا للحكومة ، أو وزيرا للخارجية ، أو رئيسا للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التي يتم التفاوض مع ممثليها ، أو الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيأتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة. ففي هذه الأحوال لا يحتاج المفاوض إلى اوراق بالتفويض ، أما غير ما ذكرناه فيجب إن يكونوا مزودين بوثيقة التفاوض ، وهذا ما بينته المادة (7) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 في معرض كلامها عن وثيقة التفويض الكامل ، إذ نصت على ان (1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:-
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة (ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها.
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيأتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
ولكن التساؤل الذي يبرز في هذا الصدد ، ماذا لو قام شخص باتخاذ عمل معين يتعلق بنص اتفاقية دولية من دون إن يكون مفوضا بذلك؟ لاشك في أن هذا الشخص يُعد غير ذوي صفة ، ومن ثم ليس لعمله اي أثر قانوني ما لم يتم الإقرار اللاحق لهذا العمل بواسطة السلطات المختصة للدولة (10).
3- الالتزام بالتفاوض بحسن نية - إن المفاوضات الدولية ليس لها صفة الإلزام على صعيد قواعد القانون الدولي بعد الانتهاء من مرحلة التفاوض ، وكل ما يلزم الدولة في إثناء التفاوض فقط الذي يشترط إن يكون التفاوض مبنياً على حسن نية ، ولهذا يمتنع عن الدول أثناء إجراء التفاوض القيام بأي تصرف من شأنه إن يعرض الاتفاقية للخطر أو يفوت الفرصة المتوخاة منها ، وهذا ما كانت تقضي به المادة (15) من مشروع لجنة القانون الدولي لاتفاقية قانون المعاهدات ، الا أن الاتفاقية بصيغتها النهائية قيدت من مجال هذا الالتزام وجعلته قاصرا على الدول الموقعة (11).
وقد عرفت محكمة العدل الدولية مضمون الالتزام بالتفاوض بحسن النية ، إذ أشارت إلى أن يلتزم الأطراف بالتصرف بحسن نية ، فلا تكون المفاوضات من دون معنى ، وليس هذا هو الوضع المثالي حين يكون هناك إصرار من أحد الطرفين من دون القبول بالبحث بإجراء أي تعديل (12) .
وبعد ان تسفر المفاوضات الدولية على اتفاق بين الأطراف ، فلابد أن تتجه إرادة الدول المتعاقدة إلى تحرير ما تم الاتفاق عليه مسبقا ، وحسب ما يتفق عليه الاطراف المتعاقدة ، وبعد الانتهاء من تحرير الاتفاقية الدولية يأتي دور التوقيع، الذي يعني موافقة المندوبين على المفاوضات الدولية ، وعرفه الدكتور عادل الطائي بأنه: "الإجراء الذي يفيد اتجاه إرادة اطراف الاتفاقية الدولية إلى قبولها والالتزام بما ورد فيها من الإحكام (13) ويعرفه الدكتور أ . ن طلالايف بأنه :" هو الإجراء الذي تثبت به صحة المعاهدة (14)، في حين عرفه شارل روسو على انه هو الإجراء الذي يحدد إرادة الدولة اتجاه المعاهدة ولا يضفي على المعاهدة صفة الإلزام "(15). ومن خلال ما تقدم، يمكن إن نعرف التوقيع بأنه : إجراء غير نهائي للالتزام بالاتفاقية الدولية بمثابة إثبات لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتفاوضة .
ويتخذ التوقيع صورا عدة هي كالاتي :-
1- التوقيع الكامل:- يقوم ممثل الدولة عادة بإجراء التوقيع بصورة كاملة ، إذا كان يمتلك تفويض يسمح له بذلك (16) ، وهذا التوقيع يمثل اعترافا من المتفاوضون بنصوص الاتفاقية وإحالة تلك النصوص إلى السلطات المختصة في دولهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول الاتفاقية والتصديق عليها ، وقد تتفق الأطراف المتفاوضة على أن التوقيع الكامل يضفي على الاتفاقية الصفة الإلزامية من دون حاجة إلى التصديق من السلطات المختصة (17) .
2- التوقيع المشروط : قد يلجا مندوب الدولة إن يوقع على الاتفاقية الدولية بشرط الرجوع إلى الدولة ، و يفعل ذلك، بناءً على تعليمات مسبقة من الدولة التي ينتمي اليها ، والغرض من ذلك فسح المجال امام الدولة في التفكير قبل الإعراب عن موقفها النهائي بالالتزام بالاتفاقية .
وقد اشارت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الى ذلك في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (12) إذ نصت على أن (يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازته دولته بعد ذلك).
3- التوقيع بالأحرف الأولى -: يقصد بالتوقيع بالأحرف الأولى هو تثبت صحة نصوص الاتفاقية الدولية بالأحرف الأولى لأسماء المفوضين ، والهدف من هو ترك فرصة للمندوب للرجوع إلى السلطات المختصة في الدولة ، فان أقرت السلطات الاتفاق ، حينئذ يتم التوقيع عليه بصورة كاملة ، والحقيقة ان هذ الاحتياط غريب، لأن مجرد التوقيع لا يلزم الدولة ، بل لابد من التصديق على الاتفاقية الدولية من الجهات المكلفة في الدولة (18)، ومن الأمثلة على التوقيع بالأحرف الأولى، اتفاقية التعاون المعقودة بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا الاتحادية، إذ وقعت بالأحرف الأولى في /7/ آب 1970 وتم توقيعها بصورة كاملة في 12 آب/ 1970 . ومع ذلك يمكن عد التوقيع بالأحرف الأولى من قبيل التوقيع الكامل ، متى ما اتفقت الدول الأطراف على ذلك . وهذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (12) من اتفاقية فينا يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك).
من خلال ما تقدم، يمكن أن نضع معيارا للتمييز بين التوقيع المشروط والتوقيع بالأحرف الأولى ، إذ إن الأول إذا إجازته الدولة فان تلك الإجازة لها اثر رجعي ، بينما لا يكون التوقيع بالأحرف الأولى مثل هذا الأثر ، إذ يُعد التوقيع اللاحق ، عملا منفصلا ينتج آثاره من يوم إتمامه وليس له أثر رجعي ، أما ما يتعلق بالفرق بين التوقيع الكامل والتوقيع بالأحرف الأولى فيمكن أن نحدده بالنقاط الاتية :-
1 - يُعد التوقيع الكامل تعبيرا عن موافقة الدولة بإلزاميتها ويعد نهائيا بعد موافقة الدولة، في حين التوقيع بالأحرف الأولى يقصد به تثبت صحة الاتفاقية ويجب التوقيع عليها إذا أجازته الدولة بعد ذلك.
2 - الاختلاف من ناحية الشكل، إذ يتم التوقيع بالأحرف الأولى فقط، في حين يكون التوقيع تاماً في حالة التوقيع الكامل ويتطلب الأخير وثائق تفويض (19) .
- تظهر أهمية التمييز في الاتفاقيات التنفيذية ، إذ من ش أن التوقيع الكامل إضفاء الصفة الإلزامية على الاتفاقية الدولية، بعكس التوقيع بالأحرف الأولى الذي لا يرتب النتيجة نفسها .
_____________
1- العلامة ابن منظور، لسان العرب ، المجلد 2 ، دار لسان العرب ، بيروت ، من دون سنة طبع ، ص 1144.
2- الشيخ عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة والعلوم ، المجلد الثاني ، دار الحضارة ، بيروت، من دون سنة طبع ، ص 265.
3- ينظر ، د. ابراهيم الشهاوي : ثقافة التفاوض والحوار ، ط 1 ، الشركة القومية للطبع والتوزيع ، القاهرة ، 2010 ، ص13. ود. محمد بدر الدين زايد: المفاوضات الدولية بين العلم والممارسة ، ط 1 ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، 2003 ،ص 15
4- د. علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف، الاسكندرية، من دون سنة طبع ، ص 636.
5- د. احمد ابو الوفا ، المفاوضات الدولية (دراسة لبعض جوانبها القانونية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص 9.
6- د. محمد علي جواد ، العقود الدولية مفاوضاتها ابرامها تنفيذها ، ط 1 ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، 2010، ص 57.
7- د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 207.
8- تعرف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (2) اوراق التفويض بأنها ( وثيقة تصدر عن السلطة المختصة في الدولة تحدد شخصا أو أكثر لتمثيلهما في التفاوض أو إقرار أو توثيق نص معاهدة ما أو للتعبير عن رضا الدولة في الارتباط بمعاهدة ما أو القيام بأي عمل بخصوص المعاهدة ).
9- ينظر ، د. محمد المجذوب : الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية ، بيروت ، من دون سنة طبع ، ص503-504
10- نصت المادة (8) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 بشأن الإجازة اللاحقة لتصرف تم من دون تفويض (لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة (7) مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة).
11- د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007، ص 182.
12- هذا ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال لعام 1969 وقضية تغير اتفاق 25 مارس بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لعام 1980 ينظر، موجز الإحكام وفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، نيويورك ص 95 ، 145.
13- د. عادل احمد الطائي ، القانون الدولي العام ، ط 1 دار الثقافة ، عمان ، 2009 ، ص 129.
14- د. أ . ن طلالايف: قانون المعاهدات الدولية النظرية العامة ، مطبعة العاني، بغداد، 1986، ، ص 149
15- شارل روسو ، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 1987، ص 43. ولمزيد من التفاصيل حول التعريف ينظر ، د. عدنان طه الدوري وعبد الأمير عبد العظيم العكيلي : القانون الدولي العام (الاحكام المنظمة للعلاقات الدولية وقت السلم والحرب) ، الجزء الثاني، منشورات الجامعة المفتوحة ، الجامعة المفتوحة ، 1994، ص 223.
16- جمال محي الدين ، القانون الدولي العام (المصادر القانونية) ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009، ص 75.
17- د. عبد الكريم منصوري ، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ص49-50 .
18- رینه جان دوبوي، القانون الدولي ، ترجمة سموحي فوق العادة ، 3، دار منشورات عويدات ، بيروت ، 1983، ص 67 - 68 .
19- لمزيد من التفاصيل ينظر، محمد سعيد الدقاق ود . مصطفى سلامة : مصادر القانون الدولي العام ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص 36 .



|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه
|
|
|