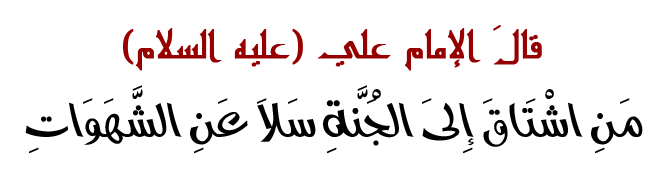
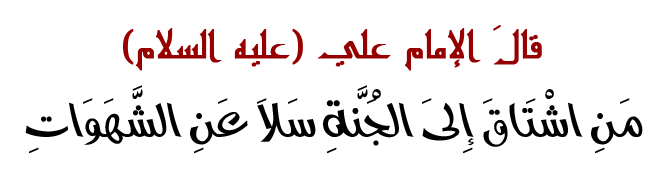

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
التاريخ: 19-9-2016
التاريخ: 19-9-2016
التاريخ: 30-9-2018
|
الإحرام فريضة ، لا يجوز تركه ، فمن تركه متعمدا فلا حج له ، وإن تركه ناسيا كان حكمه ما قدّمناه في الباب الأول ، إذا ذكر ، فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه ، فقد تمّ حجّه ، ولا شيء عليه ، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا (1) والذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا يجزيه ، وتجب عليه الإعادة ، لقوله عليه السلام : الأعمال بالنيات (2) وهذا عمل بلا نية ، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، ولم يورد هذا ، ولم يقل به أحد ، من أصحابنا ، سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال.
وإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا، فإذا انتهى إلى ميقاته، تنظف ، وقص أظفاره ، وأخذ شيئا من شاربه ، ويزيل الشعر من تحت إبطيه ، وعانته ، ثم ليغتسل ، كل ذلك مستحب ، غير واجب ، ثمّ يلبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ، ويتوشح بالآخر ، أو يرتدي به.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار ، في الجزء الثاني ، في باب كيفية التلفظ بالتلبية ، خبرا عن الرضا عليه السلام ، قال فيه : وآخر عهدي بأبي ، أنّه دخل على الفضل بن الربيع ، وعليه ثوبان وساج (3).
قال محمّد بن إدريس: وساج يريد طيلسانا ، لأنّ الساج بالسين غير المعجمة ، والجيم ، الطيلسان الأخضر ، أو الأسود ، قال أبو ذويب:
فما أضحى همي الماء حتى كأنّ على نواحي الأرض ساجا
ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات ، إذا خاف عوز الماء ، فان وجد الماء عند الميقات والإحرام ، أعاد الغسل ، فإنّه أفضل ، وإذا اغتسل بالغداة ، كان غسله كافيا لذلك اليوم ، أيّ وقت أراد أن يحرم فيه فعل ، وكذلك إذا اغتسل أوّل الليل ، كان كافيا له إلى آخره ، سواء نام أو لم ينم ، وقد روي أنّه إذا نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام ، كان عليه اعادة الغسل استحبابا (4) والأول هو الأظهر ، لأنّ الأخبار عن الأئمة الأطهار ، جاءت في أنّ من اغتسل نهاره ، كفاه ذلك الغسل ، وكذلك من اغتسل ليلا.
ومتى اغتسل للإحرام ثمّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله ، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه لأجل الإحرام ، يستحب له اعادة الغسل.
ولا بأس أن يلبس المحرم ، أكثر من ثوبي إحرامه ، ثلاثة ، أو أربعة ، أو أكثر من ذلك ، إذا اتقى بها الحر ، أو البرد ، ولا بأس أيضا أن يغيّر ثيابه ، وهو محرم.
فإذا دخل إلى مكة ، وأراد الطواف ، فالأفضل له أن لا يطوف إلا في ثوبيه ، اللذين أحرم فيهما.
وأفضل الثياب للإحرام القطن ، والكتاب البياض ، وانّما يكره التكفين في الكتان ، ولا يكره الإحرام في الكتان.
وجميع ما تصح الصلاة فيه من الثياب للرجال ، يصح لهم الإحرام فيه.
فأمّا النساء ، فالأفضل لهن الثياب البياض من القطن والكتان ، ويجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض ، لأنّ الصلاة فيها جائزة لهن ، وإلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله ، في كتابه أحكام النساء ، وهو الصحيح ، لأنّ حظر الإحرام لهن في الإبريسم ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وصحة التصرّف في الملك ، وحمل ذلك على الرجال قياس ، ونحن لا نقول به.
وأفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها ، بعد الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر ، فعلى هذا يكون ركعتا الإحرام المندوبة ، قبل فريضة الظهر ، بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر ، وإن اتفق أن يكون الإحرام في غير هذا الوقت ، كان أيضا جائزا ، والأفضل أن يكون الإحرام ، بعد صلاة فريضة ، وأفضل ذلك ، بعد صلاة الظهر ، فإن لم تكن صلاة فريضة ، صلّى ست ركعات ، ونوى بها صلاة الإحرام ، مندوبا قربة إلى الله تعالى ، وأحرم في دبرها ، فإن لم يتمكن من ذلك ، أجزأه ركعتان ، وليقرأ في الأوّلة منهما بعد التوجه ، الحمد ، وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإذا فرغ منهما ، أحرم عقيبهما ، بالتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، فيقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به ، من التمتع بالعمرة إلى الحجّ ، على كتابك وسنّة نبيّك ، صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض ، يحبسني ، فحلّني حيث حبستني ، لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم يكن حجة ، فعمرة أحرم لك شعري ، وجسدي ، وبشري من النساء ، والطيب ، والثياب ، أبتغي بذلك وجهك ، والدار الآخرة ، وكل هذا القول مستحب ، غير واجب.
وإن كان قارنا ، فليقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من الحجّ ، قارنا ، وإن كان مفردا فليذكر ذلك ، نطقا في إحرامه ، فإنّه مستحب.
فأمّا نيات الأفعال ، وما يريد أن يحرم به ، فإنّه يجب ذلك ، ونيات القلوب ، فإنّه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية ، والتلبية للمتمتع والمفرد ، وأمّا القارن ، فينعقد إحرامه بالنيّة ، وانضمام التلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ، مخير بين ذلك ، وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ينعقد الإحرام ، في جميع أنواع الحج ، إلا بالتلبية فحسب ، وهو السيد المرتضى رحمة الله ، وبه أقول ، لأنّه مجمع عليه ، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل ، كان عليه إعادة الإحرام ، بصلاة وغسل (5) فأقول : إن أراد أنّه نوى الإحرام ، وأحرم ، ولبّى ، من دون صلاة وغسل ، فقد انعقد إحرامه ، فأيّ اعادة تكون عليه ، وكيف يتقدر ذلك ، وإن أراد أنّه أحرم بالكيفية الظاهرة ، من دون النية والتلبية ، على ما قدّمنا القول في مثله ، ومعناه ، فيصح ذلك ، ويكون لقوله وجه.
ولا بأس أن يصلّي الإنسان صلاة الإحرام ، أي وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يكن قد تضيق وقت فريضة حاضرة ، فإن تضيق الوقت بدأ بالفريضة ، ثمّ بصلاة الإحرام ، وإن لم يكن تضيق بدأ بصلاة الإحرام.
ويستحب للإنسان ، أن يشترط في الإحرام ، إن لم يكن حجة فعمرة ، وان يحله حيث حبسه ، سواء كانت حجته تمتعا ، أو قرانا ، أو إفرادا ، وكذلك الحكم في العمرة ، وإن لم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل ، فإن من حج حجة الإسلام ، وأحصر ، لزمه الحج من قابل ، وإن كانت تطوعا ، لم يكن عليه ذلك ، وانّما يكون للشرط تأثير ، وفائدة ، أن يتحلل المشترط ، عند العوائق ، من مرض ، وعدو ، وحصر ، وصدّ ، وغير ذلك ، بغير هدي.
وقال بعض أصحابنا : لا تأثير لهذا الشرط ، في سقوط الدم عند الحصر والصد ، ووجوده كعدمه ، والصحيح الأول ، وهو مذهب السيد المرتضى ، وقد استدل على صحّة ذلك ، بالإجماع ، وبقول الرسول عليه السلام ، لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : حجي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني (6). ولا فائدة لهذا الشرط ، إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم ، فان احتجوا بعموم قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قلنا : نحمل ذلك على من لم يشترط ، هذا آخر استدلال السيد المرتضى.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : مسألة ، يجوز للمحرم ، أن يشترط في حال إحرامه ، أنّه إن عرض له عارض يحبسه أن يحلّه حيث حبسه من مرض ، أو عدو ، أو انقطاع نفقة ، أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحا ، يجوز له أن يتحلّل إذا عرض له شيء من ذلك ، وروي ذلك عن عمرو ابن مسعود ، وبه قال الشافعي ، وقال بعض أصحابه : إنّه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم ، والمسألة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وقال الزهري ، ومالك ، وابن عمر ، الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلّق به التحلل ، وقال أبو حنيفة : المريض له التحلل من غير شرط ، فإن شرط ، سقط عنه الهدي ، دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنّه شرط ، لا يمنع منه الكتاب ، ولا السنة ، فيجب أن يكون جائزا ، لأنّ المنع يحتاج إلى دليل ، وحديث ضباعة بنت الزبير ، يدل على ذلك ، وروت عائشة أنّ النبي عليه السلام ، دخل على ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رسول الله ، إنّي أريد الحج ، وأنا شاكية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أحرمي ، واشترطي ، وقولي أن تحلّني حيث حبستني (7) وهذا نص.
ثمّ قال رحمه الله بعد هذه المسألة بلا فصل : مسألة : إذا شرط على ربّه في حال الإحرام ، ثم حصل الشرط ، وأراد التحلّل فلا بدّ من نية التحلّل ، ولا بدّ من الهدي ، وللشافعي فيه قولان ، في النية والهدي معا ، دليلنا : عموم الآية ، في وجوب الهدي ، على المحصر ، وطريقة الاحتياط (8) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
قال محمّد بن إدريس : في المسألة الأوّلة ، يناظر شيخنا رحمه الله ، ويخاصم ، من قال أن الشرط لا تأثير له ، ووجوده كعدمه ، وأنّه لا يفيد شيئا ، ثم يستدل على صحّته وتأثيره ، ولا شرط لا يمنع منه الكتاب ، ولا السنّة ، فيجب أن يكون جائزا ، ويستدل بحديث ضباعة بنت الزبير ، وفي المسألة الثانية ، يذهب إلى أنّ وجوده كعدمه ، ولا بدّ من الهدي ، وان اشترط ، ويستدل بعموم الآية ، في وجوب الهدي على المحصر ، وهذا عجيب ، طريف ، فيه ما فيه.
وينبغي إذا أراد الإشعار ، أن يشعرها وهي باركة ، وإذا أراد نحرها ، نحرها وهي قائمة.
والتقليد ، يكون بنعل قد صلى فيه ، لا يجوز غيره.
وإذا كان حاجا على غير طريق المدينة ، جهر من موضعه بتكرار التلبية المستحبة ، إن أراد ، وإن مشى خطوات ثمّ لبى ، كان أفضل.
والتلبية التي ينعقد بها الإحرام فريضة ، لا يجوز تركها على حال ، والتلفظ بها دفعة واحدة ، هو الواجب ، والجهر بها على الرجال مندوب ، على الأظهر من أقوال أصحابنا ، وقال بعضهم: الجهر بها واجب ، فأمّا تكرارها مندوب مرغب فيه ، والإتيان بقول لبيك ذا المعارج إلى آخر الفصل مندوب ، أيضا شديد الاستحباب.
وكيفية التلبية الأربع الواجبة التي تتنزل في انعقاد الإحرام بها منزلة تكبيرة الإحرام في انعقاد الصلاة ، هو أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك انّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك فهذه التلبيات الأربع فريضة ، لا بدّ منها.
فإذا لبّى بالتمتع ، ودخل إلى مكة ، وطاف ، وسعى ، ثم لبّى ، بالحج ، قبل أن يقصّر ، فقد بطلت متعته ، على قول بعض أصحابنا ، وكانت حجته مبتولة ، هذا إذا فعل ذلك متعمدا ، فإن فعله ناسيا ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمت متعته ، وليس عليه شيء.
ومن لبى بالحجّ مفردا ، ودخل مكة ، وطاف ، وسعى ، جاز له أن يقصّر ويجعلها عمرة ، ما لم يلب بعد الطواف ، فإن لبّى بعده ، فليس له متعة ، وليمض في حجّته ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (9). ولا أرى لذكر التلبية هاهنا وجها ، وانّما الحكم للنية ، دون التلبية ، لقوله عليه السلام : الأعمال بالنيات (10).
وينبغي أن يلبّي الإنسان ، ويكرر التلبيات الأربع ، وغيرها من الألفاظ ، مندوبا ، في كل وقت ، وعند كل صلاة ، وإذا هبط واديا ، أو صعد شرفا ، وفي الأسحار.
والأخرس ، يجزيه في تلبيته ، تحريك لسانه ، وإشارته ، بالإصبع.
ويقطع المتمتع ، التلبية ، المكررة المندوبة ، إذا شاهد بيوت مكة ، فإذا شاهدها ، يستحب له قطعها ، فإن كان قارنا أو مفردا ، قطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال ، وإذا كان معتمرا قطعها إذا دخل الحرم ، فإن كان المعتمر ممن قد خرج من مكة ، ليعتمر ، فلا يقطعها ، إلا إذا شاهد الكعبة.
ويجنبون ، كلّما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم ، ما يجب على المحرم فعله ، وإذا حجّ بهم متمتعين ، وجب أن يذبح عنهم ، ويكون الهدي من مال من حجّ بالصبي ، دون مال الصبي ، وينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا ، ويحضر المشاهد كلّها ، ويرمى عنه ، ويناب عنه ، في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه ، وإذا لم يوجد لهم هدي ، كان على الولي الذي أدخلهم في الحج ، أن يصوم عنه.
وأفعال الحج على ضربين: مفروض ، ومسنون ، في الأنواع الثلاثة. والمفروض على ضربين: ركن ، وغير ركن.
فأركان المتمتع عشرة له النيّة ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة ، والسعي بين الصّفا والمروة لها ، والإحرام بالحج ، من جوف مكة ، لأنّها ميقاته ، والنية له ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي للحج.
وما ليس بركن ، فثمانية أشياء : التلبيات الأربع على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين ، هي ركن ، وهو الأظهر والأصح ، لأن حقيقة الركن ، ما إذا أخل به الإنسان في الحج عامدا ، بطل حجّه ، والتلبية هذا حكمها ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر ، في النهاية في باب فرائض الحج (11) ويذهب في الجمل والعقود ، إلى أنّ التلبية واجبة ، غير ركن (12) ، أو ما قام مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحج ، أو ما يقوم مقامها ، على رأي من لا يرى أنّها ركن ، والهدي ، أو ما يقوم مقامه ، من الصوم مع العجز ، ولا يجوز إذا عدمنا القدرة على الهدي ، الانتقال إلا إلى الصوم ، دون الثمن ، لأنّ الله تعالى (13) ما نقلنا إلى ثالث ، بل نقلنا إذا عدمنا الهدي ، إلى بدله ، وهو الصوم ، وبعض أصحابنا قال : لا يجوز الانتقال إلى الصوم ، إلا بعد عدم ثمنه ، والأوّل أظهر ، ودليله ما قدّمناه ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له.
وأركان القارن والمفرد ستة: النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي.
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية ، أو ما يقوم مقامها للقارن ، من تقليد ، أو إشعار ، على أحد المذهبين ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له.
ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي.
ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.
وأشهر الحج ، قال بعض أصحابنا: ثلاثة أشهر وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقال بعض أصحابنا: شهران ، وتسعة أيام ، وقال بعض منهم: شهران وعشرة أيام ، فالأول مذهب شيخنا المفيد ، في كتابه الأركان ، ويناظر مخالفه على ذلك ، وهو أيضا مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته (14) وقال في جمله وعقوده : شهران وتسعة أيام (15) وقال في مسائل خلافه (16) ومبسوطة (17) وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وإلى يوم النحر ، قبل طلوع الفجر منه ، فإذا طلع ، فقد مضى أشهر الحج ، ومعنى ذلك ، أنّه لا يجوز أن يقع إحرام الحج إلا فيه ، ولا إحرام العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، إلا فيها ، وأمّا إحرام العمرة المبتولة ، فجميع أيام السنة وقت له.
والذي يقوى في نفسي ، مذهب شيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر ، في نهايته ، والدليل على ما اخترناه ، ظاهر لسان العرب ، وحقيقة الكلام ، وذلك أنّ الله تعالى قال في محكم كتابه : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (18) فجمع سبحانه ، ولم يفرد بالذكر ، ولم يثن ، ووجدنا أهل اللسان ، لا يستعملون هذا القول ، فيما دون أقل من ثلاثة أشهر ، فيقولون : فلان غاب شهرا ، إذا أكمل الشهر لغيبته ، وفلان غاب شهرين ، إذا كان فيهما جميعا غائبا ، وفلان غاب ثلاثة أشهر ، إذا دامت غيبته في الثلاثة ، فثبت أنّ أقل ما يطلق عليه لفظ الأشهر ، في حقيقة اللغة ثلاثة منها ، فوجب أن يجري كلام الله تعالى ، وكتابه على الحقيقة ، دون المجاز ، لأنّ الكلام في الحقائق ، دون المجازات ، والاستعارات.
ويزيد ذلك بيانا ما روي عن الأئمة من آل محمّد عليهم السلام أنّ أشهر الحج ثلاثة: شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة (19) ويصحّح هذه الرواية ، عن الأئمة عليهم السلام ، ما أجمعت عليه الطائفة عنهم عليهم السلام في جواز ذبح الهدي طول ذي الحجة ، وطواف الحج ، وسعي الحج ، طول ذي الحجّة ، وكذلك طواف النساء عندنا ، وقالوا عليهم السلام ، فإن لم يجد الهدي حتى يخرج ذو الحجة ، أخّره إلى قابل ، فإنّ أيام الحج قد مضت ، فجعلوا عليهم السلام آخر منتهى الحج ، آخر ذي الحجّة.
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون آخر أشهر الحج ، اليوم العاشر من ذي الحجة ، بدلالة إجماع الأمّة ، على أنّه ليس لأحد أن يهل بالحج ، ولا يقف بعرفة ، بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، وذلك أنّه لو كان باقي ذي الحجة من أشهر الحج ، لجاز فيه ما ذكرناه.
قيل له قد تقدّم القول في بطلان هذا المذهب ، بما ذكرناه من كلام العرب ، وحقيقة اللسان ، وقد قال الله تعالى ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) (20) وقال تعالى ( قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ) (21) فلو كان الأمر على ما يذهب إليه مخالفنا في المسألة ، لكان القرآن واردا على غير مفهوم اللغة ، وذلك ضدّ الخبر الذي تلوناه من الكتاب ، على أنّ هذا الذي عارض به الخصم ، بيّن الاضمحلال ، وذلك أنّ أشهر الحج ، انّما هي على ترتيب عمله ، فبعضها وقت للإهلال ، وبعضها وقت للطواف والسعي ، وبعضها وقت للوقوف ، وقد اتفقنا جميعا بغير خلاف ، أنّ طواف الزيارة من الحج ، وهو بعد الفجر من يوم النحر ، وكذلك السعي ، وطواف النساء عندنا ، على ما مضى بيانه ، والمبيت ليالي التشريق بمنى ، ورمي الجمار بعد يوم النحر ، فثبت بذلك ، أنّ القول في ذلك على ما اخترناه.
واختلف أصحابنا ، في أقل ما يكون بين العمرتين ، فقال بعضهم : شهر ، وقال بعضهم : يكون في كل شهر تقع عمرة ، وقال بعضهم : عشرة أيام ، وقال بعضهم : لا أوقت وقتا ، ولا أجعل بينهما مدّة ، وتصح في كل يوم عمرة ، وهذا القول يقوى في نفسي ، وبه افتي ، وإليه ذهب السيّد المرتضى ، في الناصريات وقال : الذي يذهب إليه أصحابنا ، أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة. وقال : وقد روي أنّه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام (22) وروي أنّها لا تجوز إلا في كل شهر مرة (23). ثم قال : دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه ، قوله صلى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (24) ولم يفصّل عليه السلام (25).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين ، فأخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج ، ولا إدخال الحج على العمرة ، ومعنى ذلك أنّه إذا أحرم بالحج ، لا يجوز أن يحرم بالعمرة ، قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، وكذلك إذا أحرم بالعمرة ، لا يجوز أن يحرم بالحج ، حتى يفرغ من مناسكها ، فان فاته وقت التحلّل ، مضى على إحرامه ، وجعلها حجّة منفردة ، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
والمتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة ، وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان ، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شيء وتمّ حجه ولا دم عليه ، لأجل ذلك.
والقارن والمفرد ، إذا أراد أن يأتيا بالعمرة بعد الحج ، وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ، ويحرما منه ، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزهما.
والمستحب لهما ، أن يأتيا بالإحرام ، من الجعرانة ( بفتح الجيم ، وكسر العين ، وفتح الراء ، وتشديدها ، هكذا سماعنا من بعض مشايخنا ، والصحيح ما قاله نفطويه ، في تاريخه ، قال : كان الشافعي يقول : الحديبية بالتخفيف ، ويقول أيضا : الجعرانة بكسر الجيم ، وسكون العين ، وهو أعلم بهذين الموضعين. قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وجدتها كذلك ، بخط أثق به ، قال ابن دريد في الجمهرة : الجعرانة بكسر الجيم ، والعين ، وفتح الراء ، وتشديدها ، وهذا الذي يعتمد عليه ) أو التنعيم.
______________
(1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 20 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل: كتاب الطهارة باب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6.
(3) الاستبصار: حديث 13 من ذلك الباب.
(4) الوسائل: كتاب الحج، الباب 10 من أبواب الإحرام.
(5) النهاية: كتاب الحج، باب كيفية الإحرام.
(6) مستدرك الوسائل: كتاب الحج، الباب 16 من أبواب الإحرام، (وفي المصدر: أحرمي بدل حجي ـ من دون قولي اللهم).
(7) الخلاف: كتاب الحج، مسائل جزاء الصيد، مسألة 323.
(8) النهاية: كتاب الحج، باب كيفية الإحرام.
(9) النهاية: كتاب الحج، باب كيفية الإحرام.
(10) الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6.
(11) النهاية: كتاب الحج، باب فرائض الحج.
(12) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر أفعال الحج.
(13) في سورة البقرة الآية 196 قال (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ).
(14) النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج.
(15) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في كيفية الإحرام وشرائطه.
(16) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 23.
(17) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها.
(18) البقرة: 197.
(19) الوسائل: كتاب الحج، الباب 11 من أبواب أقسام الحج.
(20) إبراهيم: 4.
(21) الزمر: 29.
(22) الوسائل: كتاب الحج، الباب 6 من أبواب العمرة.
(23) الوسائل: كتاب الحج، الباب 6 من أبواب العمرة.
(24) كنز العمال: ج 5، كتاب الحج والعمرة، ص 114.
(25) الناصريات: كتاب الحج، مسألة 139.



|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|