


 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-02-2015
التاريخ: 2024-04-13
التاريخ: 2023-08-17
التاريخ: 24-02-2015
|
عطف البدل
البدل على أربعة أقسام: إما أن يكون الثاني هو الأول أو بعضه، أو يكون المعنى مشتملًا عليه أو غلطًا، وحق البدل وتقديره أن يعمل العامل في الثاني كأنه خالٍ من الأول، وكان الأصل أن يكونا خبرين، أو تدخل عليه واو العطف، ولكنهم اجتنبوا ذلك للبس.
الأول: ما ابتدلته من الأول وهو هُو: وذلك نحو قولك: مررتُ بعبد الله زيدٍ، ومررت برجلٍ عبد الله، وكان أصل الكلام: مررت بعبد الله ومررت بزيدٍ أو تقول: مررتُ بعبد اللهِ وزيدٍ, ولو قلت ذلك لظن أن الثاني غير الأول؛ فلذلك استعمل البدل فرارًا من اللبس وطلبًا للاختصار والإِيجاز، ويجوز إبدال المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة والمضمر من المظهر والمظهر من المضمر، البدل في جميع ذلك سواء. فأما إبدال المعرفة من النكرة فنحو قول الله: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ(1) فهذا إبدال معرفة من نكرة، فتقول على هذا: مررت برجلٍ عبد اللهِ، وأما إبدال النكرة من المعرفة فنحو قولك: مررت بزيدٍ رجلٍ صالحٍ كما قال الله عز وجل: بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ)2)، فهذا إبدال نكرة من معرفة، وأما إبدال الظاهر من المضمر فنحو قولك: مررتُ بهِ زيدٍ وبهما أخويك, ورأيت الذي قامَ زيدٌ، تبدل زيدًا من الضمير الذي في "قام" ولا يجوز أن تقول: رأيتُ زيدًا أباهُ والأب غير زيدٍ؛ لأنك لا تبينه لغيره.
الثاني: ما أبدل من الأول وهو بعضه: وذلك نحو قولك: ضربتُ زيدًا رأسَهُ(3)، وأتيتُ قومَكَ بعضَهم، ورأيتُ قومَكَ أكثَرهم، ولقيت قومكَ ثلاثَتهم, ورأيت بني عمِّكَ ناسًا منهم, وضربت وجوهها أولها قال سيبويه: فهذا يجيء على وجهيِن(4): على أنه أراد أكثَر قومِكَ، وثلثي قومكَ، وضربتُ وجوهَ أولِها، ولكنه ثنى الاسم تأكيدًا، والوجه الآخر: أن يتكلم فيقول: رأيتُ قومَكَ ثم يبدو أن يبين ما الذي رأى منهم, فيقول: ثلاثتَهم، أو ناسًا منهم، ومن هذا قوله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(5) والمستطيعونَ بعضُ الناسِ.
الثالث: ما كان من سبب الأول: وهو مشتمل عليه نحو: سُلبَ زيدٌ ثوبَهُ وسرق زيد مالُه؛ لأن المعنى: سُلبَ ثوب زيد, وسرق مالُ زيدٍ, ومن ذلك قول الله عز وجل: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (6) لأن المسألة في المعنى عن القتال في الشهر الحرام، ومثله: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ} (7)، وقال الأعشى:
لَقدْ كَانَ في حَوْل ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ ... تفضى لَبَانَاتُ ويسأْمُ سائِمُ(8)
وقال آخر:
وذَكَرَتْ تَقْتُدَ بَرْدَ مَائِهَا ... وعَتَكُ البولِ على أنسائِها(9)
الرابع: وهو بدل الغلط والنسيان: وهو البدل الذي لا يقع في قرآن ولا شعرٍ، وذلك نحو قولهم: مررتُ برجلٍ حمارٍ، كأنه أراد أن يقول: مررتَ بحمار فغلط فقال: برجلٍ أو بشيءٍ.
واعلم: أن الفعل قد يبدل من الفعل وليس شيء من الفعل يتبع الثاني الأول في الإِعراب إلا البدل والعطف, والبدل نحو قول الشاعر:
إنَّ على اللهِ أنْ تُبايعا ... تُؤخذَ كُرهًا أو تجيء طائعا(10)
وإنما يبدل الفعل من الفعلِ إذا كان ضربًا منه نحو هذا البيت, ونحو قولك: إن تأتني تمشي أمشي معكَ؛ لأن المشيَ ضرب من الإِتيان, ولا يجوز أن تقول: إن تأتي تأكل آكلْ معكَ؛ لأن الأكل ليس من الإِتيان في شيء.
تقول: بعتُ متاعَك أسفلَهُ قبلَ أعلاهُ، واشتريتُ متاعَك بعضَهُ أعَجلَ من بعضٍ، وسقيت إبلَك صغارها أحسن من سقي كبارها، ودفعت الناس بعضَهم ببعضٍ، وضربت الناسَ بعضَهم قائمًا وبعضَهم قاعدًا، وتقول: مررت بمتاعِكَ بعضِه مرفوعًا، وبعضِه مطروحًا، كأنك قلت: مررت ببعضِ متاعِكَ مرفوعًا وببعض مطروحًا؛ لأنك مررتَ به في هذه الحال، وإذا كان صفة للفعل لم يجز الرفع, وتقول: بعتُ طعامَكَ بعضه مكيلًا وبعضَهُ موزونًا إذا أردت أن الكيل والوزن وقعا في حال البيع، فإن رفعت فإلى هذا المعنى، ولم يكن متعلقًا بالبيع فقلت: بعتُ طعامَك بعضهُ مكيلٌ وبعضهُ موزونٌ، أي: بعته وهو موجود كذا, فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة للبيع, وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعتُكَ هذا الطعامَ مكيلًا وهذا الثوب مقصورًا, فعليه أن يسلمه إليه مكيلًا ومقصورًا, وإذا قال: بعتُكَ وهو مكيل فإنما باعه شيئًا موصوفًا بالكيل ولم يتضمنه البيع، تقول: خَوفتُ الناسَ ضعيفَهم وقويهم، كأنك قلت: خوفت ضعيفَ الناسِ وقويهم, وكان تقدير الكلام قبل أن ينقل فعل إلى "فَعَلتُ" خافهُ الناس ضعيفُهم وقويهم, فلما قلت: خَوَّفتُ صار الفاعلُ مفعولًا وقد بينت هذا فيما
تقدم. ومثل ذلك ألزمت الناس بعضهم بعضًا، كان الأصل: لزمَ الناسُ بعضهم بعضًا، فلما قلت: ألزمتُ صار الفاعل مفعولًا، وصار الفعل يتعدى إلى مفعولين، وتقول: دفعتُ الناس بعضهم ببعضٍ على قولكَ: دفع الناسُ بعضُهم بعضًا فإذا قلت: دفعَ صار ما كان يتعدى لا يتعدى إلا بحرف جر فتقول: دفعَ الناسُ بعضهم ببعضٍ وتقول: فضلتُ متاعَكَ أسفلَهُ على أعلاه كأنه في التمثيل: فَضل متاعُكَ أسفلهُ على أعلاه، فلما قلت: فضَّلتُ صار الفاعل مفعولًا، ومثله: صككتُ الحجرينِ أحدهما بالآخرِ, كان التقدير: اصطك الحجرانِ أحدهما بالآخرِ، فلما قلت: صككتُ، صار الفاعل مفعولًا، ومثل ذلِكَ: "ولولا دفاعُ* اللهِ الناسَ بعضَهُم ببعضٍ"(11) والمعنى: لولا أن دفعَ الناسُ بعضهُم ببعضٍ، ولو قلت: دفعَ الناسُ بعضهم بعضًا لم يحتج إلى الباء؛ لأنه فعل يتعدى إلى مفعول، قلت: دفَع اللهُ الناسَ واستتر في الفعلِ عمله في الفاعل، لم يجز أن يتعدى إلى مفعول ثانٍ إلا بحرفِ جرٍّ، فعلى هذا جاءت الآيةُ؛ ولذلك دخلت الباء وتقول: عجبتُ من دفعِ الناسِ بعضهم بعضًا، إذا جعلت الناس فاعلين كأنك قلت: عجبت من أن دفع الناسُ بعضَهم بعضًا فإن جعلت الناس مفعولين قلت: عجبت من دفعِ الناسِ بعضِهم ببعضٍ؛ لأن المعنى: عجبتُ من أنْ دفَع الناسُ بعضهم ببعضٍ وتقول: سمعتُ وقع أَنيابهِ بعضِها فوقَ بعضٍ, جرى على قولك: وقعت أنيابهُ بعضُها فوقَ بعضٍ, فأنيابُه هنا فاعلةٌ وتقول: عجبتُ من إيقاعِ أنيابهِ بعضِها فوقَ بعضٍ جرًّا, فأنيابه هنا مفعولةٌ قامت مقام الفاعل, ولو قلت: أوقعت أنيابُه بعضُها فوقَ بعضٍ لقلت: عجبتُ من إيقاعي أنيابَهُ بعضَها فوقَ بعضٍ فنصبت أنيابَه, وتقول: رأيتُ متاعك بعضَهُ فوقَ بعضٍ إذا جعلت "فوقَ" في موضع الاسم المبني، على المبتدأ, وجعلت المبتدأ بعضهُ كأنك قلت: رأيتُ متاعَكَ بعضهُ أجود من بعضٍ، فإن جعلت "فوقَ" وأجودها حالًا نصبتَ "بعضَهُ" وإن شئت قلت: رأيت متاعَك بعضه أحسنَ من بعض فتنصبُ "أَحسنَ" على أنه مفعول ثانٍ وبعضه منصوب بأنه بدلٌ من متاعِكَ.
قال سيبويه: والرفع في هذا أعرف، والنصب عربي جيدٌ(12)، فما جاء في الرفع: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ} (13). ومما جاء في النصب: "خلقَ اللهُ الزرافةَ يديها أطول من رجلِيها" قال: حدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت لعبدة بن الطبيب:
فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُه هُلْك وَاحِدٍ ... ولكنهُ بُنيانُ قَوْمٍ تَهَدَّما(14)
وقال رجل من خثعم أو بجيلة:
ذَرِيني إنَّ أَمركِ لَنْ يُطاعَا ... وما ألفيتِني حِلْمي مُضَاعا(15)
وتقول: جعلتُ متاعَكَ بعضَهُ فوقَ بعضٍ، كما قلت: رأيتُ متاعَك بعضَهُ فوقَ بعضٍ، وأنتَ تريد رؤية العين، وتنصب "فوقَ" بأنه وقع موقع الحال, فالتأويل: جعلت ورأيتُ متاعك بعضهُ مستقرًّا فوقَ بعضٍ أو راكبًا فوق بعضٍ أو مطروحًا فوق بعضٍ أو ما أشبه هذا المعنى "ففوقَ" ظرف نصبه الحال وقام مقام الحال كما يقوم مقام الخبر في قولك: زيدٌ فوقَ الحائِط إذا قلت: رأيتُ زيدًا في الدار, فقولك "في الدارِ" يجوز أن يكون ظرفًا لرأيت ويجوز أن يكون ظرفًا لزيدٍ, كما تقول: رميتُ من الأرضِ زيدًا على الحائِط فقولك: على الحائِط، ظرف يعمل فيه استقرار زيدٍ, كأنكَ قلت: رميتُ من الأرضِ زيدًا مستقرًّا على الحائِط, ونحو هذا ما جاء في الخبر: كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام: الغوثَ الغوثَ وأبو عبيدة وعمر -رحمه اللهُ- كتب إليه من الحجاز، فالكتاب لم يكن بالشام ولك أن تعدي "جعلتَ" إلى مفعولين فتقول: جعلتُ متاعَكَ بعضَهُ فوقَ بعضٍ, فتجعل "فوقَ بعضٍ" مفعولًا ثانيًا كما يكون في "ظننتُ" متاعَكَ بعضَه فوقَ بعضٍ "فجعلتُ" هذه إذا كانت بمعنى "علمتُ" تعدت إلى واحد مثل "رأيتُ" إذا كانت من رؤية العين، وإذا كانت جعلتُ ليست بمعنى علمتُ وإنما تكلم بها عن توهم أو رأيٍ أو قولٍ كقول القائل: جَعلتُ حسني قبيحًا وجعلتُ البصرةَ بغدادَ وجعلت الحلالَ حرامًا, فإذا لم ترد فجعلت العلاج والعمل في التعدي بمنزلة "رأيتُ" إذا أردت بها رؤية القلب ولم ترد رؤية العين ولك أن تعدي "جعلتُ" إلى مفعولين على ضرب آخر على أن تجعل المفعول الأول فاعلًا في الثاني, كما تقول: أَضربتُ زيدًا عمرًا تريد: أنك جعلتَ زيدًا يضربُ عمرًا فيكون حينئذٍ قولك: فوقَ بعضٍ مفعول مفعولٍ, وموضعه نصب تعدى إليه الفعل بحرف جرٍّ؛ لأنك إذا قلت: مررت بزيدٍ فموضع هذا نصب وهذا نحو: صُكَّ الحجرانِ أحدهما بالآخرِ, فإذا جعلت أنت أحدهما يفعل بالآخر قلت: صككتُ الحجرين أحدهما بالآخر ولم يكن بُدٌّ من الباء لأن الفعل متعدٍّ إلى مفعولٍ واحدٍ, فلما جعلت المفعول في المعنى فاعلًا احتجت إلى مفعول، فلم يتصل الكلام إلا بحرف جرٍّ، وقد بينت ذا فيما تقدم وأوضحته، فهذه ثلاثة أوجهٍ في نصب "جَعَلْتُ"
تاعَكَ بعضَهُ على بعضٍ، وهي النصب على الحال، والنصب على أنه مفعولٌ ثانٍ، والنصب على أنه مفعولُ مفعولٍ، فافهمهُ فإنه مشكل في كتبهم ويجوز الرفعُ فتقول: جعلت متاعَك بعضه على بعضٍ, وتقول: أبكيتَ قومكَ بعضهم على بعضٍ, فهذا كان أصله: بكى قومُكَ بعضُهم على بعضٍ, فلما نقلته إلى "أبكيتُ" جعلت الفاعل مفعولًا، وهو في المعنى فاعلٌ، إلا أنك أنت جعلتهُ فاعلًا وقولك: على بعضٍ لا يجوز أن يقع موقع الحال لأنك لا تريد أنّ بعضَهم مستقرٌّ على بعضٍ ولا مطروحٌ على بعضٍ, كما كان ذلكَ في المتاعِ, قال سيبويه: لم ترد أن تقول: بعضُهم على بعضٍ في عونٍ ولا أن أجسادَهم بعضًا على بعضٍ(16)، وقولك: بعضُهم، في جميع هذه المسائل منصوب على البدل, فإن قلت: حزنتُ قومك بعضُهم أفضلُ من بعضٍ، كان الرفع حُسنًا لأن الآخر هو الأول وإن شئت نصبت على الحال يعني "أفضلَ" فقلت: حَزنت قومَكَ بعضَهم أفضلَ من بعضٍ, كأنك قلت: حَزنت بعضَ قومِكَ فاضلين بعضهم.
قال سيبويه: إلا أن الأعرف والأكثر إذا كان الآخر هو الأول أن يبتدأ، والنصب عربي جيد(17) وتقول: ضُربَ عبد اللهِ ظهرُه وبطنُهُ، ومُطرنا سهلنا وجبلنا، ومطرنَا السهل والجبل، وجميع هذا لك فيه البدل, ولك أن يكون تأكيدًا كأجمعينَ لأنك إذا قلت: ضُرب زيدٌ الظهرُ والبطنُ, فالظهر والبطن هما(18)جماعة زيدٍ وإذا قلت: "مطرنا" فإنما تعني: مطرت بلادُنا, والبلاد يجمعها السهل والجبل.
قال سيبويه: وإن شئت نصبت فقلت: ضُربَ زيدٌ الظهرَ والبطنَ، ومطرنا السهل والجبل، وضُرب زيد ظهرهُ وبطنهُ(19)، والمعنى: حرف الجر، وهو "في" ولكنهم حذفوه قال: وأجازوا هذا كما أجازوا: دخلتُ البيتَ، وإنما معناه: دخلت في البيتِ والعامل فيه الفعل، وليس انتصابه هنا انتصاب الظروف، قال: ولم يجيزوا حذف حرف الجر في غير السهلِ والجبلِ، والظهر والبطنِ، نظير هذا في حذف حرف الجر: نُبئت زيدًا، تريد: عن زيدٍ، وزعم الخليل أنهم يقولون: مطرنا الزرع والضرع، وإن شئت رفعت على البدل على أن تصيره بمنزلة أجمعينَ(20)، توكيدًا.
قال سيبويه(21): إن قلت: ضُربَ زيد اليدُ والرجلُ، جاز أن يكون بدلًا، وأن يكون توكيدًا, وإن نصبته لم يحسن، والبدل كما قال جائزٌ حَسنٌ، والتوكيد عندي يَقْبُحُ إذا لم يكن الاسم المؤكدُ هو المؤكدُ, واليد والرجل ليستا جماعة زيدٍ وهو في السهلِ والجبلِ عندي يحسنُ لأن السهلَ والجبلَ هما جماعة البلادِ، وكذلك البطنُ والظهرُ، إنما يراد بهما(22) جماعة الشخص، فإن أراد باليد والرجل أنه قد: ضُربت جماعة، واجتزأ بذكر الطرفين في ذلك جاز.
قال: وقد سمعناهم يقولون: ضربتهم(23) ظهرًا وبطنًا، وتقول: ضربت قومَك صغيرهم وكبيرهم على البدل، والتأكيد جميعًا فإن قلت: أو كبيرهم لم يجز إلا البدل وتقول: زيد ضربتهُ أخاكَ فتبدل "أخاك" من الهاء؛ لأن الكلام الأول قد تم وقد خبرتك: أن البدل إنما هو اختصار خبرين فإن قلت: زيدٌ ضربتُ أخاكَ إيّاهُ لم يجز لأن الكلام الأول ما تم فإن قلت: مررتُ برجلٍ قائمٍ رجل أبوهُ، فجعلت أباه بدلًا من رجل، لم يجز لأنه لا يصلح أن تقول: مررت برجلٍ قائمٍ أبوهُ وتسكت ولا يتم بذلك الكلام, فإن قلت: مررتُ برجلٍ قائمٍ زيدٍ أبوهُ فقد أجازه الأخفش على الصفة، وقال: لأن قولك: أبوه من صفة زيدٍ، فصار كأنه بعض اسمه، ولو كان بدلًا من زيدٍ لم يكن كلامًا، ونظير هذا: مررتُ برجلٍ قائمٍ رجلٌ يحبهُ, وبرجلٍ قائمٍ زيدٌ الضاربه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الشورى: 52-53, والآية: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ} .
وانظر الكتاب 1/ 224.
2- العلق: 15، 16، والآية: {كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ....} وانظر الكتاب 1/ 260، و1/ 198.
3- أردت أن تبين موضع الضرب، فصار كقولك: ضربت رأس زيد.
4- انظر الكتاب 1/ 75.
5- آل عمران: 97، وانظر الكتاب 1/ 75-76.
6- البقرة: 217، وانظر الكتاب 1/ 75.
7- البروج: 4، وانظر المقتضب 4/ 297.
8- من شواهد سيبويه 1/ 423 على رفع الفعل "يسأم" واستشهد به المبرد على بدل الاشتمال كذلك فعل المصنف. ثويته: الأصل: ثويت فيه، فحذف حرف الجر واتصل الضمير بالفعل، والثواء: الإقامة، اللبانات: الحاجات. وانظر المقتضب 4/ 297، و1/ 27, وأمالي ابن الشجري 1/ 363, وابن يعيش 3/ 65, والديوان/ 177.
9-من شواهد سيبويه 1/ 75، على نصب برد مائها على البدل من "تقتد" لاشتمال الذكر عليها. وصف ناقة بعد عهدها بورود الماء لإدمانها السير في الفلاة، فيقول: ذكرت برد ماء تقتد وهو موضع بعينه وأثر بولها على أنسائها ظاهر بين لخثارته. وإذا قل ورودها للماء خثر بولها وغلظ واشتدت صفرته، وعتك البول أن يضرب إلى الحمرة.
ويروى: وعبك البول, وهو اختلاطه بوبرها وتلبده به والأنساء: جمع نسأ, وهو عرق يستبطن الفخذ والساق. والبيت لجبر بن عبد الرحمن. وانظر: الجمهرة 2/ 21.
10- من شواهد الكتاب 1/ 78، على حمل "تؤخذ على تبايع؛ لأنه مع قوله تجيء تفسير للمبايعة إذ لا تكون إلا أحد الوجهين من إكراه أو طاعة". وأراد بقوله الله: القسم. والمعنى: إن على والله، فلما حذف الجار نصبت.
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. وانظر المقتضب: 2/ 63, والخزانة 2/ 373, ومنهج السالك 26, وشواهد الألفية للعاملي/ 347, وشرح شواهد ابن عقيل/ 179.
11- البقرة: 251، وانظر الكتاب 1/ 76.
* قال شعيب: هي قراءة نافع، وقرأ الباقون: {وَلَوْلا دَفْعُ} حجة القراءات ص140.
12- انظر الكتاب 1/ 77.
13- الزمر: 60، وانظر الكتاب 1/ 77.
14-من شواهد سيبويه 1/ 77، على رفع "هلك واحد" ونصبه على جعل هلكه بدلًا من قيس، أو مبتدأ أو خبره فيما بعد.
رثى الشاعر: قيس بن عاصم المنقري وكان سيد أهل الوبر من تميم, فيقول: كان لقومه وجيرته مأوًى وحرزًا، فلما هلك تهدم بنيانهم وذهب عزهم.
وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 3/ 65.
15- من شواهد سيبويه 1/ 78 على حمل الحلم على الضمير المنصوب بدلًا منه لاشتمال المعنى عليه، يخاطب عاذلته على إتلافه ماله، فيقول: ذريني من عذلك فإني لا أطيع أمرك، فالحلم وصحة التمييز والفعل يأمرني بإتلافه في اكتساب الحمد ولا أضيع، والبيت من قصيدة لعدي بن زيد العبادي.
وانظر: الهمع 2/ 172, والدرر اللوامع 2/ 165, والمفصل لابن يعيش 3/ 65، ومعاني الفراء 2/ 73، وشواهد الألفية للعاملي 345, وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي/ 178.
16- انظر الكتاب 1/ 79.
17- انظر الكتاب 1/ 79.
18- في الأصل: "هو".
19- انظر الكتاب 1/ 79.
20- انظر الكتاب 1/ 79.
21- انظر الكتاب 1/ 79.
22- في الأصل: "به".
23- في سيبويه 1/ 80: مطرتهم.
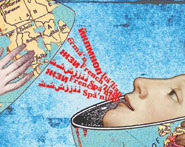
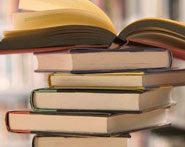

|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|