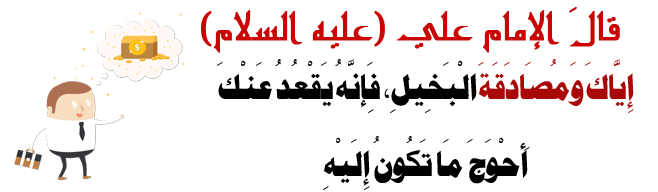
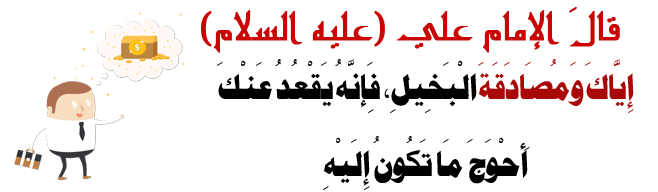

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-01
التاريخ: 2-4-2022
التاريخ: 23-3-2022
التاريخ: 2023-04-01
|
هي: ((الهمزة-آ-يا-إي-أيا-هيا-وا)).
ولكن لماذا أحرف النداء أولاً:
لقد اخترنا أن نفتتح هذه الدراسة عن حروف المعاني بأحرف النداء، بمعرض الكشف عن العلاقة الفطرية بين (أصالة) الحرف العربي و(حداثته).
فمعظمها هو أقدم مستحاثاتنا اللغوية وأبسطها تراكيب ومعاني واستعمالاً. وبذلك تتاح لنا فرصة نادرة لمواكبة هذه العلاقة الفطرية بين المعاني التراثية لأحرف النداء، وبين خصائص الحروف العربية التي تشارك في تراكيبها منذ فجر فجرنا اللغوي إلى يومنا هذا.
فالحروف التي تشارك في تراكيب أحرف النداء السبعة هي: (الهمزة والألف اللينة والواو، والياء). وهي جميعاً ذوات أصوات هيجانية تنتمي إلى المرحلة الغابية ما شذ منها سوى (الهاء) التي تنتمي إلى المرحلة الرعوية، كما ثبت لي ذلك في دراستي: ((الحرف العربي….)).
كما أن قِدم أحرف النداء هذه يعود إلى قِدم الحاجة إليها. فالنداء بادرة غريزيِّة يمارسها الإنسان والحيوان تلبية لحاجاتها الفطرية. وذلك إما للاستعانة أو التوجع أو الشكوى بمعرض الدفاع عن النفس، وإما لشتى الأغراض الاجتماعية من التعاون والتودُّد والتعاطف وما إلى ذلك مما يهيئ لأفراد المجتمع البدائي والحيواني ما يلزمهم من أسباب التواصل والتماسك والاستمرار.
إنّه لغريب ومثير للدهشة أن تتألف أحرف النداء من الأحرف الغابية. فلم يستعن الإنسان العربي بأيِّ حرف آخر سوى ((الهاء)) الرعويّة لمرة واحدة في (هيا) للنداء القريب وذلك لخاصية الاهتزاز في صوتها، لفتا لانتباه السامع، ولكن بأقل مما تستطيعه (الهمزة) في (أيا) للنداء البعيد، كما سيأتي.
على أن الأشد غرابة وإثارة للدهشة من ذلك، أن يحافظ الإنسان العربي طوال آلاف كثيرة من الأعوام على معانيها التراثية، بما يتوافق مع الخصائص الفطرية للأحرف التي تشارك في تراكيبها على وجه ما سيأتي وشيكاً.
يسميها ابن هشام (الألف المفردة)، وهي فيما نرى أقدم المستحاثات اللغوية جميعاً، ليس في اللغة العربية فحسب، وإنما في سائر لغات الدنيا أيضاً، بائدها وغير بائدها على حد سواء.
وهذا الحكم لا يتعارض مع الإقرار بأن أصول الأصوات الجوفية الثلاثة (الألف اللينة والواو والياء) هي بالضرورة أقدم الأصوات الإنسانية جميعاً. وذلك لأنها غريزية هيجانية في طبيعتها غير إرادية ولأنَّ تدخل جهاز النطق في تشكيل أصواتها يكاد يكون معدوماً، مِمَّا أبعدها في فجرها الأول عن وظيفتها اللغوية الإرادية.
أما (الهمزة) فيتشكل صوتها في الحنجرة بانطباق شفتي المزمار على بعضهما بعضاً وانفراجهما الفجائي.
وهذه العمليّة، من حيث التحكم بشفتي المزمار في الحنجرة عند تشكُّل صوت (الهمزة) تبدو لي كأنها إراديَّة في أصلها، وإن كانت تأخذ الطابع الهيجاني الغريزي بعد أن أتقنت الإنسانية صناعة صوتها في ذات المرحلة الغابية.
وإذن، فإن الإنسان الفجر قبل أن يستطيع التحكم بجهاز نطقه من شفويه إلى حلقيه، وقبل أن يبدع صوتي (الباء والميم) الشفويتين بمئات ألوف الأعوام، كان يطلق ذلك الصوت المزماري الانفجاري الذي تطور إلى (الهمزة)، مترافقاً مع الأصوات الجوفية الثلاثة قوام أحرف النداء في اللغة العربية. وهذا يثبت عراقتها في القدم، وبالتالي أصالتها وفطرتها.
فصوت (الهمزة) الانفجاري من شأنه أن يثير انتباه المخاطب المنادى إلى المتكلم المنادِي. ووظيفة أدوات النداء أصلاً تتلخص بإثارة انتباه السامع قبل ذكر اسمه.
وما أحسبني بعيداً عن الصواب لو قلت أن الإنسانية لو لم تهتد إلى (الهمزة) المزمارية هذه، فتتدرَّب على استعمال صوتها طِوال مئات ألوف الأعوام قبل أن تستطيع التحكم بجهاز نطقها من أوّله في الحلق إلى آخره في الشفتين. لما كان لها لغة ولا عقل ولا ثقافة ولا حضارة.
انفجار صوتي في (الهمزة) قد شق للإنسانية منذ فجر فجرها دروب التطور في كل –الاتجاهات، ويطيب لي أن أشبِّهه بالانفجار الكوني العظيم، الذي يحدد بعض علماء الفيزياء والفلك حدوثه قبل (20) مليار سنة في نقطة أصغر من النقطة. فكانت المجرات والشموس، وكان الإنسان شاهداً واعياً على هذا الإبداع الإلهي لا أعظم ولا أروع: (1) فقال تعالى في سورة /الأنبياء/ 30/: ((إن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما)).
إذا لفظت غير ممدودة، فإن صوتها الانفجاري لا يلفت انتباه السامع إلاّ لمسافة قصيرة، -فاستعملها الإنسان العربي للنداء، القريب كقول امرؤ القيس.
|
كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي |
|
أفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ وإِنْ |
وللهمزة المزيد من المعاني سنتحدث عنها في بحث خاص.
هي في حقيقتها (همزة) يلفظ صوتها الانفجاري ممطوطاً حسب ((المعنى المقصود والغرض المراد كما قال (ابن جني). فكان من الخصائص الفطرية ما للهمزة من إثارة الانتباه فقط، ولكن لأبعد مما يستطيعه صوت (الهمزة) الانفجاري القصير، نحو: (آزيداً). فكانت بذلك لنداء البعيد ولا معنى آخر لها ولا استعمال.
1- (الياء). يتشكل صوتها في جوف الفم مترافقاً مع حركة الفك السفلي باتجاه الصدر مما يشير إلى تحت. وهي تنتمي إلى المرحلة الغابية كما أسلفنا.
2- (الألف اللينة): يتشكل صوتها في جوف الفم مع حركة الفك العُلوي إلى الأعلى، مما يشير إلى فوق، فيوحى بالعلوِّ والامتداد. وهي تنتمي إلى المرحلة الغابية أيضاً.
ومحصلة المعاني المتناقضة لهذين الحرفين تتوافق مع حركة ((الصعود من تحت إلى فوق)).
1- هي للنداء البعيد، بما يتوافق مع خروج الصوت من حفرة عميقة على الطبيعة نحو: (يا زيد يا ناس…).
2- وهي للاستغاثة، بما يتوافق مع خروج الصوت من هاوية نفسية عميقة، لمأزق أو ضائقة أو شِدَّة قد وقع فيها المستغيث نحو (يا ألله، يا ربَّ السماء…).
وهذان الاستعمالان فطريان أصيلان.
3- أما استعمالها للنداء القريب أو المتوسط أو للتعجب، كما ورد لدى (ابن هشام والأنطاكي) فهي معان اصطلاحية قد تمت في مراحل لغوية متطورة لاحقة. وقد ساعدها على أداء هذه المهام المتنوعة مرونة صوتي (الياء والألف اللينة)، وسهولة التكيف في النطق بهما قِصراً أو مدّاً، أو بين بين، وفقاً (للمعنى المقصود والغرض المراد). ولا يبعد أن تكون هذه المعاني الاصطلاحية من مبتكرات الشعراء لمقتضيات معانيهم وأوزانهم الشعرية.
1- ((الهمزة) المكسورة تشير إلى تحت، بشيء من إثارة الانتباه بحكم انفجارها الصوتي.
2- و(الياء) تشير إلى تحت أيضاً.
ومحصلة خصائصهما، حصر الصوت في حفرة يصعب الخروج منها. ولمّا كان الانفجار الصوتي في (الهمزة) المكسورة من (إي) قصيراً لا يكاد يلفت الانتباه، فقد استعملها العربي للنداء القريب.
1- هي للنداء القريب حصراً.
2- حرف جواب بمعنى (نعم)، ولا تستعمل إلا والقَسَم بعدها، نحو: ((إي والله، إي وربَّك)).
ولما كان الجواب بها بمعنى نعم، ولا سيما بعد القسم، فهي تفيد الاستكانة كمن استقر في حفرة بما يتوافق مع الخصائص الفطرية لحرفيها. وذلك على العكس من الجواب نفياً بـ (لا) الذي يتضمن الشموخ والإباء، بفعل خاصية (الألف) التي تشير إلى الأعلى.
(الهمزة) انفجار صوتي يلفت الانتباه. (يا) للنداء البعيد. فكانت بذلك أبلغ تأثيراً من (يا) فاستعملها العربي للبعيد البعيد، كقول الشاعرة ليلى بنت طرفة:.
|
كأنك لم تجزع على ابن طريف |
|
أيا شجر الخابور مالك مورقا |
وقد غابت عنها معاني الاستغاثة، لأنه لا يستغاث بالبعيد البعيد ، لعدم الجدوى من نجدته
1- (الهاء): تختلف خصائصها، أي موحياتها الصوتية تبَعَاً لطريقة النطق بها. وإن ما يهمنا من معانيها العديدة هنا هو خاصية الاهتزاز في صوتها مما يثير انتباه السامع، فكانت للتنبيه.
2- (الياء والألف) في (يا) للنداء البعيد، كما مر معنا آنفاً.
فتكون محصلة المعاني الموافقة لأحرفها، النداء للبعيد، كما في (أيا). ولكن بفارق أن (الهاء) في هيا أقل إثارة للانتباه من (الهمزة) في (أيا)، فكانت هذه للبعيد البعيد وظلت (هيا) للبعيد فقط.
هي للنداء البعيد حصراً. ولم يستعملها العربي للاستغاثة، على الرغم من دخول (يا) للاستغاثة في تركيبها.
وذلك يعود فيما نرى إلى أنها مؤلفة من ثلاثة أحرف. ولما كانت الاستغاثة ردَّ فِعلٍ غريزيٍّ فُجائي، فيجب أن تتمَّ بأبسط تعبير وأقلِّ زمن. وهذان الشرطان لا يتوافران فيها ولا في (أيا) كما توافرا في (يا) فلم يستعملها العربي للاستغاثة، وما أرهف حِسَّه وأصدق حِدسه.
1- (الواو) –يحصل صوتا إذا أُشبع بتدافع النفَس في جوف الفم مع انضمام الشفتين على شكل حلقة ضيقة، مما يشير إلى الفعاليّة والاستمراريّة.
2- (الألف اللينة)، هي هنا للامتداد.
هي مختصة بنداء النّدبة، نحو (وازيداه). وذلك لأن تدافع النفَس في صوت (الواو) في بداية (وا) يتوافق مع تدافع الشجون والأحزان في نفْس المفجوع من مشاعر الأسى والحزن واللوعة بلا ترتيب على مثال ما تستعمل (الواو) للجمع العشوائي بلا ترتيب كما سيأتي وشيكاً في أحرف العطف.
وهكذا، بانتهائنا إلى هذه النتائج من توافق المعاني والاستعمالات التراثية لأحرف النداء مع الخصائص الفطرية للأحرف العربية التي تشارك في تراكيبها، نكون قد أقمنا الدليل الميداني على أن العربي ظل يستعمل معظم أحرف النداء لهذه المعاني بصورة عامة منذ فجره اللغوي حتى يومنا هذا.
وبذلك تكون اللغة العربية قد حافظت على فطرتها وبداءتها وأوصالها في هذا القطاع الخاص من أحرف المعاني.
كما أن وعينا الجديد لهذه العلاقة بين المعاني التراثية لأحرف النداء وبين الخصائص الفطرية للحروف العربية التي شاركت في تراكيبها، تتوافر فيه شروط (الحداثة) في الحرف العربي، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، وكما سيأتي لاحقاً.
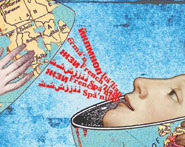
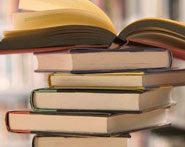

|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه
|
|
|