

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
طرق تحمّل الحديث / القراءة على الشيخ
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 475 ـ 494
2025-07-13
16
النوع الثاني: القراءة على الشيخ.
* [العرض وصحّته]:
وأكثر المحدّثين يسمّونها (عرضًا) من حيث أنّ القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأ(1)، سواء كنت (2) تقرأ من الكتاب، أو من حفظك، أو كان القارئ غيرك وأنت تسمع، وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ عليه أو لم يحفظ، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره.
ولا خلاف في أنّها رواية صحيحة (3).
* [هل العرض مثل السماع أو دونه؟]:
ثم اختلفوا في أنّ القراءة على الشيخ: هل هو مثل السماع منه، أو دونه، أو فوقه: فنقل عن أبي حنيفة، وابن أبي ذئب، وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضًا (4).
وروي عن مالك (5) وغيره أنّهما سواء.
وقيل: إنّ التسوية مذهب معظم علماء الحجاز، والكوفة، ومذهب مالك، وأشياخه من أهل المدينة، ومذهب البخاري (6).
والصحيح ترجيح (7) السماع من لفظ الشيخ والقراءة منه مرتبة ثانية.
وقيل: هذا مذهب جمهور أهل المشرق (8).
قلت: وممّا يعضد هذا المذهب أنّ السماع من لفظ الشيخ موافق للأصل؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - أخبر الناس ابتداءً، وأسمعهم بما جاء به، والتقرير على ما جرى بحضرته - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، أو السؤال عنه مرتبة ثانية، فالأول أولى، والله أعلم.
* [العبارة عن العرض في الرواية]:
وأمّا العبارة عنها عند الرواية فعلى مراتب:
أجودها: يقول: قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع، وأقرّ به، وهذا شائع من غير إشكال، ويجوز فيه من العبارات ما في السماع إذا أتى بها مقيدة، كقولنا: حدّثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا فلان قراءة عليه، وفي الشعر: أنشدنا فلان قراءة عليه.
وأمّا إطلاق حدّثنا وأخبرنا فاختلف فيه على ثلاثة مذاهب:
فمنهم من منع منهما جميعًا، وقيل: إنّه قول ابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميميّ، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وغيرهم (9).
ومنهم من جوّزهما جميعًا، وقيل: إنّ هذا مذهب الحجازيّين، والكوفيّين، والزهريّ، ومالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطّان، والبخاريّ، وغيرهم (10).
وهؤلاء يجوّزون أيضًا أن يُقال فيه: سمعت فلانًا (11).
والمذهب الثالث: الفرق بينهما، وهو المنع من إطلاق حدّثنا (12)، ويجوز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعيّ، وأصحابه، ومنقول عن مسلم، وجمهور أهل المشرق(13).
وذكر محمد بن الحسن التميميّ المصريّ (14) أنّ هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث، وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، ومصطلح عليه للتمييز.
وحُكي (15) عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أنّه قرأ على بعض الشيوخ، عن الفربري "صحيح البخاري"، وكان يقول في كلّ حديث: حدّثكم الفربري، فلمّا فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنّه إنّما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كلّه، وقال له في جميعه: أخبركم الفربري (16).
فروع: [في العرض]]
* [إذا كان أصل الشيخ بيد غيره]:
الأول: إذا كان أصل الشيخ بيد غيره، وهو موثوق به، مراعٍ لما يقرأ، والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، فهو كما لو كان الأصل بيده (17)، وإذا كان الشيخ يقرأ عليه (18)، فالمختار أنّ السماع صحيح (19)، وبه عمل معظم الشيوخ، وأهل الحديث، خلافًا لبعض الأصوليّين (20).
* [إذا كان أصل الشيخ بيد القارئ]:
وإذا كان أصل الشيخ بيد القارئ، وهو موثوق به دينًا ومعرفةً فهو أولى بالتصحيح، وإن كان بيد من لا يوثق به، ولا يؤمن إهماله، سواء كان (21) القارئ أو غيره، لم يصحَّ السماع إذا كان الشيخ غير حافظ لما يقرأ عليه.
* [لا يشترط نطق الشيخ لفظًا عند العرض عليه]:
الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ، ويقول: أخبرك فلان، أو قلت: أخبرنا فلان، والشيخ ساكت، مصغٍ إليه، فاهم لذلك، كفى ذلك في صحّة السماع، وتجويز الرواية به (22)، ولا يشترط نطق الشيخ لفظًا، خلافًا لبعض الظاهريّة (23)، وأبي إسحاق الشيرازيّ، وأبي الفتح سليم الرازيّ، وأبي نصر بن الصبّاغ (24)، فإنّهم اشترطوا نطق الشيخ بذلك. وقال أبو نصر: ليس له أن يقول: حدّثني، وأخبرني، بل له أن يعمل بما قرئ عليه، وله أن يروي قائلاً: قرئ عليه وهو يسمع. وشرط بعض الظاهريّة إقرار الشيخ بعد تمام السماع (25)، والصحيح ما ذكرناه.
* [التفريق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا]:
الثالث: قال الحاكم: "الذي أختاره في الرواية، وعهدت عليه أكثر مشايخي فيما سمع من المحدّث هو وحده يقول: حدّثني، وإن سمع معه غيره يقول: حدّثنا، وفيما قرأ على المحدّث بنفسه يقول: أخبرني، وفيما قرئ على المحدّث وهو حاضر يقول: أخبرنا"(26).
* [إن شكَّ في وجود غيره]:
وإن شكَّ في وجود غيره فليقل: حدّثني، أو أخبرني؛ لأنّ الأصل عدم الغير (27). واختاره الحافظ أحمد البيهقي (28).
* [حكم التفريق المذكور]:
ثم هذا التفصيل من الأصل مستحبّ غير واجب، حكاه الخطيب أبو بكر عن أهل العلم كافّة (29)، فيجوز أن يقول فيما سمع أو قرأ وحده: حدّثنا، وأخبرنا، وفيما سمع، وقرأ مع غيره: حدّثني وأخبرني.
* [حكم تبديل أدوات التحمل عند الأداء]:
الرابع: قال أحمد بن حنبل: "اتّبع لفظ الشيخ في حدّثني، وحدّثنا، وسمعت، وأخبرنا، ولا تعدوه" (30).
وإن جوّزت الرواية بالمعنى (31)، إلّا إذا عرف من مذهب ذلك المصنّف التسوية.
* [عدم جواز التبديل في الكتب المصنّفة]:
قال الشيخ تقي الدين: "ليس لك فيما تجده من الكتب المصنّفة أن تبدّل ما قيل فيه من لفظ أخبرنا بحدّثنا ونحو ذلك، لاحتمال أن يكون ذلك قول من لا يرى التسوية.
وما ذكر الخطيب (32) من إجراء ذلك الخلاف في هذا محمول على ما يسمع من لفظ المحدّث لا الموضوع في كتاب مؤلّف" (33).
* [المذاهب فيما إذا كان التلميذ (السامع) أو الشيخ (المسمع) ينسخ وقت القراءة]:
الخامس: إذا كان السامع أو المسمّع ينسخ وقت القراءة، هل يصحّ سماعه فيه أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: لا يصحّ مطلقًا، وهو مذهب إبراهيم العربيّ، وأبي أحمد بن عدي، والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينيّ (34).
الثاني: يصحّ مطلقًا، وهو مذهب ابن المبارك، وموسى بن هارون الحمّال، ومحمد بن الفضل، وعمرو بن مرزوق، وأبي حاتم الرازيّ (35).
الثالث: التفصيل، فإن امتنع فهم الناسخ للمقروء، لم يصحّ السماع، وإن فهم صحّ(36).
* [عجيبة في حفظ الدارقطنيّ]:
وروي عن الدارقطني أنّه حضر مجلس إسماعيل الصفّار، فجلس ينسخ جزءًا، وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصحّ سماعك وأنت تنسخ، فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال: أتحفظ كم أملى الشيخ من الحديث؛ فقال: لا، فقال الدارقطني: أملى ثمانية عشر حديثا، وعدّها بأسانيدها مفصّلة، فوجدت كما قال، فتعجّب الناس منه (37).
* [إذا كان التلميذ أو الشيخ يتحدّث، أو كان القارئ يفرط في الإسراع أو كان خفيف القراءة أو بعيدًا عن القارئ وما شابه]:
السادس: ما ذكرنا في النسخ من التفصيل يجري مثله إذا كان الشيخ أو السامع يتحدّث، أو كان القارئ خفيف القراءة، أو يفرط في الإسراع (38)، أو كان السامع بعيدًا عن القارئ، أو نحو ذلك (39).
ثم الظاهر أنّه يعفى في كلّ ذلك عن قدر يسير، نحو كلمتين (40).
* [إجازة الشيخ جميع السامعين رواية الكتاب الذي سمعوه]:
ويستحبّ للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الكتاب الذي سمعوه بالتلفظ أو الكتابة، لينجبر له بالإجازة ما فاته، ولذلك قال أبو محمد بن عتاب (41) الأندلسيّ: "لا غنى في السماع عن الإجازة" (42).
* [إذا سمع الشخص من المملي]:
وإن كان شخص بعيدًا عن المملي (43) لم يسمعه منه، فبلغ عنه المستملي فلا يجوز لمن سمع عن المبلغ أن يروي ذلك عن المملي عند المحقّقين، وهو الصواب (44).
* [صحّة السماع ممّن هو وراء حجاب]:
السابع: يصحّ السماع ممّن هو وراء حجاب، إذ عرف صوته فيما حدث بلفظه، وعرف حضوره فيما قُرئ عليه، أو علم ذلك بخبر عدل يوثق به.
وروي عن شعبة (45) خلاف ذلك، وهو بعيد عن الصواب لما ثبت أنّ الصحابة سمعوا عن عائشة وغيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - من وراء حجاب اعتمادًا على الصوت (46).
* [إذا قال الشيخ رجعت عن إخباري، أو قال للتلميذ: لا تروه عني]:
الثامن: من سمع من محدّث حديثًا، ثم قال له الشيخ: لا تروه عنّي، أو رجعت عن إخباري إيّاك، ونحو ذلك، على أن أسند ذلك إلى أنّه أخطأ فيه، أو شكّ فيه؛ لا تجوز روايته ذلك الحديث، وإن لم يكن شيء من ذلك، بل يمنعه عن الرواية عنه لا يضر ذلك (47). وللسامع أن يروي عنه، كما إذا قال: "إنّي أخبركم ولا أخبر فلانًا"، لا يضرّ لفلان، ويجوز أن يرويَ عنه (48).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بين القراءة والعرض عموم وخصوص؛ لأنّ الطالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلّا بالقراءة؛ لأنّ العرض عبارة عمّا يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، انظر "فتح الباري" (1/ 149)، "تدريب الراوي" (2/ 13).
(2) تحتها في الأصل بخط الناسخ: "القارئ".
(3) استدلّ له البخاري بحديث ضمام بن ثعلبة وأورده في (كتاب العلم) وبوّب عليه: (باب القراءة والعرض على المحدّث)، وتقدّم، وانظر "صحيح البخاري" (رقم 63)، "مسائل أحمد وأبي داود" (282)، "المعرفة" (258) للحاكم، "الإلماع" (70). وإطلاق عدم الخلاف غير دقيق أو فيه تجوّز، وعبارة ابن الصلاح: "إلا ما حكي عن بعض من لا يعتدّ به" وهي منتقدة، كما تراه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 34/ ب)، "محاسن الاصطلاح" (319). ثم وجدت ابن حجر يقول: "قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزيء، وإنّما كان يقوله بعض المتشدّدين من أهل العراق"، وانظر: "فتح الباري" (1/ 150)، "توضيح الأفكار" (2/ 303).
(4) وروي أيضا عن الحسن بن عمارة وابن جريج، وانظر لتوجيه هذا الترجيح: "الكفاية" (ص 227) - ونقله عن جماعات غير المذكورين - "الإلماع" (ص 74)، "فتح المغيث" (2/ 27).
(5) بل هذا هو المعروف عنه، وبه جزم القاضي عياض في "الإلماع" (71)، وانظر "فتح المغيث" (2/ 26).
(6) انظر: "المحدّث الفاصل" (420 - 422)، "معرفة علوم الحديث" (257 - 258) - فإنّه ذكر من قال به من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر - و"فتح الباري" (1/ 148): كتاب العلم: باب القراءة والعرض على المحدّث، كتابي "البيان والإيضاح" (92).
(7) ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى، بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك، وكان يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو، ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرّز الشيخ والطالب، وحينئذٍ؛ فالحقّ أنّه كلّما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة، وأعلاهما فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر، ليجتمع فيه اللفظ والعرض. انظر "فتح الباري" (1/ 155)، "فتح المغيث" (2/ 28).
(8) وهو مذهب جمهور أهل خراسان، وهو أحد قولي أبي حنيفة وهو قول والشافعي ومسلم بن الحجّاج، وهو الذي مشى عليه الجمهور. انظر عدا المصادر المذكورة في الهامش السابق: "الإلماع" (73).
(9) قال الخطيب: "هو مذهب خلق من أهل الحديث"، وإليه ذهب ابن معين والبرقاني، واختاره ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (248)، قال: "والذي أراه ألّا يستعمل فيها أخبرنا بالإطلاق ولا التقييد، لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار؛ إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية"، وحكاه ابن الحاجب في "مختصره" الأصوليّ، وليس العمل عليه، ولا سيما من القرن السادس في بعد. انظر: "الكفاية" (292، 293، 297، 3001)، كتابي "البيان والإيضاح" (92 - 93). والمتأمّل نقولات الخطيب عن أحمد يشك في أنّ مذهبه المنع، ولعلّه يرى الاحتياط فحسب. وتأمّل ما نقله أبو داود في "مسائله" (282) قال: "سمعت أحمد يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس به، فقيل لأحمد: كيف يعجبك أن يقول؟ قال: يعجبني أن يقول كما فعل: إن قرأ قال: قرأت. قيل لأحمد وأنا أسمع: كان (أخبرنا) أسهل من حدّثنا؟ قال: نعم، أخبرنا شديد"، فتأمّل.
(10) من الأقدمين طائفة غيرهم، مثل: الحسن البصري، ومنصور، والثوري، وابن جريج، وشعبة، وأبي حنيفة، ويزيد بن هارون والنضر بن شميل. انظر "الكفاية" (ص 305 - 310) - والمتأمّل فيه يجد رأيا آخر لسفيان وهو المنع، انظر منه (299) - و"المحدّث الفاصل" (428)، "الإلماع" (71 - 73)، "فتح المغيث" (2/ 300) - وفيه: "وعليه استمر عمل المغاربة" -.
(11) عبارة ابن الصلاح: "ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا…" وهذا هو الصواب، إذ هو مذهب السفيانين ومالك، ذكره عنهما الخطيب في "الكفاية" (296، 306)، والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 71) وغيرهما.
وقال البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (322): "وممّن جوز إطلاق حدّثنا في ذلك: عطاء والحسن، وأبو حنيفة وصاحباه وزفر، ومنصور".
قلت: مذهبهم في "المحدث الفاصل" (422، 425، 428، 464).
(12) انظر "المحدث الفاصل" (425، 431)، "الكفاية" (297، 303)، وزاد شيخ المصنّف ابن جماعة في "المنهل الروي" (82): "وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وعن النسائي أيضا، وهو الشائع الغالب الآن"، وانظر "المحدّث الفاصل" (432)، "الكفاية" (302)، "الإرشاد" (2/ 352) للنووي، "فتح المغيث" (2/ 31).
(13) نقل مذهب أهل المشرق: الحاكم في "المعرفة" (260) قال: "وعليه عهدنا أئمّتنا، وبه قالوا، وإليه ذهبوا، وبه نقول: إنّ العرض ليس بسماع، وإنّ القراءة على المحدّث إخبار…" وفصّل في ذلك.
قل أبو عبيدة: نعم، لا يصحّ أن يطلق في العرض على الشيخ "سمعت" و"حدّثنا"، والوضع اللغويّ لا يدلّ عليه، ومن جوزه تسامح بتغيير الاصطلاح، فإذا كان هذا الاصطلاح عاما، فقد يقرب الأمر فيه، وهذا واقع من غير دافع في (حدّثنا) دون (سمعت)، وإنّ وضعه الراوي لنفسه، فلا ينبغي إلّا بالتصريح والبيان، والله المستعان.
(14) في كتابه "الإنصاف" فيما ذكر ابن الصلاح في "مقدّمته" (322 – ط: بنت الشاطئ) والعراقي في "التقييد" (143)، ومحمد بن الحسن التميميّ هذا هو صاحب "نوادر الفقهاء" المطبوع بتحقيق د - محمد فضل المراد. قال في أوّل تحقيقه (ص 16) له: "وبعد جهد كبير بذلته لم أستطع الحصول على ترجمة للمؤلف، ومع الرجوع إلى المصادر التي أمكنني الرجوع إليها، والبحث العميق، وسؤال بعض العلماء، لم أعثر على من ترجم لهذا المؤلف".
قلت: هو ابن بنت نعيم بن حمّاد، كما في "الجوهر النقي" (4/ 225 و10/ 151)، ونقل منه ابن رشد في "بداية المجتهد" (6/ 10 - مع "الهداية").
ثم وجدت من شيوخ الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت 409 هـ) ذكره في كتابه "المتوارين" (ص 59 - بتحقيقي): "أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن محمد" فلعلّه ولد هذا.
(15) حكاه عنه الحافظ أبو بكر البرقاني، أفاده ابن الصلاح.
(16) "الكفاية" (303 - 304)، "المحدث الفاصل" (420)، وجعل البلقيني في "المحاسن" (ص 323) أبا حاتم في هذا متشدّدا، وذكر تساهلا عن حبيب بن أبي ثابت، وسبقه إليه مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ أ).
(17) بل أولى، لاجتماع اثنين على الضبط.
(18) ولا يحفظه.
(19) في كتاب السلفي "شرط القراءة": "هل على التلميذ أن يُري الشيخ صورة سماعه في الجزء، أو يقتصر على إعلامه أنّه عمّن يسمّيه؟ قال أبو طاهر: هما سيان، على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم، ولم يزل الحفّاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول، فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولا، وهل كانت الأصول أوّلا إلا فروعا"، قال: "ولم يذكر هذا الإيراد أحد من الأئمّة"، نقله مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ أ) وعنه البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (324) باختصار يسير.
(20) هذا الذي أبهم ابن الصلاح - وتبعه المصنّف - هو إمام الحرمين، فإنّه اختار ذلك ونقله القاضي عياض في "الإلماع" (75)، وقال: "وتردّد فيه القاضي ابن الطيب - هو الباقلاني - وأكثر ميله إلى المنع" ونقله العراقي في "التقييد والإيضاح" (171) عن عياض. قال أبو عبيدة: وعبارة إمام الحرمين في "البرهان" (1/ 413): "وتردّد جواب القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ، وكانت الأحاديث تقرأ، وذلك الناظر عدل مؤتمن، لا يألو جهدا في التأمّل، وصِغوه الأظهر إلى أنّ ذلك لا يصحّ؛ فإنّ الشيخ ليس على دراية فيه، فلم ينهض مفهما محملا، فلئن جاز الاكتفاء بنظر الغير، فينبغي أن يجوز الاكتفاء بقراءة القارئ المعتمد من النسخة المصحّحة، فهذا ما يتعلّق بالتحمّل، وفيه بيان الغرض من التحميل". فأنت ترى أنّ إمام الحرمين نقله عن القاضي الباقلاني.
(21) بعدها في "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها: "بيد" فلعلّه سقط من الأصل!
(22) الأجود والأولى التمييز، ولإمام الحرمين في "التلخيص" (2/ 388 - 389) كلمة مهمّة في هذا، نسوقها بتمامها قال: "ثم أجاز معظم المحدّثين أن تطلق فتقول: أخبرني فلان، وإن كان ساكتًا إذا قرّرك، قال القاضي: وأولى عندنا غير ذلك، فإنّ التلقّي من الشيخ ينقسم طريقه فربّما يكون بأن يسمعك من قراءة نفسه، وربّما يقرّرك على قراءتك، فإذا أطلقت الأخبار والتبس النوعان، فالذي تقتضيه النزاهة في الرواية وتوقي الإبهام أن تميز فتقول: أخبرني قراءة عليه، أو قرأت عليه وهو ساكت فقرّرني. فإن قيل: فإذا لم يبدر منه تقرير لفظ، في قولكم فيه؟ قلنا: ما اختار معظم أهل الحديث أن سكوته مع سلامة الأحوال نازل منزلة صريحة بالتقرير، وعنينا بسلامة الحال أن ينتفي عنها إلجاء أو إكراه أو غفلة مقارنة للسكوت، فإذا انتفت هذه الموانع وأمثالها فالسكت يكتفى به، فإنّ الذي ينقل عنه إذا كان ثقة وعلم أنّ الذي يقرأ عليه لا بُدَّ أن يؤثر عنه، وهو مختار مقتدر على ردِّ ما يقرأ عليه، فلو سكت غير مقرّر كان ذلك مؤذنًا بفسقه، فالطريق الذي يقتضي حمل لفظه على الصدق - وهو الثقة والعدالة - فذلك بعينه يقتضي تنزّل سكته منزلة تقريره. وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنّه لا بُدَّ من التصريح بالتقرير، وفيما ذكرناه أوضح الردّ عليهم". وصرّح في "البرهان" (1/ 412 - 413) بدليل الجواز، وذكر الاعتراض عليه ودفعه، فقال: "ولو كان الحديث يقرأ والشيخ يسمع، نظر: فإن كان يحيط بما يحرفه القارئ، ولو فرض منه تصريف وتحريف لرده، فسكوته والأخبار التي تقرأ بمثابة نطقه، والحديث يستند بذلك. فإن قيل: هذا تنزيل منكم للسكوت منزلة القول، وهذا من خصائص من يجب له العصمة. قلنا: إخباره تصريحا ونطقا كان تحميلا للرواية من جهة أنّه أفهم بما أسمع السامع من عباراته. فإذا كان الحديث يقرأ وهو يقرّر ولا يأبى، مع استمرار العادات في أمثال ذلك؛ فهذا على الضرورة حال محل التصريح بتصديق القارئ. ومن لم يفهم من هذه القرائن ما ذكرناه، فلا يفهم أيضًا من الإخبار النطقي.
وأمّا ما ذكره السائل من أنّ السكوت إنّما ينزل منزلة التقرير من يجب عصمته، فيقال: السكوت مع القرائن التي وصفناها ينزل منزلة النطق، ثم النطق ممّن لا يعصم عرضة الزلل أيضا، ولكنّا تعبّدنا بالعمل بظواهر الظنون، مع العلم بتعرّض النقلة لإمكان الزلل، وتعمّد الخلف والكذب. ثم ما ذكرناه يتأيد بإجماع أهل الصناعة، في زالوا يكتفون بما وصفناه في تلقي الأحاديث من المشايخ، وهذا إذا كان الشيخ يدري ما يجري". قلت: وهذا التفصيل هو المعتمد عند أئمّة الحديث، وعليه العمل عند جماهيرهم، انظر: "الإلماع" (78)، "الكفاية" (280 - 281، 309)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 38)، "فتح المغيث" (2/ 36)، "جامع الأصول" (1/ 79).
(23) انظر: "الإحكام" لابن حزم (2/ 232) ونقله مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ أ) عن الحميدي منهم، وسيأتي كلامه قريبا إن شاء الله تعالى.
(24) انظر: "جامع الأصول" (1/ 79)، "الإحكام" للآمدي (2/ 100)، "اللمع" للشيرازي (81)، "فتح المغيث" (2/ 37 - 38)، "التبصرة والتذكرة" (4/ 39)، "المنهل الروي" (82).
(25) بأن يقول القارئ للشيخ: هو كما قرأته عليك؟ فيقول: نعم.
قال مغلطاي "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 35 - ب): "قال الحميدي الحافظ: وأهل صناعة الحديث لا يقنعون بالسكوت فيما يتعلق بها ولا بد من التصريح، وإلا لم يحكموا على الساكت بما لم يحكم، ولا قوّلوه ما لم يقل؛ لأنّهم شهود وحكّام فيما يروونه من الشرائع والأحكام، حتّى إنّهم إذا قرأوا على المحدّث شيئا من حديثه كرّروا الإسناد في كلّ حديث ثم قرّروه بعد ذلك، وقالوا: حدّثك فلان عن فلان بما قرئ عليك؟ فإذا قال: نعم؛ أمسكوا، إلا إذا أملى أو قرأ، فيسقط حينئذ هذا السؤال عنه، ولعهدي بالشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد الله الأرموي - وناهيك به علما وذكاء، وكان قد تفقّه على أبي حامد الإسفراييني، وسمع من أبي محمد يحيى بن البيع، وأبي عمر بن مهدي وغيرهما - وتصدّر في جامع عمرو، فكنّا نقرأ عليه الحديث نحن وغيرنا، فكلّما كرّر القارئ عليه: حدّثكم فلان، يقول: نعم، بدارًا إلى الواجب عليه، ومنهم من يجعل التقرير قبل القراءة احترازًا ممّا حكى بعض أصحاب الحديث أنّ رجلا استأذنه في قراءة جزء، ثم قرأه بين يديه، فلمّا استوعب قراءته إيّاه قال له: حدّثك به فلان عن فلان؟ قال: لا، قال: فلم تركتني أقرأ وقد استأذنتك؟ فقال: إنّك استأذنتني في القراءة ولم تسألني عمّا سوى ذلك".
(26) معرفة علوم الحديث (260 أو 678 - ط السلوم) باختصار وتصرّف، وتتمّة كلامه: "وما عرض على المحدّث، فأجاز له روايته شفاها يقول فيه: أنباني فلان، وما كتب إليه المحدّث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة، يقول: كتب إليّ فلان". وانظر "الإلماع" (ص 126).
(27) انظر: "التقييد والإيضاح" (172 - 183) حيث اعترض فيه العراقيّ على تسوية المصنّف في هذه الحالة بين الشك في السماع والإقراء، وسوّغ ما قال في الأولى دون الثانية، والنكتة فيه أنّه يسوّغ أن يقول (قرأنا) فيما سمعه بقراءة غيره، فتأمّل.
(28) قال السخاوي في "فتح الغيث" (2/ 41): "علله البيهقي بأنّه لا يشك في واحد، وإنّما الشك في الزائد، فيطرح الشك، ويبني على اليقين".
(29) انظر "الكفاية" (294 أو 2/ 235 - ط المحققة).
(30) الكفاية (293 أو 2/ 232) وفيه "تَعدُهُ" والمثبت "تعدوه" من الأصل وله وجه، ففي نسخة دار الكتب بالقاهرة من "علوم الحديث" لابن الصلاح وهي منسوخة سنة 713 هـ، وآلت النسخة لمحمد بن عيسى بن عثمان، المعروف بابن الفاسي وقابلها على أصل الشيخ شمس الدين ابن جميل بقراءة الشيخ يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني على الشمس ابن جميل -: "تعدوه" وفوقها: "ش صح" أي: نسخة ابن جميل. وهكذا "تعدوه" في متن "علوم الحديث" من "التقييد والإيضاح" (173) وكذا أثبت في هامش غير نسخة من نسخه الخطية.
(31) أي: إن غيرت فيما تجده من الكتب المؤلفة من روايات من تقدّمك: "أخبرنا" بـ "حدثنا" لقيام أحدهما مقام الآخر؛ فجائز من باب تسوية الرواية بالمعنى، ولذا اشترط الجواز في الإسناد الذي يعرف من منصب رجاله التسوية بينهما، وانظر: "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ ب)، "التقييد والإيضاح" (174 - 175)، كتابي "البيان والإيضاح" (101).
(32) في "الكفاية" (305 أو 2/ 231 – ط: المحقّقة).
(33) مقدّمة ابن الصلاح (ص 144) بتصرّف واختصار.
(34) أسند الخطيب في "الكفاية" (66) قول الأوليين عن الأول بإسناد صحيح، وعن الثاني (ابن عدي) بإسناد ضعيف.
وقول الإسفرائيني في المنع: "إذا اشتغل بالنسخ عن الاستماع حتّى إذا استعيد منه، تعذّر عليه" فالظاهر أنّه يرى التفصيل، وكلامه في "فتح المغيث" (2/ 42).
(35) أسند الأخبار عن المذكورين: الخطيب في "الكفاية" (ص 67 - 68) وبعضها فيها لازم هذا المذهب، كقوم عارم (محمد بن الفضل) وعمرو بن مرزوق، فأسند الخطيب عن أبي حاتم قوله: "كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ" وهذه المقولة في "مقدّمة الجرح والتعديل" (367).
(36) قال ابن الصلاح بعد القولين السابقين: "وخير من هذا الإطلاق، التفصيل..."، وذكره، وعبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 362): "والأظهر التفصيل"، وقال ابن جماعة (شيخ المصنّف) في "المنهل الروي" (83): و"الأصحّ. التفصيل"، وعبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (ص 107): "والحق تنزيلهما على حالين: إن وعى الكلام كالدارقطني؛ صح، وإلا فلا"، وألحق بالنسخ: صنعة أو حديث أو نوم أو فكر أو هينم - أي: أخفى - القارئ أو هذ أو بعد، وانظر (الفرع السادس) الآتي عند المصنّف.
(37) أسند قصّته هذه: الخطيب في "تاريخه" (12/ 36) ومن طريقه ابن الجوزي في "الحث على حفظ العلم" (ص 98). ووقع مثلها للمزي، قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 97): "وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزيّ يكتب في مجلس السماع، وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردّا جيدا بيّنا واضحا، بحيث يتعجّب القارئ من نفسه: إنّه يغلط فيما في يده، وهو مستيقظ، والشيخ ناعس، وهو أنبه منه! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". وبنحوه في "تذكرة الحفاظ" (4/ 1499)، وقال السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 143): "والعمل على هذا، فقد كان شيخنا - أي ابن حجر - ينسخ في مجلس سماعه، ثم إسماعه، بل ويكتب على الفتاوي، ويصنّف، ويردّ مع ذلك القارئ ردّا مفيدا".
ونقل مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 36/ أ) عن كتاب "تاريخ القدس" للشريف قصة لأبي مسعود أحمد بن الفرات الضبي الرازي وقعت له نحو ما حكي عن الدارقطني.
(38) من الآداب المرعية في التحديث: عدم الإسراع المذموم، وعدم سرد الأحاديث على استعجال، على وجه لا تظهر فيه حروف بل كلمات، وهذا يخالف الصدق ومطابقة الواقع، ولا سيما أنّ قدرات التلاميذ في التنّبه لما يملي عليهم متفاوتة قوة وضعفا، بل قد يكتب أحدهم شيئا على غير وجهه، نتيجة لخداع السمع، حين يخلط المملي المهموس بالمجهور ونحو ذلك، والأدهى من ذلك أن يكون المملي غير مبين في كلماته، فلا يفصل حروفه تفصيلا، ولا يراعي مخارج الحروف، وهذا كله يوقع في "تصحيف السمع"، وقد انتشر ذلك في زمان ابن دقيق العيد، وتسامح فيه آنذاك المحدّثون، واستمر ذلك إلى العصور المتأخّرة، قال الذهبي في "الموقظة" (ص 67): "وقد تسمّح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك: سمعت أو قرأت هذا الجزء كله، مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب".
نعم، السماع بالسرد الذي لا يتبيّن معه بعض الكلمات لا يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع؛ لأنّه يزعم أنّه سمع من الشيخ جميع الجزء، وحقيقة الأمر ليس كذلك، فهو ممّا لا يطابق الواقع، وفيه تشبع بما لم يعط، ولا سيما إن لم يكن جميع ما في الكتاب واضحا، وقد تتصحّف أو تتحرّف فيه بعض الكلمات، وقد تعجم بعض الحروف، ويلتبس بعض الشكل.
من كتابي "البيان والإيضاح" (116 - 117) بتصرّف واختصار، وانظر "فتح المغيث" (2/ 45)، "توضيح الأفكار" (2/ 307).
(39) أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل.
(40) ذهب أحمد وتبعه الجماهير أن من لم يدرك كلمة واثنتين وثلاث خفيت على السامع من كلام القارئ وهو يعرفها من السياق، جازت روايته، وهذا متّجه، انظر "فتح المغيث" (2/ 45).
والورع ما كان عليه السابقون من التمييز، كما وقع للنسائي؛ فإنّه كان إذا غابت عنه كلمة لم يسمعها من شيخه، قال: "وذكر كلمة معناها كذا وكذا" كما تراه في مواطن من كتابه "المجتبى" له، مثل: (1/ 178، 189، 214، و2/ 82 و 3/ 29، 232) وهذا يدل على تحريه وورعه، وتشبه في الرواية عن شيخه، فلمّا شك في اللفظ بعدم سماعه الجيد له أسقطه، وأتى بكلمة من (كيسه) بمعناه، وصرّح بذلك، وانظر "المنهل الروي" (83)، "فتح المغيث" (2/ 45).
(41) كذا في "المنهل الروي" (84) و"الإرشاد" (1/ 364) للنووي، وهو ليس كذلك، إذ أسنده القاضي عياض في "الإلماع" (92) بسماعه من شيخه أبي محمد عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن عتاب القرطبي عن أبيه.
فصاحب هذا القول هو أبو عبد الله - لا أبو محمد - محمد بن عتاب مولاهم، المالكي، مفتي قرطبة وعالمها ومحدثها. (ت 462 هـ) ترجمته في "السير" (18/ 328).
(42) الإلماع (92، 141) وتتمة كلامه: "لأنّه قد يغلط القارئ، ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته بالإجازة". أورده ابن الصلاح (328 – ط: بنت الشاطئ) وقال قبله: "فيما نرويه عن الفقيه أبي محمد… عن أبيه" وقال على إثره: "هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن". وقال السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 48) على إثره: "وكلام ابن عتاب إلى الوجوب أقرب، وهو الظاهر من حاله، فإنّه كان كثير الاحتياط والورع" ووجهه بالنسبة إلى زمنه (ابن عتاب) وما بعده.
وفي هذا رد ضمني على ما قرّره في "التبصرة والتذكرة" (2/ 50) من أنّ أول من كتب الإجازة في طباق السماع أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي (ت 619 هـ)، قال: "فجزاه الله خيرًا في سنّه ذلك لأصل الحديث، فقد حصل به نفع كثير". قلت: في "الإلماع" (92): "وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيّين من أهل المشرق: سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاريّ، وأجاز ما أغفل وصحّف، ولم يصغِ إليه أن يروي عنه على الصحة" قال القاضي: "وهذا منزع نبيل في الباب جدّا جدّا" وعبد العزيز البخاري متقدّم جدّا عن الأنماطي. ولعلّ الأنماطي هو الذي شهر ذلك، غفر الله لهما، وأحسن إليهما، وألحقنا بهم في الصالحين.
(43) إذا عظم المجلس، وكان كثير من أكابر المحدّثين يعظم الجمع في مجالسهم جدّا حتّى ربّما بلغ ألوفا مؤلفة ويبلغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين.
(44) عبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (84): "جوز قوم رواية ذلك عن المملي، وقال المحقّقون: لا يجوز"، وعبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 365): "ذهب جماعة من المتقدّمين وغيرهم إلى جواز ذلك، ومنع ذلك المحقّقون وهذا هو الصواب"، فالخلاف قائم في هذا الفرع، وعبارة ابن الصلاح: "فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي" ونقله عن الأعمش وحماد بن زيد وابن عيينة، قال: "وأبى آخرون ذلك"، ونقله عن الثوريّ. ومنه تعلم ما في عبارة الجعبريّ في "رسوم التحديث" (108): "والصواب أن يروي ما سمعه من المبلغ عنه خلافا للأعمش وحمّاد"!
ومذاهب جميع المذكورين في "الكفاية": (72 - الأعمش) و (71 - حماد) و (72 - ابن عيينة) و (70 - الثوري) ومذهبه في "المحدث الفاصل" (601).
والذي صوّبه الجعبري هو الصواب بلا شك، خلافا للمصنّف! وقال عنه ابن كثير في "اختصار علوم الحديث": "هو القياس" ونصره العلّامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث"، (ص 117) بقوله: "هذا القول راجح عندي" وأيده بقوله: "لأنّ المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدّا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدّث به الشيخ، ولئن فعل ليردنّ عليه كثيرون ممّن قرب مجلسهم من شيخهم، وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدًّا". قلت: ترجيحه صحيح، وتأييده للمسمع الأول، دون ما بعده، والأقعد منه أن يقال: إنّ السماع حينئذٍ كالعرض سواء؛ لأنّ المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ، ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي، كالقارئ عليه، والأحوط أن يبيّن حالة الأداء: أنّ سماعه كان لذلك، أو لبعض الألفاظ من المستملي. فإن قيل: عاد الترجيح في حق المملي الأول! قلنا: لا، التأييد بمساواته بالعرض يكون كما لو وقع العرض من جمع، بخلاف تأييده بقدم الخطأ على الشيخ، فلا يكون إلا في حق الأول دون غيره، فتأمل.
نعم، يفرع على القول الأول فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه، فسأل عنها بعض الحاضرين. والذي عليه العمل هذا الذي رجّحناه، بخلاف اختيار المصنّف، وانظر لنصرته وتأييده: "التقييد والإيضاح" (177 - 178)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 55)، "فتح المغيث" (2/ 50).
(45) قال: "إذا سمعت من المحدّث ولم ترَ وجهه فلا تروَ عنه"، أسنده عنه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 599) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 137). وكأنّه يريد حديث من لم يكن معروفا، فإذا عرف وقامت عنده قرائن أنّه فلان المعروف، فلا يختلف فيه، نقله السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 152) عن بعض المتأخّرين. تلت: ويؤيّده: أنّ تتمّة مقولته عند ابن الصلاح: "فلعلّه شيطان قد تصوّر في صورته، يقول: حدّثنا وأخبرنا". قلت: اشتراط الرؤية "عجيب غريب جدّا" على حدّ تعبير ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (118)، وتعليل شعبة - إن صحّ عنه - يرد عليه بأنّ الشيطان قد يتشكّل في صورة المملي المعروف، ونقل ابن تيمية في غير كتاب من كتبه أنّ الشيطان كان يتمثّل في صورته، لما يستغيث المنقطعون في الطرقات به. انظر كتابي "فتح المنان" (ص 270 و320)، نشر الدار الأثرية.
(46) واحتجّوا بأنّ النبيَّ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - أمر بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن مع غيبة شخصه عمّن يسمعه، وبوّب عليه البخاري في (كتاب الشهادات): (شهادة الأعمى ونكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين) (6/ 191 - 193 - مع "الفتح"). ويخدش فيه بأنّ الأذان لا قدرة للشيطان على سماع ألفاظه، فكيف بقوله، أفاده السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 52). والأمر ليس خاصًّا بأمّهات المؤمنين، بل هو في حقّ من بعدهنّ ممّن شاركن في إملاء الحديث، وإيّاك أن تغتر باستدلال يوسف هوروفش (المستشرق الالماني) في كتابه "المغازي الأولى ومؤلفوها" (ص 42، 78، 79) بذلك على وجود الاختلاط العام بينهما منذ فجر الإسلام! فإنّه غفلة عن هذا الأصل، وينظر كتابي "عناية النساء بالحديث النبوي"، "الحافظ العراقي وأثره في السنة" (1/ 386).
وينظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 58)، "توضيح الأفكار" (2/ 308).
(فائدة) ذكر صاحب "فتح الملهم" (2/ 64) عن ابن حجر - وهو الهيثمي ووجدتها في "الإجازة في علم الحديث" له (ق 3/ أ - بنسخة شستربتي) - عن بعض المحدّثين أنّه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، لكنّه كان يجعل بينه وبينه حجابا، ولم يرَ وجهه، فلما طالت ملازمته له، ورأى حرصه على الحديث، كشف له السر، فرأى وجهه وجه حمار، … إلخ القصة، وهي لم تصحّ، وغفلت عن ذلك، فذكرتها في كتابي "القول المبين" (ص 261)، وانظر لوهائها كتابي "قصص لا تثبت" (8/ 263 - 264).
(47) لأنّه قد حدّثه، وهو شيء لا يرجع فيه، فلا يؤثر منعه، وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح؛ لأنّ الشهادة على الشهادة لا تصحّ إلّا مع الإشهاد، ولا كذلك الرواية، فإنّها متى صحّ السماع، صحّت بغير إذن من سمع منه، وحقّ الشهادة خاص والرواية عام، فتبليغها أقوى من مراعاة من منعها، انظر: "المحدث الفاصل" (452)، "الإلماع" (110 - 112)، "فتح المغيث" (2/ 53)، "المنهل الروي" (84)، "رسوم التحديث" (108).
(48) وعن النسائي ما يؤذن بالتحرّز منه في روايته عن الحارث بن مسكين، وتقدّمت، وانظر: "المنهل الروي" (84)، "الكفاية" (348 - 349)، "فتح المغيث" (2/ 54) وفيه: "لكنّه لا يحسن في الأداء أن يقول، حدّثني، ونحوها، ممّا يدلّ على أنّ الشيخ رواه".
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)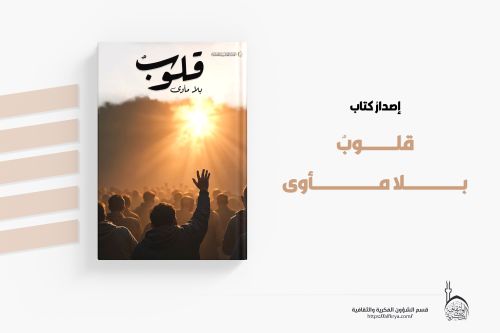 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)


















