

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
علوّ الإسناد ونزوله
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 394 ـ 405
2025-07-03
16
الفصل الثالث: فيما يقع في الإسناد من العُلوِّ والنُّزولِ وغيِرهما.
وفيه تسعة أنواع:
* [أنواع العلوّ والنُّزول]:
النوع الأول: في عُلوِّ الإسناد ونزولهِ، وفيه طرفان:
الطرف الأول: في علو الإسناد، وهو على خمسة أقسام (1):
* [أنواع العلوّ]:
الأول: القُرْبُ من رسولِ الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - بإسنادٍ نظيف غيرِ ضعيفٍ.
الثاني: ما ذكره الحاكم أبو عبد الله (2)، وهو القُربُ من إمامٍ من أئمَّة الحديث، وَإِنْ كَثُر العددُ من ذلك الإمام إلى رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -.
الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية "الصَّحيحين"، وغيرِهما من الكتب المعروفةِ المعتمدِ عليها.
وقد اشتهر من هذا القسم أجزاء الموافقات، والأبدال، والمساواة، والمصافَحات.
* [الموافقة]:
أمّا الموافقة فهي أن يقعَ لَك حديثٌ عن شيخِ أحد الأئمّة كشيخ مسلم عاليًا من غير طريق مسلم بعدد أقلّ من العدد [الذي] (3) يقع لك به عن ذلك الشَّيخِ لو رويتَه عن مسلمٍ.
* [البدل]:
وأمّا البدل فهو أن يرويَ البخاريُّ مثلًا حديثًا عن قُتيبة، عن مالك، عن نافع، وأنتَ تروي ذلك الحديثَ من غير جهةِ البُخاريِّ، عن أبي مُصعبٍ، عن مَالكٍ، فيكون أبو مُصعب بدلًا عن قُتيبة، ويشترط فيه [أن يكون] (4) إسنادُك إلى مالكٍ عاليًا أيضًا(5).
* [المساواة]:
وأمّا المساواة فهي أن يقعَ في إسنادكِ إلى صحابيٍّ، أو إلى رسولِ الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - من قلَّة العدد مثل ما يقع لإمام من الأئمّة، كمسلم مثلًا بينه وبين الصحابي، أو بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، فتكون مساويًا لمسلم في قُرب الإسناد، وعدد رجاله (6).
* [المصافحة]:
وأمّا المصافحة فهي التي وقعت لهذه المساواة لشيخك لا لك، فيقع لشيخك المساواة ولك المصافحة وكأنّك لقيتَ مسلمًا وصافحتَهُ بلقائك شيخك، وإِن كانت المساواةُ لشيخ شيخك كانت المصافحةُ لشيخِك، فتقول: كأنّ شيخي سمع مسلمًا وصافحه (7).
الرابع: من علوِّ الإسناد، وهو المستفاد من تقدَّم وفاة الراوي، فهو أعلى من إسناد آخر فيه تأخُّر وفاة الراوي، وإِن كان متساويين في العدد، مثل ما روي عن المشايخ، عن الحافظ البيهقي، عن الحاكم أبي عبد الله، فهو أعلى ممّا يرويه عن المشايخ، عن ابنِ خَلَف (8)، عن الحاكم، وإنْ تسَاويا في العدد لتقدُّم وفاة البيهقي على وفاة ابنِ خلف؛ لأنّه مات سنة ثمان وخمسين وأربع مئة، وابن خلف مات سنة سبع وثمانين وأربع مئة (9).
الخامس: العلو المستفاد من تقدُّم السَّماع، وذلك بأن سمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما قبل الآخر بزمان، فإذا تساوى السند إليهما بالعدد فيقال لمن تقدَّم سماعه أعلى (10).
* [معنى آخر للعلو]:
وقد يُطلقُ علوُّ الإسناد ويراد به صحَّته (11) على ما روي عن الحافظ أبي الطَّاهر السِّلفي في قوله (12):
"بل علوُّ الحديث بين أولي الحفـ *** ـــظ والإتقان صحَّةُ الإسنادِ".
والمتعارف ما ذكرناه، وقد بيَّنا أنَّ ذلكَ في إسنادٍ غيرِ ضعيفٍ (13) في (القسم الأول).
* [طلب العلو سنّة ودليله]:
وطَلَبُ الإسنادِ العالي سُنَّةٌ، وورد به حديثٌ صحيحٌ، قد رُوِّينَاهُ في "صحيح مسلم"(14)، عن ثابت، عن أنس قال: "كنَّا (15) نُهِيْنَا أنْ نَسْأَلَ رسولَ الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - عن شَيءٍ، فكان يُعْجبُنا أنْ يأْتِيَه (16) الرَّجُلُ من أهل البَادِية(17) فيسْأَلَه ونحنُ نسْمَعُ، فَأَتَى رجلٌ منهم (18) فقال: يا مُحمَّد! أتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَم أنَّكَ تَزْعُمُ أنَّ اللهَ أرْسلَكَ، قَالَ: صَدَق، قال: فَمَنْ خَلَق السماءَ؟ قال: الله، قال: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قال: الله، قال: فَمَنْ نَصَبَ فيها (19) هذه الجبال (20)؟ [قال: الله، قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟] (21) قال: الله، قال: فبِالَّذِي خَلَقَ السَّماءَ والأرْضَ(22)، ونَصَبَ الجبال(23)، [وجعل فيها هذه المنافع] (24) الله أرْسَلَكَ؟ قَال: نَعَم، وقال(25): وَزَعَم رَسُولُك أنَّ علينا خَمْسَ صَلَواتٍ في يوِمِنا ولَيْلَتِنا؟ قَالَ: صَدَق، قال: فبالذي أرْسَلَك اللّهُ أَمَرَكَ بِهَذا؟ قَالَ: نعَم، قال: وَزَعَمَ رَسُولُك أنَّ عَلَينا صدقة (26) فيِ أموالنا؟ قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك اللّهُ أَمَرَكَ بِهَذا؟ قَالَ: نعَم، قال: وَزَعَم رِسُولك أنَّ عَلَينا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَان في سَنَتِنَا؟ قال: صَدَق، قال: فَبِالّذِي أَرْسَلَك اللّه أَمَرَك بِهَذا؟ قَالَ: نَعَم، قال: وَزَعَمَ رَسُولُك أنَّ عَلَينا حَجَّ البيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيه سَبيلًا؟ قال: صَدَق، [قَال: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللّهُ أَمَرَكَ بِهذا؟، قَالَ: نَعَم]، (27)، قال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أَزِيدُ عَلَيهنَّ ولا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَلَمَّا مَضَى قال (28): لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ"(29).
* [توجيه الدليل]:
وَوَجْهُ الاستدلالِ به أَنَّ البَدَوِيَّ لمَّا جاءَه رَسُولُ رسولِ الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - فأخبَرَهُ بما فَرَضَ الله عليه لم يُقْنِعْهُ ذلك حتّى رَحَلَ بنفسه إلى رسولِ الله - صلّى الله عليه [وآله] وسلم -، وسَمِعَ منه ما بلَّغَهُ الرَّسُول عنه بلا واسطة، ولو كان طَلَب عُلوِّ الإسناد غيرَ مُسْتَحبٍّ، لأنكرَ عليه النبيُّ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - سؤاله إيّاه عمّا أخبره رسولهُ عنه، ولأَمره بالاقتصارِ على ما أخبرَه الرَّسولُ عنه(30)، والله أعلم.
* [أهمّيّة الإسناد]:
وعن ابن المبارك أنّه قال: "الإسناد من الدِّين، لولا الإسنادُ لقَالَ مَن شاء ما شاء"(31).
وعنه أنّه قال: "الذي يطلب أمر دينه بلا إسنادٍ، كَمَثل الذي يَرْتَقي السَّطَح بلا سُلَّم"(32).
وعن أحمد الإمام: "طَلَبُ الإسنادِ العالي سُنَّةٌ عمَّن سَلَف" (33).
[النزول في الإسناد]:
الطَّرف الثَّاني: في نزول الإسناد، هو ضد العلوِّ في كلِّ قسمِ من الأقسام الخمسة، وتفصيلُها يُعرف ممّا قدَّمناه.
* [المفاضلة بين العلوّ والنزول]:
ثم الفضيلة للعلوِّ، والنُّزولُ مرغوبٌ عنه (34).
وقد رُويَ عن عَليٍّ بن المدينيٍّ، وأبي عَمرو المسْتَملي النَّيسابوريِّ أنَّهما قالا: "النزول شؤمٌ" (35).
وهذا يُحمَل على بعض النُّزول، لجواز اختصاصِ بعض النُّزول بفائدةٍ لا تُوجَد في العُلوِّ، فحينئذٍ يكون مختارًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظرها في "مسألة العلو والنزول في الحديث"، للإمام ابن طاهر المقدسي (ت 507 هـ)، مع مقدّمة محقّقه الفاضل الشيخ صلاح مقبول، وينظر كتابي "البيان والإيضاح" (ص 144 - 147) ومن لطيف ترتيب المصنّف أنّه وضع (العلو) عقب (التدليس)؛ لأنّ قومًا دلَّسوا بسبب إظهار العلو، وروى بعضهم عن ضعفاء بسببه، ووقع هذا لأئمّة أعلام.
(2) في "المعرفة" (ص 124).
(3) غير موجودة في الأصل، والسياق يقتضيها، وهي مثبتة عند ابن الصلاح.
(4) غير موجودة في الأصل، والسياق يقتضيها.
(5) اخترع ابنُ دقيق العيد له اسم (علو التنزيل)، أفاده الأبناسي في "الشذا الفيّاح" (2/ 424). ومثاله: حديث "إذا جاوز الختان الختان" يرويه أحمد في "المسند" (6/ 161) عن الوليد بن مسلم، بينما أخرجه أصحاب "السنن الأربعة" بأسانيد مختلفة، كلّ منهم عن شيخ له عن الوليد، فلمّا ساقه ابن حجر بسنده في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 279 - 280) من طريق أحمد عن الوليد، قال: "وقع لنا بدلًا عاليًا".
(6) كان هذا يوجد قديمًا، قاله السيوطي في "التدريب" (2/ 167)، وزاد: "وأمّا الآن فلا يوجد في حديث بعينه، بل يوجد مطلق العدد".
قال أبو عبيدة: وبانقطاع الإملاء، ومجالس التحديث انعدم هذا الحال من هذا النوع من أنواع العلو، كغيره، ولا قوة إلَّا بالله.
(7) العلو في المصافحة علوٌّ نسبيّ، لانتفاء النزول فيها؛ لأنّ العادة جرت بالمصافحة بين مَنْ تلاقيا.
(8) هو أبو بكر الشيرازي ثم النيسابوري، واسمه: أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف (ت 487 هـ)، ترجمته في "السير" (18/ 487).
(9) الإرشاد (2/ 535) للنووي، وكتابي "البيان والإيضاح" (148).
(10) مثَّل عليه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص 270) بسماع ابن بنت السِّلفي، واسمه عبد الرَّحمن بن بكر بن عبد الرَّحمن الطرابلسي المعروف بـ(ابن الحاسب) (ت 651 هـ)، وسمع من جدّه أبي الطاهر السلفي، وإليه علو الإسناد بالديار المصريّة، وسماع أبي الحسن علي بن المفضَّل اللخمي المقدسي (ت 611 هـ) من أبي الطاهر أيضًا، فالمقدسي أقدم سماعًا من ابن بنت السِّلفي؛ لتقدُّم وفاته عليه بأربعين سنة، فإذا سمع اثنان عن السَّلفي، أحدهما بواسطة المقدسي والآخر بواسطة ابن ابنته، فالأول يعدّونه علوًّا، ويثبتون له مزيَّةً في الرواية، وأهمل ابن حجر في "النخبة" و"شرحها" هذا النوع؛ لعدم ظهور ثمرته، ولخفاء تأريخ الوفيات، والاختلاف فيها، ولحصول التغيُّر والاختلاط عند المتقدّم في السن، فالمساواة من حيث الصحّة متفاوتة، والترجيح لا يكون للعلوّ دائمًا، كما سيأتي، وانظر كتابي "البيان والإيضاح" (ص 148 - 149).
(11) مِن العلماء مَن يعدُّ العلو: الإتقان والضبط، وإن كان نازلًا في العدد، وهذا علوٌّ معنويّ، والأول صوري.
وممّن قال بهذا أبو طاهر السَّلفي، ونظم فيه - كما نقله المصنّف - وكان يقول: "الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من علو الجهلة على مذهب المحقّقين من النقلة، والنازل حينئذٍ هو العالي عند النظر والتحقيق".
ومثله: قول نظام الملك الوزير الصالح (ت 385 هـ): "عندي أن الحديث العالي ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -"، وإن بلغت رواته مئة"! وليس هذا - على التحقيق - من قبيل العلو المتعارف إطلاقه عند المحدِّثين، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب، انظر "المقنع" (2/ 425)، "فتح المغيث" (3/ 24).
ويعجبني تعقّب ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (2/ 452) لنظام الملك لمّا قال: "وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صحَّ الإسنادان، لكن هذا أقرب رجالًا" نعم، النزول مفضول بالنسبة إلى العلو، ورعايته عند تعارض الصحة أولى، قال عبيد الله بن عمرو: "حديث بعيد الإسناد صحيح، خير من حديث قريب الإسناد سقيم، أو قال: ضعيف" انظر "الجامع" للخطيب (1/ 124) كتابي "البيان والإيضاح" (149).
(12) أسنده التقي ابن رافع السلمّي في "فوائد حديثية" (ق 17/ ب - التيمورية) عن أبي الطاهر السِّلفي ضمن ثلاثة أبيات، هو الثاني، وقبله:
ليس حُسْنُ الحديثِ قُرْب رجالٍ … عندَ أرباب علمِه النُّقادِ
وبعده: فإذا ما تجمعا في حديث … فاغْتنِمْهُ، فذاك أقصى المرادِ
(13) ميزة العلو وفضله أنّ وسائطه قليلة، فهو أقرب إلى الصحّة من غيره، ولذا رحل العلماء في الطلب، وسافر بعض المقتدى بهم في هذا الشأن إلى الآفاق طلبًا للعلو، وفرارًا من النزول، حتّى قال ابن معين: "الحديث بنزول كالقرحة في الوجه"، ذكره ابن القيسراني في "مسألة العلو والنزول في الحديث" (ص 55)، وقال قبله: "فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول، لم يرحل أحدٌ منهم". ومنهم من فضَّل النزول بإطلاق، لكثرة الوسائط، ويستلزم هذا كثرة البحث، وهذا مستلزم لمزيد التعب والمشقة، وهو قائم على اطّراد قاعدة (الأجر على قدر المشقّة) وهي ليست على إطلاقها، فيما قرّره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (10/ 620 - 621)، وبيَّنتُه بما لا مزيد عليه في تعليقي على كلام العز ابن عبد السلام في " قواعد الإحكام" فقرة (217)، فمطلق التفضيل غلط، وصوابه التفصيل: فإذا كان النزول فيه إتقان وضبط، والعلو ليس كذلك، فبلا شك هذا الصواب؛ لأنّ المقصود من الرواية الصحّة فحسب، ولذا قال ابن معين: "النزول خير من علوِّ من غير ثبت"، ولهذا المعنى قال بعض الزهّاد: "طلب العلوّ من زينة الدنيا" قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (266) على إثره: "وهذا كلام واقع، وهو الغالب على الطالبين اليوم" وهذا مذهب الجماهير، كما تراه في "فتح المغيث" (3/ 8)، و"توضيح الأفكار" (2/ 400).
(14) برقم (12).
(15) ساقه مسلم بلفظين، الثاني منهما: "كنّا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - عن شيء"، قال: "وساق الحديث بمثله". واللفظ الأول هو المطوّل، وبينه وما عند المصنّف فروق، ننبّه عليها في الهامش، وليس في أوّله "كنّا" مثل ما أورده.
(16) عند مسلم: "يجيء".
(17) بعدها عند مسلم: "العاقل".
(18) في "صحيح مسلم": "نسمع، فجاء رجل من أهل البادية".
(19) لا وجود لها في مطبوع "صحيح مسلم".
(20) بعدها في "صحيح مسلم": "وجعل فيها ما جعل".
(21) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع "صحيح مسلم".
(22) في مطبوع "صحيح مسلم": "وخلق الأرض".
(23) في مطبوع "صحيح مسلم": "هذه الجبال".
(24) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع "صحيح مسلم".
(25) في "صحيح مسلم": "قال" دون واو في أوّله.
(26) في مطبوع "صحيح مسلم": "زكاة".
(27) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع "صحيح مسلم".
(28) في مطبوع "صحيح مسلم": "منهن، فقال النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -"دون "فلمّا مضى" ولعلّ اللفظ الذي ساقه المصنّف هو اللفظ الذي اختصره مسلم، وهذا سنده: حدّثني عبد اللَّه بن هاشم العبدي حدثنا بَهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنّا نُهينا … إلخ.
وجمع الألفاظ التي ساق مسلم أسانيدها دون ألفاظها باب مهم، وهو مغفّل! إلَّا ما جاء عرضًا، ولا سيما في "المستخرجات" عليه وله فوائد، وقبل شدّ النفس في التخريج للوقوف على اللفظ المذكور هنا، فحصت لفظ الحاكم في "المعرفة" - والمصنف كثير الاعتماد عليه - فوجدته فيه (ص 112 - 113 - ط السلوم) بألفاظه، وهو من طريق محمد بن إسحاق الصَّغاني عن أبي النضر حدثنا سليمان بن المغيرة به.
وأبو النضر هو هاشم بن القاسم، وهو شيخ شيخ مسلم في الرواية الأولى التي ساق مسلم لفظها، وقابلنا عليها، ومنه يعلم عدم الدّقة التي توهّمتها من صنيع المصنف من سياقه لفظ مسلم في الرواية الثانية التي اكتفى مسلم بسوق إسنادها! وينظر للفظ بهز: "مسند أحمد" (3/ 193). وينظر "تحفة الإشراف" (1/ 287 - ط دار الغرب) و"إتحاف المهرة" (1/ 523 - 524).
(29) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (63) أيضًا، فهو متفق عليه.
(30) هذه عبارة الحاكم في "المعرفة" (ص 113 - 114 - ط السلوم).
وقال ابن حجر في "الفتح" (1/ 191 - ط دار الحديث): "استنبط منه الحاكم أصل طلب علوِّ الإسناد؛ لأنّه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنّه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - مشافهة، ويحتمل أن يكون قوله: "آمنت" إنشاء، ورجّحه القرطبي لقوله: "زعم" قال: والزعم القول الذي لا يوثق به، قاله ابن السكّيت وغيره. قلت: وفيه نظر؛ لأنّ الزعم يطلق على القول المحقّق أيضًا كما نقله أبو عمر الزاهد في "شرح فصيح شيخه ثعلب"، وأكثر سيبويه من قوله "زعم الخليل" في مقام الاحتجاج، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي، وأمّا تبويب أبي داود عليه: "باب المشرك يدخل المسجد" فليس مصيرًا منه إلى أنّ ضمامًا قدم مشركًا بل وجهه أنّهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال، وممّا يؤيد أنّ قوله "آمنت" إخبار أنّه لم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام، ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق، قاله الكرماني، وعكسه القرطبي فاستدلّ به على صحّة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح، والله أعلم".
وقال ابن طاهر في "مسألة العلو والنزول" (ص 53) بعد إسناده هذا الحديث: "فهذا دليل على طلب المرء العلوَّ من الإسناد، والرحلة فيه، فإنّ هذا الرجل المكّنى عن اسمه في هذا الحديث، هو ضمام بن ثعلبة، لمّا جاءه رسولُ رسولِ الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - فأخبره بما فرض عليهم، لم يقنعه ذلك، حتّى وصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع منه". وانظر: "فتح المغيث" (3/ 5 - 7)، "تدريب الراوي" (2/ 160 - 161).
(31) أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 16) ومسلم في (مقدمة) "صحيحه" (1/ 15) والترمذي في "العلل الصغير" (5/ 740 - آخر "الجامع") والحاكم في "المعرفة" (ص 114) وفي "المدخل" (ص 135) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (209) وابن حبان في مقدمة "المجروحين" (1/ 26) والخطيب في "الكفاية" (2/ 450، 452، 453) و "تاريخ بغداد" (6/ 166) و "الجامع" (2/ 213 - الطحان) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 194) والهروي في "ذم الكلام" (4/ 214 رقم 1016) وابن عبد البر في (مقدمة) "التمهيد" (ص 56) والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (رقم 16) وابن طاهر المقدسي في "مسألة العلو.
والنزول" (رقم 6) وابن خير في "فهرسته" (12) والذهبى في "السير" (17/ 224) وفي "تذكرة الحفاظ" (3/ 1054).
(32) أخرجه الهروي في "ذم الكلام" (4/ 215 رقم 1017) والخطيب في شرف أصحاب الحديث" (رقم 74) وفي "الكفاية" (2/ 452) والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (رقم 14).
(33) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1/ 123).
(34) قال ابن طاهر في "مسألة العلو والنزول" (ص 54): "فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول، لم يرحل أحد منهم، ثم وجدنا الأئمّة المقتدى بهم في هذا الشأن سافروا الآفاق في سماعه، ولو اقتصروا على النزول، لوجد كلّ واحد منهم ببلده من يخبره بذلك الحديث، ولو شرعنا في ذكر من مدح العلو، ونعت مَن رحل فيه، وأقاويلهم في ذلك، تجاوزنا حدَّ الاختصار، إلَّا أنّ المميّز يستدلُّ برواياتهم على سفرهم". وانظر لزامًا ما قدمناه في التعليق على (ص 397 و398).
(35) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1/ 123) عنهما، وابن طاهر القيسراني في "مسألة العلو" (55 - 56) عن ابن المديني قوله. وانظر "الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال" (654).
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)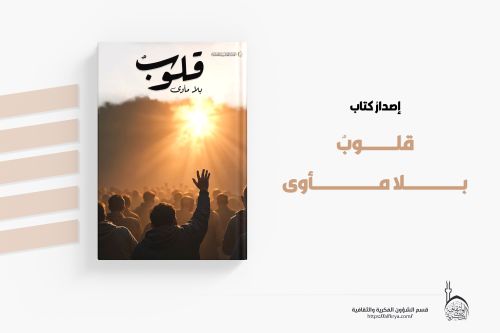 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)

















