

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
التدليس وحكم المدلّس
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 384 ـ 393
2025-07-02
27
النوع الثالث: التدليس وحكم المدلّس.
* [أقسام التدليس]:
أمّا التدليس فقسمان (1):
* [تدليس الإسناد]:
الأول: تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمّن لقيه ما لم يسمعه منه، أو من عاصره ولم يلقه (2)، موهما أنّه قد لقيه وسمعه، وإنّما يكون تدليسًا إذا لم ينصَّ في روايته على سماعه منه، أمّا إذا نصَّ فهذا كذب (3)؛ لأنّه لم يسمعْه، فلا يُسمَّى تدليسًا بأن يقول في روايته: أخبرنا فلان، أو حدَّثنا فلان، أو سمعتُ عن فلان، وإنّما يكون تدليسًا إذا قال: قال فلان، أو عن فلان، ونحو ذلك.
مثاله: ما روي عن عَليِّ بن خَشْرَم قال: كنّا عند ابن عيينة فقال: الزهري، فقيل له: حدَّثكم الزُّهري، فسَكَت، ثم قال: الزهريّ، فقيل: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهريّ، ولا ممّن سمع من الزهريّ، حدَّثني عبد الرزّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ (4).
قلت: هذا النَّوعُ هو المنقطعُ يجب الحكمُ بضَعفه (5)، والله أعلم.
* [تدليس الشيوخ]:
الثاني: تدليس الشَّيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه، ويُسمِّيه، أو يُكنّيه، أو يصفه بما لا يُعرف، كي لا يُعرف (6).
* [حكم التدليس]:
وأمّا القسم الأول فمكروهٌ جدًّا، وكان شُعبةُ من أشدِّهم ذمًّا له (7).
وقال الشَّافعيُّ الإمامُ: "التدليس أخو الكذب" (8).
* [حكم المدلِّس]:
أمّا حُكم المدلِّس، فقد اختلفوا في قبول رواية مَنِ اشتهر بهذا التَّدليس، فجعله فريقٌ من المُحدِّثين مَجروحًا بذلك، والصَّحيح التفصيل (9)، في رواه بلفظٍ محتملٍ لم يبيِّن فيه السَّماعَ والاتِّصال حكمهُ حكمُ المرسل (10)، وما رواه بلفظٍ مبيِّن للاتِّصال نحو: سمعت، وحدّثنا، وأخبرنا؛ فهو مقبول محتجٌّ به.
وفي "الصحيحين" وغيرهما من الكتب المعتبرة من حديث هذا الضَّرب كثير جدًّا(11)، كقتادة، والأعمش، والسَّفيانَينِ، وهُشيم، وغيرِهم، لأنَّ التَّدليس ليس كذبًا، وإنّما هو ضَرْبٌ من الإيهام بلفظٍ محتملٍ.
ثم الحكمُ بأنَّه لا يُقبل من المدلِّس حتّى يبيِّن، أجراه الشافعي الإمام فيمن عرف دلَّس مرّة (12).
قال الشيخ محيي الدين: "ما كان في "الصحيحين" وغيرهما من الكتب الصحيحة من المدلِّس بعن محمولٌ بثبوت سماعه من جهةٍ أخرى" (13).
* [مفسدة التدليس]:
وقال قاضي القُضَاة تقيُّ الدِّين: "وللتَّدليس مَفْسَدة إذ يصير الراوي مجهولًا، فيسقط العملُ بالحديث؛ لجهالة الراوي، وإنْ كان عدلًا في نفس الأمر، وله مصلحةٌ، وهو امتحان النَّفس في استخراج التَّدليسات" (14).
وأمّا القسم الثاني فأمرُه أخفُّ (15) وفيه تضييعٌ للمرويّ عنه، وتوعيرُ طريقِ معرفتهِ(16) على مَنْ يطلبُ الوقوفَ على حالهِ.
* [عودة إلى حكم التدليس]:
وتختلف كراهيةُ ذلك بحسب الغَرَضِ الحاملِ عليه (17)، فقد يكونُ لأجلِ أنَّ شيخَه غيرُ ثقةٍ، أو أصغرُ من الرَّاوي عنه، أو متأخِّرُ الوفاة قد شاركه في السَّماع منه جماعة دونه، أو كونُه كثيرَ الرِّواية عنه، أو رواه عنه ولا يحبّ تكرار شخصٍ على صورةٍ واحدة، وقد تسمَّح بهذا القسم الحافظ أبو بكر الخطيب (18) وغيرُه من المصنِّفين(19).
قلت: وتسامحهم هذا إنّما يجوزُ إذا لم يكن الشَّيخ المكنيُّ عنه ليس (20) هالكًا ساقطًا، وأمّا التَدليس عن مثل الكذَّابين الوضَّاعين كمحمَّد بن سعيد المصلوبِ الزِّنديقِ، صَلَبه المنصورُ في زَنْدَقَتهِ، فلا يجوزُ أصلًا (21).
قال عبد الله بن أحمد بن سوادة: "قلَب أهلُ الشَّام اسمَه على مئة اسم" (22).
وقال أبو الفرج الحافظ: "والذي وصل إلينا من تدليسهم تسعة عشر وجهًا" (23)، والتَّدليس عن مثل هذا بعد المعرفة بحاله لا يجوز أصلًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جعله الحاكم ستّة أقسام، وتبعه عليه أبو عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث"، (ص 136 - 158 - بتحقيقي) ووضّحتها ووجّهت الأمثلة المسوقة عليها في شرحي على جزء أبي عمرو المسمّى "بهجة المنتفع" (ص 370) وهو منشور، ولله الحمد والمنّة. وانظر "محاسن الاصطلاح" (232) وفيه: "الأقسام الستّة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين...".
(2) هذا هو الإرسال، وكان الأقدمون يطلقونه على (التدليس)، والفرق بينهما أنّ الإرسال لا يوهم السماع، بخلاف التدليس فهو يُوهمه، فلمّا أضيف لعدم السماع المعاصرة أوهمه من هذا الوجه، فألحقوه بالتدليس. وانظر كتابي "بهجة المنتفع" شرح فقرة (119) واعترض على قيد "من عاصره ولم يلقه" وانظر تطويلًا في رد هذا الاعتراض: "المرسل الخفي" (1/ 85 وما بعد).
(3) للتدليس طرق وعرة، وقد يقع إيهام التصريح بالسماع في تدليس (العطف) أو (السكوت) أو (القطع)، وكان يفعله (عمر بن علي المقدَّمي) قال ابن سعد في "طبقاته" (7/ 291) عنه: "كان يدلّس تدليسًا شديدًا، وكان يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش" وتنظر ترجمة (عمر بن عبيد الطنافسي) في "الكامل" لابن عدي (6/ 124 - ط دار الكتب العلمية). وكان بعض الرواة يتوسع في المناولة والإجازة، ويلحقها بالسماع، كابن جريجٍ مثلًا، انظر "العلل" للترمذي (2/ 753) و"السير" (6/ 331) والتعليق على "الفوائد المجموعة" (ص 43)، فهؤلاء يقولون "حدثنا" فيما لم يسمعوه، وليس هو بالكذب الصراح! وكذا صنيعه في روايته من غير كتاب وصحيفة، انظر "المجروحين" (3/ 142)، "الجرح والتعديل" (5/ 357)، وينظر في بابته: "الكامل" (1/ 289)، "الجعديات" (3474 - ط رفعت). وأخيرًا؛ قد يقع تغيير في أدوات التحمل من بعض الرواة، فيقول الثقة حدثنا ممن لم يسمعه، وهو ليس بكاذب، فخطأ "حدثنا" من بعض الرواة عنه، وتفطن لهذا جمع من حذَّاق أهل الصنعة، انظر أمثلة عليه في "فتح الباري" (8/ 255)، "شرح علل الترمذي" (1/ 369 و 2/ 591 - 594) كلاهما لابن رجب. وقد يقع تسامح في لفظة (حدثنا)، فيقع التصريح بالتحديث ولا يكون الإسناد متصلًا بالسماع، انظر "فتح الباري" (3/ 54، 94 - 95) لابن رجب.
(4) أخرجه الحاكم في "المدخل" (ص 70) و"المعرفة" (رقم 241 - ط السلوم) ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (رقم 1157 - ط الدمياطي) وأبو عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث" (رقم 91 - بتحقيقي).
واشتهر عن ابن عيينة أنّه لم يدلس إلَّا عن ثقة، وأنّه لا يفعل ذلك غيره! وأنّ عنعنته وتصريحه بالسماع سواء، وهذا كله غير دقيق، فهناك آخرون لا يدلّسون إلَّا عن ثقات، ولكن ابن عيينة لم يدلس إلَّا عن ثقة مثله، وكان إذا روجع وسئل عمَّن حدّثه بالخبر، نصّ على اسمه، ولم يكتمه، كما وقع له في هذا المثال، قال ابن حبّان في (مقدمة) "صحيحه" (1/ 150) لما ذكر من لم يدلس إلَّا عن ثقة: "وهذا ليس في الدنيا إلَّا سفيان بن عيينة وحده فإنّه كان يدلّس ولا يدلّس إلَّا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلَّس فيه إلَّا وُجد ذلك الخبر بحينه قد بيَّن سماعه عن ثقة مثل نفسه"، وانظر "كشف الأسرار" للبخاري (3/ 70 - 71)، "بهجة المنتفع" (ص 384).
(5) إيراد هذا التقرير عقب مثال فيه تدليس ابن عيينة ليس بدقيق، اللهمّ إلَّا إذا دخلت عليه قيود، وينظر الهامش السابق.
(6) يدخل في هذا القسم تدليس التسوية أيضًا، بأن يصف شيوخ السند بما لا يعرفون به من غير إسقاط، فيكون تسوية الشيوخ، كذا في "النكت الوفية" (ق 143 / ب).
قلت: وأما إسقاط المدلس مَنْ بعد شيخه إن كان ضعيفًا، فهو شر أنواع التدليس، وهو يلحق بالقسم الأول، وهو الذي يطلق عليه (تدليس التسوية).
ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ (تدليس البلاد)، كما إذا قال المصري: حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعًا بالقرافة، وجلُّ أمثلته نظرية واحتمالية، وأثره غير ظاهر ظهور الأنواع السابقة في التطبيق العملي.
(7) أوردت أقواله في ذمّه، مع توجيهها، وتعقّب من حملها على التجوّز في كتابي "بهجة المنتفع" (ص 371)، وذكرتُ فيه من (وصم) شعبة بالتدليس، ودافعت عنه.
(8) ظفرت بها عن الشافعي عن شعبة، أخرجها بسند صحيح له: الخطيب في "الكفاية" (508) وابن عدي في مقدمة "الكامل" (1/ 47) والبيهقي في "مناقب الشافعي" (2/ 35) وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 107). وبعد إثبات هذا وجدت في هامش الأصل ما نصه: أعلق هذا بالشافعي، وإنما رواه عن شعبة".
(9) نعم، الصحيح التفصيل، إذ ليست أغراض المدلِّسين محصورة في النوع المذموم، وإنّما لهم أغراض أخرى، باعث بعضها الخير، ولا سيما عند التابعين، حتّى قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 340) عن تدليس التابعين: "إنّ غرضهم من ذكر الرواية أن يدعوا إلى الله (عزَّ وجَلَّ)" قال: "فكانوا يقولون: قال فلان لبعض الصحابة"، قال: "فأمّا غير التابعين، فأغراضهم فيه مختلفة".
فكان همُّ التابعين تبليغ ما تحمَّلوه من السُّنَّة، ونشرها، ليعمل مَنْ بعدهم بها، وبلَّغوها إليهم بأقرب طريق وأسهله، رغبة في الاختصار، فنسبوها إلى أعلى من تنسب إليه من الثقات، دون مراعاة لأدوات التحمّل، وتسلسل الرواة، ولا سيما أنّ بعض الناس في زمنهم صُبغوا بغير الفطرة، وحادوا عن الجادّة، واجتالتهم البدع، وأصبح - يا للأسف - بعض الرواة من الصحابة وتلاميذهم (أعلى طبقة في التابعين) غير عدول عندهم، فلم يكن - بالجملة - همُّ من دلَّس من التابعين ما عُرف عند المتأخِّرين من الرواة، وتوسَّعوا فيه؛ إذ كان يدلّس الواحد من المتأخّرين ويغيِّر اسم من سمع منه لكونه أصغر سنًّا منه، أو كونه حيًّا، أو إيهامًا للسامعين بكثرة الشيوخ، أو تفنّنًا في العبارة. فهذه الأغراض متفاوتة، ولذا المدلِّسون على طبقات، ويختلف حكم التدليس بحسب الباعث عليه من جهة، والأثر المترتب عليه من جهة أخرى، وهو يشبه حكم التعريض عند الفقهاء، يقول محققوهم: متى كان البيان واجبًا كان التعريض حرامًا، فإذا كان مسنونًا، فهو مكروه، فإذا كان حرامًا، فالتعريض واجب، وإذا كان مكروهًا، فهو مسنون، انظر "إعلام الموقعين" (5/ 180 - بتحقيقي).
وهكذا التدليس، فهو من باب قول ابن سيرين: "العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف".
قال ابن الصلاح في "علومه" (68) عن التدليس: "ويختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه".
ومن أشنع وأبشع وأفظع أنواعه: تدليس التسوية، وهو أن يروي المدلّس حديثًا عن شيخ ثقة، بسندٍ فيه راوٍ ضعيف، فيحذفه المدلّس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر، ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل، فيسوّي الإسناد كلّه ثقات، وهذا النوع لا يقبل فيه تصريح المدلّس بالسماع من شيخه، وإنّما لا بدَّ من تصريح جميع مَنْ فوقه بالسَّماع أيضًا.
ويلحق به في السوء أن يكون عند الراوي حديثين بإسنادين مختلفين، فيرويهما بأحدهما، وكذا أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق، وهذا يسمَّى (تدليس المتون)!
وسبب سوء التسوية أنّه باب لترويج الكذب، وسبب سوء تدليس المتون أنّه مدعاة لأن يقع الغير في الكذب على رسوله الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -.
وذمُّ العلماء للتدليس مشهورٌ، وكان أكثرهم كراهة له - كما قال المصنّف قبلُ - شعبة، ولذا تكرّرت عبارته واشتهرت.
(10) فهو على هذا الحال عيب في الرواية، وليس في الراوي، ولكن هذا ليس على إطلاقه، نعم، هو كذلك ما لم يؤثر على مرويات الراوي بصفة عامة، وأنّه إن صرح بالسماع زالت تهمة التدليس، هذا كله حق، ولكن إذا كثر وكان المدلس يسقط الثقات ويتعمد ذلك في باب الرواية لا في المذاكرة، وكان في حفظه شيء، وأكثر من التدليس ولا سيما عن المجاهيل والمتروكين والضعفاء، فإن هذا يعود على جملة رواياته، ولا سيما إن قامت القرائن أنه لا يضبط فيما يصرح به، أو يشتبه عليه، أو يلقِّن إياه، أو لا يتميز حديثه بحيث تلتزق به المناكير التي يرويها عن المشاهير، وعيب بهذا جمع من الرواة فقال ابن حجر - مثلًا - في (يحيى بن أبي حية): "ضعَّفوه لكثرة تدليسه). فهذا النوع لا يكتفي التصريح بسماعه، وينبغي أن نتوقى تمشية مروياته إلَّا بعد النظر الدقيق.
(11) تمشية عنعنتهم وهم مدلّسون محمول على (تحسين الظنّ) قاله المزّي للسبكي، ومع هذا فقد أعلَّت بعض الحروف بعنعنتهم، كما تجده في "علل مسلم" لأبي الفضل الشهيد وفي مواطن من كلام الدارقطني، وانظر للمسألة: "النكت" لابن حجر (2/ 635 - 636) "جامع التحصيل" (110)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/ 33)، وانظر الهامش الآتي.
(12) قال في "الرسالة" (ص 379): "ومَنْ عرفناه دلَّس مرّة، فقد أبان لنا عورته في روايته، وليس تلك العورة بالكذب، فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلِّسٍ حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت".
قلت: الذي جرى عليه أئمّةّ النقد أنّهم تتبّعوا تدليس المشاهير، وميَّزوا ما سمعوه وما دلَّسوه، فقبلوا الأول، وإن لم يقع تصريح منهم بالسماع. ففي عبارة الشافعي تأصيل، ولكنّه ليس على إطلاقه من حيث التطبيق، ولذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 287) - مثلًا -: "وقال بعض من يقول بالتيمّم إلى المرفقين: قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدّثنا، فلا حجّة في نقله" وقال: "وهذا تعسُّف".
وعبارات النقّاد كثيرة جدًّا في إمكانية تمييز التدليس عن غيره حتّى في حقِّ من وعَّروا الطريق لمعرفة الوصول إليها كابن جريجٍ، قال الخليلي في "إرشاده" (1/ 352): "وابن جريجٍ يدلِّس في أحاديث، ولا يخفى ذلك على الحفّاظ"، وقال الحاكم في "المدخل" (ص 46): "وأخبار المدلِّسين كثيرة، وضبط عنهم الأئمّة ما لم يدلّسوا" وذكره بنحوه في "المعرفة" (ص 108 - 109).
ولذا مشَّى أصحاب "الصحيحين" رواية جماعة بالعنعنة، كما تقدّم عند المصنّف، وكان ذلك فيما لم يخالفوا فيه غيرهم، ولذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 307): "وقتادة إذا لم يقل سمعت، وخولف في نقله، فلا تقوم به حجّة؛ لأنّه يدلِّس كثيرًا عمّن لم يسمع منه وربّما كان بينهما غير ثقة"، فمن لم يتفطّن لانتقاء أصحاب "الصحيحين"، فإنّه يُلْزِمُهُما بما لا يَلْزَمُهُمَا، فتفطّن، وتفقَّد تجد، وسبق التنبيه على مثله.
(13) التقريب (1/ 363 - مع "التدريب")، "الإرشاد" (1/ 211)، وكلامه واقع في كثير من الأمثلة، ويقع ثبوت السماع من خارج "الصحيحين"، ولكن هذا ليس مستغرقًا لجميع الأسانيد، ويعجبني ما قاله الصنعاني في "توضيح الأفكار" (1/ 356) هنا: "يحتمل أنّ الشيخين لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه، لكن عرفا لحديثه من التوابع ما يدلُّ على صحته مما لو ذكراه لطال، فاختار إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه، ولم يكن في المتابعين الثقات الذين تابعوا المدلس من يماثله ولا يقاربه فضلًا وشهرة، مثل أن يكون مدلّس الحديث سفيان الثوري والحسن البصري أو نحوهما، ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه من هو دونه من أهل الصدق ممن هو ليس بمدلس".
وينظر: "النصيحة" لشيخنا الألباني (27 - 28).
(14) الاقتراح (ص 214) بتصرّف.
ومن مفاسد التدليس وسوالبه: التزيُّن بعدم، والتشبُّع بما لم يعط، وأمّا امتحان النفس، فهي مصلحته، ومثاله: ما ذكره الذهبي في "رحلته" أنه لمّا اجتمع بابن دقيق العيد، سأله ابن دقيق العيد: مَنْ أبو محمد الهلالي؟ فقال: سفيان بن عيينة، فأعجبه استحضاره. أفاده السخاوي، وانظر كتابي "البيان والإيضاح" (85).
(15) لم يبِّين المُصنِّفُ - تبعًا لابن الصلاح - حكمه، واكتفى بقوله: "أمره أخفّ"، فأردت بيان الحكم فيه للفائدة: وقد جزم أبو نصر ابن الصباغ في "العدّة" أنّ من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس، وإنّما أراد أن يغيّر اسمه ليقبلوا خبره، يجب ألّا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة، فقد غلط، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وإنما كان لصغر سنه، فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه، قاله العراقي في "التقييد والإيضاح" (100).
(16) قد يكون لامتحان الأذهان في استخراج المدلّسات، واختبار الحفظ، وقد يكون لغير ذلك فتحصل المفسدة، قاله البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (235).
(17) هذا من جهة، وتختلف الكراهة أيضًا على حسب الأثر المترتّب عليه، كما بيَّنَاه قريبًا، والحمد لله وحده.
(18) تسمُّحه واقع بلا دافع في طريقة روايته عن مشايخه في كتبه، وتفطن لهذا ابنُ الصلاح في (النوع الثامن والأربعين)، فقال: "والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضًا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير".
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب في (تقعيده) في "الكفاية" (2/ 402) لم يتسمَّح، إذ قال: "وفي الجملة، فإنَّ كلّ مَنْ روى عن شيخ شيئًا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره، فخفي ذلك على سامعه، لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله، ثابت الجهالة، معدوم العدالة، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط، والعمل به غير لازم، على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم، والله أعلم"!!
(19) مثل: أبو موسى المديني في جزئها ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع لي عاليًا من حديثه" فإنّي وجدت فيه (من رقم 15 - 31) يروي هذه الأخبار عن أبي بكر الشافعي في "الغيلانيّات"، وينوِّع اسمه على ألوان وضروب، لإخفائه على قارئه.
(20) كذا في الأصل، ولا داعي لها، إذا سبق "إذا لم يكن...".
(21) لأنّه حينئذٍ بمعنى إخفاء العلّة لحديث مطروح أو موضوع، ليروج، وهو من الحرام في دين الله عزَّ وجلَّ، ولذا يعجبني صنيع ابن حزم في رسالته "التلخيص لوجوه التخليص" (ص 250 - 252) فإنّه أورد مقولة شعبة: "لأن أَزني أحبُّ إليَّ من أن أُدلِّس"، وقال على إثرها ما نصّه: "وأنا أقول: لأن يضرب عنقي، أو أصلب، أو يرمى بي وأهلي وولدي؛ أحبُّ إليَّ من أقطع الطريق، أو أقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وأنا أعلم أنّ ذلك حرام، وهذا أحبَّ إليَّ من أنْ أستحلَّ الاحتجاج بحديث عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - لا أعتقده صحيحًا، أو أن أردَّ حديثًا صحيحًا عنه - صلى الله عليه [وآله] وسلم - ولم يصحّ نسْخُهُ بنصٍّ آخر، ولا صحَّ عندي تخصيصُهُ بنصٍّ آخر"، فهذا محمول على ظاهره، خلافًا لمن قال إنّ كلام شعبة محمول على المبالغة في الزجر! قال مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 22/ ب) بعد نقله نقل ابن الصلاح لمقولة شعبة: "لأن أزني .. " وصنيعه في توجيهها على المبالغة في الزجر، قال: "وشرع - أي ابن الصلاح - في الاعتذار عنه - أي: عن شعبة -، ولو رأى ما ذكره الخطيب لكان له مندوحة عن ذكر ما ذكره، وهو قول شعبة: التدليس في الحديث أشد من الزنا" انتهى.
ووافقه البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص 234) فقال تحت (فائدة): "قد جاء عن شعبة … " وساق قوله. قال: "وهذا الذي قاله شعبة ظاهر، فإن آفة التدليس لها ضرر كبير في الدين وهي أضر من أكل الربا، … ".
(22) نقلها العقيلي في "الضعفاء" (4/ 71) دون تسمية القائل.
(23) الموضوعات (1/ 280) وسرد الأوجه جميعًا.
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)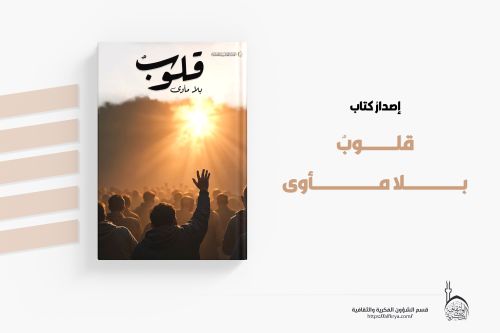 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)

















