مأساة العقل: عندما نجيب عن أسئلة لم تُطرح
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
16/10/2025
كم مرة أجابنا بسرعة، ظنًّا أننا نفهم، لنكتشف بعد ذلك أن السؤال لم يكن كما تصوّرنا هذه هي مأساة العقل، الذي يسبق الفهم بالعجلة، ويختزل الحقيقة في صورة الإجابة الأولى.
في مسيرتي الأكاديمية الطويلة، التي تشعّبت بين قاعات الدرس وأروقة الامتحانات ومناقشات الطلبة، ترسّخت في ذهني قناعةٌ لم تتبدّد مع مرور الأعوام، بل ازدادت رسوخًا مع التجربة والتأمل.
قناعةٌ مفادها أن أغلب الإخفاقات في الإجابة لا تنشأ من ضعف المعرفة، بل من ضعف الفهم للسؤال نفسه، وهو ما يجعل العقل عاجزًا عن تقديم الجواب الصحيح مهما توفّرت لديه المعلومات.
كنت أرى ذلك المشهد يتكرر أمامي مرارًا: طالبٌ مجتهدٌ، يحمل في رأسه زادًا من المعلومات، لكنّه حين يجلس إلى ورقة الامتحان، يضع قلمه على السطر قبل أن يضع عقله على السؤال. يقرأ العبارة الأولى، ثم يهرع إلى الإجابة، وكأنّ الزمن يطارده، أو كأنّ السؤال عدوّ يريد أن يفلت منه قبل أن يصيبه برصاصة الجواب.
وما يزيد الأمر مأساويةً، أن هذه العجلة غالبًا ما تكون مصحوبة بثقة زائفة، فالمُجيب يشعر بأنه يعرف، بينما هو في الحقيقة يسبح في محيطٍ من سوء الفهم.
غير أنّ المأساة لا تكمن في العجلة وحدها، بل في تلك العادة الذهنية الخطيرة التي تترسخ منذ المراحل الأولى في التعليم، حين يقرأ الطالب شيئًا ثم يعيد تركيبه في ذهنه وفق ما يريد هو لا وفق ما ورد أمامه.
إنّه لا يجيب عن السؤال المطروح، بل عن سؤالٍ آخر اخترعه خياله، يراه أقرب إلى ما يعرف أو إلى ما يحبّ أن يقول. ومن هنا يبدأ الانفصال بين العقل والموضوع، وبين الفهم والإجابة، وهو انفصال قد يظلّ مرافقًا للفرد مدى حياته إذا لم يُعالج.
كنت أحرص دائمًا على أن أقول لطلابي:
اقرأوا السؤال مرّتين قبل أن تكتبوا كلمة واحدة، فربّ دقيقةٍ في الفهم خيرٌ من ساعةٍ في الجواب.
لكن مع مرور الوقت، تبيّن لي أن المشكلة ليست أكاديمية فحسب، ولا يمكن حصرها في جدران الصفوف أو قاعات الامتحانات. لقد اكتشفت، بدهشةٍ مؤلمة، أن هذه ليست ظاهرة طلابية، بل اجتماعية شاملة، وأنّ ما كنت أظنه نتيجةً لضغط الامتحان، هو في الحقيقة نموذجٌ مصغّر لطبيعة التفكير السائد في مجتمعاتنا.
فنحن في الغالب لا نُحسن الإصغاء إلى السؤال، سواء جاء من أستاذٍ في قاعة، أو من مفكرٍ في مقالة، أو من سياسيٍّ في خطاب، أو حتى من جارٍ في نقاشٍ عابر.
ما إن نسمع الكلمات الأولى حتى نقاطع الفكرة بعجلة الاستنتاج، فنقيسها على ما في أذهاننا من قوالب مسبقة، ونُسقط عليها أحكامًا محفوظة، ثم نُجيب بما نظنّ أنه ردٌّ مقنع، بينما هو في جوهره جوابٌ عن سؤالٍ لم يُطرح أصلًا.
وتتفاقم المشكلة حين تتشابك هذه العادة مع ثقافة الانفعال والغضب، فتتحول المسائل البسيطة إلى صراعات كلامية، ويصبح الحوار معركة إثبات وجود لا وسيلة للتفاهم.
ولعلّ أكثر ما يفضح هذه الظاهرة في عصرنا هو ما نراه على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث يتحول الحوار في كثير من الأحيان إلى سلسلة من سوء الفهم المتبادل.
يكتب أحدهم فكرة محددة، فيها رأي أو تحليل، فيأتيه الرد لا على ما قال، بل على ما توهّم الآخر أنه قال.
تتحوّل الكلمات إلى مرايا مشوّهة، تعكس ما في النفوس لا ما في النصوص. فتُبنى التهم على الظن، وتُشنّ الحروب اللفظية على أساس سوء قراءةٍ لا سوء نية.
كم من مرةٍ رأيت تعليقًا على منشورٍ يتحدث عن مسؤولية المعارضة وقت الحرب، فيردّ عليه آخر ساخطًا: وهل تبرّر الدكتاتورية بينما صاحب المنشور لم يبرّر شيئًا، بل كان يناقش فكرةً أخرى تمامًا
وهنا تتجلّى الظاهرة في صورتها المجتمعية العارية: العقل لا يقرأ ليفهم، بل يقرأ ليثبت أنه على صواب، حتى لو كان الجواب عن سؤالٍ لم يُسأل.
لقد غدت هذه العادة الذهنية مرضًا مستفحلًا، لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد إلى الإعلام والخطاب العام والسياسة أيضًا.
كم من أزمةٍ تفاقمت لأن أحدهم أساء فهم الرسالة أو حرّف السؤال وكم من حوارٍ انتهى إلى خصومة لأن الطرفين كانا يتحدثان عن موضوعين مختلفين، ظنّ كلٌّ منهما أنه يفهم الآخر
إنّ جذور هذه الظاهرة عميقة في بنية التفكير العربي المعاصر، الذي يغلب عليه التسرّع والانفعال والرغبة في الانتصار لا في الفهم.
نحن لا نمارس التأمل قبل الردّ، ولا نُدرّب أبناءنا على الإصغاء بوصفه فضيلة معرفية.
في مدارسنا، يُكافأ الطالب الذي يجيب بسرعة أكثر مما يُكافأ الذي يسأل بدقة.
وفي مجتمعاتنا، يُعاب من يتأنّى في الفهم، ويُمدح من يردّ فورًا وكأنّ سرعة اللسان دليلُ ذكاء.
إنّ أولى خطوات الإصلاح الفكري هي أن نتعلّم كيف نقرأ السؤال على وجهه الصحيح، لأنّ السؤال هو مفتاح الوعي، ومن ضيّع المفتاح تاه في الأبواب.
فلا يمكن لعقلٍ أن يبني معرفة إذا كان ينطلق من فهمٍ مغلوط لما يُطرح عليه. ولا يمكن لأمّةٍ أن تتقدّم وهي تجيب عن الأسئلة الخطأ، وتغفل الأسئلة الحقيقية التي تصنع مستقبلها.
لقد أدركت، بعد سنواتٍ من المراقبة والتعليم، أن التربية على فنّ الفهم أهمّ من كل الدروس التي نلقّنها.
فالفهم ليس تلقّيًا، بل مشاركة عقلية، وهو مهارة لا تُكتسب من الكتب وحدها، بل من الصبر على الإصغاء، والتواضع أمام السؤال، واحترام المعنى قبل الجواب.
إننا نحتاج، في بيوتنا ومدارسنا ومنصّاتنا، إلى ثورة هادئة في طريقة التفكير. نحتاج أن نربّي أبناءنا على أن الذكاء ليس في سرعة الردّ، بل في دقّة الإصغاء. وأنّ السؤال ليس فخًّا نُفلت منه بالدهاء، بل جسرٌ نعبر عليه إلى فهمٍ أعمق.
وأنّ الإجابة الصحيحة لا تُبنى على الحفظ، بل على الوعي بالمراد. حين نُصلح علاقتنا بالسؤال، نُصلح علاقتنا بالحقيقة. وحين نتعلّم أن نفهم قبل أن نحكم، نكون قد خطونا أول خطوةٍ في طريق النضج الإنساني والعقلي.
فما أكثر الذين يُخطئون الجواب لأنهم لم يُحسنوا قراءة السؤال، وما أقلّ الذين يوقنون أن الفهم نصف العلم، والإنصات نصف الفهم.
وكم هو مؤسف أن يستمر هذا النمط من التفكير من جيلٍ إلى جيل، حتى أصبحنا أمام مجتمعٍ يجيب بسرعة، لكنه يخطئ كثيرًا في فهم ماهية السؤال الحقيقي، فتتوالى الأخطاء، وتتكاثر الفجوات بين الفكر والواقع، بين العقل والجواب، وبين المعرفة والفهم العميق.

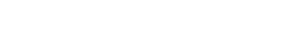




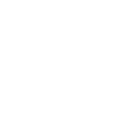
















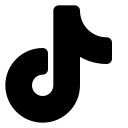








.png) وائل الوائلي
وائل الوائلي .png) منذ 13 ساعة
منذ 13 ساعة 










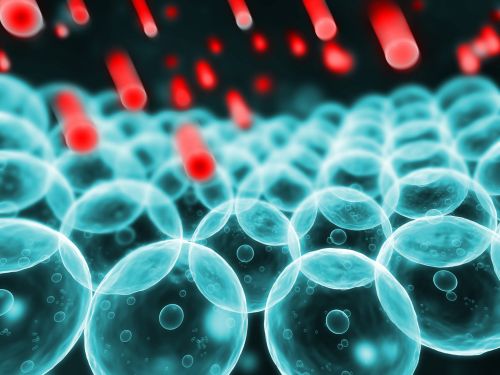
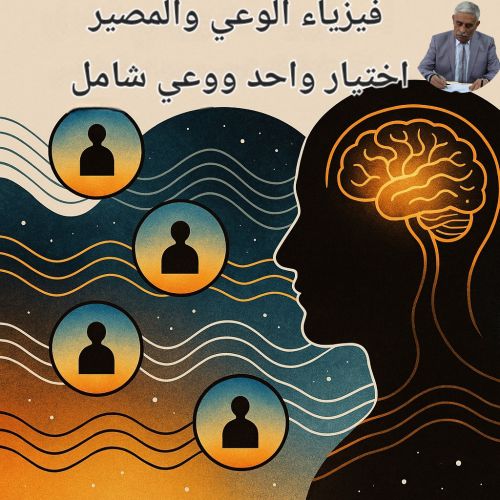



 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى) EN
EN