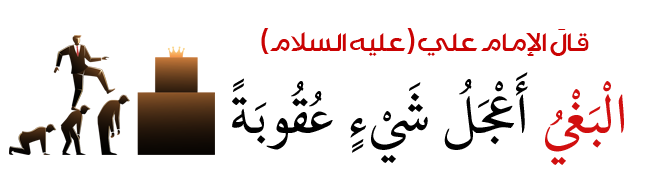
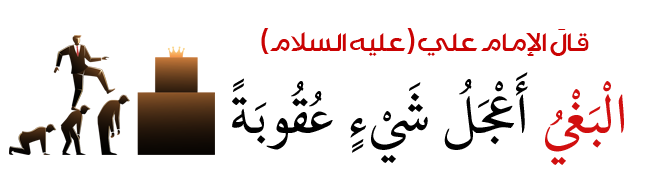

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
التاريخ: 24-8-2016
التاريخ: 24-8-2016
التاريخ: 1-8-2016
|
الرواية الاُولى : حديث الرفع :
روى الصدوق في «الخصال» بسند صحيح عن حريز عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال : «قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ رفع عن اُمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة»(1) .
وقد ذكر القوم كيفية دلالتها على المقام ، غير أنّ المهمّ بيان اُمور يتمّ بها ما يستفاد من الحديث الشريف :
الأمر الأوّل : في شمول الحديث للشبهات الحكمية:
قد استشكل في الاستدلال به للشبهات الحكمية باُمور :
أوّلها : أنّه لا شكّ أنّ أكثر ما ذكر في الحديث الشريف موجود في الخارج كثير وجوده بين الاُمّة ، مع أنّ ظاهره الإخبار عن نفي وجوده ، فلابدّ من تقدير أمر في الحديث حسب دلالة الاقتضاء ; صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية والكذب .
فالظاهر : أنّ المقدّر هو المؤاخذة ، غير أنّه يصحّ في «ما لا يطيقون» و «ما اضطرّوا إليه» و« ما استكرهوا عليه» ، وأمّا «ما لا يعلمون» فإن اُريد منه الشبهة الموضوعية والمجهول من ناحية المصداق فيصحّ التقدير أيضاً ; وإن اُريد منه الأعمّ أو نفس الحكم المجهول فتقدير المؤاخذة يحتاج إلى العناية(2) .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أجاب عن الإشكال : بأنّه لا حاجة إلى التقدير ; فإنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه ، كما إذا كان الكلام إخباراً عن أمر خارجي ، أو كان الرفع رفعاً تكوينياً ، فلابدّ في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب .
وأمّا إذا كان الرفع تشريعياً فالكلام يصحّ بلا تقدير ; فإنّ الرفع التشريعي ـ كالنفي التشريعي ـ ليس إخباراً عن أمر واقع ، بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي ، كقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «لا ضرر ولا ضرار» ، وقوله ـ عليه السلام ـ : «لا شكّ لكثير الشكّ» ونحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمراً ثابتاً في الخارج(3) .
وفيه : أنّ الفرق بين الإنشاء والإخبار في احتياج أحدهما إلى التقدير دون الآخر كما ترى ; فإنّ الكلام في مصحّح نسبته إلى المذكورات ، فلو كان هناك مصحّح ; بحيث يخرج الكلام عن الكذب واللغوية تصحّ النسبة مطلقاً ; إخباراً كان أو إنشاءً ، وإن كان غير موجود فلا تصحّ مطلقاً .
والحاصل : أنّ إسناد الشيء إلى غير ما هو له يحتاج إلى مناسبة وادّعاء ، فلو صحّ لوجود المناسبة يصحّ مطلقاً ، بلا فرق بين الإنشاء والإخبار .
أضف إلى ذلك : أنّ النبي والأئمّة من بعده ـ عليهم السلام ـ ليسوا مشرّعين حتّى يكون الحديث المنقول عنه إنشاءً ، بل هو إخبار عن أمر واقع ; وهو رفع الشارع الأقدس .
مضافـاً إلى أنّ الإخبار بـداعي الإنشاء لا يجعلـه إنشاءً ، لا يسلخـه عـن الإخبارية ; فإنّ الإخبار بداعي الإنشاء لا يجعل الشيء مـن قبيل استعمال الإخبار في الإنشاء ، بل هو يبقى على إخباريته ; وإن كان الداعي إليه هو البعث والإنشاء .
كما هو الحال في الاستفهام الإنكاري والتقريري ; فإنّ كلمة الاستفهام مستعملة في معناها حقيقة; وإن كان الغرض أمراً آخر مخرجاً به عن المحذور .
على أنّ الرفع التشريعي مآله إلى رفع الشيء باعتبار آثاره وأحكامه الشرعية ، وهو عين التقدير .
نعم ما ادّعاه ـ قدس سره ـ من عدم احتياجه إلى التقدير صحيح ، لا لما ذكره بل لأجل كون الرفع ادّعائياً ، وسيأتي توضيحه ، فانتظر(4) .
ثانيها : لا شكّ أنّ المراد من الموصول في «ما لا يطيقون» ، و «ما استكرهوا» و «ما اضطرّوا» هو الموضوع الخارجي لا الحكم الشرعي ; لأنّ هذه العناوين الثلاثة لا تعرض إلاّ للموضوع الخارجي دون الحكم الشرعي .
فليكن وحدة السياق قرينة على المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو الموضوع المشتبه، لا الحكم المشتبه المجهول ، فيختصّ الحديث بالشبهات الموضوعية(5) .
ثالثها : أنّ إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي المجهول من قبيل الإسناد إلى ما هو له ; لأنّ الموصول الذي تعلّق الجهل به بنفسه قابل للوضع والرفع الشرعي ، وأمّا الشبهات الموضوعية فالجهل إنّما تعلّق فيها بالموضوع أوّلاً وبالذات ، وبالحكم ثانياً وبالعرض .
فيكون إسناد الرفع إلى الموضوع من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له ; لأنّ الموضوع بنفسه غير قابل للرفع ، بل باعتبار حكمه الشرعي ، ولا جامع بين الموضوع والحكم ، فلابدّ أن يراد من الموصول هو الموضوع ; تحفّظاً على وحدة السياق(6) .
وأجاب بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ ; قائلاً بأنّ المرفوع في جميع التسعة إنّما هو الحكم الشرعي ، وإضافة الرفع في غير «ما لا يعلمون» إلى الأفعال الخارجية لأجل أنّ الإكراه والاضطرار ونحو ذلك إنّما يعرض الأفعال الخارجية لا الأحكام ، وإلاّ فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي .
كما أنّ المرفوع في «ما لا يعلمون» أيضاً هو الحكم الشرعي ، وهو المراد من الموصول ، وهو الجامع بين الشبهات الموضوعية والحكمية .
ومجرّد اختلاف منشأ الشبهة لا يقتضي الاختلاف فيما اُسند الرفع إليه ; فإنّ الرفع قد اُسند إلى عنوان «ما لا يعلم» ، ولمكان أنّ الرفع التشريعي لابدّ أن يرد على ما يكون قابلاً للوضع والرفع الشرعي فالمرفوع إنّما يكون هو الحكم الشرعي ; سواء في ذلك الشبهات الحكمية والموضوعية . فكما أنّ قوله ـ عليه السلام ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» يعمّ كلا الشبهتين بجامع واحد ، كذلك قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «رفع عن اُمّتي تسعة أشياء»(7) ، انتهى .
وأنت خبير : بأنّ في المقام إشكالين ، وهو ـ قدس سره ـ يريد الجواب عنهما معاً : أمّا الأوّل فحاصله : أنّ وحدة السياق يقتضي حمل الموصول في «ما لا يعلمون» على الموضوع حتّى يتّحد مع أخواته ، فالقول بأنّ رفع تلك العناوين بلحاظ رفع آثارها وأحكامها لا يفي بدفع الإشكال.
ومنه يعلم ما في جوابه عن ثاني الإشكالين ; لأنّ مناطه إنّما هو في الإسناد بحسب الإرادة الاستعمالية ; فإنّ الإسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، دون الإسناد إلى الموضوع ، فلابدّ أن يراد في جميعها الموضوع حتّى يصحّ الإسناد المجازي في الجميع . فكون المرفوع بحسب الجدّ الحكم الشرعي لا يدفع الإشكال .
فالحقّ في دفع المحذورين : ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ :
أمّا عن الأوّل : فلأنّ عدم تحقّق الاضطرار والإكراه في الأحكام لا يوجب التخصيص في قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «ما لا يعلمون» ولا يقتضي السياق ذلك ; فإنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظة سعة متعلّقه وضيقه ، فقوله : «ما اضطرّوا إليه» اُريد منه كلّ ما اضطرّ إليه في الخارج ، غاية الأمر : لم يتحقّق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم .
فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد من قوله «ما لا يعلمون» أيضاً كلّ فرد من أفراد هذا العنوان ، ألا ترى أنّه إذا قيل : «ما يؤكل وما يرى» في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني بذلك البعض .
وبعبارة أوضح : أنّ الإشكال نشأ من الخلط بين المستعمل فيه وما ينطبق عليه ; فإنّ الموصول والصلة في عامّة الفقرات مستعمل في معناهما لا في المصاديق الخارجية ، والاختلاف بين المصاديق إنّما يظهر عند تطبيق العناوين على الخارجيات ، وهو بمعزل عن مقام الاستعمال .
وهذا خلط سيّال في أكثر الأبواب ، ومن هذا الباب توهّم أنّ الإطلاق يفيد العموم الشمولي أو البدلي أو غيرهما ، مع أنّ الإطلاق لا يفيد قطّ العموم ، بل هو مقابل العموم ، كما مرّ تحقيقه في مقامه(8) .
وأمّا عن الثاني : فإنّ الأحكام الواقعية إن لم تكن قابلة للرفع ، وتكون باقية بفعليتها في حال الجهل يكون الإسناد في كلّ العناوين إسناداً إلى غير ما هو له ، وإن كانت قابلة للرفع يكون الإسناد إلى «ما لا يعلمون» إسناداً إلى ما هو له ، وإلى غيره إلى غير ما هو له ، ولا يلزم محذور ; لأنّ المتكلّم ادّعى قابلية رفع ما لا يقبل الرفع تكويناً ، ثمّ أسند الرفع إلى جميعها حقيقة.
وبعبارة اُخرى : جعل كلّ العناوين بحسب الادّعاء في رتبة واحدة وصفّ واحد في قبولها الرفع، وأسند الرفع إليها حقيقة ، فلا يلزم منه محذور(9) .
ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر أنكر وحدة السياق في الحديث ; قائلاً بأنّ من الفقرات في الحديث : الطيرة والحسد والوسوسة ، ولا يكون المراد منها الفعل ، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه ؟ !
على أنّه لو اُريد تلك فهو يقتضي ارتكاب خلاف الظاهر من جهة اُخرى ; فإنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» هو ما كان بنفسه معروض الوصف ، وهو عدم العلم كما في غيره من العناوين الاُخر ، كالاضطرار والإكراه ونحوهما ; حيث كان الموصول فيها معروضاً للأوصاف المزبورة .
فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذا الظهور ; إذ لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضاً للجهل ، وإنّما المعروض له هو عنوانه . وحينئذ يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول في «ما لا يعلمون» على الحكم ، وبين حفظه من جهة اُخرى بحمله على إرادة الفعل ، والعرف يرجّح الأوّل(10) ، انتهى .
والجواب عن الأوّل ـ مضافاً إلى أنّ المدّعى وحدة السياق فيما يشتمل على الموصول ، لا في عامّة الفقرات ـ أنّ الفقرات الثلاث أيضاً فعل من الأفعال ، غاية الأمر أنّها من قبيل الأفعال القلبية ، ولأجل ذلك تقع مورداً للتكليف ; فإنّ تمنّي زوال النعمة عن الغير فعل قلبي محرّم . وقس عليه الوسوسة والطيرة ; فإنّها من الأفعال الجوانحية .
وعن الثاني : أنّ المجهول في الشبهات الموضوعية إنّما هو نفس الفعل أيضاً لا عنوانه فقط ، بل الجهل بالعنوان واسطة لثبوت الجهل بالنسبة إلى نفس الفعل ، لا واسطة في العروض . فالشرب في المشكوك خمريته أيضاً مجهول ; وإن كان الجهل لأجل إضافة العنوان إليه .
أضف إلى ذلك : أنّه لو سلّم ما ذكره فلا يختصّ الحديث بالشبهة الحكمية ; لأنّ الرفع ادّعائي ، ويجوز تعلّقه بنفس الموضوع ، فيدّعى رفع الخمر بما لها من الآثار ، فيعمّ الحديث كلتا الشبهتين .
وربّما يدّعى اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية ; لأنّ الموضوعات الخارجية غير متعلّقة للأحكام ، وإنّما هي متعلّقة بنفس العناوين . فرفع الحكم عنها فرع وضعها لها ، وقد عرفت منعه .
وفيه أوّلاً : بالنقض بالاضطرار ونحوه ; فإنّه يتعلّق بالموضوع بلا إشكال ; فأيّ معنىً لرفع الحكم فيه فليكن هو المعنى في «ما لا يعلمون» .
وثانياً : يمكن أن يقال إنّ الرفع في الشبهات الموضوعية راجع إلى رفع الحكم عن العناوين الكلّية ، كما هو الحال في الاضطرار والإكراه ; فإنّ الحكم مرفوع عن البيع المكره والشرب المضطرّ والخمر المجهول حكماً أو موضوعاً .
وإن شئت قلت : إنّ رفع الحكم مآله إلى نفي المؤاخذة أو رفع إيجاب الاحتياط أو رفع الفعلية ، من غير فرق بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية .
الأمر الثاني : معنى الرفع في الحديث:
هل الرفع في الحديث بمعناه الحقيقي ، أو هو بمعنى الدفع ، استعمل في المقام مجازاً ؟
التحقيق هو الأوّل ; سواء قلنا إنّ المرفوع هو نفس الموضوعات ادّعاءً ـ كما هو المختار ـ أو المرفوع آثارها وأحكامها بالتزام تقدير في الكلام .
أمّا على الأوّل فبيانه : أنّ معنى الرفع الحقيقي هو إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه ، وقد اُسند إلى نفس هذه العناوين التسعة المتحقّقة في الخارج ، فلابدّ أن يحمل الرفع إلى الرفع الادّعائي ، وهو يحتاج إلى وجود المصحّح لهذا الادّعاء .
ثمّ المصحّح كما يمكن أن يكون رفع الآثار يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن التأثير ; لأنّ رفع الموضوع تكويناً كما يوجب رفع الآثار المترتّبة عليه والمتحقّقة فيه ، كذلك يوجب عدم ترتّب الآثار عليه بعد رفعه وإعدامه ، وهذا مصحّح الدعوى ; لاسيّما مع وجود المقتضي .
فيجوز نسبة الرفع إلى الموضوع ادّعاءً بواسطة رفع آثاره أو دفعها أو دفع المقتضي عن التأثير، وذلك لا يوجب أن يكون الرفع المنسوب إلى الموضوع بمعنى الدفع ، بل لو بدّل الرفع بالدفع ليخرج الكلام عمّا له من البلاغة إلى الابتذال .
وأمّا على الثاني ـ أعني كون المرفوع هو الآثار بالتزام تقدير ـ فتوضيحه : أنّ إطلاق الرفع إنّما هو لأجل شمول إطلاقات الأدلّة أو عمومها لحالات الاضطرار والإكراه والنسيان والخطأ وعدم الطاقة ، فعمومات الكتاب ـ مثل : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة: 38] وأضرابه ـ والسنّة شاملة حسب الإرادة الاستعمالية هذه الحالات .
وإطلاق الرفع إنّما هو حسب تلك الإرادة ; وإن كان حسب الإرادة الجدّية دفعاً ; لعدم شمولها لهذه الحالات من أوّل الأمر ، لكنّ المصحّح لاستعمال الرفع هو الإرادة الاستعمالية التي مآله إلى ضرب القانون عموماً على موضوعات الأحكام ، بلا تقييد وتخصيص . فيستقرّ في ذهن المخاطب بدواً ثبوت الحكم للمضطرّ والناسي وأشباههما .
ثمّ إنّ المتكلّم يخبر برفع الآثار والأحكام عن الموضوعات المضطرّ إليها والمستكره بها ، وإطلاق الرفع لأجل شمول العامّ القانوني لها ، واستقراره في أذهان المخاطبين .
وهذا كلّه بناءً على جواز خطاب الناسي واضح ، وأمّا بناءً على عدم جواز خطابه يكون الرفع في الأحكام التكليفية في حقّه في غير مورده .
وأمّا الطيرة والوسوسة : فالمصحّح لاستعمال الرفع كونهما محكومين بالأحكام في الشرائع السابقة ، ولم يكن الشرائع السماوية محدودة ظاهراً ، بل أحكامها حسب الإرادة الاستعمالية كانت ظاهرة في الدوام والبقاء ; ولهذا يقال : إنّها منسوخة .
وإن شئت قلت : كان هناك إطلاق أو عموم يوهم بقاء الحكم في عامّة الأزمنة ، فإطلاق الرفع لأجل رفع تلك الأحكام الظاهرة في البقاء والدوام ، ويشهد على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «عن اُمّتي» ; وإن كان كلّ ذلك دفعاً حسب اللبّ والجدّ ، إلاّ أنّ مناط حسن الاستعمال هو الاستعمالية من الإرادتين لا الجدّية ، بل لو كان الميزان للرفع هو إطلاق الأحكام في الشرائع السماوية يمكن أن يكون وجه استعمال الرفع في عامّة الموضوعات التسعة لأجل ثبوت الحكم فيها في الشرائع السابقة على نحو الدوام والاستمرار .
وأمّا «ما لا يعلمون» : فالرفع فيه لأجل إطلاق الأدلّة وظهورها في شمول الحكم للعالم والجاهل بلا فرق ، كما هو المختار في الباب . نعم لو لم نقل بإطلاق الأدلّة فلا شكّ في قيام الإجماع على الاشتراك في التكاليف .
فالرفع لأجل ثبوت الحكم حسب الإرادة الاستعمالية لكلّ عالم وجاهل ; وإن كان الجاهل خارجاً حسب الإرادة الجدّية ، غير أنّ المناط في حسن الاستعمال هو الاستعمالي من الإرادة .
فتلخّص : كون الرفع بمعناها ; سواء كان الرفع بلحاظ رفع التسعة بما هي هي ، أو كان رفع تلك الاُمور حسب الآثار الشرعية .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أفاد : أنّ الرفع بمعنى الدفع ; حيث قال : إنّ استعمال الرفع مكان الدفع ليس مجازاً ، ولا يحتاج إلى عناية أصلاً ; فإنّ الرفع في الحقيقة يمنع ويدفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق ; لأنّ بقاء الشيء كحدوثه يحتاج إلى علّة البقاء . فالرفع في مرتبة وروده على الشيء إنّما يكون دفعاً حقيقة ، باعتبار علّة البقاء ; وإن كان رفعاً باعتبار الوجود السابق .
فاستعمال الرفع في مقام الدفع لا يحتاج إلى علاقة المجاز ، بل لا يحتاج إلى عناية أصلاً ، بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ ; لأنّ غلبة استعمال الرفع فيما يكون له وجود سابق لا يقتضي ظهوره في ذلك(11) ، انتهى .
وفي كلامه مواقع للنظر :
منها : أنّ اللغة والارتكاز قد تطابقا على أنّ معنى الرفع هو إزالة الشيء عن صفة الوجود بعد تحقّقه وتحصّله ، فعلى هذا فلو استعمل بمعنى الدفع فلا مناص عن العناية وما به يتناسب الاستعمال ، وإنكار احتياجه إلى العناية مكابرة ظاهرة .
منها : أنّ ما أفاده ـ قدس سره ـ ; من أنّ بقاء الشيء يحتاج إلى العلّة كحدوثه صحيح لا ريب فيه إلاّ أنّ ما أفاده من أنّ الرفع عبارة عن دفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق غير صحيح ; فإنّ دفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق لا يطلق عليه الرفع ، بل يطلق عليه الدفع ، وإنّما يستعمل الرفع في هذه الحالة لا بهذه الحيثية ، بل باعتبار إزالة الشيء عن صفحة الوجود بعد تحقّقه .
ومجرّد تواردهما أحياناً على مورد واحد أو حالة واحدة لا يجعلهما مترادفين ، ولا يرفع احتياج الاستعمال إلى العناية .
وإن شئت فاعتبر الحدوث والبقاء ; فإنّ الأوّل عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه وجوداً أوّلياً ، والثاني عبارة عن استمرار هذا الوجود ، وتواردهما على المورد لا يجعل الحدوث بقاءً ولا بالعكس .
منها : أنّ ما اختاره في المقام ينافي مع ما أفاده في الأمر الخامس في بيان عموم النتيجة ; حيث قال : إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، وأنّ الرفع يتوجّه على الموجود ، فيجعله معدوماً(12) .
وينافي أيضاً مـع ما أفاده فـي التنبيه الأوّل مـن تنبيهات الاشتغال ; حيث قال : إنّ الدفع إنّما يمنع عن تقرّر الشيء خارجاً وتأثير المقتضي في الوجود ، فهو يساوق المانـع ، وأمّـا الرفـع فهو يمنع عـن بقاء الوجـود ويقتضي إعـدام الشيء الموجـود عـن وعائـه .
نعم ، قـد يستعمل الرفـع في مكـان الـدفع وبالعكس ، إلاّ أنّ ذلك بضرب مـن العناية والتجوّز . والذي يقتضيه الحقيقـة هـو استعمال الـدفع في مقـام المنع عـن تأثيـر المقتضي فـي الـوجـود ، واستعمال الرفـع فـي مقام المنع عـن بقـاء الشـيء الموجود(13) ، انتهى .
وبقي في كلامه أنظاراً تركناها مخافة التطويل .
الأمر الثالث : في كيفية حكومة حديث الرفع:
لاشكّ في أنّه لا تلاحظ النسبة بين هذه العناوين وما تضمّنه الأدلّة الواقعية ; لحكومتها عليها ، كحكومة أدلّة نفي الضرر والعسر والحرج عليها ، إلاّ أنّ الكلام في كيفية الحكومة وفرقها في هذه الموارد الثلاثة : فقال بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ : إنّه لا فرق بين أدلّة نفي الضرر والعسر والحرج
وبين حديث الرفع ; سوى أنّ الحكومة في أدلّة نفي الضرر والحرج إنّما يكون باعتبار عقد الحمل ; حيث إنّ الضرر والعسر والحرج من العناوين الطارئة على نفس الأحكام ; فإنّ الحكم قد يكون ضررياً أو حرجياً ، وقد لا يكون .
وفي دليل رفع الإكراه ونحوه إنّما يكون باعتبار عقد الوضع ; فإنّه لا يمكن طروّ الإكراه والاضطرار والخطأ والنسيان على نفس الأحكام ، بل إنّما تعرض موضوعاتها ومتعلّقاتها . فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الأحكام ، نظير قوله : «لا شكّ لكثير الشكّ» ، و« لا سهو مع حفظ الإمام»(14) ، انتهى .
وفيه أمّا أوّلاً : أنّ معنى قوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] هو نفي جعل نفس الحرج لا الأمر الحرجي . وكذا قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «لا ضرر ولا ضرار»(15) هو نفي نفس الضرر لا الأمر الضرري .
فعلى ذلك لا يصحّ ما أفاد : أنّ الحكومة في أدلّة نفي الضرر والحرج باعتبار عقد الحمل ; فإنّه إنّما يصحّ لو كان المنفي الأمر الضرري والحرجي ; حتّى يقال : إنّ الحكم قد يكون ضررياً أو حرجياً .
وثانياً : أنّ الحكومة قائمة بلسان الدليل ، كما سيوافيك بيانه في محلّه(16) ، ولسان الدليلين ـ أعني «لا ضرر ولا ضرار» و {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ـ متغايران ; فإنّ الأوّل ينفي نفس الضرر والثاني ينفي جعل الحرج ، وبينهما
فرق في باب الحكومة ، ويأتي الكلام من أقسام الحكومة في بابها .
وثالثاً : أنّ الضرر والحرج من العناوين الطارئة على الموضوعات التي وقعت تحت دائرة الحكم ، كالصوم والوضوء والمعاملة المغبون فيها أحد الطرفين ; فإنّ الموصوف بالضرر والحرج نفس هذه العناوين .
نعم ، قد ينسبان إلى أحكامها بنحو من العناية والمجاز ; فإنّ إلزام الشارع وتكليفه ربّما يصير سبباً لوقوع المكلّف في الضرر والحرج ، وعلى هذا فلا يصحّ قوله : إنّ الضرر والحرج من العناوين الطارئة على نفس الأحكام . اللهمّ إلاّ أن يريد ما قلنا من المسامحة .
ورابعاً : لا شكّ أنّ الخطأ والنسيان قد يعرضان على الموضوع وقد يعرضان على الأحكام .
فمن العجيب ما أفاده ـ رحمه اللّه ـ من أنّ الخطأ والنسيان لا يمكن طروّهما على نفس الأحكام ، ولعلّه سهو من قلم المقرّر ـ رحمه اللّه ـ .
الأمر الرابع : في بيان المصحّح لإسناد الرفع:
لا شكّ : أنّ الرفع تعلّق بهذه العناوين في ظاهر الحديث ، مع أنّها غير مرفوع عن صفحة الوجود ، فيحتاج تعلّق الرفع بها إلى عناية ومناسبة . وهل المصحّح للدعوى هي رفع المؤاخذة أو جميع الآثار أو الأثر المناسب ؟ ذهب إلى كلٍّ فريق :
فاختار الأوّل شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ حيث أفاد : مـن أنّ الظاهـر لـو خلّينا وأنفسنا أنّ نسبـة الرفـع إلى المذكـورات إنّما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة(17) ، انتهى .
وفيه ـ مضافاً إلى أنّ المؤاخذة أمر تكويني لا يناسب رفعه ولا وضعه مع مقام التشريع ـ أنّ المؤاخذة ليست من أظهر خواصّها ; حتّى يصحّ رفع العناوين لأجل رفعها .
مع أنّ صحيحة البزنطي(18) التي استشهد الإمام ـ عليه السلام ـ فيها بهذا الحديث على رفع الحلف الإكراهي أوضح دليل على عدم اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فقط ، والخصم لم يتلقّ حكم الإمام أمراً غريباً ، بل أمراً جارياً مجرى الاُمور العادية .
وأمّا رفع الأثر المناسب : فقد استشكل فيه شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ بأنّه يحتاج لملاحظات عديدة(19) .
والظاهر : أنّ ما ذكره ليس مانعاً عن الذهاب إليه ; إذ لا نتصوّر فيه منعاً إذا ناسب الذوق العرفي ، بل الوجه في بطلانه : أنّ رفع الموضوع برفع بعض آثاره ليس أمراً صحيحاً عند العرف الساذج ، بل يرى العرف رفع الموضوع مع ثبوت بعض آثاره أمراً مناقضاً ، وإنّما يصحّ في نظره رفع الموضوع إذا رفع جميع آثاره تشريعاً حتّى يصحّ ادّعاء رفعه عن صفحة الوجود .
فإن قلت : لو كان الأثر المناسب من أشهر خواصّه وآثاره ; بحيث يعدّ العرف ارتفاعه مساوقاً لارتفاع الموضوع فمنع توافق العرف على هذا الرفع ممنوع .
قلت : رفع الموضوع برفع بعض الآثار الظاهرة إنّما يصحّ لو نزّل غيره منزلة العدم .
وإن شئت قلت : إنّ رفع الموضوع بلحاظ رفع بعض آثاره يتوقّف على تصحيح ادّعائين : الاُولى دعوى أنّ رفع هذا البعض رفع لجميع آثاره وخواصّه ، الثانية دعوى أنّ رفع جميع الآثار وخلوّ الموضوع عن كلّ أثر مساوق لرفع نفس الموضوع .
وهذا بخلاف ما لو قلنا : إنّ المرفوع هو عامّة الآثار ; فإنّه لا يحتاج إلاّ إلى الدعوى الثانية فقط. هذا ، مع أنّ إطلاق الدليل أيضاً يقتضي رفع الموضوع بجميع آثاره .
لا يقال : إنّ الدعوى الاُولى ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ; فإنّ لهذه العناوين آثاراً غير شرعية، فهي غير مرفوعة جدّاً . فلابدّ من دعوى أنّ الآثار غير الشرعية في حكم العدم ، أو أنّ الآثار الشرعية جميع الآثار ، وأيّ فرق بين أن يقال : إنّ هذا الأثر الشرعي جميع الآثار الشرعية ، أو أنّ الآثار الشرعية تمام الآثار ؟
لأنّا نقول : لا حاجة إلى هذه الدعوى بعدما كان الرفع في محيط التشريع ; فإنّ وظيفة الشارع رفع أو وضع ما هو بيده ، وأمّا الخارج عن يده فليس له بالنسبة إليهما شأن . فالآثار التكوينية مغفول عنها ، فلا يحتاج إلى الدعوى .
لا يقال : إنّ المرفوع بالحديث عند طروّ الخطأ والنسيان الآثار المترتّبة على ذات المعنونات ، وأمّا الآثار المترتّبة على نفس الخطأ والنسيان فغير مرفوع قطعاً . فعلى هذا يحتاج إلى الدعوى الاُولى .
لأنّا نقول : إنّ المرفوع إنّما هو آثار الخطأ والنسيان المأخوذين طريقاً إلى متعلّقاتهما ، وعنواناً ومرآة إلى معنونهما ; فإنّه المتبادر من الحديث عند الإلقاء .
فعلى هذا فالآثار المترتّبة على نفس الخطأ والنسيان على نحو الموضوعية مغفولة عنها ، فلا يحتاج إلى الدعوى .
وإن شئت قلت : إنّ العرف لا يفهم من رفعهما إلاّ رفع آثار ما أخطأ ونسي ، كما هو المتبادر إذا قيل : «جهالاتهم معفوّة» . ويدلّ على ذلك تعبير الإمام في صحيحة البزنطي ; حيث نقل الحديث بلفظ : «ما أخطأوا» .
فظهر : عدم شمول الحديث للآثار المترتّبة على نفس العناوين ، وعدم لزوم التفكيك بين فقرات الحديث ; فإنّ أكثر العناوين المذكورة في الحديث مأخوذ على نحو الطريقية ; خصوصاً فيما نسب فيه الرفع إلى الموصول ، فيكون ذلك قرينة على انتقال الذهن عند استماع إسناد الرفع إليها إلى رفع آثار معنوناتها ، لا غير .
نعم ، العناوين الثلاثة الأخيرة ـ الحسد ، والطيرة والوسوسة ـ عناوين نفسية ، لا مناص فيها إلاّ رفع ما هو آثار لأنفسها ; لعدم قابليتها على الطريقية ; وإن لزم منه التفكيك ، إلاّ أنّ هذا المقدار ممّا لابدّ منه .
وإن أبيت إلاّ عن وحدة السياق يمكن أن يقال : إنّ الرفع قد تعلّق في الجميع بعناوين نفسية حسب الإرادة الجدّية ، إلاّ أنّ ذلك إمّا بذكر نفس تلك العناوين النفسية ، أو بذكر ما هو طريق إليها ; من الخطأ والنسيان ، أو بتوسّط الموصول ، من دون تفكيك أو ارتكاب خلاف ظاهر .
الأمر الخامس : في شمول الحديث للأمور العدمية بعدما أثبتنا : أنّ المرفوع في الحديث هو عموم الآثار ، فهل يختصّ بالاُمور الوجودية ـ أي رفع آثار اُمور موجودة في الخارج إذا انطبق عليها إحدى تلك العناوين ـ أو يعمّ ؟
مثلاً : لو نذر أن يشرب مـن ماء الفرات ، فاُكره على الترك أو اضطـرّ إليه أو نسي أن يشربـه فهل يجب عليه الكفّارة ـ بناءً على عـدم اختصاصها بصورة التعمّد ـ أو لا ؟
فيظهر عن بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ اختصاصه بالاُمور الوجودية ; حيث قال : إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود ; لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون وضعاً لا رفعاً ، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان ، فلم يصدر منه أمر وجودي قابل للرفع .
ولا يمكن أن يكون عدم الشرب في المثال مرفوعاً وجعله كالشرب ; حتّى يقال : إنّه لم يتحقّق مخالفة النذر ، فلا حنث ولا كفّارة .
والحاصل : أنّه فرق بين الوضع والرفع ; فإنّ الوضع يتوجّه إلى المعدوم فيجعله موجوداً ويلزمه ترتيب آثار الوجود ، والرفع بعكسه ، فالفعل الصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه ، وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلّف عن نسيان أو إكراه فلا محلّ للرفع فيه ; لأنّ رفع المعدوم لا يمكن إلاّ بالوضع والجعل ، والحديث حديث رفع لا حديث وضع(20) ، انتهى .
وفيه : أنّ ترك الشرب بعد ما تعلّق عليه النذر وصار ذات أثر يكون له ثبوت في عالم الاعتبار; إذ ما لا ثبوت له ـ ولو بهذا النحو من الثبوت ـ لا يقع تحت دائرة الحكم ، ولا يصير موضوعاً للوفاء والحنث .
كيف ، وقـد فرضنا أنّ الكفّارة قـد تترتّب على ترك ذاك الترك ، وصار مـلاكاً للحنث ، وبعد هـذا الثبوت الاعتباري لا مانع مـن تعلّق الرفـع عليـه بما لـه مـن الآثار .
وأمّا ما أفاده من أنّ الرفع لا يمكن إلاّ بالوضع غريب جدّاً ; فإنّ الرفع قد تعلّق بحسب الجدّ على أحكام تلك العناوين وآثارها ، فرفع تلك الآثار ـ سواء كانت أثر الفعل أو الترك ـ لا يستلزم الوضع أصلاً .
على أنّ التحقيق : أنّه لا مانع من تعلّق الرفع بالاُمور العدمية ; إذ الرفع رفع ادّعائي لا حقيقي ، والمصحّح له ليس إلاّ آثار ذلك العدم وأحكامها ، كما أنّ المصحّح لرفع الاُمور الوجودية هو آثارها وأحكامها .
أضف إلى ذلك : أنّ مصبّ الرفع وإن كان نفس الأشياء لكن لا بما هي هي ، بل بمعرّفية العناوين المذكورة في الحديث ، فكلّ أمر يتعلّق عليه الاضطرار أو يقع مورد النسيان والإكراه فهو مرفوع الأثر لأجل تلك العناوين ، من غير فرق ; سواء كان المضطرّ إليه أمراً وجودياً أو عدمياً .
وربّما يقال في مقام جواب المستشكل : أنّ الرفع مطلقاً متعلّق بموضوعية الموضوعات للأحكام; فمعنى رفع «ما اضطرّوا إليه» أنّه رفع موضوعيته للحكم ، وكذا في جانب العدم والترك(21) ، انتهى .
وفيه : أنّه لو رجع إلى ما قلناه فنِعْم الوفاق والاتّفاق ، وإن أراد ظاهره من تقدير موضوعية كلّ واحد لأحكامها فهو ضعيف جدّاً ; لأ نّه يكون أسو حالاً من تقدير الآثار ، بل لا يصير الرفع ادّعائياً ، مع أنّه قد اعترف القائل في بعض كلماته : أنّ الرفع ادّعائي(22) .
الأمر السادس في شمول الحديث للأجزاء والشرائط والأسباب والمسبّبات:
القول في نسيان الجزء والشرط في العبادات
لو نسي شرطاً أو جزءً من المأمور به فهل يمكن تصحيحها بالحديث ـ بناءً على عموم الآثار ـ أو لا يمكن ; وإن كان المرفوع هو العموم ؟
واختار الثاني بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ ، وأوضحه بوجوه :
منها : أنّ الحديث لا يشمل الاُمور العدمية ; لأنّه لا محلّ لورود الرفع على الجزء والشرط المنسيين ; لخلوّ صفحة الوجود عنهما ، فلا يمكن أن يتعلّق الرفع بهما .
ومنها : أنّ الأثر المترتّب على الجزء والشرط ليس إلاّ الإجزاء وصحّة العبادة ، وهما ليسا من الآثار الشرعية التي تقبل الوضع والرفع ، بل من الآثار العقلية .
ومنها : أنّه لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة ; فإنّ ذلك يقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة ، وهو ينافي الامتنان وينتج عكس المقصود ; فإنّ المقصود من التمسّك بالحديث تصحيح العبادة لا فسادها . هذا كلّه بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط .
وأمّا بالنسبة إلى المركّب الفاقد للجزء أو الشرط المنسي فهو وإن كان أمراً وجودياً قابلاً لتوجّه الرفع إليه إلاّ أنّه :
أوّلاً : ليس هو المنسي أو المكرَه عليه ليتوجّه الرفع إليه .
وثانياً : لا فائدة في رفعه ; لأنّ رفع المركّب الفاقد للجزء أو الشرط لا يثبت المركّب الواجد له ; فإنّ ذلك يكون وضعاً لا رفعاً . وليس للمركّب الفاقد للجزء أو الشرط أثر يصحّ رفع المركّب بلحاظه ; فإنّ الصلاة بلا سورة ـ مثلاً ـ لا يترتّب عليها أثر إلاّ الفساد وعدم الإجزاء ، وهو غير قابل للرفع الشرعي .
ولا يمكن أن يقال : إنّ الجزئية والشرطية مرفوعتان ; لأنّ جزئية الجزء لم تكن منسية ، وإلاّ كان من نسيان الحكم ، ومحلّ الكلام إنّما هو نسيان الموضوع . فلم يتعلّق النسيان بالجزئية حتّى يستشكل بأنّ الجزئية غير قابلة للرفع ; فإنّها غير مجعولة ، فيجاب بأنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها(23) ، انتهى .
وقبل الخوض فيما يرد على كلامه نذكر ما هو المختار :
فنقول : إنّ النسيان قد يتعلّق بالجزئية والشرطية ، فيكون مساوقاً لنسيان الحكم الكلّي ، وقد يتعلّق بنسيان نفس الجزء والشرط مع العلم بحكمهما ، كما هو المبحوث في المقام .
وحينئذ فلا مانع من أن يتعلّق الرفع بنفس ما نسوا حتّى يعمّ الرفع كلا القسمين ; فإنّ المنسي قد يكون الجزئية وقد يكون نفس الجزء والشرط ; فلو تعلّق الرفع بنفس ذات الجزء والشرط بما لهما من الآثار يصير المأمور به ـ عندئذ ـ هو المركّب الفاقد لهما ، ويكون تمام الموضوع للأمر في حقّ الناسي هو ذلك الفاقد ، وهو يوجب الإجزاء على ما مرّ تفصيله في مبحث الإجزاء(24) .
وإن شئت قلت : إنّ الحديث حاكم على أدلّة المركّبات أو على أدلّة الأجزاء والشرائط ، وبعد الحكومة تصير النتيجة اختصاص الأجزاء والشرائط بغير حالة النسيان ، ويكون تمام المأمور به في حقّ المكلّف عامّة الأجزاء والشرائط ، غير المنسي منها .
والقول بحكومتها في حال نسيان الحكم ـ الجزئية ـ لا في حال نسيان نفس الجزء والشرط تحكّم محض بعد القول بتعلّق الرفع بنفس ما نسوا ; أي المنسي على نحو الإطلاق .
فإن قلت : إنّ النسيان إذا تعلّق بالموضوع ولم يكن الحكم منسياً لا يرتفع جزئية الجزء للمركّب; لعدم نسيانها ، فلابدّ من تسليم مصداق واجد للجزء ; حتّى ينطبق عليه عنوان المأمور به .
ولا معنى لرفع الجزء والشرط من مصداق المأمور به . ولو فرض رفعه لا يكون مصداقاً للمأمور به ما لم يدلّ دليل على رفع الجزئية .
وبالجملة : لا يعقل صدق الطبيعة المعتبرة فيها الجزء والشرط على المصداق الفاقد لهما ، ولا معنى لحكومة دليل الرفع على الأدلّة الواقعية مع عدم تعلّق النسيان بالنسبة إليها ، كما أنّه لا معنى لحكومته على مصداق المأمور به .
قلت : هذا رجوع عمّا ذكرناه أساساً لهذا البحث ; فإنّ عقد هذا البحث إنّما هو بعد القول برفع الآثار عامّة . وعليه : فمعنى رفع نفس الجزء رفع جميع آثاره الشرعية التي منها الجزئية .
فمرجع رفع الجزء إلى رفع جزئية الجزء للمركّب عند نسيان ذات الجزء ، ويتقيّد دليل إثبات الجزء بغير حالة النسيان ، ومرجع رفع جزئيته إلى كون المركّب الفاقد تمام المأمور به ، و إتيان ما هو تمام المأمور به يوجب الإجزاء وسقوط الأمر ، ويكون بقاء الأمر بعد امتثاله بلا جهة ولا ملاك .
فإن قلت : لو كان مفاد رفع جزئية المنسي مطلقاً ـ حتّى بعد التذكّر والالتفات ـ ملازماً لتحديد دائرة المأمور به في حال النسيان بما عدا المنسي لكان لاستفادة الإجزاء وعدم وجوب الإعادة مجال ، ولكن ذلك خارج عن عهدة حديث الرفع ; حيث إنّه ليس من شأنه إثبات التكليف بالفاقد للمنسي ، وإنّما شأنه مجرّد رفع التكليف عن المنسي مادام النسيان(25) .
قلت : قد ذكر ذلك الإشكال بعض محقّقي العصر ، غير أنّه يظهر ضعفه بعد المراجعة بما حرّرناه في مبحث الإجزاء(26) ; فإنّ معنى حكومته على الأدلّة الواقعية ليس إلاّ تقييد الدليل الدالّ على جزئيته بغير حالة النسيان ، أو تخصيصه بغير هذه الحالة ، فلو أتى بالمركّب الفاقد للجزء فقد امتثل الأمر الواقعي ، ولا معنى بعدم الإجزاء بعد امتثاله .
وبعد الوقوف على ما ذكرنا يظهر لك : أنّه لا يحتاج إلى إثبات كون حديث الرفع محدّداً لدائرة التكليف أو متعرّضاً إلى بعد حال النسيان ، أو غير ذلك ممّا هو مذكور في كلامه .
إذا عرفت ذلك : يظهر لك الخلل فيما نقلناه عن بعض الأعاظم ـ قدس سره ـ (27) ; إذ فيما أفاده مواقع للأنظار ، نشير إلى بعضها :
منها : أنّ ما هو متعلّق الرفع إنّما هو نفس الجزء المنسي بما له من الآثار ، وقد مرّ أنّ معنى رفعه إخراجه عن حدود الطبيعة المأمور بها ، وأمّا ترك الجزء فليس متعلّقاً له حتّى يرد عليه ما أفاد من أنّ الرفع لا يتعلّق بالأعدام .
ومنها : أنّ الأثر المترتّب على الجزء والشرط إنّما هو الجزئية والشرطية ،وهما ممّا تنالهما يد الجعل باعتبار منشأ انتزاعهما ، ولا يحتاج في رفعهما إلى أثر آخر ; حتّى يقال : إنّ الإجزاء وصحّة العبادة من الآثار العقلية ، كما لا يخفى .
ومنه يظهر النظر في ثالث الوجوه التي ذكرها ـ قدس سره ـ ، فراجع .
فإن قلت : إنّما يصحّ عبادة الناسي ، ويكون المركّب الفاقد تمام المأمور به في حقّه فيما إذا أمكن تخصيص الناسي بالخطاب ، وأمّا مع عدم إمكانه ـ لأجل كون الخطاب بقيد أنّه ناس يوجب انقلاب الموضوع إلى الذاكر ـ فلا يمكن تصحيح عبادته .
قلت : قد ذكر المشايخ ـ قدّس الله أسرارهم ـ وجوهاً صحّحوا بها تخصيص الناسي بالخطاب(28) ; وإن كان كلّها غير خال عن التكلّف ، إلاّ أنّ التصحيح لا يتوقّف على تخصيصه بالتكليف .
بل الأمر المتعلّق بالصلاة في الكتاب والسنّة كاف في التصحيح ; فإنّ الذاكر والناسي إنّما يقصد بقيامه وقعوده امتثال تلك الخطابات المتعلّقة بالطبيعة التي منها قوله تعالى : {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78] ، والداعي إلى العمل والباعث نحو الفعل في الذاكر والناسي أمر واحد بلا اختلاف في هذه الجهة ، وإنّما الاختلاف في مصداق الطبيعة ، وهو لا يوجب اختلافاً في الأمر .
وبالجملة : أنّ الفرد الكامل والفرد الناقص كلاهما فردان من الطبيعة المأمور بها ، غير أنّه يلزم على الذاكر إيجادها في ضمن ذلك الفرد الكامل ، وعلى الناسي إيجادها في ضمن ذلك الناقص ; لرفع جزئية الجزء في حقّ الناسي لأجل حكومة الحديث ، وإيجاد الفرد إيجاد لنفس الطبيعة المأمور بها ، وإيجادها مسقط للأمر محصّل للغرض موجب للإجزاء .
وإن شئت فنزّل المقام بما دلّ على الاكتفاء بالطهارة الترابية عند فقدان الماء ; فإنّ باعث الواجد والفاقد إنّما هو أمر واحد ; وهو الأوامر المؤكّدة في الكتاب والسنّة ، والمأمور به هو الطبيعة الواحدة ـ أعني طبيعة الصلاة ـ غير أنّه يجب على الواجد إيجادها بالطهارة المائية وعلى غير المتمكّن إيجادها بالطهارة الترابية .
والاختلاف في المصداق لا يوجب تعدّد الأمر والخطاب ، ولا يوجب وقوع طبيعة الصلاة متعلّقاً لأمرين .
وإذا اتّضح الحال فيها : فقس المقام عليه ; فإنّ حديث الرفع يجعل الفاقد مصداق الطبيعة ، ولا يصير الطبيعة متعلّقة لأمرين ، ولا تحتاج إلى خطابين ، ولا إلى توجّهه بحاله ، ولا إلى كون المصداق هو الناقص ; حتّى يبحث عن إمكان اختصاص الناسي بالخطاب .
فقد اتّضح ممّا ذكر صحّة عبادة الناسي بحديث الرفع .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ قد أيّد ما ادّعاه ـ قصور حديث الرفع عن إثبات صحّة عبادة الناسي ـ بأنّ المدرك لصحّة الصلاة الفاقدة للجزء والشرط نسياناً إنّما هو قاعدة لا تعاد . فلو كان المدرك حديث الرفع كان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقاً ، من غير فرق بين الأركان وغيرها ; فإنّه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع . ويؤيّد ذلك: أنّه لم يعهد من الفقهاء التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاة وغيرها من سائر المركّبات(29) ، انتهى .
وفيه : أنّ استفادة التفصيل بين الأركان وغيرهـا مـن قاعدة لا تعاد لا يوجب عـدم كون حـديث الرفع دليلاً لصحّة عبادة الناسي ، غايـة الأمـر يلزم مـن الجمع بين الدليلين تخصيص أحدهما ـ أعني حديث الرفع ـ بما يقتضيه الآخـر من التفصيل .
وأمّا ما أفاده من عدم معهودية التمسّك به في كلمات القوم فكفاه منعاً تمسّك السيّدين ـ علم الهدى وابن زهرة ـ به عند البحث عن التكلّم في الصلاة نسياناً ، وكلامهما وإن كان في خصوص التكلّم إلاّ أنّه يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع الموارد إلاّ ما قام عليه دليل :
قال الأوّل في «الناصريات» : دليلنا على أنّ كلام الناسي لا يبطل الصلاة ـ بعد الإجماع المتقدّم ـ ما روي عنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «رفع عن اُمّتي النسيان وما استكرهوا عليه» . ولم يرد رفع الفعل ; لأنّ ذلك لا يرفع ، وإنّما أراد رفع الحكم ، وذلك عامّ في جميع الأحكام إلاّ ما قام عليه دليل(30) .
ويقرب منـه كلام ابن زهـرة في «الغنيـة»(31) وتبعهما العلاّمـة والأردبيلي في مواضع(32).
وقد نقل الشيخ الأعظم في مسألة ترك غسل موضع النجو عن المحقّق في «المعتبر»(33) أنّه تمسّك بالحديث لنفي الإعادة في مسألة ناسي النجاسة(34) .
وقد تمسّك(35) الشيخ الأعظم وغيره في مواضع بحديث الرفع لتصحيح الصلاة ، فراجع .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من البيان جار في النسيان المستوعب للوقت وغير المستوعب ، بلا فرق بينهما أصلاً ; لأنّ المفروض أنّ الطبيعة كما يتشخّص بالفرد الكامل كذلك يوجد بالناقص منه ، وبعد تحقّق الطبيعة التي تعلّق بها الأمر لا معنى لبقاء الأمر ; لحصول الامتثال بعد إتيانها .
والحاصل : أنّ هنا أمراً واحداً متعلّقاً بنفس الطبيعة التي دلّت الأدلّة الواقعية على جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته لها ، والمفروض حكومة الحديث على تلك الأدلّة ، وتخصيصها بحال الذكر أو بغير حال النسيان ، فيبقى إطلاق الأمر المتعلّق بالطبيعة بحالها ، ويصير الإتيان بالفرد الناقص إتياناً بتمام المأمور به في ذلك الحال ، وهو يلازم الإجزاء وسقوط الأمر .
وكون النسيان مستوعباً أو غير مستوعب لا يوجب فرقاً في الحكم ; فإنّ حكومة الحديث في جزء من الوقت كاف في انطباق ما هو عنوان المأمور به عليه ، وبانطباقه يسقط الأمر بلا إشكال .
وممّا ذكرنا يظهر الإشكال فيما أفاده بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ ; حيث قال : إنّه لا يصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في جزء من الوقت مع التذكّر في بقيّته ; لأنّ المأمور به هو الفرد الكلّي الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ; ولو في جزء من الوقت . فمع التذكّر في أثناء الوقت يجب الإتيان بالمأمور به ; لبقاء وقته لو كان المدرك حديث الرفع ; لأنّ المأتي به لا ينطبق على المأمور به .
فلولا حديث لا تعاد كان اللازم هو إعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسياناً مع التذكّر في أثناء الوقت(36) ، انتهى .
وأنت خبير بمواقع النظر فيما أفاده ، فلا نطيل بتكرار ما سبق منّا .
القول في نسيان الأسباب في المعاملات إنّ ما ذكرنا كلّه في ناحية الجزء والشرط جار في السبب حرفاً بحرف .
غير أنّ بعض أعاظم العصر قد أفاد في المقام : أنّ وقوع النسيان والإكراه والاضطرار في ناحيتها لا يقتضي تأثيرها في المسبّب ولا تندرج في حديث الرفع ; لما تقدّم في باب الأجزاء والشرائط من أنّ حديث الرفع لا يتكفّل تنزيل الفاقد منزلة الواجد . فلو اضطرّ إلى إيقاع العقد بالفارسية أو اُكره عليه أو نسي العربية كان العقد باطلاً ـ بناءً على اشتراط العربية ـ فإنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي ، وليس للعقد الفارسي أثر يصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره ، وشرطية العربية ليست منسية حتّى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية(37) ، انتهى .
قلت : التحقيق هو التفصيل : فإن تعلّق النسيان بأصل السبب أو بشرط من شرائطه العقلائية الذي به قوام العقد عرفاً ـ كإرادة تحقّق معناه ـ فلا ريب في بطلان المعاملة ; إذ ليس هنا عقد عرفي حتّى يتّصف بالصحّة ظاهراً .
وإن تعلّق بشرط مـن شرائط الشرعيـة ، ككونه عربياً ، أو تقدّم الإيجاب على القبول ونحـو ذلك; فلا إشكال في تصحيح العقد المذكـور بحـديث الـرفع ; فإنّ الموضوع ـ أعني نفس العقد ـ محقّق قطعاً في نظر العرف ، غير أنّه فاقـد للشرط الشرعي .
فلو قلنا بحكومة الحديث على الشرائط ; بمعنى رفع شرطية العربية أو تقدّمه على القبول في هذه الحالة يصير العقد الصادر من العاقد عقداً مؤثّراً في نظر الشارع أيضاً . والنسيان وإن تعلّق بإيجاد الشرط لا بشرطيته لكن لا قصور في شمول الحديث لذلك ; لأنّ معنى رفع الشرط المنسي رفع شرطيته في هذا الحال ، والاكتفاء بالمجرّد منه .
وأمّا ما أفاده من أنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي فواضح الإشكال ; لأنّ النسيان لم يتعلّق بالفارسي من العقد حتّى يترتّب عليه ما ذكر ، بل إنّما تعلّق بالشرط ـ أعني العربية ـ فرفعه رفع لشرطيته في المقام ، ورفع الشرطية عين القول بكون ما صدر سبباً تامّاً .
وتوهّم : أنّ القول بصحّة العقد المجرّد عن الشرط خلاف المنّة ، بل فيه تكليف المكلّف بوجوب الوفاء بالعقد ، ولا يعدّ مثل ذلك امتناناً أصلاً(38) ، مدفوع بأنّ إنفاذ المعاملة وتصحيحها حسب ما تراضيا عليه امتنان جدّاً ; إذ ليس وجوب الوفاء أمراً على خلاف رضائه ، بل هو ممّا أقدم المتعاقدان عليه بطيب نفسهما .
فإنفاذ ما صدر عن المكلّف بطيب نفسه إحسان له ، فأيّ منّة أعظم من تصحيح النكاح الذي مضى منه عشرون سنة ، وقد رزق الوالدان طيلة هذه المدّة أولاداً ؟ ! فإنّ الحكم ببطلان ما عقده بالفارسية مع كون الحال كذلك من الاُمور الموحشة الغريبة التي يندهش منه المكلّف ، وهذا بخلاف القول بالصحّة .
القول في الإكراه:
فإن تعلّق الإكراه على ترك إيجاد السبب أو ما يعدّ أمراً مقوّماً للعقد فهو كالنسيان .
وأمّا المانع : فلو تعلّق الإكراه بإيجاد مانع شرعي : فإن كان العاقد مضطرّاً اضطراراً عادياً أو شرعياً لإيجاد العقد ، والمكرِه يكرهه على إيجاده فالظاهر جواز التمسّك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف ـ على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان ـ وإن لم يكن مضطرّاً للعقد فالظاهر عدم صحّة التمسّك ; لعدم صدق الإكراه .
وأمّا إذا تعلّق الإكراه بترك الجزء والشرط فقد بنينا سابقاً على صحّة التمسّك بالحديث على رفع جزئيته أو شرطيته في حال الإكراه إذا كان مضطرّاً في أصل العقد عادة أو شرعاً(39) ، غير أنّه عدلنا عنه أخيراً .
ومحصّل المختار فيه : عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة ; لأنّ الإكراه قد تعلّق بترك الجـزء والشرط ، وليس للترك ـ بما هـو هـو ـ أثر شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجـوب الإعادة ، وهـو ليس أثراً شرعياً ، بل مـن الاُمـور العقلية الواضحـة .
فإنّ ما يرجع إلى الشارع ليس إلاّ جعل الجزئية والشرطية تبعاً أو استقلالاً ، بناءً على صحّـة جعلهما أو إسقاطهما ـ كما في مـوارد النسيان ـ وأمّا إيجاب الإعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به للمأتي به فإنّما هو أمر عقلي يدركه هـو عند التطبيق .
وتوهّم : أنّ مرجع الرفع عند الإكراه على ترك جزء أو شرط إلى رفع جزئيته وشرطيته في هذه الحالة ، كما مرّ توضيحه في رافعية النسيان إذا تعلّق بنفس الجزء والشرط .
مدفوع بأنّ المرفوع لابدّ وأن يكون ما هو متعلّق العنوان ; ولو باعتبار أنّه أثر لما تعلّق به العنوان ، كالجزئية عند تعلّق النسيان بنفس الجزء ، وأمّا المقام فلم يتعلّق الإكراه إلاّ بنفس ترك الجزء والشرط ، والجزئية ليست من آثار نفس الترك . نعم لو كان لنفس الترك أثر شرعي يرتفع أثره الشرعي عند الإكراه .
لا يقال : إنّ وجوب الإعادة مترتّب على بقاء الأمر الأوّل ، كترتّب عدم وجوبها على عدم بقائه، فإذا كان بقاء الأمر كحدوثه أمراً شرعياً تناله يد الجعل والرفع ، فلا محذور في التمسّك بالحديث لنفي وجوب الإعادة .
لأنّا نقول : إنّ وجوب الإعادة ليس أثراً شرعياً في حدّ نفسه ، ولا أثراً مجعولاً لبقاء الأمر الأوّل ، بل هو أمر عقلي منتزع ، يحكم به إذا أدرك مناط حكمه .
وما يرى في الأخبار مـن الأمـر بالإعادة فإنّما هـو إرشاد إلى فساد المأتي به وبطلانه .
ويشهد على ذلك : أنّ التارك للإعادة لا يستحقّ إلاّ عقاباً واحداً لأجل عدم الإتيان بالمأمور به ، لا لترك إعادته . واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف إلى وجوب الإعادة باطل بالضرورة.
فتلخّص من جميع ما ذكر : أنّ الإكراه إن تعلّق بإيجاد المانع فيمكن أن يتمسّك بحديث الرفع لتصحيح المأتي به ، وأمّا إذا تعلّق بترك الجزء والشرط فلا ، كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط وبين تركهما لأجل الإكراه ، فلاحظ .
القول في الاضطرار:
فقد ظهر حاله ممّا فصّلناه في حال الإكراه حرفاً بحرف ، وحاصله : أنّه لو تعلّق بما له حكم تكليفي ـ أي بإتيان حرام نفسي أو ترك واجب ـ فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار ; أي حرمة فعله في الحرام ، ومبغوضية تركه في الواجب ، بناءً على الملازمة العرفية بين الأمر بالشيء ومبغوضية تركه .
وإن تعلّق بإيجاد مانع في أثناء المعاملة أو العبادة فلا إشكال في صحّة العمل برفع المانعية في ذلك الظرف ، كما مرّ بيانه في النسيان والإكراه .
وإن تعلّق بترك جزء أو شرط فلا يمكن تصحيح العمل به حسب ما أوضحناه في الإكراه ، فلا نعيده .
القول في المسبّبات :
فلنذكر ما أفاده بعض أعاظم العصر ، ثمّ نعقّبه بما هو المختار :
قال ـ قدس سره ـ : المسبّبات على قسمين ، فهي :
تارة : تكون من الاُمور الاعتبارية التي ليس بحذائها في وعاء العين شيء ، كالملكية والزوجية ممّا أمضاها الشارع ، فهذا القسم من الأحكام الوضعية يستقلّ بالجعل ; فلو فرض أنّه أمكن أن يقع المسبّب عـن إكراه ونحوه كان للتمسّك بحديث الرفع مجال . فينزّل المسبّب منزلة المعدوم في عدم ترتّب الآثار المترتّبة على المسبّب . لا أقول : إنّ الرفع تعلّق بالآثار ، بل تعلّق بنفس المسبّب ; لأنّـه بنفسه ممّا تناله يد الجعل .
واُخرى : ما يكون المسبّب من الاُمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ، كالطهارة والنجاسة ; فإنّها غير قابلة للرفع التشريعي ، ولا تناله يد الجعل والرفع . نعم يصحّ أن يتعلّق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتّب عليها من الآثار الشرعية .
ولا يتوهّم : أنّ لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من اُكره على الجنابة ، أو عدم وجوب التطهير على من اُكره على النجاسة ; بدعوى : أنّ الجنابة المكره عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعي إلاّ أنّها باعتبار ما لها من الأثر ـ وهو الغسل ـ قابلة للرفع .
فإنّ الغسل والتطهير أمران وجوديان قد أمر بهما الشارع عقيب الجنابة والنجاسة مطلقاً ; من غير فرق بين الجنابة الاختيارية وغيرها(40) ، انتهى كلامه .
قلت : إنّ ما تفصّى به عن الإشكال غير صحيح ; فإنّ كونهما أمرين وجوديين لا يوجب عدم صحّة رفعهما ، كما أنّ إطلاق الدليل في الجنابة الاختيارية وغيرها لا يمنع عن الرفع ; ضرورة أنّ الغرض حكومة الحديث على الإطلاقات الأوّلية ، بل الإطلاق مصحّح للحكومة ، كما لا يخفى .
والأولى أن يقال في التفصّي عن الإشكال : إنّه قد تحقّق في محلّه أنّ الغسل مستحبّ نفسي قد جعل بهذه الحيثية مقدّمة للصلاة(41) .
وعلى ذلك : فالمرفوع بالحديث في الصورة المفروضة لو كان هو الاستحباب النفسي فغير صحيح ; لأنّ الحـديث حديث امتنان ، ولا منّـة في رفـع المستحبّات .
وإن كان المرفوع شرطيته للصلاة فلا ريب أنّ الإكراه إنّما يتحقّق إذا اُكره على ترك الغسل للصلاة . فحينئذ فلو ضاق الوقت وتمكّن المكلّف من التيمّم فلا إشكال في أنّه يتبدّل تكليفه إلى التيمّم ، وإن لم يتمكّن منه ; بأن اُكره على تركه أيضاً صار كفاقد الطهورين . والمشهور سقوط التكليف عن فاقده . هذا كلّه في الطهارة الحدثية .
وأمّا الخبثية من الطهارة فلو أكرهه المكرِه على ترك غسل البدن والساتر ، إلى أن ضاق الوقت فلا ريب أنّه يجب عليه الصلاة كذلك ، فيرفع شرطية الطهارة بالحديث . ولو أمكن أن يخفّف ثوبه ونزعه فيجب عليه ـ على الأقوى ـ ولو لم يتمكّن فعليه الصلاة به ، ويصير المقام من صغريات الإكراه بإيجاد المانع ، وقد مرّ حكمه(42) .
بحث وتحقيق:
في عدم اختصاص رافعية الإكراه بباب المعاملات بالمعنى الأخصّ:
إنّ بعض محقّقي العصر ـ قدس سره ـ قد قال باختصاص مجرى الرفع في قوله : «ما استكرهوا عليه» بباب المعاملات بالمعنى الأخصّ ، بعكس الرفع في الاضطرار ، فلا يجري في التكليفيات من الواجبات والمحرّمات ; لأنّ الإكراه على الشيء يصدق بمجرّد عدم الرضا بإيجاده ، ومع التوعيد اليسير أو أخذ مال كذلك ، مع أنّه غير مسوغ لترك الواجب أو الإتيان بالمحرّم . نعم لو بلغ ذلك إلى حدّ الحرج جاز ذلك ، ولكنّه لأجل الحرج لا الإكراه(43) ، انتهى ملخّصاً .
وفيه : ـ مضافاً إلى عدم اختصاصه بالضرورة للمعاملات بالمعنى الأخصّ ; لجريانـه في الطلاق والنكاح والوصيـة وغيرها مـن المعاملات بالمعنى الأعمّ ـ أنّ ما ذكره لا يوجب الاختصاص ، بل يوجب اختصاص رافعية الإكراه لبعض مراتبه دون بعض .
كيف ، وقد ورد في بعض الروايات(44) في تفسير قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «رفع ما اُكرهوا» أنّه إشارة إلى قوله تعالى : {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] الذي ورد في شأن عمّار(45) ، ومن المعلوم أنّ ما صدر من عمّار من التبرّي عن الله ورسوله كان حراماً تكليفياً قد ارتفع بالإكراه .
أضف إلى ذلك : ما ورد في حقّ الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان(46) ، وفي حقّ المكرهة على الزنا(47): أنّه لا شيء عليهما عند الإكراه ، وهذا يدلّ على عمومية رافعية الإكراه للوضعي والتكليفي .
وما أفاده من أنّ الإكراه إن وصل إلى الحرج جاز ذلك ، إلاّ أنّه من جهة الحرج لا الإكراه ، مدفوع بأنّ التدبّر في الروايات والآية يعطي أنّ علّة ارتفاع الحكم لأجل كون المكلّف مكرهاً .
أضف إلى ذلك : أنّ الإكراه الشديد لأجل توعيده بأمر لا يتحمّل عادة لا يوجب كون المكرَه فيه ـ أي متعلّق الإكراه ـ حرجياً ، إلاّ مع التكلّف .
فلو أكرهه المكره على شرب الخمر وأوعده بالضرب والجرح فما هو متعلّق الإكراه ليس حرجياً . وكون تركه حرجياً لأجل ما يترتّب عليه عند الترك لا يوجب اتّصاف متعلّق الإكراه بالحرج إلاّ بالتكلّف ، وهذا بخلاف الإكراه ; فإنّ الشرب متعلّق للإكراه بلا ريب . وقصارى ما يمكن أن يقال : إنّ الضرورة قاضية على عدم كفاية الإكراه لارتكاب بعض المحرّمات ، وهو ليس بأمر غريب ، ولها نظائر وشواهد في الفقه ; فإنّ بعض العظائم من المحرّمات لا يمكن رفع حكمه بالحديث بعامّة عناوينها ، ولا بعنوان آخر كالتقيّة .
وقـد ذكرنا تفصيل ذلك في الرسالة(48) التي عملناها لبيان حال التقيّة ، فراجع(49) .
الأمر السابع : تصحيح العبادة بالحديث عند الشكّ في المانعية:
قد فصّل شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ فيما إذا شكّ في مانعية شيء للصلاة بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، فاستشكل جريان البراءة في الثانية .
وقد أفاد في وجهه : أنّ الصحّة فيها إنّما يكون ما دام شاكّاً ، فإذا قطع بالمانعية يجب عليه الإعادة ، ولا يمكن القول بتخصيص المانع بما علم مانعيته ; فإنّه مستحيل ، بخلاف الشبهة الموضوعية ; لإمكان ذلك فيها(50) .
أقول : إنّ المستحيل إنّما هو جعل المانعية ابتداءً في حقّ العالم بالمانعية ،لاستلزامه الدور ، وأمّا جعلها ابتداءً بنحو الإطلاق ، ثمّ إخراج ما هو مشكوك مانعيته ببركة حديث الرفع ; بأن يرفع فعلية مانعيته في ظرف مخصوص فليس بمستحيل ، بل واقع شائع . وقد مرّ نبذ من الكلام في الإجزاء(51) وفي البحث عن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية(52) .
وأمّا الاكتفاء بما أتى به المكلّف وسقوط الإعادة والقضاء فقد مرّ بحثه تفصيلاً(53) ، وخلاصته: أنّ حكومة الحديث على الأدلّة الأوّلية يقتضي قصر المانعية على غير هذه الصور التي يوجد فيها إحدى العناوين المذكورة في الحديث . وعليه : فالآتي بالمأمور به مع المانع آت لما هو تمام المأمور به ، ولازمه سقوط الأمر وانتفاء القضاء . هذا غيض من فيض ، وقليل من كثير ممّا ذكره الأساطين حول الحديث .
الرواية الثانية : حديث الحَجْب:
ممّا استدلّ به على البراءة ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ ، قال : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»(54) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(55) .
وأمّا فقه الحديث : فيحتمل بادئ الأمر وجوهاً :
الأوّل : أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع المكلّفين .
الثاني : أنّ المراد ما حجب الله علمه عن كلّ فرد فرد من أفراد المكلّفين .
الثالث : أنّ المراد كلّ من حجب الله علم شيء عنه فهو مرفوع عنه ; سواء كان معلوماً لغيره أو لا .
والمطابق للذوق السليم هو الثالث ، كما هو المراد من قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في حديث الرفع : «رفع عن اُمّتي ما لا يعلمون»(56) ، على أنّ مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك ; فإنّ الظاهر : أنّ المناط للرفع هو الحجب عن المكلّف ، وحجبه عن الغير وعدمه لا دخل له لذلك ، كما لا يخفى .
وتقرير الاستدلال : أنّ الظاهر من قوله : «موضوع عنهم» هو رفع ما هو المجعول بحسب الواقع ، كما هو المراد في حديث الرفع ، لا ما لم يجعل وسكت عنه تعالى من أوّل الأمر ; فإنّه ما لم يجعل من بدو الأمر فكيف يرفع .
وأنّ الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج من اختيار المكلّف ، لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه . وعندئذ يعمّ كلّ حجب لم يكن مستنداً لتقصيره ; لأجل ضياع الكتب أو طول الزمان أو قصور البيان أو حدوث حوادث ونزول نوازل وملمّات عائقة بحسب الطبع عن بلوغ الأحكام إلى العباد على ما هي . وعندئذ يكون إسناد الحجب إليه على سبيل المجاز .
ومثله كثير في الكتاب والسنّة ; فإنّ مطلق تلك الأفعال يسند إليه تعالى بكثير ، من دون أن يكون خلاف ظاهر في نظر العرف .
وممّا ذكرنا يظهر : ضعف ما أفاده الشيخ الأعظم(57) من أنّ الظاهر من الحديث ما لم يبيّنه للعباد وتعلّقت عنايته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه ; لعدم أمر رسله بتبليغه حتّى يصحّ إسناد الحجب إليه تعالى ، فالرواية مساوقة لما ورد من : «أنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً»(58) .
وجه الضعف : أنّ الظاهر المتبادر من قوله : «موضوع عنهم» هو رفع ما هو المجعول ، لا رفع ما لم يبيّن من رأس ولم يبلّغ ، بل لم يأمر الرسل بإظهاره ; فإنّ ما كان كذلك غير موضوع بالضرورة ولا يحتاج إلى البيان . مع أنّه مخالف لظاهر «موضوع عنهم» .
أضف إلى ذلك : أنّه مخالف للمناسبة المغروسة في ذهن أهل المحاورة .
والداعي لهم لاختيار هذا المعنى تصوّر أنّ إسناد الحجب إلى الله تعالى لا يصحّ إلاّ في تلك الصورة ، وأمّا إذا كان علّة الحجب إخفاء الظالمين وضياع الكتب فالحاجب نفس العباد ، لا هو تعالى . وقد عرفت جوابه ، فلا نكرّره .
الرواية الثالثة : حديث السعة:
من الأخبار التي استدلّوا بها قوله ـ عليه السلام ـ : «الناس في سعة ما لا يعلمون»(59) .
ودلالته على البراءة وعدم لزوم الاحتياط واضح جدّاً ; فإنّه لو كان الاحتياط لازماً عند الجهل بالواقع لما كان الناس في سعة ما لا يعلمون ، بل كان عليهم الاحتياط ، وهو موجب للضيق بلا إشكال .
فإن قلت : بعد العلم بوجوب الاحتياط يرتفع عدم العلم ، وينقلب إلى العلم بالشيء .
قلت : إنّ الظاهر المتبادر هو العلم بالواقع والجهل به ، وليس العلم بوجوب الاحتياط علماً بالواقع ; إذ ليس طريقاً إليه .
وإن شئت قلت : إنّ العلم المستعمل في الروايات وإن كان المراد منه المعنى الأعمّ ـ أي الحجّة لا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ـ ولكن الحجّة عبارة عن الطرق العقلائية والشرعية إلى الواقع التي تكشف كشفاً غير تامّ ، والاحتياط ليس منها بلا إشكال .
والشاهد على ذلك : أنّه لو أفتى أحد على الواقع لقيام الأمارة عليه لما يقال إنّه أفتى بغير علم ، وأمّا إذا أفتى بوجوب شيء لأجل الاحتياط فإنّه أفتى بغير علم .
ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل : إنّ وجوب الاحتياط إن كان نفسياً يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلّة الاحتياط ; لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط(60) .
وجه الضعف : أنّ مفاد الحديث هو الترخيص للناس فيما ليس لهم طريق ولا علم إلى الواقع ، فلو دلّ دليل على لزوم الاحتياط في الموارد التي لم يقف المكلّف على حكم تلك الموارد لعدّ ذلك الـدليل معارضاً للحـديث الشريف ، لا رافعاً لموضوعه .
وإن شئت قلت : إنّ شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخّص فيه حسب الحديث ، فلو تمّ أخبار الاحتياط ولزم وجوب الاحتياط لعدّ ذلك منافياً للترخيص ، من غير فرق بين أن يكون لزوم الاحتياط نفسياً أو غيرياً .
نعم ، لو أمكن القول بالسعة من حيث ما لا يعلمون ـ وإن كان الضيق من حيث الاحتياط النفسي لأجل مصلحة في ذلك الحكم النفسي ـ لكان لما ادّعى وجه . لكنّه كما ترى ; فإنّ جعل السعة ـ حينئذ ـ يكون لغواً بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط .
وأمّا حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد له . مع أنّه اعتراف على تمامية الدلالة .
الرواية الرابعة : حديث الحلّ:
من الروايات التي استدلّ بها للبراءة : قوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» .
ويظهر من الشيخ في المقام(61) بل صريحه في الشبهة الموضوعية(62) ، أنّه رواية مستقلّة بهذا اللفظ ، بلا انضمام كلمة «بعينه» ، ولم نجده في مصادر الروايات ، بل الظاهر : أنّه صدر رواية مسعدة بن صدقة(63) .
وكيف كان : فربّما يستشكل في دلالته على الشبهة الحكمية بأنّ كلمة «بعينه» قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية(64) .
ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة ; فإنّه تأكيد لقوله «تعرف» ، ومفاده كناية عن وقوف المكلّف على الأحكام ; وقوفاً علمياً لا يأتيه ريب .
نعم ، يرد على الرواية : أنّها بصدد الترخيص لارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال ، فيكون وزانه وزان قوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه»(65) ; فإنّ المتبادر منهما هو جواز التصرّف في الحلال المختلط بالحرام ، الذي جمع رواياته السيّد الفقيه الطباطبائي ـ قدس سره ـ في حاشيته على «المكاسب» عند بحثه عن جوائز السلطان(66) .
فوزان الروايتين وزان قوله ـ عليه السلام ـ في موثّقة سماعة : «إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعاً فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس»(67) ، وصحيحة الحذّاء : «لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه»(68) .
وعلى ذلك : فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال ، ولا ترتبطان بالشبهة البدوية .
الرواية الخامسة : صحيحة عبدالصمد بن بشير:
ومن الروايات : صحيحة عبدالصمد بن بشير التي رواه صاحب «الوسائل» في الباب الخامس والأربعين من تروك الإحرام : إنّ رجلاً عجمياً دخل المسجد يلبّي ، وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله ـ عليه السلام ـ : إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة ، فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، وافتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وأنّ حجّي فاسد ، وأنّ عليّ بدنة .
فقال له : «متى لبست قميصك ، أبعدما لبّيت أم قبل ؟» .
قال : قبل أن أُلبّي .
قال : «فاخرجه من رأسك ; فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»(69) .
فدلّت على أنّ الآتي بشيء عن جهل بحكمه لا بأس به .
وأورد عليه الشيخ الأعظم : بأنّ مورد الرواية وظهورها في الجاهل الغافل ، وتعميمه إلى الجاهل الملتفت يحوج إلى إخراج الجاهل المردّد المقصّر ، ولسانه يأبى عن التخصيص(70) .
وأيّده بعضهم : بأنّ الباء في قوله : «بجهالة» للسببية ، والجهل بالحكم سبب للفعل في الجاهل الغافل دون الملتفت(71) .
أقول : قد أمر الشيخ في آخر كلامه بالتأمّل ، وهو دليل على عدم ارتضائه لما ذكر ; فإنّ أمثال هذه التراكيب كثير في الكتاب والسنّة ; فانظر إلى قوله تعالى : {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ } [النساء: 17] وقوله تعالى : { أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6] فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل ؟
ومجرّد كون مورد الرواية من هذا القبيل لا يوجب التخصيص ; لا سيّما في أمثال المقام الذي يتراءى أنّ الإمام بصدد إلقاء القواعد الكلّية العالمية .
أضف إلى ذلك : ما ورد في أبواب الصوم(72) والحجّ(73) من روايات تدلّ على معذورية الجاهل ، من غير استفصال .
وأمّا ما ذكره أخيراً من أنّ التعميم يحتاج إلى التخصيص ولسانه آب عنه فيرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ التخصيص لازم على أيّ وجه ; فإنّ الجاهل الغافل المقصّر خارج عن مصبّ الرواية ـ أنّ ذلك دعوى مجرّدة ; فإنّ لسانه ليس على وجه يستهجن في نظر العرف ورود التخصيص به ، كما لا يخفى .
وما أيّد به بعضهم مقالة الشيخ فيرد عليه : أنّ الجهل ليس علّة للإتيان بالشيء ; فإنّ وجود الشيء في الخارج معلول لمبادئه . نعم ربّما يكون العلم بالحكم مانعاً ورادعاً عن حصول تلك المبادئ في النفس .
وعليه : فالمناسب جعـل «الباء» بمعنى «عن» . ولو سلّم كونها للسببيـة فليس المراد مـن السببية المعنى المصطلح ـ صدور الفعل عنه ـ بل بمعنى دخالتها في العمل في الجملة ، فيصحّ أن يقال : إنّ الارتكاب يكون لجهالـة ، مع الفحص عـن الحكم وعدم العثور عليه .
الرواية السادسة : حسنة ابن الطيّار:
ومن الروايات : ما رواه ثقة الإسلام في باب البيان والتعريف عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن ابن الطيّار عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال : «إنّ الله احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم»(74) .
فدلّت على أنّ التكليف فرع التعريف ، وإيتاء القدرة الذي عليه قوله تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] ، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ، وقد استدلّ بهما الإمام في رواية عبد الأعلى كما تقدّم(75) .
والمعنى المتبادر منها حسب مناسبة الحكم والموضوع شرطية التعريف والإيتاء في كلّ التكاليف على كلّ فرد فرد من المكلّفين حتّى يتمّ الحجّة بالنسبـة إلى كلّ واحد منهم ، وأنّ التعريف للبعض لا يكفي في التكليف على الجميع ; لأنّ المقصود إنّما هو إتمام الحجّـة ، وهـو لا يتمّ إلاّ إذا حصل الأمـران عند كلّ واحد واحد منهم .
وعلى ذلك : فلو فحص المكلّف عن تكليفه فحصاً تامّاً ولم يظفر به ; وإن صدر من الشارع حكمه ، غير أنّ الحوادث عاقت بينه وبين تكليفه ، لم يصدق أنّه عرّفه وآتاه .
فإن قلت : قد رواه ثقة الإسلام أيضاً في باب حجج الله ـ عزّوجلّ ـ على خلقه ، وهو مذيّل بجملة ربّما توهم خلاف ما ذكرنا ، وإليك الرواية : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطيّار عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال : قال لي : اُكتب فأملى عليّ : «أنّ من قولنا : إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم ، ثمّ أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى . . .»(76) إلى آخره .
فإنّ ظاهر الرواية : أنّ التعريف والإيتاء كانا قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب . ومن المعلوم أنّ المراد من هذا التعريف ـ عندئذ ـ هو التوحيد الفطري بالله وصفاته ، لا المعرفة بأحكامه ، فيكون أجنبياً عن المقام ، وحينئذ فالتقطيع من ناحية الراوي .
قلت : ما ذكر من الذيل لا يضرّ بما نحن بصدده ; فإنّ ما بعده شاهد على أنّ المقصود هو التكليف بالأحكام الفرعية ، فإليك الذيل : «أمر فيه بالصلاة والصوم ، فنام رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن الصلاة ، فقال : أنا اُنيمك وأنا اُوقظك ، فإذا قمت فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك وكذلك الصيام أنا اُمرضك وأنا اُصحك فإذا شفيتك فاقضه» .
فعلى هذا فلا يمكن الأخذ بظاهر الرواية ; لأنّ ظاهرها : أنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب بعد الاحتجاج بما آتاهم وعرّفهم ، فلابدّ أن يقال : إنّ المقصود منه أنّ سنّة الله تعالى هو الاحتجاج على العباد بما آتاهم وعرّفهم ، وهي منشأ لإرسال الرسل والتعريف ، ولأجل ذلك تخلّل لفظة «ثمّ» بين الأمرين .
فإن قلت : ما دلّ من الأخبار على لزوم الاحتياط وارد على هـذه الروايـة ; فإنّ التعريف كما يحصل ببيان نفس الأحكام ، كذلك يحصل بإلزام الاحتياط في موارد الأحكام .
قلت : لو لم نقل بحكومتها على أخبار الاحتياط فلا أقلّ بينهما التعارض ; فإنّ مفاد الرواية : أنّ الاحتجاج لا يتمّ إلاّ ببيان نفس الأحكام وتعريفها ، فلو تمّ الاحتجاج بإيجاب الاحتياط مع أنّه ليس بواجب نفسي ، ولا طريق إلى الواقع لزم إتمام الحجّة بلا تعريف ، وهو يناقض الرواية .
وإن شئت قلت : إنّ المعرفة بالأحكام موجبة للاحتجاج ، وبما أنّه في مقام الامتنان والتحديد تدلّ على أنّه مع عدم المعرفة لا يقع الاحتجاج ، ولا يكون الضيق والكلفة ، كما دلّ عليه ذيل الرواية الثانية .
ولزوم الاحتياط لا يوجب المعرفة بالأحكام ; ضرورة عدم طريقيته للواقع ; لا حكماً ولا موضوعاً ، فلو احتجّ بالاحتياط لزم الاحتجاج بلا تعريف . بل لا يبعد حكومتها على أدلّة الاحتياط ; لتعرّضها لما لم يتعرّض به أدلّة الاحتياط ; لتعرّضها لنفي الاحتجاج ما لم يعرّف ولم يبيّن ، كما لا يخفى .
الرواية السابعة : رواية إبراهيم بن عمر اليماني:
ومن الروايات : ما رواه المحدّث الكاشاني عن ثقة الإسلام في باب البيان والتعريف بإسناده عن اليماني ، قال : سمعت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ يقول : «إنّ أمر الله عجيب ، إلاّ أنّه قد احتجّ عليكم بما عرّفكم من نفسه»(77) .
وهذه الرواية قريبة ممّا تقدّم . وليس المراد من قوله : «بما عرّفكم من نفسه» هو تعريف ذاته وصفاته ، بل الظاهر هو تعريف أحكامه وأوامره ونواهيه ، فيرجع معنى الحديث إلى أنّ بيان الأحكام عليه تعالى دون غيره .
الرواية الثامنة : حديث الإطلاق:
ومن الروايات : ما أرسله الصدوق ورواه الشيخ الحـرّ في كتاب القضاء عـن محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»(78) .
وإسناد الصدوق متن الحديث إليه ـ عليه السلام ـ بصورة الجزم والقطع شهادة منه على صحّة الرواية وصدورها عنه ـ عليه السلام ـ في نظره ـ قدس سره ـ ، وهذا الإرسال بهذه الصورة ، من دون أن يقول : «وعن الصادق» حاك عن وجود قرائن كاشفة عن صحّة الحديث ومعلومية صدوره عنده ، كما لا يخفى .
وأمّا فقه الحديث : ففيه احتمالات ; فإنّ قوله «مطلق» إمّا أن يراد منه اللاحرج من قبل المولى، في قبال الحظر العقلي ; لكونه عبداً مملوكاً ينبغي أن يكون صدوره ووروده عن رأي مالكه ، أو يراد الإباحة الشرعية الواقعية ، أو الإباحة الظاهرية المجعولة للشاكّ .
ثمّ المراد من النهي : إمّا النهي المتعلّق بالعناوين الأوّلية أو الأعمّ منه ومن الظاهري ، كالمستفاد من الاحتياط .
ثمّ المراد من الورود : إمّا الورود المساوق للصدور واقعاً ; سواء وصل إلى المكلّف أم لا ، أو الورود على المكلّف المساوق للوصول إليه .
وتمامية دلالة الحديث إنّما يتمّ لو دلّ على الإباحة الظاهرية المجعولة للشاكّ فيما لم يصل إلى المكلّف نهي ; سواء صدر النهي عن المولى أو لا .
ثمّ إنّ بعض الأعيان المحقّقين : قد اعتقد بامتناع إرادة بعض الاحتمالات ; أعني كون المطلق بمعنى الإباحة الشرعية ; واقعية كانت أو ظاهرية فيما إذا اُريد من الورود هو الصدور من الشارع .
أمّا الأوّل ـ كون المطلق بمعنى الإباحة الواقعية والمراد من الورود هو الصدور ـ فأفاد في وجه امتناعه ما هذا ملخّصه : إنّ الإباحة الواقعية ناشئة من لا اقتضائية الموضوع ; لخلوّه عن المصلحة والمفسدة ، فلا يعقل ورود حرمة في موضوعها ; للزوم الخلف من فرض اقتضائية الموضوع المفروض أنّه لا اقتضاء . وفرض عروض عنوان آخر مقتض للحرمة مخالف لظاهر الرواية الدالّة على أنّ الحرمة وردت على نفس ما وردت عليه الإباحة .
ولو اُريد من ورود النهي تحديد الموضوع وتقييده بأنّ ما لم يرد فيه نهي مباح فهو ـ مع كونه خلاف الظاهر ـ فاسد ; لأنّه إن كان بنحو المعرّفية فهو كالإخبار بأمر بديهي لا يناسب شأن الإمام ـ عليه السلام ـ ، وإن كان بنحو التقييد والشرطية فهو غير معقول ; لأنّ تقييد موضوع أحد الضدّين بعدم الضدّ حدوثاً أو بقاءً غير معقول ; لأنّ عدم الضدّ ليس شرطاً لوجود ضدّه .
وأمّا الثاني ـ كون المطلق بمعنى الإباحة الظاهرية ، والورود بمعنى الصدور ـ
فأفاد : أنّه يمتنع لوجوه :
منها : لزوم تخلّف الحكم عن موضوعه التامّ ; فإنّه مع فرض كون الموضوع ـ وهو المشكوك ـ موجوداً يرتفع حكمه بصدور النهي المجامع مع الشكّ واقعاً ، فلا يعقل أن يتقيّد إلاّ بورود النهي على المكلّف ; ليكون مساوقاً للعلم المرتفع به الشكّ .
ومنها : أنّ الإباحة إذا كانت مغيّاة بصدور النهي واقعاً أو محدّدة بعدمه ، والغاية أو القيد مشكوك الحصول فلا محالة يحتاج إلى أصالة عدم صدوره لفعلية الإباحة .
وأمّا الأصل : فإن كان لمجرّد نفي الحرمة فلا مانع منه إلاّ أنّه ليس من الاستدلال بالخبر ، وإن كان للتعبّد بالإباحة الشرعية ـ واقعية أو ظاهرية ـ فقد علم امتناع ذلك مطلقاً ، وإن كان للتعبّد بالإباحة ـ بمعنى اللاحرج ـ فهي ليست من مقولة الحكم ، ولا هي موضوع ذو حكم .
ومنها : أنّ ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للإباحة الظاهرية المفروضة ، ومقتضى فرض عدم الحرمة إلاّ بقاءً هو فرض عدم الحرمة حدوثاً ، ومقتضاه عدم الشكّ في الحلّية والحرمة من أوّل الأمر ، فلا معنى لجعل الإباحة الظاهرية .
وليست الغاية غاية للإباحة الإنشائية حتّى يقال : إنّه يحتمل في فرض فعلية الشكّ صدور النهي واقعاً ، بل غاية لحقيقة الإباحة الفعلية بفعلية موضوعها ـ وهو المشكوك ـ وحيث إنّ المفروض صدور النهي بقاءً في مورد هذه الإباحة الفعلية فلذا يرد المحذور المزبور(79) .
أقول : في كلامه مواقع للنظر :
منها : ما أفاده في امتناع الأوّل من أنّ الإباحة الواقعية ناشئة من لا اقتضاء الموضوع ، فلا يعقل ورود النهي على نفس الموضوع ، ففيه : أنّ اللااقتضاء والاقتضاء لو كانا راجعين إلى نفس الموضوع لكان لما ذكره وجه ، إلاّ أنّ الأحكام الشرعية وإن كانت مجعولة عن مصالح ومفاسد لكن لا يلزم أن يكون تلك المصالح أو المفاسد في نفس الموضوعات حتّى يكون الاقتضاء واللااقتضاء راجعاً إليه ، بل الجهات الخارجية مؤثّرة في جعل الأحكام بلا ريب .
وأوضح شاهد على ذلك هو نجاسة الكفّار والمشركين ; فإنّ جعل النجاسة عليهم ليس لأجل وجود قذارة أو كثافة في أبدانهم ـ كما في سائر الأعيان النجسة ـ بل الملاك لهذا الجعل الجهات السياسية ; فإنّ نظر المشرّع تحفّظ المسلمين عن مخالطة الكفّار والمعاشرة معهم ; حتّى تصون بذلك أخلاقهم وآدابهم ونواميسهم ، فلأجل هذه الأمنية حكم على نجاستهم .
فحينئذ : فمن الممكن أن يكون الموضوع مقتضياً للحرمة لكن الموانع منعت عن جعلها ، أو المصالح السياسية اقتضت جعل الإباحة الواقعية . فلو كان الشارع حاكماً بحلّية الخمر في دور الضعف ـ وإن كان تراها ذات مفسدة مقتضية للتحريم وجعل الحرمة ـ لكان أشبه شيء بالمقام .
ومنها : أنّه يمكن جعل ورود النهي تحديداً للموضوع بكلا الوجهين ; من المعرّفية والشرطية بلا محذور :
أمّا الأوّل : فلأنّ ما هو كالبديهي إنّما هو الإباحة بمعنى اللاحرجي قبال الحظر ، وأمّا الإباحة الواقعية المجعولة الشرعية فليس كذلك ; لأنّها لا تحصل إلاّ بجعل الجاعل ، بخلاف اللاحرجية.
فإن قلت : يلزم اللغوية حينئذ ; إذ بعد ما حكم العقل باللاحرجية فلا مجال لجعل الإباحة الواقعية.
قلت : إنّه منقوض أوّلاً بالبراءة الشرعية ، مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وثانياً نمنع لغوية الجعل بعد كونها ذات آثار لا تترتّب إلاّ بجعل تلك الإباحة الواقعية ، ولا يغني عنها ما يحكم به العقل ; ضرورة أنّه مع الشكّ في ورود النهي من الشارع يمكن استصحاب الحلّية المجعولة ، بعد الإشكال في جريان أصالة عدم ورود النهي لأجل كونها أصلاً مثبتاً ، وبدونها لا يجوز استصحاب اللاحرجية ; لعدم كونها حكماً شرعياً ، ولا موضوعاً ذا أثر .
على أنّه يمكن منع اللغوية بأنّ جعلها لرفع الشبهة المغروسة في الأذهان من أنّ الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر حتّى يرد منه الترخيص .
وأمّا الثاني : أعني أخذ عدم الضدّ شرطاً لوجود الضدّ الآخر ، فالمنع عنه يختصّ بالاُمور التكوينية كما حقّق في محلّه ، وأمّا الاُمور الاعتبارية التي لا يتحمّل أحكام التكويني ـ كالتضادّ وغيره ـ فلا ، وقد أوضحنا في بعض المباحث : أنّه لا تضادّ بين الأحكام(80) ، فلأجل ذلك يمكن أن يجعل عدم أحد الضدّين شرطاً لوجود الضدّ الآخر .
ومنها : ما أفاده من امتناع إرادة الإباحة الظاهرية من المطلق مع كون الورود الواقعي غايةً أو تحديداً للموضوع لأجل تخلّف الحكم من موضوعه التامّ ، ففيه : أنّ الموضوع على التحديد هو المشكوك الذي لم يرد فيه نهي واقعاً ، وهو غير المشكوك الذي ورد فيه نهي .
وبالجملة : لو كان الموضوع للإباحة الظاهرية هو المشكوك بما هو هو ، المجامع مع ورود النهي واقعاً ، يلزم تخلّف الحكم ـ الإباحة الظاهرية ـ عن موضوعه المشكوك . فمع كون الموضوع ـ وهو المشكوك ـ موجوداً ليس معه الحكم ـ أعني الإباحة ـ لأجل ورود النهي واقعاً .
وأمّا لو كان الموضوع هو المشكوك الذي لم يرد فيه نهي واقعاً ، فلو ورد هنا نهي لانتفى ما هو موضوع الإباحة بانتفاء أحد جزئيه ، فليس هنا موضوع حتّى يلزم انفكاك الحكم عن موضوعه .
نعم ، لو كان غاية فالموضوع وإن كان هو المشكوك بما هو هو ـ وهو محفوظ مع ورود النهي ـ لكن لا مانع من تخلّف الحكم عن موضوعه إذا اقتضت المصالح الخارجية لذلك .
وما ذكر من الامتناع ناش من قياس التشريع على التكوين ، بتخيّل أنّ الموضوعات علل تامّة للأحكام ـ كما هو المعروف ـ وهو غير تامّ .
وقد عرفت : أنّ المصالح الخارجية ومفاسدها لها دخالة في تعلّق الأحكام ، كما مرّ(81) في نجاسة الكفّار ، وطهارة العامّة في حال الغيبة لأجل حصول الاتّفاق والاتّحاد ; حتّى دلّت الأخبار على رجحان معاشرتهم والحضور في جماعاتهم إلى غير ذلك(82) .
وعلى ذلك : فالمشكوك يمكن أن يكون حلالاً إلى أمد ; لاقتضاء العصر وحراماً إلى زمان آخر. وإن شئت أخذت الحوادث المقارنة قيداً محدوداً ، وبتغيّرها يتغيّر الحكم .
وأمّا إجراء الأصل : فنختار أنّه للتعبّد بالإباحة الشرعية واقعية أو ظاهرية . وما أفاد من أنّه قد علم امتناع ذلك مطلقاً قد علمت صحّته ومعقوليته . أضف إلى ذلك : أنّ ما أفاد تحت ذلك العنوان ـ إجراء الأصل ـ ظاهر في كونه دليلاً مستقلاًّ ، مع أنّه في الإباحة الظاهرية مصادرة جدّاً . اللهمّ أن يتشبّث بما أفاده قبله ، فلا يكون ذلك دليلاً مستقلاًّ .
ثمّ إنّ الأصل الجاري في المقام :
إن كان أصالة عدم الحرمة : فسيوافيك الإشكال فيه .
وإن كان أصالة عدم ورود النهي حتّى يثبت الحلّية الواقعية أو الظاهرية : فسيوافيك أنّه من الاُصول المثبتة ; لأنّ تحقّق ذي الغاية مع عدم حصول غايته من الأحكام العقلية ، والشكّ في تحقّق ذيها وإن كان مسبّباً عن تحقّق نفس الغاية وعدمها ، إلاّ أنّه ليس مطلق السببية مناطاً لحكومة السببي على المسبّبي ما لم يكن الترتّب شرعياً .
وإن كان الأصل أصالة بقاء الإباحة الواقعية أو الظاهرية فلا مانع منه .
والقول بأنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام الظاهرية صحيح ، لكن المقام ليس من أفراده ; لأنّ ذلك فيما إذا كان نفس الشكّ كافياً في ترتّب الأحكام ; لأنّ الحكم في المقام ليس مرتّباً على نفس الشكّ ، بل عليه مغيّاً بعدم ورود النهي الواقعي ، وهذا لا يكفي فيه الشكّ أصلاً حتّى لا تحتاج إلى الاستصحاب .
وأمّا ما أفاده في ثالث إشكالاته : فلأنّا نمنع استلزام عدم الحرمة إلاّ بعد ورود النهي عدمَ تحقّق الشكّ ; فإنّ تحقّقه ضروري مع الشكّ في الورود وعدمه ; فإنّ المكلّف إذا التفت إلى حرمة شرب التتن وعدمها ; محتملاً ورود النهي واقعاً فلا محالة يتحقّق في نفسه الشكّ ، وهو كاف في جعل الحكم الظاهري ; سواء كان الحكم الظاهري هو إيجاب الاحتياط حتّى يرد الترخيص ، أو الترخيص حتّى يرد النهي ، وقد أوضحنا عدم لغوية هذا الجعل ، كما تقدّم .
ثمّ هذا كلّه على القول بأنّ موضوع الحلّية الظاهرية هو الشكّ في الحكم الشرعي المجعول .
ويمكن أن يقال : إنّ موضوعها هو الشكّ في كون الأشياء على الحظر وعدمه ، أو الشكّ في الملازمة بين حكم العقل والشرع إذا قلنا بالحظر عقلاً ، فيكون قوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ناظراً لكلا الشكّين . فلو شكّ في أنّ الأصل في الأشياء هو الحظر أو عدمه تفيد الرواية كونها على الإباحة ، وكذا لو قلنا بأنّ الأصل الأوّلي هو الحظر ولكن شككنا في الملازمة .
والحاصل : يكون قوله ـ عليه السلام ـ ناظراً إلى ما إذا شكّ في الحكم الشرعي لأجل الشكّ في أنّ الأصل في الأشياء هو الحظر أو عدمه ، أو لأجل الشكّ في الملازمة . فهذا الشكّ محقّق مطلقاً ; حتّى مع العلم بعدم ورود النهي في الشرع ; لأنّ متعلّق الشكّ كون الأصل في الأشياء قبل الشرع هل هو الحظر أو لا ؟
وهذا لا ينافي العلم بعدم ورود النهي من الشارع ، وهذا نحو آخر من الحكم الظاهري المجعول في حقّ الشاكّ في الحكم الواقعي . وعلى هذا يكون عامّة إشكالاته واضحة الدفع ; خصوصاً الثالث منها ; فإنّه على فرض تسليمه لا يرد في هذا الفرض ، كما لايخفى .
المختار في معنى الرواية
هذا كلّه محتملات الرواية حسب الثبوت ، وأمّا مفادها حسب الإثبات فلا شكّ أنّ معنى قوله ـ عليه السلام ـ : «حتّى يرد فيه نهي» أنّ هذا الإطلاق والإرسال باق إلى ورود النهي ، وليس المراد من الورود هو الورود من جانب الشارع ; لانقطاع الوحي في زمان صدور الرواية .
والحمل على النواهي المخزونة عند ولي العصر ـ عليه السلام ـ بعيد جدّاً ; فإنّه على فرض وجود تلك النواهي عنده فتعيّن أن يكون المراد من الورود هو الوصول على المكلّف ، وهذا عرفاً عين الحكم الظاهري المجعول في حقّ الشاكّ إلى أن يظفر على الدليل .
والحاصل : أنّ قوله : «يرد» جملة استقبالية ، والنهي المتوقّع وروده في زمان الصادق ليست من النواهي الأوّلية الواردة على الموضوعات ; لأنّ ذلك بيد الشارع ، وقد فعل ذلك وختم طوماره بموت النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وانقطاع الوحي ، غير أنّ كلّ ما يرد من العترة الطاهرة كلّها حاكيات عن التشريع والورود الأوّلي .
وعلى ذلك : ينحصر المراد من قوله : «يرد» على الورود على المكلّف ـ أي الوصول إليه ـ حتّى يرتفع بذلك الحكم المجعول للشاكّ ، وهذا عين الحكم الظاهري .
وأمّا احتمال كون الإطلاق بمعنى اللاحظر ; حتّى يكون بصدد بيان حكم عقلي ومسألة اُصولية أو كلامية ، أو بمعنى الحلّية الواقعية قبل الشرع المستكشف بحكم العقل الحاكم بكون الأشياء على الإباحة ، وبملازمة حكم العقل والشرع ، ففي غاية البعد ; فإنّ ظواهر هذه الكلمات كون الإمام بصدد بيان الفتوى ورفع حاجة المكلّفين ، لا بيان مسألة اُصولية أو كلامية أو عقلية .
ولو فرض كونها بصدد بيان الحكم العقلي أو بيان التلازم يشكل إثباته بالرواية ; لعدم صحّة التعبّد في الأحكام العقلية أو ملازماتها ، كما لا يخفى .
الرواية التاسعة : صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج:
ومن الروايات : صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج المنقولة في أبواب ما يحرم بالمصاهرة عن أبي إبراهيم ـ عليه السلام ـ قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبداً ؟
فقال ـ عليه السلام ـ : «لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» .
قلت : بأيّ الجهالتين أعذر ; بجهالة أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالة أنّها في العدّة ؟
قال ـ عليه السلام ـ : «إحدى الجهالتين أهون من الاُخرى ; الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم عليه ذلك ; وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط» .
قلت : فهو في الاُخرى معذور ؟
قال ـ عليه السلام ـ : «نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها»(83) .
وجه الدلالة : أنّ التعبير بالأهونية في جواب الإمام وبالأعذرية لا يناسب الأحكام الوضعية ; فإنّ كون الجهل عذراً وموجباً لعدم التحريم الأبدي لا مراتب له ، فلابدّ من الحمل على الحكم التكليفي ; إذ هو الذي يتفاوت فيه بعض الأعذار ، ويكون بعضها أهون من بعض . فالغافل المرتكب للمحرّم أعذر من الجاهل الملتفت المرتكب له ; وإن كان ارتكابه بحكم أصل البراءة .
وعليه : فالرواية دالّة على كون الجهل مطلقاً عذراً في ارتكاب المحرّمات ; وإن كان الأعذار ذات مراتب ، والجهالات ذات درجات .
وأمّا ما عن بعض محقّقي العصر ـ قدس سره ـ من تقريب دلالتها بأنّ قوله ـ عليه السلام ـ : «فقد يعذر الناس بما هو أعظم» دالّ على معذورية الجاهل من حيث العقوبة عند الجهل ، الشامل بإطلاقه للمعذورية عن العقوبة والنكال الاُخروي(84) ، فضعيف جدّاً ; لأنّ قوله : «فقد يعذر» لا يستفاد منه الإطلاق ; لأنّ «قد» فيه للتقليل لا للتحقيق .
وعلى أيّ تقدير : التمسّك بها للمقام محلّ إشكال ; لأنّ التعليل بأنّه كان غير قادر على الاحتياط يجعلها مختصّة بالغافل ، وهو غير محلّ البحث . وإلغاء الخصوصية مع التفاوت الفاحش لا يمكن في المقام .
الرواية العاشرة : رواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام . . .»:
ومن الروايات : قوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه» .
أقول : قد صدر هذه الكبرى عنهم ـ عليهم السلام ـ في عدّة روايات :
منها : في صحيحة عبدالله بن سنان المنقولة في أبواب ما يكتسب به ، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه»(85) .
ومنها : رواية عبدالله بن سليمان عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ المنقولة في الأطعمة المباحة ، بعد السؤال عن الجبن : «كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه»(86) .
ومنها : ما رواه البرقي بسنده عن معاوية بن عمّار عن رجل من أصحابنا ، قال : كنت عند أبي جعفر فسأله رجل عن الجبن .
فقال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ : «إنّه لطعام يعجبني ، وساُخبرك عن الجبن وغيره : كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام ، فتدعه بعينه»(87) .
ومنها : رواية عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ في الجبن ، قال : «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة»(88) .
ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة قال : سمعتـه يقول : «كـلّ شيء هـو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب . . .»(89) إلى آخره .
هذه جملة من الروايات المذكورة فيها هـذه الكبرى مـع اختلاف يسير ، ومـا يظهر من الشيخ الأعظم من كون قوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» رواية مستقلّة غير هذه الروايات(90) فلم نقف عليه .
والظاهر : أنّ الكبرى المذكورة في رواية عبدالله بن سليمان عين ما ذكر في صحيحة ابن سنان; لوحدة العبارة ; وإن كانت الاُولى مصدّرة بحكم الجبن ، فيكون الاُولى مختصّة بالشبهات الموضوعية ، ولأجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن سنان على الحكمية .
أضف إلى ذلك قوله : «بعينه» و«منه» و«فيه» ومادّة العرفان المستعملة في الاُمور الجزئية ; فإنّ كلّ واحد من هذه الاُمور وإن كان في حدّ نفسه قابلاً للمناقشة ، إلاّ أنّ ملاحظة المجموع ربّما تصير قرينة على الاختصاص أو سلب الاعتماد بمثل هذا الإطلاق .
ومثل تلك الصحيحة موثّقة مسعدة بن صدقة ; فإنّ الأمثلة المذكورة فيها كلّها من الشبهات الموضوعية ، وفيها إشكالات ذكرها الشيخ الأعظم(91) وإن كان في بعض ما أجاب به تأمّل .
_____________
1 ـ الخصال : 417 / 9 ، التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
2 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 28 .
3 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 342 ـ 343 .
4 ـ يأتي في الصفحة 33 ـ 34 .
5 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 28 .
6 ـ درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 190 .
7 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 345 .
8 ـ تقدّم في الجزء الثاني : 157 ـ 159 .
9 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 441 ـ 442 .
10 ـ نهاية الأفكار 3 : 216 .
11 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 337 .
12 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 353 .
13 ـ نفس المصدر 4 : 222 .
14 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 347 .
15 ـ الكافي 5 : 292 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 .
16 ـ الاستصحاب ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ : 234 ـ 238 .
17 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 442 .
18 ـ المحاسن : 339 / 124 ، وسائل الشيعة 23 : 226 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 12 .
19 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 443 .
20 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 353 .
21 ـ نهاية الأفكار 3 : 219 .
22 ـ نفس المصدر 3 : 209 .
23 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 353 ـ 354 .
24 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 277 ـ 278 .
25 ـ نهاية الأفكار 3 : 218 .
26 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 277 ـ 278 .
27 ـ تقدّم في الصفحة 45 .
28 ـ كفاية الاُصول : 418 ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 213 ـ 216 ، نهاية الأفكار 3 : 420 ـ 423 .
29 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 355 .
30 ـ الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 235 / السطر 27 .
31 ـ غنية النزوع 1 : 113 .
32 ـ تذكرة الفقهاء 3 : 278 و 290 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 55 و 67 و 133 .
33 ـ المعتبر 1 : 441 ـ 442 .
34 ـ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 497 .
35 ـ لم نعثر عليه .
36 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 355 .
37 ـ نفس المصدر 3 : 356 ـ 357 .
38 ـ نهاية الأفكار 3 : 221 .
39 ـ أنوار الهداية 2 : 65 .
40 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 357 ـ 359 .
41 ـ الطهارة ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ 2 : 9 ، مناهج الوصول 1 : 385 .
42 ـ تقدّم في الصفحة 55 .
43 ـ نهاية الأفكار 3 : 224 .
44 ـ تفسير العياشي 2 : 272 / 75 ، الكافي 2 : 462 / 1 ، وسائل الشيعة 16 : 218 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 26 ، الحديث 10 .
45 ـ تفسير العياشي 2 : 271 / 72 ، مجمع البيان 6 : 597 .
46 ـ الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .
47 ـ راجـع وسائـل الشيعـة 28 : 110 ، كتاب الحـدود ، أبواب حـدّ الـزنا ، الباب 18 ، الحـديث 1 و2 و4 و5 .
48 ـ وهذه الرسالة جاهزة للطبع وعلّقنا عليها بعض التعاليق . [المؤلّف]
49 ـ الرسائل العشرة ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ : 12 .
50 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 445 ـ 446 .
51 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 277 ـ 278 .
52 ـ تقدّم في الجزء الثاني : 378 .
53 ـ تقدّم في الصفحة 46 ـ 47 .
54 ـ التوحيد ، الصدوق : 413 / 9 ، وسائل الشيعة 27 : 163 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 33 .
55 ـ الكافي 1 : 164 / 3 .
56 ـ تقدّم تخريجه في الصفحة 26 .
57 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 41 ، اُنظر كفاية الاُصول : 388 .
58 ـ الفقيه 4 : 53 / 193 ، وسائل الشيعة 27 : 175 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 68 .
59 ـ عوالي اللآلي 1 : 424 / 109 ، مستدرك الوسائل 18 : 20 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 4 ، (مع اختلاف يسير) .
60 ـ كفاية الاُصول : 389 .
61 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 48 .
62 ـ نفس المصدر 25 : 119 ـ 120 .
63 ـ الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
64 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 364 .
65 ـ الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .
66 ـ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 172 .
67 ـ الكافي 5 : 126 / 9 ، وسائل الشيعة 17 : 88 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 2 .
68 ـ الكافي 5 : 228 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 52 ، الحديث 5 .
69 ـ تهذيب الأحكام 5 : 72 / 239 ، وسائل الشيعة 12 : 488 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 .
70 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 42 .
71 ـ بحر الفوائد (الجزء الثاني) : 20 / السطر 18 ، نهاية الأفكار 3 : 229 .
72 ـ راجع وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 و 6 .
73 ـ راجع وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب 10 .
74 ـ الكافي 1 : 162 / 1 .
75 ـ تقدّم في الصفحة 19 .
76 ـ الكافي 1 : 164 / 4 .
77 ـ الكافي 1 : 86 / 3 ، الوافي 1 : 552 / 456 .
78 ـ الفقيه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشيعة 27 : 173 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 67 .
79 ـ نهاية الدراية 4 : 72 ـ 75 و 78 ـ 79 .
80 ـ تقدّم في الجزء الثاني : 50 ـ 53 و 373 ـ 376 .
81 ـ تقدّم في الصفحة 76 .
82 ـ راجع وسائل الشيعة 16 : 219 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 26 ، و8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 .
83 ـ الكافي 5 : 427 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 306 / 1274 ، وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 4 .
84 ـ نهاية الأفكار 3 : 231 .
85 ـ الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .
86 ـ الكافي 6 : 339 / 1 ، وسائل الشيعة 25 : 117 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 1 .
87 ـ المحاسن : 496 / 601 ، وسائل الشيعة 25 : 119 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 7 .
88 ـ الكافي 6 : 339 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .
89 ـ الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
90 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 48 و 119 .
91 ـ نفس المصدر 25 : 120 .



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|