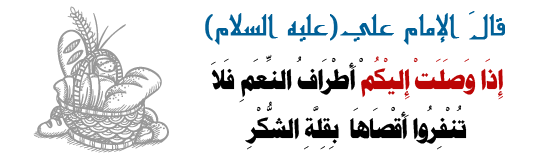
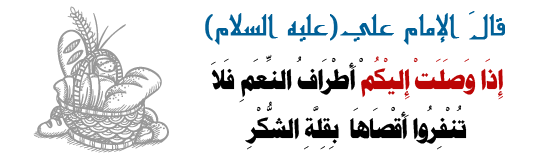

 التاريخ والحضارة
التاريخ والحضارة
 اقوام وادي الرافدين
اقوام وادي الرافدين 
 العصور الحجرية
العصور الحجرية 
 الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق 
 العهود الاجنبية القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق 
 احوال العرب قبل الاسلام
احوال العرب قبل الاسلام 
 مدن عربية قديمة
مدن عربية قديمة
 التاريخ الاسلامي
التاريخ الاسلامي 
 السيرة النبوية
السيرة النبوية 
 الخلفاء الاربعة
الخلفاء الاربعة
 علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
 الدولة الاموية
الدولة الاموية 
 الدولة الاموية في الشام
الدولة الاموية في الشام
 الدولة الاموية في الاندلس
الدولة الاموية في الاندلس
 الدولة العباسية
الدولة العباسية 
 خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
 خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
 عصر سيطرة العسكريين الترك
عصر سيطرة العسكريين الترك
 عصر السيطرة البويهية العسكرية
عصر السيطرة البويهية العسكرية
 عصر سيطرة السلاجقة
عصر سيطرة السلاجقة
 التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر
 التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
 تاريخ الحضارة الأوربية
تاريخ الحضارة الأوربية| الملك بسمتيك الأوَّل (مؤسس الأسرة السادسة والعشرين 663 –609 ق. م) |
|
|
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-04
التاريخ: 2024-06-27
التاريخ: 2024-03-25
التاريخ: 2024-02-13
|
تعد الأسرة التي تبتدئ بالملك «بسمتيك الأول» ابن الملك «نيكاو»، وتنتهي بالملك «بسمتيك الثالث» من الأسر التي نعرف تاريخها بصورة مرضية على وجه عام. وتحتوي هذه الأسرة على ستة ملوك حكموا جميعًا حوالي تسع وثلاثين ومائة سنة. ويبتدئ حكمها بالسنة الرابعة والستين والستمائة، وينتهي بالسنة الخامسة والعشرين والخمسمائة قبل الميلاد (664–525 ق.م).
ولكن «مانيتون» قد وضع لهذه الأسرة ثمانية ملوك؛ وذلك لأنه أضاف قبل «بسمتيك الأول» ثلاثة ملوك وهؤلاء في الواقع يعدون بقية ملوك الأسرة الرابعة والعشرين، وهي أسرة «ساوية» كما ذكرنا من قبل، أو الأسرة اللوبية الثالثة. وهؤلاء الملوك هم «واح-ايب-رع» «تفنخت الثاني» وحكم سبع سنين، والملك «ار-أب-رع» «نيكاوبا» حكم ست سنوات، ثم الملك «من-ايب-رع» «نيكاو» الأول وحكم ثماني سنين.
وقد كان بداية عهد «بسمتيك الأول» فاتحة عهد جديد في تاريخ مصر، وبداية حكم أسرة جديدة بلا نزاع.
إن أول عقبة تصادفنا في حياة «بسمتيك» هي: لماذا عُد مؤسس أسرة جديدة وهي الأسرة السادسة والعشرون، مع أنه من سلسلة أسرة ملوك متتابعين وهم ملوك الأسرة الرابعة والعشرين؟ وفي اعتقادي أن الجواب الشافي على ذلك هو أنه ابتدأ عصرًا جديدًا في حياة «مصر». فقد أصبحت البلاد في عهده مستقلة، بعد أن كانت ترزح تحت نير الحكم الآشوري. ولدينا حادث يعد نظيرًا لذلك في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة التي ابتدأها «أحمس الأول»، فقد كان أخًا للملك «كامس» آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة، ومع ذلك عد مؤسسًا لأسرة جديدة، حقًّا أسس هذا العاهل أسرة جديدة في تاريخ مصر، فقد سار بها في طريق الاستقلال حتى بلغت غايته، ثم أخذ بعد ذلك في تأسيس إمبراطورية جديدة على أنقاض دولة «الهكسوس» الذين هزمهم، وها نحن أولاء نرى «بسمتيك» يلعب نفس الدور، فإنه خلص «مصر» من النير الآشوري والكوشي، ونهض بها نهضة كانت مضرب الأمثال في تاريخ «مصر» بل في تاريخ الشرق عامة، فقد خلص البلاد من حكم «الآشوريين» الغاشمين، ثم سار بالكنانة نحو المجد، فأعاد لها بعض عظمتها القديمة، فأحيا فنونها واسترد كثيرًا من ممتلكاتها خارج حدودها.
وقد عزا الأستاذ «بتري» تأسيس الأسرة الجديدة إلى سبب آخر، فرأى أن ذلك يرجع إلى تأثير «كوش»، فقال: إن شواهد الأحوال تدل على أنه حوالي 690 ق.م عندما كان الملك «تهرقا» في أوج عظمته وقوته في بلاد الدلتا وفي بلاد «فلسطين»، عمل على أن يضم أمير «سايس» «نيكاو» بالمحالفة إلى جانبه، فزوجه ابنته التي أصبحت فيما بعد أم «بسمتيك» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين، وقال: إنه من البديهي أن اسم «بسمتيك» في تركيبه هو من طراز تركيب اسم «شبتاكا»، ومعنى هذا الاسم هو: ابن القط البري، وعلى هذا النمط يكون معنى «بسمتيك» «ابن سام» والمقطع «با» = أداة التعريف (اﻟ) للمذكر كما توجد أداة التأنيث «تا» في اسم «تاسمتيك». ومعنى «بسمتيك» معناه «ابن الأسد»؛ وذلك لأن كلمة «سام» معناه الأسد باللوبية، وكذلك لدينا في العربية اسم «أسامة» = «أسد». وقد وافق «بتري» في اشتقاق اسم «بسمتيك» على أنه من أصل «كوشي» الأثري «بروكش» (راجع Brugsch, Gesch. Aegypten P. 737).
ولكن من جهة أخرى نجد أن «لبسيوس» و«سترن» و«ارمان» يعدون هذا الاسم من أصل «لوبي»، وعلى العكس من ذلك قد برهن «فيدمان» بوضوح أن هذا الاسم «مصري» بحت وأخيرًا يقول الأستاذ «شبيجلبرج»: إن التفسير اللغوي للاسم هو إنسان الإله «متك»، وقد ذهب إلى أن «متك» هو الإله المحلي للمكان الذي نشأت فيه هذه الأسرة (راجع المصادر عن ذلك في Gauthier L. R. IV P. 66, N. 2).
وعلى أية حال فنحن نعرف من مصادر مختلفة إغريقية أن «بسمتيك الأول» كان ابن «نيكاو». من ذلك ما جاء في «هردوت» (راجع Herod. II 152) و«بسمتيكوس» هذا الذي فر أمام «سبكون» «الأثيوبي» الذي قتل والده «نيكاو»، وكان قد هرب في ذلك الوقت إلى «سوريا»، وقد أحضره المصريون التابعون لإقليم «سايس» عندما تقهقر الأثيوبيون بسبب رؤيا في منام (راجع عن هذا الحلم Herod. II 139) ، وجاء في «مانيتون» أن «بسمتيك» حكم أربعًا وخمسين سنة (راجع Unger Chronologie des Manetho P. 271).
وقد أكد هذا التاريخ ما جاء في لوحة «السربيوم» الموجودة بمتحف «اللوفر» (راجع Louvre N. 193: L. R. IV P. 74–9 XXXI-XXXII).
ومن بين الأساطير التي كانت شائعة في «سايس» في القرن الخامس قبل الميلاد قصة تحدثنا أنه في ذلك الوقت كانت كل البلاد قسمة بين اثني عشر أميرًا، وأنهم كانوا يعيشون في أمان جنبًا لجنب إلى أن أوحي إليهم وحي بأن كل الوادي سيكون في نهاية الأمر في قبضة أمير منهم، وهو الذي سيصب القربان للإله «بتاح» في كأس من النحاس، ومن ذلك الوقت أخذ كل واحد منهم يرقب الآخر بغيرة شديدة في كل مرة يجتمعون فيها سويًّا في معبد «منف»؛ ليقيموا الصلاة ويقدموا القرابين، واتفق ذات يوم عندما اجتمعوا معًا رسميًّا وقدم لهم الكاهن الأكبر كؤوسا من الذهب اعتادوا استعمالها، أن وجد أنه قد أخطأ في الكؤوس، وأنه قد أعد أحد عشر كأسًا بدلًا من اثني عشر، وقد ترك من أجل ذلك «بسمتيكوس» بدون كأس، ولكن لأجل ألا يرتبك الاحتفال أخذ «بسمتيكوس» قبعته المصنوعة من النحاس واستعملها كأسًا ليأخذ فيها قربانه، وعندما لحظ سائرهم ذلك مرت بأذهانهم كلمات الوحي، فنفوا «بسمتيكوس» الأمير الطائش إلى المستنقعات الواقعة على ساحل «البحر الأبيض» وحذروه أن يغادرها أبدًا. ولكنه استشار وحي «إيزيس» (1) صاحبة بلدة «بوتو»؛ ليعرف ماذا ينتظر من الآلهة، وقد أجابته أن طريقة الانتقام ستصل إليه من البحر في اليوم الذي سيخرج من مياهه جنود من نحاس. وقد ظن في بادئ الأمر أن الكهنة يهزؤون منه، ولكنه لم يمضِ طويل وقت حتى نزل إلى البر قرصان من «ايونيا» و«كاريا» لابسين دروعهم على مسافة قريبة من مسكنه، ولم يكن الرسول الذي جاء ليخبر بوصولهم قد رأى من قبل جنديًّا مدججًا بسلاحه مثل الذين رآهم، وقد أخبر أن رجالًا من نحاس قد خرجوا من أمواج البحر، وأنهم ينهبون البلاد. ولما لحظ «بسمتيكوس» أن نبوءته قد تحققت هرول ليقابل هؤلاء الأجانب، وخرطهم في خدمته وبمساعدتهم تغلب على مناهضيه الأحد عشر أميرًا حكام المقاطعات على التوالي (راجع Herod. II 152–57).
وعلى ذلك نجد أن قبعة من النحاس ووحيًا قد خلعاه عن العرش، وأن وحيًا آخر ورجالًا من النحاس قد وضعاه على العرش. وقد وصلت إلينا رواية أقصر من السابقة عن هذه الحوادث لم تذكر الاثني عشر ملكًا، ولكن ذكرت بدلًا منهم ملكًا يدعى «تمنتس» Tementhes حذره وحي «آمون» أن يحترس من الديوك. وقد كان «لبسمتيكوس» رفيق في النفي وهو رجل من بلاد «كاريا» يدعى «بجرس»، وفي أثناء الحديث معه ذات يوم عرف بطريق الصدفة أن «الكاريين» كانوا أول أناس يلبسون القبعات ذات العرف، وعلى ذلك تذكر في الحال كلمات الوحي، واستأجر من «آسيا» عددًا من هذه «الديوك» — الأعراف — وبمساعدتهم ثار على ملكه وهزمه في موقعة تحت جدران «منف» على مقربة من معبد «أزيس» (راجع Polyaenus, Stratagemata VII 3) (2).
هذه هي الأسطورة التي تعزى إلى نهضة العصر «الساوي»، وتاريخها الحقيقي لم يعرف على وجه الدقة حتى الآن، ومن المحتمل جدًّا أنها تشير إلى التحالف الذي عقد بين «جيجز» ملك «ليديا» وبين «بسمتيك» على طرد «الآشوريين»، والتخلص من نيرهم. حقًّا كانت مصر في حالة انحلال تام عندما أخذ «بسمتيك» في نهاية الأمر يحيي مشاريع أسرته الطموحة، غير أن القضاء على أجزائها التي تتألف منها لم يحدث على وتيرة واحدة في كل مكان. فكان الشمال أي: «الدلتا» ووادي النيل حتى «سيوط» في يد سلطة حربية أرستقراطية يشد أزرها جنود وطنيون غير نظاميين بالإضافة إلى فرق من الجنود المرتزقة، الذين كان معظمهم من أصل «لوبي»، وهم الذين كانوا يطلق عليهم اسم قبيلتهم «المشوش». ومعظم هؤلاء الأشراف كان الواحد منهم لا يحكم أكثر من مدينتين أو ثلاث، وكان لديهم مجرد العدد الكافي من المعاضدين للمحافظة على كيانهم المهدد في أملاكهم المحددة، وقد كان الأمير منهم يخضع في الحال لسلطان جاره القوي إذا هاجمه عندما لم يجد له مساعدًا قويًّا يحمي ذماره. وانتهى أمرهم أخيرًا بأن انقسموا جماعتين يفصل الواحدة عن الأخرى فرع النيل الأوسط. وتحتوي إحداهما على المراكز التي يمكن أن يطلق عليها «الدائرة الآسيوية»، وتشمل «هليوبوليس» و«بوبسطة» و«منديس» و«تانيس» و«سمنود»، وكان يتزعمها سيد من أسياد المدن الفتية، فكانت مرة تدين بالطاعة لحاكم «بوبسطة»، وأخرى لحاكم «تانيس»، وأخيرًا لصاحب «باسبد» — صفط الحنة — المسمى «باكرورو».
وكانت المجموعة الثانية تلتف حول أسياد مدينة «سايس»، التي كانت بسيطرتها على «منف» قد أصبح لها الكلمة العليا في مجالس الدولة أكثر من قرن من الزمن. وهذا التقسيم كان ممكنًا أن نلحظه مما جاء على الآثار «الآشورية» و«المصرية» في ذلك العصر، فقد رأينا أن أمراء الإقطاع كانوا يلتفون حول «نيكاو الأول» و«باكرورو». وقد وصلت إلينا قصة كتبت بالديموطيقية أساسها وصف حالة مصر في عهد الاثني عشر ملكًا التي تحدث عنها الكتاب الإغريق، وعلى الرغم من أن هذه القصة قد لا تكون لها قيمة تاريخية قط، إلا أنها مع ذلك تضع أمامنا مختصرًا مقبولًا عن الأحوال في بلاد الدلتا الإقطاعية في حوالي القرن السابع قبل الميلاد. ومما يؤسف له جد الأسف أن هذه القصة لم تصل إلينا سليمة، بل وصلت إلينا في صورة أخرى مكتوبة بالديموطيقية أيضًا (راجع Maspero, Popular Stories of Ancient Egypt P. 217–264)، وهاك ملخص هذه القصة إتمامًا للفائدة: «في الوقت الذي كان يحكم فيه الفرعون «بدي باست» في «تانيس»، كانت كل البلاد مقسمة بين حزبين معاديين، وكان على رأس كل حزب منهما السيد العظيم صاحب «آمون» في «طيبة» أمير «منديس» وهو الذي سرق صدرية «أناروس» أمير «هليوبوليس». وبدون هذه الصدرية أصبح لا يمكن أن يكون حفل جنازه تامًّا، وقد شكا «بمبي» ابن أمير «هليوبوليس» هذا إلى الملك «بدي باست» في «تانيس» مما حدث، وكان الرئيس الأعلى لكل الدلتا وقتئذ. غير أن السيد العظيم صاحب «آمون» في «طيبة» لم يطع أوامر الملك. وكان لكل فريق منهما أتباع كثيرون، وبذلك كانت كل الدلتا على أهبة الدخول في حروب داخلية. وقد نظم «بدي باست» الحرب وأمر بتأليف جمع رسمي مكون من الرؤساء الإقطاعيين، ووضعهم في صفين متقابلين. ونشبت الحرب ودارت الدائرة على حزب السيد العظيم «صاحب آمون في طيبة»، على الرغم من أن الملك «بدي باست» كان يميل إليه، وانتهى الأمر بإعادة الصدرية إلى «هليوبوليس».»
والآن يتساءل الإنسان لماذا كانت الصدرية تحتل هذه المكانة في مراسيم الدفن؟
والواقع أن القصة لم تقدم لنا جوابًا عن ذلك. ولكن يقول «بتري» (راجع Petrie, Hist. III, P. 322): إننا إذا تأملنا موميات هذا العصر وجدنا أنه توجد صدريات عظيمة مذهبة محلاة بأشكال آلهة وشياطين، وهذه كانت تؤلف جزءًا أصليًّا من المراسيم الجنازية في هذا العصر، وهذه الصدريات التي كانت تصنع من نسيج مقوى في العادة كانت في الواقع تقليدًا لصدريات من الذهب أو الفضة المذهبة (راجع صدرية «حوروزا» Petrie, Kahun P. 19)، وكانت تصنع خصيصًا لعظماء الرجال في ذلك العصر. ومن ثم لا بد أن الصدرية المسروقة كانت على أغلب الظن عظيمة وذات قيمة كبيرة.
وقد كانت الحرب بوجه عام قائمة بين الإقليم المتحد الجديد الذي نشأ في الشمال الشرقي من الدلتا، وبين مقاطعات الجزء الأعلى من الدلتا وغيرها (راجع Petrie, Ibid P. 322).
ومن أسماء أمراء المقاطعات يتبين لنا أن ثلاثة منهم ذكروا في القائمة، التي تركها لنا «أسرحدون» بوصفهم من أتباعه وهم: «بدي باست» (بوتوبيستي صاحب «تانيس») و«باكرورو» صاحب «باسبد» (صفط الحنة) و«ناهكي» صاحب «أهناسيا المدينة». ومن هذه الأسماء نفهم أن هذه القصة لا يمكن أن نضعها قبل عام 670ق.م وأنها تحدثنا في الوقت نفسه عن أشخاص تاريخيين.
ومن دراسة هذه القصة نعلم أن «بدي باست» كان الرئيس الأعلى لكل حكام الإقطاع من الدلتا، وأنه هو الذي كان يرجع إليه للفصل بينهم في مشاكلهم. وأنه عندما كانت الأحوال تحتم الحرب بين الفريقين كان هو الذي ينظمها، غير أنه لم يكن في مقدوره أن يصدر أوامره بمنعها كلية. ففي الحرب التي نشبت بسبب الصدرية نجد أنه قد وعد مرارًا بإعادتها، غير أنه لم يكن في استطاعته إرغام السيد العظيم «صاحب آمون في طيبة» على الخضوع لأمره، وعندما تحرجت الأحوال وأصبح لا بد من الحرب، وجد أن «باكرورو» رئيس الشرق قد أرسل رسائل يطلب فيها حضور حلفائه المختلفين، ويحدد لهم أن يجتمعوا عند بحيرة «الغزال» (نبيشة) وبعد ذلك تقص علينا القصة وصف وصول «بدوخنسو» صاحب «أتريب»، ومعه أربعون سفينة كبيرة وستون ومائة سفينة صغيرة هذا إلى خيل وجنود رجالة بمقدار عظيم لدرجة أن النهر وشاطئيه قد ضاقا بهم. وقد تدخل الملك راجيًا «بدوخنسو» ألا يحارب حتى يحضر كل الأحزاب الأخرى، وبعد أن وصلوا جميعًا أمر الملك أن يحضر صفان من المقاعد المرتفعة أو الشرفات يقابل أحدهما الآخر، وذلك لأجل قعود الفريقين المتعاديين. وبعد ذلك أمر الملك أن تنشب حرب منظمة، ويظهر أن كل رئيس كان يقود فيها جيشه بنفسه، وقد وصفت لنا تسليح «باكرورو».
وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الحرب لم تكن حرب مبارزة ينازل فيها المحارب قرنه، كما كانت الحال في حروب القرون الوسطى أو الحروب التي نسمع عنها في القصص الشعبي أمثال قصة «عنترة العبسي» و«الزناتي خليفة» و«دياب بن غانم». بل كانت حربًا منظمة تستعمل فيها كل قوة الجيش، ولم يكن يسمح فيها بالهجوم المباغت أو الخدع الحربية. ويحتمل أن هذا النظام في الحرب كان نتيجة لحروب قد استمرت عدة أجيال، كانت المشاحنات فيها قائمة على قدم وساق دون انقطاع؛ مما دعا إلى وضع قواعد دقيقة لا بد من السير على مقتضاها كما كانت الحال في حروب القرون الوسطى في «أوروبا».
وقد حضر «منتو بعل» السوري واشتبك في المعركة، وهاجم جيش صاحب «سمنود» بشدة لدرجة أن جنوده أرسلوا للملك، وأخبروه بما أصابهم مما جعله يرتعد فرقًا، ورجا «باكرورو» أن يأمر حليفه بالكف عن القتال والانسحاب. وقد صمم «باكرورو» على أن يذهب الملك معه إلى ساحة القتال، وقد وعد الملك مرة أخرى بإعادة الصدرية. ولما كان السيد المعظم «صاحب آمون في طيبة» على وشك أن يقتله «بمبي» بن «اناروس»، فإنه سلم أخيرًا بمطلب عدوه. وفي هذه الأثناء كان «بدو-خنسو» صاحب «منديس» يقاتل «عنخ حور» ابن الملك «بدي باست» ويتغلب عليه، وعندئذ أسرع الملك ورجا المنتصر أن يكف عن القتال. وفي خلال ذلك ظهر أمير «الفنتين» بجيشه، وهاجم «تاحر» قائد «منديس» وهو الذي كان يحرس الصدرية، وفي نهاية الأمر أعيدت الصدرية، وكان القوم يحفونها بمظاهر السرور والفرح من خلف ومن قدام. وهذه الحروب المنظمة التي شبت وفق قواعد موضوعة هي التي كانت تقوم بسبب مناهضة أمير مقاطعة الآخر، وقد تظهر أمامنا هامة؛ وبخاصة لأن منظمها كان ملكًا يعلن انحيازه لأحد الفريقين المتحاربين. ومن ذلك تكونت فكرة غريبة عن ذلك العصر المضطرب في تاريخ مصر.
وتدل الأحوال على أن مقاطعات «مصر الوسطى» وإماراتها الصغيرة كانت تتأرجح في ولائها من حين لآخر بين الحزبين السابقين اللذين تتألف منهما بلاد الدلتا، وكان عملها سلبيًّا، فقد كانت بلاد مصر الوسطى في الحقيقة تستسلم لتيار الحوادث، وليس لها أي دخل في توجيهه، فكانت أحيانًا تدين بالطاعة «لسايس» وأميرها، وأحيانًا تستسلم «لتانيس» وفرعونها على التوالي على حسب فوز فريق على الآخر. وإذا ما انتقلنا إلى إقليم «طيبة»، وجدنا عالمًا آخر مختلفًا اختلافًا تامًّا فقد كان الإله «آمون»، كما عرفنا من قبل هو صاحب السيطرة التامة، وقد حول نفوذه المتزايد وأملاكه إلى دولة دينية حيث كانت أعظم وظيفة فيها في يد امرأة تقلب «زوج الإله»، وهي التي كانت وحدها مصدر السلطات. وقد شرحنا من قبل أن هذه السلطة كانت في يد ابن الملك أو أحد أفراد أسرته (راجع مصر القديمة الجزء العاشر)، ثم انتقلت إلى يد المتعبدة الإلهية التي كانت إحدى بنات الملك الحاكم أو السالف.
................................................



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|