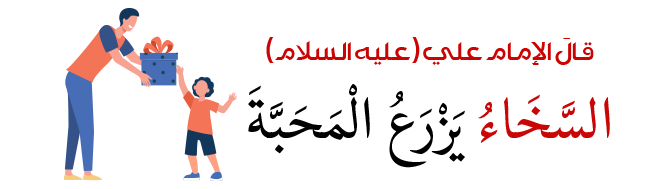
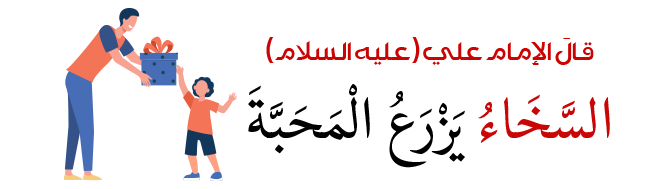

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2020
التاريخ: 21-5-2019
التاريخ: 6-7-2020
التاريخ: 25-2-2019
|
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): "يا علي ألا أنبئك بشرّ النّاس؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: من لا يغفر الذنب، ولا يقيل العثرة، ألا أنبئك بشر من ذلك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره" (1).
الاحتياج إلى الخالق:
إنّ الله تعالى خلق الكائنات محتاجة في أصل وجودها وفي ديمومة بقائها إليه تعالى إذ كلّ مخلوق ممكن وكّل ممكن بحاجة إلى العلة في حدوثه وفي بقائه كما يعبّر الحكماء والمتكلّمون وهذه الحاجة في الكائنات من لطيف حكمة الله تعالى إذ جعلها محتاجة إليه في أصل وجودها وفي بقائها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد جعل سبحانه الكائنات يحتاج بعضها البعض في إدارة أوضاعها وتنظيم حياتها وجعل الإنسان أكثر حاجة من غيره لأنّ بعض الحيوانات أو النباتات قد تكون مستقلة بنفسها وتعيش حياة انفراديّة بينما الإنسان لا يتمكّن أن يعيش بمعزل عن الآخرين وذلك لأنّ تركيبة الإنسان النفسيّة والبدنيّة وقدراته الخاصّة لا تتمكّن أن تستوعب كلّ جوانب
الحياة وتجعله مستغنياً عن الآخرين في إدارة شؤونه وتنظيم حياته إذ إنّ الإنسان وشؤونه النفسيّة واحتياجاته الروحيّة والماديّة من الأمور المعقّدة الصعبة التي تفرض عليه أن يعيش مع الآخرين ويتفاعل معهم أخذاً وعطاء، فمثلاً حاجة الإنسان النفسيّة إلى الكمال وتهذيب الأخلاق وتنمية المواهب الفكريّة والعقليّة هذه لا يمكن للإنسان أن يستغني فيها عن الآخرين ويكتفي لإشباعها بقدراته الذاتيّة بلا معلّم ومرشد ومربّي "ألا وإنّ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه" (2).
وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].
كما أنّ احتياجاته الماديّة من التغذية واللباس والسكن والوظيفة لا يتمكّن الإنسان من أن يلبّيها بمفرده بلا تكافل مع الآخرين وتوزيع في الأدوار والمسؤوليّات. أمّا حياة الحيوان ونظراً لبساطتها وسهولة نظمها فلا تتطلب كلّ هذا التعقيد في العلاقات والروابط والوظائف، من هنا قد يتمكّن الحيوان في بعض الحالات والظروف من أن يعيش منفرداً عن أشباهه أمّا الإنسان. فلا؛ لأنّه كما يحتاج بطبيعته إلى الآخرين في إشباع حاجاته الروحيّة والمادّيّة معاً كذلك هو بحاجة إلى دفع وحشته وعزلته بالاجتماع والترابط والتعايش، من هنا قالوا الإنسان اجتماعيّ بالطبع.
الترابط والتدابر:
وحيث خلق الإنسان اجتماعياًّ بالطبع لا لحاجته الجسديّة فقط وإنّما لحاجته النفسيّة أيضاً فالإنسان يستأنس بوجود الإنسان إلى جانبه ويستوحش لفقده ويتولّد من هذا الاستئناس ترابط اجتماعيّ تقوّيه المحبّة والاحترام والخدمة ونحو ذلك. ويقابله التدابر إذا ما تصرّف الإنسان مع الآخرين بالصفات السلبيّة والتنازع وما شابه. وينشأ الترابط بين الناس من أمور عديلة:
1 - وحدة الهدف، فيجتمعون للوصول إليه بدون أن يكون للمجتمعين لون واحد وهذا يسمى بالترابط الهدفيّ.
2 - وقد يكون الترابط من أجل وحدة اللون التابعة لوحدة الثقافة في الأخلاق والآداب والدين والمراسيم، وهذا ما يسمّى بالترابط الاجتماعيّ.
3 - وقد يكون الترابط بسبب التوالد والتناسل والعلاقات الأسريّة وهو ما يسمّى بالترابط الأسريّ.
كما أنّ التدابر والانفصال قد ينشأ من أمور عديدة منها:
اختلاف الهدف الناشئ من اختلاف الفكر والثقافة أو الدين ونحو ذلك. ففي الوقت الذي ترى أنّ صاحب الهدف فرداً كان أو جماعة يسعى وراء هدفه ويبذل من أجله الغالي والنفيس، يرى الآخرون أنّ هذا ليس هدفاً أو هو ليس المصداق الأتمّ للهدف أو ما يسمّى بالهدف الجذريّ أو العميق، لذا كما يعمل الأوّل لأجل هدفه يعمل الآخرون لأجل ما يرونه هدفاً بعكس الأول، وهذا ما يولّد الانفصال بين الفردين أو الجماعتين وهذا الانفصال والسعي لتحقيق الأهداف مرّة يكون إيجابيّاً ومرة يكون سلبيّاً.
فإذا كانت الجماعتان تسعى كلّ منهما وراء أهدافها بلا أن تعرقل مسيرة الجماعة المقابلة بل كلّ يسعى وراء هدفه ولا يوقع الآخرين في الضرر أو الضيق ونحو ذلك فهذا انفصال إيجابيّ وعملهما من أجل أهدافهما يسمّى (استباق) والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى بقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 148] لأنّ كلًّا منهما يستبق الآخر لنيل الهدف والوصول إلى طموحه.
أمّا إذا كان السعي والعمل مقروناً بالمنافسة الشديدة {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: 26] من أجل تقوية الجماعة الخاصة وتقدمها على الاخرين واكتساح ميدان العمل ولكن مع المنطقيّة والاعتدال يصطلح عليه في علم السياسة والاجتماع باسم (الرقابة) كرقابة التجّار والأحزاب السياسيّة في البلدان الحرّة وأصحاب الحرف والعلوم ونحو ذلك.
وقد يكون الثاني بإضافة كون الرقابة بالعداء والبغضاء وهو ما يسمّى (بالمحاربة) كما في المقاتلات والحروب (3) ومن الواضح أنّ الأوّل والثاني صحيحان أمّا الثالث فمرفوض في منطق الإسلام.
والخير والشر يتولّدان عادة من علاقات الإنسان بأقرانه، والخير يتولّد من العلاقات الاجتماعيّة التي أمرت بها الشريعة الإسلاميّة وأمّا الشر فيتولّد من العلاقات التي نهت عنها الشريعة الإسلامية وأحياناً يكون الخير نسبياً يختلف بالوجوه والاعتبارات فيكون بالقياس إلى أمر خير وإلى آخر شر ومثال ذلك جاء في الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن النبيّ وأئمّة الهدى (عليهم الصلاة والسلام).
مَن هو الأكثر شراً:
إذن للإنسان علاقتان بفضل كونه اجتماعيّاً، علاقته بالنّاس وعلاقة النّاس به ومن خلال هذه العلاقة الثنائيّة إما أن يكون الإنسان فاضلاً ومتشرعاً ويلتزم بحقوق الآخرين، والناس أيضاً يقابلونه بنفس الأمر فيكون أثر هذه العلاقة الخير، وإمّا أن يعامله الناس أحياناً بالسوء والاعتداء على حقّه دون أن يعتدي عليهم بالسوء فهؤلاء هم من أشرار الناس كما يعبّر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، وإمّا ألّا يأمن من شرّه هو بالذات باقي النّاس ولا يرجى منه الخير فهو أشدّ شرّاً بل شرّ النّاس لأنّ في الحالة الأولى الإساءة إليه وحده ويمكن الإغضاء عن الإساءة وإشاعة روح الفضيلة في الآخرين وفي الحالة الثانية تتعلق الإساءة بالكثيرين، فالأولى أقل سوءاً والثانية تكون أكثر سوءاً ولذا يعتبر الرسول الأعظم ص هذا الإنسان الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره أكثر شراً . . إذن لكون الإنسان اجتماعياً بالطبع ولا يمكنه أن يعيش بمعزل عن الآخرين يلزم عليه أن يراعي بعض الأمور لدى علاقاته بالناس منها:
لذّة العفو ولذّة المحبّة:
إنّ الإنسان ومن خلال احتكاكه بالمجتمع ومعايشته للناس تصدر منه ذنوب وعثرات يرتكبها الناس بحقه أو هو يرتكبها بحق الآخرين وإذا لم يكن عفوّاً سموحاً لا يبقى له صديق أو حميم بل يعيش دائماً في عناء وتعب ومشقة نتيجة تأذيه من قبل الآخرين بما يسبّب له الانعزال وانفصال روابطه الاجتماعيّة ابتداء من الزوجة والأولاد إلى الأرحام ثم الأصدقاء وهكذا. ومن الواضح أنّ الإنسان الذي لا يعفو ولا يصفح يعيش وحيداً غير ممدوح ولا محبوب وهذا ألمه أشدّ على نفسه من ألم الصبر والتسامح، بل إنّ العفو السموح يعيش لذّتين لذة العفو ولذة المحبة والارتباط الاجتماعي أمّا الذي لا يغض عن الذنوب ودائماً يتوقع من الآخرين أن يكونوا معصومين في علاقاتهم وروابطهم معه فإنّ هذا يعيش ألمين ألم العزلة وألم الغضب.
قال الشاعر:
ولست بمستبقٍ أخاً لا تلمه *** على شعث أي الرجال المهذّب
وقال مولانا الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام):
«الصفح أن يعفو الرجل عمّا يجنى عليه ويحلم عمّا يغيظه» (4).
وعنه أيضاً (عليه السلام): «مَن عفى عن الجرائم فقد أخذ بجوامع الفضل» (5).
وعنه أيضا (عليه السلام): «معالجة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام» (6).
وعنه أيضاً (عليه السلام): «شرّ الناس من لا يعفو عن الزلّة ولا يستر العورة» (7).
القدوة الطاهرة:
كان الأئمة الطاهرون (عليهم السلام) يتغافلون عن إساءة الناس لهم ويغضّون عن سيّئاتهم وهم خير قدوة لنا في هذا.
جاء رجل إلى علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له: إنّ فلاناً قد وقع فيك وآذاك، قال: فانطلق بنا إليه، فانطلق معه وهو يرى أنّه سينتصر لنفسه، فلمّا أتاه قال له: يا هذا إن كان ما قلت فيّ حقّاً فالله تعالى يغفره لي، وإن كان ما قلت فيّ باطلاً فالله يغفر لك (8).
ولا شكّ بأنَّ ما ذكره الرجل في الإمام (عليه السلام) كان باطلاً ولكنّ الإمام يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وهي أشدّ تأثيراً من النهي والزجر أو الصدام لأنّ في هذا التصرف العداوة والبغضاء وفي الإقالة المحبة والترابط، واستطال رجل على علي بن الحسين (عليه السلام) فتغافل عنه، فقال له الرجل: إيّاك أعني؟ فقال له علي بن الحسين (عليه السلام) وعنك أغضي (9).
لأنّ في الإغضاء عن زلّات الآخرين تربية ومصلحة اجتماعية كبيرة ولهذا السبب أيضاً ثبت الدين ودعائمه إذ استخدم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) سياسة العفو والإغضاء عن المجرمين والمنافقين والمتآمرين بل حتى من آذاه وقتل عمه وأهل بيته وشرده من دياره ليقول لهم كلمته المشهورة عند فتح مكة «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (10).
وكذلك عفى (صلى الله عليه وآله) عن الهبار بن الأسود الذي روّع زينب ابنته (صلى الله عليه وآله) فالقت ما في بطنها وماتت بعد مرض فأباح رسول الله ص دمه ثم إنه لما عرف أنّ الرسول يعفو جاء إليه واعتذر من سوء فعله وقال: كنّا يا نبي الله على شرك فهدانا الله تعالى بك وأنقذنا من الهلكة فاصفح عن جهلي وعمّا كان يبلغك عنّي فإنّي مقرّ بسوء فعلي معترف بذنبي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله. وكذلك عفى عن وحشي قاتل عمّه حمزة (رضوان الله عليه) فإنّه روي أنّه أسلم وجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمن جانبه فقال له النبي أوحشي؟ قال: نعم قال: أخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره فبكى (صلى الله عليه وآله) ثم عفى عنه. وعفوه عن المشرك (غورث) في قصّة مفصّلة مذكورة في البحار (11)، فسياسة العفو واللين التي استخدمها النبي هي التي ركّزت دعائم الإسلام وجذبت العدو والصديق يقول تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159]. فالسماح وسعة الصدر والاحتواء واللين كلّها اتّصف بها النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) فاستطاع بهذه الصفات الكريمة تجميع النّاس حوله ولولا روح السماحة واللين والقبول لانفضّوا من حوله بل إنّه (صلى الله عليه وآله) كان يمتاز بقلب يستقطب الناس ويجذبهم نحوه بنورانيته الشريفة وقدسيّته الرفيعة.
السلام في ظلّ الإسلام:
إنّ من أسرار عظمة الإسلام وانتشاره بين الناس كدين ونظام عالمي خالد رغم المواجهات الصعبة التي يفعلها أعداؤه ضده، هو مبدأ العفو والإغضاء حتّى مع أعدائه قال سبحانه وتعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصلت: 34، 35].
وقال الإمام زين العابدين (عليه السلام): "اللّهُمّ سدّدني لأن أعارض من غشّني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبرّ، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأشكر الحسنة وأغضي عن السيئة» (12)، وأمّا قوله سبحانه وتعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ..} [الفتح: 29] فذلك حيث قصوى حالات الاضطرار كالعمليّة الجراحيّة الخطرة حيث لا يقدم عليها الطبيب إلّا في الحالات القصوى ولذا كان الرسول الأعظم والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) يخفّفون دائماً أسباب العداء ويقلّصونها فتراهم يعطون الماء لمن حاربهم ويوجّهون لهم كلمات التذكير بمكانتهم وآثار خروجهم على إمام زمانهم ويمهلون العدو ولا يبدأون القتال إلّا إذا بدأه الأعداء بعدما ألقوا الحجة عليهم وبيّنوا طريق الهدى والنجاح وإذا كان لا بدّ من القتال فهو لحالة الاضطرار القصوى وإذا كانت هذه أفعال أئمتنا مع الأعداء، الرحمة والعفو والإغضاء فهم أشدّ رحمة واغضاءاً مع مجتمعهم ورعاياهم.
موقف كريم:
ومن سياسة العفو التي اتبعها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه عفى عن عائشة بعد أن انتصر على أهل الجمل وبعثها من البصرة إلى المدينة معزّزة مكرّمة وقد جاء عن المسعودي في مروج الذهب: «وخرجت عائشة من البصرة، وقد بعث معها علي أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وثلاثين رجلاً وعشرين امرأة من ذوات الدين من عبد القيس وهمدان وغيرهما، ألبسهنّ العمائم وقلّدهنّ السيوف، وقال لهنّ لا تعلمنّ عائشة أنكنّ نسوة وتلثمنّ كأنكنّ رجال وكنّ اللاتي تلين خدمتها وحملها، فلمّا أتت المدينة قيل لها: كيف رأيت مسيرك؟ قالت: كنت بخير والله، لقد أعطى علي بن أبي طالب فأكثر، ولكنّه بعث معي رجالاً أنكرتهم فعرّفها النسوة أمرهنّ، فسجدت وقالت: ما ازددت والله يا ابن أبي طالب إلّا كرماً..» (13).
وفي كتاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين: «وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أنّ ربّنا واحد ونبيّنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله، ولا يستزيدوننا: الأمر واحد، إلّا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائرة، وتسكين العامة حتّى يشتد الأمر ويستجمع، فنقوى على وضع الحق مواضعه، فقالوا بل نداويه بالمكابرة، فأبوا حتى جنحت الحرب وركدت، ووقدت نيرانها وحمست، فلمّا ضرستنا وإيّاهم، ووضعت مخالبها فينا وفيهم أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناهم إلى ما طلبوا حتّى استبانت عليهم الحجة، وانقطعت منهم المعذرة» (14).
ولذا فإنّ من لا يغفر الذنب ولا يقيل العثرة فهو من شر الناس لما فيه من شر واضح على التباعد الاجتماعي.
الإساءة إلى الآخرين:
هناك بعض الأفراد أكثر شرّاً من الذين لا يغفرون ذنوب الآخرين ولا يقيلونهم عثراتهم وهؤلاء هم الذين يسيئون إلى الآخرين فلا يؤمن شرهم ولا يرجى منهم الخير يسعون إلى الخراب والدمار والإصلاح والبرّ بعيد عنهم، فيغتابون الناس بما ليس فيهم وينسبون لهم صفات سيّئة لتهديم منزلتهم الاجتماعيّة ويثيرون متاعب كثيرة للأحبة والأصدقاء ويفرّقون بين المرء وخليله ويتعاملون أحياناً بخشونة في الكلام والفحش في العبارات ويؤثرون أحياناً على جهلاء الناس في سير سلوكهم وقد تنشأ من خلال هذه الخصلة عصابات إجرامية تسلب المجتمع الراحة والأمان. . وقد حارب الإسلام هذه الخصلة بالأخوة الإسلامية وأفهم الإنسان أن الحياة ليست له وحده، وأنها لا تصلح به وحده، وليتذكر أن هناك أناساً مثله ينبغي أن يعاملهم معاملة حسنة ويعاشرهم بالمعروف ويوصل إليهم منه الخير والبر والإحسان. «خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره» (15) وقد حثّت الشريعة الإسلاميّة الإنسان على دفع المضرة عن الآخرين ومشاركتهم آلامهم والحزن لمصائبهم ومشاركتهم أفراحهم وجعلت الثواب على ذلك.
ولذلك كانت الشعائر الحسينيّة ومجالس التعزية والمصائب وإقامة الفاتحة على الأموات والمشاركة في الأعراس والمواليد وإقامة الولائم لأجل تمتين العلاقات الاجتماعية واشتراك العواطف في هذا الأمر سبب لتقويتها وبالتالي تكون آثارها كبيرة؛ لأنّ الاختلاط والمشاركة الجماعيّة تؤدّي إلى ارتفاع الخلافات وتأمين حوائج المحتاجين وإرساء المشاريع الخيريّة لتحسّس آلام الآخرين حتّى يكون المجتمع الإسلاميّ جسداً واحداً وفي الحديث الشريف: "المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده.." (16).
وفي حديث آخر قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» (17).
من علائم الأخوة:
ومن علائم الأخوة الإسلاميّة أن تحبّ النفع لأخيك وأن تدفع عنه الأضرار والشر، كما تبتهج للنفع الذي يصل إليك وكما لا تحبّ أن يضرك أحد إذن لا تضر الآخرين.
روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال لرفاعة بن موسى: يا رفاعة ما آمن بالله ولا بمحمد ولا بعلي (عليهما وآلهما السلام) مَن إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه، فإن كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها وإن لم يكن من عنده تكلّف من عند غيره حتّى يقضيها له، فإذا كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه (18).
وعن الرضا (عليه السلام): ومن قضى لمؤمن حاجته كان أفضل من صيامه واعتكافه في المسجد الحرام (19).
كان النجاشي وهو رجل من الدهّاقين عاملاً على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ في ديوان النجاشيّ عليَّ خراجاً، وهو مؤمن يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب إليه كتاباً؟ قال: فكتب إليه أبو عبد الله (عليه السلام): "بسم الله الرحمن الرحيم سرّ أخاك، يسرّك الله"، قال: فلمّا ورد الكتاب عليه، دخل عليه وهو في مجلسه فلمّا خلا ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبد الله (عليه السلام) فقبّله ووضعه على عينيه، وقال له ما حاجتك؟ قال: خراجٌ عليَّ في ديوانك فقال له: وكم هو؟ قال: عشرة آلاف درهم، فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه، ثم أخرجه منها وأمر أن يثبتها له لقابل، ثم قال له: سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك ثم أمر بركب وجارية وغلام، وأمر له بتخت ثياب في كلّ ذلك يقول: هل سررتك؟ فيقول: نعم جعلت فداك، فكلّما قال: نعم زاده حتّى فرغ، ثم قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي الذي ناولتني فيه، وارفع إليّ حوائجك قال: ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك، فحدّثه بالحديث على جهته فجعل يسرّ بما فعل، فقال الرجل: يا ابن رسول الله كأنّه قد سرّك ما فعل بي؟ فقال: إي والله لقد سرّ الله ورسوله (20).
هذه المواقف الشريفة تصوّر لنا أهميّة الخير وفعله فى الشريعة الإسلاميّة لأجل زيادة علائق الأخوة، وتقديره العالي لضروب الخدمات العامة التي يحتاجها المجتمع لإرساء أركانه وصيانة بنيانه فإن جوهر الإسلام الأخوة بتمام معانيها وأبعادها.
المرء كثير بإخوانه:
إنّ حاجة الإنسان لإكمال نواقصه والوصول إلى كماله تضعه أمام أعباء كثيرة وجسيمة، والإنسان وحده أضعف من أن يقف طويلاً تجاه الشدائد بل قد ينتهي ويزول ولكنّه قد يكون في غنى عن الجهد العظيم لو أنّ إخوانه هرعوا لنجدته وظاهروه في نجاح مقاصده وفي الحديث الشريف "المرء كثير بأخيه" (21).
ومن حقّ الأخوّة أن يشعر المسلم بأنّ إخوانه له في السرّاء والضرّاء وأنّ قوّته لا تتحرّك في الحياة وحدها وكما يشعر بذلك نحو نفسه لا بد له من أن يقف مع الآخرين هو أيضاً بهذا الشعور وهذه الروحيّة متجنّباً الشرّ ولا يرجى منه إلّا الخير:
وما المرء إلّا بإخوانه *** كما يقبض الكف بالمعصم
ولا خير في الكفّ مقطوعة *** ولا خير في الساعد الأجذم
ولذا فإن قوى المؤمنين لو تآزرت وانشد بعضها إلى البعض لا يمكن لأي قوة معادية أن تهدّها او تخترقها.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً» (22) وأخوّة الدين تفرض على المسلمين التناصر وفعل الخيرات لإحقاق الحق وإبطال الباطل وردع المعتدي وإجارة المهضوم وقضاء حاجة المحتاج، فلا يجوز ترك مسلم يكافح في الحياة وحده دون أن نمد له يد المساعدة المادّيّة أو المعنويّة على الأقل، فيكون شرّه مأموناً إذا لم يتوصّل إلى طريقة يساعد بها الآخرين، أمّا إذا فعلنا العكس وكان شرّنا هو الواصل والخير والمساعدة لا يرجيان منّا لإخواننا وهان الأمر على الآخرين وصرنا أفراداً متشتّتين وكلّ ينقص الآخر ولا يدافع عنه وقد يرى البعض الظلم بعينه دون أن يحرّك ساكناً أو يتخاذل في الأمر ومن الواضح أنّ هذه الحالة لو سرت في المجتمع والعياذ بالله فسوف تنزل علينا اللعنة كما في قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يقفنّ أحدكم موقفاً يضرب فيه رجل ظلماً فإنّ اللعنة تنزل على مَن حضره حين لم يدفعوا عنه» (23) وكذلك وصفه الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في حديثه الذي افتتحنا به بحثنا بأنّه أشر من شرار الناس.
المجتمع الإسلامي:
وهناك بعض الناس لا يهمّه أمر الأخوّة الإسلاميّة وفعل الخير تراه يؤذي الناس بسوء أخلاقه وتصرّفاته المشينة ولذا ترى الناس يخافون منه ويبتعدون عنه لأنّه سيّئ الأخلاق ولسانه بذيء ويغتاب ولا يعاشر بالمعروف وإنّما أغلب حياته خشونة وفظاظة والبعض الآخر لا ينتخب طريقة العنف لإخافة الناس وإنّما تراه بعيداً عن الناس إذ لا يرجى منه الخير ولا يتوسّط في أمور الخير ولا يجيب السائل ولا يساهم في الإحسان والمبرّات سواء كانت المساهمة مادية أو معنوية، وهكذا أناس يكونون أشد شراً من الذي لا يغض طرفه عن الذنب الصادر من أخيه أو لا يقيله عثرته لأنّه يساهم في خراب المجتمع الإسلاميّ وتفتت الأواصر والعداوة بدل الأخوّة وبذلك يستطيع الأعداء النفوذ إلى المجتمع الإسلاميّ ودس أفكارهم الباطلة وسطه وهناك يكمن الشر العظيم على المجتمع الإسلامي.
بالإضافة إلى انتشار حالة الأنانية والشقاء بين الناس، أمّا لو انعكست الصورة وتوفق جميع الأبناء إلى عمل الخير وتمتين أواصر الأخوّة والعيش بسلام فإنّ المجتمع سيتماسك ويكون كالجسد الواحد لا يمكن للأعداء اختراقه، في الوقت الذي يعيش الجميع فيه آمنين مطمئنين على حياتهم وأوضاعهم أمام نوائب الدهر كما عاشت المدينة (يثرب) قبل أربعة عشر قرناً هذا الاطمئنان والأمان بفضل تماسك المسلمين وتوادّهم وإخلاصهم العمل لله تعالى، وكما ارتفعت حالة العداء بين القبائل القاطنة في المدينة والوافدة إليها وحصل التآخي بين المهاجرين والأنصار وتصالحت قبيلتا الأوس والخزرج بظل الإسلام وكذلك الإيثار عن سماحة والمساواة بين الأنساب والأجناس وتبادل الاحترام والحب كلّ ذلك ساعد على انتشار الإسلام العظيم إلى جميع أنحاء العالم بمبادئه الإلهية العظيمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تحف العقول: ص 18.
(2) البحار: ج 40، ص 340، باب 98، ح 27، ط ـ بيروت.
(3) راجع كتاب فقه الاجتماع: ج 1، ص 39، ط ـ بيروت.
(4) تصنيف غرر الحكم: ص 245، ط 1.
(5) المصدر نفسه.
(6) المصدر نفسه.
(7) المصدر نفسه.
(8) كشف الغمّة: ج2، ص 287، ط ـ بيروت.
(9) المصدر نفسه: ص 313.
(10) الوسائل: ج 11، ص19، الباب 72، ح 1.
(11) البحار: ج20، ص 179، باب 15، ح 6.
(12) الصحيفة السجاديّة من دعاء مكارم الأخلاق: ص 109.
(13) مروج الذهب: ج 2، ص370.
(14) نهج البلاغة: ص448، صبحي الصالح.
(15) نهج الفصاحة: ص 319، ح 1526.
(16) الكافي: ج 2، ص 166، باب أخوّة المؤمنين، ح 4.
(17) مستدرك الوسائل: ج 12، ص 415، باب 29، ح 7.
(18) سفينة البحار: ج 2، ص 488، ط ـ جديدة.
(19) المصدر نفسه.
(20) البحار: ج47، ص370، ح 89.
(21) البحار: ج 75، ص 251، باب 23، ح 99.
(22) نهج الفصاحة: ص628، ح 3103.
(23) شرح رسالة الحقوق: ج 1، ص 632.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|