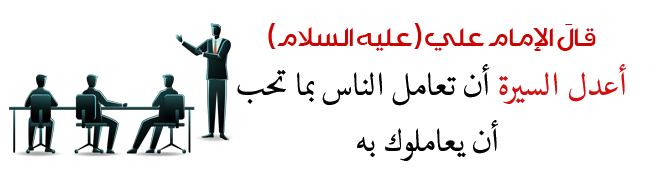
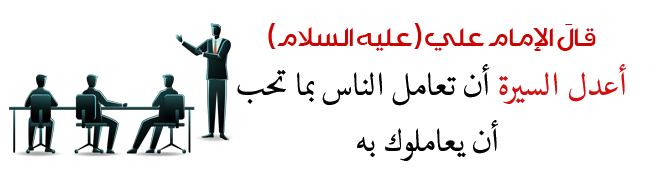

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-08-2015
التاريخ: 3-08-2015
التاريخ: 3-08-2015
التاريخ: 3-08-2015
|
توطئة خاصة :
قال
الاِمام أبو عبدالله الصادق عليه السلام : « إنّا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً
صانعاً متعالياً عنّا ، وعن جميع ما خلق ، وكان ذلك الصانع حكيماً ، لم يجز أن
يشاهده خلقه ، لا يلامسهم ولا يلامسوه ، ولا يباشرهم ولا يباشروه ، ولا يحاجّهم
ولا يحاجّوه. فثبتَ أنّ له سفراء في خلقه وعباده ، يدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم
، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم ، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في
خلقه. ثبت عند ذلك أنّ له معبرين ، وهم الاَنبياء وصفوته من خلقه ، حكماء ،
مؤدّبين بالحكمة ، مبعوثين بها ، غير مشاركين للناس في أحوالهم ، على مشاركتهم لهم
في الخلق والتركيب » (1).
ولعلّه
من هنا وممّا على شاكلته ، استفيدت مقدّمات ما جعلوه بياناً وأسّسوا عليه قاعدة
متينة تسمى بقاعدة «اللطف » وخلاصة ذلك :
أنّه
تعالى لا يشاهده خلقه ، ولا يلامسهم ، ولا يلامسوه ، ولا يحاجّهم ، ولا يحاجّوه ،
إذن لابدّ من وجود سفراء له في خلقه وعباده.
وهؤلاء
هم الذين يدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم ، وفي تركه فناؤهم ، فثبت
حينئذٍ الآمرون والناهون ، عن الحكيم العليم في خلقه.
ولذا
قد ورد : « إنّ الخلق لمّا وقفوا على حدٍّ محدود ، وامروا ان لا يتعدّوا ذلك الحد
لما فيه من فسادهم ، لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلاّ بأن يجعل عليهم أميناً يأخذهم
بالوقف عندما أُبيح لهم ، ويمنعهم من التّعدّي والدخول فيما حظر عليهم ، لاَنّه لو
لم يكن ذلك لكان أحدٌ لا يترك لذَّته ومنفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم قيّماً
يمنعهم من الفساد ، ويقيم فيهم الحدود والاَحكام.
و ـ
إنّا لا نجد فرقةً من الفرق ولا ملّةً من الملل بقوا وعاشوا إلاّ بقيّم ورئيس لما
لابدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلق ممّا
يعلم انّه لابدّ لهم منه ، ولا قوام لهم إلاّ به » (2).
ومنه
يجب ان يكون هؤلاء لكي تتمّ الحكمة من سفارتهم صفوته من خلقه ، وإلاّ لكان هناك
ترجيحٌ بلا مرجّح ، أو تقديمٌ لمفضول على فاضل ، وهو منافٍ للحكمة. وهؤلاء حكماء ،
قد ادّبهم الباري عزّ وجلّ بآدابه فبُعثوا بالحكمة كما كانوا هم من أهلها وسادتها.
ويجب أن يكونوا بصراء مطيعين لله تعالى لا يشركون به طرفة عينٍ ولا أقلَّ من ذلك
ولا أكثر. ويجب ألاّ يكونوا كاذبين وإلاّ لانتفت الحكمة في بعثهم ، إذ سيتردد
الناس في قبول قولهم ، ولا يصلح أن يكونوا أدلاّء على طريقه. وهؤلاء يجب أن يكونوا
من جنس البشر وطينتهم حتى يكونوا مثالاً حيّاً للائتمام بهم. واختصاراً لكلِّ
الصفات الكاملة المجتمعة في ذاته المقدّسة نقول إنّه يجب أن يكون معصوماً.
وبما
انّ العصمة ، ليست من الامور الظاهرة والواضحة ، بل من الامور غير المدركة للبشر ،
إذن لابدّ وان يُشار إليها ، بالطرق الثلاثة الآتية أو ببعضها :
أ ـ
بالعقل.
ب ـ
بالنقل بالاضافة إليه.
جـ ـ
أو بالإعجاز لاثبات منصبه ، ومن إثبات المنصب تثبت له بالملازمة.
ويتأكد
العنصر الثالث ، إذ لابدّ من إعجاز يظهر لتأييد صدق مدّعي السفارة ، وإلاّ
لادّعاها كلُّ أحد. ولابدّ ان يفهم أهل عصر السفير أنّ ذلك إعجازٌ ، فلذا كانت
المعاجز مختلفة باختلاف العصور.
والرعاية
شاملةٌ لكلِّ البشرية من أولها إلى آخرها لا يختص ذلك بزمانٍ دون زمان. ولكن نعلم
علم اليقين أنّه لا نبيّ بعد نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ المنكر
لذلك لا يعدّ مسلماً أصلاً ، إذ إنَّ ذلك من ضروريات الدين ، فمنكره منكر للضروري
، ومنكر الضروري كافر. فإذن لابدّ من وجود سفير لله ، ولا يكون نبيّاً ، وذلك هو
الذي نعبّر عنه « بالإمام ».
ونحصر
البحث في الاِمامة عند المسلمين إذ إنّه « لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً
حافظاً مستودعاً لدرست الملّة، وذهب الدين ، وغُيّرت السُنّة والاَحكام ، ولزاد
فيه المبتدعون ، ونقص منه الملحدون ، وشبّهوا ذلك على المسلمين ؛ لاَنّا وجدنا
الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم ، وتشتّت انحائهم ،
فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول ، فسدوا على نحو ما بيّنّا ،
وغُيِّرت الشرائع والسنن ، والاَحكام ، والايمان ، وكان ذلك فساد الخلق أجمعين » (3).
ولذا
قالوا : ( لمّا أمكن وقوع الشرّ والفساد وارتكاب المعاصي من الخلق ، وجب في الحكمة
وجود رئيس قاهر ، آمر بالمعروف ، ناهٍ عن المنكر ، مُبين لما يخفى على الاُمّة من
غوامض الشرع ، مُنفِّذ لأحكامه ، ليكونوا إلى الصلاح أقرب ، ومن الفساد أبعد ،
ويأمنوا من وقوع الشر والفساد ).
فوجوده
لطف ، وقد ثبت ان اللطف واجب عليه تعالى ، وهذا اللطف يسمى إمامة ، فتكون الاِمامة
واجبة ، ( ولمّا كان علّة الحاجة إلى الاِمام عدم عصمة الخلق وجب ان يكون الاِمام
معصوماً ) (4).
ومن
ناحية اُخرى فإنّ القرآن حق كلّه وإنّه قطعي الصدور ، إلاّ انّه ظنّي الدلالة ،
فلذا سيقع الاختلاف في تأويله ، وكلُّ متأول يدعي انّه على الحق وغيره ليس عليه ،
فيكون ذلك سبباً للفرقة والنزاع أكثر من التأليف والاجتماع ، وهذا منافٍ للحكمة ،
إذن لابدّ من وجود مبيّن لكتابه العزيز ونعبِّر عنه بالحافظ له.
ومن
جانب آخر نرى أن السُنّة النبوية كذلك ، بل ملئت كتب نقلها بأحاديث كاذبة ومُلفقة
، فما أدرانا ما الذي قاله صاحب الشرع وما الذي لم يقله ؟ خاصّةً أنّ هذه الفجوة
تكبر وتكبر كلّما ابتعدنا عن مركز الرسالة الاَول ، فبذا لابدّ من وجود مبيّن
ومفسّر وكاشف عنها. ومن هنا صرّح الشيخ الصدوق قدس سره بهذا الدليل في اول كلامه
إذ قال :
«
إنّه لمّا كان كلّ كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوهاً من التأويل ، وكان أكثر القرآن
والسُنّة مما اجمعت الفرق على انّه صحيح لم يغيّر ولم يبدّل ، ولم يزد فيه ولم
ينقص منه ، محتملاً لوجوه كثيرة من التأويل ، وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم
من تعمد الكذب والغلط ، مُنبئ عمّا عني الله ورسوله في الكتاب والسُنّة على حق ذلك
وصدقه ، لاَنّ الخلق
مختلفون
في التأويل ، كلّ فرقةٍ تميل مع القرآن والسُنّة إلى مذهبها ، فلو كان الله تبارك
وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه لكان قد سوّغهم الاختلاف
في الدين ودعاهم إليه... وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات والاعتماد للحق وخلافه.
فلمّا
استحال ذلك على الله عزّ وجلّ ، وجب أن يكون مع القرآن والسُنّة في كلّ عصر من
ينبئ عن المعاني التي عناها الله عزّ وجلّ في القرآن بكلامه... وينبئ عن المعاني
التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وأخباره... واذا وجب انه
لابدّ من مخبر صادق وجب ان لا يجوز عليه الكذب تعمّداً ، ولا الغلط وجب ان يكون
معصوماً » (5).
وبما
أنّ مهمته كذلك إذن يجب ان يكون صادقاً وأميناً ، لكي يقبل منه الناس كلّ ما يبينه
ويوضحه كما كان الرسول كذلك.
(
وثبت عند ذلك أنّ له معبّرين هم الاَنبياء وصفوته من خلقه... ).
فالاَنبياء
قد ذكر ، والاَئمة بصفوته من خلقه قد بيّنهم كذلك ، فالاَنبياء والاَئمة كلُّهم
لابدّ وان يكونوا (مؤدّبين بالحكمة ، مبعوثين بها ، غير مشاركين للناس في أحوالهم
، على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب.. ). ومن هنا نفهم وندرك جيداً معنى حديث
الثقلين : « إنّي مُخَلِّفٌ فيكم الثقلين كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي...».
وندرك
كذلك لِمَ سكت ذلك الشامي عندما ناظره هشام بن الحكم رضي الله عنه
عندما
قال له هشام : يا هذا أربُّك أنظَر لخلقه أم خَلقُهُ لأنفسهم ؟
فقال
الشامي : بل ربي أنظر لخلقه.
فقال
: ففعل بنظره لهم ماذا ؟ !
قال
: أقام لهم حجّةً ودليلاً كيلا يتشتتوا ، أو يختلفوا ، يتألّفُهُم ويقيم أودهم
ويخبرهم بخبر ربهم.
قال
: فمن هو ؟ !
قال
: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال
هشام : فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ ؟ !
قال
: الكتاب والسُنّة.
قال
هشام : فهل ينفعنا اليوم الكتاب والسُنّة في رفع الاختلاف عنّا ؟ !
قال
الراوي ـ الذي هو يونس بن يعقوب ـ فسكت الشامي » (6).
وأخيراً
نقول إنّ الاِمامة منصبٌ خاص.
ونستطيع
أن نضيف : بانّ منزلة الاِمامة تساوي الاُسوة والقدوة.
فالمُقتدى
به هو الاِمام ، وبما أنّه النموذج الاَمثل والاَكمل للخلافة الالهية فعليه يجب أن
يكون حاوياً لكلِّ معنى الكمال الذي يمكن أن يتّصف به المخلوق ، حتّى يكون قدوةً
للجميع.
وبالخليفة
يُستدلُّ على المستخلِف ، فلو كان عادلاً لاَشعر وأشار إلى عدله ، ولو كان ظالماً
لبيّن ظلمه.
كما
أنّ نصب الكامل أبعد للخيانة ، فالله قادرٌ لا يعجزهُ شيء ، وهو المُطّلع على
عباده ، فاختياره لمن يحمل رسالته ويكون خليفته لابدّ أن يكون أتمّ خلقه ، ولا يصح
أن يقع بالخيانة مهما صغرت ، إذ الله يقول وقوله الحقّ : {أَنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} [يوسف: 52].
فعليه
لابدّ وأن يكون أحسن خلقه وأتمَّهم. وبذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اسوةً لنا : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }
[الأحزاب: 21].
فالإمام
كما يظهر للمتتبع يمثل الاسوة والقدوة الالهية الكاملة للممكن سواء كان نبيّاً أم
غيره.
وبهذا
كلّه ظهر بعض خصائص الاِمام المعبّر عنه بالعصمة.
الاَدلة
العقلية :
بعد
هذا الاستعراض وهذه المقدّمات نحاول أن نضع أصابعنا على الاَدلة العقلية التي تثبت
العصمة لمن اختاره الله تعالى لهداية خلقه بعد إنذارهم...
1 ـ
إنّ من يدّعي منصباً إلهيّاً لابدّ أن يظهر المعجز على يديه ، فدعوى ذلك المنصب
أولاً ، وإظهار المعجز ثانياً ، فيعلم صدقه ووساطته عن الله تعالى إلى الناس.
ومقتضى
هذا كلّه يجب أن يكون صادقاً وأميناً ليؤدّي رسالته على أتمّ وجه ، وأكمل صورة ،
إذ يقبح عقلاً أن يبعث الله تعالى ، أو يوسِط بينه وبين خلقه من هو كاذبٌ غير
أمين. وهذا واضحٌ لا غبار عليه.
فكأنّ
المُعجز قد وقع وأيّد مُدّعي النبوة والرسالة والمقام الالهي. فلابدّ أن يكون مانعاً
من الكذب، لاَنّ تصديق الكذّاب قبيح. وهذا المقام الالهي بتأييده يدلُّ على
الاتّباع والتصديق ، وذلك لاَنّ الغرض الامتثال لما جاء به صاحب هذا المقام.
من
هنا نستكشف أنّ كلّ ما يقدحُ في صاحب هذا المقام ، يقدح في الامتثال ويزحزحه ،
فلابدّ أن يكون هذا الصاحب مؤيّداً بالبُعد عن جميع ما يكون منفّراً عنه مبعّداً ،
ولعلّ هذا أقرب للوقوع من إظهار المعجز ، إذ إظهار المعجز لقبول قوله ، فكلّ ما
يؤيِّد هذا القبول ويقوّيه يُرَجّحُ وقوعه ، وهذا كلُّه ممكن وشرائطه واضحة طبيعية
، فهو أولى للتصديق من اختراق القوانين الكونية والنواميس الطبيعية لتأييد هذا
الوسيط ليكون بذلك كلّه الامتثال أقرباً. إذ إنّ النفس لا تميل لمرتكب كلّ ما يكون
منفراً.
وبعبارة
أوضح نقول : إنّ مدّعي الوساطة لابدّ أن يكون خالياً من السخف ، والجنون ،
والخلاعة.. الخ. ونضيف إلى ذلك الذنوب كلّها ، وبالخصوص الكبائر منها ، فإنّها
أوضح للقبول ، ولذا عبّر من عبّر ، وأصاب فيما عبّر ( انّ حظّ الكبائر في هذا
الباب إن لم يزد عن حظّ السخف والجنون والخلاعة ، لم ينقص منه ) (7).
فإذا
تمَّ هذا يظهر أنّ كلّ ما هو منفرٌ يجب أن لا يتّصف به الوسيط ، رعاية من الله
تعالى لنا ، ليقرِّبنا إلى الطاعة أكثر ، ويبعدنا عن المعصية (8).
فإذا
سلّمنا بهذا نقول : إنَّهم اختلفوا في عدد الكبائر ، بل في حدود الكبيرة ، فبعضٌ
قد رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة ، ورووا انّ ابن عمر زادها اثنين
، وابن مسعود زاد عليها ثلاثة. كما أنّ كثيراً من عظائم الذنوب ليس في ما ذكروه
وسطّروه.
وقد
اختلفوا كذلك في تحديد الكبيرة ، فقالوا : هي الذنب الذي واعد الله تعالى عليه
النار في القرآن ، وبعضهم قال : إنّ الكبائر من الذنوب هي التي عُدّت كبائر في
الاَخبار (9). بل بعضهم صرَّح أنّه ليس هناك كبيرة ولا صغيرة بل كلّها كبائر.
كلّ
هذا لا مدخلية له في بحثنا عند التمعّن بشيء ، وذلك لاَنّ الذي يهم ، هو ما كان
مُنفّراً للخلق من الوسيط ، وما كان مبعّداً للوسيط من الخالق ، فاذا رضينا بذلك
وقنعنا به ، يكون حينئذٍ حال الذنوب كلّها واحداً.
ولو
دققنا في الاَمر أكثر لرأينا أن هناك ذنباً أي معصية ، وعاصياً ، ومن قد عُصي ،
فمن جهة نفس المعصية رأينا الاختلاف في الكبيرة والصغيرة ، وحدودهما. ومن جهة
العاصي رأينا علو مقامه ، وحسّاسيّة ذلك المقام فعلمنا أنّه من المقربين ، وإذا
سلّمنا بأنّ حسنات الاَبرار سيئات المقرّبين ، علمنا ما يُفيده ذنب المقرب سواء
كان صغيراً أو كبيراً بما أنّه مقرّب ، إذ إنّ ما يُعدُّ حسنةً في مقام يُعدُّ له
ذنباً وسيئة ، فكيف بالذنب والمعصية.
ومن
جهة ثالثة نظرنا إلى الذي عُصِيَ فرأيناهُ عظيماً فعظُمت معصيته أيّاً كانت ، ولذا
جاء في الاَثر : « لا تنظروا في صغر الذنوب ، ولكن انظروا على من اجترأتم » (10).
من
هذه الجهات الثلاث نرى انّ استبعاد بل امتناع صدور المعصية من صاحب هذا المقام
أقرب للقبول ، بل هو عين الواقع ، إذ حاله يختلف عن حالنا جزماً.
ومن
هنا يظهر معنى قول الشيخ المفيد قدس سره : ( وإنّه ليس في الذنوب صغيرة في نفسه ،
وإنّما يكون فيها بالاضافة إلى غيره ) (11).
كما
أننّا لو دقّقنا النظر لرأينا أنّ النفس تسكن للذي لم تصدر منه المعصية أصلاً أكثر
ممن صدرت منه ، سواء تاب عنها أم لا ، والمثل الذي نضربه يُقرِّبُ هذا المعنى
ويجعله أوضح : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (12) ، إذ لو لم يكن أعلا منه
منزلة لما شُبّه به ، فإذا ثبت هذا : ( أمكن التمسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا
من تنزيههم « صلوات الله عليهم » عن كلِّ منقصة ، ولو على سبيل السهو والنسيان من
حين الولادة إلى الوفاة بالإجماع المركب ) (13).
إذ
العلماء بين قائل بعصمتهم كذلك مطلقاً. وبين قائل بعصمتهم من الكبائر ، واختلفوا
بالصغائر، وبين قائل بعصمتهم من الكبائر في حال دون حال. فإذا ثبتت عصمتهم من
الكبائر والصغائر يتعيّن القول الاَول. إذ لا قائل بعصمتهم منهما معاً ويشكّك
بمقام دون مقام.
2 ـ
لو صدر ذنب منه لزم اجتماع الضدين ، فيجب إطاعته لاَنّ مقامه يقتضي هذا ، ويجب
عصيانه لاَنّ ما جاء به ذنب. بل يجب منعه ، والانكار عليه ، بل ردعه وحتى زجره لكي
يترك ذلك الذنب ، فلربما يولّد ذلك الايذاء له ، وإيذاؤه كما نعلم حرام بالإجماع ،
ولقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } [الأحزاب: 57].
3 ـ
كما أنّه لو أذنب كان فاسقاً ، فيجب أن تُردَّ شهادته ، للإجماع ، ولقوله تعالى :
{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ... } [الحجرات: 6]. فيلزم حينئذٍ أن يكون أدون من
آحاد الاُمّة.
4 ـ
وبعصيانه يكون من حزب الشيطان ، فيلزم منه خسرانه ، إذ قال تعالى : {ألا إنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } [المجادلة: 19]. وهو باطل بالضرورة.
ـ
وكما قدّمنا فإنّ حسنات الاَبرار سيئات المقربين ، فعلى هذا يكون حظُّه أقلّ مرتبة
من أقلّ أحد من أفراد الاُمّة. بل قد يلزم منه استحقاقه للعذاب ، قال تعالى : {وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء: 14]. ومن هذه الآية بالذات يظهر لنا
جليّاً أنّ الرسول لا يعصي أصلاً ، فحدوده هي الله ورسوله ، ولا يمكن أن يكون
المُحدَّدُ خارجاً عن الحدّ.
6 ـ
وقد يستحق اللعن ، إذ بتعديه للحدود يكون ظالماً ، والله تعالى يقول : {ألا
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [هود: 18]وهو باطل بالضرورة ، والاجماع.
7 ـ
ويشمله التهوين في قوله تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 44].
قول
وفعل وإقرار المُرسَل والاِمام عليهما السلام هل هو حجّة أم لا ؟ !
إن
قلنا كون كلّ ذلك حجّة ثبتت العصمة ، ( وهذا الدليل من أمتن ما يمكن أن يُذكر من
الاَدلّة على حجيّة السُنّة...
إذ
مع إمكان صدور المعصية منه ، أو الخطأ في التبليغ ، أو السهو ، أو الغفلة ، لا
يمكن الوثوق أو القطع بما يدّعي تأديته عن الله عزّ وجلّ ، لاحتمال العصيان ، أو
السهو ، أو الغفلة ، أو الخطأ منه ولا مدفع لهذا الاحتمال ) (14).
وربما
يتوهّم مُتَوهِّم عند استطلاع ما نقلناه من آراء العلماء حول العصمة واختلافهم في
حدودها من أنّ هذا لا يجدي شيئاً ؛ وذلك لاَنّهم اتفقوا على أنّه معصوم بما يتعلق
بالتبليغ والفتيا ، فيكون الدليل أضيق من المدّعى.
نقول
رفعاً لهذا التوهم : إنّ الحجّة كما نعلم هي ما يُحتجّ به ، أي أنّ للمسلم أن
يتّبع مؤدّاها ويكون له الحقّ يوم القيامة ، والله سبحانه وتعالى يقول : {لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165].
فيكون
عملهم حينئذٍ إذا كان مُطابقاً لما صدر من الوسيط بين الله وخلقه حجة للناس على
الله لو كان ذاك قد أدى وفعل أو قرّر ما ليس صحيحاً شرعاً ، وهذا لا يمكن. فعليه
لابدّ أن يكون فعله وقوله وإقراره صحيحاً دائماً.
حصر
العصمة في حال التبليغ والفتيا :
وإذا
حصروه في حال التبليغ والفتيا ، نقول لهم : إنّ العلماء كافة قد اطلقوا وقالوا : (
إنّ النبي بشرٌ مثلنا ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وهو مكلّف من الله تعالى بما
كلّف به الناس ، إلاّ ما قام الدليل الخاصّ على اختصاصه ببعض الاَحكام : إمّا من
جهة شخصه بذاته ، وإما من جهة منصب الولاية ، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس
في التكليف. هذا مقتضى عموم اشتراكه معنا في التكليف. فإذا أصدر منه فعل ولم يعلم
اختصاصه به ، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس. فيكون فعله حجّة علينا
وحجّة لنا ، لا سيما مع ما دلّ على عموم حسن التأسيّ به ) (15) ، فلا مجال للتقييد
هذا أولاً.
وثانياً
: أنّى لنا تمييز الفعل والقول والاقرار منه ، بحيث نعلم أنّ هذا تبليغ أو فتيا
وأنّ هذا ليس كذلك ؟ ! أي كيف يتمّ لنا تمييز ما هو تبليغ وفتيا عمّا هو فعل شخصي
؟ !
ولو
قال قائل : إنّ عليه التنبيه ، فعلى المعصوم أن يقول : إنّ هذا الفعل فعل تبليغ ،
وإنّ هذا الفعل ليس كذلك. عليه أن يقول : إنّ هذا القول تبليغ ، وإنّ هذا القول
ليس تبليغاً ولا فتيا. عليه أن يبين أنّ هذا الاقرار تبليغ أو فتيا أو ليس كذلك.
وهكذا يملأ المعصوم حياته من قول : إنّ هذا
هذا
، وإنّ هذا ليس هذا ، وهو كما ترى.
ولو
كان ذاك لبان ، مع أننّا لا نجد لذلك عيناً ولا أثراً في حياة الاَنبياء والمرسلين
، وخاصة في حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، مع أنّ كتب الروايات من
صحيحها إلى سقيمها قد نقلت حتى خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم ، نعم قد نُقلت
في ذلك واقعة أو واقعتان ، بأنّ فلاناً سأله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ هذا
الاَمر منك أم من الله ؟ !! ولا تقوم تلك لقلّتها أمام هذه العويصة أبداً.
بل
لم يكن ذلك في أفعالٍ وتصرّفات شخصية أصلاً ، بل كانت في أمور تهمّ المسلمين كافة
، كما في صلح الحديبية ، أو في تقديم الاِمام علي عليه السلام. وهذا يدلُّ على
وقاحة من لفظها أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا على إيمانه ، هذا والقرآن
قد صرّح : {أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59].
ثالثاً
: اننّا نجد أنّ الروايات متضافرة وكثيرة في أنّ لله في كلِّ واقعة حكماً ، منها
ما ورد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام : « ما
من شيءٍ إلاّ وله حدٌّ كحدود داري هذه ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما
كان من الدار فهو من الدار» (16).
وعن
خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي ، قال : حدّثني أبو الوليد البحراني ، عن أبي جعفر عليه
السلام انّه أتاه رجل بمكة فقال له : يا محمد بن علي أنت الذي تزعم انه ليس شيء
إلاّ وله حدّ ؟ !
فقال
له أبو جعفر عليه السلام : « نعم ، أنا أقول إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغيراً أو
كبيراً إلاّ وله حدّ ، إذا جوز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه... » (17).
وعن
سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ـ في حديث طويل أنّه قال
لطلحة : « إنّ كلَّ آية أنزلها الله على نبيه عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وخطّ يدي ، وتأويل كلّ آية أنزلها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،
وكلّ حلال وحرام أو حدّ ، أو حكم ، أو شيء تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة
مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ يدي.
فقال
: كل شيء من صغير أو كبير ، أو خاص أو عام ، كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك
مكتوب ؟ !
قال
: نعم ،و سوى ذلك أسرّني في مرضه ألف باب يفتح كلُّ باب ألف باب » (18).
وكذا
ورد عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حمّاد ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سمعته
يقول : « ما من شيء إلاّ وفيه كتاب وسُنّة » (19).
واستفاد
العلماء من تلك الروايات وأشباهها : « أنّ لكلِّ شيء حداً ، وأنّهُ ليس شيء إلاّ
ورد فيه كتابٌ وسُنّة ، وعلم ذلك كلِّه عند الاِمام عليه السلام »(20).
وعليه
قالوا : ( إنّ كلّ مُتشرِّع يعلم أنّه ما من فعل من أفعال الاِنسان الاختيارية ،
إلاّ وله حكم في الشريعة الاِسلامية ، من وجوب أو حرمة ، أو نحوهما من الاَحكام
الخمسة ) (21).
فلو تمّت
هذه المقدمة ـ وهي تامة ـ يكون حينئذٍ كلُّ تصرّف للمعصوم له حكمه الخاص ، وبما
أنّ له حكمه الخاص ، وهو مبين لذلك الحكم ، فعليه يقتضي ذلك عصمته ، وإلاّ لاختل
التبليغ ، إلاّ إذا قلنا بأنّ عصمته في الواقعة الاُولى واجبة ، وأمّا في الوقائع
اللاحقة فلا ، وهو ما لم يقله أحد لحدِّ الآن ، وحينئذ إذا تجرّأ أحدٌ وقاله فهو
خلاف الاجماع المركب للمسلمين كما هو ظاهر.
بل
لعلَّ ما ورد في سبب جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين ، يوضِّح لنا الاَمر أكثر ،
فيكون المطلب أجلى وأوضح ، فقد ذكر أهل التاريخ أنّ : ( سبب تسميته بذي الشهادتين
هو أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى فرساً من أعرابي ، ثمّ إنّ
الاَعرابي أنكر البيع. فأقبل خزيمة بن ثابت الاَنصاري ففرَّج الناس بيده حتى انتهى
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أشهد يارسول الله لقد اشتريته منه. فقال
الاَعرابي : أتشهد ولم تحضرنا ؟ ! قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أشهدتنا
» ؟ ! قال : لا ، يا رسول الله ، ولكنّي علمتُ أنّك قد اشتريت ، أفأصدِّقُكَ بما
جئت به من عند الله ، ولا أُصدّقك على هذا الاَعرابي الخبيث ؟ !
فعجب
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : « يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين » )(22)
إذ
إنّ تلك القضية بلا ريب ولاشكّ لم تكن تبليغاً ، ولم تكن فتيا ، بل كانت أمراً
شخصياً متعلِّقاً بمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بما هو شخصٌ ، لا بما هو نبيٌّ
أو مرسل.
وكما
يعلم الجميع ادّعى أحد المتنازعين الذي كان من الاَعراب ، بأنّ الفرس فرسه ،
وادّعى الشخص الآخر الذي هو محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم الفرس ذاته ،
ووقع النزاع بينهما.
وعندما
سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة له ، لم يشهد له أحد من المسلمين
لجهلهم ، لا لشيء آخر ، لاَنّهم لم يروه عنده ، ولم يطّلعوا على ملكيته ، ولم
يشهدوا بيعه ، إلاّ أن شخصاً من العرب أقبل ، وفضَّ النزاع بشهادته انّ الفرس
لمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم!!!
فكيف
تمّت شهادته ؟ ! هل شهد ملكيته للفرس ؟ ! هل عَلِمَ بها بما تعلم به الملكية لشخصٍ
على مالٍ مُعيّن ؟ ! كُلُّ هذا لم يكن...
فلماذا
لم يزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله هذا ؟ ! ولماذا لم يقل له لم تشهد
فلم تشهد ؟ ! ولماذا هو لم يقل أصلاً بأنَّ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم الشخص
ربما يكون قد اشتبه عليه الاَمر ؟ ! أو أن يكون قد أخطأ ؟ ! أو نسي ؟ ! أو... إلى
آخر محامل الاشتباه...
هذا
الرجل لم يعتنِ بذلك أصلاً ، وشهد بأن الفرس له ، معلِّلاً شهادته بعد سؤاله صلى
الله عليه وآله وسلم له كيف شهدت بذلك ؟ ! فقال : انّك اخبرتنا عن السماء فصدّقناك
فكيف لا أُصدِّقك على فرس ؟ ! وبهذا الايمان المطلق أصبحت شهادته تعادل شهادتين
فسُمي بخُزيمة ذي الشهادتين. ألا يكون ذلك شاهد صدق على مدّعانا ؟ !!
فالقضية
كانت شخصية مع هذا جعل من شهِدَ بلا رؤية بصرية ، بل برؤية بصيرية بهذه القاعدة
العقلية المرتكزة في ذهن العقلاء التي لم يلتفت إليها أغلب الناس آنذاك في ذلك
المجتمع الذي لم ينضج بعد عقائدياً ؛ ولتوضيحها وترسيخها في أذهان الناس جعلت
شهادة هذا الرجل شهادتين. فما لنا كيف نحكم ؟ !
يبقى
شيء ربّما يقع فيه المتعرِّض لهذه المباحث ، ومؤداه من أنّ العقاب يرفع عمّن تاب ،
فعليه لا عقاب ولا عتاب يبقى. ولكن هذا لا شيء ، بالنظر إلى حديثنا بالخصوص ، فلا
مدخلية لذلك باستحقاق العقاب أو الثواب ، أو عدم أحدهما ، أو كليهما أصلا ؛ وذلك
لاَنّ حديثنا بالمنفّر ووجوده ، لا باستحقاق العقاب الاُخروي ، أو حتى الدنيوي
وعدمه ، إذ قد يأتي الابتلاء من جهة الاختبار ليس إلاّ ، لا من جهة الذنب كما هو
واضح ، فلا فرق.
إلاّ
أنّ الزاوية المنظور منها تختلف ، وذلك لاَنَّ كثيراً من المباحات مع أنّها لا
توجب عقوبة ولا ذماً ، إلاّ انّها منفرة ، فاننا نقول بعدم جواز ارتكابها من قبل
من علت درجته بلا ريب ولاشكّ وهو واضح بالتأمل. وكذلك هناك كثير من الهيئات
والحالات التي لا يمكن لمثل هؤلاء ان يكونوا فيها ، مع أنها خارجة عن مورد العقاب
والذمّ. فحديثنا منصبٌّ حول وجود المنفّر وعدم وجوده.
فنرى
من أنّ أي شيء يكون منفّراً عن هؤلاء الاَشخاص لا يمكن أن يرتكبوه أو يكونوا فيه
سواء كان مباحاً أم غير مباح ، وسواء كان عملاً أم غير عمل ، وسواء كان حالة وهيئة
أم غيرهما.
ولازم
من يقول من أنّ الحديث حول التوبة من ذاك الذنب الصغير وعدمه ، فإذا تاب كان هذا
غير لازم للتنفير عنه ؛ لاَنّها قد أزالت الذم والعقاب ، لازم ذلك القائل جواز
ارتكاب الكبائر قبل البعثة إذا تاب ، بل بعدها مع التوبة ، وهو كما ترى.
كما
أنّ ارتكاب الصغيرة لا يمكن قياسه بترك النوافل وأشباهها ، فهما مختلفان من حيث ان
ارتكاب الصغيرة يكون منفّراً ، بينما ترك النافلة لا يكون كذلك إلاّ في حالات خاصة
نلتزم بعدم تركها فيها.
المهم
أنّ العرف هو الذي يُحدّد ما هو المنفّر من غيره ، ولا ضابطة دقيقة في ذلك أصلاً ،
ولكن يمكن إعطاء ضابطة كلية وهو أنّ كلّ منفّرٍ لايمكن لهؤلاء أن يرتكبوه ، لاَنّ
اللطف الالهي يقتضي تقريب الناس منهم. وكل منفر يوجب ابتعاد الناس عنهم ، وهو عكس
المطلوب.
ولذا
عبّروا : ( فرقٌ واضحٌ في العادة بين الانحطاط عن رتبة ثبتت ، واستحقت وبين فوتها
). ويعنون من أنّ الصغيرة لكونها ذنباً توجب الانحطاط لمرتكبها فهو قبلها كان أعلا
رتبة ، ومن أنّ ترك النافلة توجب عدم الصعود من رتبة هو فيها إلى أعلى منها كان
يستحقها لو أنه فعل تلك النافلة ، وهذا الكلام يبطل قول من يقول بجواز ارتكاب
الصغائر منهم ، سواء كان عن عمد أم عن تأويل (23).
____________________
(1) التوحيد/ الشيخ الصدوق قدس سره :
249.
(2) بحار الاَنوار/المجلسي 3 : 19 عن
الاِمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
(3) بحار الاَنوار/ المجلسي 23 : 19 عن الاِمام علي بن موسى الرضا
عليه السلام.
(4) تعليقة العلاّمة الاُستاذ الشيخ علي الاَنصاري على فصول
العقائد للحكيم الطوسي رضي الله عنه : 35 ـ 36 ط1393 هـ.
(5) معاني الاَخبار/ الشيخ الصدوق : 133 ـ 134 بتصرف طفيف.
(6) اُنظر اصول الكافي 1 : 171 ـ 172/3. وكذلك وسائل الشيعة/ الحر
العاملي 27 : 177/ 2 باب 13.
(7) بحار الانوار/ المجلسي 11 : 92.
(8) وهذا من أساسيات قاعدة اللطف ،
فقد حدَّ القوم اللّطف : بأنّه هبة مقربة إلى الطاعة ، ومبعدة عن المعصية ، ولم
يكن لها حظٌّ في التمكين ، ولم تبلغ به الهبة حدَّ الالجاء. راجع كتاب العقائد من
أنوار الملكوت في شرح الياقوت : 153.
(9) راجع : الكافي في كتاب الايمان
والكفر ، باب الكبائر ، والوسائل 11 : 45 من أبواب جهاد النفس.
(10) كنز العمال 4 : 229/ 10294. ووسائل الشيعة/ الحر العاملي 11 :
247/ 13.
(11) أوائل المقالات/ الشيخ المفيد 4
: 83.
(12) كنز العمال 4 : 207/ 10174 وغيره.
(13) بحار الانوار/ المجلسي 11 : 92.
(14) الاُصول العامّة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم : 128.
(15) اُصول الفقه/ الشيخ محمد رضا المظفر 2 : 67.
(16) بحار الاَنوار/ المجلسي 2 : 170/ 7 باب 22.
(17) بحار الاَنوار 2 : 170/ 10 باب 22.
(18) بحار الاَنوار 26 : 65/ 147 باب
1.
(19) اُصول الكافي 1 : 59/ 4 باب
الردّ إلى الكتاب والسُنّة.
(20) الاصول الاصلية/ العلاّمة السيد عبدالله شبر : 273.
(21) اصول الفقه/ العلاّمة الشيخ
محمد رضا المظفر 1 : 7.
(22) رواها الشيخ الكليني بسند صحيح عن أبي عبدالله عليه السلام.
الكافي 7 : 23/ 1 كتاب الشهادات باب النوادر. كلّه عن معجم رجال الحديث/ السيد
الخوئي 7 : 49 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام. وأوردها الشيخ المجلسي قدس سره في
بحاره عن معاوية بن وهب باختلاف في بعض ألفاظ الواقعة عن كتاب الاختصاص : 64 راجع
بحار الانوار/ المجلسي 22 : 141 مؤسسة الوفاء 1983 م ط2.
(23) وهو رأي أبي علي الجبائي ومن وافقه.



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|