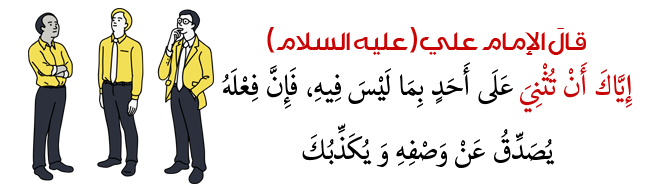
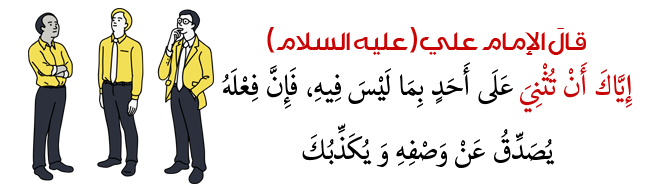

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2020
التاريخ: 14-8-2020
التاريخ: 9-8-2020
التاريخ: 13-8-2020
|
قال تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوالسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } [النحل: 78، 83]
عدد سبحانه نعما له أخر فقال { وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ } منعما عليكم بذلك وأنتم { لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا } من منافعكم ومضاركم في تلك الحال { وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ } أي: تفضل عليكم بالحواس الصحيحة التي هي طرق إلى العلم بالمدركات وتفضل عليكم بالقلوب التي تفقهون بها الأشياء إذ هي محل المعارف { لعلكم تشكرون } أي: لكي تشكروه على ذلك وتحمدوه.
ثم عطف سبحانه على ما تقدم من الدلائل بدلالة أخرى فقال {أ لم تروا} أي: أ لم تتفكروا وتنظروا { إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ } أي: كيف خلقها الله خلقة يمكنها معها التصرف في جوالسماء صاعدة ومنحدرة وذاهبة وجائية مذللات للطيران في الهواء بأجنحتها تطير من غير أن تعتمد على شيء { مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ } أي: ما يمسكهن من السقوط على الأرض من الهواء إلا الله فيمسك الهواء تحت الطير حتى لا ينزل فيه كإمساك الماء تحت السائح في الماء حتى لا ينزل فيه فجعل إمساك الهواء تحتها إمساكا لها على التوسع فإن سكونها في الجوإنما هوفعلها فالمعنى أ لم تنظروا في ذلك فتعلموا أن لها مسخرا ومدبرا لا يعجزه شيء ولا يتعذر عليه شيء وإنه إنما خلق ذلك ليعتبروا به فيصلوا إلى الثواب الذي عرضهم له ولوكان فعل ذلك لمجرد الأنعام على العبيد لكان حسنا لكنه سبحانه وتعالى ضم إلى ذلك التعريض للثواب.
{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ } أي: دلالات على وحدانية الله تعالى وقدرته { لقوم يؤمنون } لأنهم الذين انتفعوا به ثم عدد سبحانه نعما أخر في الآية الأخرى فقال { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا } أي: موضعا تسكنون فيه مما يتخذ من الحجر والمدر وذلك أنه سبحانه خلق الخشب والمدر والآلة التي يمكن بها تسقيف البيوت وبناؤها { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ} يعني الأنطاع والأدم { بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا} أي: قبابا وخياما يخف عليكم حملها في أسفاركم { يوم ظعنكم } أي: ارتحالكم من مكان إلى مكان وقيل معنى الظعن سير أهل البوادي لنجعة أوحضور ماء أوطلب مرتع.
{ ويوم إقامتكم } أي: اليوم الذي تنزلون موضعا تقيمون فيه أي لا يثقل عليكم في الحالتين { ومن أصوافها } وهي للضأن { وأوبارها } وهي للإبل { وأشعارها } وهي للمعز { أثاثا } أي: مالا عن ابن عباس وقيل: نوعا من متاع البيت من الفراش والأكسية وقيل طنافس وبسطا وثيابا وكسوة والكل متقارب { ومتاعا } تتمتعون به ومعاشا تتجرون فيه { إلى حين } أي: إلى يوم القيامة عن الحسن وقيل إلى وقت الموت عن الكلبي ويحتمل أن يكون أراد به موت المالك أوموت الأنعام وقيل إلى وقت البلى والفناء وفيه إشارة إلى أنها فانية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة .
ثم عدد سبحانه نعما أخر أضافها إلى ما عدده قبل من نعمة فقال { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ } من الأشجار والأبنية { ظلالا } أي: أشياء تستظلون بها في الحر والبرد { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا } أي: مواضع تسكنون بها من كهوف وثقوب وتأوون إليها { وجعل لكم سرابيل } أي: قميصا من القطن والكتان والصوف عن ابن عباس وقتادة { تقيكم الحر } ولم يقل وتقيكم البرد لأن ما وقى الحر وقى البرد وإنما خص الحر بذلك مع أن وقايتها للبرد أكثر لأن الذين خوطبوا بذلك أهل حر في بلادهم فحاجتهم إلى ما يقي الحر أكثر عن عطا على أن العرب تكتفي بذكر أحد الشيئين عن الآخر للعلم به كما قال الشاعر :
وما أدري إذا يممت أرضاة أريد الخير أيهما يليني(2)
فكنى عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه ذكره الفراء { وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } يعني دروع الحديد تقيكم شدة الطعن والضرب وتدفع عنكم سلاح أعدائكم { كذلك } أي: مثل ما جعل لكم هذه الأشياء وأنعم بها عليكم { يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ } يريد نعمة الدنيا ويدل عليه قوله { لعلكم تسلمون } قال ابن عباس معناه لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا غيره فتوحدوه وتصدقوا رسوله { فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين } هذا تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ومعناه فإن أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد والقبول عنك وعن التدبر لما عددته في هذه السورة من النعم وبينت فيها من الدلالات فلا عتب عليك ولا لوم فإنما عليك البلاغ الظاهر وقد بلغت كما أمرت والبلاغ الاسم والتبليغ المصدر مثل الكلام والتكليم.
ثم أخبر سبحانه عن الكفار فقال { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا } أي: يعرفون نعم الله تعالى عليهم بما يجدونه من خلق نفوسهم وإكمال عقولهم وخلق أنواع المنافع التي ينتفعون بها لهم ثم أنهم مع ذلك ينكرون تلك النعم أن تكون من جهة الله تعالى خاصة بل يضيفونها إلى الأوثان ويشكرون الأوثان عليها يقولون رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا فيشركونهم معه فيها وقيل أن معناه يعرفون محمدا (صلى الله عليه وآله وسلّم) وهو من نعم الله سبحانه ثم يكذبونه ويجحدونه عن السدي { وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } إنما قال أكثرهم لأن منهم من لم تقم الحجة عليه إذ لم يبلغ حد التكليف لصغره أوكان ناقص العقل مأووفا أولم تبلغه الدعوة فلا يقع عليه اسم الكفر.
وقيل: إنما ذكر الأكثر لأنه علم سبحانه أن فيهم من يؤمن وقيل: أنه من الخاص في الصيغة العام في المعنى عن الجبائي وقريب منه قول الحسن أراد جميعهم الكافرون وإنما عدل عن البعض احتقارا له أن يذكره وفي هذه الآية دلالة على فساد قول المجبرة أنه ليس لله تعالى على الكافر نعمة وإن جميع ما فعله بهم إنما هو خذلان ونقمة لأنه سبحانه نص في هذه الآية على خلاف قولهم.
_______________
1- تفسير مجمع البيان ،الطبرسي،ج6،ص183-188.
ذكر سبحانه في هذه الآية طرفا من الدلائل على وجود الخالق الحكيم لهذا الكون ، وهذه الدلائل هي في نفس الوقت من نعم اللَّه تعالى على عباده ، منها :
مع الماديين :
1 - { واللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً } يخرج الإنسان من بطن أمه جاهلا لا يعلم شيئا بطبيعة الحال ، ولكن اللَّه سبحانه زوّده بأداة المعرفة الحسية ، وهي السمع والبصر ، وأداة المعرفة العقلية أيضا ، وهي العقل والفطرة التي عبّر عنها بالأفئدة .
وقال الماديون : ان المادة الصماء العمياء هي التي أنشأت لنفسها بنفسها أسماعا وأبصارا وأفئدة ، ونجيبهم أولا بأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وثانيا إذا كانت الحياة والإدراك من خصائص المادة ولوازمها وجب أن يكون لكل مادة سمع وبصر وفؤاد لأن عموم السبب يستدعي عموم المسبب .
وإذا قالوا : ان في المادة نوعا من الأجسام وجد على نحو خاص بحيث يلزمه حتما أن يكون الجسم سميعا مبصرا مدركا ، إذا قالوا هذا قلنا لهم : إما أن تقولوا ان المادة بما هي هي تنشئ الحياة والإدراك ، وإما أن لا تقولوا ذلك ، وعلى الأول يجب أن لا يكون شيء في المادة الا وهو وحي مدرك ، وعلى الثاني يجب أن لا توجد الحياة في المادة على الإطلاق . . وكل من الفرضين أوالالزامين باطل بالحس والوجدان ، لأن المشاهد بالعيان ان بعض المادة جامد ، وبعضها حي غير مدرك ، وبعضها حي ومدرك . . وهذا التقسيم والتفاوت دليل قاطع على أن وراء المادة قوة عليمة حكيمة وهي التي منحت الحياة والإدراك لبعض أفراد المادة دون بعض وأوجبت التمييز والتفاوت فيما بينها .
الكون أكبر من الصواريخ :
2 - { أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوالسَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } . المراد بمسخرات مهيئات للطيران ، وبالإمساك عدم السقوط على الأرض ، ومثله قوله تعالى : « أَولَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ ويَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ - 19 الملك » . . ومن الواضح ان اللَّه سبحانه يجري الأمور على أسبابها ، وقد اشتهر على كل لسان ان اللَّه إذا أراد أمرا هيأ أسبابه ، فمعنى قوله تعالى : ما يمسكهن الا اللَّه . . والا الرحمن انه تعالى خلق للطير جناحين ، وزوده بجميع المعدات اللازمة للطيران بين السماء والأرض ، قال تعالى : « وخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً - 2 الفرقان » . . وقال : « إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ - 49 القمر » . وهذا الخلق والتقدير والتدبير دليل واضح وقاطع على وجود الخالق المدبر .
وتسأل : لقد اخترع الإنسان طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت ، بل اخترع صواريخ تقطع بالساعة آلاف الأميال ، وتنطلق إلى القمر والمريخ ، واخترع الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والقمر ، وتتحدث من هناك إلى العلماء بلغتهم عما تسمع وترى ، فأين الطيور من هذه المخترعات ؟ .
وغريب ان يسأل عاقل مثل هذا السؤال ، ويدهش لهذه المخترعات ، ويذهل عن العقل الذي اخترعها وأوجدها . . وبالأصح يذهل عن خالق هذا العقل الذي أوجد هذه المخترعات . . ولو أنصف الإنسان لنظر إلى نفسه وعقله ، فإنه أعظم من اختراع الصواريخ والأقمار الصناعية ، لأنه هو مخترعها ومبدعها . . بل لو أنصف لنظر إلى خلق الكون فهو أعظم من خلق الإنسان الذي اخترع الصاروخ والقمر الصناعي ، قال تعالى في الآية 57 من غافر : « لَخَلْقُ السَّماواتِ والأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » . وخلق الإنسان أكبر من خلق الصاروخ والأقمار الصناعية بملايين المرات .
هذا ، إلى أن الحديث منذ بدايته انما هو عن الطير ، والطير من الأحياء ، والطائرة والصاروخ والقمر الصناعي من الجماد ، فالنقض بشيء منها في غير محله . .
ومن الواضح المؤكد ان علماء الصواريخ ومعهم علماء الإنس والجن لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة ، ولا خلية من جناح ذبابة : « لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً ولَو اجْتَمَعُوا لَهُ وإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ والْمَطْلُوبُ - 73 الحج » .
وتجدر الإشارة إلى أن اللَّه سبحانه أسند إليه إمساك الطير في الجو لأنه تعالى هو السبب الأول الذي خلق الطير وزوده بمعدات الطيران . . وأنكر الأشاعرة وجود الأسباب الطبيعية بشتى أنواعها وأشكالها ، وقالوا : كل الأفعال تسند إلى اللَّه مباشرة وبلا واسطة ، سواء أظهرت هذه الأفعال من طير أم حشرة أم حيوان أم إنسان أم من الطبيعة . . فلا علاقة على الإطلاق بين الإحراق والنار ، ولا بين الري والشرب ، ولا بين الشبع والأكل . . ولكن اللَّه يوجد الإحراق عند مماسة النار للجسم ، ويوجد الري عند شرب الماء ، والشبع عند أكل الطعام . . ويكفي لرد هذا القول انه يخالف الحس والوجدان ، وان اللازم له أن يكون الإنسان تماما كالحيوان والجماد ، لا يوصف بطيب أو خبيث ، وبمجرم أوبريء ، وانه لا يستحق مدحا ولا ذما ، ولا ثوابا ولا عقابا ، لأن المفروض ان اللَّه هو الفاعل والإنسان ظرف للفعل ، تماما كالإناء الذي يوضع فيه ماء .
3 - { واللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً } . والمراد بالسكن هنا الفعل والاستقرار في البيوت ، والمقصود من هذه البيوت ما يؤخذ من الحجر والخشب والحديد والاسمنت { وجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ويَوْمَ إِقامَتِكُمْ } .
تستخفونها أي حملها خفيف عليكم ، والظعن السفر ، والإقامة الحضر . . بعد أن ذكر البيوت الثابتة ذكر البيوت المتنقلة مع الإنسان من مكان إلى مكان كالخيم ، وذكر سبحانه الجلود ، ولم يذكر الكتان والقنب ونحوه ، لأن الجلود كانت هي الغالبة في بلاد العرب . . ومهما يكن فإن قوائم البيت من أي نوع كانت فإنها تدل على وجود خالقها وصانعها . . وأعجبتني هنا عبارة لفقيه يتفاصح ، أنقلها بالحرف الواحد ، قال : « كل ما علاك فأظلك فهو سقف ، وكل ما أقلك فهو أرض ، وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار ، فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت » .
احترام البيت في الشريعة :
والبيوت بشتى أنواعها من نعم اللَّه تعالى على عباده ، ولا يعرف قدرها إلا الذين لا بيوت لهم ، وللبيت حرمته في الشريعة الاسلامية ، من ذلك أن لا يدخل الإنسان بيتا حتى يستأذن أهله ، قال تعالى : « فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا - 28 النور .
وقال الفقهاء : من تطلع في بيت إنسان من ثقب أو شق باب ، ونحوه فلصاحب البيت أن يزجره أولا ، فإن أصر فله أن يضربه ، أويرميه بحصاة وما أشبه ، فإذا تضرر المتلصص المتجسس فلا شيء على صاحب البيت ، فقد جاء في الحديث النبوي : « من اطلع عليك ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه فلا جناح عليك » . وقال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : عورة المؤمن على المؤمن حرام . .
ومن اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال .
4 - { ومِنْ أَصْوافِها وأَوْبارِها وأَشْعارِها أَثاثاً ومَتاعاً إِلى حِينٍ } أي وجعل لكم من أصوافها الخ ، والصوف من الغنم ، والوبر من الإبل ، والشعر من المعز ، والأثاث معناه في الأصل الكثرة ، يقال : أثّ النبت يئث إذا كثر ، والمراد بالأثاث هنا ما يحتاج إليه المرء من فرش أولباس ونحوه ، والمتاع كل ما ينتفع الإنسان به في مصالحه وقضاء حوائجه ، وقوله : إلى حين إشارة إلى أن متع الحياة كلها مؤقتة لا دوام لها ولا قرار .
فكيف بنعمة الذهب الأسود ؟
5 - { واللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا } . الظلال جمع ظل ، وهو الفيء الذي يقي من حر الشمس .
6 - { وجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً } . الأكنان جمع كن من كهف وثقب ، ونحوه مما يقي من حر الشمس ، وكل ما يحتاج إليه المرء فهو نعمة إذا وجده حتى فيء الغمامة ، والثقب في الجبل .
7 - { وجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ } . وهنا حذف تقديره والبرد ، وانما حذف للعلم به { وسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } . هذا كناية عن الدرع والمغفرة وغير ذلك { كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ } . والمراد بالإسلام هنا الاستسلام والانقياد للحق والعمل به ، والمعنى انه تعالى أنعم عليهم بالبيوت والأثاث والمتاع والسرابيل والظل وبالكن ليشكروه ويتقوه ، ولا يعثوا في الأرض مفسدين .
وإذا امتن سبحانه على عرب الجاهلية بفيء الغمامة والشجرة ، وبالثقب في الجبل ونحوه ، واعتبر ، جلت عظمته ، هذا الظل ، وهذا الثقب من إتمام النعمة عليهم
وطالبهم لقاء ذلك بالشكر والانقياد للحق ، وهددهم ان عصوا وتمردوا ، إذا كان الظل نعمة والثقب فضلا فكيف بالذهب الأسود الذي يتدفق أبحرا في البلاد العربية ؟ . وكيف بالفئة التي تتحكم به ، فتبني بثمنه ناطحات السحاب ، وتقتني الجواري والعبيد ، وتمتلك لرفاهيتها أسطولا من الطائرات والسيارات ، وتملأ الأرض إسرافا وفسادا ؟ .
لقد امتن اللَّه على الماضين بالأنعام والخيل والبغال والحمير ، وبالبيوت من الحجر والجلد ، وبالاثاث من الصوف والوبر والشعر ، وبالسرابيل تقي من الحر والبرد ، بل امتن عليهم بالظل والثقب ، وطالبهم أن يشكروا ويتذكروا ، فكيف بالمترفين المنحرفين في هذا العصر الذين يسكنون الفيلات ، ويؤثثونها بمئات الألوف ، ويكيفون أجواءها كما يشتهون من دفء أورطوبة ، وحولهم خيام اللاجئين وأكواخ المشردين ؟ . ومع هذا يدعون الايمان باللَّه واليوم الآخر .
{ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ } يا محمد ، وعلينا الحساب ، وقد أديت أنت الرسالة على أكمل الوجوه ، وسنوفيهم نحن حسابهم وجزاءهم . وتقدمت هذه الآية في سورة آل عمران الآية 20 ج 2 ص 30 ، وفي الآية 40 من سورة الرعد { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها } . المراد بمعرفتهم إياها انهم يتنعمون بها ، وبإنكارهم انهم يسندونها إلى غير اللَّه ، أي انهم يأكلون رزق اللَّه ، ويعبدون سواه { وأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ } يجوز استعمال كلمة الأكثر في معناها الظاهر ، ويجوز أيضا استعمالها بالجميع .
والمراد بها هنا كل من بلغه رسالة محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) وأنكرها عنادا للحق وتمردا عليه .
_____________
1- التفسير الكاشف، ، محمد جواد مغنية،ج4، ص536-540.
الآيات تذكر عدة أخرى من النعم الإلهية ثم تعطف الكلام إلى ما تكشف عنه من حق القول في وحدانيته تعالى في الربوبية وفي البعث وفي النبوة والتشريع نظيره القبيل السابق الذي أوردناه من الآيات.
قوله تعالى:{ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا } إلى آخر الآية.
الأمهات جمع أم والهاء زائدة نظير أهراق وأصله أراق وقد تأتي أمات، وقيل: الأمهات في الإنسان والأمات في غيره من الحيوان، والأفئدة جمع قلة للفؤاد وهو القلب واللب، ولم يبن له جمع كثرة.
وقوله:{ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ } إشارة إلى التولد و{لا تعلمون شيئا} حال من ضمير الخطاب أي أخرجكم من أرحامهن بالتولد والحال أن نفوسكم خالية من هذه المعلومات التي أحرزتموها من طريق الحس والخيال والعقل بعد ذلك.
والآية تؤيد ما ذهب إليه علماء النفس أن لوح النفس خالية عن المعلومات أول تكونها ثم تنتقش فيها شيئا فشيئا - كما قيل - وهذا في غير علم النفس بذاتها فلا يطلق عليه عرفا{يعلم شيئا} والدليل عليه قوله تعالى في خلال الآيات السابقة فيمن يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا} فإن من الضروري أنه في تلك الحال عالم بنفسه.
واحتج بعضهم بعموم الآية على أن العلم الحضوري يعني به علم الإنسان بنفسه كسائر العلوم الحصولية مفقود في بادىء الحال حادث بعد ذلك ثم ناقش في أدلة كون علم النفس بذاتها حضوريا مناقشات عجيبة.
وفيه أن العموم منصرف إلى العلم الحصولي ويشهد بذلك الآية المتقدمة.
وقوله:{وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} إشارة إلى مبادىء العلم الذي أنعم بها على الإنسان فمبدأ التصور هو الحس، والعمدة فيه السمع والبصر وإن كان هناك غيرهما من اللمس والذوق والشم، ومبدأ الفكر هو الفؤاد.
قوله تعالى:{ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ} إلخ، قال في المجمع: الجو الهواء البعيد من الأرض. انتهى. يقول: أ لم ينظروا إلى الطير حال كونها مسخرات لله سبحانه في جوالسماء والهواء البعيد من الأرض، ثم استأنف فقال مشيرا إلى ما هو نتيجة هذا النظر:{ما يمسكهن إلا الله}.
وإثبات الإمساك لله سبحانه ونفيه عن غيره مع وجود أسباب طبيعية هناك مؤثرة في ذلك وكلامه تعالى يصدق ناموس العلية والمعلولية إنما هو من جهة أن توقف الطير في الجومن دون أن تسقط كيفما كان وإلى أي سبب استند هو وسببه والرابطة التي بينهما جميعا مستندة إلى صنعه تعالى فهو الذي يفيض الوجود عليه وعلى سببه وعلى الرابطة التي بينهما فهو السبب المفيض لوجوده حقيقة وإن كان سببه الطبيعي القريب معه يتوقف هو عليه.
ومعنى توقفه في وجوده على سببه ليس أن سببه يفيد وجوده بعد ما استفاد وجود نفسه منه تعالى بل أن هذا المسبب يتوقف في أخذه الوجود منه تعالى إلى أخذ سببه الوجود منه تعالى قبل ذلك، وقد تقدم بعض الكلام في توضيح ذلك من قريب.
وهذا معنى توحيد القرآن، والدليل عليه من جهة لفظه أمثال قوله:{ألا له الخلق والأمر}: الأعراف: 54، وقوله:{أن القوة لله جميعا}: البقرة: 165، وقوله:{الله خالق كل شيء}: الزمر: 62، وقوله:{ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }: النحل: 77. والدليل على ما قدمناه في معنى النفي والإثبات في الآية قوله تعالى:{مسخرات} فإن التسخير إنما يتحقق بقهر أحد السببين الآخر في فعله على ما يريده السبب القاهر ففي لفظه دلالة على أن للمقهور نوعا من السببية.
وليس طيران الطائر في جو السماء بالحقيقة بأعجب من سكون الإنسان في الأرض فالجميع ينتهي إلى صنعه تعالى على حد سواء لكن ألفة الإنسان لبعض الأمور وكثرة عهده به توجب خمود قريحة البحث عنه فإذا صادف ما يخالف ما ألفه وكثر عهده به كالمستثنى من الكلية انتبه لذلك وانتزعت القريحة للبحث عنه والإنسان يرى الأجسام الأرضية الثقيلة معتمدة على الأرض مجذوبة إليها فإذا وجد الطير مثلا تنقض كلية هذا الحكم بطيرانها تعجب منه وانبسط للبحث عنه والحصول على علته، وللحق نصيب من هذا البحث وهذا هو أحد الأسباب في أخذ هذا النوع من الأمور في القرآن مواد للاحتجاج.
وقوله:{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } أي في كونها مسخرات في جو السماء فإن للطير وهو في الجودفيفا وصفيفا وبسطا لأجنحتها وقبضا وسكونا وانتقالا وصعودا ونزولا وهي جميعا آيات لقوم يؤمنون كما ذكره الله.
قوله تعالى:{ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} إلى آخر الآية، في المفردات: البيت مأوى الإنسان بالليل لأنه يقال: بات أقام بالليل كما يقال: ظل بالنهار.
ثم قد يقال: للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه، وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر، قال: ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر.انتهى موضع الحاجة.
والسكن ما يسكن إليه، والظعن الارتحال وهو خلاف الإقامة، والصوف للضأن والوبر للإبل كالشعر للإنسان ويسمى ما للمعز شعرا كالإنسان، والأثاث متاع البيت الكثير ولا يقال للواحد منه أثاث، قال في المجمع: ولا واحد للأثاث كما أنه لا واحد للمتاع. انتهى.
والمتاع أعم من الأثاث فإنه مطلق ما يتمتع به ولا يختص بما في البيت.
وقوله:{ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا } أي جعل لكم بعض بيوتكم سكنا تسكنون إليه، ومن البيوت ما لا يسكن إليه كالمتخذ لادخار الأموال واختزان الأمتعة وغير ذلك وقوله:{وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا} إلخ، أي من جلودها بعد الدبغ وهي الأنطاع والأدم{بيوتا} وهي القباب والخيام{تستخفونها} أي تعدونها خفيفة من جهة الحمل{يوم ظعنكم} وارتحالكم{ويوم إقامتكم} من غير سفر وظعن.
وقوله:{ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا } إلخ، معطوف على موضع{من جلود} أي وجعل لكم{من أصوافها} وهي للضأن و{أوبارها} وهي للإبل{وأشعارها} وهي للمعز{أثاثا} تستعملونه في بيوتكم{ومتاعا} تتمتعون به{إلى حين} محدود، قيل: وفيه إشارة إلى أنها فانية داثرة فلا ينبغي للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة.
قوله تعالى{ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا } إلى آخر الآية، الظرفان أعني قوله:{لكم} و{مما خلق} متعلقان بجعل وتعليق الظلال بما خلق لكونها أمرا عدميا محققا بتبع غيره وهي مع ذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان وسائر الحيوان والنبات فما الانتفاع بالظل للإنسان وغيره بأقل من الانتفاع بالنور ولولا الظل وهو ظل الليل وظل الأبنية والأشجار والكهوف وغيرها لما عاش على وجه الأرض عائش.
وقوله:{ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا } الكن ما يستتر به الشيء حتى أن القميص كن للابسه، وأكنان الجبال هي الكهوف والثقب الموجودة فيها.
وقوله:{ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أي قميصا يحفظكم من الحر، قال في المجمع:، ولم يقل: وتقيكم البرد لأن ما وقى الحر وقى البرد، وإنما خص الحر بذلك مع أن وقايتها للبرد أكثر لأن الذين خوطبوا بذلك أهل حر في بلادهم فحاجتهم إلى ما يقي الحر أكثر، عن عطاء.
قال: على أن العرب يكتفي بذكر أحد الشيئين عن الآخر للعلم به قال الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضا. أريد الخير أيهما يليني.
فكنى عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه، ذكره الفراء انتهى.
ولعل بعض الوجه في ذكره الحر والاكتفاء به أن البشر الأولى كانوا يسكنون المناطق الحارة من الأرض فكان شدة الحر أمس بهم من شدة البرد وتنبههم لاتخاذ السراويل إنما هو للاتقاء مما كان الابتلاء به أقرب إليهم وهو الحر والله أعلم.
وقوله:{ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } الظاهر أن المراد به درع الحديد ونحوه.
وقوله:{ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ } امتنان عليهم بإتمام النعم التي ذكرها، وكانت الغاية المرجوة من ذلك إسلامهم لله عن معرفتها فإن المترقب المتوقع ممن يعرف النعم وإتمامها عليه أن يسلم لإرادة منعمه ولا يقابله بالاستكبار لأن منعما هذا شأنه لا يريد به سوء.
قوله تعالى:{ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } قال في المجمع:، البلاغ الاسم والتبليغ المصدر مثل الكلام والتكليم، انتهى.
لما فرغ عن ذكر ما أريد ذكره من النعم والاحتجاج بها ختمها بما مدلولها العتاب واللوم والوعيد على الكفر ويتضمن ذكر وحدانيته تعالى في الربوبية والمعاد والنبوة وبدأ ذلك ببيان وظيفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في رسالته وهوالبلاغ فقال:{فإن تولوا} أي يتفرع على هذا البيان الذي ليس فيه إلا دعوتهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم من غير أن يتبعه إجبار أوإكراه أنهم إن تولوا وأعرضوا عن الإصغاء إليه والاهتداء به{ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } والتبليغ الواضح الذي لا إبهام فيه ولا ستر عليه لأنك رسول وما على الرسول إلا ذلك.
وفي الآية تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبيان وظيفة له.
قوله تعالى:{ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } المعرفة والإنكار متقابلان كالعلم والجهل وهذا هوالدليل على أن المراد بالإنكار وهوعدم المعرفة لازم معناه وهوالإنكار في مقام العمل وهو عدم الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر أوالجحود لسانا مع معرفتها قلبا، لكن قوله:{ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } يخص الجحود بأكثرهم كما سيجيء فيبقى للإنكار المعنى الأول.
وقوله:{ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } دخول اللام على{الكافرون} يدل على الكمال أي إنهم كافرون بالنعم الإلهية أوبما تدل عليه من التوحيد وغيره جميعا لكن أكثرهم كاملون في كفرهم وذلك بالجحود عنادا والإصرار عليه والصد عن سبيل الله.
والمعنى: يعرفون نعمة الله بعنوان أنها نعمة منه ومقتضاه أن يؤمنوا به وبرسوله واليوم الآخر ويسلموا في العمل ثم إذا وردوا مورد العمل عملوا بما هو من آثار الإنكار دون المعرفة، وأكثرهم لا يكتفون بمجرد الإنكار العملي بل يزيدون عليه بكمال الكفر والعناد مع الحق والجحود والإصرار عليه.
وفيما قدمناه كفاية لك عما أطال فيه المفسرون في معنى قوله:{ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } مع أنهم جميعا كافرون بإنكارهم من قول بعضهم، إنما قال:{أكثرهم} لأن منهم من لم تقم عليه الحجة كمن لم يبلغ حد التكليف أوكان مئوفا في عقله أولم تصل إليه الدعوة فلا يقع عليه اسم الكفر.
وفيه أن هؤلاء خارجون عن إطلاق الآية رأسا فإنها تذكر توبيخا وإيعادا أنهم ينكرون نعمة الله بعد ما عرفوها، وهؤلاء إن كانوا ينكرونها كانوا بذلك كافرين وإن لم ينكروها لم يدخلوا في إطلاق الآية قطعا، وكيف يصح أن يقال: إنهم لم تقم عليهم الحجة وليست الحجة إلا النعمة التي يعدها الله سبحانه وهم يعرفونها؟.
وقول بعضهم: إنما قال:{ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } لأنه كان يعلم أن فيهم من سيؤمن، وفيه أنه قول لا دليل عليه.
وقول بعضهم: إن المراد بالأكثر الجميع وإنما عدل عن البعض احتقارا له أن يذكره، ونسب إلى الحسن البصري، وهو قول عجيب.
قيل: وفي الآية دليل على فساد قول المجبرة إنه ليس لله على الكافر نعمة وإن جميع ما فعله بهم إنما هو خذلان ونقمة لأنه سبحانه نص في هذه الآية على خلاف قولهم، انتهى.
والحق أن للنعمة اعتبارين: أحدهما كونها نعمة أي ناعمة ملائمة لحال المنعم عليه من حيث كونه في صراط التكوين أي من حيث سعادته الجسمية، والآخر من حيث وقوع المنعم عليه في صراط التشريع أي من حيث سعادته الروحية الإنسانية بأن تكون النعمة بحيث توجب معرفتها إيمانه بالله ورسوله واليوم الآخر واستعمالها في طريق مرضاة الله، والمؤمن منعم بالنعمتين كلتيهما والكافر منعم في الدنيا بالطائفة الأولى محروم من الثانية، وفي كلامه سبحانه شواهد كثيرة تشهد على ذلك.
______________
1- تفسير الميزان ،الطباطبائي،ج12،ص255-259.
أنواع النعم المادية والمعنوية:
يعود القرآن الكريم مرّة أُخرى بعرض جملة أُخرى من النعم الإِلهية كدرس في التوحيد ومعرفة اللّه، وأوّل ما يشير في هذه الآيات المباركات إِلى نعمة العلم والمعرفة ووسائل تحصيله.. ويقول: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا }.
فمن الطبيعي أنّكم في ذلك المحيط المحدود المظلم تجهلون كل شيء، ولكنْ عندما تنتقلون إِلى هذا العالم فليس من الحكمة أن تستمروا على حالة الجهل، ولهذا فقد زودكم الباري سبحانه بوسائل إِدراك الحقائق ومعرفة الموجودات {وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ}. لكي يتحرك حس الشكر للمنعم في أعماقكم من خلال إِدراككم لهذه النعم الربانية الجليلة {لعلكم تشكرون}.
وتستمر الآية التالية في بيان أسرار عظمة اللّه عزَّوجلّ في علم الوجود، وتقول: {أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ}.
«الجو» لغةً: هو الهواء (كما ذكره الراغب في مفرداته)، أو ذلك الجزء من الهواء البعيد عن الأرض (كما ورد في تفسير مجمع البيان وتفسير الميزان وكذلك تفسير الآلوسي).
وبما أنّ الأجسام تنجذب إِلى الارض طبيعياً فقد وصف القرآن الكريم حركة الطيور في الهواء بالتسخير، أيْ: أنّ الباري سبحانه قد جعل في أجنحة الطيور قوّة، وفي الهواء خاصية، تمكنان الطيور من الطيران في الجو على رغم قانون الجاذبية.
ويضيف قائلا: {مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ}.
صحيح أنّ ثمّة أُمور مجتمعة تعطي للطيور إِمكانية التحليق والطيران، مثل: الخاصية الطبيعية للأجنحة، قدرة عضلات الطيور، هيكل الطير بالإِضافة إِلى خواص الهواء الملائمة.. ولكنْ، مَنْ الذي خلق هذه الهيئة وتلك الخواص؟
ومَنْ الذي أقرّ هذا النظام الدقيق؟
فهل هي الطبيعة العمياء، أم مَنْ يعلم بجميع الخواص الفيزيائية للأجسام وأحاط علمه المطلق بكل هذه الأُمور؟؟
فإِذا ما رأينا نسبة هذه الأُمور إِلى اللّه، لأنّ منبع وجودها منه تعالى، وأمثال هذا التعبير في نسبة الأسباب والعلل إِلى اللّه كثيرة في القرآن الكريم.
وفي نهاية الآية، يأتي قوله عزَّ مَنْ قائل: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}أي إنّهم ينظرون إِلى هذه الأُمور بعين باصرة وأذن سميعة ويتفكرون فيما يرون ويسمعون، وبذلك يقوى إِيمانهم ويرسخ أكثر فأكثر.
وتستمر الآيات في الإِشارة إِلى النعم الإِلهية حتى نصل إِلى الآية الثّالثة (مورد البحث) لتقول: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا}.
وحقّاً إنّ هذه النعمة المباركة من أهم النعم، فلولاها لم يمكن التمتع بغيرها.
«البيوت»: جمع بيت، مأخوذ من (البيتوتة): وهي في الأصل بمعنى التوقف ليلا، وأُطلقت كلمة (بيت) على الحجرة أو الدار لحصول الإِستفادة منهما للسكن ليلا.
ويلزمنا هنا التنويه بالملاحظة التالية: إِنّ القرآن الكريم لم يقل: إِنّ اللّه جعل بيوتكم سكناً لكم، وإِنّما ذكر كلمة (مِنْ) التبعيضية أوّلاً وقال: (من بيوتكم) وذلك لدقة كلام اللّه التامة في التعبير، حيث أنّ الدار أو الحجرة الواحدة تلحقها مرافق أُخرى كالمخزن والحمام وغيرها.
وبعد أنْ تطرق القرآن الكريم إِلى ذكر البيوت الثابتة عرّج على ذكر البيوت المتنقلة فقال: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا}(2).
وهي من الخفة بحيث {تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ـ أي رحيلكم ـ ويوم إِقامتكم}.
بل وجعل لكم: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}.
ويشير القرآن الكريم إِلى نعمة أُخرى بقوله: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا}.
«الأكنان»: جمع (كن) بمعنى وسائل التغطية والحفظ، ولهذا فقد أُطلقت على المغارات وأماكن الإِختفاء وفي الجبال.
ونرى إِطلاق كلمة «الظلال» في الآية لتشمل كل الظلال، سواء كانت ظلال الأشجار أو المغارات الجبلية أو ظل أي شيء آخر، باعتبارها إِحدى النعم الإِلهية {وحقيقة الأمر كذلك)، فكما يحتاج الإِنسان إِلى النّور في حياته فكثيراً ما يحتاج إِلى الظل كذلك، لأنّ النّور إذا ما استمر في اشراقه فسوف تكون الحياة مستحيلة، ويكفينا أن نلمس ما لظل الكرة الأرضية (والمسمى بالليل) على حياتنا، وكذلك دور الظلال الأُخرى خلال النهار في مختلف الأمكنة والحالات.
وكأن ذكر نعمة «الظلال» و «أكنان الجبال» بعد ذكر نعمة «المسكن» و«الخيام» في الآية السابقة، للإِشارة إِلى: أنّ طوائف الناس لا تخرج عن إِحدى ثلاثة.. واحدة تعيش في المدن والقرى وتستفيد من بناء البيوت لسكناها، وأُخرى تعيش الترحال والتنقل فتحمل معها الخيام، وثالثة أُولئك الذين يسافرون وليس معهم مستلزمات المأوى.. ولم يترك الباري جل شأنه المجموعة الثّالثة تعيش حالة الحيرة من أمرها، بل في طريقهم الظلال والمغارات لتقيهم.
وقد لا يدرك سكنة المدن ما لوجود المغارات الجبلية من أهمية، ولكنّ عابرى الصحاري والمسافرين العزل والرعاة وكل مَنْ حرم من نعمة البيوت الثابتة أو السيارة (مؤقتاً أو دائماً) عندما يكونون تحت سطوة حرارة الصيف اللاهبة أو تحت وطأة زمهرير الشتاء القارص، سيعرفون عندها أهمية تلك المغارات، وخصوصاً كونها باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، وهي ملاذ ينجي من موت قريب ـ في بعض الأحيان ـ للإِنسان أو الحيوانات.
وبعد ذكر القرآن الكريم لنعمة الظلال الطبيعية والصناعية، ينتقل لذكر ملابس الإنسان فيقول: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ }، وثمّة ألبسة أُخرى تستعمل لحفظ أبدانكم في الحروب {وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ }.
«السرابيل»: جمع «سربال» (على وزن مثقال)، بمعنى الثوب من أيِّ جنس كان (على ما يقول الراغب في مفرداته)، ويؤيده في ذلك أكثر المفسّرين، ولكنّ البعض منهم قد اعتبر معنى السربال هو: لباس وغطاء لبدن الإِنسان، إِلاّ أنّ المشهور هو المعنى الأوّل.
وكما هو معلوم، فإِنّ فائدة الألبسة لا تنحصر في حفظ الإنسان من الحر والبرد، بل تُلْبِس الإنسان ثوب الكرامة وتقي بدنه من الأخطار الموجهة إِليه، فلو تعرى الإِنسان لكان أكثر عرضه للجراحات وما شابهها، واستناد الآية المباركة على الخاصية الأُولى دون غيرها لأهميتها المميزة.
ولعل ذكر خصوص الحر في الآية جاء تماشياً مع ما شاع في لغة العرب من ذكر أحد المتضادين اختصاراً، فيكون الثّاني واضحاً بقرينة وجود الأوّل، أو لأنّ المنطقة التي نزل فيها القرآن الكريم كان دفع الحرِّ فيها ذا أهمية بالغة عند أهلها.
وثمّة احتمال آخر: أنْ يكون ذلك بلحاظ خطورة الإِصابة بمرض ضربة الشمس المعروفة، وبتعبير آخر: إِنّ تحمل الإِنسان لحر أشعة الشمس الشديدة أقل من تحمله ومقاومته للبرد، لأنّ حرارة البدن الداخلية يمكن لها أن تعين الإِنسان على تحمل البرودة لحد ما.
وفي ذيل الآية.. يقول القرآن مذكِّراً: {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} أي تطيعون أمره.
وطبيعي جدّاً أن يفكر الإِنسان بخالق النعم، خصوصاً عند تنبّهه للنعم المختلفة التي تحيط بوجوده، وأنّ ضميره سيستيقظ ويتجه نحو المنعم قاصداً زيادة معرفته به إِذا ما امتلك أدنى درجات حسن الشكر.
ومع أنّ بعض المفسّرين قد حصروا لكلمة «النعمة» في الآية ببعض النعم: كنعمة الخلق، وتكامل العقل، أو التوحيد، أو نعمة وجود النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إِلاّ أنّ معنى الكلمة أوسع من ذلك، ليشمل كل النعم (المذكور منها أو غير المذكور)، وما التخصيص في حقيقته إِلاّ من قبيل التّفسير بالمصداق الواضح.
وبعد ذكر هذه النعم الجليلة.. يقول عزَّوجلّ أنّهم لو اعرضوا ولم يسلموا للحق فلا تحزن ولا تقلق، لأنّ وظيفتك ابلاغهم: { فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ }.
ومع كل ما يمتلكه المتكلم من منطق سليم ومدعمُّ بالإِستدلال الحق والجاذبية، إِلاّ أنّه لا يؤثر في المخاطب مالم يكن مستعداً لاستماع وقبول كلام المتكلم، وبعبارة أُخرى: إِنّ (قابلية المحل) شرط في حصول التأثر.
وعلى هذا، فإِنْ لم يسلم لك أصحاب القلوب العمياء ومَنْ امتاز بالتعصب والعناد، فذلك ليس بالأمر الجديد، وما عليك إِلاّ أن تصدع ببلاغ مبين وأنْ لا تقصر في ذلك والمراد من هذا المقطع القرآني هو مواساة النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وتسليته.
وتكميلا للحديث.. يضيف القرآن الكريم القول: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا}.
فعلّة كفرهم ليست في عدم معرفتهم بالنعم الإِلهية وإِنّما بحملهم تلك الصفات القبيحة التي تمنعهم من الإِيمان كالتعصب الأعمى والعناد في معاداة الحق، وتقديم منافعهم المادية على كل شيء، وتلوّثهم بمختلف الشهوات، بالإِضافة إِلى مرض التكبّر الغرور.
ولعل ما جاء في آخر الآية {وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} إِشارة لهذه الأسباب المذكورة.
وقد جذبت كلمة «أكثرهم» انتباه واهتمام المفسّرين وراحوا يبحثون في سبب ذكرها... حتى توصل المفسّرون إِلى أسباب كثيرة كلُّ حسب زاوية اهتمامه في البحث، ولكنّ ما ذكرناه يبدو أقرب من كلِّ ما ذكروه، وخلاصته: إِنّ أكثرية الكفار هم من أهل التعصب والعناد، والذين كفروا نتيجة جهلهم أو غفلتهم فهم القلّة قياساً إِلى أُولئك.
ويشاهد في القرآن الكريم مقاطع قرآنية تطلق الكفر على ذلك النوع الناشىء من التكّبر والعناد، ومنها ما يتحدث عن الشيطان كما جاء في الآية (34) من سورة البقرة { أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ }.
واحتمل البعض: أنّ المقصودين بـ «أكثرهم» مَنْ تمّت عليهم الحجّة في قبال أقلية لم تتم عليهم الحجّة بعد، وهذا المعنى يمكن أن يعود إِلى المعنى الأوّل.
ملاحظتان:
1ـ كلمات المفسّرين
ما نطالعه في كلمات المفسّرين المتعددة بخصوص تفسير {نعمة اللّه}في الآية لا يعدو غالباً من قبيل التّفسير بالمصداق، في حين أنّ مفهوم «نعمة اللّه» من السعة بحيث يشمل جميع النعم المادية والمعنوية، حتى أنّ النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يعتبر أحد المصاديق الحيّة لنعمه سبحانه وتعالى.
وروايات أهل البيت(عليهم السلام) تؤكّد على أنّ المقصود بـ «نعمة اللّه» هو وجود الأئمّة المعصومين(عليهم السلام).
وفي رواية عن الإِمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «نحن واللّه نعمة اللّه التي أنعم بها على عباده، وبنا فاز مَنْ فاز»(3).
فواضحُّ أَنَّ السعادة والنجاح لا يمكن إِدراكهما إِلاّ عن طريق قادة الحق وهم الأئمّة عليهم السلام فوجودهم إِذِنْ من أوضح وأفضل النعم الإِلهية (وقد ذكر هنا لأنّه أحد المصاديق الجلية لنعم اللّه سبحانه).
2 ـ صراع الحقّ مع الباطل
لقد توقف بعض المفسّرين عند كلمة «ثمّ» من قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا}، لأنّ استعمالها عادةً كأداة عطف مع وجود فاصلة بين أمرين، ولذلك فثمّة فاصلة بين معرفتهم لنعم اللّه وبين إِنكارهم للنعم، فقالوا: إِنّ الهدف من هذا التعبير تبيان ما ينبغي عليهم من الإِعتراف بالتوحيد بعد معرفتهم بنعمة اللّه، وكان عليهم أن يذعنوا لذلك الإِعتراف، إِلاّ أنّهم ساروا في طريق الباطل! فاستبعد القرآن عملهم وعبر عن ذلك بكلمة «ثمّ».
ونحتمل أنّ «ثمّ» هنا إِشارة إِلى معنى خفي، خلاصته: أنّ دعوة الحقّ عندما تتوغل إِلى دواخل الروح الإِنسانية عن طريق أصولها المنطقية السليمة، فإِنّها ستصطدم مع عوامل السلب والإِنكار الموجود فيه أحياناً، فيستغرق ذلك الجدال أو الصراع الداخلي مدّة تتناسب مع حجم قوّة وضعف تلك العوامل، فإِنْ كانت عوامل النهي والإِنكار أقوى فإِنها ستغلبها بعد مدّة.. وعبّر القرآن عن تلك الحالة بكلمة «ثمّ».
والآيتان (64 و 65)، من سورة الأنبياء ضمن عرضهما لقصة إِبراهيم(عليه السلام)تتحدثان عن قوّة احتجاج نبي اللّه إِبراهيم(عليه السلام) بعد أن حطم أصنامهم جميعها إِلاّ كبيرها ممّا تركهم في الوهلة الأُولى يغوصون في تفكير عميق، ممّا حدا بهم لأنّ يلوموا أنفسهم وكادوا أن يهتدوا إِلى الحقَّ لولا وجود تلك الرواسب من العوامل السلبية في نفوسهم (التعصب، الكبر، العناد) التي أمالت كفة انحرافهم على قبول دعوة الحق، فعادوا من جديد إِلى ما كانوا عليه، ولوصف تلك الحالة نرى القرآن قد استعمل كلمة «ثم» أيضاً: { فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ }.
وعلى هذا فمعنى «الكافرون» يتوضح بشكل أدق عند وجود كلمة «ثم».
_______________
1- تفسير الامثل ،مكارم الشيرازي ،ج7،ص126-137.
2- إِنّ صناعة الخيام من الجلود قليلة في عصرنا المعاش، ولكنَّ الآية المباركة أرادت أن تظهر أن هذا النوع من الخيام كان من أفضل الأنواع في تلك الأزمان، واختص بالذكر دون بقية الأنواع ربما لكونها أكثر مأمناً أمام عواصف الصحراء الحارقة في الحجاز.
3 ـ نور الثقلين، ج3، ص72.



|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
شعبة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) تنظم دورة تخصصية في أحكام التلاوة
|
|
|