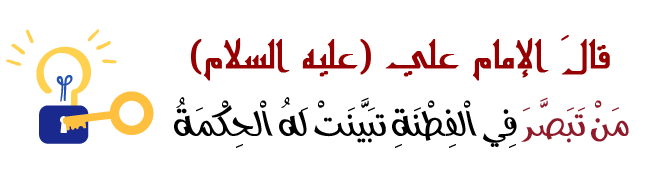
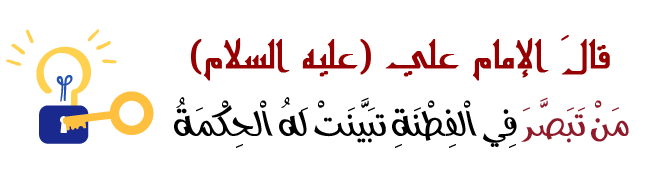

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2019
التاريخ: 4-2-2019
التاريخ: 4-2-2019
التاريخ: 4-2-2019
|
منهج النحو:
لقد ذكرنا أن النحو دراسة العلاقات بين أبوابه، ممثلة في الكلمات التي في النص، فنحن حين نعرب نترجم الكلمات إلى أبواب، ليمكن أن ننظر إليها في ضوء علاقاتها النحوية، فإذا أعربنا "ضرب محمد عليا"، لمن نقنع بضرب كما هي،
وإنما سميناها باسم باب نحوي هو الفعل الماضي، ولم نقع بمحمد كما هو، فسميناه باسم باب آخر هو الفاعل، ولا بعلي على حاله، فسميناه باسم باب المفعول.
والسبب الذي نحول من أجله الكلمات إلى أبواب واضح جدا، وهو كما ذكرنا أن النحو دراسة العلاقات بين الأبواب، لا بين الكلمات، ويقول ابن مالك: وبعد فعل فاعل إلخ، ولا يقول: وبعد ضرب محمد؛ لأنه يتكلم عن الأبواب لا عن الأمثلة.
ص192
فحين تتحول الكلمات بالتحليل الإعرابي إلى أبواب، تتضح العلاقات التي بينها؛ لأن هذه العلاقات مقررة في قواعد النحو، وكل باب من هذه الأبواب، معنى وظيفي للكلمة المعربة به، فحين نقول إن المعنى الوظيفي "لضرب"، أنها فعل ماضي، ونقصد أنها تقوم في السياق بدور الفعل الماضي، وتؤدي وظيفته النحوية الخاصة به، وحين قال النحاة قديما: إنا الإعراب فرع المعنى، كانوا في منتهى الصواب في القاعدة، وفي منتهى الخطأ في التطبيق؛ لأنهم طبقوا كلمة المعنى تطبيقا معيبا، حيث صرفوها إلى المعنى المعجمي حينا، والدلالي حينا، ولم يصرفوها إلى المعنى الوظيفي.
والحق أن الصلة وثيقة جدا بين الإعراب، وبين المعنى الوظيفي، فيكفي أن تعلم وظيفة الكملة في السياق، لتدعي أنك أعربتها إعرابًا صحيحًا، وتأتي وظيفة الكلمة من صيغتها ووضعها، لا من دلالتها على مفهومها اللغوي، ولذلك يستطيع المرء أن يعرب كلمات لا معنى لها، ولكنها مصوغة على شرط اللغة العربية، ومصروفة على غرار تراكيبها.
وإذا لم يصدق القارئ هذا الكلام، فليسمح لي بأن أجرؤ على خلق هذا النص الآتي على مثال اللغة العربية، وإن لم يكن هذا نصا عربيا، فكل كلماته هراء:
"حنكف المستعص بسقاحته في الكمظ فعنذ التران تعنيذا خسيلا، فلما اصطقف التران، وتحنكف شقله المستعص بحشله فانحكز سحيلا سحيلا، حتى خزب".
لكأني بالقارئ الآن قد بدأ في إعراب هذا النص، وكأني أسمعه يقول: حنكف فاعل ماضي، والمستعص فاعل، وبسقاحته جار ومجرور متعلق بحنكف، إلى أن يتم له الإعراب الصحيح.
ولكن مهلا! كيف يستطيع القارئ أن يعرب كلمات، ليس لها معنى في القاموس، مع أن نصها المسوق هنا لا يدل على معنى دلالي خاص؟ الجواب بسيط جدا؛ لأن هذه الكلمات الهرائية تحمل في طيها معنى وظيفيا، فالكلمة الأولى في النص تؤدي وظيفة الفعل الماضي لسببين: الأول أنها جاءت في صيغته، والثاني
ص193
أنها وقعت موقعه، وتقوم الكملة الثانية بدرو آخر، والثالقثة بوظيفة ثالثة، وهلم جرا، فالإعراب إذًا فرع المعنى الوظيفي، لا المعنى المعجمي، ولا المعنى الدلالي، وأظننا قد فرقنا بين هذه المعاني الثلاثة في مكان سباق من هذا الكتاب، ومن هنا كان قول النحاة صوابًا، وكان تطبيقهم خاطئًا.
ولا يمكن أن تقوم دراسة نحوية صحيحة، دون أن يدخل في منهجها علم الأصوات، وعلم التشكيل الصوتي، وعلم الصرف، والباب الذي لا يستغنى عنه من علم التشكيل في الدراسة النحوية هو باب الموقعية؛ لأن النحو مليء بالسلوك الموقعي للكلمات، أي أن الموقع يتحكم إلى حد كبير في الإعراب، وما يدل عليه من حركات وعلامات، ألست ترى موقعية واضحة في كسر آخر فعل الأمر في "اضرب الولد"، وآخر المضارع في "لم أضرب الولد"، مع أن الأول مبني على السكون من الناحية التقسيمية، والثاني مجزوم؟ فالموقعية هنا، أو على وجه التحديد موقعية التقاء الساكنين، هي التي اقتضت الحركة الأخيرة في الفعلين، وقد سبق أن شرحنا الدور الذي يلعبه التنغيم في التفريق بين التقرير والنفي، هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا على ضرورة الإحاطة بالأصوات، والتشكيل الصوتي في أية دراسة نحوية، ولقد كان النحاة القدماء هم واضعي علم القراءات، فساعدتهم معرفتهم بالقراءة والأصوات التي فيها على أن يأتوا في النحو بما أتوا به.
أما الصرف، ومدى ارتباطه بالنحو، فدليله أن النحاة القدماء لم يفصلوا بين منهجيهما في التناول، ويكفي أن تنظر مثلا إلى ألفية ابن مالك، ثم تحاول أن تفصل فيها بين أبواب النحو وأبواب الصرف، وأنا واثق أن الأمر سيتطلب منك تفكيرًا عميقًا، وأنك ستجد بعض الأبواب مستعصية على الإضالة إلى هذا المنهج أو ذاك، لاختلاط المنهجين فيها.
وهذه المناهج الأربعة "الأصوات، والتشكيل، والصرف، والنحو"، هي ما يطلق عليه في مجموعة اسم الجراماطيقا "Grammar"، فمن قال: إنني أدرس اللهجة
الفلانية من جهة الجراماطيقا، والأصوات، أو الجراماطيقا
ص194
والتشكيل، أو الجراماطيقا والصرف، أو الجراماطيقا، والنحو، فهو مخطيء فيما يقول؛ لأن الجراماطيقا اسم يشمل كل هذه المناهج.
والنحو دراسة الجمل التامة من ناحية العلاقات السنتاجماتية Syntagmatic relations أو السياقية، في مقابل الصرف الذي يدرس العلاقات البراديجماتية Paradigmatic relations أو الجدولية، وإلى جانب ذلك يدرس النحو الأبواب العامة لمعاني الجملة كالتقرير، والنفي، والاستفهام، والتأكيد، وهلم جرا، وهنا يدخل المنطق، فحذار من الخلط بين النحو والمنطق.
وإذا علمنا أن الجراماطيقا تعالج المعنى، حتى حدود المعجم، ثم يبدأ دور المعجم في تحديده على مستوى الكلمة، حتى يصل به إلى حدود الدلالة التي تعالجه على مستوى اجتماعي، يشمل الجملة، والماجريات المحيطة بها، ظهر لنا أن المعنى الذي تدرسه الجراماطيقا هو المعنى الوظيفي فحسب، هو معنى يحدد وظيفة الصوت، فوظيفة الحرف والمقطع والموقع، والنبر والكمية والتنغيم، فوظيفة المورفيم والصيغة، فوظيفة الباب من أبواب النحو، ذلك هو قسط المعنى الذي يدرسه علم الجرماطيقا بفروعه الأربعة، ولعل ذلك يوضح أن الدراسات اللغوية جميعا، إنما تتجه إلى تحديد المعنى، سواء باعتبارها فرادى أو مجتمعة.
والمعنى المدروس هنا هو مدلول العلامات اللغوية، سواء كانت هذه العلامات أصواتا، أو كلمات أو جملا، فهو معنى يوصل إليه عن طريق المنهج الشكلي، وليس المقصود هنا المعنى النفسي، أو المعنى الذي تبحث فيه الابستيمولوجيا "علم أصول المعارف"؛ لأننا نباعد بين الفلسفة وبين الدراسات اللغوية؛ إذ نريد أن نجعل المعلومات اللغوية كلها براجماتية، تنبني على الاستقراء بالحس، لا ترانسندنتالية تنبني على الحدس والتخمين.
ص195
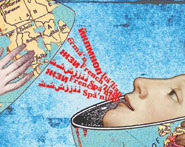
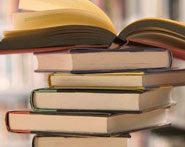

|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|