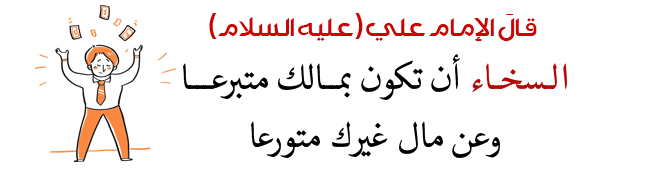
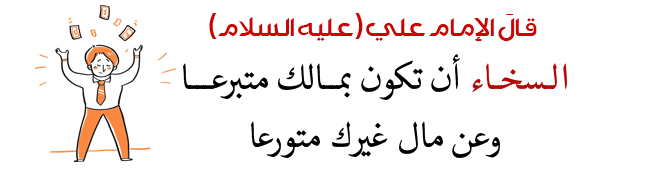

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2017
التاريخ: 8-10-2017
التاريخ: 9-10-2017
التاريخ: 8-10-2017
|
قال تعالى : {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا } [الفتح: 25، 26].
ذكر سبحانه سبب منعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ذلك العام دخول مكة فقال {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام} أن تطوفوا وتحلوا من عمرتكم يعني قريشا {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} أي وصدوا الهدي وهي البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) معه وكانت سبعين بدنة حتى بلغ ذي الحليفة فقلد البدن التي ساقها وأشعرها وأحرم بالعمرة حتى نزل بالحديبية ومنعه المشركون وكان الصلح فلما تم الصلح نحروا البدن فذلك قوله {معكوفا} أي محبوسا عن أن يبلغ محله أي منحره وهو حيث يحل نحره يعني مكة لأن هدي العمرة لا يذبح إلا بمكة كما أن هدي الحج لا يذبح إلا بمنى.
{ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات} يعني المستضعفين الذين كانوا بمكة بين الكفار من أهل الإيمان {لم تعلموهم} بأعيانهم لاختلاطهم بغيرهم {أن تطئوهم} بالقتل وتوقعوا بهم {فتصيبكم منهم معرة} أي إثم وجناية عن ابن زيد وقيل فيلحقكم بذلك عيب يعيبكم المشركون بأنهم قتلوا أهل دينهم وقيل هو غرم الدية والكفارة في قتل الخطأ عن ابن عباس وذلك أنهم لو كبسوا مكة وفيها قوم مؤمنون لم يتميزوا من الكفار لم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم السيئة بقتل من على دينهم فهذه المعرة التي صان الله المؤمنين عنها وجواب لولا محذوف وتقديره لولا المؤمنون الذين لم تعلموهم لوطأتم رقاب المشركين بنصرنا إياكم وقوله {بغير علم} موضعه التقديم لأن التقدير لولا أن تطأوهم بغير علم وقوله.
{ليدخل الله في رحمته من يشاء} اللام متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام تقديره فحال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني من أسلم من الكفار بعد الصلح وقيل ليدخل الله في رحمته أولئك بسلامتهم من القتل ويدخل هؤلاء في رحمته بسلامتهم من الطعن والعيب {لو تزيلوا} أي لو تميز المؤمنون من الكافرين {لعذبنا الذين كفروا منهم} أي من أهل مكة {عذابا أليما} بالسيف والقتل بأيديكم ولكن الله تعالى يدفع المؤمنين عن الكفار فلحرمة اختلاطهم بهم لم يعذبهم .
ثم قال سبحانه {إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية} إذ يتعلق بقوله لعذبنا أي لعذبنا الذين كفروا وأذنا لك في قتالهم حين جعلوا في قلوبهم الأنفة التي تحمي الإنسان أي حميت قلوبهم بالغضب ثم فسر تلك الحمية فقال {حمية الجاهلية} أي عادة آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لأحد ولا ينقادوا له وذلك أن كفار مكة قالوا قد قتل محمد وأصحابه آباءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا واللات والعزى لا يدخلونها علينا فهذه الحمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم وقيل هي أنفتهم من الإقرار لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم حيث أراد أن يكتب كتاب العهد بينهم عن الزهري {فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى} وهي قول لا إله إلا الله عن ابن عباس وقتادة ومجاهد {وكانوا أحق بها وأهلها} قيل أن فيه تقديما وتأخيرا والتقدير كانوا أهلها وأحق بها أي كان المؤمنون أهل تلك الكلمة وأحق بها من المشركين وقيل معناه وكانوا أحق بنزول السكينة عليهم وأهلها وقيل وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها وأهلها وقد يكون حق أحق من غيره أ لا ترى أن الحق الذي هو طاعة يستحق بها المدح أحق من الحق الذي هو مباح لا يستحق به ذلك {وكان الله بكل شيء عليما} لما ذم الكفار بالحمية ومدح المؤمنين بلزوم الكلمة والسكينة بين علمه ببواطن سرائرهم وما ينطوي عليه عقد ضمائرهم.
__________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج9 ، ص207-210.
{ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ والْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}.
قلنا عند تفسير الآية 10 من هذه السورة : ان المشركين منعوا الرسول ( صلى الله عليه واله وسلم ) والصحابة من زيارة المسجد الحرام سنة ست للهجرة ، وكان معهم سبعون ناقة - على ما قيل - ساقوها للنحر بمكة وهي التي عناها سبحانه بقوله : {والْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} ومعكوفا أي محبوسا للنحر ، ومحله أي محل نحره وهو مكة . وأيضا قلنا عند تفسير الآية 24 : ان المسلمين فتحوا مكة من غير قتال سنة ثمان ، لأن اللَّه ألقى الرعب من المسلمين في قلوب المشركين . . . والآية التي نحن بصددها تشير إلى هذا المعنى وتؤكد ان أهل مكة لم يسكتوا ويكفوا عن قتال النبي والصحابة حين دخلوا مكة - إلا خوفا من المسلمين ، والدليل على ذلك - كما صرحت الآية - ان هؤلاء المكيين هم الكافرون الذين منعوا المسلمين من زيارة المسجد الحرام ومن وصول الهدي إلى مكة لينحر فيها . ويأكل منه البائس الفقير .
ثم أشار سبحانه إلى بعض فوائد السلم والكف عن القتال في فتح مكة ، بقوله :
1 – {ولَولا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ونِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} . حين دخل النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) مكة فاتحا كان فيها جماعة من المسلمين نساء ورجالا ولكنهم كانوا غير معروفين ولا متميزين عن المشركين لأنهم كتموا ايمانهم خوفا من أعداء الإسلام ، ولو دارت رحى الحرب لأصاب ضررها المسلم والكافر . . . فربما قتل المسلم أخاه المسلم الذي يكتم إيمانه ، وهو يظن انه يقتل كافرا ، وفي ذلك ما فيه من المشقة على المسلمين بما يلزمهم من الكفارة ودية قتل الخطأ ، بالإضافة إلى ان أعداء الدين يتخذون منه وسيلة للطعن والتشهير بأن المسلمين يقتل بعضهم بعضا .
2 – {لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ } . المراد بالرحمة هنا الإسلام ، والمعنى ان اللَّه سبحانه كف الأيدي عن القتال في فتح مكة لأنه يعلم ان بعض أهلها المشركين سيهتدون ويسلمون ، وهذا ما حدث بالفعل { لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً } . أي لو تميز كل فريق عن الآخر ، وعرف المسلم من الكافر لأذن اللَّه للمسلمين بقتال الكافرين ، وأنزل بهم أشد العذاب .
{إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ } . يشير سبحانه بالذين كفروا إلى عتاة الشرك الذين منعوا النبي سنة ست للهجرة من زيارة المسجد الحرام ، لا لشيء إلا لأن قلوبهم مفعمة بالتعصب وأنفة الكبرياء . . . وهذا وحده يستوجب الإذن بقتالهم وقتلهم ، ولكن اللَّه سبحانه كف أيدي المسلمين عنهم حرصا على حياة من كتم إيمانه ومن سيدخل في الإسلام منهم بعد فتح مكة .
{فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وكانُوا أَحَقَّ بِها وأَهْلَها} . المراد بالسكينة هنا الرضا والصبر الجميل ، وبألزمهم أوجب على المؤمنين ، أما كلمة التقوى فقيل : ان المراد بها قول لا إله إلا اللَّه . . .
والأرجح ان المراد بها العمل بالتقوى ، والمعنى ان النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) قبل صلح الحديبية على الرغم من كبرياء المشركين وعتوهم ، وكره هذا الصلح بعض الصحابة وأصروا على القتال ، ولكن اللَّه سبحانه ألهمهم الصبر الجميل على غطرسة المشركين ، وأمرهم أن يقبلوا الصلح ويرضوا به فسمعوا وعملوا بما يوجبه الايمان والتقوى ، ولا بدع فإنهم أهلها وأولى الناس بالعمل بها ، فلقد جاهدوا وضحّوا بالكثير في سبيل اللَّه ، وصبروا صبر الأحرار والأبرار {وكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} . يعلم المتقين والمجرمين ، ويجزي كلا بما كسبوا وهم لا يظلمون .
______________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7، ص98-99.
قوله تعالى: {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله} العكوف على أمر هو الإقامة عليه، والمعكوف - كما في المجمع - الممنوع من الذهاب إلى جهة بالإقامة في مكانه، ومنه الاعتكاف وهو الإقامة في المسجد للعبادة.
والمعنى: المشركون مشركوا مكة هم الذين كفروا ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي - الذي سقتموه - حال كونه محبوسا من أن يبلغ محله أي الموضع الذي ينحر أو يذبح فيه وهو مكة التي ينحر أو يذبح فيها هدي العمرة كما أن هدي الحج ينحر أو يذبح في منى، وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن معه من المؤمنين محرمين للعمرة ساقوا هديا لذلك.
قوله تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم} الوطء الدوس، والمعرة المكروه، وقوله: {أن تطئوهم} بدل اشتمال من مدخول لولا، وجواب لولا محذوف، والتقدير: ما كف أيديكم عنهم.
والمعنى: ولولا أن تدوسوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات بمكة وأنتم جاهلون بهم لا تعلمون فتصيبكم من قتلهم وإهلاكهم مكروه لما كف الله أيديكم عنهم.
وقوله: {ليدخل الله في رحمته من يشاء} اللام متعلق بمحذوف، والتقدير: ولكن كف أيديكم عنهم ليدخل في رحمته أولئك المؤمنين والمؤمنات غير المتميزين بسلامتهم من القتل وإياكم بحفظكم من أصابه المعرة.
وقيل: المعنى: ليدخل في رحمته من أسلم من الكفار بعد الصلح.
وقوله: {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} التزيل التفرق وضمير {تزيلوا} لجميع من تقدم ذكره من المؤمنين والكفار من أهل مكة أي لو تفرقوا بأن يمتاز المؤمنون من الكفار لعذبنا الذين كفروا من أهل مكة عذابا أليما لكن لم نعذبهم لحرمة من اختلط بهم من المؤمنين.
قوله تعالى: {إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية} إلى آخر الآية قال الراغب: وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فيقال: حميت على فلان أي غضبت عليه قال تعالى: {حمية الجاهلية} وعن ذلك استعير قولهم: حميت المكان حمى انتهى.
والظرف في قوله: {إذ جعل} متعلق بقوله سابقا: {وصدوكم} وقيل: متعلق بقوله: {لعذبنا} وقيل: متعلق باذكر المقدر، والجعل بمعنى الإلقاء و{الذين كفروا} فاعله والحمية مفعوله و{حمية الجاهلية} بيان للحمية والجاهلية وصف موضوع في موضع الموصوف والتقدير الملة الجاهلية.
ولوكان {جعل} بمعنى صير كان مفعوله الثاني مقدرا والتقدير إذ جعل الذين كفروا الحمية راسخة في قلوبهم ووضع الظاهر موضع الضمير في قوله: {جعل الذين كفروا} للدلالة على سبب الحكم.
ومعنى الآية : هم الذين كفروا وصدوكم إذ ألقوا في قلوبهم الحمية حمية الملة الجاهلية.
وقوله: {فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين} تفريع على قوله: {جعل الذين كفروا} ويفيد نوعا من المقابلة كأنه قيل: جعلوا في قلوبهم الحمية فقابله الله سبحانه بإنزال السكينة على رسوله وعلى المؤمنين فاطمأنت قلوبهم ولم يستخفهم الطيش وأظهروا السكينة والوقار من غير أن يستفزهم الجهالة.
وقوله : {وألزمهم كلمة التقوى} أي جعلها معهم لا تنفك عنهم، وهي على ما اختاره جمهور المفسرين كلمة التوحيد وقيل: المراد الثبات على العهد والوفاء به وقيل : المراد بها السكينة وقيل: قولهم : بلى في عالم الذر، وهو أسخف الأقوال.
ولا يبعد أن يراد بها روح الإيمان التي تأمر بالتقوى كما قال تعالى : {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة : 22] ، وقد أطلق الله الكلمة على الروح في قوله: {وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ } [النساء : 171].
وقوله: {وكانوا أحق بها وأهلها} أما كونهم أحق بها فلتمام استعدادهم لتلقي هذه العطية الإلهية بما عملوا من الصالحات فهم أحق بها من غيرهم، وأما كونهم أهلها فلأنهم مختصون بها لا توجد في غيرهم وأهل الشيء خاصته.
وقيل : المراد وكانوا أحق بالكسينة وأهلها، وقيل : إن في الكلام تقديما وتأخيرا والأصل وكانوا أهلها وأحق بها وهوكما ترى.
وقوله: {وكان الله بكل شيء عليما{ تذييل لقوله: {وكانوا أحق بها وأهلها} أو لجميع ما تقدم، والمعنى على الوجهين ظاهر.
قوله تعالى : {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون} الخ، قيل : إن صدق وكذب مخففين يتعديان إلى مفعولين يقال : صدقت زيدا الحديث وكذبته الحديث، وإلى المفعول الثاني بفي يقال : صدقته في الحديث وكذبته فيه، ومثقلين يتعديان إلى مفعول واحد يقال: صدقته في حديثه وكذبته في حديثه.
___________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج18، ص235-237.
في الاية الاولى إشارة لطيفة تتعلّق بمسألة صلح الحديبيّة وحكمتها إذ تقول الآية: {هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله}(2).
كان أحد ذنوبهم كفرهم، والذنب الآخر صدّهم إيّاكم عن العُمرة زيارة بيت الله ولم يجيزوا أن تنحروا الهدي في محله، أي مكّة (الهدي في العمرة ينحر [أو يذبح] في مكّة وفي الحج بمنى) على حين ينبغي أن يكون بيت الله للجميع وصدّ المؤمنين عنه من أعظم الكبائر، كما يصرّح القرآن بذلك في مكان آخر من سورة: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة: 114].
ومثل هذه الذنوب يستوجب أن يسلّطكم الله عليهم لتعاقبوهم بشدّة! لكنّ الله تعالى لم يفعل ذلك فلماذا؟! ذيل الآية يبيّن السبب بوضوح إذ يقول: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الفتح: 25] (3)..
وهذه الآية تشير إلى طائفة (من الرجال والنساء) المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام في مكّة ولم يهاجروا إلى المدينة لأسباب خاصة.
فلو قاتل المسلمون أهل مكّة لأوقعوا أرواح هؤلاء المستضعفين في خطر ولامتدت ألسنة المشركين بالقول: إنّ جنود الإسلام لم يرحموا لا أعداءهم ومخالفيهم ولا أتباعهم ومؤالفيهم، وهذا عيب وعار كبير!
وقال بعضهم أيضاً، إنّ المراد من هذا العيب لزوم الكفارة ودية قتل الخطأ، لكنّ المعنى الأوّل أكثر مناسبةً ظاهراً.
«المعرّة» من مادة «عرّ» على زنة «شرّ» «والعرّ على زنة الحر» في الأصل معناه مرض الجرب وهومن الأمراض الجلدية التي تصيب الحيوانات أو الإنسان أحياناً ثمّ توسّعوا في المعنى فأطلقوا هذا اللفظ على كلّ ضرر يصيب الإنسان.
ولإكمال الموضوع تضيف الآية: {ليدخل الله في رحمته من يشاء}.
أجل، كان الله يريد للمستضعفين المؤمنين من أهل مكّة أن تشملهم الرحمة ولا تنالهم أية صدمة..
كما يرد هذا الإحتمال أيضاً وهو أنّ أحد أهداف صلح الحديبيّة أنّ من المشركين من فيه قابلية الهداية فيهتدي ببركة هذا الصلح ويدخل في رحمة الله.
والتعبير بـ «من يشاء» يراد منه الذين فيهم اللياقة والجدارة، لأنّ مشيئة الله تنبع من حكمته دائماً، والحكيم لا يشاء إلاّ بدليل ولا يعمل عملاً دون دقّة وحساب..
ولمزيد التأكيد تضيف الآية الكريمة: {لو تزيلوا لعذّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً} أي لو افترقت وانفصلت صفوف المؤمنين والكفار في مكّة ولم يكن هناك خطر على المؤمنين لعذّبنا الكفار بأيديكم عذاباً أليماً.
صحيح أنّ الله قادر على أن يفصل هذه الجماعة عن الآخرين عن طريق الإعجاز، ولكنّ سنّة الله ـ في ما عدا الموارد الإستثنائية ـ أن تكون الأُمور وفقاً للأسباب العاديّة.
جملة «تزيلوا» من مادة زوال، وهنا معناها الإنفصال والتفرّق.
ويستفاد من روايات متعدّدة منقولة عن طرق الشيعة والسنّة حول ذيل هذه الآية أنّ المراد منها أفراد مؤمنون كانوا في أصلاب الكافرين والله سبحانه لأجل هؤلاء لم يعذّب الكافرين..
ومن جملة هذه الروايات نقرأ في الرواية أنّه سأل رجلٌ الإمام الصادق (عليه السلام): ألم يكن علي (عليه السلام) قوياً في دين الله؟ قال (عليه السلام): بلى. فقال: فعلام إذ سُلّط على قوم (في الجمل) لم يفتك بهم فما كان منعه من ذلك؟!
فقال الإمام: آية في القرآن!
فقال الرجل: وأية آية؟!
فقال الصادق (عليه السلام) قوله تعالى: {لو تزيلوا لعذّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً}.. ثمّ أضاف (عليه السلام): أنّه كان لله عزَّ وجلَّ ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، ولم يكن علي ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع.. وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع الله عزَّ وجلّ(4).
أي أن اللّه سبحانه يعلم أنّ جماعة سيولدون منهم في ما بعد وسيؤمنون عن إختيارهم وإرادتهم ولأجلهم لم يعذب اللّه أباءهم وقد أورد هذا القرطبي في تفسيره بعبارة اُخرى.
ولا يمنع أن تكون الآية مشيرة إلى المؤمنين المختلطين بالكفّار في مكّة وإلى المؤمنين الذين هم في أصلاب الكافرين وسيولدون في ما بعد!..
التعصّب «وحمية الجاهلية» أكبر سدٍّ في طريق الكفّار:
والاية الثانية تتحدّث مرّة أُخرى عن (مجريات) الحديبيّة وتجسّم ميادين أُخرى من قضيتها العظمى.. فتشير أوّلاً إلى واحد من أهم العوامل التي تمنع الكفار من الإيمان بالله ورسوله والإذعان والتسليم للحق والعدالة فتقول: {إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية}(5).
ولذلك منعوا النّبي والمؤمنين أن يدخلوا بيت الله ويؤدّوا مناسكهم وينحروا «الهدي» في مكّة. وقالوا لو دخل هؤلاء ـ الذين قتلوا آباءنا وإخواننا في الحرب ـ أرضنا وديارنا وعادوا سالمين فما عسى أن تقول العرب فينا؟! وأية حيثية واعتبار لنا بعد؟
هذا الكبر والغرور والحميّة ـ حمية الجاهلية ـ منعتهم حتى من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» بصورتها الصحيحة عند تنظيم معاهدة صلح الحديبيّة، مع أنّ عاداتهم وسننهم كانت تجيز العُمرة وزيارة بيت الله للجميع، وكانت مكّة عندهم حرماً آمناً حتى لو وجد أحدهم قاتل أبيه فيها أو أثناء المناسك فلا يناله منه سوء وأذى لحرمة البيت عنده، فهؤلاء ـ بهذا العمل ـ هتكوا حرمة بيت الله والحرم الآمن من جهة، وخالفوا سننهم وعاداتهم من جهة أخرى، كما أسدلوا ستاراً بينهم وبين الحقيقة أيضاً، وهكذا هي آثار حمية الجاهلية المميتة!
«الحمية» في الأصل من مادة حَمي ـ على وزن حمد ـ ومعناها حرارة الشمس أو النّار التي تصيب جسم الإنسان وما شاكله، ومن هنا سمّيت الحُمّى التي تصيب الإنسان بهذا الاسم «حُمّى» على وزن كبرى، ويقال لحالة الغضب أو النخوة أو التعصّب المقرون بالغضب حمية أيضاً.
وهذه الحالة السائدة في الأُمم هي بسبب الجهل وقصور الفكر والإنحطاط الثقافي خاصةً بين «الجاهليّين» وكانت مدعاة لكثير من الحروب وسفك الدماء!..
ثمّ تضيف الآية الكريمة ـ وفي قبال ذلك ـ (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)..
هذه السكينة التي هي وليدة الإيمان والإعتقاد بالله والإعتماد على لطفه دعتهم الى الإطمئنان وضبط النفس وأطفأت لهب غضبهم حتى أنّهم قبلوا ـ ومن أجل أن يحفظوا ويرعوا أهدافهم الكبرى ـ بحذف جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» التي هي رمز الإسلام في بداية الأعمال وأن يثبتوا ـ مكانها «بسمك اللّهمَّ» التي هي من موروثات العرب السابقين ـ في أوّل المعاهدة وحذفوا حتى لقب «رسول الله» التي يلي اسم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).
وقبلوا بالعودة إلى المدينة من الحديبيّة دون أن يستجيبوا لهوى عشقهم بالبيت ويؤدّوا مناسك العمرة! ونحروا هديهم خلافاً للسنّة التي في الحج أو العمرة في المكان ذاته وأحلّوا من احرامهم دون أداء المناسك!..
أجل، لقد رضوا بمرارة أن يصبروا إزاء كلّ المشاكل الصعبة، ولو كانت فيهم حميّة الجاهلية لكان واحد من هذه الأُمور الآنفة كفيلاً أن يشعل الحرب بينهم في تلك الأرض!
أجل.. إنّ الثقافة الجاهلية تدعو إلى «الحمية» و «التعصّب» و«الحفيظة الجاهلية»، غير أنّ الثقافة الإسلامية تدعو إلى «السكينة» و «الإطمئنان» و«ضبط النفس».
ثمّ يضيف القرآن في هذا الصدد قائلاً: {وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها}..
(كلمة) هنا بمعنى «روح»، ومعنى الآية أنّ الله ألقى روح التقوى في قلوب أولئك المؤمنين وجعلها ملازمة لهم ومعهم، كما نقرأ ـ في هذا المعنى ـ أيضاً الآية (171) من سورة النساء في شأن عيسى بن مريم إذ تقول الآية: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ } [النساء: 171].
واحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد من «كلمة التقوى» ما أمر الله به المؤمنين في هذا الصدد!
إلاّ أنّ المناسب هو «روح التقوى» التي تحمل مفهوماً تكوينياً، وهي وليدة الإيمان والسكينة والإلتزام القلبي بأوامر الله سبحانه، لذا ورد في بعض الروايات عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ المراد بكلمة التقوى هو كلمة لا إله إلاّ الله(6)، وفي رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه فسّرها بالإيمان(7).
ونقرأ في بعض خطب النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «نحن كلمة التقوى وسبيل الهدى»(8) وشبيه بهذا التعبير ما نُقل عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قوله: «ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى»(9)!
وواضح أنّ الإيمان بالنبوّة والولاية مكمل للإيمان بأصل التوحيد ومعرفة الله لأنّهما جميعاً داعيانِ إلى الله ومناديان للتوحيد.
وعلى كلّ حال فإنّ المسلمين لم يُبتلوا في هذه اللحظات الحسّاسة بالحميّة والعصبية والنخوة والحفيظة، وما كتب الله لهم من العاقبة المشرفة في الحديبيّة لم تمسسْه نار الحمية والجهالة!
لأنّ الله يقول: {وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها}.
وبديهي أنّه لا يُنتظر من حفنة عتاة وجهلة وعبدة أصنام سوى (حميّة الجاهلية) ولا ينتظر من المسلمين الموحّدين الذين تربّوا سنين طويلة في مدرسة الإسلام مثل هذا الخلق والطباع الجاهلية، ما ينتظر منهم هو الإطمئنان والسكينة والوقار والتقوى، وذلك ما أظهروه في الحديبيّة ولكن بعض حاديّ الطبع والمزاج أوشكوا على كسر هذا السدّ المنيع بما يحملوه من أنفسهم من ترسبات الماضي وأثاروا البلبلة والضوضاء، غير أنّ سكينة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و وقاره كانا كمثل الماء المسكوب على النّار فأطفأها!
وتُختتم الآية بقوله سبحانه: {وكان الله بكلّ شيء عليماً}. فهو سبحانه يعرف نيّات الكفّار السيئة ويعرف طهارة قلوب المؤمنين أيضاً فينزل السكينة والتقوى عليهم هنا، ويترك أُولئك في غيّهم وحميّتهم حميّة الجاهلية، فالله يشمل كلّ قوم وأمّة بما تستحقّه من اللطف والرحمة أو الغضب والنقمة!
____________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج13، ص62-
2 ـ «معكوفاً» مشتق من العكوف ومعناها المنع عن الحركة والبقاء في المكان.
3 ـ جواب لولا في الجملة الآنفة محذوف والتقدير: لمّا كفَ أيديكم عنهم، أو: لوطأتم رقاب
المشركين بنصرنا إيّاكم..
4 ـ تفسير نور الثقلين، ج5، ص70، وروايات أُخر متعددة وردت أيضاً في هذا المجال!.
5 ـ يستوفي الفعل (جعل) مفعولاً واحداً أحياناً وذلك إذا كان معناه «الإيجاد» كالآية محل البحث
وفاعله الذين كفروا ومفعوله الحمية والمراد بالإيجاد هنا البقاء على هذه الحالة والتعلّق بها، وقد
يستوفي هذا الفعل (جعل) مفعولين وذلك إذا كان بمعنى (صار).
6 ـ الدر المنثور، الجزء 6، ص80.
7 ـ أصول الكافي طبقاً لما نقل في تفسير نور الثقلين، ج5، ص73.
8 ـ خصال الصدوق، ج2 ، ص432، تفسير نور الثقلين، ج5، ص73.
9 ـ بحار الانوار ، ج23، ص35 ، وتفسير نور الثقلين ، ج5 ، 74.



|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
طائرة شراعية تزيّن سماء كربلاء المقدّسة بلافتة حفل تخرّج طلبة الجامعات العراقية
|
|
|