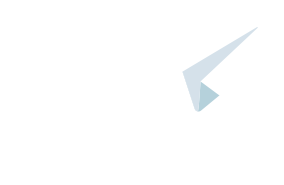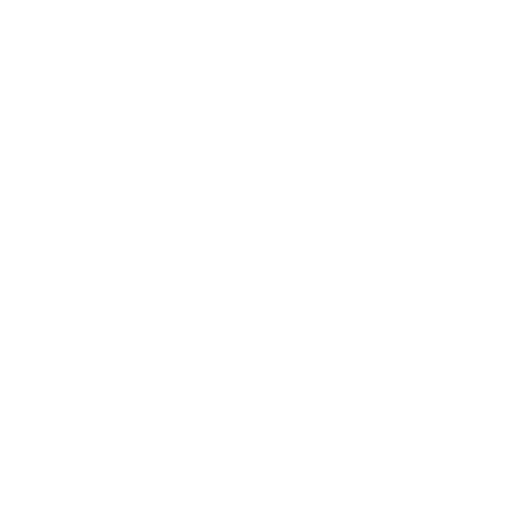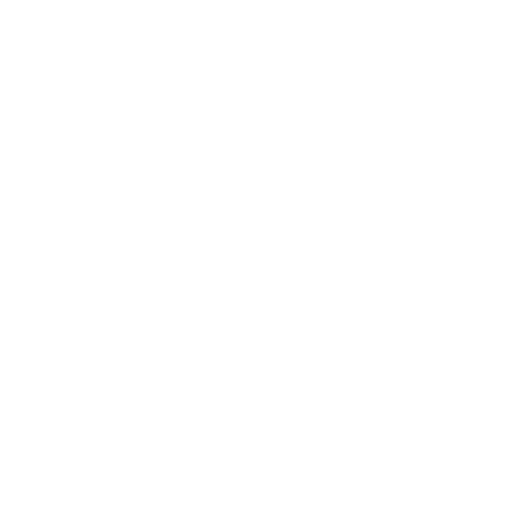تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
شواهد من القران الكريم
المؤلف:
محمّد هادي معرفة
المصدر:
تلخيص التمهيد
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص210-220.
5-11-2014
9162
[اولا] : آيتا السرقة والزنا :
حينما يذكر السرقة نراه يُورد السارق مقدّماً على السارقة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة : 38] ، أما في الزنا فنراه يذكر الزانية مقدّمة على الزاني {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور : 2] ، والحكمة واضحة ، فالمرأة في الزنا هي البادئة وهي التي تدعو الرجل ، بزينتها وتبرّجها ، أمّا في السرقة فهي أقلّ جرأة من الرجل .
إننا إذاً أمام كلمات مصفوفة بإحكام ودقة وانضباط {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } [هود : 1] .
[ثانيا] : ليس كمثله شيء :
ومن دقيق تعبيره : قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] .
زعموا زيادة الكاف هنا ، فراراً من المحال العقلي ؛ إذ لو كانت باقيةً على أصلها للزم التسليم بثبوت المثل !
وحاول بعضهم توجيه عدم الزيادة ، بأنّه من الدلالة على المطلوب بلازم الكلام ، حيث نُفي مِثل المِثل يستلزم نفي المِثل ؛ إذ لو كان له مِثل لكان لمثله أيضاً مثل ، وهو الله تعالى ، تحقيقاً لقضية التماثل .
فهو نَفي للمِثل بهذه الطريق الملتوية ، نظير قولهم : أنت وابن أخت خالتك ، يُعدّ نوعاً من التعمية في الكلام شبيهاً بالألغاز .. الأمر الذي تأباه طبيعة الجدّ في تعابير القرآن .
ولكن لتوجيه هذا الكلام تأويل مشهور :
لو قيل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) كان المنفي هو المماثل له تماماً وفي جميع أوصافه ونعوته وخصوصياته الكلّية والجزئية ، أي ليس على شاكلته التامّة شيء ، وهذا يُوهم أن عسى قد يوجد مَن يكون على بعض أوصافه ، وفي رتبة تالية من المماثلة التامّة ؛ لأنّ هذا المعنى لم يقع تحت النفي .
وعليه فكان موضع الكاف هنا ، نفياً للمماثلة وما يشبه المماثلة أو يدنو منها بعض الشيء ، فليس هناك شيء يشبه أن يكون مماثلاً له تعالى ، فضلاً عن أن يكون مِثلاً له على الحقيقة ، وهذا من باب التنبيه بالأدنى دليلاً على الأعلى ، على حدّ قوله تعالى : {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا} [الإسراء : 23] .
وتأويل آخر أدق : وهو أنّ الآية لا ترمي نفي الشبيه له تعالى فحسب ، إذ كان يكفي لذلك أن يقول : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) ، أو ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) بل ترمي وراء ذلك دعم النفي بما يصلح دليلاً على الدعوى والإلفات إلى وجه حجة هذا الكلام وطريق برهانه العقلي .
أَلا ترى أنّك إذا أردت أن تنفي نقيصة عن إنسان ، فقلت : ( فلان لا يكذب ) أو ( لا يبخل ) كان كلامك هذا مجرّد دعوى لا دليل عليها ، أمّا إذا زدت كلمة المِثل وقلت : ( مثل فلان لا يكذب ) أو ( لا يبخل ) فكأنّك دعمت كلامك بحجّة وبرهان ، إذ من كان على صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك ؛ لأنّ وجود هذه الصفات والنعوت ممّا تمنع عن الاستسفال إلى رذائل الأخلاق .
وهذا منهج حكيم وضع عليه أُسلوب كلامه تعالى ، وأنّ مثله تعالى ـ ذا الكبرياء والعظمة ـ لا يمكن أن يكون له شبيه ، وأنّ الوجود لا يتسع لاثنين من جنيه (1) .
فجيء بأحد لفظي التشبيه ركناً في الدعوى ، وبالآخر دعامةً لها وبرهاناً عليها ، وهذا من جميل الكلام ، وبديع البيان ، ومن الوجيز الوافي .
قال الزمخشري : قالوا : مثلك لا يبخل ، فنفوا البخل عن مثله ، وهم يريدون نفيه عن ذاته ، قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية ؛ لأنّهم إذا نفوه عمّن يسدّ مسدّه وعمّن هو على أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه ، وهذا أبلغ من قولك : أنت لا تبخل .
ومنه قولهم : ( قد أيفعت لدِّاته ) (2) و ( بلغت أترابه ) (3) ، وفي الحديث : ( أَلا وفيهم الطيّب الطاهر لدِّاته ) ، وهذا ما تعطيه الكناية من الفائدة (4) .
وقال ابن الأثير : ومن لطيف هذا الموضع وحسنه ما يأتي بلفظة ( مِثل ) ، كقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح : ( مثلي لا يفعل هذا ) أي أنا لا أفعله ؛ لأنّه إذا نفاه عمّن يماثله فقد نفاه عن نفسه لا محالة ، إذ هو بنفي ذلك عنه أجدر ، وسبب ورود هذه اللفظة في هذا الموضع أنّه يُجعل من جماعة هذه أوصافهم وتثبيتاً للأمر وتوكيداً ، ولو كان وحده لقلق منه موضعه ولم يرسُ فيه قدمه (5) .
قال الأُستاذ درّاز : واعلم أنّ البرهان الذي تُرشد إليه الآية ـ على هذا الوجه ـ (6) برهان طريف في إثبات الصانع لا نعلم أحداً من علماء الكلام حام حوله ، فكلّ براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدّد بإبطال لوازمه وآثاره العملية ، حسبما أرشد إليه قوله تعالى : {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء : 22] .
أمّا آية الشورى المذكورة فإنّها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ، ينقض فرض التعدّد من أساسه ويُقرّر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار ، فكأنّنا بها تقول لنا :
إنّ حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدّد والاشتراك والتماثيل في مفهومها ، كلاّ ، فإنّ الذي يقبل ذلك فإنّما هو الكمال الإضافي الناقص ، أمّا الكمال التامّ المطلق ـ الذي هو معنى الإلهية ـ فإنّ حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والاثنينيّة ؛ لأنّك مهما حقّقت معنى الإلهية حقّقت تقدّماً على كلّ شيء وإنشاءً لكل شيء : {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأنعام : 14] (7) ، وحقّقت سلطاناً على كل شيء وعلواً فوق كلّ شيء : {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الزمر : 63] ، فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت إذ تجعل كلّ واحد منهما سابقاً ومسبوقاً ، ومُنشِئاً ، ومنشَئاً ، ومستعلياً ومستعلى عليه ، أو لأَحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيّد فيهما ، إذ تجعل كل واحد منها بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً ، فأنّى يكون كلّ منهما إلهاً ، وللإله المَثل الأعلى !
فكم أفادتنا هذه الكاف من وجوه المعاني كلّها كافٍ شافٍ ، وهذا من دقة الميزان الذي وُضع عليه النظم الحكيم في القرآن الكريم (8) .
[ثالثا] : آية القصاص :
كانت العرب تعرف ما لهذه اللفظة ( القصاص ) من مفهوم خاص : ( قَتْلُ من عَدَ على غيره فقَتَله بغير حق ) ، وكانت تعرف ما لهذه العقوبة ( مقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى ) من أثر بالغ في ضمان الحياة العامّة .
لكنّها عندما عَمَدت إلى وضع قانون يحدّ من جريمة القتل ، ويضمن للناس حياتهم ، وليكون رادعاً لمَن أراد الإجرام فأزمعت بكلّيتها على وضع عبارة موجزة وافية بهذا المقصود الجلل وأجمعت آراؤهم على عقد الجملة التالية : ( القتل أنفى للقتل ) ، غفلت عن لفظة ( القصاص ) واستُعملت كلمة ( القتل ) مكانها ، ذهولاً عن أنّها لا تفي بتمام المقصود ، وهم بصدد الإيفاء والإيجاز .
ذلك أنّ الذي يحدّ من الإجرام على النفوس ويحقن دماء الأبرياء هو فرض عقوبة القصاص ، وهو قتل خاص ، وليس مطلق القتل بالذي يؤثّر في منعه ، بل ربّما أوجب قتلات إذا لم يكن قصاصاً .
ومع الإحاطة بهذه المزايا في لفظ ( القصاص ) جاء قوله تعالى : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة : 179] (1) تعبيراً تامّاً وافياً بالمقصود تمام الوفاء ، بل وفيها زيادة مزايا شَرَحها أرباب الأدب والتفسير .
قال سيّدنا الطباطبائي ـ طاب ثراه ـ : إنّ هذه الآية ـ على اختصارها وإيجازها ، وقلّة حروفها ، وسلاسة لفظها ، وصفاء تركيبها ـ لهي من أبلغ التعابير وأرقى الكلمات ، فهي جامعة بين قوّة الاستدلال وجمال المعنى ولطفه ، ورقّة الدلالة وظهور المدلول .
وقد كان للبلغاء قبلها كلمات وتعابير في وضع قانون القصاص ، كانت تعجبهم بلاغتها وجزالة أُسلوبها ، كقولهم : ( قُتل البعض إحياء للجميع ) ، وقولهم : ( أَكثروا القتل ليقلّ القَتل ) وأَعجب من الجميع عندهم قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) .
غير أنّ الآية أَنست الجميع ، ونفت الكل ، ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) فهي أقلّ حروفاً وأسهل تلفّظاً ، وفيها تعريف القصاص وتنكير الحياة ، دلالة على أنّ الهدف الأقصى أوسع من أمر القصاص وأعظم شأناً ، وهي الحياة ، حياة الإنسان الكريمة .
واشتمالها على بيان النتيجة وعلى بيان الحقيقة ، وأنّ القصاص هو المؤدّي إلى الحياة ، دون مطلق القتل ، وغير ذلك ممّا تشتمل عليه من فوائد ولطائف ...(9) .
هذا بالإضافة إلى ما لتعبير القرآن من محسّنات بديعية باهرة ، ليست في ذلك التعبير العربي .
قال ابن الأثير : من الإيجاز ما يُسمّى الإيجاز بالقصر ، وهو الذي لا يُمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أُخرى مثلها ، وفي عدّتها ، بل يستحيل ذلك ، وهو أعلى طبقات الإيجاز مكاناً ، وإذا وُجد في كلام بعض البلغاء فإنما يوجد شاذّاً نادراً ، والقرآن الكريم مَلآن منه (10) .
فمن ذلك ما ورد من قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) .
فإنّ قوله تعالى : ( الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) لا يُمكن التعبير عنه إلاّ بألفاظ كثيرة ؛ لأنّ معناه أنّه إذا قُتل القاتل امتنع غيره عن القتل ، وكذلك إذا أيقن القاتل أن سوف يدفع حياته ثمناً لحياة مَن يقتل ، تردّد في ارتكاب القتل وربّما أمسك عنه ، فكان في ذلك حياة للناس .
ولا يُلتفت إلى ما ورد عن العرب من قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) ، فإنّ مَن لا يعلم يظنّ أنّ هذا على وزن الآية ، وليس كذلك ، بل بينهما فرق من ثلاثة أوجه :
الأَوّل : أنّ ( القصاص حياة ) لفظتان ، و( القتل أنفى للقتل ) ثلاثة ألفاظ .
الثاني : أنّ في قولهم ( القتل أنفى للقتل ) تكريراً ليس في الآية .
الثالث : أنّه ليس قتل نافياً للقتل ، إلاّ إذا كان على حكم القصاص .
قال : وقد صاغ أبو تمام هذا المعنى الوارد عن العرب في بيت من شعره ، فقال :
وأَخـافَكُم كـي تُغمدوا iiأسيافَكم إنّ الدمَ المُعترَّ يحرسُهُ الدمُ (11)
فقوله : ( إنّ الدم المعترّ يحرسه الدم ) أجمل أُسلوباً وأحسن أداءً من قولة العرب .
وقال أبو هلال العسكري : والإيجاز ، القصر والحذف ، فالقصر تقليل الألفاظ وتكثير المعاني وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) ، ويتبّين فضل هذا الكلام إذا قَرنته بما جاء عن العرب في معناه ، وهو قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) فصار لفظ القرآن فوق هذا القول ، لزيادته عليه في الفائدة ، وهو إبانة العدل لذكر القصاص ، وذِكر العوض المرغوب فيه لذكر الحياة واستدعاء الرغبة والرهبة لحكم الله به ، ولإيجازه في العبارة ، فإنّ الذي هو نظير قولهم ( القتل أنفى للقتل ) إنّما هو ( القصاص حياة ) وهذا أقلّ حروفاً من ذلك ، ولبعده من الكلفة بالتكرير ، ولفظ القرآن بَرِئ من ذلك ، وبحسن التأليف ، وشدة التلاؤم المُدرك بالحسّ ؛ لأنّ الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة (12) .
وقال جلال الدين السيوطي : وقد فُضلّت الآية على قولة العرب بعشرين وجهاً أو أكثر ، وإن كان لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق ، وإنّما العلماء يقدحون أفهامهم فيما يظهر لهم من ذلك ، كما قال ابن الأثير ، نذكر منها :
1 ـ في الآية إيجاز قصر ، من غير حاجة إلى تقدير ، أمّا قولتهم فبحاجة إلى تقدير ( من ) لمكان أفعل التفضيل ، وبذلك جاء الإبهام في قولتهم ؛ لأنّه يسأل : من أيّ شيء ؟ فإن قُدّر العموم فلعلّه غير مطّرد بالنسبة إلى جميع الموارد وجميع أفراد الناس .
2 ـ ثُمّ الذي ينفي القتل ويوجب الحياة هي شريعة القصاص ، وهو قتل بإزاء قتل خاصّ دون مطلق القتل ، إذ ربَّ قتلة أوجبت قتلات كما في حرب البَسوس طالت أربعين سنة .
3 ـ في الآية طباق ، جمعاً بين ضدّين : القصاص ـ وفيه إشعار بقتل ـ والحياة ، وأيضاً فيها بَداعة ، الضدّ أوجب ضدّه . ولا سيّما في تعريف القصاص وتنكير الحياة ، وفيه غرابة فائقة .
4 ـ قال الزمخشري : ومن إصابة محزّ البلاغة ، بتعريف القصاص وتنكير الحياة ؛ لأنّ المعنى : ولكم في هذا الجنس من الحكم ـ الذي هو شريعة القصاص ـ حياة عظيمة ، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة ، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب ، حتّى كاد يُفني بكر بن وائل ، ولقد كانوا يقتلون بالمقتول غير قاتله ، وهذه العادة جارية بين العرب حتّى الآن (13) ، فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر ، ففي شرع القصاص ـ وهو قتل القاتل المعتدي ـ حياة أيّة حياة (14) .
5 ـ وأمّا قولة العرب ، ففيها تناقض ظاهر ؛ إذ الشيء لا ينفي نفسه ، فكيف القتل ينفي القتل ؟ وأيضاً فيها تكرار ، وتقدير ، وتهويل بسبب تكرار لفظ القتل المؤذن بالوحشة .
أمّا الآية فاستُبدلت من لفظ ( القتل ) الموحش بلفظ ( القصاص ) الموجب للتشفّي والانشراح ، ثُمّ عقّبها بلفظ ( الحياة ) التي تبتهل إليها النفوس وتحتفل بها .
6 ـ وأيضاً ففي لفظ القصاص إيذان بالعدل ، حيث مساواة نفس المقتول بالقاتل ، الأمر الذي لا يدلّ عليه لفظ القتل المطلق .
7 ـ والآية بُنيت على الإثبات ، وقولتهم على النفي ، والكلام المُثبت أوفى من النافي مهما كان المعنى واحداً .
8 ـ ثُمّ إشكال في ظاهر قولتهم ، ببناء أفعل التفضيل من فعل عدمي الذي لا تفاضل فيه ظاهراً ، والآية سالمة منه .
9 ـ وأيضاً فإنّ التفاضل يقتضي المشاركة في القَدر الجامع ، بخلاف الآية التي حصرت نفي القتل في القصاص لا في غيره على الإطلاق ، فكانت أبلغ في الوفاء بالمقصود .
10 ـ الآية مشتملة على حروف متلائمة متناسقة ، تتحلّق صُعُداً ، ثُمّ تهوي نُزلاً ، ثُمّ تعود فتتصاعد إلى ما لا نهاية ( في القصاص حياة ) .
قالوا : لتلاؤم القاف مع الصاد ، كلاهما من حروف الاستعلاء ، أمّا القاف مع التاء فلا تلاؤم بينهما ؛ لأنّ التاء من المنخفض ، وكذا الخروج من الصاد إلى حاء الحياة أمكن من الخروج من اللام إلى الهمز ، لبُعد طرف اللسان عن أقصى الحلق . وأيضاً ففي النطق والحاء والتاء متتالية ظرافة وحسن ، ولا كذلك في تكرار النطق بالقاف والتاء .
11 ـ هذا فضلاً عن توالي حركات متناسبة في الآية ، بما يَسَّر النطق بها في سهولة ، وربّما في جرس صوتيّ بديع .
أمّا قولتهم فيتعقّب فيها كل حركة بسكون ، وذلك مستكره ، ويوجب عسر النطق بها ، إذا الحركات ـ وهي انطلاقات اللسان ـ تنقطع بالسكنات المتتالية ، الموجبة للضجر ووعورة الكلام ، نظير ما إذا تحرّكت الدابة أدنى حركة فجثت ، ثمّ تحرّكت فجثت ، وهكذا لا يبين انطلاقها ولا تتمكن من حركتها على إرادتها ؛ لأنّها كالمقيّدة .
12 ـ إنّ في افتتاح الآية بـ ( لكم ) مزيد عناية بحياة الإنسان ، وإنّ في شريعة القصاص حكمة بالغة ترجع فائدتها إلى النفع العام ، فهي عامّة رُوعيت في شرع القصاص ، وليست مصلحة خاصّة ترجع إلى شرح صدور أولياء المقتول المفجوعين فحسب .
وغير ذلك ممّا ذكره نَقدة الكلام ، لا زالت مساعيهم مشكورة (15) .
أرض هامدة وأرض خاشعة :
تعبيران وردا على الأرض الميتة فقدت حياتها ؛ لأنّ السماء ضنّت بمائها فلم تَمطر عليها ... فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت وأنبتت من كلّ زوج بهيج !
فقد جاء التعبير الأَوّل في سورة الحج : { يَا أَيّهَا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمّ مِن نّطْفَةٍ ثُمّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمّ مِن مّضْغَةٍ مّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلّقَةٍ لّنُبَيّنَ لَكُمْ وَنُقِرّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مّسَمّىً ثُمّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمّ لِتَبْلُغُوا أَشُدّكُمْ وَمِنكُم مّن يُتَوَفّى وَمِنكُم مّن يُرَدّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلّ زَوْجٍ بَهِيجٍ } [الحجّ : 5] .
وجاء التعبير الثاني في سورة فصّلت : {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ } [فصلت : 37، 38].
أمّا لماذا هذا الاختلاف في التعبير في المقامينِ ؟
الجوّ في السياق الأَوّل جوّ بعث ونشور وحشر أموات ، فيتناسب معه تصوير الأرض ( هامدة ) لا حياة فيها ولا حركة ولا انتفاضة .
يقال : همدت النار أي خمدت وأُطفئت وهدأت حرارتها وسَكَن لهيبها ، وهمد الثوب : إذا بَلي وتقطّع من طول البِلى .
لكن الجوّ في السياق الثاني جوّ عبادة وضراعة وخشوع وابتهال إلى الله تعالى ، فناسبه تصوير الأرض ( خاشعة ) خشوع الذلّ والاستكانة . يقال : خشعت الأرض إذا يبست ولم تُمطَر .
ونكتة أُخرى : لم تجئ ( اهْتَزّتْ وَرَبَتْ ) هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك ، إنّهما هنا تُخيّلان حركةً حاصلةً عن خشوع ، حركة تضاهي حركة العُبّاد في عباداتهم ؛ ومِن ثَمّ لم تكن الأرض لتبقى وحدها خاشعة ساكنة ، فاهتزّت لتشارك العابدينَ في حركاتهم التعبّدية وِفق إرادة الله في الخلق .
الحلف بالتاء :
قوله تعالى : {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا } [يوسف : 85].
جملة ألفاظها غريبة ، بعيدة عن الاستعمال العام ، وقع الاختيار عليها لحكمة هي مقتضى الحال والمقام ، فضلاً عن جرس اللفظة في هذا التناسب والوئام .
قال جلال الدين السيوطي : أتى بأغرب ألفاظ القَسَم ، وهي التاء ، فإنّها أقلّ استعمالاً وأبعد من أفهام العامّة بالنسبة إلى الباء والواو ، وبأغرب صيغ الأفعال الناقصة ، فإنّ ( تزال ) أقرب إلى الأفهام ، وأكثر استعمالاً من ( تفتأ ) ، وبأغرب الألفاظ الدالّة على الإشراف على الهلاك ( حَرَضاً ) ، فاقتضى حسن الوضع في النظم ، أنّ تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة ؛ توخّياً لحسن الجوار ، ورغبة في ائتلاف المعاني مع الألفاظ ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع ، وتتناسب في النظم ، فضلاً عن تناسب الغريب في التعبير مع الغريب من حالة نبيّ الله يعقوب ( عليه السلام ) (16) .
________________
1- النبأ العظيم : ص 128 .
2- أيفع الغلام : ترعرع وناهز البلوغ ، فهو يافع ، واللدّ : القرن والخَصم .
3- الأتراب : جمع تِرب بمعنى المتوافق في السنّ .
4- تفسير الكشّاف : ج4 ص213 .
5- المَثل السائر : ج3 ص61 ذكره في باب الإرداف في الكناية .
6- أي إرداف اللفظ بحجّته في أوجز كلام .
7- الأنعام : 14 ، يوسف : 101 ، إبراهيم : 10 ، فاطر : 1 ، الزمر : 46 ، الشورى : 11 .
8- النبأ العظيم : ص130 .
9- تفسير الميزان : ج1 ، ص442 .
10-المَثل السائر : ج2 ص348 وص 352 ـ 353 .
11- ديوان أبي تمّام : ص274 . والمعترّ : المضطرب لخوف الخطر .
12- انظر الصناعتين : ص175 ، وهامش المَثل السائر : ج2 ص352 ـ 353 .
13-ونحن في مطلع القرن الخامس عشر للهجرة .
14- راجع الكشّاف : ج1 ص222 ـ 223 .
15- راجع معترك الأقران لجلال الدين السيوطي : ج1 ص300 ـ 303 .
16- معترك الأقران : ج1 ص389 .
 الاكثر قراءة في الإعجاز البلاغي والبياني
الاكثر قراءة في الإعجاز البلاغي والبياني
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












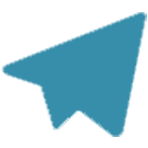
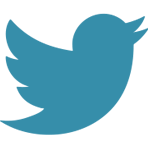

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)