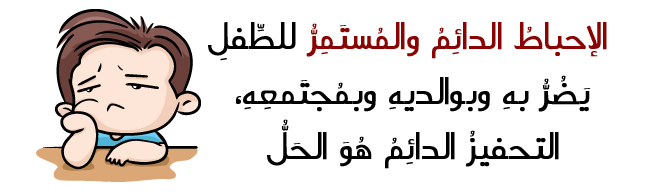
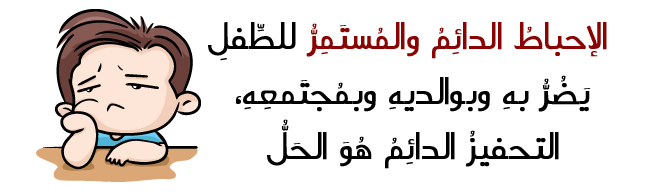

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-10-2014
التاريخ: 3-07-2015
التاريخ: 24-10-2014
التاريخ: 2025-02-15
|
___________________________________________________
أنّ صفاته إمّا ذاتية وإمّا مدحية وإمّا فعلية ، وهي نفس أفعاله تعالى ، والمقصود هنا أنّ فعله بتمامه هل هو حادث أم لا ؟ بل منه ما هو قديم ومنه ما هو حادث ؟ وهذا هو النزاع المعروف بحدوث العالَم وقِدمه .
والمراد بالحدوث هو المسبوقية بالعدم لا بالغير فقط وإن لم يكن مسبوقاً بالعدم ، فإنّه ليس من الحدوث في شيء ، نعم اصطلح الفلاسفة على ذلك ، ولا مشاحّة في الاصطلاح ، فالحدوث عندهم مرادف للإمكان الذاتي ، والحاصل أنّ مرادنا بالحدوث هو معناه الواقعي، وهو المسبوق بالعدم ، والكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأَوّل : في نقل الأقوال:
1 ـ حدوث ما سوى الله وصفاته ، فالأشياء صادرة عنه تعالى بعد أن لم تكن أصلاً ، هذا هو مذهب المتكلّمين قاطبةً ، بل ادّعى غير واحد اتّفاق الملّيين عليه ، بل نُسب إلى جمع من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة ، وقيل : إنّ القول بقِدم العالَم وأزلية الحركات ظهر بعد أرسطو (1) ، و ... أنّ حدوث العالَم بمعناه الواقعي ممّا لم يلتزم به فِرقة غير الشيعة الإمامية ، فيما أعلم .
2 ـ قِدم السماوات بذواتها وصفاتها إلاّ الحركات والأوضاع ، فإنّهما قديمتان بالنوع فقالوا : إنّ الفَلكيات قديمة بموادّها ، وصورها الجسمية والنوعية ، وبمقاديرها وأشكالها ، وغيرهما من الأعراض ، وأمّا العنصريات فقديمة بموادّها وبصورها الجسمية بنوعها ، وبصورها النوعية بجنسها ، وأمّا الصور المشخّصة في هذه الصور الجسمية ، والنوعية ، والأعراض المختصة ، فهي حادثة ، حكي عن أرسطو ، ومَن وافقه ومنهم الفارابي ، وابن سينا وغيرهما .
أقول : ولا شك في أنّهم قائلون بقِدم العقول أيضاً ، بل مرّ التزامهم بقِدم الصور المرتسمة في ذاته تعالى ، التي جعلوها مناط علمه بالأشياء ، وسمّوها بالعلم التفصيلي .
3 ـ قِدم العالم ذاتاً وحدوثه صفةً ، نسب إلى جماعة ، لكن اختلفوا في هذه الذات القديمة فقيل : إنّه ماء ، وقيل : إنّه بخار ، وقيل غير ذلك .
4 ـ ما ذهب إليه صاحب الأسفار ومَن تبعه ، من قِدم العقول وحدوث الطبائع من جهة الحركة الجوهرية ، لكن هذا الحدوث حدوث فردي وليس بنوعي ؛ لئلاّ يلزم انقطاع الفيض وإمساك الجود ، كما صرّح به نفسه والسبزواري في شرح المنظومة ، وعلى هذا القول يتمّ القياس المعروف : إنّ العالم متغيّر ، وكل متغيّر حادث ، ولا يرد عليه حينئذٍ منع الصغرى في الذوات واختصاصها بالصفات .
5 ـ ما ذكره السيد الداماد من حدوث العالّم بأجمعه ، لكنّه حدوث دهري ، وأوضحه السبزواري في شرح منظومته وإليك ملخّصه : إنّ كل موجود فلوجوده وعاء ، أو ما يجري مجراه ، فوعاء السيّالات كالحركات والمتحرّكات هو الزمان سواء كان بنفسه أو بأطرافه ، وما يجري مجرى الوعاء للمفارقات النورية هو الدهر ، وهو كنفسها بسيط مجرّد عن الكمية والاتّصال ونحوها ، وما يجري مجرى الوعاء للحق وصفاته وأسمائه هو السرمد ، فمعنى الحدوث الدهري : أنّ عالَم المُلك (2) مسبوق بالعدم الدهري ؛ لأنّه مسبوق بوجود الملكوت الذي وعاؤه الدهر سبقاً دهرياً .
وإن شئت فقل : إنّ وجود عالم المُلك مسبوق بعدمه الواقعي الفَلكي الواقع في عالم الدهر، بمعنى أنّه ليس بموجود بالوجود الدهري ، فهو حينئذٍ معدوم بذلك الوجود ، بل هو موجود بوجود عالَم المُلك كما قيل ، وهكذا حال الدهر بالنسبة إلى السرمد .
والحاصل : أنّ العالم عنده مسبوق الوجود بالعدم الواقعي الدهري ، لا الزماني الموهوم كما يقول المتكلّم ، ولا العدم المجامع الذي في مرتبة الماهية فقط ، كما ينسب إلى بعض الفلاسفة .
6 ـ ما ذكره السبزواري في شرح المنظومة من الحدوث الأسمى ، وهو غير واضح ، وشرحه بعض الأفاضل بما يرجع إلى نفي العالَم رأساً .
المقام الثاني : فيما استدلّ به لقِدم العالَم :
وهو وجوه لكنّا نذكر أهمّها ، وهو أنّه إذا لاحظنا الواجب أَزلاً في طرف وجميع ما عداه ـ بحيث لا يشذّ عنه شيء ـ في طرف آخر ، فحينئذ إمّا أن يكون الواجب سبحانه علّةً تامة لشيء ما أم لا ، وعلى الأَوّل يلزم قِدم ذلك الشيء المعلول ؛ ضرورة استحالة تخلّف المعلول عن علّته التامة ، وعلى الثاني توقّف وجود الأثر ـ وهو العالَم ـ على شيء آخر ، فهذا مع كونه خُلفاً يرد عليه أنّ هذا الشيء إن كان قديماً فقد ثبت أيضاً قِدم العالَم ، وإن كان حادثاً فلابدّ له من مرجّح حادث ، وإلاّ لكان الحادث غير حادث ، ثمّ ننقل الكلام إلى ذلك المرجّح الحادث في احتياجه إلى مرجّح آخر حادث ، وهكذا إلى غير النهاية ، فيلزم قِدم العالَم من وجود حوادث لا أَوّل لها .
وإن شئت فقل : إنّ العالَم بماله من الشروط الحادثة المذكورة بحيث لا يشذّ عنها شيء ، إذا لاحظنا الواجب إليه فهو إمّا علة تامة له أم لا ، الأَوّل يُثبت المطلوب ، والثاني يوجب نفي وجود العالَم أزلاً وأبداً .
أقول : وهذا أقوى دليلهم في هذا المقام ، وقد أجاب عنه المتكلّمون بوجوه عديدة ، وبجوابات مختلفة ، وإليك بيان بعضها :
الجواب الأَوّل : ما هو المشهور بين المتكلّمين (3) ، من أنّ الفلاسفة إنّما يقولون بقِدم العالَم ؛ لزعمهم لزوم توسّط أمر ذي جهتي استمرار وتجدّد بين الحادث اليومي والقديم ؛ لئلا يلزم التخلّف عن العلة التامّة .
ونحن نقول : إنّه الزمان ولا يلزم القِدم ؛ لكونه أمراً اعتبارياً انتزاعياً ، وأدلة وجوده مدخولة، ولا نقول بانتزاعه من موجود ممكن حتى يلزم القِدم أيضاً ، بل هو منتزع من بقائه تعالى (4) ، فكما أنّهم يصحّحون ربط الحادث بالقديم بالحركة والزمان ، كذلك نصحّحه أيضاً بالزمان ، وكون الزمان مقدار حركة الفًلك ممنوع ، بل نعلم بديهة أنّه إذا لم يتحرّك الفَلك مثلاً ، يتوهّم هذا الامتداد المسمّى بالزمان ، والقول بأنّه لعلّه من بديهة الوهم لا يصغى إليه .
ثمّ إنّ الزمان وإن كان وهمياً إلاّ أنّه ليس باختراعي ، بل هو نفس أمري ؛ ومثل هذا الوهمي يصحّ أن يكون منشأ للأمور الموجودة ، لا بأن يكون فاعلاً لها بل دخيلاً فيها .
وحاصل هذا الجواب : أنّا نختار أنّه ليس في الأزل مستجمعاً لشرائط التأثير .
قولهم : فلابدّ له من مرجّح حادث .
قلنا : هو تمام قطعة من الزمان يتوقّف عليها وجود العالم ، ويرتبط به الحادث بالقديم ، على نحو ما التزمه الفلاسفة في الحركة .
وما قيل : من امتناع انتزاع الزمان من بقاء الواجب ؛ لعدم المناسبة بين الأمر التدريجي وما لا تدريج فيه أصلاً ، وإنّما هو منتزع من الحركة القطعية التي هي أمر تدريجي غير قارّ .
فجوابه : أنّ اعتبار المناسبة المذكورة غير بيّن ولا بمبيّن على نحو الإطلاق ، وعلى فرض تسليمه فهو غير منحصر فيما نفهمه ؛ لاحتمال وجود مناسبة خفيّة علينا ، أَلا ترى أنّ أكثر الانتزاعيات ـ كالزوجية والفردية والفوقية والتحتية وغيرها ـ يُنتزع من محالّها ، ولا يحكم وجداننا بتحقّق مناسبات تفصيلية بين كلّ منتزع وما يُنتزع منه ؟
لا يقال : البقاء ينتزع من الزمان فلو عُكس لدار .
فإنّه يقال : إنّ الزمان المزبور يُنتزع من نفس وجود الواجب الذي لا يعرضه العدم ، فتوقّف البقاء عليه لا يستلزم محذوراً .
فإن قلت : لو انتزع الزمان منه لكان صفةً له ، كما هو شأن سائر ما يُنتزع منه ، مثل العلم والإرادة والقدرة والخلق وغيرها ، مع أنّه لا يتّصف به لا بالحمل مواطاةً وهو ظاهر ، ولا اشتقاقاً فإنّه ليس بزماني .
قلنا : لا نسلّم أنّ كلّ ما يُنتزع من شيء يجب أن يكون صفةً له ؛ لأنّ مناط الوصفية هو وجود العلاقة الناعتية بينهما ، واستلزام الانتزاع لهذه العلاقة غير بيّن ولا بمبيّن ، ولو سلّم فنقول : إنّ ما ورد من أنّه تعالى ليس بزماني ولا بمكاني معناه : أنّه كما لا يحيط به مكان حتى يكون ظرفاً له مشتملاً عليه ، كذلك لا يحيط به زمان حتى يتقدّم عليه جزء من ذلك الزمان ، ويتأخّر عنه جزء آخر منه ، فيكون وجوده مقارناً لحدّ خاصّ من الزمان مسبوقاً بحدّ آخر منه خالٍ عن وجوده .
وأمّا مقارنة الحقّ القديم للزمان ، وتحقّقه معه في نفس الأمر من الأزل إلى الأبد ، فلا شكّ في صحّته ووقوعه ، وهذا المقدار كافٍ فيما نحن بصدده .
وأمّا عدم اتّصافه بالمكان ؛ فلعدم تحقّق كلا المعنيين المفروضين في الزمان هناك ، فليس المكان محيطاً به ولا مقارناً له ، ثمّ إنّ ما ورد شرعاً ، من أنّه قديم أزلي سرمدي أبدي دائم وغيرها ، يشهد بأنّه تعالى زماني بالمعنى الثاني ، وليس فيه مانع .
الجواب الثاني : ما استظهره المجلسي قدّس سره من أكثر قدماء الإمامية واختاره هو أيضاً وقال : إنّه في غاية المتانة ، وهو مبني على عدم صحّة انتزاع الزمان منه تعالى ، وعلى أنّه ليس بزماني مطلقاً .
ومحصّله : أنّا لا نسلّم تخلّف المعلول عن العلّة في فرض حدوث العالَم ، فإنّ التخلّف إنّما يتصوّر لو كان العلّة زمانيةً ، ووجدت العلّة في زمان ولم يوجد المعلول معه في ذلك الزمان ، وهنا لعلّ العلّة والمعلول كليهما لم يكونا زمانيين ، أمّا العلّة فانتفاء الزمان عنها واضح ، وأمّا المعلول فالكلام في الصادر الأَوّل ، وهناك لم يوجد زمان ولا زماني أصلاً .
وبالجملة : إذا كانت العلّة والمعلول كلاهما زمانيين يجب أن يجمعها آن أو زمان ، وإلاّ فلا ، ونظيره التخلّف المكاني ، فإنّه لو كانا مكانيين يتصوّر الاجتماع والافتراق والمماسة واللامماسة، وأمّا إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مكانيين لم يتصوّر أمثال هذه الأُمور ، وكذا إنّما يتصوّر الترجيح بلا مرجّح ، إذا تحقّق زمان وقع أمر في جزء منه دون جزء ، وصدر المعلول عن العلّة مرّة ولم يصدر مرة أُخرى ، فإذا فرضنا الزمان معدوماً ، فلا يجري فيه أمثال هذه الأوهام الكاذبة الحاصلة من الأُلفة بالزمان والمكان .
فصاحب هذا القول يقول : بأنّ الزمان والحركات وسلسلة الحوادث كلّها متناهية في طرف الماضي ، وأنّ جميع الممكنات ينتهي في جهة الماضي في الخارج إلى عدم مطلق ولا شيء بحت ، لا امتداد فيه ، ولا تكمّم ، ولا تدريج ، ولا قارية ، ولا سيلان .
ويقرب من هذا القول أو يرجع إليه ، ما أفاده المحقّق الطوسي قدّس سره في تجريده .
ومحصّله : أنّ الحدوث اختصّ بوقت الإحداث ؛ لانتفاء وقت قبله ، فلا معنى لطلب الترجيح فيه.
أقول : لكنّ السؤال يتوجّه إلى نفس الوقت المذكور ، وأنّه لِمَ وجد في هذا الحدّ دون سابقه؟ إلاّ أن يقال : لا تدرّج ولا امتداد قبل الوقت المذكور حتى يُسأل عن الترجيح ، فتأمل .
الجواب الثالث : ما قيل من عدم تحقّق جميع ما لابدّ منه في وجود العالم في الأزل ، إذ من جملته تعلّق الإرادة بوجوده في الأزل ، ولم تتعلّق الإرادة بوجوده في الأزل ، بل وجوده فيما لا يزال من الأوقات الآتية ؛ لحكمة ومصلحة .
الجواب الرابع : النقض بالحادث اليومي ، فإنّ هذا الوجه لو تمّ لأبطل الحادث مطلقاً ، إذ نقول حينئذٍ : هل الواجب علّة تامّة لشيء ما أم لا ؟ فعلى الثاني ينتفي العالَم ، وعلى الأَوّل نأخذ الصادر الأَوّل ، ونقول : الواجب مع هذا الصادر إمّا أن يكون علّةً تامّة لشيءٍ ما ممّا عداهما أم لا ، ويلزم قِدم الصادر الثاني ، وهكذا ينتهي إلى الحادث اليومي فيدخل في سلسلة القدماء ، وهذا خلف .
الجواب الخامس : ما ذكره المستحلّون للترجيح بلا مرجّح ، من أنّ الفاعل المختار يتمكّن من إيجاد فعل بلا مرجّح وداعٍ .
إلى غير ذلك من الأجوبة التي لا حاجة إلى نقلها .
لكنّ الخامس باطل كما ... في مبحث الترجيح بلا مرجّح ، وقد عرفت أنّ الحقّ هو التفصيل الثاني .
والرابع فيه بحث طويل الذيل .
والثالث ممنوع ؛ إذ الامتداد الوهمي المذكور عدم بحت ، لا تأثير له في توليد المصلحة في طرف المفعول ، فإن كان أصلح فهو كذلك أزلاً ، فلا يُقاس بالحوادث الزمانية التي يختلف صلاحها وفسادها باختلاف الزمان .
والثاني يصعب قبوله ؛ إذ بعد تمامية فاعلية الواجب ، وكونه علّةً تامّة ، لا يتصوّر تخلّف المعلول عنه ، وقدماء الإمامية لم يثبت منهم تجويز هذا المعنى ، وعبارة المجلسي المتقدّمة أيضاً غير ظاهرة حقّ الظهور في هذه النسبة إليهم ، بل الظاهر منها هو نفي الزمان الموهوم عنه تعالى ، فلاحظ .
والأَوّل أُورد عليه ، بامتناع انتزاع الأمر التدريجي عن مَن هو بريء من التدرّج والسيلان ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الوجهين المذكورين ـ الأَوّل والثاني ـ وإن لم يكونا بثابتين، لكنّهما يوجبان الاحتمال المنافي للدليل... فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
تحقيق وتفنيد :
هذا الذي ذكره الفلاسفة ، وتشعّب المتكلّمون في جوابه إلى شعب ، مجرّد تلفيق لا واقع له أصلاً ، بل السؤال المذكور فيه غلط لا مسرح له في المقام .
توضيح ذلك : أنّ ما عنه التأثير على قسمين : الفاعل المختار والعلّة الموجبة ، والأَوّل كالحيوان ؛ إذ له أن يفعل وله أن لا يفعل ، والثاني كالأسباب الطبيعية ، والسؤال المذكور في الدليل المزبور إنّما يتمشّى على الثاني ، فإنّ المؤثّر الطبيعي إمّا علّة تامّة ، كالنار بالنسبة إلى الحرارة ، والشمس بالنسبة إلى النهار ، وإمّا ليس كذلك بل مقتضٍ له يتوقّف تنجّز أثره على شرط أو أمر آخر ، كالنار بالقياس إلى الإحراق ، والشمس إلى التسخين ، وأمّا الفاعل المختار فمهما بلغ شوقه إلى إيجاد الفعل الملائم له فهو متمكّن من الفعل والترك ، ولا يجب الفعل عنه أصلاً ، فإنّ الوجوب السابق باطل في أفعاله ، فالفعل موقوف على إعمال قدرته لا على شوقه .
إذا تقرّر ذلك فنقول : إنّا قد قرّرنا سابقاً أنّ الله تعالى ليس بعلّة موجَبة بفتح الجيم ، وحقّقنا أيضاً أنّ إرادته ليست هو علمه بالأصلح ، أو نفس ذاته ابتداءً ، بلا رجوعها إلى العلم ، بل هي حادثة؛ فحينئذٍ له أن فعل وله أن لا يفعل ، والسؤال المذكور لا مجرى له في حقّه تعالى كما عرفت، ولنا أن نختار كلاًّ من الشقين فنقول : إنّه تعالى كان مستجمعاً لجميع شرائط التأثير ، وعلةً تامة ، بمعنى أنّه غير محتاج إلى شيء بحيث إن شاء لفعل ، أو نقول : إنّه ليس مستجمعاً لشرائط التأثير ، وليس بعلّة تامة ، ونعني به أنّ الفعل غير صادر عنه ؛ لأنّه لم يرده ولا يمكن صدوره عنه اضطراراً وإيجاباً .
فهذا السؤال ـ بعد تمهيد الأُصول السالفة الحقّة من اختياره تعالى وحدوث إرادته ـ ممّا لا مجال له أبداً من جهة الحكمة النظرية وأحكام العقل العلمية ، نعم يمكن أن يقرّر الاستدلال من وجهة الحكمة العملية فيقال : الواجب وإن كان مختاراً غير أنّ إهمال الأصلح أو الصالح قبيح منه ، وهو لحكمته البالغة لا يفعله وإن كان قادراً عليه ، بل مرّ أنّ صدور الأكمل أو الكامل لازم عنه، فهذا السؤال له وجه ولا يدفعه الوجوه المتقدّمة ، كما هو مسلّم عند مَن أنصف من نفسه .
ولكن هؤلاء القوم لو تركوا العصبية والعناد ، وامتنعوا من السب والطعن ، وأسكتوا غضبهم لنجيبهم ، بأنّ قِدم الممكن ممتنع ، والممتنع المحال لا يعقل صدوره عن الواجب؛ إذ لا قابلية له لتعلّق القدرة الكاملة العميمة الواجبة به ، فأين ترك الجود وإمساك الفيض؟ وأين البخل ؟ ومع الغض عمّا قلناه آنفاً أين تخلّف المعلول عن العلّة ؟ فإنّ الشيء إذا كان ممتنع الوجود لا يصير معلولاً أبداً ، وهذا ظاهر .
وهذا الجواب يكفي لإبطال جميع الوجوه المستدلّ بها على قِدم العالَم .
_______________________
(1) البحار 14 / 49.
(2) وهو عالَم الناسوت ويقال له : عالم الشهادة أيضاً .
(3) السماء والعالَم / 57.
(4) هذا هو المسمّى بالزمان الموهوم ، وهو الامتداد الموهوم المنتزع من بقاء الواجب ، وأمّا الزمان المتوهّم فهو الامتداد الموهوم غير المنتزع من بقاء الواجب ، فالموهوم ما لا فرد لا يحاذيه ، ولكن له منشأ الانتزاع ، والمتوهّم ما لا فرد له ولا منشأ لانتزاعه ، ويجعلون هذا الزمان وعاءً لعدم العالَم ، فيقولون : إنّ العالَم حادث زماني وليس بقديم .



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|