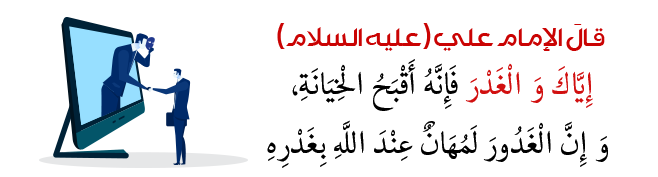
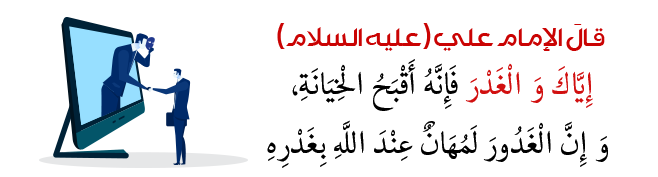

 الحياة الاسرية
الحياة الاسرية 
 المجتمع و قضاياه
المجتمع و قضاياه
 التربية والتعليم
التربية والتعليم |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-6-2018
التاريخ: 11-5-2022
التاريخ: 3/11/2022
التاريخ: 19-6-2016
|
1- إن ترتّب الثواب والعقاب هو من لوازم ومقتضيات العدالة، وبما أن العدالة مبدأ ثابت راسخ في الإسلام، لذا فإن الثواب والعقاب أمر ثابت كذلك، من هنا كان الإيمان بالمعاد واليوم الآخر والحساب كأصل من أصول الدين على قاعدة أنه لتجزى كل نفس بما كسبت وأنه ليس من العدالة أن يكون جزاء المحسنين والظالمين واحداً: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18].
2- إن ترتب الثواب والعقاب أمر متوقف على التقويم فليس اعتباطاً أن يتم إثابة جهة أو عقوبتها، وإن مقتضى العدالة أن يتم الحساب والتقويم قبل حصول الإثابة أو العقوبة، كما أن من لوازمها (أي العدالة) أن يكون الجزاء متناسباً مع الفعل: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60]، {ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى} [النجم: 41].
3- إن التقويم يجب أن يحصل وفق معايير وقواعد في الإسلام، هذه المعايير هي المبادئ والقيم والأحكام الإسلامية. أي أن المعيار الأساسي هو مستوى الالتزام أو الانحراف عن الأوامر الإلهية في كل المراتب والمستويات من الاعتقادات الأساسية وصولاً إلى السلوكيات الجزئية. وعليه فإن أي عملية تقويم يجب أن تلحظ الأهداف المقررة في التعليم، أي الكفايات التعليمية الممنهجة بحسب المراحل العمرية، وإن أي عملية تقويم تربوية يجب أن تقوم على منظومة القيم المقررة من صاحب الشريعة أو النظرية، فلو كان العمل صالحاً تبعاً لمنظومة القيم، فلا بد من الجزاء، وإن كان سيئاً تبعاً لنفس المنظومة، فلا بد من العقوبة.
والله سبحانه وتعالى لم يضع الثواب والعقاب للتشفي أو للعبث، فهو سبحانه يقول: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا} [النساء: 147].
أي أن العقاب ليس مطلوباً لذاته، وليس الله بحاجة إليه بصفة ذاته، فما هي الفائدة التي يحصل عليها الحق تعالى لو عذب الناس؟ وأين يضع هذا العذاب وعلى أي رصيد يضيفه (مادياً أو معنوياً)؟ فليس من فائدة خاصة للحق من العقاب سوى أن يعدل بين الناس، وأن يكون الناس متساوين في معادلة الصح والخطأ والسلب والإيجاب، وفق المعايير الموحدة التي تتضمن العدالة في الحساب والتقويم، ولاحقاً العدالة في الحكم والجزاء.
4- إن الحساب والتقويم يتفاوت تبعاً للفئة العمرية وللقدرة على تحمل المسؤوليات؛ فالتكليف متفاوت على أساسها، وكذلك التقويم؛ لأن التقويم ناتج المسؤولية وتحمل المهام والوظائف. فلو كان الإنسان مريضاً يسقط عنه تكليف ما فيسقط عنه الحساب عليه، فليس على الأعمى حرج، ولا على المريض، ولا على الأعمى في موضوع الجهاد، فيسقط التكليف ومعه الحساب وكذلك المستضعفون من الرجال والنساء والولدان لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، فهؤلاء أيضاً ما عليهم من سبيل.
فالعذاب متوقف على المسؤولية وهي على القدرة، والأخيرة على البلاغ والحجة: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، أي أن الانحراف عن منظومة المبادئ لا يؤدي إلى العذاب حكماً إذا لم تكن هذه المبادئ قد وصلت فعلاً إلى المكلف وسمع بها ووعاها عبر رسول ونبي أو وصي أو حجة فلا عقاب بلا بيان بحسب ما ورد في النصوص واقتضاء العقل وبنى عليه المنطق السليم والعدالة).
وعليه فإن التقويم (القائم على المعايير والمبادئ المقررة) يتفاوت تبعاً لمستويات التكليف المرتبطة بالقدرات والمرتبطة أيضاً بالحجة والبلاغ.
فلو كانت المشكلة في المعلم المربي الذي لا يستطيع أن يوصل الكفايات التعليمية فلا يمكنك أن تحاسب الطفل فضلاً عن أن تعاقبه لأنّ الحجّة لم تتم، والتبليغ لم يحصل؛ فالنبي موسى (عليه السلام) كان يدعو ربه: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: 27، 28]، كما أنه تقوّى بأخيه هارون من أجل البيان وقدرته الإضافية حتى لا تبقى معذرة في البلاغ للناس، وعليه قبل الحساب يجب أن ننظر في أصل المشكلة، وهل هي في المعلم العاجز أو القاصر أو المقصر عن إيصال المعلومات أو عن التربية والإرشاد؟
فلو كانت المشكلة في الكفايات وعدم قدرة الطفل أو الفتى على تقبلها أو تحملها لعسرها وصعوبتها فالأمر أيضاً يتطلب التوقف وعدم المباشرة في عملية التقويم ونتائجها الثواب والعقاب لأن العسر والصعوبة مشابهان للعجز عن القيام بالتكليف الذي يُسقط الواجب فيسقط معه العقاب أي التقويم. فالسبيل على القادر وليس على القاصر.
من هنا فإن عملية التقويم يجب أن تخضع للضوابط الآتية:
ـ أن تكون وفق معايير محددة مرتبطة بالأهداف وهي في الإسلام منظومة التكاليف الإلهية التي تتفرع في مهام ومسؤوليات ووظائف شرعية.
ـ أن تكون مبنية على وصول الحجة ولزومها من خلال حسن الدعوة والتبليغ للأهداف.
ـ أن تكون مبنية على أنّ الأهداف المصوغة منهجياً متناسبة مع المستويات العمرية ومع القدرات البشرية بحسب الفئة.
ـ أما المؤشر القرآني على الأول فهو التفصيل والتعريف والتمييز المتواتر في القرآن بين من آمن وعمل صالحاً وكان له جنات الفردوس جزاءً وثواباً، وبين من كفر وضل وأشرك وعمل طالحاً ومفسداً وكانت له جهنم عقاباً ووبالاً وساءت مصيراً.
- والمؤشر القرآني على الأمر الثاني، {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [المائدة: 92].
{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الفتح: 8].
- المؤشر القرآني على الأمر الثالث، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286].
{وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 41، 42].
ومن جملة الأمثلة القرآنية على موضوع الثواب والعقاب:
ـ في موضوع الثواب
قصة بقرة بني إسرائيل، التي وردت في القرآن، وكانت شاهداً على ظلم بني إسرائيل، والتي جازى بها الحق تعالى أولئك القوم بتعجيزهم لكثرة متطلباتهم وقلة طاعتهم وولايتهم، ويقال إن هذه البقرة كانت لغلام من بني إسرائيل وإنه كان باراً بوالديه وإنه كان يملك هذه البقرة لوحدها فاضطر بنو إسرائيل أن يشتروها من ذلك الغلام بأبهظ الأثمان لحاجتهم الماسة إليها والذي ألجأهم إلى هذه الحاجة هو الله سبحانه الذي يعلم حقيقة الفتى وحقيقة بره بوالديه (وبر الوالدين من منظومة القيم، وهي من المعايير الأساسية للتقويم بحسب النظرية القرآنية).
ـ قصة السيدة مريم (عليها السلام) والتي أحصنت فرجها وعفت عن المحارم، فنفخ الله فيها من روحه ووهبها كلمته عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وسيداً وحصوراً من الصالحين.
{وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 91]، فالفاء للنتيجة والعلة المرتبة على التحصين للفرج (وهو من معايير التقوى المشتقة من مبادئ الإسلام).
- قصة أم موسى (عليه السلام) التي صبرت على فراق رضيعها مع شدة الشوق إليه امتثالاً لأمر الله، فأعاده الله إليها مصوناً من كل سوء وسخر له عدوّه المتربص به شراً لكي يحفظه ويربيه ويرعاه (الصبر من المعايير المشتقة من المبادئ).
ـ في موضوع العقاب (القصص الفردية والأخرى الجماعية)
من القصص الفردية:
- قصة بلعم بن باعورة، الذي ورد ذكره في: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: 175، 176].
والشخص المذكور كان يعلم أسرار الاسم الأعظم، وسولت له نفسه أن يستخدم هذه الأسرار في الدعاء على نبي الله موسى (عليه السلام) ابتغاء الدنيا (اخلد إلى الأرض) وفي ذلك انحراف عن المعايير المبدئية المشتقة من المبادئ والقيم الإسلامية، فكان لا بد من العقوبة.
- قصة السامري: الذي أضل قوم موسى وأدخل في قلوبهم حب العجل وحاول قطع طريق الصلاح أمام بني إسرائيل والحؤول دون أن يصل موسى إلى هداية قومه، فعاقبه الله تعالى في قوله: {قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا} [طه: 97]، فطرده وعاقبه بإبقائه على الأرض دون إمكانية مقاربته الإنس.
- قصة قارون: والاستكبار والعلو في الأرض والمرح والاطمئنان إلى الدنيا وإلى مالها وزخرفها وامتطاء الثروة من أجل الاستعباد والإذلال والتكبر والتعجرف، وهذا مخالف للمبادئ والقيم، وهو شخص مدرك مسؤول، ويتحمل عاقبة أعماله، فالنتيجة هي العقاب، {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ} [القصص: 81].
ومن القصص المرتبطة بالأمم وعقوباتها:
ـ قصة قوم نوح مع الطوفان: الذين لم يؤمنوا بعد نحو من ألف عام بل استكبروا واستهزؤوا بآيات الله.
ـ قصة قوم هود (عاد) مع الريح الصرصر العاتية، نتيجة استكبارهم وطغيانهم وجحودهم وكفرهم بآيات الله.
- قصة قوم صالح (ثمود) مع الصيحة، بعد أن رفضوا أمر الله وخالفوه وعقروا الناقة التي أوجب الله لها النهل والشرب من ذلك المعين فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها..
- قصة قوم شعيب مع الخسف والتدمير بعد أن أخسروا الميزان والمكيال وبخسوا الناس أشياءهم وغشوا وأفسدوا.
- قصة قوم لوط مع الأعاصير والأمطار والوحل، بعد أن خالفوا حدود ما أحل الله وتعدوا الفطرة إلى الشذوذ والانحراف.
- قصة قوم موسى (بني إسرائيل) مع الضفادع والقمل والدم ومع المسخ بفعل الكفر المتواصل، والجحود وكثرة الإلحاح على الله والاعتداء على أنبيائه وقتلهم لهم وصدهم عن سبيل الله، وقتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس، وغيرها من المفاسد والمساوئ والرذائل والآفات.
وإذا عدنا إلى كل العقوبات التي نالتها أمم سابقة طاغية ظالمة، مفسدة، نجد أنها نالت تلك العقوبات بفعل انحرافها عن المعايير الإلهية المقررة في الشرائع السماوية وفي رسالات الله سبحانه وبالتالي فالعقوبة لم تكن اعتباطية بل هي نتيجة تقويم مبني على معايير تفرضها طبيعة المبادئ المقررة.



|
|
|
|
الصين.. طريقة لمنع تطور قصر النظر لدى تلاميذ المدارس
|
|
|
|
|
|
|
ماذا سيحدث خلال كسوف الشمس يوم السبت؟
|
|
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الدينية يختتم محاضراته الرمضانية في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)
|
|
|