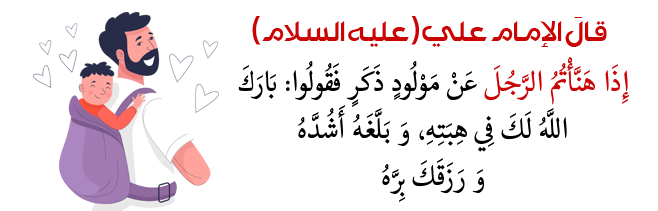
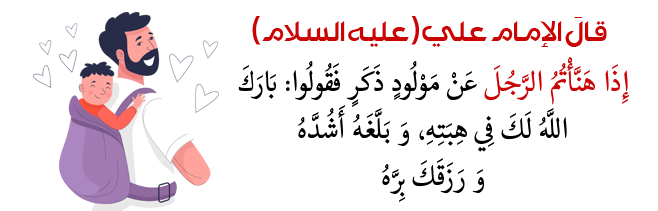

 التاريخ والحضارة
التاريخ والحضارة
 اقوام وادي الرافدين
اقوام وادي الرافدين 
 العصور الحجرية
العصور الحجرية 
 الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق 
 العهود الاجنبية القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق 
 احوال العرب قبل الاسلام
احوال العرب قبل الاسلام 
 مدن عربية قديمة
مدن عربية قديمة
 التاريخ الاسلامي
التاريخ الاسلامي 
 السيرة النبوية
السيرة النبوية 
 الخلفاء الاربعة
الخلفاء الاربعة
 علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
 الدولة الاموية
الدولة الاموية 
 الدولة الاموية في الشام
الدولة الاموية في الشام
 الدولة الاموية في الاندلس
الدولة الاموية في الاندلس
 الدولة العباسية
الدولة العباسية 
 خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
 خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
 عصر سيطرة العسكريين الترك
عصر سيطرة العسكريين الترك
 عصر السيطرة البويهية العسكرية
عصر السيطرة البويهية العسكرية
 عصر سيطرة السلاجقة
عصر سيطرة السلاجقة
 التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر
 التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
 تاريخ الحضارة الأوربية
تاريخ الحضارة الأوربية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-1-2020
التاريخ: 2024-10-30
التاريخ: 5-6-2020
التاريخ: 2023-08-25
|
الجانب السياسي
لقد مر بنا القول بأن فلسفة الحكم عند الإمام أخلاقية في جوهرها. فيصيح على هذا الأساس جانبها السياسي تطبيقاً لجوهرها الأخلاقي في مجال الإدارة العامة من حيث علاقة الحكومة بالشعب ومن حيث علاقة أفراد الشعب ببعضهم وبالحكومة.
كما يصبح جانبها المالي سائراً في الاتجاه السابق نفسه فيما يتصل بالثروة العامة من حيث إنماؤها وتوزيعها واستهلاكها.
ويتلخص جوهر سياسة الإمام من الناحية السياسية في إشاعة العدل بين الناس في شتى ضروب الحياة وفي مختلف المجالات الاجتماعية.
والعدل عند الإمام أفضل من الشجاعة (لأن الناس لو استعملوا العدل عموما في جميعهم لاستغنوا عن الشجاعة).
والمراد بالشجاعة في هذا الباب القوة المادية المتمثلة في الجسم أو المال أو السلاح أو النفوذ عندما يستعين المرء بذلك لاسترداد حق مهضوم أو لاغتصاب حق من حقوق الناس.
ويلجأ الإنسان في العادة إلى هذا التصرف إذا فقد العدل وانعدم ناصروه ومنفذوه. ويتجلى ذلك بأوضح أشكاله في عالم الحيوان وفي المجتمعات البدائية وفي الحالات التي ينعدم فيها تطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات الراقية الحديثة.
والعدل عند الإمام يحتاج إلى تعهد ورعاية في اتباعه وفي قبوله.
وهو يحتاج كذلك إلى ضبط النفس وجلد وبخاصة في تحمل مضضه عند الشخص الذي يطبق عليه. لأن الإنسان في العادة يميل - بطريقة لا شعورية أحياناً - إلى عدم إلزام نفسه في اتباع الحق - في القول وفي العمل - إذا كان في دم الإلزام.
هذا ما يخدم مصالحه أو مصالح من يعطف عليهم من الناس. وربما وقف موقف المحايد أو عدم المكترث بالباطل والحق في الحالات التي لا تتعلق به من قريب أو بعيد.
أما إذا كان الأمر متصلا بمصالحه الخاصة أو بمصالح من يعطف عليهم فإن عدم اتباع الحق - كما يبدو له - يصبح مثار نقمته وامتعاضه وتحديه. على أن كثيراً من الناس يميلون - بطريقة غير مقصودة أحياناً - إلى اظهار الباطل بمظهر الحق لإحراز نفع، أو لتجنب ضرر محتمل الوقوع.
وسبب ذلك على ما يبدو هو أن ظهور الشخص بمظهر الباطل - بشكل مكشوف وصريح - لا يضمن حصوله على المنافع ولا يدفع الأضرار عن طريقه في كثير من الأحيان. يحصل هذا حتى في المجتمعات التي ينعدم فيها تطبيق الحق على تصرفات المواطنين. لأن الاعتراف بالتزام الحق (بغض النظر عن نوعه) من الناحية النظرية أمر مسلم به في جميع المجتمعات البشرية المعروفة قديماً وحديثاً.
والعدل عند الإمام (صورة واحدة والجور صور كثيرة. ولهذا سهل ارتكاب الجوز وصعب تحرى العدل. وهما يشبهان: الإصابة في الرماية والخطأ فيها. وإن الإصابة تحتاج إلى تعهد ورعاية والخطأ لا يحتاج إلى شيء من ذلك).
والعدل عند الإمام ينتظم الناس جميعاً - مسلمين وغير مسلمين، عرباً وغير عرب حكاماً ومحكومين -. لأن الناس بنظر الإمام صنفان:
(إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).
أخ لك في الدين يعني مسلماً عربياً أو غير عربي، ونظير لك في الخلق يعني: إنساناً مثلك بغض النظر عن دينه وجنسه.
ويجمل بنا أن نذكر هنا: أن أحب شيء للإمام هو تطبيق العدل بين المواطنين. وكانت الخلافة بنظره إحدى الوسائل الفعالة التي تعينه على تطبيق ذلك العدل بأوسع مدى ممكن.
ويتجلى شعور الإمام بضرورة تطبيق العدل على الناس بأروع أشكاله - قبل أن تنتقل إليه الخلافة، وبخاصة في شطر من خلافة عمر وفي أغلب سنى خلافة عثمان - إذا تذكرنا أن الإمام كثيراً ما كان يتولى بنفسه تطبيق حدود الله على المستحقينكلما قصر الخليفة القائم عن ذلك أو تهاون فيه.
وفي التاريخ الإسلامي - بين وفاة الرسول ومصرع ابن عفان - أمثلة كثيرة في هذا الباب.
ذكرنا أن الخلافة لم تكن بنظر الإمام وسيلة الأبهة أو الإثراء غير المشروع أو مجالا لتوزيع المناصب والجاه والنفوذ على الأصهار والأتباع وذوى القربى.
وإنما هي مجال يتسنى به للإمام أن يطبق العدل على المواطنين.
وقال ابن عباس: دخلت على علي بذي قار وهو يخصف نعله.
فقال لي ما قيمة هذه النعل؟ فقلت لا قيمة لها، فقال: والله لهى أحب إلى من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلا).
وكتب على إلى سهل بن حنيف:
(أما بعد: فقد بلغني أن رجالا من قبلك يتسللون إلى معاوية. فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم... قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه. وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة فهربوا إلى الإثرة... إنهم والله لم يفروا من جور ولم يلحقوا بعدل).
فإذا كانت الغلبة تعنى كثرة الأتباع على الباطل - وهي ليست كذلك بالطبع - (فاختر أن تكون مغلوباً وأنت منصف ولا تختر أن تكون غالباً وأنت ظالم).
فأفضل شيء بنظر الإمام إطفاء باطل وإحياء الحق (فلا يكن أفضل ما نلت من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن: إطفاء باطل وإحياء حق.
وليكن سرورك بما قدمت من ذلك وأسفك على ما خلقت منه.
وموقف الإمام هذا - كما ذكرنا - ينتظم الرعية جميعاً: عرباً وغير عرب، مسلمين وغير مسلمين.
أما ما يتصل بالمسلمين (العرب وغير العرب) فيتضح موقف الإمام تجاههم بقوله: (ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم... والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. وليسبقن سابقون كانوا قصروا، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا). ليأخذ كل ذي حق حقه وفق نصوص القرآن والسنة النبوية.
وهذا لا يتم بالطبع إلا إذا أعيد النظر في علاقات المسلمين ببعضهم وبالخليفة وفق ما ذكرناه.
وهذا يعني - من الناحية السلبية - القضاء على كل ما لا يتفق مع ذلك مما حصل عليه بعض المسلمين - على حساب غيرهم أو على حساب الدين - في الفترة التي تقع بين وفاة النبي ومقتل عثمان بن عفان.
فالحق عند الإمام هو الشيء المشروع الذي يستحقه الشخص وإن لم يتمتع به من الناحية العملية الواقعية نتيجة لسوء تصرف الحكام، أي إن الحق بنظر الإمام (دي جوري) كما يعبر عن ذلك المشرعون الحديثون. والباطل بنظره يشمل (من جملة ما يشمل) حقوقاً اكتسبها بعض الناس بطريقة غير مشروعة. فهو بنظره: (دي فاكتو) كما يقول: المشرعون. أي أن تطبيق الحق بنظر الإمام له أثر رجعي.
قال علي (فيما رده على المسلمين من فظائع عثمان:
والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته. ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق).
وأما موقفه من غير المسلمين فقد كان يجري ضمن الإطار الذي وصفناه. وتتجلى روعة ذلك الموقف إذا تذكرنا قوة إيمان الإمام بمبادئ الدين الإسلامي واعتباره إياه أرقى الأديان. ولعل إيمانه العميق بذلك هو الذي جعله يقف من غير المسلمين ذلك الموقف العادل المعروف.
قال علي: (من آذى ذمياً فكأنما آذاني). أي إن من اعتدى على يهودي أو مسيحي - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل مادي أو معنوي - فكأنما اعتدى على جوهر الإسلام المتمثل بالإمام آنذاك.
وفي هذا الموقف من الروعة في اتباع العدل ما يعجز عن وصفه البيان.
ثم علل الإمام موقفه من أولئك الناس بقوله: (إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا) يجري عليهم ما يجري علينا من الحقوق والواجبات العامة.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية من الناحية السياسية وضع الإمام شروطاً خاصة لتكوين الجهاز الحكومي وتعيين وابجاته العامة تجاه الشعب. والأساس الذي يرتكز عليه الجهاز الحكومي هو من الناحية الإدارية كما قال الإمام:
(لا تقبلن في استعمال عمالك وأمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفاءة والأمانة.) هذا من جهة الحاكم
أما أنت - أيها المواطن - فمن النقص عليك (أن يكون شفيعك شيئاً خارجاً عن ذاتك وصفاتك.) وأنت - أيها الحاكم - أنظر مرة أخرى - في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً. ولا تولهم محاباة وإثرة فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة) فيجب ألا يتم تعيين الموظف محاباة له أو لمن يشفع فيه، ولا إنعاماً عليه، لأنهما - أي المحاباة والإثرة - جماع من شعب الجور والخيانة. ومعنى ذلك كما يقول ابن أبي الحديد إن هذا النوع من التعيين (يجمع ضروباً من الجور والخيانة:
أما الجور فإنه - أي الحاكم - يكون قد غدل عن المستحق. ففي ذلك جور على المستحق.
وأما الخيانة: فلأن الأمانة تقضي تقليد الأعمال الأكفاء. فمن لم يعتمد ذلك فقد خان من ولاه.) على أن الأمر - على ما نرى - أبعد أثراً مما ذكره ابن أبي الحديد.
فالجور في هذا الموضوع - لا يقتصر على عدول الحاكم في التعيين عن المستحق إلى غير المستحق فقط وإنما هو يمس غير المستحق في الصميم. فقد حل غير المستحق - على حد تعبير يحيى بن خالد (محل من نهض بغيره. ومن لم ينهض بنفسه لم يكن للعمل أهلا).
يضاف إلى ذلك إن هذا الموظف - إذا ما قصر عن أداء واجبه أو خانه - عرض نفسه للفصل والعقاب. فكأن تعينه - محاباة أو إثرة - قد مهد السبيل إلى إقصائه عن الخدمة وتطبيق حدود الله عليه في حالة الخيانة.
ولكن الأمر مع هذا كلّه يتعدى ضرره المستحق وغير المستحق فينظم المصلحة العامة ومصالح المواطنين - الذي يعنيهم الأمر - على السواء.
هذا ما يتصل بموضوع الجور في تعيين الموظفين على أسس غير أسس الكفاءة والأمانة.
أما الخيانة فينطبق عليها ما ذكرناه. لأن من لم يعتمد تقليد الأعمال الأكفاء فقد خان من ولا وخان من ولى عليهم وخان المستحق وغير المستحق على السواء.
وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول:
لقد وضع الإمام الذي عاش قبل زهاء أربعة عشر قرناً مقياساً للتوظيف لم يصل إليه أرقى القوانين في المجتمع الغربي الحديث. فلم يكتف الإمام بأن تسند الوظائف الحكومية لذوى الكفاءة والاختصاص - دون غيرهم - بل أضاف إلى ذلك جانباً آخر لا يقل أهمية عن الكفاءة هو الأمانة ونزاهة النفس.
فالموظف الكفؤ (غير الأمين) قد يتجاوز ضرره الاجتماعي ضرر الموظف غير الكفؤ: فيتخذ من كفاءته وسيلة لإتقان فن الخيانة، وإتقان فن التواري عن الأنظار من جهة، وإتقان فن التباكى على المصلحة العامة من جهة أخرى.
أما الموظف الأمين غير الكفؤ فيكون ضرره الاجتماعي - في حالة وقوعه - غير مقصود في العادة من جهة وغير موجه نحو الناس على حساب بعض آخر من جهة أخرى.
والخيانة (بنظر الإمام) تشمل من يتعاطاها بشكل مباشر بقدر ما تشمل من يعطف على من يتعاطاها أو يغض النظر عنه. ولهذا قال الإمام:
(كفاك خيانة أن تكون أميناً للخونة)
لقد مر بنا القول بأن مقياس التوظيف عند الإمام هو الكفاءة والأمانة. ترى ما الكفاءة؟ وما الأمانة؟ بنظر الإمام؟ وكيف نقيس كلا منهما؟ وللإجابة عن السؤال الأول نقول:
إن الكفاءة هي قدرة الشخص على إنجاز الواجب الذي يسند إليه بشكل مرضى. وتقاس الكفاءة في العادة بالدراسة والتخصص وبالشهادة المدرسية. غير أن تلك الأمور (بشكلها الحاضر) لم تكن موجودة في عهد الإمام. فكان مقياس الكفاءة بنظره هو توسم قيام الشخص بالواجب المنوط به بشكل مرضى. فإذا عين الشخص بمنصبه ولم يثبت (بعد فترة من الزمن الكفاءة المطلوبة) تحتم فصله عن العمل وتطبيق حدود الله عليه. وبخاصة إذا لم يعمل وجوده في الوظيفة على جعله قادراً على أداء واجبه على شكله الصحيح.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو: أن الخبرة (أو وجود الشخص في الوظيفة) كثيراً ما تكون عاملا من عوامل تخصصه في ذلك العمل وتدريبه على انجازه على الوجه المطلوب. وبالتالي عاملا من العوامل التي تجعله موظفاً كفؤاً.
أما الأمانة: فهي الامتناع عن الاعتداء على أموال الآخرين وحقوقهم.
فالأمانة ذات جانبين: جانب مادى وآخر معنوي يعملان معاً في الأعم الأغلب. فالموظف الأمين هو الذي لا يقبل الرشوة ولا تمتد يده إلى ما تحتها من أموال الدولة.
هذا من الناحية المادية.
أما من الناحية المعنوية: فالموظف الأمين هو الذي يعطى كل ذي حقه في المجال الذي يعمل فيه. فلا يجعل بعض الناس يعتدى على حقوق بعض آخر، ولا يجعل الدولة تعتدي على حقوق الناس أو بالعكس.
وأما مقياس الأمانة بنظر الإمام فهو (في بدايته) سمعة الشخص ومركز عائلته من الناحية الدينية.
كل ذلك بالطبع يسبق عملية التوظيف. فإذا ظهر الشخص (بعد التوظيف) بمظهر الخائن وثبت ذلك عليه وجب إقصاؤه عن الخدمة وتطبيق حدود الله عليه.
فالموظف الأمين غير الكفؤ يكتفي (كما ذكرنا) بإقصائه عن الخدمة.
أما غير الأمين فيقصى عن الخدمة ثم تطبق حدود الله عليه. وسبب ذلك هو أن خيانة غير الكفؤ تحصل عفواً دون قصد في الأعم الأغلب.
أما إذا ثبتت خيانته مع عدم كفاءته فيجب أن يعزل ثم يعاقب: يعزل لعدم كفاءته ويعاقب لخيانته بعد ثبوت ذلك عليه بالطبع. ويعكس الأمر عند الخائن الكفؤ. ويمكن أن يشبه عمل الأول منهما (في حالة حدوثه بسبب عدم الكفاءة) بما يحدثه وقوع حجر من مكان مرتفع على أحد المارة. وعمل الثاني بقذف ذلك الشخص بذلك الحجر من قبل بعض الناس بصورة مقصورة: فتنتفي المسئولية في الحالة الأولى مع ما يتبعها من العقاب.
هذا بالإضافة إلى أن في موضوع الخيانة (عند الموظف الكفؤ غير الأمين) أمراً خلقياً عاهراً، هو وإن كان ذا صلة بعدم كفاءته إلا أنه شيء مستقل عنه.
أما الخيانة - عند غير الكفؤ - فهي ناتجة عن عدم الكفاءة، اللهم إلا إذا كان ذلك الموظف يجمع بين الصفتين: الخيانة وعدم الكفاءة.
أما القضاء فيجب أن تتوافر فيهم (بالإضافة إلى ما ذكرنا) شروط أخرى هي كذلك على جانب كبير من الأهمية والروعة. وقد نص عليها الإمام بقوله:
(ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك: ممن لا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطرا. ولا يستميله إغراء).
ومن طريف ما يروى عن الإمام في موضوع الإطراء أنه حذر المسلمين عامة عن إطرائه - لغرض المصانعة - على ما يقوم به من الأعمال وذلك لتعويد الحكام على إلتزام الحق الحق نفسه دون إطراء أو إغراء من جهة، وتعويد الرعية على عدم الإطراء على موظف لمجرد قيامه بواجب هو ملزم أن يقوم به لقاء ما يتقاضاه من أجور ويتمتع به من نفوذ. قال علي:
(بما استحلى الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا على بجميل ثناء لإخراجي نفسي إلى الله من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها. فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا إعظام لنفسي. فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه).
لقد مر بنا ذكر الشروط التي وضعها الإمام لانتقاء القضاة وهي شروط لا يتوافر وجودها إلا في القليلين من الناس.
وقد فطن الإمام إلى ذلك حين قال - بعد ذكر صفاتهم -: (وأولئك قليل).
فينبغي البحث عنهم والتقاطهم على القدر المستطاع. على أن هؤلاء - مع هذا - كما سلف أن ذكرنا من الممكن أن يكتسبوا (عن طريق الخبرة أثناء ممارستهم العمل) كثيراً من المزايا التي جعلها الإمام أساساً لانتقائهم، وأن يبرعوا في الوقت نفسه في المزايا التي كانت عليهم قبل التوظيف.
ومن الممكن أن يحصل ذلك كله إذا تذكر هؤلاء أنهم عرضة للفصل والإهانة والعقاب إذا ما نصروا في أداء واجبهم. وبالعكس فإنهم مؤهلون المكافأة والترفيع إذا ما قاموا بواجبهم على الوجه المرضى.
فالموظفون - بعد أن يتم تعيينهم على الشكل الذي وصفناه - يجب أن يخضعوا الرقابة حكومية شديدة وأن يتعرضوا بصورة مستمرة لتفتيش دقيق ليعرف الصالح منهم فيكافأ على صلاحه والطالح ليلقى جزاءه.
وقد أشار إلى ذلك الإمام بقوله:
(ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية).
أي أن المفتشين الحكوميين يجب أن يكونوا من أهل الصدق والوفاء لكي يزودوا الوالي والخليفة بأوثق الأخبار وأدق المعلومات عن الموظفين - لأن على تقاريرهم وأخبارهم يتوقف مصير الموظف في حالتي الثواب والعقاب.
فإذا كذب المفتش أو تحيز أو خان ما ائتمن عليه تعرضت إجراءات الوالى، أو الخليفة (المستندة إلى تلك الأمور) إلى الزلل والشطط.
والغاية من مراقبة الموظفين (مراقبة سرية كما ذكرنا) هي أن تقدم عنهم تقارير سرية وهم على حقيقتهم غير متظاهرين أو مغالطين.
يضاف إلى ذلك أن هذا النوع من المراقبة يحفزهم على القيام بواجباتهم على الوجه المطلوب.
(فإن أحد منهم بسط يده إلى الخيانة اجتمعت عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت العقوبة عليه في بدنه وأخذته بما أصاب عمله. ثم نصبته بمقام المذلة ووصمته بالخيانة وقلدته عار التهمة).
فللوظيفة (بقسميها الإداري والقضائي) إذن بنظر الإمام جانب تربوي تثقيفي بالإضافة إلى جانبها المتصل بإنجاز أمور الناس وفق شروط الشريعة السمحاء.
فينبغي والحالة هذه أن نتوخي من المرشحين للوظيفة: (أهل التربية والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام. فإنهم أكرم أخلاقاً وأقل في المطامع إسرافاً وأبلغ في عواقب الأمور.) من غيرهم.
ثم (لا يكون اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك... ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك. فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثر أو أعرفهم بالأمانة وجهاً. أي أن الامام أوصى إليه أن ينتقي موظفيه من أبناء الأسر الطالحة التي هدمها الإسلام، بل من أبناء الأسر المتواضعة التي رفعها شأنها الإسلام من حضيض الجاهلية إلى مستوياته الرفيعة.
ثم اشترط عليه أن يكون المرشحون للتوظيف مع ذلك - أي مع كونهم من ذوى الأحساب الاسلامية الرفيعة - أحسن أولئك في العامة أثراً وأعرفهم بالأمانة وجهاً. لأن (من أبطأ به عمله - كما ذكرنا - لم يسرع به نسبه) وإن كان ذووه ممن ينطبق عليهم ما ذكرناه.
فالتحدر من الأسر الاسلامية الكريمة شرط أساسي من شروط التوظيف ولكنه بحد ذاته غير كاف كما رأينا. فجعل الإمام ذلك الشرط مشروطاً كذلك (إذا جاز هذا التعبير) حين اشترط أن يكون الشخص المرشح للوظيفة (مع ذلك كله) أحسن أولئك (المتحدرين من الأسر الاسلامية الكريمة) أثراً في العامة وأعرفهم بالأمانة وجهاً. وإذا لم يحل ذلك كلّه بين ذلك الشخص - بعد توظيفه بالطبع - وبين امتداد يده إلى ما تحتها من الأموال والمصالح - للدولة والناس وجب فصله وتطبيق حدود الله عليه حسبما تستلزم الظروف ذلك.
ومن طريف ما يروى عن الإمام في هذا الصدد أنه كتب إلى المنذر بن الجارود العبدي - وكان قد استعمله على بعض النواحي فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعمال:
(أما بعد فإن صلاح أبيك قد غرني فيك. وظننت أنك تتبع هديه... ولئن كان ما بلغني عنك حقاً لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك... فاقبل إلى حين يصل إليك كتابي).
يتضح من كل ذلك أن الإمام نهى عن التحيز - بشتى صوره ومختلف مجالاته - في هذه القضية (أي موضوع التوظيف) وفي غيرها على السواء. (فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال).
ذلك ما يتصل بانتقاء الموظفين للإدارة والقضاء.
أما ما يتعلق بموقف الوالي منهم فيتجلى - فيما يتصل بالإداريين - بقوله:
(ثم أسبغ عليهم الأرزاق...... فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك).
وهذا الإجراء من أنجح الإجراءات وقاء من الرشوة ومن أعدلها في معاقبة المرتشين.
وأما القاضي فأكثر (تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وثقل معه حاجته إلى الناس. واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن اغتيال الرجال له عندك).
أي أن الإمام قد خص القاضي - بالإضافة إلى ما ينطبق عليه من شروط التوظيف التي ذكرناها - بمنزلة رفيعة من الناحيتين المادية والمعنوية. وسبب ذلك كما لا يخفى هو دقة مركزه وأهميته من الناحية العامة بالنسبة لحقوق الناس.
فأمر الإمام الوالي - من الناحية المادية - أن يفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس. وهو: إجراء فطن له مؤخراً بعض فطاحل المشرعين البريطانيين كما هو معروف.
على أن الإمام مع هذا الم يكتف بذلك بل سبق هؤلاء المشرعين (الذين جاؤا من بعده بمئات السنين) بأمور لم ينتبهوا إليها على ما نعلم حتى كتابة هذه السطور. فحص القاضي بمنزلة رفيعة من الناحية المعنوية أيضاً وذلك بإيصائه الولاة - والمسئولين الآخرين - أن يصادفوا على قرارات القاضي العادل (لأنها عادلة بالطبع) فلا يسمحوا للتنفذين (الذين لم يتسن لهم التأثير على القاضي نفسه) بالتأثير على من هو فوقه فتنقض قراراته العادلة ويعطل عمله وربما فسد خلقه كذلك.
يضاف إلى ذلك أنه جعل للقاضي (العادل) منزلة رفيعة عند من هم فوقه في سلم الرتب الحكومية ليسد بذلك منافذ الموتورين (والمنافقين والمصطادين في الماء العكر) إلى الوالي لكيلا يوغروا صدره عليه في الباطل وللسعاية. وفي ذلك ما فيه من تشجيع للقاضي (ولغيره من القضاة وأضرابهم) على المضى في توخى العدل في الحكم بين الناس من جهة وتثبيط عزائم مناوئيه وإفساد مؤامراتهم من جهة أخرى.
وأما ما يتعلق بموظفى السلك العسكري (فول من جنودك أنصحهم لله ولرسوله ولإمامك. وأنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً. ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء وممن لا يثيره العنف ولا يعقد به الضعف.
فإذا فرغت من انتقائهم على الشكل المذكور (فتنفقد من أمورهم. ولا يتفاقمن في نفسك شيء قوتهم به ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل. فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به وللجسم موقعاً لا يستغنون عنه.).
فرجال الجيش يجب أن يتم انتقاؤهم - بنظر الإمام - حسب شروط خاصة وإن كانت تجري، من حيث الأساس، على المجري العام الذي ذكرناه حين التحدث عن الموظفين المدنيين. وبما أن الناحية العسكرية ترتبط بالذهن عادة مع الشدة والقسوة وأخذ الناس بالصرامة والعنف فقد فطن الإمام إلى ذلك فحدد مجال عمل ذلك من جهة وعمل على إضعافه في المواطن التي تحتاج إلى ذلك الإضعاف من جهة أخرى.
وقد اشترط الإمام أول ما اشترط في الجنود - أي رجال الجيش من مختلف الصنوف المعروفة في عهده - النصيحة العقيدة الإسلامية لأنها (بنظره) الأساس الذي تستند إليه تصرفات الجندى (وغيره من المسلمين) في جميع مجالات الحياة.
ثم نص الإمام (بالإضافة إلى ذلك) على الشرط العام الذي يجب أن يتوافر في جميع أفراد الجهاز الحكمي (المدني والقضائي والعسكري) وهو نقاوة الجيب.
ثم اشترط الإمام في الجندى شرطاً خاصاً - ليزيل جانب الصرامة المرتبط بمنته في المواضع التي تستلزم إزالته:
هذا الشرط هو أن يكون الجندى: (ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف الضعفاء وينبو على الأقوياء).
يبطئ عن الغضب أي لا يوقع العقوبة بمن يعتقد أنه يستحقها أثناء غضبه لينتفى عنصر الانتقام في الموضوع من جهة، وليتسنى له (أي لمن يوقع العقوبة مباشرة أو من له سلطة الأمر بإيقاعها) بعد زوال غضبه أن ينظر في الموضوع برأيه الهادئ لا بعواطفه الثائرة ليكون حكمه سليما من الناحية العقلية.
(فإن من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.) ولا يسهل على من استسلم لعاطفة الغضب أن يستقبل وجوه الآراء ليعرف مواقع الخطأ فيها وفيما يتبعها من الإجراءات كما هو معروف.
(أملك حمية أنفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك. واحترس من كل ذلك بكف الباردة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك وتملك الاختيار.).
وهناك أمر لابد من الإشارة إليه في هذا الصدد هو: أن الإمام يعتبر العقوبة وسيلة للإصلاح لا للإنتقام. وهي - بنظره - آخر إجراء ينبغي أن يستعان به.
فالمذنب بنظره كالمريض يجب أن يعالج باللطف والإرشاد على القدر المستطاع. على أن العقوبة (إذا كان لابد من الاستعانة بها لتقويم الأخلاق كما نصت على ذلك العقيدة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسيرة النبوية) فيجب، مع ذلك، أن يتأخر إنزالها (لفترة مناسبة من الزمن) ليرى المذنب جريرته ونتائجها وما يتبعها من عقوبة لعله يرتدع عن الذنب في المستقبل.
(فلا تتبع الذنب العقوبة واجعل بينهما وقتاً للاعتذار.) هذا من الناحية السلبية.
أما من الناحية الإيجابية فازجر (المسيء بثواب المحسن).
أما الضعفاء فقد أوصى الإمام - كما رأينا - جنوده بضرورة الرأفة بهم فيعاقبونهم عن طريق التهذيب بالتجاوز عن عفواتهم ضمن الحدود المعقولة.
وأما الأقوياء (وأصحاب النفوذ) فابطش بهم - إذا أذنبوا - بطشاً يتناسب هو مع طبيعة الذنب. وسبب ذلك هو: أن العفو عن القوى ربما يجعله يعتقد بأن ذلك العفو ناتج عن نفوذه فيتمادى في الزلة. هذا من الناحية النفسية.
أما من الناحية الاجتماعية فقد يخيل للآخرين أن نفوذ المجرم المتنفذ (المعفو عنه) كان عاملا من عوامل العفو عنه، الأمر الذي يشجعهم - وبخاصة إذا كانوا من ذوى النفوذ أو ممن يمتون إليهم بصلة - على ارتكاب الباطل. فتنتفي - في الحالتين - الغاية من العفو وهي الإصلاح والتهذيب عن طريق العفو نفسه.
أما ترفيع أفراد الجيش وترقيتهم (بعد تعيينهم وفق الشروط التي ذكرناها) فقد وضع ذلك الإمام بشكل صريح لا يحتاج إلى شرح أو توضيح. ولكي يكون الترفيع عادلا وجب أولا وقبل كل شيء مراقبة أعمالهم وتقديم التقارير الأمينة عنهم والتوصيات العادلة بحق كل منهم. ثم اعطاه كل ذي حق حقه في مجال الترفيع والتقدير.
ويجب مع ذلك كله أن تقاس قيمة كل منهم بنوع عمله بغض النظر عن الأسر والأحساب. (فمن أبطأ به عمله - كما ذكرناه - لم يسرع به حسبه.) ولكن ينبغي مع هذا أن يطرى المسئولون على الأعمال الحسنة التي يقوم بها بعض الجنود مهما كانت بسيطة وذلك تشجيعاً لهم على الاستمرار عليها واستنهاضاً للآخرين على الاقتداء بأصحابها.
وهناك أمران آخران يتصلان بالجيش يجمل بنا أن نشير إليهما قبل الانتقال إلى التحدث عن الولاة.
وأولهما: موقف الإمام بصورة عامة من الجيش من حيث كونه ركناً من أركان جهاز الحكم في البلاد.
وثانيهما: موقفه من القطعات العسكرية التي تجهز للاشتراك الفعلي مع العصم، وموقفها ممن تمر بأرضهم من المواطنين.
وقد لخص الإمام الجانب الأول منهما بقوله: (إن حقاً على الإمام أن لا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به. وأن يزيده ما قسم الله له من نعمة دنواً من عباده وعطفاً على إخوانه. ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سراً إلا في حرب ولا أطوى دونكم أمراً إلا في حكم. ولا أؤخر لكم حقاً عن محله ولا أقف به دون مقطعه وأن تكونوا عندي في الحق سواء. ولى عليكم الطاعة وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. فإن أنتم لم تستقيموا لي فلم يكن أحد أهون على ممن أعوج منكم..
فالإمام يريد أن يطبق مبدأ العدالة الاجتماعية تاما غير منقوص. وفق مستلزمات الشريعة الإسلامية على الجنود وعلى غيرهم من أفراد الشعب ومن أعضاء الحكومة. وهو يريد من أفراد الجيش أن يعينوه على ذلك في مجال عملهم. ومع ذلك كله (فلم يكن أحد أهون عليه ممن أعوج منهم) فيجب أن لا يدفعهم مركزهم العسكري (واعتماد الخليفة عليهم في حفظ الأمن والوقوف للأعداء بالمرصاد) إلى الزهو وعدم الإكتراث بالقانون فإن ذلك يعرض أصحابه للعقاب.فليس أحد - من هذا الجيش العزيز - بأهون على الإمام ممن أعوج في تصرفاته من أفراده.
أما ثاني الأمرين اللذين ذكرناهما فقد نص الإمام بقوله:
(في كتاب له إلى العمال الذين يطأ الجيوش عملهم).
(أما بعد فإني سيرت جنوداً هي مادة بكم. وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم (يعني اليهود والنصارى) من معرة الجيش... وأنا بين ظهر الجيش (أي في أعقابه)، فارفعوا إلى مظالكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي، أغيره بمعونة الله.).
أي أن الإمام يريد من الجيش (في حالة مسيره إلى المعركة أو رجوعه منها) أن يتحلى بالخلق الإسلامي - الذي وصفناه - فيما يتصل بالأماكن التي يمر بها وفي موقفه من السملمين وغير المسلمين من أهل الذمة. ومن يخالف ذلك يقع - دون شك - تحت طائلة العقاب.
ثم يختتم الامام موقفه من رجال السلك العسكري بالملاحظات التالية:
ثم أفسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل.
ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى. ولا تضيفن بلاء امرئ إلى غيره ولا تقصرون به دون غاية بلائه. ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراً ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما).
وأما الولاة فينطبق عليهم ما ذكرناه مع اختلاف كبير ذي جانبين:
أحدهما: هو أن الامام نفسه يعين الولاة بصورة مباشرة في حين أنهم (- منفردين - في الأعم الأغلب) يعينون الموظفين الآخرين.
وثانيهما: عظم المسئولية الملقاة على عاتق الوالي فيما يتصل بإدارة شئون المصر الذي يخضع له من الناحية السياسية والمالية والخلقية.
فالأمام يحكم الأقاليم الاسلامية المختلفة بطريقة غير مباشرة. أي أنه يحكمها عن طريق الولاة.
فالوالي إذن هو الخليفة (مصفراً) في ولايته. فعليه إذن - كما على الخليفة - واجبات خلقية وسياسية ومالية في حدود أضيق، من حدود الخليفة من الناحية المكانية، وأوسع من حدود الموظفين الآخرين. وواجبات الوالي هي - من الناحية الأخلاقية:
(أن ينصر الله بيده وقلبه ولسانه... وأن يكسر من نفسه عند الشهوات وينزعها عند الجمحات.) و (ليكن أحب الذخائر إليك - أيها الوالي - ذخيرة العمل الصالح. فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لها. فإن الشح بالنفس هو الانصاف منها فيما أحبت أو كرهت).
والانصاف من النفس فيما أحبت يعني: أن لا يسيء الوالي استعمال منصبه الرفيع فيتخذه وسيلة للانتفاع الشخصى - بطريقة غير مشروعة - بما تحت يديه من ممتلكات ومال ونفوذ، أو لخلع ذلك على ذويه والمقربين إليه. أما الانصاف من النفس فيما كرهت فيستلزم أن يأخذ الحق مجراه - في حالة العقوبة - مع النفس ومع المقربين إليه ومع ذوى قرباه، وفي حالة الثواب - أو المكافأة أو استرجاع حق مهضوم (مع الخصوم ومع من هم على شاكلتهم).
أي أن الوالي يجب أن يكون - بعبارة أخرى.
كالخليفة نفسه في تطبيق حدود الله على المستحقين في جميع الأحوال دون تمييز من أي نوع كان.
وأما واجبات الوالي تجاه الرعية فقد رسمها الإمام بقوله:
(أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم. ولا تكونن عليهم سبعاً. ضارياً تغتنم أكلهم). لأن الرعية صنفان - كما ذكريا - إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
(فاخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظة والنظرة.) وبذلك يكون عدلك شاملا لا يشوبه تحيز إلا للحق.
فإذا عرف الناس ذلك منك عندئذ (لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييئس الضعفاء من عدلك عليهم).
فيجب عليك (أن لا تسخط الله برضا أحد من خلقه. لأن سخط الله يحصل من فقدان العدالة الاجتماعية بين الناس نتيجة محاباة الوالي بعضهم وإيثاره إياهم - دون حق - على حساب الآخرين.
(إني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً):
أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه. وأما المشرك فيمنعه الله بشركه. ولكني أخاف عليكم كل منافق اللسان عالم الجنان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون).
فالإمام إذن لا يخش على أمته جوراً من مؤمن لأن نفسه رادعاً من تقوى الله، ولا جوراً من مشرك لعدم احتمال توليته أمور المسلمين لأن الله لا يجيز ذلك اللهم إلا إذا كان ذلك خارج نطاق إرادتهم وهنا ينتفي الشرط من أساسه.
ولكن الإمام يخاف من المشرك المقنع بقناع الإسلام. على أنك - أيها الوالي - يجب أن تتذكر دائماً فيما يتصل بعلاقتك برعيتك (أنك فوقهم وولى الأمر فوقك والله فوق من ولاك) فلا تتعد حدودك التي رسمها لك فإن الخليفة فوقك يحاسبك على ذلك حساباً عسيراً والله فوق من ولاك يحاسبه ويحاسبك على السواء.
وبما أنك بحكم مركزك عرضة للزهو والكبرياء (فإذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم الله فرقك. لأن ذلك يريك صغر نفسك وضآلة شأنك وحقارة سلطانك فيكبح جماحك ويستثير التواضع فيك ويدفعك على تحرى الصواب في أحكامك.
(واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤنات عنهم وترك استكراهه إياهم ما ليس قبلهم) ذلك لأن هذا التصرف يجعل الرعية تشعر بأن الوالي منها وإليها، وأنه ساهر على خدمتها بجميع الوسائل المشروعة المتوافرة لديه.
وهذا يؤدى بدوره إلى تعاونها معه في إقامة الحق وإشاعة العدل ومكافحة الرذائل سواء أكان ذلك عن طريق الترفع عن تعاطيها أم بالكشف عمن يتعاطاها لردعه من قبل الحكومة وازدرائه من قبل أفراد الشعب.
ثم يوجه الخليفة انتباه الوالي إلى ظاهرة اجتماعية عامة تتصل بالرعية بمجموعها فيقول: (إن الرعية تفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ... وإن في الناس عيوباً الوالي أحق من سترها. فلا تكشفن عما غاب عنك منها فإن عليك تظهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك... فتغاب عن كل مالا يضح لك).
وفي هذه النقطة بالذات تتضح فروق رئيسية بين فلسفة الإمام في الحكم وبينها عند عمر بن الخطاب.
فقد سار عمر - كما معروف - على قاعدة تختلف هي وما ذكرناه كل الاختلاف. وفي كتب التاريخ الإسلامي من الأمثلة على ذلك الشيء الكثير(١) .
ذكرنا أن الرعية تفرط منهم الزلل كما قال الإمام:
فيجب عليك أيها الوالى مع ذلك أن تعطيهم (من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه).
ولا يستطيع القارئ أن يتصور مقدار الصفح الذي ينبغي للوالي أن يعطيه لرعيته إلا إذا تذكر أن الإنسان محتاج - من وجهة نظر الإمام - إلى عفو الله في جميع الظروف والأحوال ما دام على قيد الحياة.
هذا مع العلم أن الإمام كان المثل الأعلى في إطاعة أوامر الله ونواهيه في قلبه ولسانه ويده في تصرفاته العامة والخاصة مع خصومه وأنصاره على السواء.
إستمع إليه في إحدى وصايا: (اعلم أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا... وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه... فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك.
واعلم - يا بني - إن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفاً ويقطع المسافة وإن كان مقيماً وادعاً).
فالإمام، مع هذه الحالة من الورع ومخافة الله، كان مؤمناً أشد الإيمان وأعمقه بأنه أحوج ما يكون إلى عفو الله ومغفرته.
أما الوالي (أي وال) فهو بحكم كونه دون ورع الإمام بمراحل أحوج إلى عفو الله ومغفرته دون شك. غير أن عفو الله كما هو معلوم له حدود لا يتعداها وعفو الوالي يجب أن يسير ضمن نطاق الإسلام. والغاية المتوخاة من هذا العفو هي التهذيب والتوجيه لا التسيب وفقدان المحاسبة على الموبقات.
لأن فقدان المحاسبة على الموبقات عامل من عوامل انتشارها - وهو أمر يأباه الإسلام. فعفو الوالي يجب أن يكون واسعاً كسعة عفو الله رقيقا لينا كرقته ولينه صارما كلما مس العمل حداً من حدود الله فتجاوزه أو خرج عليه. على أن العفو مع هذا لابد من اللجوء إليه كلما كان ذلك ممكنا. فلا تندمن على عفو.
ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مندوحة. لأن النفس البشرية تميل في العادة إلى التربح بين نقيضين كلما عملت عملا بطريقة معينة وكانت النتيجة على خلاف ما كانت تتوخاه.
فإذا صفح الحاكم مثلا عمن ارتكب جرماً يستحق العقاب (لغرض ردعه وتهذيبه عن طريق العفو عنه) وكانت النتيجة تمادى ذلك للشخص في سلوكه الشائن بدلا عن إقلاعه عنه فإن الحاكم يميل في العادة إلى الاستعانة بالشدة في معالجة أمثال تلك الأمور، لا فيما يتصل بذلك الشخص فقط بل فيما يتصل بغيره من الناس.
أي أن الحاكم (بدلا من أن يعتبر تصرف ذلك الشخص خروجاً على قاعدة الصفح في حالة خاصة - ربما تكون شاذة - فيعاقبه إذا عاد إلى تعاطى ذلك العمل في المستقبل محتفظاً بمبدأ الصفح سليماً قابلا للتطبيق على تصرفات الآخرين) يثور على مبدأ الصفح عنه - إذا جاز هذا التعبير. وبالعكس.
قال الإمام: في هذا المعنى من الناحية الأخلاقية العامة (لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك. فقد يشكرك عليه من لا ينتفع بشيء).
ثم أوصى الوالي بأمور أخرى تتصل بشخصه فقال له: (أطلق عن الناس عقدة كل حقد وارفع عنها سبب كل وتر... ولا تعجلن على تصدق ساع. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في العدل وأجمعها لرضى الرعية فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة وغن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة).
ذلك لأنه يستحيل على الوالي - من الناحية العملية - أن يرضى في كل تصرف من تصرفاته جميع الأشخاص الذين يعنيهم الأمر من قريب أو بعيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أي أن كل تصرف - مهما كان عادلا - يرضى بعض الناس ويسخط بعضاً آخر. فإذا رضى جميع الذين يعنيهم الأمر بذلك التصرف العادل (وهو ما يهدف إليه الإمام) فلا مشكلة هناك.
أما إذا لم يحصل ذلك فإن رضى العامة هو مقياس سلامة التصرف لأن الخاصة من أصحاب المصالح تميل في العادة نحو المحافظة على مصالحها المركزة بشتى الوسائل ومختلف الجهود. فتغضب وتثور وتحتج وتملأ الدنيا ضجيجا وتهديداً ومغالطة وتضليلا إذا ما تعرضت مصالحها للتصدع أو الانهيار.
ثم أيها الوالي إن طبيعة مركزك - من حيث كونك والياً - تستلزم اتصالك بالرعية بصورة مستمرة لتتفقد شئونها (فلا تطوان احتجابك عن الرعية) لأن (الاحتجاب عنهم يقطع عنهم علم ما اجتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم عندهم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل.
وإنما الوالي بشر لا يعرف ما تواري عنه الناس من الأمور وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب.) أي أن احتجاب الوالي عن الرعية قد يخلق جواً من الريبة والدعاية الكاذبة التي يقوم بها الموتورون والمستهترون وأصحاب المصالح التي زعزع الباطل منها عدل الحاكم. هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإن الاحتجاب قد يشجع الوالي على تعاطى الموبقات وعلى الارتماء بأحضان أصدقاء السوء.
ثم إنك أيها الوالي (أحد رجلين - إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق فقيم احتجابك من واجب تعطيه أو فعل كريم تسديه؟) فلا معنى لاحتجابك عن الرعية إذن ولا لزوم له. بل لابد من العمل على عكسه. (أو إنك مبتل بالمنع. فما أسرع كف الناس عن مساءلتك إذا أيسوا من بذلك.) وبذلك يفسد احتجابك عنهم وينتفي تحقيق ما كنت تصبو إليه. هذا (مع أن كثرة حاجات الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة.) فواجبك إذن يستلزم عم احتجابك عن الناس.
ثم (الصق بأهل الورع والصدق ورضهم على أن لا يطروك في باطل لم تفعله ويبجحوك بباطل لم تفعله.) لأن ذلك يفسد ورعهم ويلوث صدقهم من جهة وبسوقك إلى صحارى الزهو والخيلاء من جهة أخرى.
(ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء - فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً لأهل الإساءة على الاساءة).
فضع كل شخص في منزلته وصارحه بحقيقة أمره كي تستقيم لك الناس وتعاونك على القضاء على عوامل الفساد والدس والمواربة والتضليل.
(وأكثر من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس).
فإن العلماء الحكماء ذوو خبرة واسعة وبصيرة نافذة في الأمور، وذوو إخلاص في إسداء النصح للحكام الصالحين.
والقاعدة العامة التي يجب أن يخضع لها سيرك العام هي (في هذا المجال وأمثاله) إن (رضا الناس غاية لا تدرك. فتحر الخير بجهدك ولا قبال بسخط من لا يرضيه الحق).
ثم أوصاه بعدم العطيش والاندفاع ونهاه عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فقال له: (إياك والدماء وسفكها بغير حلها... ولا عذر لك عند الله وعندي في قتل العمد.
املك حمية أنفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك. واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار.) فلا تتبع (الذنب العقوبة - كما ذكرنا - واجعل بينهما وقتاً للاعتذار) من قبل المذنب، وفترة لتجنب إيقاع العقوبة بشكل أكثر مما يستحقه الجرم في حالة الغضب والاندفاع.
أما القاعدة العامة التي وضعها الإمام في هذا الباب فهي (ينبغي للوالي أن يعمل بخصال ثلاث: تأخير العقوبة منه في سلطان الغضب، والأناة فيما يرتئيه من رأى، وتعجيل مكافأة المحسن بالاحسان. فإن في تأجيل تأخير العقوبة إمكان العفو).
على أن العفو يجب أن يكون في مواضعه ومع أهله. (لأن العفو يفسد من اللئيم بقدر ما يصلح من الكريم).
اللئيم الذي يعتبر العفو عنه تهرباً من إيذائه فيركب رأسه ويسير سادراً في طريق الضلال.
أما الكريم فهو الذي يعتبر العفو عنه وسيلة لزجره وإرشاده فيسير في طريق الهداية متحاشياً تعاطى الموبقات في تصرفاته اللاحقة.
ذلك ما يتعلق بشخصية الوالى وتصرفاته العامة المباشرة وغير المباشرة تجاه الرعية.
أما ما يتصل بحاشيته والمقربين إليه وتصرفاتهم تجاه الناس - فلكل وال حاشية مقربون وذوو قربى يكونون عوناً له أحياناً في إصلاح الأوضاع العامة ووبالا عليه وعلى الناس أحياناً أخرى فقد ذكره الامام بقوله:
(إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف في معاملة. فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال.
فلا تقطعن لأحد من خاصتك قطيعة ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم).
ثم أوصاه قائلا: (أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك وممن لك فيه هوى من رعيتك. (وإنصاف الله يتحقق - في هذا الباب - عن طريق السير وفق شريعته السمحاء. وإنصاف الناس يتحقق بواسطة تطبيق تلك الشريعة على الأحكام والمعاملات.
واعمل (أن من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء.) وقديماً قيل:
إلى الماء يسعى من يغص بريقه فقل أين يسعى من يغص بماء!!
(وليكن أبعد رعيتك أطلبهم لمعايب الناس.) لكيلا يتخذ من التحدث المشين عن أعراض الناس وسيلة يتقرب بها منك فيتمادى - بعد ذلك - في غيه مختلقاً المثالب والموبقات وواصماً بها دون حساب. هذا من جهة.
ومن جهة ثانية: فإن (في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها... كما سلف أن ذكرنا. (إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيراً، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة.) ذلك لأنه ألف - منذ عهدهم - أساليب الجور وأصبحت له منذ ذلك الحين مصالح مركزة وأتباع ومؤيدون في الباطل.
يضاف إلى ذلك أن تصرفاته الشريرة لابد أن تكون قد أزعجت الصالحين من الناس فشجبوها، الأمر الذي يجعله يتحين الفرص للإيقاع بهم.
ففتش عن وزراء صالحين، وأنت واجد منهم خير الخلف له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه أوضارهم وأزاهم وآثامهم.) ولا يخفى عليك أن الوزراء الجدد يختلفون - مع صلاحهم - في نفاذ البصيرة ودقة الملاحظة وفي الإقدام واتباع الحق فليكن (آثرهم عندك أقولهم للحق).
ذلك هو الجانب السياسي من فلسفة الحكم عند الإمام. وقد لخص خطوطه العامة - من الناحية السياسية التي شرحناها والمالية التي سنبحثها في الفصل القابل - بقوله -: (إنه ليس على الإمام إلا ما حصل من أمر ربه: الإبلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها.
أيها الناس: (أنا رجل منكم. لي ما لكم وعلى ما عليكم. والحق لا يبطله شيء(2) .
ثم استخلف أبوبكر عمر فعمل بطريقته، ثم جعلها شورى بين ستة فأفضى الأمر إلى عثمان، فعمل ما أنكرتم منه... ثم حصر و قتل. ثم جئتموني طائعين... وإني حاملكم على منهج نبيكم).
ومنهج نبيهم، الذي يستند إلى القرآن، هو (من الناحية الاقتصادية) المساواة في العطاء بين المسلمين بغض النظر عن جميع الاعتبارات التي تميز العرب المسلمين عن المسلمين غير العرب من جهة، والتي تميز بين العرب أنفسهم - حسب منزلتهم في الجاهلية التي سجبها الاسلام - من جهة أخرى.
ثم التفت الإمام - بعد فراغه من كلمته - يميناً وشمالا وقال:
(ألا لا يقولن رجال منكم غداً (قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار، ركبوا الخيول الفارهة واتخذوا الوصائف الرقيقة، فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً) إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم التي تعلمون) أنى اعتيدت على حقوقهم المشروعة. فلا يتذمر هؤلاء الذين وصلوا إلى ما هم عليه من الناحية المالية بطرق ملتوية - بعد وفاة الرسول - ويقولون:
(حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا) التي اكتسبناها.
تلك الحقوق والامتيازات المالية حتى حصلت على حساب المسلمين، مع ما يرافقها من نفوذ سياسي واجتماعي، وما يتعلق بذلك من صرف لها في غير أوجهها المشروعة.
ولعل السبب الذي دعا الإمام إلى إعلان سياسته الإقتصادية بالشكل الآنف الذكر - بالإضافة إلى مستلزمات الشريعة السمحاء - هو ذلك التفاوت المالي المريع بين المسلمين: أقلية مترفة مرابية لا تتقيد إلا ببعض مظاهر الدين في المواضع التي لا تتضارب هي ومصالحها، وأكثرية معدمة يبيت أغلبها على الطوى. في حين أنهم جميعاً (عباد الله والمال مال الله يقسم بينهم بالسوية، لاقضل لأحد على أحد).
ذكر الإمام ذلك كله على مرأى ومسمع ممن حضر الاجتماع - من المهاجرين والأنصار، وأهل السابقة في الإسلام. فاختلفت مواقفهم منه باختلاف مصالحهم، فارتاع ذووا المصالح المركزة وأسروا في أنفسهم الإمتعاض، والحقد، لعلمهم أن ابن أبي طالب يعني ما يقول: وأنه ينجزو عده مهما كلف الأمر من مشقة وتضحية:
ثم التفت إلى السامعين وقال:
(وإذا كان غد إن شاء الله فاغدوا علينا فإن عندنا ما لا نقسمه بينكم، ولا يتخلفن أحد منكم - عربي ولا عجمي - كان من أهل العطاء أو لم يكن إلا حضر).
وغرضه من هذا بالطبع هو أن يريهم عدله، من الناحية العملية الواقعية، ليكيفوا سلوكهم وفق ذلك في المستقبل.
فلما كان من الغد غدا على وغدا الناس لقبض المال. فأمر على كاتبه (عبد الله ابن أبي رافع) أن: (ابدأ بالمهاجرين فنادهم وأهط كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانير).
لله أنت يا ابن أبي طالب!! تأمر كاتبك أن يدفع ثلاثة دنانير لطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام - وهو هم على شاكلتهما ممن اعتاد في زمن عثمان خاصة - أن يأخذ من بيت المال مبالغ ضخمة لا يكاد العقل أن يصدقها.
فلا عجب إذن أن امتعض هؤلاء السادة وحقدوا على الذي ساواهم في العطاء مع مواليهم، ومع من هم دونهم في الأحساب - بمقابيس الجاهلية - من المسلمين.
وإذا نظرنا إلى موضوع المساواة في العطاء من زاوية أخرى أمكننا أن تقول إنه يتضمن أكثر من مجرد حرمان أصحاب الإمتيازات المالية من امتيازاتهم المادية.
________________
(١) لقد ذكرنا جانبا منها في كتابنا. (على ومناوئوه) الفصل الثالث وطبع بالقاهرة بمطبعة حسان شارع الجيش، ومطبعة دار العلم للطباعة بالسيدة زينب.
(2) جميع الفقرات المقتبسة من كلام الإمام - التي ذكرناها في الفصل السابق وفي هذا الفصل والتي سنذكرها في الفصول القابلة - مأخوذة من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد سوف نشير في آخر فصل من فصول هذا الكتاب إلى مواقعها بالضبط ذاكرين اسم المجلد الذي اقتبسناها منه مع رقم صفحته. وغرضنا من ذلك - كما أن ذكرنا - هو تفادى التكرار من جهة وعدم إرباك القارئ باشارات وهوامش كثيرة قد تفسد عليه تسلسل مطالعته.



|
|
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|