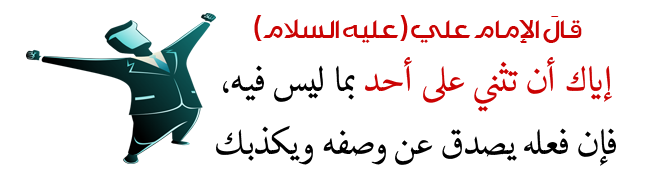
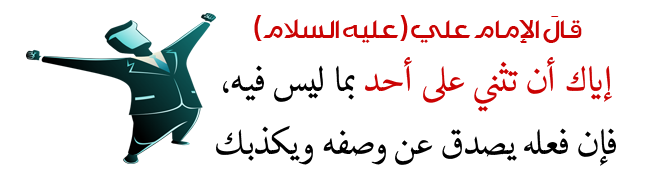

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2020
التاريخ: 2-5-2020
التاريخ: 9-6-2020
التاريخ: 22-5-2020
|
قال تعالى:{ ولَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الْكتَب فَاخْتُلِف فِيهِ ولَولا كلِمَةٌ سبَقَت مِن رَّبِّك لَقُضىَ بَيْنهُمْ وإِنهُمْ لَفِى شك مِّنْهُ مُرِيب(110) وإِنَّ ُكلاً لَّمَّا لَيُوَفِّيَنهُمْ رَبُّك أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(111) فَاستَقِمْ كَمَا أُمِرْت ومَن تَاب مَعَك ولا تَطغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(112) ولا تَرْكَنُوا إِلى الَّذِينَ ظلَمُوا فَتَمَسكُمُ النَّارُ ومَا لَكم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصرُونَ(113) وأَقِمِ الصلَوةَ طرَفىِ النهَارِ وزُلَفاً مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الحَْسنَتِ يُذْهِبنَ السيِّئَاتِ ذَلِك ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ(114) واصبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [هود: 110، 115]
{ وَلَقَدْ آتَيْنَا} أي: أعطينا { مُوسَى الْكِتَابَ} يعني التوراة { فَاخْتُلِفَ فِيهِ} يريد أن قومه اختلفوا فيه أي في صحة الكتاب الذي أنزل عليه وأراد بذلك تسلية النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن تكذيب قومه إياه وجحدهم للقرآن المنزل عليه فبين أن قوم موسى كذلك فعلوا بموسى فلا تحزن لذلك ولا تغتم له.
{ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ} أي: لولا خبر الله السابق بأنه يؤخر الجزاء إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من المصلحة { لقضي بينهم} أي: لعجل الثواب والعقاب لأهله وقيل: معناه لفصل الأمر على التمام بين المؤمنين والكافرين بنجاة هؤلاء وهلاك أولئك { وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} يعني: إن الكافرين لفي شك من وعد الله ووعيده مريب والريب أقوى الشك وقيل: معناه إن قوم موسى لفي شك من نبوته {وإن كلا} من الجاحدين والمخالفين. وقيل: إن كلا من الفريقين المصدق والمكذب جميعا { لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} أي: يعطيهم ربك جزاء أعمالهم وافيا تاما إن خيرا فخير وإن شرا فشر {إنه بما يعملون خبير } يعني: إنه عليم بأعمالكم وبما استحققتم من الجزاء عليها لا يخفى عليه شيء من ذلك {فاستقم} يا محمد {كما أمرت} أي: استقم على الوعظ والإنذار والتمسك بالطاعة والأمر بها والدعاء عليها والاستقامة هو أداء المأمور به والانتهاء عن المنهي عنه كما أمرت في القرآن {ومن تاب معك} أي: وليستقم من تاب معك من الشرك كما أمروا عن ابن عباس وقيل: معناه ومن رجع إلى الله وإلى نبيه فليستقم أيضا أي ، فليستقم المؤمنون وقيل: استقم أنت على الأداء وليستقيموا على القبول {ولا تطغوا} أي :لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حد الاستقامة وقيل: معناه ولا تطغينكم النعمة فتخرجوا عن حد الاستقامة عن الجبائي وقيل معناه لا تعصوا الله ولا تخالفوه.
{إنه بما تعملون بصير}أي: عليم بأعمالكم لا تخفى عليه منها خافية وروي الواحدي بإسناده عن إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار عن أبي مسلم الخولاني عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لوصليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتاد ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد لم تبلغوا حد الاستقامة وقال: ابن عباس ما نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) آية كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله شيبتني هود والواقعة .
ثم نهى الله سبحانه عن المداهنة في الدين والميل إلى الظالمين فقال { وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} أي: ولا تميلوا إلى مشركين في شيء من دينكم عن ابن عباس وقيل: لا تداهنوا الظلمة عن السدي وابن زيد وقيل: إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هوالدخول معهم في ظلمهم وإظهار الرضا بفعلهم أوإظهار موالاتهم فأما الدخول عليهم أومخالطتهم ومعاشرتهم دفعا لشرهم فجائز عن القاضي وقريب منه ما روي عنهم (عليهم السلام) إن الركون المودة والنصيحة والطاعة.
{فتمسكم النار} أي: فيصيبكم عذاب النار { وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ} أي: ما لكم سواه من أنصار يدفعون عنكم عذاب الله وفي هذا بيان أنهم متى خالفوا هذا النهي وسكنوا إلى الظالمين نالتهم النار ولم يكن لهم ناصر يدفع عنهم عقوبة لهم على ذلك {ثم لا تنصرون} أي: لا تنصرون في الدنيا على أعدائكم لأن نصر الله نوع من الثواب فيكون للمطيعين {وأقم الصلاة } أي: أدها وائت بأعمالها على وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر فروضها وقيل: معناه أعملها على استواء وقيل أدم على فعلها.
{ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} قيل: أراد بطرفي النهار صلاة الفجر والمغرب وبزلف من الليل صلاة العشاء الآخرة والزلف أول ساعات الليل عن ابن عباس وابن زيد قالوا وترك ذكر الظهر والعصر لأحد أمرين إما لظهورهما في أنهما صلاتا النهار فكأنه قال: وأقم الصلاة طرفي النهار مع المعروفة من صلاة النهار وإما لأنهما مذكورتان على التبع للطرف الأخير لأنهما بعد الزوال فهما أقرب إليه وقد قال: سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوك الشمس زوالها وهذا القول هوالمروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وقيل: صلاة طرفي النهار الغداة والظهر والعصر وصلاة زلف الليل المغرب والعشاء الآخرة عن الزجاج وبه قال مجاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي والحسن قالوا لأن طرف الشيء من الشيء وصلاة المغرب ليست من النهار قال الحسن: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) المغرب والعشاء زلفتا الليل وقيل: أراد بطرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر {إن الحسنات يذهبن السيئات } قيل: في معناه إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب لأنه عرف الحسنات بالألف واللام وقد تقدم ذكر الصلاة عن ابن عباس وأكثر المفسرين وذكر الواحدي بإسناده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا يابسا منها فهزه حتى تحات ورقه(2) ثم قال: يا أبا عثمان أ لا تسألني لم أفعل هذا قلت ولم تفعله قال هكذا فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال أ لا تسألني يا سلمان لم أفعل هذا قلت ولم فعلته قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق ثم قرأ هذه الآية {وأقم الصلاة } إلى آخرها.
وبإسناده عن أبي أمامة قال بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في المسجد ونحن قعود معه إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فقال هل شهدت الصلاة معنا قال نعم يا رسول الله قال فإن الله قد غفر لك حدك أوقال ذنبك وبإسناده عن الحرث عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في المسجد ننتظر الصلاة فقام رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا فأعرض عنه فلما قضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) الصلاة قام الرجل فأعاد القول فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أ ليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور قال: بلى قال فإنها كفارة ذنبك.
وروي أصحابنا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فقال له من أين جئت ثم قال له تقول جئتك من هاهنا وهاهنا لغير معاش تطلبه ولا بعمل آخر تكسبه أنظر بما ذا تقطع يومك وليلتك واعلم أن معك ملكا كريما موكلا بك يحفظ عليك ما تصنع ويطلع على سرك الذي تخفيه من الناس فاستحيا لا تستحقرن سيئة فإنها ستسوؤك يوما ولا تحقرن حسنة وإن صغرت عندك وقلت في عينك فإنها ستسرك يوما واعلم أنه ليس شيء أضر عاقبة ولا أسرع ندامة من الخطيئة وأنه ليس شيء أشد طلبا ولا أسرع دركا للخطيئة من الحسنة أما إنها لتدرك الذنب العظيم القديم المنسي عند عامله فتجتذبه وتسقطه وتذهب به بعد إثباته وذلك قول الله سبحانه { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} ورووا عن أبي حمزة الثمالي قال :سمعت أحدهما (عليهماالسلام) يقول إن عليا (عليه السلام) أقبل على الناس فقال أية آية في كتاب الله أرجى عندكم ؟ فقال: بعضهم {إن الله لا يغفر أن يشرك به } الآية فقال حسنة وليست إياها وقال بعضهم ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه قال حسنة وليست إياها وقال بعضهم { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} قال: حسنة وليست إياها وقال بعضهم {والذين إذ فعلوا فاحشة } الآية قال: حسنة وليست إياها قال ثم أحجم الناس فقال ما لكم يا معشر المسلمين فقالوا لا والله ما عندنا شيء قال سمعت حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقول أرجى آية في كتاب الله { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} وقرأ الآية كلها قال يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس ثم قال يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم فما يظن أحدكم لوكان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات أ كان يبقى في جسده درن فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي.
وقيل: { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} معناه :إن الدوام على فعل الحسنات يدعوإلى ترك السيئات فكأنها يذهبن بها وقيل: إن المراد بالحسنات التوبة فإنها تذهب السيئات بأن تسقط عقابها لأنه لا خلاف في أن العقاب يسقط عند التوبة { ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} يعني: إن ما ذكره من إن الحسنات تذهب السيئات فيه تذكار وموعظة لمن تذكر به وفكر فيه {واصبر} قيل: معناه واصبر على الصلاة كما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها { فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} أي: المصلين عن ابن عباس وقيل معناه اصبر يا محمد على أذى قومك وتكذيبهم إياك وعلى القيام بما افترضته عليك وعلى أداء الواجبات والامتناع عن المقبحات فإن الله لا يهمل جزاء المحسنين على إحسانهم ولا يبطله بل يكافيهم عليه أكمل الثواب.
____________________
1- تفسير مجمع البيان ،الطبرسي،ج5،ص341-347.
2- أي تساقط.
{ولَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ} . المراد بالكتاب هنا التوراة ، وقد اختلف فيه قوم موسى ، فمنهم من آمن به ، ومنهم من كفر ، وهكذا كل أمة قديما وحديثا لم تتفق كلمتها على نبيها ومرشدها الناصح الأمين ، بل كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم ، حتى الذين آمنوا بموسى حرفوا التوراة من بعده ، وأحيوا البدع والضلالات . . إذن ، فلا عجب إن آمن بك يا محمد قوم ، وكفر بك آخرون .
{ولَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ } . المراد بكلمة اللَّه قضاؤه بتأخير العذاب ، وضمير بينهم يعود إلى المختلفين في كتاب التوراة ، وقد شاءت حكمته تعالى ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا { وإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ } . ما زال
الكلام عن موسى وقومه وكتابه ، وقد أبعد من قال : انتقل الكلام بهذه الجملة من موسى وبني إسرائيل إلى محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) وقريش . . وشك مريب أي قوي ، مثل عجب عجيب ، وقناطير مقنطرة ، والقصد من الآية بمجموعها ان اللَّه سبحانه أخر إلى يوم القيامة عذاب من كذّب بالتوراة من قوم موسى ، وبالقرآن من قوم محمد { صلى الله عليه واله وسلم ) {وإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي ان كلا من المكذب والمصدق سيلاقي غدا جزاء عمله كافيا وافيا ان خيرا فخير ، وان شرا فشر .الاستقامة :
{ فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ ومَنْ تابَ مَعَكَ ولا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } . يختلف معنى الاستقامة باختلاف الذي تنسب إليه ، فمعنى قوله تعالى : « إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » أنه يهدي إلى هذا الصراط ، ويأمر به ، وعلى أساسه يثيب ويعاقب ، وان جميع أفعاله تعالى على وفق الحكمة والمصلحة : « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً - 116 المؤمنون » : « وما خَلَقْنَا السَّماءَ والأَرْضَ وما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا - 27 ص » .
وإذا وصفت بالاستقامة عينا من الأعيان ، وقلت : ان هذا الشيء مستقيم فمعناه أنه قد وضع في الموضع اللائق به ، أما الإنسان المستقيم فأحسن تحديد له قوله تعالى : « الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبابِ - 18 الزمر » . وأحسن القول عند اللَّه ومن آمن به هو هذا القرآن : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً - 23 الزمر » . وأحسن القول عند اللَّه والناس أجمعين والجاحدين هو ما يستريح إليه الضمير العالمي ، لا ضمير اللصوص وسفاكي الدماء . وفي الحديث عن رسول اللَّه ( صلى الله عليه واله وسلم ) أنه قال « شيبتني سورة هود » . وقيل : انه أراد هذه الآية من سورة هود ، لأن أمته أمرت بالاستقامة ، وهو غير واثق من استجابتها واستقامتها . . ونحن لا نستبعد هذا التفسير على أن يكون المراد من الأمة قادتها ، لأنهم أصل الداء ، ومصدر البلاء . . وفي ج 1 ص 26 من هذا التفسير تحدثنا عن الاستقامة ، وان الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه يتلخص بكلمة واحدة ، وهي الاستقامة .
مسؤولية التضامن ضد الظلم :
{ ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ } . ولا يختص الذين ظلموا بالمعتدين على الناس وحرياتهم ، فقد جاء في الأخبار وفي نهج البلاغة :
« الظلم ثلاثة : ظلم لا يغفر ، وظلم لا يترك ، وظلم مغفور لا يطلب ، فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك باللَّه ، واما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات - أي صغار الذنوب - واما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض » .
ومعنى الركون إلى الشيء الاعتماد عليه ، ولكن المراد بالركون إلى الظالمين في الآية ما يعم السكوت عنهم لوجوب النهي عن المنكر ، وفي الحديث : « إذا رأى الناس المنكر بينهم ، فلم ينكروه يوشك أن يعمهم اللَّه بعقابه » . وقال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : « نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة » . وفي كتاب الوسائل باب « الجهاد عن المعصوم » : ان المسلم يقاتل عن بيضة الإسلام ، أو عند الخوف على ديار المسلمين . واستنادا إلى هذه الأخبار وغيرها قسم الفقهاء الجهاد إلى نوعين :
الأول : جهاد الغزو في سبيل اللَّه ، وانتشار الإسلام . الثاني : الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين ، والدفاع عن النفس والمال والعرض ، بل الدفاع عن الحق إطلاقا ، سواء أكان له ، أم لغيره ، قال صاحب الجواهر : « إذا داهم عدو من الكفار يخشى منه على بيضة الإسلام ، أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد المسلمين ، وأسرهم وسبيهم وأخذ أموالهم - إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحر والعبد الذكر والأنثى ، والسليم والمريض ، والأعمى والأعرج ، وغيرهم ان احتيج إليهم . ولا يتوقف الوجوب على حضور الإمام ، ولا إذنه ، ولا يختص بالمعتدى عليهم والمقصودين بالخصوص ، بل يجب النهوض على كل من علم بالحال ، وان لم يكن الاعتداء موجها إليه ، هذا إذا لم يعلم بأن من يراد الاعتداء عليهم قادرين على صد العدو ومقاومته ، ويتأكد الوجوب على الأقرب من مكان الهجوم فالأقرب » .
ثم قال صاحب الجواهر : « ودفاع الإنسان عن نفسه واجب ، وان لم يظن سلامتها ، لأنه معرض للخطر على كل حال ، أما دفاعه عن عرضه وماله فواجب ان غلب على ظنه السلامة بنفسه مخافة ان تذهب النفس مع العرض والمال . وكذا يجب على الإنسان أن يدافع عن حياة الغير وماله وعرضه بشرط أن يغلب على ظنه السلامة بنفسه » .
وأفتى الفقهاء بوجوب إنقاذ الغريق ، وإطفاء الحريق إذا شب في مال الغير ، وبأن على المصلي أن يقطع صلاته ليدفع الخطر عن نفس محترمة أو مال يجب حفظه سواء أكان له أم لغيره ، وان من رأى طفلا في فلاة لا يستقل بدفع الأذى عن نفسه وجب عليه التقاطه وحفظه . وروي ان ثلاثة نفر رفعوا إلى الإمام علي ( عليه السلام ) :
واحدا أمسك رجلا ، والثاني قتله ، والثالث رأى ولم يحرك ساكنا ، فقضى بقتل القاتل ، وسجن الممسك مؤبدا ، وان تسمل عينا الممسك . وقد عمل الفقهاء بهذه الرواية .
ويجد الباحث المتتبع لكتب الفقه الكثير من هذا النوع ، وفيه الدلالة القاطعة على أن نصرة الإنسان لأخيه الإنسان ونجدته تجب شرعا إذا توقف عليها صيانة أمر هام .
{ وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ } . والطرف الأول من النهار الصبح ، والثاني الظهر والعصر ، والزلف من الليل المغرب والعشاء . وفي الآية 78 من سورة الإسراء : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » ودلوك الشمس زوالها ، وهو وقت صلاة الظهر وبعدها العصر ، وغسق الليل ظلمته ، وهو وقت صلاة المغرب وبعدها العشاء ، وقرآن الفجر يعني صلاة الصبح يشهدها الناس ، والتفصيل في كتب الفقه ومنها الجزء الأول من فقه الإمام الصادق .
{ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ } . نقل صاحب مجمع البيان عن أكثر المفسرين ان المراد بالحسنات هنا الصلوات الخمس ، وانها تكفّر ما بينها من الذنوب .
وقال آخرون : بل المراد بها مجرد قول : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله الا اللَّه واللَّه أكبر . وكل من التفسيرين يرفضه العقل والفطرة ، حيث لا ترابط ولا تلازم بين الأحكام والتكاليف لا شرعا ولا عقلا ولا قانونا ولا عرفا . . فطاعة أي حكم وجوبا كان أو تحريما لا تناط بطاعة غيره أو معصيته . أما حديث كلما صلى صلاة كفّر ما بينهما من الذنوب ، وما إليه فهو كناية عن أن الصلاة كثيرة الحسنات ، فإن كان للمصلي سيئات وضعت هذه في كفة ، وتلك في كفة ، وذهبت كل حسنة بسيئة شريطة ألا تكون كبيرة ، ولا حقا من حقوق الناس . وتقدم الكلام عن هذا الموضوع بعنوان : « الإحباط » عند تفسير الآية 217 من سورة البقرة ج 1 ص 326 .
{ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ } .ذلك إشارة إلى الأمر بالاستقامة ، وإقامة الصلاة ، والنهي عن الركون إلى الظالمين ، والمراد بالذاكرين المتعظون { واصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهً لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ } . وفيه إشارة إلى أن من يستقيم على الطريقة المثلى لا بد ان يلاقي الكثير من أهل الضلال والانحراف ، وان الصبر في جهادهم من أفضل الطاعات ، وأعظم الحسنات .
__________________
1- التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية،ج4، ص 272-276.
قوله تعالى:{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} لما كانت هذه الآيات مسوقة للاعتبار بالقصص المذكورة في السورة، وكانت القصص نفسها سردت ليتعظ بها القوم ويقضوا بالحق في اتخاذهم شركاء لله سبحانه، وتكذيبهم بآيات الله ورمي القرآن بأنه افتراء على الله تعالى.
تعرض في هذه الآيات - المسوقة للاعتبار - لأمر اتخاذهم الآلهة وتكذيب القرآن فذكر تعالى أن عبادة القوم للشركاء كعبادة أسلافهم من الأمم الماضية لها وسينالهم العذاب كما نال أسلافهم وإن اختلافهم في كتاب الله كاختلاف أمة موسى (عليه السلام) فيما آتاه الله من الكتاب وأن الله سيقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، فقوله:{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ} إشارة إلى اختلاف اليهود في التوراة بعد موسى.
وقوله:{ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} كرر سبحانه في كتابه ذكر أن اختلاف الناس في أمر الدنيا أمر فطروا عليها لكن اختلافهم في أمر الدين لا منشأ له إلا البغي بعد ما جاءهم العلم، قال تعالى:{وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا}: يونس: 19 وقال:{ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ }: آل عمران: 19، وقال:{ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ}: البقرة: 213.
وقد قضى الله سبحانه أن يوفي الناس أجر ما عملوه وجزاء ما اكتسبوه، وكان مقتضاه أن يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه حينما اختلفوا لكنه تعالى قضى قضاء آخر أن يمتعهم في الأرض إلى يوم القيامة ليعمروا به الدنيا، ويكتسبوا في دنياهم لأخراهم كما قال:{ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}: البقرة: 36، ومقتضى هذين القضاءين أن يؤخر القضاء بين المختلفين في دين الله وكتابه بغيا، إلى يوم القيامة.
فإن قلت: فما بال الأمم الماضية أهلكهم الله لظلمهم فهلا أخرهم إلى يوم القيامة لكلمة سبقت منه.
قلت: ليس منشأ إهلاكهم كفرهم ولا معاصيهم وبالجملة مجرد اختلافهم في أمر الدين حتى يعارضه القضاء الآخر ويؤخره إلى يوم القيامة، بل قضاء آخر ثالث يشير إليه قوله سبحانه:{ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون}: يونس: 47.
وبالجملة قوله:{ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم} يشير إلى أن اختلاف الناس في الكتاب ملتقى قضاءين من الله سبحانه يقتضي أحدهما الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقتضي الآخر أن يمتعهم الله إلى يوم القيامة فلا يجازيهم بأعمالهم، ومقتضى ذلك كله أن يتأخر عذابهم إلى يوم القيامة.
وقوله:{وإنهم لفي شك منه مريب} الإرابة إلقاء الشك في القلب، فتوصيف الشك بالمريب من قبيل قوله:{ظلا ظليلا} و{حجابا مستورا} و{حجرا محجورا} وغير ذلك، ويفيد تأكدا لمعنى الشك.
والظاهر أن مرجع الضمير في قوله:{وإنهم} أمة موسى وهم اليهود، وحق لهم أن يشكوا فيه فإن سند التوراة الحاضرة ينتهي إلى ما كتبه لهم رجل من كهنتهم يسمى عزراء عند ما أرادوا أن يرجعوا من بابل بعد انقضاء السبي إلى الأرض المقدسة، وقد أحرقت التوراة قبل ذلك بسنين عند إحراق الهيكل فانتهاء سندها إلى واحد يوجب الريب فيها طبعا ونظيرها الإنجيل من جهة سنده.
على أن التوراة الحاضرة يوجد فيها أشياء لا ترضى الفطرة الإنسانية أن تنسبها إلى كتاب سماوي ومقتضاه الشك فيها.
وأما إرجاع الضمير في قوله:{وإنهم} إلى مشركي العرب، وفي قوله:{منه} إلى القرآن كما فعله بعض المفسرين فبعيد من الصواب لأن الله سبحانه قد أتم الحجة عليهم في صدر السورة أنه كتابه المنزل من عنده على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) وتحدى بمثل قوله:{قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات} ولا معنى مع ذلك لإسناد شك إليهم.
قوله تعالى:{ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} لفظة إن هي المشبهة بالفعل واسمها قوله:{كلا} منونا مقطوعا عن الإضافة والتقدير كلهم أي المختلفين، وخبرها قوله:{ليوفينهم} واللام والنون لتأكيد الخبر، وقوله:{لما} مؤلف من لام تدل على القسم وما مشددة تفصل بين اللامين، وتفيد مع ذلك تأكيدا، وجواب القسم محذوف يدل عليه خبر إن.
والمعنى - والله أعلم - وإن كل هؤلاء المختلفين أقسم ليوفينهم ويعطينهم ربك أعمالهم أي جزاءها أنه بما يعملون من أعمال الخير والشر خبير.
ونقل في روح المعاني، عن أبي حيان عن ابن الحاجب أن{لما} في الآية هي لما الجازمة وحذف مدخولها شائع في الاستعمال يقال: خرجت ولما، وسافرت ولما.
ثم قال: والأولى على هذا أن يقدر: لما يوفوها أي وإن كلا منها لما يوفوا أعمالهم ليوفينهم ربك إياها. وهذا وجه وجيه.
ولأهل التفسير في مفردات الآية ونظمها أبحاث أدبية طويلة لا يهمنا منها أزيد مما أوردناه، ومن شاء الوقوف عليها فليراجع مطولات التفاسير.
قوله تعالى:{ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} يقال: قام كذا وثبت وركز بمعنى واحد كما ذكره الراغب وغيره، والظاهر أن الأصل المأخوذ به في ذلك قيام الإنسان وذلك أن الإنسان في سائر حالاته وأوضاعه غير القيام كالقعود والانبطاح والجثو والاستلقاء والانكباب لا يقوى على جميع ما يرومه من الأعمال كالقبض والبسط والأخذ والرد وسائر ما الإنسان مهيمن عليه بالطبع لكنه إذا قام على ساقه قياما كان على أعدل حالاته الذي يسلطه على عامة أعماله من ثبات وحركة وأخذ ورد وإعطاء ومنع وجلب ودفع، وثبت مهيمنا على ما عنده من القوى وأفعالها، فقيام الإنسان يمثل شخصيته الإنسانية بما له من الشئون.
ثم استعير في كل شيء لأعدل حالاته الذي يسلط معه على آثاره وأعماله فقيام العمود أن يثبت على طوله وقيام الشجر أن يركز على ساقه متعرقا بأصله في الأرض، وقيام الإناء المحتوي على مائع أن يقف على قاعدته فلا يهراق ما فيه وقيام العدل أن ينبسط على الأرض، وقيام السنة والقانون أن تجري في البلاد.
والإقامة جعل الشيء قائما أي جعله بحال يترتب عليه جميع آثاره بحيث لا يفقد شيئا منها كإقامة العدل وإقامة السنة وإقامة الصلاة وإقامة الشهادة، وإقامة الحدود، وإقامة الدين ونحو ذلك.
والاستقامة طلب القيام من الشيء واستدعاء ظهور عامة آثاره ومنافعه فاستقامة الطريق اتصافه بما يقصد من الطريق كالاستواء والوضوح وعدم إضلاله من ركبه، واستقامة الإنسان في أمر أن يطلب من نفسه القيام به وإصلاحه بحيث لا يتطرق إليه فساد ولا نقص، ويأتي تاما كاملا، قال تعالى:{ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ}: فصلت: 6 أي قوموا بحق توحيده في ألوهيته، وقال:{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا}: حم السجدة: 30 أي ثبتوا على ما قالوا في جميع شئون حياتهم لا يركنون في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم إلا إلى ما يوافق التوحيد ويلائمه أي يراعونه ويحفظونه في عامة ما يواجههم في باطنهم وظاهرهم.
وقال:{ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا}: الروم: 30 فإن المراد بإقامة الوجه إقامة النفس من حيث تستقبل العمل وتواجهه، وإقامة الإنسان نفسه في أمر هي استقامته فيه فافهم.
فقوله:{فاستقم كما أمرت} أي كن ثابتا على الدين موفيا حقه طبق ما أمرت بالاستقامة، وقد أمر به في قوله:{وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين}: يونس: 105، وقوله:{ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}: الروم: 30.
قال في روح المعاني،: أمر رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بها وهذا يقتضي أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بوحي آخر ولوغير متلوكما قاله غير واحد، والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة، وهي لزوم المنهج المستقيم وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط، وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق.انتهى.
أما احتماله أن يكون هناك وحي آخر غير متلويشير إليه قوله تعالى:{كما أمرت} أي استقم كما أمرت سابقا بالاستقامة فبعيد عن سنة القرآن وحاشا أن يعتمد بالبيان القرآني على أمر مجهول أو أصل مستور غير مذكور، وقد عرفت أن الإشارة بذلك على ما أمره الله به من إقامة وجهه للدين حنيفا، وإقامة الوجه للدين هو الاستقامة في الدين، وقد ورد قوله:{أقم وجهك للدين} - كما عرفت - في سورتين كلتاهما مكيتان، وسورة يونس التي هي إحداهما نازلة قبل هذه السورة قطعا وإن لم يسلم ذلك في السورة الأخرى التي هي سورة الروم.
وأما قوله:{إن المراد بقوله:{استقم} الدوام على الاستقامة وهي لزوم المنهج المستقيم المتوسط بين الإفراط والتفريط فقد عرفت أن معنى استقامة الإنسان في أمر ثبوته على حفظه وتوفية حقه بتمامه وكماله، واستقامة الإنسان مطلقا ركوزه وثبوته لما يرد عليه من الوظائف بتمام قواه وأركانه بحيث لا يترك شيئا من قدرته واستطاعته لغى لا أثر له.
ولو كان المراد بالأمر بالاستقامة هو الأمر بلزوم الاعتدال بين الإفراط والتفريط لكان الأنسب أن يردف هذا الأمر بالنهي عن الإفراط والتفريط معا مع أنه تعالى عقبه بقوله:{ولا تطغوا} فنهى عن الإفراط فقط، وهو بمنزلة عطف التفسير لقوله:{ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ} وهذا أحسن شاهد على أن المراد بقوله:{فاستقم} إلخ الأمر بإظهار الثبات على العبودية ولزوم القيام بحقها، ثم نهى عن تعدي هذا الطور والاستكبار عن الخضوع لله والخروج بذلك عن زي العبودية فقيل:{ولا تطغوا} كما فعل ذلك الأمم الماضية، ولم يكونوا مبتلين إلا بالإفراط دون التفريط والاستكبار دون التذلل.
وقوله:{ومن تاب معك} عطف على الضمير المستكن في{استقم} أي استقم أنت ومن تاب معك أي استقيموا جميعا وإنما أخرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من بينهم وأفرده بالذكر معهم تشريفا لمقام النبوة، وعلى ذلك تجري سنته تعالى في كلامه كقوله تعالى:{ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ}: البقرة: 285 وقوله:{يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه}: التحريم: 8.
على أن الأمر الذي تقيد به قوله:{فاستقم} أعني قوله:{كما أمرت} يختص بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يشاركه فيه غيره فإن ما ذكر من مثل قوله:{فأقم وجهك للدين}{إلخ} خاص به فلو قيل: فاستقيموا لم يصح تقييده بالأمر السابق.
والمراد بمن تاب مع النبي المؤمنون الذين رجعوا إلى الله بالإيمان وإطلاق التوبة على أصل الإيمان - وهو رجوع من الشرك - كثير الورود في القرآن كقوله تعالى:{ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ}: غافر: 7 إلى غير ذلك.
وقوله:{ولا تطغوا} أي لا تتجاوزوا حدكم الذي خطته لكم الفطرة والخلقة وهو العبودية لله وحده كما تجاوزه الذين قبلكم فأفضاهم إلى الشرك وساقهم إلى الهلكة، والظاهر أن الطغيان بهذا المعنى مأخوذ من طغى الماء إذا جاوز حده، ثم استعير لهذا الأمر المعنوي الذي هو طغيان الإنسان في حياته لتشابه الأثر وهو الفساد.
وقوله:{إنه بما تعملون بصير} تعليل لمضمون ما تقدمه، ومعنى الآية اثبت على دين التوحيد والزم طريق العبودية من غير تزلزل وتذبذب، وليثبت الذين آمنوا معك، ولا تتعدوا الحد الذي حد لكم لأن الله بصير بما تعملون فيؤاخذكم لوخالفتم أمره.
وفي الآية الكريمة من لحن التشديد ما لا يخفى فلا يحس فيها بشيء من آثار الرحمة وأمارات الملاطفة وقد تقدمها من الآيات ما يتضمن من حديث مؤاخذة الأمم الماضية والقرون الخالية بأعمالهم واستغناء الله سبحانه عنهم ما تصعق له النفوس وتطير القلوب.
غير ما في قوله:{فاستقم كما أمرت} من أفراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالذكر وإخراجه من بين المؤمنين تشريفا لمقامه لكن ذلك يفيد بلوغ التشديد في حقه فإن تخصيصه قبلا بالذكر يوجب توجه هول الخطاب وروع التكليم من مقام العزة والكبرياء إليه وحده عدل ما يتوجه إلى جميع الأمة إلى يوم القيامة كما وقع نظير التشديد في قوله تعالى:{ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ}: إسراء: 75.
ولذلك ذكر أكثر المفسرين أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):{شيبتني سورة هود} ناظر إلى هذه الآية، وسيوافيك الكلام فيه في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى:{ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} قال في الصحاح،: ركن إليه كنصر، ركونا: مال وسكن، والركن بالضم الجانب الأقوى.
والأمر العظيم والعز والمنعة انتهى وعن لسان العرب، مثله، وعن المصباح، أن الركون هو الاعتماد على الشيء.
وقال الراغب:، ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه، ويستعار للقوة، قال تعالى:{لو أن لي بكم قوة أوآوي إلى ركن شديد} وركنت إلى فلان أركن بالفتح والصحيح أن يقال: ركن يركن - كنصر - وركن يركن كعلم - قال تعالى:{ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} وناقة مركنة الضرع له أركان تعظمه والمركن الإجابة، وأركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها. انتهى وهذا قريب مما ذكره في المصباح،.
والحق أنه الاعتماد على الشيء عن ميل إليه لا مجرد الاعتماد فحسب ولذلك عدي بإلى لا بعلى وما ذكره أهل اللغة تفسير له بالأعم من معناه على ما هو دأبهم.
فالركون إلى الذين ظلموا هو نوع اعتماد عليهم عن ميل إليهم إما في نفس الدين كأن يذكر بعض حقائقه بحيث ينتفعون به أو يغمض عن بعض حقائقه التي يضرهم إفشاؤها وإما في حياة دينية كان يسمح لهم بنوع من المداخلة في إدارة أمور المجتمع الديني بولاية الأمور العامة أو المودة التي تقضي إلى المخالطة والتأثير في شئون المجتمع أو الفرد الحيوية.
وبالجملة الاقتراب في أمر الدين أو الحياة الدينية من الذين ظلموا بنوع من الاعتماد والاتكاء يخرج الدين أو الحياة الدينية عن الاستقلال في التأثير ويغيرهما عن الوجهة الخالصة، ولازم ذلك السلوك إلى الحق من طريق الباطل أو إحياء حق بإحياء باطل وبالآخرة إماتة الحق لإحيائه.
والدليل على هذا الذي ذكرنا أنه تعالى جمع في خطابه في هذه الآية الذي هو من تتمة الخطاب في الآية السابقة بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين المؤمنين من أمته، والشئون التي له ولأمته هي المعارف الدينية والأخلاق والسنن الإسلامية في تبليغها وحفظها وإجرائها والحياة الاجتماعية بما يطابقها، وولاية أمور المجتمع الإسلامي، وانتحال الفرد بالدين واستنانه بسنة الحياة الدينية فليس للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا لأمته أن يركنوا في شيء من ذلك إلى الذين ظلموا.
على أن من المعلوم أن هاتين الآيتين كالنتيجة المأخوذة من قصص القرى الظالمة التي أخذهم الله بظلمهم وهما متفرعتان عليها ناظرتان إليها، ولم يكن ظلم هؤلاء الأمم الهالكة في شركهم بالله تعالى وعبادة الأصنام فحسب بل كان مما ذمه الله من فعالهم اتباع الظالمين والفساد في الأرض بعد إصلاحها وهو الاستنان بالسنن الظالمة التي يقيمها الولاة الجائرون، ويستن بها الناس وهم بذلك ظالمون.
ومن المعلوم أيضا من السياق أن الآيتين مترتبتان في غرضهما فالأولى تنهى عن أن يكونوا من أولئك الذين ظلموا، والثانية تنهى أن يقتربوا منهم ويميلوا إليهم ويعتمدوا في حقهم على باطلهم فقوله:{لا تركنوا إلى الذين ظلموا} نهي عن الميل إليهم والاعتماد عليهم والبناء على باطلهم في أمر أصل الدين والحياة الدينية جميعا.
ووقوع الآيتين موقع النتيجة المتفرعة على ما تقدم من القصص المذكورة يفيد أن المراد بالذين ظلموا في الآية ليس من تحقق منه الظلم تحققا ما وإلا لعم جميع الناس إلا أهل العصمة ولم يبق للنهي حينئذ معنى، وليس المراد بالذين ظلموا الظالمين أي المتلبسين بهذا الوصف المستمرين في ظلمهم فإن لإفادة الفعل الدال على مجرد التحقق معنى الصفة الدالة على التلبس والاستمرار أسبابا لا يوجد في المقام منها شيء ولا دلالة لشيء على شيء جزافا.
بل المراد بالذين ظلموا أناس حالهم في الظلم حال أولئك الذين قصهم الله في الآيات السابقة من الأمم الهالكة، وكان الشأن في قصتهم أنه تعالى أخذ الناس جملة واحدة في قبال الدعوة الإلهية المتوجهة إليهم ثم قسمهم إلى من قبلها منهم وإلى من ردها ثم عبر عمن قبلها بالذين آمنوا في بضعة مواضع من القصص المذكورة وعمن ردها بالذين ظلموا وما يقرب منه في أكثر من عشر مواضع كقوله:{ولا تخاطبني في الذين ظلموا} وقوله:{وأخذت الذين ظلموا الصيحة} وقوله:{ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} وقوله:{ألا إن ثمود كفروا ربهم} وقوله:{ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ} إلى غير ذلك.
فقد عبر سبحانه عن ردهم وقبولهم قبال الدعوة الإلهية وبالقياس إليها بالفعل الماضي الدال على مجرد التحقق والوقوع، وأما في الخارج من مقام القياس والنسبة فإن التعبير بالصفة كقوله:{وقيل بعدا للقوم الظالمين} وقوله:{وما هي من الظالمين} وقوله:{ولا تتولوا مجرمين} إلى غير ذلك وهو كثير.
ومقتضى مقام القياس والنسبة إلى الدعوة قبولا وردا أن يكتفي بمجرد الوقوع والتحقق، ويبين أنهم وسموا بإحدى السمتين: الإيمان أوالظلم، ولا حاجة إلى ذكر الاتصاف والاستمرار بالتلبس فمفاد قوله: ظلموا وعصوا واتبعوا أمر فرعون أنهم وسموا بسمة الظلم والعصيان واتباع أمر فرعون، ومعنى نجينا الذين آمنوا نجينا الذين اتسموا بسمة الإيمان وتعلموا بعلامته.
فكان التعبير بالماضي كافيا في إفادة أصل الاتسام المذكور وإن كان مما يلزمه الاتصاف، وبعبارة أخرى الذين ظلموا من قوم نوح صاروا بذلك ظالمين لكن العناية إنما تعلقت بحسب المقام بتحقق الظلم منهم لا بصيرورته وصفا لهم لا يفارقهم بعد ذلك، ولذا ترى أنه كلما خرج الكلام عن مقام القياس والنسبة بوجه عاد إلى التعبير بالصفة كقوله:{بعدا للقوم الظالمين} وقوله:{ولا تكن مع الكافرين} فافهم ذلك.
ومن هنا يظهر ما في تفسير القوم قوله:{الذين ظلموا} حيث أخذه بعضهم دالا على مجرد تحقق ظلم ما، وآخرون بمعنى الوصف أي لا تركنوا إلى الظالمين، قال صاحب المنار في تفسيره،: فسر الزمخشري{الذين ظلموا} بقوله: أي إلى الذين وجد منهم الظلم ولم يقل: إلى الظالمين، وحكى أن الموفق صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية فغشي عليه فلما أفاق قيل له، فقال؟ هذا فيمن ركن إلى ظلم فكيف بالظالم انتهى.
ومعنى هذا أن الوعيد في الآية يشمل من مال ميلا يسيرا إلى من وقع منه ظلم قليل أي ظلم كان، وهذا غلط أيضا وإنما المراد بالذين ظلموا في الآية فريق الظالمين من أعداء المؤمنين الذين يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم من المشركين ليردوهم عنه فهم كالذين كفروا في الآيات الكثيرة التي يراد بها فريق الكافرين لا كل فرد من الناس وقع منه كفر في الماضي وحسبك منه قوله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}: البقرة: 6، والمخاطبون بالنهي هم المخاطبون في الآية السابقة بقوله:{فاستقم كما أمرت ومن تاب معك}.
وقد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين بالذين ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم من هذه السورة به في الآيات 37، 67، 94، وعبر عنهم فيها بالظالمين أيضا كقوله:{وقيل بعدا للقوم الظالمين} فلا فرق في هذه الآيات بين التعبير بالوصف والتعبير بالذي وصلته فإنهما في الكلام عن الأقوام بمعنى واحد - انتهى.
أما قول صاحب الكشاف:{إن المراد بالذين ظلموا} الذين وجد منهم الظلم ولم يقل:{إلى الظالمين} فهو كذلك لكنه لا ينفعه فإن التعبير بالفعل في ما قررناه من المقام وإن كان لا يفيد أزيد من تحقق المعنى الحدثي ووقوعه لكنه ينطبق على معنى الوصف كما في قوله تعالى:{فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى}: النازعات: 41 حيث عبر بالفعل وهو منطبق على معنى الصفة.
وأما قول صاحب المنار:(إنما المراد بالذين ظلموا في الآية فريق الظالمين من أعداء المؤمنين الذين يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم من المشركين ليردوهم عنه) فتحكم محض، وأي دليل يدل على قصور الآية عن الشمول للظالمين من أهل الكتاب وقد ذكرهم الله أخيرا في زمرة الظالمين باختلافهم في كتاب الله بغيا، وقد نهى الله عن ولايتهم وشدد فيه حتى قال:{ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}: المائدة: 51، وقال في ولاية مطلق الكافرين،{ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ}: آل عمران: 28.
وأي مانع يمنع الآية أن تشمل الظالمين من هذه الأمة وفيهم من هو أشقى من جبابرة عاد وثمود وأطغى من فرعون وهامان وقارون.
ومجرد كون الإسلام عند نزول السورة مبتلى بقريش ومشركي مكة وحواليها لا يوجب تخصيصا في اللفظ فإن خصوص المورد لا يخصص عموم اللفظ فالآية تنهى عن الركون إلى كل من اتسم بسمة الظلم، أي من كان مشركا أو موحدا مسلما أومن أهل الكتاب.
وأما قوله: إن المراد بقوله:{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} المعنى الوصفي وإن كان فعلا أي الكافرون لا كل فرد من الناس وقع من كفر في الماضي.
ففيه أنا بينا في الكلام على تلك الآية وفي مواضع أخرى تقدمت في الكتاب أن الآية خاصة بالكفار من صناديد قريش الذين شاقوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بادىء أمره حتى كفاه الله إياهم وأفناهم ببدر وغيره، وأنهم المسمون بالذين كفروا.
وليست الآية عامة، ولو كانت الآية عامة وكان المراد بالذين كفروا هم الكافرين كما قاله لم تصدق الآية فيما تخبر به فما أكثر من آمن من الكافرين حتى من كفار مكة بعد نزول هذه الآية.
ولو قيل: إن المراد بهم الذين لم يؤمنوا إلى آخر عمرهم لم تفد الآية شيئا إذ لا معنى لقولنا: إن الكافرين الذين لا يؤمنون إلى آخر عمرهم لا يؤمنون فلا مناص من أخذها آية خاصة غير عامة، وكون المراد بالذين كفروا طائفة خاصة بأعيانهم.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن{الذين آمنوا} أيضا فيما لا دليل في المورد يدل على خلافه اسم تشريفي لمن آمن بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أول دعوته الحقة، وبهم تختص خطابات{يا أيها الذين آمنوا} في القرآن وإن شاركهم غيرهم في الأحكام.
وأما قوله في آخر كلامه: وقد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين بالذين ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم من هذه السورة به وعبر عنهم فيها بالظالمين أيضا فلا فرق بين التعبيرين{إلخ} ومحصله أن التعبير عنهم تارة بالذين ظلموا وتارة بالظالمين دليل على أن المراد بالكلمتين واحد.
ففيه أنه خفي عليه وجه العناية الكلامية الذي تقدمت الإشارة إليه واتحاد مصداق اللفظتين لا يوجب وحدة العناية المتعلقة بهما.
فالمحصل من مضمون الآية نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمته عن الركون إلى من اتسم بسمة الظلم بأن يميلوا إليهم ويعتمدوا على ظلمهم في أمر دينهم أوحياتهم الدينية فهذا هو المراد بقوله:{ولا تركنوا إلى الذين ظلموا}.
وقوله:{فتمسكم النار} تفريع على الركون أي عاقبة الركون هو مس النار، وقد جعلت عاقبة الركون إلى ظلم أهل الظلم مس النار وعاقبة نفس الظلم النار، وهذا هو الفرق بين الاقتراب من الظلم والتلبس بالظلم نفسه.
وقوله:{وما لكم من دون الله من أولياء} في موضع الحال من مفعول{فتمسكم} أي تمسكم النار في حال ليس لكم فيها من دون الله من أولياء وهو يوم القيامة الذي يفقد فيه الإنسان جميع أوليائه من دون الله.
أوحال الركون إن كان المراد بالنار العذاب، والمراد بقوله:{ثم لا تنصرون} نفي الشفاعة على الأول والخذلان الإلهي على الثاني.
والتعبير بثم في قوله:{ثم لا تنصرون} للدلالة على اختتام الأمر على ذلك بالخيبة والخذلان كأنه قيل: تمسكم النار وليس لكم إلا الله فتدعونه فلا يجيبكم وتستنصرونه فلا ينصركم فيئول أمركم إلى الخسران والخيبة والخذلان.
وقد تحصل مما تقدم من الأبحاث في الآية أمور: الأول: أن المنهي عنه في الآية إنما هو الركون إلى أهل الظلم في أمر الدين أو الحياة الدينية كالسكوت في بيان حقائق الدين عن أمور يضرهم أو ترك فعل ما لا يرتضونه أو توليتهم المجتمع وتقليدهم الأمور العامة أو إجراء الأمور الدينية بأيدهم وقوتهم وأشباه ذلك.
وأما الركون والاعتماد عليهم في عشرة أو معاملة من بيع وشرى والثقة بهم وائتمانهم في بعض الأمور فإن ذلك كله غير مشمول للنهي الذي في الآية لأنها ليست بركون في دين أو حياة دينية، وقد وثق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ما خرج من مكة ليلا إلى الغار برجل مشرك استأجر منه راحلة للطريق وائتمنه ليوافيه بها في الغار بعد ثلاثة أيام وكان يعامل هو وكذا المسلمون بمرأى ومسمع منه الكفار والمشركين.
الثاني: أن الركون المنهي عنه في الآية أخص من الولاية المنهي عنها في آيات أخرى كثيرة فإن الولاية هي الاقتراب منهم بحيث يجعل المسلمين في معرض التأثر من دينهم أو أخلاقهم أو السنن الظالمة الجارية في مجتمعاتهم وهم أعداء الدين، وأما الركون إليهم فهو بناء الدين أو الحياة الدينية على ظلمهم فهو أخص من الولاية موردا أي أن كل مورد فيه ركون ففيه ولاية من غير عكس كلي، وبروز الأثر في الركون بالفعل وفي الولاية أعم مما يكون بالفعل.
ويظهر من جمع من المفسرين أن الركون المنهي عنه في الآية هو الولاية المنهي عنها في آيات أخر.
قال صاحب المنار في تفسيره، بعد ما نقل عن الزمخشري قوله: إن النهي في الآية متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم، والتشبه بهم والتزيي بزيهم، ومد العين إلى زهرتهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم، وتأمل قوله:{ولا تركنوا} فإن الركون هو الميل اليسير، وقوله:{إلى الذين ظلموا} أي إلى الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل: إلى الظالمين. انتهى.
أقول: كل ما أدغمه في النهي عن الركون إلى الذين ظلموا قبيح في نفسه لا ينبغي للمؤمن اجتراحه، وقد يكون من لوازم الركون الحقيرة ولكن لا يصح أن يجعل شيء منه تفسيرا للآية مرادا منها، والمخاطب الأول بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والسابقون الأولون إلى التوبة من الشرك والإيمان معه، ولم يكن أحد منهم مظنة للانقطاع بظلمة المشركين، والانحطاط في هواهم، والرضا بأعمالهم.
إلى آخر ما أطنب فيه.
وقد ناقض فيه نفسه أولا حيث اعترف بكون بعض الأمور المذكورة من لوازم الركون لكنه استحقرها ونفى شمول الآية لها، والمعصية كلها عظيمة لا يستهان بها غير أن أكثر المفسرين هذا دأبهم لا ينقبضون عن نسبة بعض المساهلات إلى بيانه تعالى.
وأفسد من ذلك قوله: إن المخاطب الأول بهذا النهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والسابقون الأولون ولم يكونوا مظنة للانقطاع إلى ظلمة المشركين والانحطاط في هواهم والرضا بأعمالهم إلخ فإن فيه أولا: أن الخطاب خطاب واحد موجه إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى أمته، ولا أول فيه ولا ثاني، وتقدم بعض المخاطبين على بعض زمانا لا يوجب قصور الخطاب عن شمول بعض ما في اللاحقين مما ليس في السابقين إذا شمله اللفظ.
وثانيا: أن عدم كون المخاطب مظنة للمعصية لا يمنع من توجيه النهي إليه وخاصة النواهي الصادرة عن مقام التشريع وإنما يمنع عن تأكيده والإلحاح عليه وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عما هو أعظم من الركون إلى الذين ظلموا كالشرك بالله وعن ترك تبليغ بعض أوامره ونواهيه، قال تعالى:{ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}: الزمر: 65، وقال:{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته}: المائدة: 67، وقال:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}: الأحزاب: 2 ولا يظن به (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشرك بربه البتة، ولا أن لا يبلغ ما أنزل إليه من ربه أويطيع الكافرين والمنافقين أو لا يتبع ما يوحى إليه من ربه إلى غير ذلك من النواهي.
وكذا السابقون الأولون نهوا عن أمور هي أعظم من الركون المذكور أو مثله كقوله:{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} نزلت في أهل بدر وفيهم السابقون الأولون وقد وصف بعضهم بقوله:{الذين ظلموا} وهو أشد لحنا من قوله:{ولا تركنوا إلى الذين ظلموا}، وكعدة من النواهي الواردة في كلامه في قصص بدر وأحد وحنين، والنواهي الموجهة إلى نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فكل ذلك مما لم يكن يظن بالسابقين الأولين أن يبتلوا به على أن بعضهم ابتلي ببعضها بعد.
الثالث: أن الآية بما لها من السياق المؤيد بإشعار المقام إنما تنهى عن الركون إلى الذين ظلموا فيما هم فيه ظالمون أي بناء المسلمين دينهم الحق أوحياتهم الدينية على شيء من ظلمهم وهو أن يراعوا في قولهم الحق وعملهم الحق جانب ظلمهم وباطلهم حتى يكون في ذلك إحياء للحق بسبب إحياء الباطل، ومآله إلى إحياء حق بإماتة حق آخر كما تقدمت الإشارة إليه.
وأما الميل إلى شيء من ظلمهم وإدخاله في الدين أو إجراؤه في المجتمع الإسلامي أو في ظرف الحياة الشخصية فليس من الركون إلى الظالمين بل هو دخول في زمرة الظالمين.
وقد اختلط هذا الأمر على كثير من المفسرين فأوردوا في المقام أبحاثا لا تمس الآية أدنى مس، وقد أغمضنا عن إيرادها والبحث في صحتها وسقمها إيثارا للاختصار ومن أراد الوقوف عليها فليراجع تفاسيرهم.
قوله تعالى:{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } إلخ، طرفا النهار هو الصباح والمساء والزلف جمع زلفى كقرب جمع قربى لفظا ومعنى على ما قيل، وهو وصف ساد مسد موصوفه كالساعات ونحوها، والتقدير وساعات من الليل أقرب من النهار.
والمعنى أقم الصلاة في الصباح والمساء وفي ساعات من الليل هي أقرب من النهار، وينطبق من الصلوات الخمس اليومية على صلاة الصبح والعصر وهي صلاة المساء والمغرب والعشاء الآخرة، وقتهما زلف من الليل كما قاله بعضهم، أو على الصبح والمغرب ووقتهما طرفا النهار والعشاء الآخرة ووقتها زلف من الليل كما قاله آخرون، وقيل غير ذلك.
لكن البحث لما كان فقهيا كان المتبع فيه ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمة أهل بيته (عليهم السلام) من البيان، وسيجيء في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
وقوله:{إن الحسنات يذهبن السيئات} تعليل لقوله:{وأقم الصلاة} وبيان أن الصلوات حسنات واردة على نفوس المؤمنين تذهب بآثار المعاصي وهي ما تعتريها من السيئات، وقد تقدم كلام في هذا الباب في مسألة الحبط في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
وقوله:{ذلك ذكرى للذاكرين} أي هذا الذي ذكر وهو أن الحسنات يذهبن السيئات على رفعة قدرة تذكار للمتلبسين بذكر الله تعالى من عباده.
قوله تعالى:{ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} ثم أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصبر بعد ما أمره بالصلاة كما جمع بينهما في قوله:{واستعينوا بالصبر والصلاة}: البقرة: 45 وذلك أن كلا منهما في بابه من أعظم الأركان أعني الصلاة في العبادات، والصبر في الأخلاق وقد قال تعالى في الصلاة:{ولذكر الله أكبر}: العنكبوت: 45 وقال في الصبر:{إن ذلك لمن عزم الأمور}: الشورى: 43.
واجتماعهما أحسن وسيلة يستعان بها على النوائب والمكاره فالصبر يحفظ النفس عن القلق والجزع والانهزام، والصلاة توجهها إلى ناحية الرب تعالى فتنسى ما تلقاه من المكاره، وقد تقدم بيان في ذلك في تفسير الآية 45 من سورة البقرة في الجزء الأول من الكتاب.
وإطلاق الأمر بالصبر يعطي أن المراد به الأعم من الصبر على العبادة والصبر عن المعصية والصبر عند النائبة، وعلى هذا يكون أمرا بالصبر على جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي أعني قوله:{فاستقم}{ولا تطغوا}{ولا تركنوا}{وأقم الصلاة}.
لكن أفراد الأمر وتخصيصه بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يفيد أنه صبر في أمر يختص به وإلا قيل: و{اصبروا} جريا على السياق، وهذا يؤيد قول من قال: إن المراد اصبر على أذى قومك في طريق دعوتك إلى الله سبحانه وظلم الظالمين منهم، وأما قوله:{وأقم الصلاة} فإنه ليس أمرا بما يخصه (صلى الله عليه وآله وسلم) من الصلاة بل أمر بإقامته الصلاة بمن تبعه من المؤمنين جماعة فهو أمر لهم جميعا بالصلاة فافهم ذلك.
وقوله:{ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} تعليل للأمر بالصبر.
__________________
1- تفسير الميزان ،الطباطبائي،ج11،ص38-50.
ويسلّي القرآن قلب النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) مرّة أُخرى، فيحدّثه عن موسى وقومه قائلا: { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ} ... ويقول إِذا ما رأيت أنّ الله لا يعجل العذاب على قومك، فلأنّ مصلحة الهداية والتعليم والتربية لقومك توجب ذلك وإِلاّ فانّ القرار الالهي المسبق يقتضي التعجيل بعملية التحكيم والقضاء وبالتالي أنزال العقاب { وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ }وبالرغم من ذلك فهم في شك من هذا الامر(2).
كلمة «مريب» مشتقّة من «الريب» ومعناه الشكّ المقترن بسوء الظن والنظرة السيئة والقرائن المخالفة، وعلى هذا فيكون مفهوم هذه الكلمة أنّ عبدة الأصنام ما كانوا يترددون في مسألة حقيقة القرآن أو نزول العذاب على المفسدين فحسب، بل كانوا يدّعون بأنّ لديهم قرائن تخالف ذلك أيضاً.
أمّا «الراغب» فيقول في «مفرداتة»: إِنّ معنى الريب هو الشك الذي يرفع عنه الحجاب بعدئذ ويعود الى اليقين، فعلى هذا يكون مفهوم الآية أنّ الحجاب سيكشف عاجلا عن حقانية دعوتك وكذلك عن عقاب المفسدين وتظهر حقيقة الأمر!
ويضيف القرآن لمزيد التأكيد { وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} وهذا الأمر ليس فيه صعوبة على الله ولا حرج إِذ {إِنّه بما تعملون خبير}.
الطريف أنّ القرآن يقول: {ليوفّينهم أعمالهم} ليشير مرّة أُخرى الى مسألة تجسّم الأعمال وأنّ الجزاء والثواب هما في الحقيقة أعمال الإِنسان نفسه التي تتخذ شكلا آخر وتصل إِليه ثانيةً.
وبعد ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة ورمز نجاحهم ونصرهم، وبعد تسلية قلب النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقوية إِرادته، يبيّن القرآن ـ عن هذا الطريق ـ أهمّ دُستور أُمر به النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو {استقم كما أُمرت}.
«استقم» في طريق الإِرشاد والتبليغ ... استقم في طريق المواجهة والمواصلة ... استقم في أداء الوظائف الإِلهية ونشر التعليمات القرآنية.
ولكن هذه الإِستقامة ليست لينال فلانٌ أو فلان مستقبلا زاهراً، وليست للرياء وما شابه ذلك، وليست لإِكتساب عنوان البطولة، ولا اكتساب «المقام» أو «الثروة» أو «الموفقية» أو «القدرة»، بل هي لمجرّد طاعة الله واتباع أمره {كما أُمرت}.
كما أنّ هذه الإِستقامه ليست عليك وحدك، فعليك أن تستقيم أنت {ومن تاب معك} استقامة خاليةً من كل زيادة ونقصان وإِفراط أو تفريط {ولا تطغوا}إِذ {إِنّه بما تعملون بصير} ولا تخفى عليه حركة ولا قول ولا أي خطّة أُخرى ... الخ.
المسؤولية الكبيرة!!
نقرأ في حديث معروف عن ابن عباس أنّه قال: ما نزل على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)آية كانت أشدّ عليه ولا أشقّ من هذه الآية. ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إِليك الشيب يا رسول الله قال:(صلى الله عليه وآله وسلم) «شيبتني هود والواقعة»(3).
ونقرأ في رواية أُخرى أنّ النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال حين نزلت هذه الآية: «شمّروا شمّرُوا ... فما رُئي ضاحكاً ...»(4).
والدليل واضح، لانّ أربعة أوامر مهمّة موجودة في هذه الآية يلقي كل واحد منها عبئاً ثقيلا على الكتف.
وأهمها الأمر بالإِستقامة ... الإِستقامة (المشتقة من مادة القيام» من جهة أنّ الإِنسان يكون تسلطه وسعيه في عمله حال القيام أكثر ... الإِستقامة التي معناها طلب القيام، أي أوجِدْ حالةً في نفسك بحيث لا تجد طريقاً للضعف فيك، فما أصعَبه من أمر وما أشدّه؟!
غالباً ما يكون النجاح في العمل أمراً هيّناً نسبياً ... لكن المحافظة على النجاح فيها كثير من الصعوبة ... وفي أي مجتمع؟! في مجتمع متأخر متخلف ... في مجتمع بعيد عن العلم والتعقل .. في مجتمع لجوج وبين أعداء كثيرين معاندين ... وفي سبيل بناء مجتمع سالم وحضارة انسانية زاهرة فالإِستقامة في هذا الطريق ليس أمراً هيّناً.
والأمر الآخر: أن تحملَ هذه الإِستقامةُ هدفاً إِلهياً فحسب، وأن تكون الوساوس الشيطانية بعيدة عنها تماماً، أي أن تكتسب هذه الاستقامة أكبر القدرات السياسية والإِجتماعيّة من أجل الله.
والأمر الثّالث: مسألة قيادة أُولئك الذين رجعوا الى طريق الحق وتعويدهم على الإِستقامة أيضاً.
والأمر الرّابع: المواجهة والمبارزة في مسير الحق والعدالة والقيادة الصحيحة وصدّ كل أنواع التجاوز والطغيان، فكثيراً ما يبدي بعض الناس منتهى الإِستقامة في سبيل الوصول للهدف، لكن لا يستطيعون أن يراعوا مسألة العدالة، وغالباً ما يبتلون بالطغيان والتجاوز عن الحدّ.
أجل ... مجموع هذه الأُمور وتواليها على النّبي حمّلته مسؤولية كبرى، حتى أنه(صلى الله عليه وآله وسلم) ما رُئي ضاحكاً ... وشيّبته هذه الآية من الهمّ.
وعلى كل حال فإنّ هذا الأمر لم يكن للماضي فحسب، بل هو للماضي والحاضر والمستقبل، وهو للأمس واليوم والغد القريب والغد البعيد أيضاً.
واليوم مسؤوليتنا المهمّة ـ نحن المسلمين أيضاً، وبالخصوص قادة الإِسلام ـ تتلخّص في هذه الكلمات الأربعة. وهي: الإِستقامة، والإِخلاص، وقيادة المؤمنين، وعدم الطغيان والتجاوز. ودون ربط هذه الأُمور بعضها الى بعض فإنّ النصر على الأعداء الذين أحاطونا من كل جانب من الداخل والخارج، واستفادوا من جميع الأساليب الثقافية والسياسية والإِقتصادية والإِجتماعية والعسكريّة ... هذا النصر لايكون سوى أوهام في مخيلة المسلمين.
الرّكون إِلى الظالمين:
إِنّ هذه الآية تبيّن واحداً من أقوى وأهم الاسس والبرامج الإِجتماعية والسياسية والعسكرية والعقائدية، فتخاطب عامة المسلمين ليؤدوا وظيفتهم القطعية فتقول: {ولا تركنوا الى الذين ظلموا} والسبب واضح { فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ} ومعلوم عندئذ حالكم {ثمّ لا تُنصرون}.
الصلاة والصبر:
هذه الآيات تشير الى أمرين من أهمّ الأوامر الإِسلامية، وهما في الواقع روح الإِيمان وقاعدة الإِسلام، فيأتي الأمر أوّلا بالصلاة { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}.
وظاهر التعبير من {طرفي النهار} هو بيان صلاة الصبح وصلاة المغرب اللتين يقعان طرفي النهار، و«الزُلف» جمع «زلفة» التي تعني القرب، ويشار بها الى أوّل الليل القريب من النهار فتنطبق على صلاة العشاء.
وهذا التّفسير وارد في روايات أهل البيت{عليهم السلام) أيضاً، أي إِنّ الآية تشير الى الصلوات الثلاث «الصبح والمغرب والعشاء»(5).
سؤال:ويرد هنا سؤال وهو: لِمَ ذكرت هذه الصلوات الثلاث من بين الصلوات الخمس؟!
غموض الإِجابة دعا بعض المفسّرين لانّ يتوسع في معنى {طرفي النهار}ليشمل صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب أيضاً. وبالتعبير بـ{وزُلفاً من الليل}الذي يشير الى صلاة العشاء تكون جميع الصلوات الخمس قد دخلت في الآية!
والإِنصاف أن تعبير {طرفي النهار} لا يتحمل مثل هذا التّفسير، مع ملاحظة أنّ المسلمين في الصدر الأوّل من الإِسلام كانوا مقيدين بأداء صلاة الظهر في أوّل الوقت وأداء صلاة العصر في حدود نصف الوقت، أي بين وقت الظهر ووقت المغرب.
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال هنا: أنّ آيات القرآن قد تذكر جميع الصلوات الخمس أحياناً كما في سورة الإِسراء: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}(الاسراء،78).
وقد تذكر ثلاث صلوات ـ كالآية محل البحث ـ وقد تذكر صلاة واحدة كما في سورة البقرة { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(البقرة ،238).
فعلى هذا لا يستلزم ذكر جميع الصلوات الخمس في كل مورد، وقد توجب المناسبات الإِشارة الى صلاة الظهر «الصلاة الوسطى» لأهميتها أو تشير الى صلاة الصبح أو المغرب والعشاء وذلك لإِحتمال أن تقع في دائرة النسيان للتعب أو النوم.
ولأهمية الصلوات اليوميّة ـ خاصّة ـ وجميع العبادات والطاعات والحسنات ـ عموماً ـ فإنّ القرآن يشير بهذا التعبير { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}.
والآية آنفة الذكر كسائر آيات القرآن تبيّن تأثير الأعمال الصالحة في محو أثر الأعمال السيئة، حيث نقرأ في سورة النساء الآية (31): { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} ونقرأ في سوره العنكبوت الآية (7): { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ}.
وبهذا تثبت مقولة إِبطال السيئات بالطاعات والأعمال الحسنة.
ومن الناحية النفسية ـ أيضاً ـ لا ريب في أن الذنب والعمل السيء يوجد نوعاً من الظلمة في روح الإِنسان ونفسه، بحيث لو استمرّ على السيئات تتراكم عليه الآثار فتمسخ الإِنسان بصورة موحشة.
ولكن العمل الصالح الصادر من الهدف الإِلهي يهب روح الإِنسان لطافةً بامكانها أن تغسل آثار الذنوب وأن تبدّلَ ظلمات نفسه إِلى أنوار.
وبما أنّ الجملة الآنفة {إِنّ الحسنات يذهبن السيئات} ذكرت بعد الأمر بإقامة الصلاة مباشرة، فإنّ واحدة من مصاديقها هي الصلاة اليومية،(6) وإِذا ما لاحظنا في الرّوايات إِشارة الى الصلاة اليومية (7)في التّفسير فحسب فليس ذلك دليلا على الإِنحصار، بل ـ كما قلنا مراراً ـ إِنّما هو بيان مصداق واضح قطعي.
الأهميّة القصوى للصلاة:
تلاحظ في الرّوايات المتعددة المنقولة عن النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة الطاهرين(عليهم السلام)تعبيرات تكشف عن الأهمية الكبرى للصلاة في نظر الإِسلام.
يقول أبو عثمان: كنت جالساً مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ غصناً يابساً وهزّه حتى تساقطت أوراقه جميعاً، ثمّ التفت إِليّ وقال: ما سألتني لم فعلت ذلك؟!
فقلتُ: وما تريد؟!
قال: هذا ما كان من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حين كنت جالساً معه تحت شجرة ثمّ سألني النّبي هذا السؤال وقال: «ما سألتني لِمَ فعلت ذلك؟».
فقلت له: ولمَ يا رسولَ الله؟
فقال: «إِنّ المسلم إِذا توضأ فأحسن الوضوء ثمّ صلّى الصلوات الخمس تحاتّت خطاياه كما تحاتّ هذا الورق» ثمّ قرأ الآية «وأقم الصلاة ... الخ».(8)
ونقرأ في حديث آخر عن أحد أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) واسمه أبو أمامة أنّه قال: «كنت جالساً يوماً في المسجد مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فجاءه رجل وقال: يا رسول الله، أذنبت ذنباً يستوجب الحدّ فأقم عليَّ الحدّ، فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): «أصليت معنا؟» قال: نعم يا رسول الله، فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): «فإن الله غفر ذنبك» ... أو «أسقط عنك الحد»(9).
كما نقل عن علي(عليه السلام) أنه قال: «كنّا مع رسول الله ننتظر الصلاة فقام رجل وقال: يا رسول الله، أذنبت. فأعرض النّبي بوجهه عنه، فلما إنتهت الصلاة قام ذلك الرجل وأعاد كلامه ثانيةً، فقال النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم): ألم تصلّ معنا وأحسنت لها الوضوء؟ فقال بلى، فقال: هذه كفارة ذنبك»(10).
ونقل عن علي(عليه السلام) أيضاً أنّه قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إِنّما منزلة الصلوات الخمس لأُمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما يظن أحدكم لو كان في جسده درن ثمّ اغتسل في ذلك النهر خمس مرات، أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأُمتي»(11).
وعلى كل حال، لا مجال للشكّ في أنّه متى ما أدّيت الصلاة بشرائطها فإنّها تنقل الإِنسان الى عالم من المعنويّة والروحانيّة بحيث توثق علائقه الإِيمانية بالله، وتغسل عن قلبه وروحه الأدران وآثار الذنوب.
الصلاة تجير الإِنسان من الذنب، تجلو صدأ القلوب.
الصلاة تجذّر الملكات السامية للإِنسان في أعماق الروح البشرية، والصلاة تقوي الإِرادة وتطهر القلب والروح، وبهذا الترتيب فإن الصلاة الواعية الفاعلة هي مذهب تربوي عظيم.
أرجى آية في القرآن:
ينقل في تفسير الآية ـ محل البحث ـ حديث طريف عن الإِمام علي(عليه السلام) بهذا المضمون، وهو أنّه التفت مرّة الى الناس وقال: «أي آية في كتاب الله أرجى عندكم»؟!
فقال بعضهم: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }.(النساء ،48،116)
فقال(عليه السلام): حسنة ليست إِيّاها.
فقال آخرون: هي آية { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}.(الزمر ،53)
فقال(عليه السلام): حسنة ليست إيّاها.
فقالوا: هي آية { وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا }.(النساء ،110)
قال(عليه السلام): حسنة ليست إيّاها.
فقال آخرون: هي آية: { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} (ال عمران)فقال الإِمام أيضاً: «حسنة ليست إيّاها».
ثمّ أجم الناس، فقال: مالكم يا معشر المسلمين، فقالوا: والله ما عندنا شيء قال(عليه السلام): «سمعت حبيبي رسول الله يقول: أرجى آية في كتاب الله { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ }(12).
وبالطبع كما ذكرنا في شرح الآية (48) من سورة النساء: إِنه ورد حديث آخر يشير إِلى أن أرجى آية في القرآن هي آية {إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}.
ولكن مع ملاحظة أنّ كل آية من هذه الآيات تنظر الى زاوية من هذا البحث وتبيّن بُعداً من الأبعاد، فلا تضادّ بينها.
وفي الواقع إِنّ الآية محل البحث تتحدّث عن أُولئك الذين يؤدّون الصلاة بصورة صحيحة، صلاة مع حضور القلب والروح، بحيث تغسل آثار الذنوب عن قلوبهم وأرواحهم. أمّا الآية الأُخرى تتحدّث عن أُولئك الذين حُرموا من هذه الصلاة، فبامكانهم من باب التوبة، فإذن هذه الآية لهؤلاء الجماعة أرجى آية، وتلك الآية لأُولئك الجماعة أرجى آية.
وأيّ رجاء أعظم من أن يعلم الإِنسان أنّه متى زلت قدمه وغلب عليه هواه (دونَ أن يصرّ على الذنب) وحين يحل وقت الصلاة فيتوضأ ويقف أمام معبوده للصلاة، فيحسّ بالخجل عند التوجه الى الله لما قدمه من أعمال سيئة ويرفع يديه بالدعاء وطلب العفو فيغفر وتزول عن قلبه الظلمة وسوادها.
وتعقيباً على تأثير الصلاة في بناء شخصية الإِنسان وبيان تأثير الحسنات على محو السيئات، يأتي الأمر بالصبر في الآية الأُخرى بعدها { وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}.
وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين حاول تحديد معنى الصبر في هذه الآية في الصلاة، أو إيذاء الأعداء للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، إِلاّ أنّ من الواضح أن لا دليل على ذلك ـ بل أن الآية تحمل مفهوماً واسعاً كلياً وجامعاً ويشمل كل أنواع الصبر أمام المشاكل والمخالفات والأذى والطغيان والمصائب المختلفة، فالصمود أمام جميع هذه الحوادث يندرج تحت مفهوم الصبر.
«الصبر» أصل كلّي وأساس إِسلامي، يأتي أحياناً في القرآن مقروناً بالصلاة، ولعل ذلك آت من أن الصلاة تبعث في الإِنسان الحركة، والأمر بالصبر يوجب المقاومة، وهذان الأمران، أي «الحركة والمقاومة» حين يكونان جنباً الى جنب يثمران كل اشكال النجاح والموفقية.
وأساساً يتحقق عمل صالح دون صبر ومُقاومة ... لأنّه لابدّ من إِيصال الأعمال الصالحة الى النهاية، ولذلك فإنّ الآية المتقدمة تعقب على الأمر بالصبر بثواب الله وأجره إِذ تقول: {إِنّ الله لا يضيع أجر المحسنين} ومعنى ذلك أن العمل الصالح لا يتيسر دون صبر ومقاومة ... لا بأس بذكر هذه المسألة الدقيقة، وهي أنّ الناس ينقسمون الى عدّة جماعات إزاء الحوادث العسيرة الصعبة:
1ـ فجماعة تفقد شخصيّتها فوراً، وكما يعبر القرآن {وإِذا مسّه الشر جزوعاً}.(المعارج،20)
2 ـ وجماعة آخرون يصمدون أمام الأزمات بكل تحمّل وتجلّد.
3 ـ وجماعة آخرون بالإِضافة الى صمودهم وتحملهم للأزمة، فإنّهم يؤدّون الشكر لله.
4 ـ وجماعة آخرون يتجهون الى الأزمات والمصاعب بشوق وعشق، ويفكرون في كيفية التغلب عليها. ولا يعرفون التعب والنصب في متابعة الأُمور، ولا يهدأون حتى تزول المشاكل.
وقد وعد الله مثل هؤلاء الصابرين بالنصر المؤزر { إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}(الانفال ،65).
وأنعم عليهم وأثابهم في الدار الأُخرى بالجنّة {وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا(الانسان ،12).
_______________________
1- تفسير الامثل ،مكارم الشيرازي ،ج6،ص182-194.
2- هناك كلام بين المفسّرين في عودة الضميرين «هم» و«منه» على أية كلمتين في الآية؟! فقال بعضهم: إِنّ هذا الضمير هم «وإِنهم» يعود على قوم موسى و«منه» يعود على كتاب (التوراة) فمعنى الآية: إِن هؤلاء القوم لا يزالون يشكّون في كتاب موسى، ولكن قال آخرون: إِنّ الضمير في (إِنّهم) يعود على مشركي مكّة و«منه» يعود على القرآن، وبملاحظة أن الآيات جاءت لتسلية قلب النّبي فيكون التّفسير الثّاني أقرب للنظر.
3- تفسير مجمع البيان، ج 5، ص 199.
4 ـ الدر المنثور ،ج3،ص351.
5- بحار الانوار ،ج84،ص140،ح8. وسلئل الشيعة ،ج4،ص10،ح4385.
6- أصول الكافي ،ج3،ص366،ح10:، وسائل الشيعة ،ج8،ص 146،ح10265.
7- مستدرك ،ج3،ص15،ح1897-7.
8- تفسير مجمع البيان ،ذيل الآية مورد البحث:، بحار الانوار ،ج79،ص319، ص208 بتفاوت يسير .
9- تفسير مجمع البيان ،ذيل الآية مورد البحث.
10- المصدر السابق.
11- تفسير مجمع البيان ،ذيل الآية مورد البحث.
12- تفسير مجمع البيان ،ذيل الآية مورد البحث:، بحار الانوار ،ج79،ص220،ح41.



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|