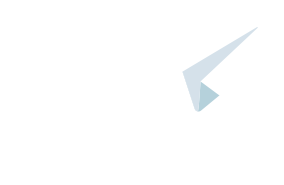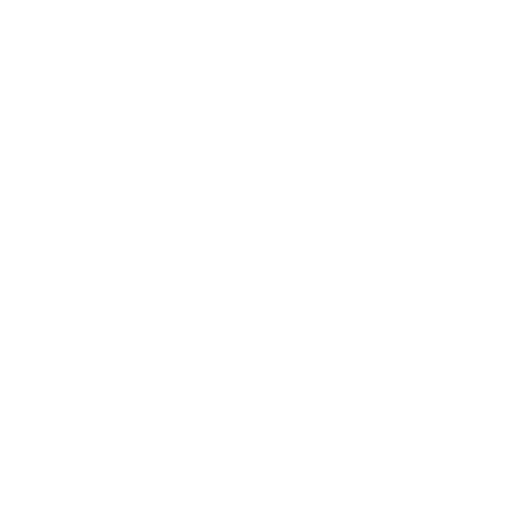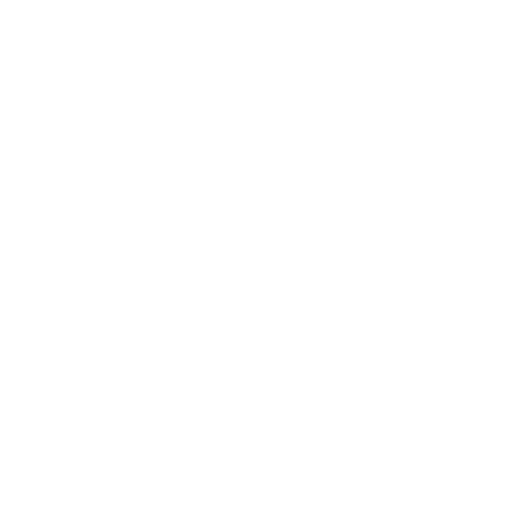الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
طبيعة التربية
المؤلف:
أ. د. عبد الكريم بكَار
المصدر:
حول التربية والتعليم
الجزء والصفحة:
ص 11 ــ 17
2025-08-18
758
قالت العرب: ربا الشيء رَبْواً وربُواً: نما وزاد. قال الله - تعالى - عن الأرض: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5]. أي: زادت وانتفخت بسبب ما يتداخلها من الماء والنبات. ويقولون: ربا المال: زاد. ويقولون: ربي فلاناً: غذّاه ونشأه (1).
والذي يظهر لنا من هذا معنيان:
معنى النمو والزيادة، وهذا أوضح ما يُطلب من التربية، وهو تنمية الجانب الذي توجه إليه؛ فالتربية العقلية تهدف إلى تنمية القدرات العقلية والتربية الروحية تهدف إلى تنمية القوى الروحية، وهكذا.
أما المعنى الثاني، فهو التدرج؛ فالتربية جهود تراكمية، يرفد بعضها بعضاً، والزمن عامل مهم في بلوغ التربية غاياتها. وهذا واضح في قولهم: تربى، وتنشأ وتثقف؛ فالتنشئة والتغذية والتثقيف لا تكون أبداً طفرة ومرة واحدة، وإنما تتم على مراحل متتالية. وعلى هذا فالإنماء والتدرج يمثلان أهم قانونين يحكمان طبيعة الأعمال التربوية. فإذا وجدنا تربية لا تثمر نمواً علمنا أنها تربية عقيم. وإذا رأينا جهوداً تستهدف تنمية شيء ما، لكنها لا تتسم بالتدرج والتعاهد المتتابع علمنا أن تلك الجهود لا تستحق أن تُسمى (تربية).
إن التربية نوع من (الحرب) الدائمة على كل أشكال الانحراف والتبلد والقصور الذاتي، وإن التربية كالحرب تحتاج إلى الرجل المكيث الذي يملك فضيلة الصبر على بذل الجهد المستمر مع التطلع إلى الفرص المواتية.
وأعتقد أن أصل الوضع اللغوي على درجة عالية من الشفافية والوضوح، وهو يعفينا من كثرة التعريفات الاصطلاحية.
وقد عرف معجم (لالاند) التربية بأنها سياق يقوم في أن تتطور وظيفة أو عدة وظائف تدريجياً بالتدريب، وأن تتحسن نتيجة لذلك السياق (2).
وعلينا أن نحاول الكشف عن جوهر التربية من خلال استعراض بعض الأدبيات والخبرات والانطباعات التي تكونت لدى المهتمين بالشأن التربوي ومن خلال علاقة التربية بالتكوينات الثقافية الأخرى.
التربية:
لا يبدأ المربون مهمتهم الشاقة من فراغ، فهناك شيء ما ثابت في النفس البشرية يمكن أن نسميه (الجوهر الإنساني) وهذا الجوهر مجموع ما فطر الله - جل وعلا - عباده عليه، حيث قال - سبحانه -: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30].
ويتمثل هذا الجوهر - فيما أحسب - في مجموعات من السمات والخصائص التي طبعت عليها نفوس البشر ومجتمعاتهم على مقتضى سنن الله في الخلق من نحو قابلية الإنسان للاتجاه نحو الخير والاتجاه نحو الشر، وإقراره في داخله بوجود قوة عظمى تسير هذا الكون، وحبه للخلود واستمرار البقاء، وحاجته إلى إطار مرجعي يوجهه، وخوفه من المجهول مع حبه للمعرفة الحقيقية، بالإضافة إلى ميله إلى التلقائية والبساطة، وكذلك استعداده للتضحية والتغير وفرحه بالإنجاز، وتضايقه من الزحام. وهو إلى جانب هذا يحمل في عقله وقلبه مبادئ منطقية ومشاعر كثيرة موحدة؛ وهذا وما شابهه يمثل الأرضية المشتركة التي تمكن الناس من التفاهم والتعايش، وهو نفسه الذي يجعل التثاقف التربوي بين الأمم شيئاً ذا جدوى.
مفردات هذا الجوهر وقسماته ثوابت في وجودها وأصولها وأقدار منها إلا أن ظروف الحياة الشديدة التنوع - تجعل من السهل ضمور بعض السمات، وتضخم أخرى على نحو مرضي. ومن المعلوم أن انتقال المرء من الصحة إلى المرض على الصعيد النفسي ليس - في أكثر الأمر - سوى اختلال في التوازن النفسي بسبب خلل في عوامل ذلك التوازن؛ فالقلق ضروري لتوازن الشخصية، لكنه حيث يحدث بصورة مبالغ فيها، فإنه يتحول إلى مرض ودرجة معينة من الاهتمام مطلوبة لحفز الطاقات المنتجة لدى الإنسان، لكنه إذا زاد قد يتحول إلى وسواس أو اكتئاب، وقد يسبب أمراضاً جسدية خطيرة.
مرادنا من كل هذا أن نقول: إن التربية لا تهدف إلى المحافظة المجردة على مفردات الجوهر الإنساني، وإنما المحافظة على المقادير المطلوبة منها، والمحافظة على علاقات سوية فيما بينها؛ بما يخدم التوازن العام للشخصية، ويحول دون تشوهها.
ویرى بعض الفلاسفة والباحثين في الشأن التربوي أن التربية لا تعدو أن تكون مجرد تقديم الفرص للنمو الطبيعي (3). وهي ليست شيئاً يقحم على الأطفال والشباب إقحاماً قسرياً من الخارج، وإنما هي نمو القدرات الفطرية الكائنة في بني الإنسان عند الميلاد (4).
ونحن نرى أن إتاحة الظروف والفرص التي تسمح لملكات الإنسان ومواهبه وقدراته بالتفتح والنمو، أمر مطلوب حقا - على نحو عام - فالنضج المأمول لأي فرد، وأي أمة لا يمكن أن يتم خارج دوائر الفعل والممارسة؛ فالأحداث التي يعيشها المرء قد لا تملكه أصولاً نظرية للفهم، ولكنها تنمي لديه حساسيات وخبرات تجعل مسيرته الحياتية أكثر أماناً، وأكثر ثراء واكتمالاً. لكن مع هذا فإن علينا ألا ننسى أن الثقافة الاجتماعية السائدة هي التي تحدد درجات النمو المطلوبة لجميع الخصائص والخبرات التي يحتاجها الكائن البشري السوي، وتلك الثقافة متفاوتة بين المجتمعات والعصور؛ مما يجعل الكلام الذي نقلناه آنفاً تجريدياً أكثر مما ينبغي.
حين نمعن النظر نجد أن جميع الأمم تعمل في تربية صغارها وكبارها حول ثلاثة محاور أساسية هي:
1- محور النفس البشرية، وما ذكرناه من مفردات فطرتها وميولها ونوازعها.
2- إرثها التاريخي والاجتماعي، والذي يشتمل على مجمل عقائدها ومبادئها، ومعايير الصواب والخطأ لديها، إلى جانب آدابها وتقاليدها وأذواقها.
3- ما تعتقد أنه مطلوب لعيش حاضرها وجوهري في تلبية حاجات مستقبلها من الصفات والخبرات والمهارات على نحو ما نشاهده اليوم من الاهتمام بالتعليم والتدريب والتخلق بالأخلاق الحضارية الإنتاجية، من مثل الدقة والفاعلية والحفاظ على الوقت.
ولا يخفى أن الأمم تختلف اختلافاً عظيماً في كثير مما يدخل في إطار التربية على المحورين الثاني والثالث؛ حيث إن لكل أمة إرثها التاريخي الخاص، وترتيبها المتميز لسلمها القيمي ومشكلاتها وآمالها الوطنية الخاصة... وهذا كله ينعكس على المناهج والأساليب المتبعة لدى كل أمة، وعلى نحو فرعي لدى كل أسرة وكل معلم وكل فرد. ومع هذا فإن ما يشبه التوحد بين الأمم في المحور الأول بالإضافة إلى شيء من التقارب في المحورين الثاني والثالث - سوف يتيح لكل أمة أن تستفيد من خبرات الأمم الأخرى، ولذا نشأ علم (التربية المقارنة).
ويمكن القول: إن مفترق الطرق الأساسي بين الأمم يكمن في تصور طبيعة مفردات كل محور من المحاور الثلاثة، وفي تصور كيفية إقامة التوازن والتناغم بينها. وهذا في الحقيقة هو بيت مشكلات التربية الكبير لدى الأمم قاطبة، حيث تتيه العقول، وتتشظى الخبرات كلما أراد المربون القبض على الهيكل الأساسي لما ينبغي أن يقوموا به حيال تكوين شخصية متكاملة متوازنة.
ومن المعروف أن التقدم الأفقي في العلوم الطبيعية قد ساعد كثيراً على التقدم الرأسي؛ فقد استفادت العلوم الطبية - مثلاً - استفادة هائلة من التقدم الذي حصل في العلوم الهندسية والكيميائية والفيزيائية؛ على حين أن التقدم في جميع العلوم غير التربوية، كان محدود الإفادة لها؛ فالتقدم الأفقي في المعرفة لا ينعكس إلا على نحو ضئيل على التقدم الرأسي في علم النفس والعلوم والفنون التربوية؛ ولذا فعلى حين تضيق الفجوة بين النظرية والتطبيق على صعيد العلوم الطبيعية يجد علماء النفس والتربية السبل تتشتت بهم أكثر كلما أوغلوا في البحث في المسائل التربوية والنفسية والاجتماعية!
والسبب الجوهري في هذا أن الله - جل وعلا - خلق العقل البشري ليكون عقلاً عملياً، لا ينتج إلا ضمن أطر ومسلمات ومحددات معينة، وحين يترك ليبتدع هو أطر عمله، فإنه يكون قد زج به في بحر لجي، لا يحسن فيه أي شكل من أشكال العوم، وستكون النتيجة ما نراه اليوم لدى فلاسفة الغرب من اختلاف واضطراب في كل شيء، حتى ما يمكن أن نعده أمراً بديهياً في بعض الأحيان.
إن (الوحي) الذي استدبره الغرب - لأسباب تاريخية - هو الذي يمنح إطار التوازن والتكامل للأعمال التربوية، وهو الذي يؤمن نوعاً من الانسجام والتلاحم بين متطلبات الفطرة في النفس البشرية ومتطلبات الانتماء التاريخي والمجتمعي ومتطلبات العيش الكريم.
وقد أحس الغرب بسعة الفجوة التي تركها الابتعاد عن الدين والاهتداء بهديه، فحاول ردمها بالكثير الكثير من الدراسات النفسية والاجتماعية والتربوية، وأبدى براعة فائقة في كل ذلك، لكن النتائج على الصعيد العملي كانت مخيبة للآمال؛ فعلى الرغم من الخبرات والمعارف التربوية التي تراكمت على نحو هائل خلال القرنين الماضيين إلا أن الجريمة وإدمان المخدرات والانحلال القيمي والتفكك الأسري آخذة في الاشتداد والانتشار وكأن عمل الباحثين كان جهاداً في غير عدو!!
أما أمة الإسلام فقد أكرمها الله - تعالى - بالوحي الذي وضع يدها على الكثير الكثير من مكونات النفس البشرية، كما أن لها تاريخاً غنياً بالخبرات والتجارب، وقد رسم لها دينها الأهداف الكبرى التي ينبغي أن تسعى لإنجازها، وملكها المنهج الرباني الكثير من الأصول والمبادئ والأدبيات التي تسعفها في بلورة نظرية تربوية متكاملة ومتماسكة، لكن مشكلتها أنها لم تبذل من الجهد ما يجعلها ترتقي إلى مستوى المنهج الذي أكرمها الله - تعالى - به ، كما أن كثيراً من التربويين من أبنائها لم يتجهوا إلى العمل في إطار ذلك المنهج: مسلماته وأدبياته ورمزياته؛ وما أجروه من بحوث تربوية قليل، ومع ذلك فإنه لم يستهدف - في أكثر الأمر - الكشف عن مفاصل النظرية التربوية الإسلامية، كما أنهم لم يستطيعوا إبداع منهج البحث الذي يلائم طبيعة المشكلات التي نعاني منها.
إن هذه الدنيا دار ابتلاء، وإن الله - تعالى - ملكنا المنهج والرؤية العامة، ولكنه كلفنا بتوظيف ذلك المنهج، وتوفير الشروط الضرورية لعمله، وتهيئة المناخ العام الذي يسهل الاهتداء به والامتثال له. إن الوحي يمنحنا الثوابت ويوضح لنا الخطوط العريضة، ويحدد لنا الأطر العامة، وعلينا نحن أن نقوم بواجبنا في تلبية مطالب ما تأتي به المتغيرات، واختلافات الأزمنة والأمكنة، والتحولات الثقافية الكبرى، وأن نتلمس عبر الدراسات والإحصاءات والملاحظات الذكية طريقنا في النهوض بأبنائنا وأوضاعنا العامة على الوجه الأكمل.
وهكذا فقد أضيرت التربية في الغرب من خلال الانحراف عن المبادئ الكلية، والخروج من الأطر العامة، وتضييع الأهداف الكبرى؛ وأصيبت التربية لدينا بالضرر نتيجة الإهمال والكسل والقصور في الوسائل ورداءة الأوضاع العامة، ولكن على حين حرق الغرب مراكب العودة إلى رياض الوحي؛ فإن طريق التصحيح لدينا ما زال مشرع الأبواب، إذا ما توفر لدينا ما يكفي من الإخلاص والعزيمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر: لسان العرب: (ربا).
2ـ فلسفة التربية: 13.
3ـ التربية والنظام الاجتماعي: 42.
4ـ قاموس جون ديوي للتربية: 55.
 الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












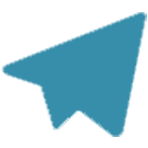
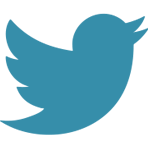

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)