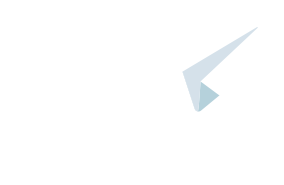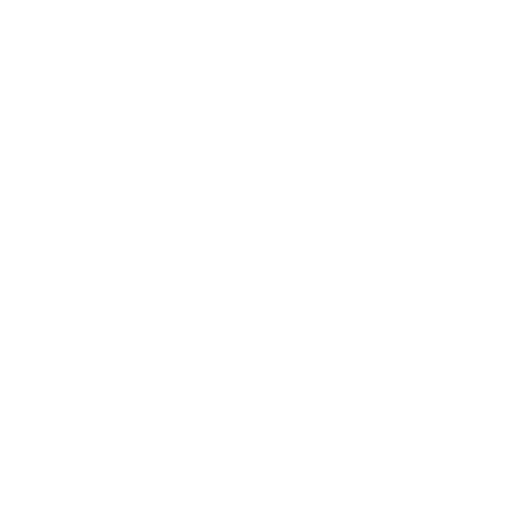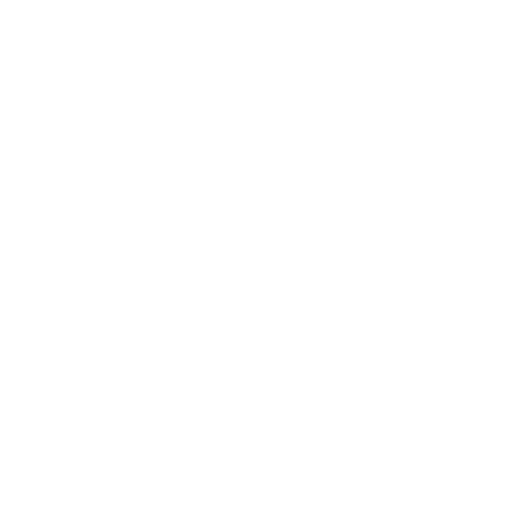الأدب


الشعر

العصر الجاهلي

العصر الاسلامي

العصر العباسي

العصر الاندلسي

العصور المتأخرة

العصر الحديث

النثر


النقد

النقد الحديث

النقد القديم


البلاغة

المعاني

البيان

البديع

العروض

تراجم الادباء و الشعراء و الكتاب
المنهج النفسي للنقد الأدبي
المؤلف:
سيّد قُطب
المصدر:
النقد الأدبي أصوله ومناهجه
الجزء والصفحة:
ص207-252
14-08-2015
32514
_________________________
العنصر النفسي
اصيل بارز في (العمل الأدبي). وإذا نحن عدنا الى التعريف الذي اخترناه منذ البدء
للعمل الأدبي، هو: (التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية) وجدنا العنصر النفسي
بارزا في كل خطوة من خطواته. (فالتجربة الشعورية) ناطقة بألفاظها عن اصالة العنصر
النفسي في مرحلة التأثر الداعية الى التعبير، و(الصورة الموحية) ناطقة بألفاظها
كذلك عن اصالة هذا العنصر في مرحلة التأثير الذي يوحي به التعبير.
فاذا نحن تجاوزنا
دلالة العنوان الى صميم العمل الأدبي، لمسنا العنصر النفسي بارزاً في كل مراحله،
فالعمل الأدبي هو استجابة معينة لمؤثرات خاصة، وهو بهذا الوصف عمل صادر عن مجموعة
القوى النفسية، ونشاط ممثل للحياة النفسية. هذا من حيث المصدر. اما من حيث الوظيفة
فهو مؤثر يستدعي استجابة معينة في نفوس الآخرين. هذه الاستجابة التي هي مزيج من
إيحاء العمل الفني، وطبيعة المستجيب له من الناحية الاخرى.
وإذا استطاع
(المنهج الفني) ان يفسر لنا (القيم الفنية) – شعورية وتعبيرية-الكامنة في العمل
الفني، بحيث نملك الحكم الفني على العمل الأدبي، وبحيث نستطيع تصور وتصوير الخصائص
الشعورية والتعبيرية لصاحبه، فان قسطا من هذا التصوير وذلك التفسير تتدخل فيه
(الملاحظة النفسية) وهي أشمل من (علم النفس) كثيراً. فالخصائص الشعورية مسألة
نفسية بالمعنى الشامل، وملاحظتها وتصورها مسألة نفسية كذلك.
ولا تقف الملاحظة
النفسية في النقد عند نصيبها الضمني في (المنهج الفني) فهناك وراء هذا مجالها
الخاص الذي تكاد تنفرد به في بعض الاحيان.
(والمنهج النفسي)
هو الذي يتكفل بالإجابة على الطوائف الآتية من الاسئلة او يحاول الإجابة عنها على الاقل:
1- كيف تتم عملية الخلق الأدبي؟ ما هي طبيعة هذه العملية من
الوجهة النفسية؟ ما العناصر الشعورية وغير الشعورية الداخلة فيها وكيف تتركب
وتتناسق؟
208
كم من هذه العناصر
ذاتي كامن في النفس، وكمن منها طارئ من الخارج؟ ما العلاقة النفسية بين التجربة
الشعورية والصورة اللفظية؟ كيف تستنفد الطاقة الشعورية في التعبير عنها؟ ما
الحوافز الداخلية لعملية الخلق الأدبي ... إلخ.
2- ما دلالة العلم الأدبي على نفسية صاحبه؟ كيف نلاحظ هذه
الدلالة ونستنطقها؟ هل نستطيع من خلال الدراسة النفسية للعمل الأدبي ان نستقرئ
التطورات النفسية لصاحبه؟ ... إلخ.
3- كيف يتأثر الآخرون بالعمل الأدبي عند مطالعته؟ ما
العلاقة بين الصورة اللفظية التي يبدو فيها وبين تجارب الآخرين الشعورية ورواسبهم
غير الشعورية؟ كم من هذا التأثير منشؤه العمل الأدبي ذاته، وكم منه منشؤه من ذوات
الاخرين واستعدادهم؟ ... إلخ.
هذه الطوائف
الثلاثة من الاسئلة يتصدى لها (المنهج النفسي) ويحاول الإجابة عليها، ولكنه الى
هذه اللحظة لا يستطيع ان يجيب اجابة حاسمة، وحين يحاول الإجابة الحاسمة يبدو كثير
من التكلف والتعسف في تأويلاته وتعليلاته. ومنشأ هذا في اعتقادنا هو الاعتماد على
(علم النفس) – وهو أضيق دائرة من (النفس) بطبيعة الحال – هذا الى انه علم يعد الى
هذه اللحظة ناشئا بالقياس الى عمر العلوم الاخرى – الطبيعة والبيولوجية – وما وصلت
إليه من نتائج لها حظ كبير من الثبوت. ولأن من طبيعته – وهو يتناول (النفس) – ألا
يصل الى نتائج من نوع نتائج العلوم التي تتناول المادة الجامدة او الحية. وعلم هذه
مادته يكون أضمن له ان يوضح ولا يقرر، وان يلقي الضوء ولا يجزم.
وهذا الكلام قد لا
يرضي أصحاب (المنهج النفسي) المحدثين في النقد، فقد يكونون أشد ثقة بعلم النفس الى
حد أ، يكلوا إليه الاهتداء الى حل حاسم وتقرير جازم في مسائل الفن النفسية، حتى
وهو في طوره الحاضر البعيد عن الاكتمال، ولكن كثيرا من اصحاب مذهب التحليل النفسي
– آخر ميادين علم النفس الحديث – يقفون موقفا أكثر تحفظا من أصحابنا هؤلاء، ففرويد
مثلا (يقرر في صراحة تامة أننا لا نستطيع الاطلاع على طبيعة الانتاج الفني من خلال
التحليل النفسي. ويقول ان حديثه عن ليونارد دافنشي ليس سوى عرض لهذا الرجل من
ناحية (الباثوجرافيا) (وصف الامراض) وهي لا تهدف الى توضيح نواحي النبوغ لدى الرجل
العظيم (1).
وقد بين فرويد في
بعض دراساته الآليات التي تساهم في عملية الابداع الفني، وقرر ان الخصائص الرئيسية
لهذه الاليات تشترك في كثير مع تلك التي تكمن وراء عمليات ذهنية غير متماثلة في
الظاهر، كالأحلام، والنكتة والامراض العصابية (2) ذلك ان اللاشعور هو الاساس الذي
تقوم عليه هذه الظاهرات والابداع الفني على السواء، غير انه يعمل بطريقة خاصة في
كل منها. فمصدر الطاقة نفسه يستخدم ويشكل، واخيرا يستحضر في كل هذه الظاهرات
بالطريقة التي تلائمها (3)).
والى هنا يكون
الرجل مقتصدا ومنطقيا، لأنه لا يزال في حدود اعترافه بمدى المجال الذي يعمل فيه،
وهو ان ابحاثه (لا تزيد على ان تكون نورا يسطع في أماكن تركها بقية العلماء مظلمة
(4).
***
ويحسن ان نثبت هنا
ملخصا لطريقة دراسته (لليوناردو دافنشي) والأسس التي قام عليها:
يلجأ فرويد الى
افكاره الرئيسية التي تقوم عليها آراؤه السيكولوجية كلها وهي: الكبت، والرغبة
الجنسية، ومرحلة الطفولة، فيبدأ الاطفال قرب نهاية السنة الثالثة من العمر ما
نسميه بالبحث الجنسي الطفولي، مدفوعين الى ذلك بولادة اخ جديد (سينزعهم عن عروشهم
الذي يتمثل في عناية الام بهم) او بالخوف من مثل هذا الحدث، وعندئذ يتجهون الى
التفكير في كيفية مجيء الأطفال، فلا يفهمون مهمة الأدب، ولكنهم يكونون نظريات خاصة
لهم، وهم على يقين من ان الطفل موجود في رحم الأم، الا انهم يفكرون في أنه يولد من
خلال الامعاء مثلا. على ان الاطفال يستعينون بالكبار، فيوجهون إليهم سيلا من
الاسئلة لا تنقطع لأنهم في الواقع يحومون حول سؤال رئيسي لا يلقونه. وربما قدم لهم
الكبار تفسيرا اسطوريا، لكنهم يشعرون بانه مخالف للحقيقة فينكرونه ولا يغفرون
للكبار هذا التضليل ويتوجهون الى اشباع حب الاستطلاع لديهم بوساطة نظريات خاصة
بهم. وهنا يلزمنا ان ندخل في حسابنا الظروف المحيطة بالطفل. ومن هذه الظروف مثلا
ما أحاط بطفولة (ليوناردو دافنشي) فهو ابن غير شرعي أمضى السنوات الأولى من طفولته
مع امه دون ابيه. ومثل هذا الوضع من شأنه ان يقدم للطفل مشكلات لا تواجه غيره من
الاطفال (ممن يعيشون في ظروف عادية) والطفل الذي يواجه مشكلة واحدة يزيد بها على
المشكلات التي تواجه سائر الاطفال يظل يتأملها في عمق وانفعال. وليس عجيبا بعد ذلك
ان يصبح باحثا منذ فجر الحياة، وقد كان (ليوناردو) صاحب ابحاث نظرية عميقة الى
جانب اعماله الفنية، وانتهى الامر في السنوات الاخيرة من عمره الى الانصراف عن
الابتداع الفني، الى البحث والابتكار في ميدان العلم (5).
والى هنا حاول ان
يعلل عبقرية (ليوناردو دافنشي). ولكن أهذا تعليل حاسم؟ ان الافا يحيط بهم مثل هذه
الظروف التي احاطت بليوناردو فلا تخلق منهم فنانين عظاما ولا باحثين متعمقين. نعم
انه اراد تعليل مسلك هذا الفنان بأنه ينطبق على حالة خاصة من حالات الكبت يتوافر
فيها ان يعجز الكبت الجنسي عن توجيه جزء مهم من دافع اللذة الجنسية الى اللاشعور
فيتجه (اللبيدو) (الشهوة) الى التسامي منذ البداية (ويتحول هو نفسه الى حب استطلاع
وينضم الى دوافع البحث الذي تحدثنا عنه من قبل، والذي قلنا انه يتجه الى الاطلاع
على بعض الامور الجنسية، وهناك كذلك يصبح البحث قهريا وبديلا من النشاط الجنسي الى
حد ما (6).
ولكن هذا كذلك لا
يفسر عبقرية الفنان. فلماذا اتجه الكبت فيه الى التسامي؟ لم يجب فرويد عن هذا
السؤال اجابة واضحة. كل ما هنالك انه قرر ان النبوغ الفني والاستعداد للإنتاج
مرتبطان تمام الارتباط بالتسامي، وإننا لا نستطيع ان نستدل على الاستعداد للتسامي
في التحليل النفسي (7).
وقد طبق نظريته
على أعمال ليوناردو على النحو التالي:
(تحققت لدى
ليوناردو الامكانية الثالثة (اي التسامي) فاستطاع ان يتسامى بالجزء الاكبر من
اللبيدو مدخلا اياه في دافع البحث، ونتج عن ذلك عدة نتائج .. أهمها ان الحياة الجنسية
لليوناردو تعطلت الى حد بعيد (ومن العسير علينا من نعثر على اسم امرأة أحبها
ليوناردو) مما أدى الى انحرافه ناحية (الجنسية المثلية) وقد تجلى ذلك في شغفه بان
يجمع حوله شبابا يمتازون بالجمال أكثر مما يمتازون بالاستعداد للتتلمذ، ويحاول ان
يتخذ منهم تلامذة، ولكن احدا منهم لم ينبغ. ونتج عن ذلك ايضا ان عجز (ليوناردو) عن
اخفاء نواحيه المكبوتة، فظهرت في آثاره الفنية، وذلك ما أراد فرويد ان يبينه (ان
اعمال الفنان تقدم منفذا لرغبته الجنسية ايضا) وقد ظلت الرغبة الجنسية عند
ليوناردو مرتبطة بأمه، لظروف طفولته الخاصة، مما منع عنه التوفيق في ان يكون
علاقات غرامية ناضجة عندما اصبح شابا، لان الشرط الأول لتكوين هذه العلاقات
بصورتها السوية، ان يتخلص الشخص من صورة امه، وذلك يتوقف – الى حد بعيد – على
مقدار ارتباطه بأيام طفولته ويرى فرويد ان ليوناردو ربما استطاع التغلب على شقائه
في حياته الغرامية من خلال نشاطه الفني، فاستحضر اشباعا للصبي الذي عشق امه، في
مثل هذا الاتحاد الرائع للطبيعتين الأنوثية والذكورية كما هو واضح في صورة (يوحنا
المعمدان (8)).
وهذا التعليل
لأعمال ليوناردو الفنية، كالتعليل لعبقريته سواء. نستطيع ان نستعين به في توسعة
نطاق بحثنا، ولإلقاء اضواء على حياة الفنان وأعماله. ولكننا لا نستطيع ان نتخذه
قاعدة مسلمة ولا حقيقة مقررة. لان هناك فجوات كثيرة لا تعليل لها – وهذا طبيعي-ولأن
المسألة من أساسها الى هذا الوقت لا تزال في دائرة الفروض العلمية القابلة
للمناقشة من أساتذة مدرسة التحليل النفسي أنفسهم، فأدلر تلميذ فرويد يرى ان عقدة
الجنس بسائر مركباته لا تحل لنا مشكلة النبوغ، وقد يعتمد في حالة كحالة ليوناردو
على تعليل آخر وهو (التعويض) عن النقص. كما ان تلميذه الاخر يونج لا يوافق على
اعتبار الفنان مريضا تنبعث عبقريته من أسباب مرضية، وهو يميل الى اعتبار (الابداع
الفني) نتيجة لعملية (كشف) غير واعية، يتصل فيها الفرد عن طريق اللاشعور ببعض
مكونات (اللاشعور الجمعي) وهو أعمق من (اللاشعور الفردي) فيكون بذلك معبرا عن
رغبات غامضة لنوع (الإنسان) لا لذاته الفردية في فترة معينة، وهو يصنع ذلك عن طريق
(الحدس) (إدراك الذهن للعمليات اللاشعورية) الذي يصبح في الفنان كأنه وظيفة
متميزة. وعن طريقها يتوافق مع العالم بوساطة الرموز اللاشعورية التي يتلقاها خلال
عالمه الباطني، وقد يتم ذلك على حساب الحقيقة، (فنيتشه) مثلا قد أدرك حاجة عصره عن
طريق (لا شعوره الجمعي) (والادراك ضرب من الاستجابة، والاستجابة خطوة نحو التوافق)
ومن ثم فقد أعلن موت الإله (في: هكذا قال زرادشت) أي انهيار الرمز القديم والحاجة
للمصلح الجديد واتفق معه في ذلك شوبنهور الذي أنكر العالم (9).
ولكن يونج يقرر أن
هذه الخاصية ليست مقصورة على الفنان وحده، فالأنبياء والحكماء والقادة هم ايضا
يشهدون ذلك الجانب المظلم العميق من اللاشعور الجمعي، ويدركونه خلال عوالمهم
الباطنية، وهنا نجدنا مرة اخرى ازاء فرض عام يشمل أعمالا اخرى غير الابداع الفني.
على ان هذا
التفسير قد يكون أكثر قبولا، من تفسير فرويد وتلاميذه التابعين له، لأنه لا يحصر
الابداع الفني في الدائرة المرضية، ولا يحسبه مجرد محاولة للتوفيق بين الرغبة في المحرم
وبين الشعور بالخطيئة (كرغبة استمتاع سوفوكليس بأمه في (أوديب) ورغبة شكسبير في
قتل العم الممثل للرغبة المكبوتة في (قتل الاب) في (هاملت)) بل يعقد الصلة بينه
وبين أعمال اخرى منشؤها يشبه الإلهام. ولا بأس ان نتصور الالهام الفني في مثل هذه
الصورة العلمية التي يعرضها يونج، وهي الاستجابة غيرا لشعورية لحاجات وأشواق
(الإنسان) من خلال اللاشعور الفردي.
على انه من المفيد
ان نذكر ان علماء التحليل النفسي لم يقصدوا أولاً الى ايجاد (منهج نفسي) للنقد
الفني (إنما رأوا ان العمل الفني صورة من صور التعبير عن النفس، فدرسوه على هذا
الاساس، حتى لا يدعوا ثغرة في بناء مذاهبهم (10)).
اما الذين قصدوا
الى ايجاد هذا المنهج، فهم فريق من نقاد الأدب ارادوا ان ينتفعوا بما كشفته
الدراسات الفنية – وبخاصة في ميدان التحليل النفسي – فاقتفوا آثار فرويد في دراسته
لليوناردو دافنشي، ويونج في دراسته لمسرحية (فاوست) لجيته، وإرنست جونز في دراسته
(هاملت) لشكسبير.
ومن هؤلاء (هربرت
ريد) الذي قام بدراسات على (وردزورث) و(شلي) والأختين (شارلوت وإملي برونته)
وغيرهم.
ويسير (ريد) في
بحثه عارضا معضلات ادبية مهمة، ملتمسا لها فهما وتعليلا من علم النفس. فهناك الظاهرة
المعروفة بالفترات المتقطعة في حياة النبوع: لم يزدهر شاعر ما في غالب الاحيان في
فترة بلوغه اوائل رجولته، ثم يخمد بعد ذلك؟ لم يجيء الالهام في نوبات وغالبا في
فترات من السنين؟ لم ترك (ملتن) كتابة الشعر مدة خمس وعشرين سنة؟ لماذا كتب (غراي)
قصيدة واحدة فقط رائعة الجودة؟ لماذا استمرت القريحة الشعرية عند (وردزورث) تخرج
نفسها المكنونة مدة عشر سنوات، ثم انحطت بعد ذلك الى فقر نسبي (11)؟
(اما تحليل ريد لحياة
الاختين الكاتبتين (شارلوت وإملي برونته) فقد تناول بحث عوامل الوراثة فيهما،
وظروف الاسرة وخصائص أفرادها، وما كان فيها من ضعف البنية انتقل الى اطفالها، وكيف
ماتت الام في سن باكرة. فأحدث ذلك هزة عصبية كان أثرها في حياة الاختين – وكانت
احداهما في الخامسة والاخرى في الثالثة من العمر – وكيف كان ذلك الحنين الى الام
المفقودة – من ناحية – والى التعلق بالأب من ناحية اخرى أثر في هواجس الاختين
وأوهامها ومصادر فنهما الكتابي. وقد كانت (إملي) مثالا للظاهرة السيكولوجية
المعروفة (ظاهرة التشبه بالذكور او الترجل) فقد كان القرويون في صغرها يرون فيها
ولداً او أكثر مما يرون بنتا، وقد كان في أخلاقها شيء من القوة والقسوة، ووصفها
بعضهم بأنها اقوى من رجل وأكثر سذاجة من طفل. ولكنها كانت مع ذلك وقورا متزنة من
النوع الذي قد يسميه (يونج) داخلي الاتجاه – وقد وجد كل ذلك تعبيرا عن كتابها
(مرتفعات وذرنج) الذي يجمع بين القوة والعذوبة (12)).
وهناك الباحث
الانجليزي (ريتشاردز) بجامعة كمبردج الذي لم يكتف بالبحث النظري بل حاول ان يبحث
بحثا تطبيقيا عن تأثير العمل الأدبي في قرائه. وكانت خطته في ذلك ان يوزع في أثناء
محاضراته قصائد مطبوعة من نظم شعراء مختلفي الشهرة والمنزلة، ويطلب الى الحاضرين
ان يعلقوا عليها كتابة. وكان دأبه ان يكتم عنهم اسم ناظم القصيدة وان يطلب إليهم
الا يضعوا اسماءهم على أوراقهم، على ان يظلوا مجهولين. حتى يعبروا كما يشاءون عن
آرائهم الصريحة. وكانت هذه الاجابات تجمع بعد اسبوع، وفي الاسبوع التالي يجعلها
موضوع محاضرته – القصائد من جهة، والملاحظات والتعليقات التي جمعها وبوبها من جهة
اخرى – وقد كان معظم هؤلاء طلبة يحضرون لدرجة شرف في اللغة الانجليزية والى جانبهم
عدد كبير ممن كانوا يدرسون موضوعات اخرى، ثم عدد من الخريجين وآخرون غير جامعيين.
وقد نشر هذا البحث بكل نواحيه في كتابه (النقد العلمي) وفيه يقول المؤلف :
(والعدة التي لا
غنى عنها لهذا البحث هي علم النفس، وانا حريص كل الحرص ان اواجه الاعتراض الذي قد
يوجه الي من بعض علماء النفس، من ان وثائق الاجابات التي جمعتها لا تعطي دليلا
كافيا على البواعث التي كانت هادي المجيبين في كتاباتهم. وعلى هذا فالبحث سطحي،
ولكني أقول : ان مبدأ كل بحث يجب ان يكون
سطحيا، وان تجد شيئا تبحثه يكون الوصول إليه سهلا تلك أحدى صعوبات علم النفس، ولو
انني اردت ان اسبر أعماق اللاشعور من هؤلاء الكتاب حيث توجد البواعث الحقيقية
لحبهم او لكراهيتهم لما يقرءون لكنت اخترعت لهذا الغرض فرعا من التحليل النفسي ..
ولكن الشعر طريقة إبلاغ. ماذا يبلغ؟ كيف يبلغه؟ وقيمة الشيء المبلغ، ذلك هو موضوع
النقد الأدبي (13)).
مع ان الطريقة
التي استخدمها الاستاذ لا تصل – في اعتقادنا-الى نتائج تقريرية بقدر ما نصل الى
ملاحظات وصفية، فان تعقيبه عليها يوجد الثقة في النفس، فهو تعقيب متزن، ملاحظ فيه
وظيفة الأدب، ومجال النقد الأدبي، مع التفرقة الكافية بينهما وبين طريق التحليل
النفسي.
ولعلم النفس عامة
أنصار يتحمسون له في أوروبا ومصر، لا يعتدلون هذا الاعتدال.
فأما نحن فأميل
الى الحذر في استخدامه في (المنهج النفسي) ليبقى في حدوده المأمونة، فيساعد مجرد
مساعدة على توسيع الآفاق في النظر الى العمل الفني.
وهناك خطر نلمحه
من التوسع في استخدام ذلك العلم. وهو ان يستحيل النقد الأدبي تحليلا نفسيا! وان
يختنق الأدب في هذا الجو، فمن الواضع ان العمل الفني الرديء كالعمل الجيد من ناحية
الدلالة النفسية. كلاهما يصلح شاهدا. فاذا استحال النقد الأدبي الى دراسات تحليلية
نفسية، لم تتبين قيمة الجودة الفنية الكاملة، لأن المجال لا يتسع للانتباه إليها،
وفرزها، وتقدير قيمتها، كما في المنهج الفني – وذلك خطر غير مباشر، وقد لا يلتفت
إليه في أول الامر، ولكنه يؤدي الى تواري القيم الفنية وانغمارها في لجة التحليلات
النفسية!
وشيء شبيه بهذا –
في مجال اخر – قد وقع في كتب (البلاغة) بعد عبد القاهر، فقد كان المتبع في أيامه
ان تختلط قواعد البلاغة بالنقد الفني، وان يستشهد على القاعدة البلاغية بالنصوص،
ثم تنقد هذه النصوص نقدا فنيا يبين الجمال والقبح فيها – وهذا هو المنهج الصحيح –
ولكن (البلاغة) بعد ذلك استقلت على يد السكاكي وأمثاله، فصارت القاعدة هي المقصود
أولاً وأخيرا. والقاعدة تثبت بالمثال الجيد كما تثبت بالمثال الرديء. وعلى هذا
أصبحت كتب البلاغة عند المتأخرين معرضا لنماذج في غاية السخف والرداءة، تذكر على
أنها امثلة لقواعد البلاغة، ففسد الذوق فسادا عظيما.
ونحن نخشى من مثل
هذه الدراسات النفسية. نخشى ان ننسى وظيفة النقد الأدبي – وهي تقويم العمل الأدبي
وصاحبه من الناحية الفنية – ونندفع في تطبيقات وتحليلات تستوي فيها دلالة النص
الجيد ودلالة النص الرديء.
وهناك مجال اخر
للانتفاع بالدراسات النفسية. ذلك هو مجال الخلق الأدبي ذاته. فالكشف عن كثير من
الحقائق النفسية – وخاصة في الناحية المرضية حيث أكبر حقول التحليل النفسي – قد
يفتح امام الادباء عوالم كانت محجوبة – الى حد ما – عن أذهانهم، ويزيدهم بصرا
بالطبائع والنماذج الانسانية. ويعينهم على صحة وصف الخلجات والبواعث، وبخاصة في
القصة التمثيلية والتراجم. وقد انتفعوا بهذا كله فعلا.
ولكن الخطر يجيء
للفن من ناحية الاغراق في هذا الانتفاع، حتى تغرق سمات العمل الفني في غمار
التحليلات النفسية، وحتى يستحيل العمل الأدبي محضرا لجلسة من جلسات التحليل، او
وصفا لتجربة معملية! كما نشاهد في بعض الاعمال الادبية الحديثة.
وقد فهم بعضهم ان
(علم النفس) قد أحاط بالنفس الانسانية خبرا من جميع جهاتها، وان فروضه وتعليلاته
قد صارت حقائق مسلما بها، ويمكن تطبيقها على كل شخصية فردية. وهذا وهم كبير!
كما أن بعضهم لم
ينتبه الى أن عمل الاديب غالبا مضاد في طريقته لعمل المحلل النفسي، فالمحلل النفسي
يميل لتحليل الشخصية الى عناصر متفرقة ليسهل عليه فهمها وتحليلها، والاديب ميال
الى تركيب العناصر المفردة ليكون منها شخصية. والشخصية دائما اكبر من مجموعة
العناصر المفردة المكونة لها. لما يقع بين هذه العناصر من التفاعل، ولان المحلل
النفسي لا يستطيع اطلاقا ان يصل الى جميع العناصر المكونة للشخصية.
على ان الملاحظة
النفسية والحساسية الشعورية في الأديب كثيرا ما تسبقان وتفوقان (علم النفس)
المحدود، في كشف عوالم النفس، والاهتداء الى السمات، والطبائع والنماذج البشرية.
فسوفوكليس في
(اوديب) وشكسبير في (هملت) و(دستويفسكي) في (المقامر) وأمثالهم، فقد امدتهم
الملاحظة النفسية والحساسية الشعورية بما لم يبلغ إليه من جعلوا (علم النفس)
هاديهم المباشر.
وإنه لجميل ان
ننتفع بالدراسات النفسية. ولكن يجب ان تبقى للأدب صبغته الفنية، وان نعرف حدود
(علم النفس) في هذا المجال.
والحدود التي
نراها مأمونة هي ان يكون المنهج النفسي أوسع من علم النفس، وأن يظل مع هذا مساعدا
للمنهج الفني والمنهج التاريخي، وان يقف عند حدود الظن والترجيح، ويتجنب الجزم
والحسم، وألا يقتصر عليه في فهم الشخصية الانسانية، فالأدب الصادق يحس بشعوره
وملاحظاته في محيط أوسع مما يصل إليه الباحث النفسي – وان كانت معلومات هذا أدق في
محيطه – وألا نعتمد في تصوير الشخصيات في القصة وما إليها على العقد النفسية
والعناصر الشعورية وغير الشعورية وحدها. فالأديب يدرك الشخصية الانسانية كلا
مجتمعا لا تفاريق مجزأة. وتنطبع في حسه وحدة، تتصرف بكامل قواها في كل حركة من
حركاتها.
والاعتماد على
التحليل النفسي وحده يخلق مضحكات في بعض الاحيان لأنه يجرد الشخصيات من اللحم
والدم، ويحيلها أفكارا وعقدا. ويبني بعض القصاصين تصرفات أبطالهم على أساس هذا
العقد التي كشفها التحليل النفسي، فتجيء شخصيات غير بشرية. لان أصغر شخصية بشرية أكبر
في مجموعها من كل ما يملك علم النفس ان يكشفه منها.
وبقدر ما نستخدم
كل علم وكل منهج في دائرته المأمونة، نحصل منه على أفضل نتائجه وأنفعها.
وقد تتبعنا تتبعا
سريعا مجملا نشأة المنهجين الفني والتاريخي، ونموهما وأطوارهما في الأدب العربي
قديما وحديثا، فالآن نتتبع نشأة (المنهج النفسي) كذلك.
ربما يبدو ان
النزعة النفسية في فهم الأدب ونقده وليدة العصر الحديث، وأنها وافدة علينا من
المغرب، حيث نمت الدراسات النفسية – وبخاصة التحليلية – نمواً عظيما في هذا القرن
الاخير، وان الأدب العربي لم يعرف هذه النزعة من قبل.
وفي هذا الذي يبدو
للنظرية العجلى صوابا وخطأ يحسن تمييزها.
ان استخدام (علم
النفس) وما وصلت إليه الدراسات فيه من نظريات مرسومة، وقواعد محدودة، وطرائق خاصة،
لفهم الأدب ونقده ... هي اشياء مستحدثة بلا جدال، والذين حاولوا عندنا ان ينتفعوا
بها قد استمدوها من الغرب فعلا، ولم يكن لها – على هذا الوضع-أصول في ثقافتنا
العربية الأدبية.
فأما تدخل
(الملاحظة النفسية) بصفة عامة في فهم الأدب ونقده، فهي أقدم من ذلك كثيرا في الأدب
العربي، لأنها عصارته منذ صدر الاسلام – ان لم يكن قبل ذلك – وتمشت معه في نموه
حتى بدت في هيئة قواعد ونظريات – على يدي عبد القاهر – في القرن الخامس الهجري. ثم
وقفت هناك شانها شان الخطوات الاخرى في المنهجين السالفين.
وحقيقة إنها حين
وجدت في نقدنا الحديث لم يكن وجودها استئنافا لتلك الخطوات البعيدة، إنما كان ذلك
ابتداء واستمدادا من الغرب، وربما كان هذا موقفنا – الى حد كبير – في المنهجين:
الفني والتاريخي. ولكن لقد آن لنا أ، نلتفت الى هذه الجذور الأولى. ولو من وجهة
التسجيل والتسلسل التاريخي.
وقد فطن الى قدم
الملاحظة النفسية في الأدب العربي باحثان فاضلان قبلي، فعرضا لبعض مظاهرها إجمالا
– بالقدر الذي أعرض لها الآن – اذ كان عرضها تفصيلا وتتبعها تتبعا دقيقا في حاجة
الى بحث خاص مطول عن (مناهج النقد في الأدب العربي). هذان الباحثان الفاضلان هما:
الاستاذ أمين الخولي، وقد نشر فضلا في المجلد الرابع مع الجزء الثاني من مجلة كلية
الآداب سنة 1939 بعنوان (البلاغة وعلم النفس). والدكتور محمد خلف الله، وقد نشر فصلين
في هذا الموضوع، أولهما عن (التيارات الفكرية التي أثرت في دراسة الأدب) في المجلد
الأول بتاريخ مايو سنة 1943 من مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية، والثاني عن
(نظرية عبد القاهر الجرجاني في اسرار البلاغة) في المجلد الثاني من المجلة نفسها
سنة 1944.
وحديث الاستاذ
الخولي في هذا الموضوع كان لفتة سريعة في ثنايا دعوته لاستخدام (علم النفس) في
دراسة البلاغة. وأحب ان اثبت هنا هذه اللفتة بنصها، لأن لي رايا خاصا في صميم
الدعوة التي تمثلها، قد أشرت إليه من قبل:
قال تحت عنوان
(صلة قديمة) بعد تعريف البلاغة بأنها (فن القول، والبحث عن الجمال فيه كيف وبم
يكون؟) :
فاذا ما نظرنا
النظرة الأولى الى البلاغة على هذا البيان القريب لها، وجدنا محاولتها الفنية في
القول، ليست الا تتبعا لمواقع رضا النفس، وعناية بالتأثير فيها. ومن هنا تتصل بعلم
النفس، وتحتاج في دراستها إليه.
لكن ليس على هذا
البيان الساذج وحده يقوم اتصال البلاغة بعلم النفس، بل يتضح ذلك الاتصال بالنظر
الدقيق، وسواء في ذلك صنيع القدماء المتفلسفين في البلاغة وصنيع المتأدبين فيها
...
فالقدماء قسموا
البلاغة الى تلك الفنون الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، ووضعوا لها اقساما وابوابا،
ودونوا لها الاصول والقواعد، وهم في كل ذلك إنما يعرفون البلاغة بأنها مطابقة
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، ويشرحون هذا المقتضى بأنه الاعتبار المناسب الذي
يلاحظ، ويتحدثون عن انكار السامع لما يلقى إليه او موافقته عليه، او خلو ذهنه،
ويفرقون بين الذكي، والغبي، والمعاند، كما يتكلمون عن رغبات المتكلم، واتجاه نفسه
لما يتحدث عنه، من حب او كره، وتلذذ او تألم، وما لكل ذلك من أثر في القول.
تلك بلاغة الكلام.
وأما بلاغة المتكلم، فهم لا يعرفونها إلا بأمر نفسي محض، اذ يقولون انها ملكة
يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. وتسرف مطولات كتبهم في الحديث الفلسفي – على
المنهج القديم – عن تعريف الملكة، وبيانها والتمثيل لها، والحديث عن الجوهر
والعرض، وسائر المقولات.
وليس هذا فقط مظهر
وصلهم البلاغة بالأحداث النفسية عندهم، بل هم يعرضون لتلك كثيرا حين يتحدثون خلال
أبواب البلاغة عن الابواب النفسية وما تقتضيه، وما يلائمها من مظاهر كلامية وخصائص
اسلوبية. اذ نراهم يخالفون بين اضرب الخبر باختلاف حال المخاطب، كما أشرنا الى
ذلك، ويتحدثون عما يلزم في كل ضرب من وسائل التقوية والتأكيد، وهم يتكلمون عن
الأمزجة الانسانية في الفصائل البشرية المختلفة، وأثرها في صوغ العبارات، فيفرقون
بين المولدين والعرب، ويرون ان بناء الكلام للمزاج الأعرابي يخالف بناءه للمزاج
الدخيل المستعرب، كما في قصة بشار المشهورة عن بيته الشاهد المعروف:
بكرا صاحبي قبل
الهجير ان ذاك النجاح في التكبير
ويقول خلف الأحمر له:
لو قلت يا أبا معاذ. مكان ان ذاك النجاح (بكرا فالنجاح) كان أحسن، واجابة بشار له بقوله:
إنما بنيتها اعرابية وحشية؛ فقلت ان ذاك النجاح، كما يقول الاعراب البدويون، ولو قلت:
بكرا فالنجاح، كان هذا من كلام المولدين، ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى
القصيدة (14).
والأقدمون هم الذي
نسمعهم يتحدثون عن التخييل، ولعبه بالنفس، وعن التخيل حتى ليغلط المرء حسه، وهم
الذين يذكرون الايهام والوهم، ويشرحونهما مبينين أثرهما في القول، وهم يذكرون
الغيرة وفعلها في النفس، وأثرها في اخفاء اشياء وحذف اشياء عند القول، وهم الذين يتحدثون
عن التشويق وطلب الاصغاء ومواضع ذلك ووسائله، والطرق القولية المثيرة له، وعن
الطمع والرغبة الملحة، والاطماع والايئاس، وعن السرور بخلف الظن وما الى ذلك. وهم
الذين شرحوا – في إطالة – تنادي المثاني، وأنواع الترابط بينها فيما يبينونه من
جامع وهمي او خيالي او عقلي، وحقائق تلك الحركات النفسية وفرق ما بينها في تعمق ..
الى غير ذلك من مظاهر الاعتماد القوي على الخبرة بالنفس الانسانية اعتمادا يدل على
العلاقة الوثيقة بين البلاغة وعلم النفس، مع ما لبلاغتهم تلك من ناحية فنية ضيقة
المدى، وناحية علمية فلسفية شديدة التركيب والتعقد.
(ولكني رغم هذا
الاتصال الوطيد لم ار من القدماء من لمح هذا الارتباط فيما لمحوا من صلة البلاغة
بمختلف العلوم والبحوث – مع ان (علم النفس) كان من معارفهم وبين أقسام فلسفتهم –
ولعل ذلك يرجع الى انهم انما كانوا يقصدون من البحث النفسي الوقوف على حقيقة النفس
وقواعدها، دون عناية بالخصائص ووصف المظاهر النفسية في الحياة الانسانية، وهي
الناحية التيا تجه إليها المحدثون حين صدفوا عن تعرف المهايا والحقائق، أو لعل
إهمال القدماء لهذه العلاقة يرجع لغير هذا السبب، فنحن ندع تعليل هذا الآن لأنه
ليس من صميم ما قصدنا إليه).
وهذا التلخيص
السريع لخطوات الملاحظة النفسية في البلاغة عند القدماء تلخيص جيد مصور، ولكن يبدو
منه ومما يليه في كلام المؤلف انه لا يرضى، لا عن هذه الخطوات الصغيرة فحسب، ولكن
عن المنهج ذاته الذي اتبعه القدماء، بسبب انهم لم يلتفتوا الى صلة (علم النفس)
بالبلاغة، مع انه كان أحد اقسام فلسفتهم. وقد علل هذا بأنهم إنما كانوا يقصدون من
البحث النفسي الوقوف على حقيقة النفس وقواعدها، دون عناية بالخصائص ووصف المظاهر
النفسية في الحياة ...) وهو تعليل صحيح.
ونحن مع المؤلف في
عدم الوقوف – بطبيعة الحال-عند هذه الخطوات، فلقد كانت مرهونة بزمانها، مقيدة بما
وصل إليه الأقدمون في البلاغة والنقد الأدبي بصفة عامة، وما وصلوا إليه كذلك في
الدراسات النفسية العلمية .. ولكنننا لا نرى ان منهجهم كان مقصرا أو خاطئا. لقد
اعتمدوا على (الملاحظة النفسية) في محيطها الواسع، ولم يقتصروا على (علم النفس)
الذي يأخذ صفة (العلم). وسبيلنا فيما أعتقد، للانتفاع بالدراسات النفسية في الأدب
والنقد، ان نسلك هذا المنهج في حدوده الواسعة، وألا نتقيد بقواعد (علم النفس)
ونوغل في تقييد النقد الأدبي بنظرياته، لئلا نقع في الأغلاط التي وقع فيها من
حاولوا اخضاع قواعد النقد الفني اخضاعا تاما للفلسفة، او لنظريات العلوم الطبيعية
او البيولوجية، او لمذاهب علمية خاصة كمذهب النشوء والارتقاء، والتي يقع فيها الآن
من يحكمون نظريات وفروض (اللاشعور) والتحليل النفسي، على هيئة الجزم واليقين.
وحين ننتهي من هذا
نشير كذلك الى البحثين القيمين في هذا الاتجاه للدكتور خلف الله، وقد تناول في
سياق البحث الأول مظاهر الملاحظة النفسية في النقد الأدبي القديم على وجه الإجمال،
لا في البلاغة وحدها، فهو لم يكن مقيدا كزميله بهذا الموضوع الخاص. فانفسح له
المجال لاستعراض سريع يدل على مدى عناية النقاد والبلاغيين بالملاحظة النفسية، اما
البحث الثاني فقد خصصه (لأسرار البلاغة) وحده، فاستطاع ان يتوسع في شرح نظرية عبد
القادر القائمة على اساس نفسي.
وتلخيص الدكتور
خلف الله في بحثه، مع تلخيص الاستاذ الخولي، يغنينا عن تلخيص جديد، فنثبته هنا
أولا لنلخصه بعده الى تعليق آخر.
جاء في البحث
الأول ما يأتي:
(قديما طرق (ابن
قتيبة) – المتوفى سنة 276هـ-بعض النواحي الفنية والمكانية من انتاج الشعر. فذكر ان
للشعر دواعي تحث البطيء وتبعث المتكلف، منها الشراب ومنها الطرب، ومنها الطمع،
ومنها الغضب، ومنها الشوق، ومثل لهذه بأمثلة طريفة : قال احمد بن يوسف لأبي يعقوب
الخزيمي : مدائحك في منصور بن زياد – يعني كاتب البرامكة – أشعر من مراثيك فيه
وأجود. قال : كنا إذ ذاك نقول على الرجاء ونحن اليوم نقول على الوفاء، وبينهما بون
بعيد، وهذه عندي مثل قصة الكميت في مدحه بني أمية وآل ابي طالب فإنه يتشيع وينحرف
عن بني أمية بالرأي والهوى، وشعره في بني امية اجود من شعره في الطالبيين، ولا أرى
علة لذلك إلا قوة اسباب الطمع).
(ووصف (ابن قتيبة)
كذلك الأماكن والأوقات التي يسرع فيها اتى الشعر ويسمح ابيه، وفرق بين الشعراء من
حيث الطبع، وبني على هذا اختلافهم في اجادة بعض الفنون الشعرية، فهذا (ذو الرمة)
مثلا أحسن الناس تشبيها، وأجودهم تشبيها، وأوصفهم لرمل وهاجرة .. فاذا صار الى
المديح والهجاء خانه الطبع).
(وكذلك فعل
(القاضي ابو الحسن الجرجاني المتوفى سنة 366هـ) في مقدمته لكتابه الوساطة بين
المتنبي وخصومه، فبحث سيكولوجية اهل النقص، وما يدفعهم الى حسد الافاضل، وانتقاص
الاماثل، وحلل الملكة الشعرية، فرجعها الى الطبع والرواية والذكاء، وجعل الدربة
مادة لها وقوة لكل واحد من أسبابها، فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز،
وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الاحسان، وليس هناك فرق في هذه القضية بين القديم
والمحدث والجاهلي والمخضرم والأعرابي والمولد، يقول أبو الحسن الجرجاني:
وأنت تعلم ان
العرب مشتركة في اللغة واللسان، وأنها سواء في المنطق والعبارة، وإنما تفضل
القبيلة اختها بشيء من الفصاحة. ثم قد يجد الرجل منها شاعرا مفلقا وابن عمه وجار
جنابه ولصيق طنبه بكيا مفحما، وتجد فيها الشاعر اشعر من الشاعر، والخطيب أبلغ من
الخطيب، فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة؟ وهذه أمور عامة
في جنس البشر لا تخصيص لها بالأعصار ولا يتصف بها دهر دون دهر (15).
ويرجع (أبو الحسن)
اختلاف أحوال الشعر من رقة أو صلابة ومن سهولة او وعورة الى اختلاف الطبائع وتركيب
الخلق، فإن سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة، وانت تجد ذلك ظاهرة في
أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافي الجلف منهم كز الألفاظ وعر الخطاب، حتى إنك
ربما وجدت ألفاظه في صورته ونغمته في جرسه ولهجته. ويمثل المؤلف لهذا بشعر عدي بن
زيد فهو على جاهلية صاحبه أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة – وهما إسلاميان – ذلك
لملازمة عدي بن زيد الحاضرة وإبطانه الريف.
ومما فطن له (أبو
الحسن) من تلك النواحي رجوع القارئ الى نفسه، وتأمل حالها عند انشاد الشعر الرقيق،
وتفقد ما يتداخلها من الارتياح، ويستخفها من الطراب، ويتصور تلقاء ناظرها من سابق
ذكرياتها إذا سمعت هذا الشعر.
وهذا التعويل على التأمل
الباطني او فحص المرء نفسه يستعمله (عبدا لقاهر الجرجاني) المتوفي سنة 471هـ
استعمالا مرفقا في شرح نظرياته في النظم في كتابه (دلائل الإعجاز) وهو وان كان
ناسجا في هذه الناحية على منوال (ابي الحسن) فهو أول مؤلف في الأدب العربي عالج
موضوعه في طريقة علمية منظمة، وجمع بين وجهة النظر الواضحة والاستقراء الدقيق. وهو
يبني كتابه الاخر (أسرار البلاغة) على أساس نظرية نفسانية واضحة يقررها في فاتحة
الكتاب كما يلي:
فاذا رأيت البصر
بجواهر الكلام يستحسن شعرا او يستجيد نثراً، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول:
حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائغ، وخلوب رائع، فاعلم انه ليس ينبئك عن أحوال ترجع
الى اجراس الحروف (16) والى ظواهر الوضع اللغوي، بل الى امر يقع من المرء في
فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده.
ثم يأخذ في
تطبيقها في أبواب بلاغية مختلفة، كباب الجناس وأبواب التشبيه والتمثيل والاستعارة.
فهو – مثلا يرجع سر تأثير التمثيل الى علل وأسباب نفسية: (فأول ذلك واظهره ان انس
النفوس موقوف على ان تخرجها من خفي الى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكنى، وان ترد من
الشيء تعلمها اياه، الى شيء آخر هي بشأنه أعلم .. لان العلم المستفاد من طرق
الحواس، او المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة، يفضل المستفاد من جهة
النظر والفكر في القوة والاستحكام.
وضرب آخر من
الاندلس وهو ما يوجبه تقدم الالف .. ومعلوم ان العلم الأول أتى النفس اولا من طريق
الحواس والطباع. ثم من جهة النظر والروية فهو – إذن – أمس بها رحما، وأقوى لديها
ذمما ..
وضرب ثالث ألطف
مأخذا وهو أنك (اذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان اشد كانت
الى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطرب، وكان مكانها الى ان تحدث الاريحية اقرب،
وذلك ان موضع الاستحسان ومكان الاستظراف، والمثير للدفين من الارتياح .. أنك ترى
بها للشيئين مثلين متباينين. ومؤتلفين مختلفين. وترى الصورة الواحدة في السماء
والارض، وفي خلقة الإنسان وخلال الروض ... (17).
ثم هنالك ضرب
رابع، وهو ان المعنى إذا اتاك ممثلا فهو في الاكثر ينجلي لك بعد ان يحوجك الى طلبه
بالفكرة وتحريك الخاطر له، والهمة في طلبه، وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر،
واباؤه أظهر، واحتجابه أشد، ومن المركوز في الطبع ان الشيء إذا نيل بعد الطلب له،
والاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالميزة أولى، فكان موقعه
من النفس أجل وألطف وكانت به أظن وأشغف.
وعلى أسس مثل هذه
يفسر عبد القاهر بعض ظواهر الذوق، فالمعقد من الشعر والكلام – مثلا-لم يذم لأنه
مما تقع حاجة فيه الى الفكر على الجملة، بل لأن صاحبه يعفر فكرك في متصرفه، ويشيك
طريقك الى المعنى، ويوعر مذهبك نحوه، بل ربما قسم فكرك وشعب ظنك، حتى لا تدري من
اين تتوصل وكيف تتطلب.
(وجهة السحر في
التشبيه، انه يوقع المبالغة في نفسك من حيث لا تشعر، ويفيدكها من أن يظهر ادعاؤه
لها. لأنه وضع كلامه موضع من يقيس على أصل متفق عليه، ويزجى الخبر عن أمر مسلم لا
حاجة فيه الى دعوى ولا إشفاق من خلاف).
وجاء في البحث
الثاني الخاص بأسرار البلاغة لعبد القاهر ما يأتي:
والفكرة الرئيسية
التي تبرز في كتاب (اسرار البلاغة لعبد القاهر، التي يصح ان نعتبرها نظريته في
الأدب هي: (ان مقياس الجودة الأدبية تأثير الصورة البيانية في نفس متذوقها)
والفكرة في ذاتها فكرة انسانية قديمة. فقد تنبه الناس منذ العصور البعيدة الى ان
الأدب نوع من الابانة والة للتواصل الفكري؛ وان نجاحه يكون على قدر نفاذه الى عقول
سامعيه وقلوبهم. اذ ليس من العجيب ان نظفر بإشارات هنا وهناك – في كتب المؤلفين
السابقين من عرب وغير عرب – الى فكرة التأثير الأدبي. ومعظم النظريات الخالدة في
العلم لا تعدم ان تجد لها سوابق في اشارات المتقدمين وكتاباتهم. ولكن الفكرة التي
تستحق اسم نظرية هي ما كان لصاحبها فضل عرضها، وتحقيقها، وتعليلها، واستقراء
أمثلتها. وإزالة ما يعرض لها من شبهات، ومحاولة تطبيقها في ميدان الدراسة الخاصةِ.
وهذا هو ما قدم به
عبد القادر في فكرة التأثير الأدبي، فقد عرضها – اولا-فرضا-كدأب العلماء في عرض
نظرياتهم. ثم رسم الخطة لتحقيقها، فناقشها في الجناس، والحشو، والطباق، وما إليها،
ثم فصل القول فيها تفصيلا بارعا في ابواب التشبيه والتمثيل والاستعارة، وكلما قطع
مرحلة وقف ليحقق مثلا، أو يزيل شبهة، او يجيب على اعتراض. وهو لا يكتفي بشرح
الظاهرة وتطبيقها، ولكنه يحاول ان يلتمس لها العلل والاسباب، كما فعل في اسرار
جودة التمثيل، وهو لا يترك فرصة من الفرص الا انتهزها للحض على المعرفة المنظمة،
والوصول الى العلل الأولى للأشياء، والخروج من ربقة التقليد الفكري الذي كان قد غل
أذهان الناس في عصره.
(وهذه النظرية
التأثيرية في جودة الأدب جزء من تفكير سيكولوجي أعم يطبع كتاب (الاسرار) كله
بطابعه؛ فالمؤلف لا يفتأ يدعوك بين لحظة واخرى الى تجربة الطريقة النفسانية التي
يسميها المحدثون (الفحص الباطني) وذلك ان تقرأ الشعر، وترقب نفسك عند قراءته
وبعدها، وتتأمل ما يعروك من الهزة والارتياح والطرب والاستحسان، وتحاول ان تفكر في
مصادر هذا الاحساس (فاذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت، فانظر الى حركات
الاريحية مم كانت، وعند ماذا ظهرت).
ثم يخوض بك في
سيكولوجية الإلف والغرابة، والعيان والمشاهدة، والخلاف والوفاق، والسهولة
والتعقيد، وأثر كل منها على النفس، ويتعرض لشرح الإدراك وقيامه اولا على المعلومات
التي ترد من طريق الحس، ثم ازدياد ثروته بعد ذلك من طريق الروية او التأمل، وتميز
لك بين إدراك الشيء جملة وإدراكه تفصيلا، فيحدثك هنا حديثا يذكرك النظرية الحديثة
التي يسميها علماء النفس نظرية (الجشتالت) او (الهيكل العام) والتي تقوم في أساسها
على اعتبار ان الادراك ليس مجموعة حسوس جزئية تتضام فتؤلف الشيء المدرك في ذهنك،
ولكن الفكر ينفذ في اللمحة الأولى – بنوع من البصيرة الى هيكل الشيء جملة ثم يتبين
بعد تفاصيله ودقائق اجزائه، وما بينها من صلات. ولهذه النظرية شان كبير في
الدراسات الانسانية الحاضرة.
(ومن العناصر
الانسانية البارزة في نظرية المؤلف، حرصه من مكانة الذوق والطبع والحس الفني في
المتعة الادبية، فهو يقول لك في الكلام على الاستعارة والتخيل. وهذا موضع في غاية
اللطف، لا يبين الا إذا كان المتصفح للكلام حساسا يعرف وحي طبع الشعر وخفي حركته
التي هي كالهمس، وكمسرى النفس في النفس) (اسرار 226) ويقول لك في التفرقة بين
الحقيقة والمجاز : (وأنت اذا نظرت الى الشعر من جهته الخاصة، وذقته بالحاسة
المهيأة لمعرفة طعمه، لم تشك في أن الامر على ما أشرت لك إليه) (307) وتتكرر
الاشارة الى هذا في (الدلائل) فيقول في حسن الاستعارة والتشبيه : (وهذا موضع لا
يتبين سره الا من كان ملتهب الطبع حاد القريحة (دلائل 446) ويقول في تعليل ما
يصادف مع خصومه في نظريته من عناء : (لان المزايا التي تحتاج ان تعلمهم مكانها
وتصور لهم شأنها، امور خفية ومعان روحية، انت لا تستطيع ان تنبه السامع لها، وتحدث
له علما بها، حتى يكون مهيأ لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، ويكون له ذوق
وقريحة يجدلها في نفسه احساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق ان تعرض فيها المزية
على الجملة). ثم يقول: (فكيف بأن ترد الناس عن رأيهم في هذا الشأن، وأصلك الذي تردهم
إليه، وتعول في محاجتهم عليه استشهاد القرائح، وسبر النفوس وفليها، وما يعرض فيها
من الاريحية عندما تسمع؟).
ولعلنا هنا قد
اثبتنا ما قصدنا إليه في هذا البحث من ان عبد القاهر صاحب نظرية في النقد الأدبي،
يستحق بها ان يأخذ مكانه في تاريخ هذه الدراسات ورجالها المحققين، وان هذه النظرية
ذات طابع سيكولوجي وذوقي واضح، وأنها بهذا الطابع – وبين صاحبها والعصر الحاضر
تسعة قرون – تمت بكبير صلة الى اتجاه من أهم الاتجاهات المعاصرة في دراسة النقد،
يقوم على العناية بالعناصر الاصلية في الفن وبنواحي تأثيره في النفوس، واذن فلنا
ان نقول ان هذه النظرية كانت خطوة في الطريق الصحيح، وإنها جديرة بالالتفات والنقد
من دارسي البيان العربي الحديث، وإنها تصلح ان تكون اساسا لنظرية حديثة في النقد
العربي أوسع وأدق، تسير في المنهج التجريبي التحليلي – والذوق العلمي – الذي
ابتدأه عبد القاهر، وتنهض بما لم يفطن إليه من نواحي النظرية الادبية، وتبين ما
أجمله من مسالك الأدب الى النفوس، وتعالج ما أشار إليه من ضروب الصور الذهنية التي
تثيرها فنون البيان منتفعة في ذلك بالدراسات الادبية الحديثة، وبما وصلت إليه
الفروع الانسانية المختلفة التي تمت الى الأدب والفن بأوثق الصلات ...).
هذه المقتبسات تفي
بالحاجة في بيان خطوات (المنهج النفسي) في النقد العربي القديم بوجه عام. فلنأخذ
في التعليق عليها.
بالعودة الى طوائف
الاسئلة التي قلنا في أولها هذا الفصل المنهج النفسي يتصدى للإجابة عنها، نجد ان
النقد العربي القديم قد حاول ان يجيب عن شيء قليل من الطائفة الأولى، وشيء أكثر من
الطائفة الثالثة. اما الطائفة الثانية فلم يكد يعرض لها الا نادرا. حاول ان يجيب
عن بواعث العمل الأدبي الداخلية والخارجية، وتأثراته بالحالة النفسية لقائله،
وبالظروف المحيطة به، وذلك من الطائفة الأولى. وحاول ان يجيب عن عوامل التأثرية
للعمل الأدبي في نفوس الاخرين. ولم يشأ ان يقول شيئا ذا بال عن دلالة العمل الأدبي
على نفس صاحبه.
وكانت هناك لفتات
نفسية قوية في الناحية الأولى، لوحظت فيها عواطف القائل ومشاعره الباطنية وأثرها
في القول. ذلك مثل تعليلهم لبعض (الإطناب) بالتكرار ان ذلك للتلذذ او التحنن مثل
قول الشاعر:
أقول لصاحبي
والعيس تهوى بنا بين المنيفة فالمضار
تمتع من شميم عرار
نجد فما بعد العشية من عرار
ألا يا حبذا نفحات
نجد وريا روضه غب القطار
وعيشك اذ يحل
القوم نجدا وأنت على زمانك غير زار
شهور ينقضين وما
شعرنا بأنصاف لهن ولاسرار
أو (لعظم الخطب)
مثل ابيات مهلهل التي يكرر فيها أكثر من عشرين مرة (على ان ليس عدلا من كليب)،
وأبيات الحارث بن عبادة التي كرر فيها كذلك: (قربا مربط النعامة منى).
ومن ذلك التفاتة
رجل كأبي الحسن الجرجاني في الوساطة الى الارتباط بين التعبير وطبع صاحبه – وقد
وردت في مقتبسات الدكتور خلف الله – ونعيدها هنا كاملة لما فيها من لفتة طريفة.
(.. وقد كان القوم يختلفون في ذلك وتتباين فيه
أحوالهم فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الاخر، ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيره. وانما
ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلق، فان سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع، ودماثة
الكلام بقدر دماثة الخلقة، وأنت تجد ذلك ظاهرا في اهل عصرك وأبناء زمانك، وترى
الجافي الجلف منهم كز الالفاظ معقد الكلام وعر الخطاب حتى إنك ربما وجدت ألفاظه في
صورته ونغمته، وفي جرسه ولهجته، ومن شأن البداوة ان تحدث بعض ذلك، ولأجله قال
النبي (صلى الله عليه وآله) (من بدا جفا) ولذلك تجد شعر عدي وهو جاهلي اسلس من شعر
الفرزدق ورجز رؤبة وهما إسلاميان، لملازمة عدي الحاضرة وإبطانه الريف، وبعده عن
جلافة البدو وجفاء الاعراب، وترى رقة الشعر اكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيم،
والغزل المتهالك، فاذا اتفقت لك الدماثة والصبابة، وانضاف الطبع الى الغزل فقد
جمعت لك الرقة من أطرافها).
والتفات أبي هلال
العسكري الى أثر الحالة النفسية والذهنية والجسدية في قوة الشعر أو ضعفه، ونصيحته
للأدباء ألا يكدوا قرائحهم كدا لئلا تنضب وتنزح! والتفاته الى مرحلة الحضانة
والتحضير قبل البدء بالتعبير. وذلك حين يقول: (إذا أردت ان تصنع كلاما فأخطر
معانيه ببابك، وسوف له كرائم اللفظ واجعلها على ذكر منك، ليقرب عليك تناولها، ولا
يتعبك طلبها، واعلمه ما دمت في شباب نشاطك، فاذا غشيك الفتور، وتخونك الملال فأمسك..
فان الكثير من الملال قليل، والنفيس مع الضجر خسيس. والخواطر كالينابيع يسقى منها
شيء بعد شيء، فتجد حاجتك من الري، وتنال إربك من المنفعة، فاذا اكثرت عليها نضب
ماؤها وقل عنك غناؤها.
.... (وأعلم ان
ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الاطول بالكدر والمطالبة والمجاهدة والتكلف
والمعاودة. ومهما أخطأك لم يخطئك ان يكون مقبولاً قصدا، وخفيفا على اللسان سهلا،
وكما خرج عن ينبوعه ونجم من معدنه).
ويعدد صاحب
(العمدة) حالات لشعراء في دوري النشاط والخمول ويعلل اسباب هاتين الحالتين بما
يدخل في باب الملاحظات النفسية الباطنية فيقول:
(ولابد للشاعر وان
كان فحلا حاذقا مبرزا من فترة تعرض له في بعض الأوقات أما لشغل يسير، او موت
قريحة، او نبو طبع، في تلك الساعة او ذلك الحين. وقد كان الفرزدق وهو فحل مضر في
زمانه يقول (تمر عليّ الساعة وخلع ضرس من اضراسي أهون عليّ من عمل بيت من الشعر)
ثم إن للناس ضروبا مختلفة يستدعون بها الشعر، فتشحذ القرائح، وتنبه الخواطر، وتلين
عريكة الكلام وتسهل طريقة المعنى. كل امرئ على تركيب طبعه، واطراد عادته .. قال
بكر بن النطاح الحنفي : (الشعر مثل عين الماء، ان تركتها اندفنت، وان استهتنتها
هتنت) ليس مراد (بكر) ان تستهن بالعمل وحده، فاذا اجم طيه اياما، وربما زمانا
طويلا، ثم صنع الشعر. جاء بكل آبدة، وانهمر في كل قافية شاردة، وانفتح له من المعاني
والألفاظ ما لو رامه من قبل لاستغلق عليه، وابهم دونه، لكن بالمذاكرة مرة، فإنها
تقدح زناد الخاطر وتفجر عيون المعاني، وتوقظ أبصار الفطنة، وبمطالعة الاشعار كرة،
فإنها تبعث الجسد، وتولد الشهوة.
(وسئل ذو الرمة:
كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال: كيف ينقفل دوني وفي يدي مفتاحه؟ قيل له وعنه
سألناك: ما هو؟ قال (الخلوة بذكر الاحباب).
وقيل لكثير: كيف
تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال أطوف في الرباع المحيلة، والرياض المعشبة، فيسهل علي
أرصنه، ويسرع الي أحسنه.
وقال الاصمعي: ما
استدعي شارد بمثل الماء الجاري، والشرف العالي، المكان الخالي، وقيل الحالي، يعني
الرياض.
وحدثني بعض
اصحابنا من اهل المهدية، وقد مررنا بموضع بها يعرف بالكدية هو أشرفها ارضا وهواء. قال:
جئت هذا الموضع مرة، فاذا عبد الكريم على سطح برج هنالك، وقد كشف الدنيا. فقلت،
أبا محمد. قال: نعم. قلت ما تصنع ها هنا؟ قال: ألقح خاطري، وأجلو ناظري، قلت: فهل
نتج لك شيء؟ قال: ما تقر به عيني وعينك ان شاء الله تعالى. وأنشدني شعراً يدخل
مسام القلوب رقة. قلت: هذا اختبار منك اخترعته؟ قال: برأي الاصمعي.
وقالوا: كان جرير إذا
أراد ان يؤيد قصيدة صنعها ليلا، يشعل سراجه ويعتزل، وربما علا السطح وحده فاضطجع،
وغطى راسه رغبة في الخلوة بنفسه. يحكى انه صنع ذلك في قصيدته التي اخزى بها بني
نمير ..
وروى ان الفرزدق
كان إذا صعبت عليه صنعة الشعر، ركب ناقته، وطاف خاليا منفردا وحده في شعاب الجبل،
وبطون الاودية، والأماكن الخربة الخالية، فيعطيه الكلام قيادة. حكى ذلك عن نفسه في
قصيدته الفائية: (عرفت بأعشاب وما كدت تعرف) ...
وقيل لأبي نواس:
كيف عملك حين تريد ان تصنع الشعر؟ قال: أشرب، حتى اذا كنت أطيب ما اكون نفسا بين
الصاحي والسكران، صنعت، وقد داخلني النشاط وهزتني الأريحية ..
... وكان ابو تمام
يكره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك في شعره. حتى ذلك عنه بعض أصحابه قال: استأذنت
عليه، وكان لا يستتر عني، فأذن لي، فدخلت في بيت مصهرج، قد غسل بالماء، يتقلب
يمينا وشمالاً، فقلت: لقد بلغ بك الحر مبلغا شديدا قال: لا. ولكن غيره! ومكث كذلك
ساعة، ثم قال -كأنما أطلق من عقال – فقال: الآن أردت. ثم استمد وكتب شيئا لا أعرفه
ثم قال: أتدري ما كنت فيه منذ الآن؟ قلت: كلا. قال: قول ابي نواس (كالدهر فيه
شراسة وليان) أردت معناه فشمس علي، حتى أمكن الله منه فصنعت!
شرست بل لنت بل
قانيت ذاك بذا فأنت لا شك فيك السهل
والجبل
(ولعمري ولو سكت
هذا الحاكي، لنم هذا البيت بما كان داخل البيت، لأن الكلفة فيه ظاهرة والتعمّل بيّن
.. ).
ثم يمضي في سرد
مثل هذه الحالات والتعليق على بعضها في فصل كامل بعنوان (باب عمل الشعر، وشحذ
القريحة له) يستغرق نيفا وسبع صفحات من هذا الطراز.
ومن ذلك ما ذكره
ابن قتيبة من قوله: (وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف، منها الشراب ومنها
الطرب، ومنها الطمع، ومنها الشوق .. إلخ).
وما قيل عن أشعر الشعراء:
(امرئ القيس إذا ركب ... إلخ).
وهذا وأمثاله إنما
هو ملاحظات نفسية باطنية وخارجية عن بواعث العمل الأدبي الداخلية والخارجية،
وعلاقة القول بقائله، وتأثره بمزاجه وحوافزه وظروفه.
وقد كانت العناية بأثر
القول في الاخرين أكبر من هذا، فمعظم الاهتمام كان موجها الى هذا الغرض بحكم ظروف
الشعر العربي إبان الدراسات النقدية القديمة. كانت وظيفة الشاعر قريبة من وظيفة الخطيب:
في الفخر بالنفس والقبيلة، واثارة الحماسة في المناسبات الكثيرة، والمدح والهجاء
.. وكل هذه مواقف تستدعي العناية بأثر القول في نفوس الاخرين أكثر من العناية
بالدراسة الباطنية لبواعث القول – وذلك على عكس ما تحاوله المدرسة الحديثة
المعتمدة على التحليل النفسي – أما دراسة القائل في قوله، وتصوير خصائصه النفسية
من أعماله، فهذا فيما يبدو كان خارجا على طبيعة النقد حينذاك ومجاله.
وتبدو العناية
بأثر القول في الاخرين واضحة في كثير مما نقله الدكتور خلف الله واقتباسه هناك،
وفي تلخيص الاستاذ الخولي. وبعضهم يذكره في صورة ملاحظات أولية ساذجة، وبعضهم
يقرره ويتفحصه في نظريات قائمة كعبد القاهر في (اسرار البلاغة).
ونضيف هنا بعض
أمثلة اخرى تصور هذه العناية.
يقول صاحب الوساطة:
ومع التكلف المقت،
وللنفس عن التصنع نفرة، وفي مفارقة الطبع قلة الحلاوة، وذهاب الرونق، وإخلاق
الديباجة، وربما كان سببا لطمس المحاسن كالذي تجد كثيرا في شعر أبي تمام، فإنه
حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل في كثير من ألفاظه، فحصل منه على توعير
اللفظ، وتبجح في غير موضع من شعره فقال:
فكأنما هي في
السماع جنادل وكأنما هي في القلوب
كواكب
(فتعسف ما أمكن،
وتغلغل في التصعب كيف قدر، ثم لم يرض بذلك حتى اضاف إليه طلب البديع (فتحمله من كل
وجه، وتوصل إليه بكل سبب، ولم يرض بهاتين الخلتين، حتى اجتلب المعاني الغامضة،
وقصد الأغراض الخفية، فاحتمل فيها كل غث ثقيل (وأرصد لها الافكار بكل سبيل، فصار
هذا الجنس من شعره اذا قرع السمع لم يصل إليه القلب الا بعد اتعاب الفكر، وكد
الخاطر، والحمل على القريحة فان ظفر به ظفر بعد العناء والمشقة، وقد حسره الاعياء
وأوهن قوته الكلال. وتلك حال لا تهش فيها النفس للاستمتاع بحسن، او الالتذاذ
بمستطرف وهذه جريرة التكلف).
ويعلق على قول
لأبي تمام فيقول:
(وأي شعر أقل ماء،
وأبعد من ان يرف عليه ريحان القلوب من قوله:
خشنت عليه اخت بني
الخشين وأنجح فيك قول العاذلين
ألم يقنعك فيه
لهجر حتى بكلت لقلبه هجراً يبين
فهل رأيت أغث من
بكلت (18) في بيت نسيب؟).
ويقول في موضع آخر
عند الكلام على البحتري:
(وإنما احلتك على
البحتري لأنه أقرب بنا عهداً، ونحن به اشعر انساً، وكلامه أليق بطباعنا وأشبه
بعاداتنا. وإنما تألف النفس ما جانسها، وتقبل الاقرب فالأقرب إليها).
وأبو هلال العسكري
يقول في الصناعتين: (والنفس تقبل اللطيف، وتنبو عن الغليظ، وتقلق من الجاسي البشع،
وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن الى ما يوافقه، وتنفر عما يضاده ويخالفه، والعين
تألف الحسن وتقذى بالقبيح، والأنف يرتاح للطيب وينغز للمنتن، والفم يلتذ بالحلو
ويمج المر، والسمع يتشوف للصواب الذايع وينزوي عن الجهير الهايل، واليد تنعم
باللين وتتأذى بالخشن، والفهم يأنس من الكلام بالمعروف، ويسكن الى المألوف ويصغي
الى الصواب، ويهرب من المحال، ويتأخر عن الجافي الغليظ ...).
ومن ملاحظات صاحب الوساطة البارعة قوله – حكاية
عن مناظريه – في وظيفة النقد والشعر والذوق:
(ولسنا ننازعك في
هذا الباب، فهو باب، فهو باب يضيق مجال الحجة فيه، ويصعب وصول البرهان إليه، وإنما
مداره على استشهاد القرايح الصافية، والطبايع السليمة، التي طالت ممارستها للشعر،
فحذقت نقده. واثبتت عياره، وقويت على تميزه وعرفت خلاصه، وانما نقابل دعواك بإنكار
خصمك، وتعارض حجتك بإلزام مخالفك، إذا صرنا الى ما جعلته من باب الغلط واللحن،
ونسبته الى الإحالة والمناقضة. فأما وأنت تقول: هذا غث مستبرد، وهذا متكلف متعسف،
فإنما تخبر عن نبو النفس وقلة ارتياح القلب إليه، والشعر لا يحبب الى النفوس
بالنظر والمحاجة، ولا يحلى في الصدور بالجدال والمقياسة، وإنما يعطفها عليه القبول
والطلاوة ويقربها منه الرونق والحلاوة. وقد يكون الشيء متقناً محكما ولا يكون حلوا
مقبولا، ويكون جيدا وثيقا، وان لم يكن لطيفة رشيقا، وقد تجد الصورة الحسنة والخلقة
التامة مقلية ممقوتة، واخرى دونها مستحلاة مرموقة (19). ولكل صناعة اهل يرجع إليهم
في خصايصها، ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحوالها).
وقد ردد هذه
النغمة تلميذ (عبد القاهر) في آخر (دلائل الإعجاز) ايضا في فصل خاص (في بيان ان
العمدة في إدراك البلاغة، الذوق والاحساس الروحاني). كما رددها في (أسرار
البلاغة).
وقد يتحدثون عن
الشعر على انه صناعة. ويشرحون الاسباب التي تجعلها تروق لدى السامعين وتستعذب من
جهة البراعة والصناعة، فيقول صاحب الوساطة مثلا.
(والشاعر الحاذق
يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص من بعدهما الخاتمة، فإنها المواقف التي تستعطف
أسماع الحضور، وتستميلها الى الاصغاء، ولم تكن الأوايل تخصها بفضل مراعاة وقد
احتذى البحتري على مثالهم الا في الاستهلال، فنه عنى به، فاتفقت له فيه محاسن،
فأما ابو تمام والمتنبي فقد ذهبا في التخلص كل مذهب واهتما به كل اهتما، واتفق
للمتنبي فيه خاصة ما بلغ المراد، وأحسن وزاد).
وقبله يقول ابن
قتيبة عن وظيفة النسيب في مطلع القصيدة:
(.. ثم وصل بعد
ذلك بالنسيب، فشكا شدة الشوق، وألم الوجد والفراق، وفرط الصبابة، ليميل نحوه
القلوب، ويصرف إليه الوجوه، ويستدعي به إصغاء الاسماع إليه، لان النسيب قريب من
النفوس، لايط بالقلوب، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل، وألف
النساء، فليس يخلو أحد من ان يكون متعلقا منه بسبب، وضاربا فيه بسهم حلال او
حرام...).
وابن رشيق في
(العمدة) يذكر كلاما كهذا عن وظيفة النسيب.
ومن هذه النماذج،
النماذج التي جاءت فيما اقتبسناه من قبل، نصل الى ما قررناه وهو ان الملاحظة
النفسية في النقد القديم، قد عنيت بشيء من طوائف الاسئلة التي يثيرها (المنهج
النفسي) في النقد الحديث، ويتصدى للإجابة عنها.
وقد وصل في بعضها
الى نظريات قائمة، واكتفى في بعضها بملاحظات متفرقة. وكان للمنهج نصيبه على كل
حال، ومن هذا النقد الموغل في بطون التاريخ.
فأما في العصر
الحديث فقد نما (المنهج النفسي) نمواً عظيما، نما على يدي الدكتور طه حسين في
كتابيه الأول والثاني عن ابي العلاء، وفي سائر كتبه، على نحو ينقص في بعضها ويزيد
في البعض الاخر، ونما على يدي الاستاذ العقاد في سائر دراساته عن الشخصيات الادبية
في مقالاته المتفرقة في (الفصول) و(المطالعات) و(المراجعات) و(ساعات بين الكتب) ثم
تبلور واتضح في كتابه عن (أبن الرومي حياته من شعره) وكتابه عن (شعراء مصر
وبيئاتهم في الجيل الماضي) وفي كتابيه عن (عمر بن ابي ربيعة) و(جميل بثينة) ونما
على يدي الاستاذ المازني في مقالاته المتفرقة في (حصاد الهشيم) و(خيوط العنكبوت)
ثم في كتابه عن (بشار)، ونما على يدي الاستاذ امين الخولي في بحثه الذي اشرنا إليه
من قبل وفي كتابه (رأى في أبي العلاء، وظهرت آثار هذا المنهج كذلك في دراسات
الدكتور اسماعيل ادهم عن (توفيق الحكيم) و(خليل مطران) وفي دراسات الدكتور محمد
خلف الله النفسية وسواها، كما ظهرت في كتابي (التصوير الفني للقران) و(كتب
وشخصيات) لمؤلف هذا البحث. وتفشت على وجه العموم في الدراسات النقدية الحديثة.
ولكن لم ينفرد
(المنهج النفسي) إلا نادراً، فقد كان المنهجان الآخران يمتزجان به في معظم هذه
الدراسات التي أشرنا إليها، فيبدو في معظمها عاملا مساعدا، وإن كان في بعضها الاخر
يتبدى عاملا رئيسيا.
وتناولت هذه
الدراسات والمؤلفات كثيرا من الاسئلة التي يتصدى المنهج النفسي) للإجابة عنها.
وسنرى من النماذج التي نعرضها فيما يلي صورة بما بلغ المنهج من النمو في هذه
الدراسات المستحدثة.
من كتاب (مع ابي
العلاء في سجنه) للدكتور طه حسين.
وفي الفقرات
التالية يتحدث عن السبب النفسي لان يشق ابو العلاء على نفسه في (اللزوميات) فيلزم
فيها ما لا يلزم من القوافي، وينظم فيها على جميع الحروف، ومنها الصعب الذي لا يرد
فيه الشعر، ويتكلف في ذلك كله تكلفاً ظاهرا يفسد الشعر افسادا، ويرجع هذا كله الى
الفراغ وقسوته، وعبث الشيخ بهذه الصعوبات لتمضيته، فيقول:
وكانت نتيجة لزومي
للشيخ آناء الليل وأطراف النهار شهراً او بعض شهر هذه التي اريد ان اصورها لك،
وأعرضها عليك. وأول ما اواجهك به من ذلك، وانا أقدر أنك ستلقاه منكراً له تأثرا
عليه، وهو ان اللزوميات ليست نتيجة الجد والكد، وانما هي نتيجة العبث واللعب، وان
شئت فقل: إنها نتيجة عمل دعا إليه الفراغ، ونتيجة جد جر إليه اللعب. ولأوضح ذلك
بعض التوضيح فقد أهدئ من ثورتك، واحول انكارك الى اقرار واعتراف.
فقد لزم ابو
العلاء داره لا يبرحها نصف قرن كم يكون من سنة ومن شهر ومن
أسبوع ومن يوم ومن
ساعة، وقد أنك اضطررت الى ان تلزم سجنا من السجون، وليكن هذا السجن دارك التي
رتبتها كما تريد وتهوى اثناء هذا الدهر الطويل. فهل تتصور احتمالك للإقامة في هذا
السجن اثناء هذه الأعوام المتصلة، في حياة مطردة مستوية، يشبه بعضها بعضا كما يشبه
الماء الماء؟ وهل تقدر ان القوانين المدنية الحديثة حين ارادت ان تشق على المجرمين
وتلائم بين جرائمهم الشنيعة وآثامهم القبيحة، ومما ترك هذه الآثام والجرائم في
حياة الافراد والجماعات من آثار ليست اقل منها شناعة وقبحا، وبين العقوبات
المتكافئة لها، الرادعة لهم ولأمثالهم عنها وعن أمثالها، فقد فرضت السجن مع الفراغ
ومع العمل اليسير او الشاق آمادا تختلف طولا وقصرا، ولكنها لا تبلغ نصف هذا الدهر
الذي لزم فيه ابو العلاء سجنه بل لعلها لا تتجاوز ثلثه في أكثر الاحيان؟ ومن الحق
ان ابا العلاء لم يقبض عليه، ولم يفرض على نفسه الرحلة المتصلة او الفراغ المطلق،
فما أظنه كان يستطيع ان يحتمل ذلك او يصبر عليه، ولكنه كان يقرأ كثيرا، ويملي
كثيراً، ويلقي التلاميذ والطلاب والزائرين فيتحدث إليهم ويسمع منهم.
ولكن هذا كله على
كثرته وتنوعه لا يستطيع ان يملأ وقت الشيخ، ولا ان يغير ما فيه من التشابه
والاستقرار والاطراد، ولم يكن ابو العلاء ينفق وقته كله مع الناس قارئا او ممليا
او متحدثا، وانما ينفق بعض هذا الوقت في هذه الأعمال، وينفق بعضه الاخر فارغا
لنفسه خاليا إليها، ولعل الوقت الذي كان يفرغ فيه الى نفسه، ويخلو فيه إليها ان
يكون مساويا له، او ان يكون اقل منه شيئاً؛ وهو قد كان على كل حال وقتا طويلا
يتكرر في كل يوم دون انقطاع، لا أثناء عام او اعوام، بل اثناء عشرات الاعوام، ولم
يكن ابو العلاء اذا خلا الى نفسه شغل عنها بالحديث الى زوجه، او بمداعبة بنيه، وما
احسبه كان يتحدث الى خادم فيطيل الحديث، وما اري الا ان خادمه كان ينصرف عنه اذا
انصرف الناس، بعد ان يرتب له من أمره ما يحتاج الى الترتيب، ولم يكن ابو العلاء
اذا خلا الى نفسه يستطيع ان يقطع الوقت للقراءة، فهو لم يكن يقرأ الا اذا وجد
قارئا، لأنه كان كما حدثنا مستطيعا بغيره. ولم يكن يكتب ايضا لنفس السبب، وما أرى
انه عرف الكتابة والقراءة التي يعرفها امثاله من المكفوفين، وان اشار الى هذا
النحو من القراءة في قوله:
كأن منجم الاقوام
أعمى لديه الصحف يقرؤها بلمس
فلم يحدثنا أحد
بانه قرأ وكتب بيده، وانما حدثنا هو بأنه استطاع دائما بغيره وسمى لنا بعض الذين
اعانوه على القراءة والكتابة. وشكر لهم ما أسدوه إليه من معونة. كان اذن يخلو الى
نفسه، والى وقته، ولا يجد من الناس ولا من القراءة ولا من الكتابة ولا من اي عمل
من الاعمال اليدوية ما يعينه عليها. وما ارى انه كان كثير النوم، وانما كانت حياته
القانعة الخشنة خليقة ان تؤرقه، او ان تجعل حظه من النوم قليلا. فماذا كان ابو
العلاء يصنع اثناء ساعات الفراغ تلك التي كانت تفرض عليه في كل نهار، وفي كل ليل،
وفي كل اسبوع وفي كل شهر، وفي كل عام اثناء نصف قرن؟ كان يفكر. ولكن يفكر في ماذا؟
يفكر فيما كان قد حصل من علم وادب وفلسفة، وفيما كان يقرأ عليه من ذلك، وفيما كان
يتهيأ لإملائه منه على الطلاب والتلاميذ.
ونحن نعرف ان غير
ابي العلاء من الادباء والفلاسفة والمعلمين والمبصرين قد شغلوا بالتفكير وبالإنشاء
وبالتعليم. قرءوا وفكروا فيما قرءوا، وأملوا واستعدوا للإملاء، وأنشئوا وجدوا في
الانشاء، ولكن هذا كله لم يملأ اوقاتهم ولم يشغلهم عن الحياة الاجتماعية، ولا عن
المنزلية الخاصة، ولم يحرمهم الاستمتاع بما أبيح لهم من طيبات الحياة، بل لم يرد
بعضهم عن الاستمتاع بما حرم عليهم من سيئات الحياة. فهم قد وجدوا الوقت للتحصيل
والانتاج والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمنزلية، وهم قد وجدوا مع ذلك أوقاتا
للفراغ والراحة. فما أظنك برجل كأبي العلاء، قد صرف عن الحياة الاجتماعية، وعن
الحياة المنزلية، وعن طيبات الحياة وسيئاتها. وكف بصره فلم يشغله حتى النظر الى ما
حوله من الاشياء؟ اذن فقد كانت أوقات الفراغ لأبي العلاء طويلة شاقة، أطول مما
يستطيع وأشق مما يطيق، ولم يكن له بد من ان يستعين على هذه الاوقات بما يسليه
ويلهيه، في براءة للنفس، ونقاء للقلب، وطهارة للضمير، حتى يدركه النوم، وحتى يدخل
عليه الطلاب والزائرون. وبماذا تريد ان يتسلى ويتلهى في براءة وطهارة ونقاء، وفي
خلو الى النفس وانقطاع عن الناس واستغناء عنهم ايضا؟ لابد له ان يلتمس التسلية
والتلهية عن نفسه، وعند نفسه وحدها، وقد فعل، فاستجابت له ذاكرة قوية وحافظة
نادرة، وعقل ذكي بعيد آماد التفكير. فأما ذاكرته او حافظته فقد وجد فيها ما مسع من
الشيوخ، وما قرا في الكتب، وما روى من الشعر، وما وعى من الاخبار والآثار. وأما
عقله فقد وجد فيه ما حصل من العلم على اختلاف ألوانه، ووجد فيه بنوع خاص هذه
المقدرة على استقصاء الاشياء والنفوذ الى أعماقها.
ونظر أبو العلاء
فرأى نفسه بين الألفاظ التي لا تكاد تحصى، وبين هذه المعاني والآراء التي لا تكاد
تحصى ايضاً، ولم يجد معه إلا هذه المعاني وتلك الألفاظ، ثم نظر فوجد أوقات فراغ
طويلة، لا يطاق احتمالها، ولا يمكن الصبر عليها، فما قيمة ما حفظ من اللغة، وما
قيمة ما حصل من العلم، إذا لم يعيناه على قطع أوقات الفراغ هذه؟ غيره من الناس
يلعب النرد والشطرنج، ويضرب في الارض، ويلم بالمجالس والأندية ويجد في كسب القوت،
ويستمتع بألوان اللذات، وليس هو في شيء من هذا. فلم لا يلعب بهذه الألفاظ؟ ولم لا
يلعب بهذه المعاني؟ ولم لا يتخذ من الملائمة بينهما على أكثر عدد ممكن من الاوضاع
الاشكال والضروب سبيلا الى التسلية والتلهية والاستعانة على الفراغ؟ اما انا فما
اشك في اني لم اخطئ، ولم اخدع نفسي، حين اعتقدت اني شهدته يبعث بالألفاظ والمعاني
الوانا من العبث، لأنه لم يكن يستطيع ان يصنع غير هذا، ألوانا من العبث كثيرة
الاختلاف : نثر مرسل، ونثر مسجوع، وشعر حر، وشعر مقيد، والشعر الحر هو الذي يقوله
الناس جميعا فيلتزمون اوزانه وقوافيه المعروفة، والشعر المقيد هو الذي يقوله ابو
العلاء فيلتزم فيه ما لا يلزم، وهو لا يلزم في القافية وحدها، وإنما يلتزم ما لا
يلزم من المعاني أيضاً، وهو لا يلتزمها في المعاني التي اودعها ديوان اللزوميات
فحسب، وانما يلتزمها في المعاني التي أودعها كتاب الفصول والغايات أيضاً).
من كتاب (ابن
الرومي. حياته من شعره) للأستاذ العقاد:
وفي هذه الفقرات
يحدثنا عن مزاج ابن الرومي، وأثره في اسرافه في كل شهوات النفس والجسد، وأثر هذا
الاسراف ذاته في مزاجه، وأثرهما معا في (وسوسته) وأثر هذه الوسوسة في استطراداته
الشعرية. وهي نموذج لمواضع كثيرة في الكتاب، تتناول كل نواحي نفسه وانفعالاته
الظاهرة والخفية:
ولعل الاصوب ان نقول:
ان ابن الرومي وقع من مزاجه واسرافه في حلقة موبقة لا يدري اين طرفاها، فمزاجه
اغراه بالإسراف، والاسراف جنى على مزاجه، فان هذا الاسراف الموكل بالاستقصاء في كل
مطلب ورغبة خليق ولا غرو ان يسقم جسمه، وينهك أعصابه، ويتحيف صوابه، بيد انه لا
يسرف هذا الاسراف الا وفي جسمه سقم وفي اعصابه خلل، وفي صوابه شطط لا يكبح جماحه،
فالعلة هي سبب الاسراف، والاسراف هو سبب العلة! وهو من هذه الحلقة الموبقة في بلاء
وأصب، ومحنة لا قبل بها للضليع الركين، فضلا عن المهزول الضئيل، وعلاقة ذلك كله
باختلاف الاعصاب وشذوذ الأطوار بدءا وعودا، ثم عودا وبدءا، أوثق علاقة من جانب
الجسد وجانب التفكير.
ولا تعوزنا الادلة
على اختلال اعصاب ابن الرومي وشذوذ أطواره من شعره وغير شعره. فان أيسر ما تقرؤه
له او عنه يلقي في روعك الظنة القوية في سلامة اعصابه، واعتدال صوابه، ثم يشتد بك
الظن كلما اوغلت في قراءته والقراءة عنه، حتى ينقلب الى يقين لا تردد فيه. وكل ما
نعلمه عن نحافته وتقزز حسه، وشيخوخته الباكرة، وتغير منظره، واسترساله في الوجوم،
واختلاج مشيته، وهجائه، وإسرافه في أهوائه ولذاته، ثم كل ما نطالعه في ثنايا سطوره
من البدوات والهواجس .. قرائن لا تخطئ فيها الدلالة الجازمة على اختلال الاعصاب
وشذوذ الاطوار، بل لا نخطئ فيها الدلالة على نوع الاختلال ونوع الشذوذ.
ونقول (نوع
الاختلال) لأن هذه الكلمة عنوان واسع يشمل من الحالات النفسية والجسدية مثل ما
تشمله كلمة (الصحة) او أكثر، فهذا صحيح وهذا صحيح، ولكن البون بينهما جد بعيد،
وهذا مختل الاعصاب وذاك مختلها، ولكن الخلاف بينهما في الأخلاف والمشارب كأبعد ما
بين فردين مختلفين من بني الإنسان، فتختل أعصاب المرء فاذا هو جسور عنيد، متعسف
للأخطار، هجام على المصاعب لا يبالي العظائم، ولا يحذر العواقب، وتختل أعصاب المرء
فاذا هو مطيع حاضر الخوف، متوجس من الصغائر، يبالغ في تجسيمها، ا و يخلقها من حيث
لم تخلق، ولم يكن لها وجود في غير وهمه، وبين الحالتين – لا بل في كل حالة من
الحالتين – نقائض وفروق لا تقطع تحت حصر، ولا تطرد على قياس.
وبديهي ان ابن
الرومي لم يكن من الفريق الأول (نوع اختلاله) ولكن كان من الفريق الثاني، الذي
يستحضر الخوف، ويكثر التوجس ويتخلق الأوهام.
ومن أصحاب هذا
المزاج من يخاف الفضاء، او يخاف حيوانات منزلية لا قوة لها ولا ضراوة، كالقطط
والكلاب والجرذان. فابن الرومي واحد من هؤلاء نحسب انه كان مستعدا لهذه الهواجس
طول حياته، في صحته ومرضه، وفي شبابه ومشيبه، ونحسب ان استقصاءه للمعاني الشعرية،
والإلحاح في تفريغها، وتقليب جوانبها ان هو الا علامة خفيفة من علامات الوسواس
الذي لا يريح صاحبه ولا يزال يشككه، ويتقاضاه التثبت والاستدراك، فيمعن ثم يمعن حتى
لا يجد سبيلا الى الإمعان (20).
ولكنه مع استعداده
الهواجس في شبابه ومشيبه، قد تمادى به الوسواس في أعوامه الاخيرة حتى أصبح آفة
متأصلة. وغلبت على أقواله وأفعاله جميعا، فليس له عنها محيص، فأفرط في الطيرة،
واشتد خوفه من الماء لا يركبه ولو أدق ودعاه الى ركوبه من يمنونه الأرفاد وحسن
الضيافة، وصور لنا ما يعتريه من خوف الماء تصويرا لا يدل الا على حالة مرضية، ولو
كان التشبيه فيه من مجاز الشعر وتمويه الخيال. وهذا بعض ما قاله في مخاوفه وأهوال ركوبه:
ولو ثابت عقلي لم
أدع ذكر بعضه ولكنه من هوله غير ثائب
أظل إذا هزته ريح
ولألأت له الشمس أمواجا طوال الغوارب
كأني أرى فيهن
فرسان بهمة يليحون نحوي بالسيوف
القواضب
(والماء الذي يصفه
هو ماء دجلة، لا ماء البحر، ولا ماء المحيط!).
***
من كتاب (بشار)
للأستاذ المازني.
وفي هذه الفقرات
يتحدث عن الحياة النفسية الناشئة من عاهة بشار الخاصة:
(فهو كان يهجو
الناس، ويبسط لسانه فيهم، ويشنع عليهم، ليرهبهم ويخيفهم، ويظفر بما لهم او يبتزه
على الأصح. فيعيش مترفا منعما موسعا عليه، ويبقى مخشى اللسان. وإذا كان على ضخامة
جثته، ومتانة أسره، وشدة بنيته لا يستطيع ان يكون فاتكا، لما مني به من العمى، فقد
اتخذ من لسانه أداة للفتك والبطش، ووسيلة الى استشعار القوة وافادة العزة. قالت له
بنته مرة: (يا أبت ما لك يعرفك الناس ولا تعرفهم)؟ قال: (هكذا الامير يابنية).
ولم يكن ولوعه
بالهجاء والتقحم على الناس بالشتم لحقد دفين ينطوي عليه وعداوة كامنة يمسكها في
قلبه، وضراوة طبيعية بالشر، بل لأنه كان يشعر بالنقص من ناحيتين: أنه كفيف، وأنه
من الموالي، فلا يزال من أجل هذا يعالج ان يعوضه اذ كان لا يملك ان يغير ما به.
فما الى رد بصره من سبيل، ولا ثم حيلة يعرفها هو او سواه يخرج بها من طبقة
الموالي، سوى ما كان من تحريضه لهم على ترك الولاء. وفي طباع الإنسان ان يستر
ضعفه، او يحاول ان يفيد عوضا عما حرمه او فقده؛ ولما كان بشار قوي البدن، موفور
الصحة، وكان الى هذا عالي اللسان، فقد أغراه ذلك بالتماس العوض الميسور، وهو إفادة
القوة الأدبية، واشعار نفسه والناس قدرته على البطش المعنوي الذي سدت عليه سبيله
المادية.
فيما يبقى من شعره
وأخباره الدليل على شدة شعوره بعماه، فقد كان كثير الذكر له في شعره وكلامه، وقد
تقدم بعضه، ومن ذلك أيضاً قوله:
يا قوم أذني لبعض
الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين
أحيانا
قالوا بمن لا ترى
تهذي؟ فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كانا
وقوله:
وكاعب قالت
لأترابها يا قوم ما أعجب هذا الضرير:
هل يعشق الإنسان
من لا يرى فقلت والدمع بعيني غزير
أن تك عيني لا ترى
وجهها فإنها قد صورت في الضمير
وقوله:
بلغت عنها شكلا
فأعجبني والسمع يكفيك غيبة البصر
وقوله:
يزهدني في حب عبدة
معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي
فقلت دعوا قلبي
وما اختار وارتضى فبالقلب لا
بالعين يبصر ذو اللب
وما تبصر العينان
في موضع الهوى ولا تسمع الأذنان
إلا من القلب
(وحكوا عنه أنه
سأل صانعا ان يصنع له جاما فيه صور طير تطير، فجاءه بما طلب. فسأله بشار عما فيه،
فقال الرجل (صور طير تطير) فقال بشار (كان ينبغي ان تتخذ فوق هذا الطير طائرا من
الجوارح، كأنه يريد صيدها، فإنه كان أحسن) قال الرجل (لم أعلم) قال بشار (بل قد
علمت، ولكن علمت اني أعمى لا أبصر شيئا).
وحتى في هذه
الحكمة يريد بشار ان يكون في الصورة طائر من الجوارح يهم ان ينقض على طير ضعاف.
وعسى ان تكون الحكاية مخترعة. فما ثم ما يعين على الجزم بالصحة او الكذب، وخاصة
لان الرجل كثير التشنيع عليه، والتسميع فيه، والكراهة له. فان تكن صحيحة فهي مما
يشي بالتفات ذهنه الى عماه – كما هو طبيعي – وان تكن موضوعة فهي آية على إدراك
واضعها لحالة بشار النفسية وتأثره بعماه. ومن مغالطة نفسه قوله: (الحمد لله الذي
ذهب ببصري) فقيل له: (ولم يا أبا معاذ) قال: (لئلا ارى من أبغض) فإنه إذا كان قد
أعفى من رؤية من يبغض فقد حرم رؤية من يحب وما يحب.
(وهجاه ابو هشام
الباهلي بشعر قبيح لا يروى، وعيره بعماه وقالوا (ولم يزل بشار منذ قال فيه هذين
البيتين منكسرا).
ورفع غلام بشار
إليه في حساب نفقته جلاء مرآة عشرة دراهم، فصاح به بشار وقال:
(والله ما في
الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى بعشرة دراهم، والله لو صدئت عين الشمس حتى يبقى
العالم في ظلمة، ما بلغت أجره من يجلوها عشرة دراهم).
وهي صيحة لا داعي
لها، والتناسب بينها وبين الباعث عليها مفقود. وما كانت هذه مرآة فما بالأعمى حاجة
إليها، وإنما كانت مرآة جاريته او امرأته ولكنه زوج بنفسه وأدخلها في الأمر لفرط
احساسه بعماه، وسيطرة هذا الاحساس على وجدانه. وجرى بباله ان الغلام يكذب عليه
ويخدعه لأنه ضرير.
ومما يجري مجرى
الخبر الاسبق ان صديقا له قال له وهو يمازحه (ان الله لم يذهب بصر أحد الا عوضه
بشيء. فما عوضك...؟) قال (الطويل العريض) قال (وما هذا؟) قال (لا أراك ولا أمثالك
من الثقلاء) ثم قال (يا هلال. أتعطيني في نصيحة اخصك بها؟) قال (نعم) قال (إنك كنت
تسرق الحمير زمانا، ثم تبت وصرت رافضيا، فعد الى سرقة الحمير فهي والله خير لك من
الرفض) فهو كما ترى حساس جدا من هذه الناحية وصبره قليل وغضبه يستشري.
(كان يحرص على ان يبدي
للناس ذكاء قلبه. وأنه لم ينقص بالعمى شيئا. قالوا: مر ابن أخي بشار به ومعه قوم،
فقال بشار لرجل معه ومن هذا؟ قال ابن اخيك. قال: (اشهد ان اصحابه انذال) قال (وكيف
علمت؟ قال (ليست لهم نعال).
على أنه لا حاجة
بنا الى الشواهد من الشعر والنثر والاخبار، فما يسمع انسانا الا ان يشعر بما رزق
او حرم. ولعل الشعور بالحرمان اقوى وأبلغ وأعظم أثر في البحتري رأيت العين بابا
الى القلب!، وهو أقوى (حاسة اجتماعية) وأكثر المجازات في هذا الباب مستمدة من
إحساساتها، والمرء عنها أفهم، وبها أقوى وأقدر، وعسير ان يغني غيرها غناءها، كما
يشق ان تكفي هي مكان سواها، فإن لكل جارية عملها، كما يقول ابن الرومي.
هل العين بعد
السمع تكفي مكانه او السمع بعد
العين يهدي كما تهدي
(وإن كان من
المعقول إذا تطلعت جارية ان تقوي الاخرى. او كما يقول بشار نفسه: ان عدم النظر
يقوي ذكاء القلب، ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الاشياء. فيتوفر حسه وتذكو
قريحته).
***
من كتاب (رأى في
أبي العلاء) للأستاذ ايمن الخولي.
وفي هذه الفقرات
يعلل سبب اضطراب آراء المعري في نظرته للحياة، وذلك في دور حياته الثاني: دور الاعتزال:
وانتهت حياة ابي
العلاء على هذه الحال التي صار إليها في دوره الثاني، فأمضى حياة كلها إنكار
الواقع، واستعلاء عليه، ورغبة في تكميل ما نقصه، فيوما ينكر آفته، ويوما ينكر
بشريته .. حينا يطلب الدنيا بغير آلتها. وانا يخرج نفسه من الدنيا وهو فيها ..
ذكاؤه دفع، وآماله واثبة .. وواقعة قاس، ونقصه غير يسير، ورغبته في التكمل جامحة،
فهو ونفسه أبدا في جذب كما قال:
إني ونفسي أبدا في
جذاب أكذبها وهي لا تحب الكذاب
وفي هذه الحال
النفسي وأجه ابو العلاء الحياة في حس مرهف، وشعور دقيق، وروح ساهرة، وروح يدون
خواطره تدوينا موسعا مفصلا دقيقا شاملا للعوامل النفسية المختلفة التي تمر به ويمر
بها، ومدركا في دقة أخفي غوامض هذه العوامل النفسية. فهل يستغرب بعد ذلك ان يغضب
هذا الرجل فيواثب القدر ويهاجم الاقداس، ويلغي الناس، أو ان ينظر الى حاله فيرى
الأمر حظا واتفاقا لا غير، ويلعن هذا الحظ، أو أن يروض نفسه، فتلين حينا، وتسخر من
الحياة ومن فيها ومن متع الدنيا والمتقاتلين عليها. وتشوه ذلك تشويه زاهد ممعن في
التجرد والتخلي، او ان تشعر هذه النفس الدقيقة بالحياة الواقعة كما أخضعت الناس
وخضعوا لها فتحلل من ذلك ما تحلل تحليلا بارعا وتصفه وصفا قديراً .. أو ان تلجأ
هذه النفس اذا قسما عليها الواقع الى فسيح الرحمة الإلهية، ورحب العوالم السماوية؟ .. لا بعد في شيء من ذلك ولا غرابة أبداً، بل
شأن النفس المكبوتة هذا الكبت المتطلعة ذلك التطلع، ان تنتقل مثل هذا التنقل.
ولو أن رجلا عاديا
خالصا من هذا الصرع الدائم في نفس ابي العلاء قد راح يدون خواطر نفسه في شعور تام
بها، وتتبع متنبه لها، واستيعاب شامل لعواملها لمر في الحياة بنواح مختلفة تختلف
بها خواطره، ولخرج بشبيه لما قاله ابو العلاء يختلف فيه مرحه عن غضبه، وهزيمته عن
نجاحه، وفرحه عن حزنه، فكيف بأبي العلاء وهو يتردد بين أمرين احلاهما مر، بل هما مرير
وأمر: واقع قاس، وإنكار جريء.
فالسر في تناقض او
تغاير آراء ابي العلاء نفسي محض، ويرجع الى امرين في نفسه: او الى ظاهرتين فيه:
أولاهما: الرغبة
المتوثبة في الاستعلاء على ضعفه والقهر لواقعه .. وهو ما ساد دوري حياته على
السواء، وثانيتهما دقة هذه النفس الشاعرة في إدراك عوالمها المختلفة، وخوالجها
المتغايرة؛ ثم يؤازر هذين العاملين انقطاع ابي العلاء لتدوين خواطره، وفراغه لذلك
وتوافره عليه.
وهكذا تغايرت آراء
ابي العلاء بين معانيه: دينيها ودنيويها فنيها وعمليها، بل هو في غير الديني قد
يكون أكثر تغايرا او تقابلا .. وهكذا ينبغي ان نفهم آثار أبي العلاء – فيما ارى –
فهو نفسيا صحيحا، صادقا، دقيقا، عميقا، ممتعا، مقبولا على هذا الاساس.
(وإذا ما فهمنا
ابا العلاء على هذا الوجه، فقد فهمناه من نفسه هو. لا من نفوس دارسيه وقارئيه، كما
حصل ذلك في القديم والحديث).
***
من كتاب (توفيق
الحكيم الفنان الحائر) للدكتور اسماعيل أدهم.
ويصف في هذه
الفقرات أثر الحياة العائلية في نفس توفيق الحكيم، وتوجيهها للفنون:
لقد كانت الحياة
العائلية التي نشأ فيها توفيق الحكيم مطبوعة بالطابع التركي الارستقراطي غير انها
كانت متقلقلة، نتيجة للصراع القائم بين الطبيعة الأولى التي ركب عليها والده،
والحياة المدنية التي دلف إليها، والتي كانت تلون حياته الزوجية بلون خاص وتضطر
والدته على العمل على تغليب الحياة المدنية في زوجها بما هي عليه من قوة وشخصية،
وقدرة على التأثير على بعلها، وكان أثر هذا بليغاً على الطفل توفيق، اذ جعله ينفر
من هذا الطابع الارستقراطي المفروض في حياة الاسرة، والطابع التركي الذي يسمه
بميسم خاص.
ولما كان نظام
التربية التركية من أشد نظم التربية تضييقا على الإنسان ونزعاته ورغباته واكثرها
حفظا على المتوارث من التقاليد، فقد كانت الوالدة تبذل كل جهدها لا تصب الطفل
توفيق في قالب يتكافأ وأغراض هذا النظام من التربية، غير ان حيوية الطفل وطبيعته
المرنة التي لا تألف الى قالب، ولا تركن الى منوال كانت تجعله يفلت من بين يديها،
يساعد الطفل على هذا المحيط العائلة المتقلقل، ولم يكن هناك من سبيل امام الام
لتصل الى اغراضها الا ان تعمد للطفل توفيق، فتمنعه عن الاختلاط بأبناء العزبة من
الاولاد الفلاحين فكان نتيجة ذلك ان عاش الطفل ايام الطفولة في عزلة، فكانت
الارجاع التي تأخذ مظهر ألعاب الطفولة نتيجة لغريزة اللعب التي تقسر الطفل عليها
عند أقرانه من الاطفال، تأخذ عنده طيقا داخليا، اذ تتحول لرجوع داخلية، يحاول
الطفل معها اكتشاف المحيط الذي يحيا فيه، ومن الصور التي يخرج بها من معالجة
الاشياء معالجة حسية بطبيعته، كان يترك لميوله الفطرية في اللعب ان تعبث بها.
ولقد تحولت هذه
الميول الفطرية للعب عند الطفل توفيق عن طريق منحي المعالج الحرة للأشياء الى تخيل
بنائي وإيهام وفي هذا التخيل والإبهام كان الطفل يجـ مخرجا ومنفذا لميوله التي سدت
عليها الطرق في الحياة الواقعية، وبالنظر الى القيود التي وضعها نظام التربية التي
فرضتها والدته عليه، وكان هذا التخيل والإيهام سببا في ان يقف الطفل توفيق في
حياته عند تجاريبه الناقصة في الحياة، فيعمل على استعادة صورها، ولا يكتفي بذلك بل
يعمد لتنظيمها من جديد على حسب قاعدة التداعي، وكان يخرج بصور جديدة، ,هكذا كانت
الألعاب التي تقسر الطفل عليها غريزة اللعب عند الإنسان، تأخذ مظهرا من الألعاب
الفكرية، ولهذا كانت حياته ذهنية محضة في طفولته، ولهذا أيضاً لم يكن الطفل يميل
الى الجري والقفز كبقية اقرانه من الاطفال.
وهذا التحول
بالإرجاع نحو الداخل كان بجانب الانعزال سببا لأن يحتفظ الطفل بذاتيته سليمة
الانطباع بالقالب الذي يريد ابواه حسبه فيه، ولكن التضييق عليه ترك في نفس الطفل
اثراً واضحا هو حالة التكتم، ولهذا كانت صراحة ناقصة في إحدى جهاتها، هذا الى
تضييق الوالدين عليه، والوقوف امام شخصيته، والحيلولة دون مدها. كان سببا لان يحس
الطفل توفيق بنفرة من والديه، وتصرفاتهما معه، فعاش غريبا بين ابويه، يشعر بان
هناك شيئا لا يستوضحه يفصل بينه وبينهما.
في هذا الوسط
الخالط للشخصية كان الطفل توفيق قد وجد لشخصيته السبيل للتفتح والامتداد، ولكن عن
الطريق الداخلي، وكان يقترن تفتح شخصيته وامتدادها نحو الداخل عنده بمواقف عداء ضد
رغائب الأبوين، فلما تفتحت غريزة الجنس عند الطفل وقفت عند حدود النفس، مسوقة لذلك
بطابع الوسط العائلي الذي يكتنفه. غير ان تفتح شخصية الطفل ومد ذاتيته عن الطريق
الداخلي، وتحول ألعابه الى ألعاب فكرية، وجهت الغريزة توجيها قويا نحو التخيل
والتفكير. فكان ان تعلقت نفسيته بالفنون الجميلة.
***
من كتاب (كتب
وشخصيات) للمؤلف. وفي هذه الفقرات يتحدث عن طريقة تكون العمل الفني (الشعر) وعمل
الوعي فيه ونصيب (ما وراء الوعي):
هل يستمد العمل
الفني عناصره كلها في معين الوعي والذهن. ام هل يستمد عناصره كلها من (وراء الوعي)
وينابيع الإلهام؟ ام هل يزاوج بين الوعي وما وراء الوعي، ويستعين بهذه القوى وتلك
على السواء؟
للإجابة عن هذه
الاسئلة يجب الا نستشير القواعد النظرية وحدها، فهذه القواعد قد تقودنا الى منطق
نظري بعيد عن الواقع العملي، إنما يجب ان نستشير كذلك التجارب العملية التي عاناها
بعض رجال الفن. فلا نقضي في الأمر في غيبة عن شهوده المجرمين!
وحين نقول: (عناصر
العمل الفني) لا نعني ان هذه العناصر منفصلة، او انه يمكن البحث عن كل عنصر منها
على انفراد؛ ولا نقع في الغلطة التي وقع فيها القدامى كما وقع فيها كثير من
المحدثين حينما راحوا يقسمون الكلام الفني الى لفظ ومعنى، ثم راحوا يتجادلون: فيما
يكون فيه الابتكار، وبه يكون تقويم الكلام.
ذلك جدل لا يؤدي
الى شيء، فالعمل الفني كله وحده، لا يقوم أحد عناصرها بذاته ولا يرى منفصلا عن
بقية العناصر.
فاذا نحن تحدثنا
عن العناصر المختلفة فذلك مجرد فرض يسهل علينا الفهم والتصور. تلك حقيقة أود
تقريرها بقوة، وعندئذ لا يصبح من الخطر ان نتحدث عن عناصر العمل الفني المسمى
بالشعر.
كل من عانى نظم
الشعر يعرف ان هناك مراحل يتم فيها هذا النظم. وسرد هذه المراحل قد يساعدنا على
تبين العناصر التي تبرز في كل مرحلة منها بروزا خاصا.
فهناك في أول
المراحل مؤثر ما يقع على الحس أو النفس، فيسبب انفعالا على وجهه من الوجوه. هذا
المؤثر قد لا يكون حادثاً ماديا، او حالة شعورية، او شيئا ما بين هذين الطرفين
المتباعدين، فقد يكون منظرا تقع عليه العين، او صوتا يتسرب الى الاذن؛ او تجربة
نفسية تمر بالشاعر، او حكاية تجربة وقعت لسواه. الى اخر المؤثرات المادية
والمعنوية التي يتعرض لها الفرد وتتعرض لها الانسانية في جميع الأزمان.
وهناك في المرحلة
الثانية استجابة لهذا المؤثر في صورة انفعال؛ وهذه الاستجابة تتكيف بعوامل كثيرة:
منها طبيعة المؤثر، ومدى حساسية المتأثر به، وطبيعة مزاجه، وتجاربه الشعورية
الماضية، وعدد ضخم من العوامل التي تجعل كل فرد يستجيب للمؤثرات المتحدة نوعا
بطريقة مختلفة كل الاختلاف عن استجابة الافراد الآخرين.
هذا الانفعال
الشعوري ينصرف معظمه الى طاقة عضلية وعصبية عند غير الفنانين، وينصرف أقله عن هذا
الطريق عند رجال الفنون، بينما معظمه ينصرف على صورة اخرى، هي الصورة الفني التي
تسمى لونا منها بالشعر، فكيف يتم هذا الشعر خاصة؟
ان هذا الانفعال
يتبلور في صورة لفظية، وإيقاع موسيقى، يمتزج أحدهما بالآخر والمشاعر التي صاحبت
ذلك الانفعال في النفس، ويصور كذلك الجو الشعوري الذي عاش الانفعال فيه. وإذا نحن
سمينا جانبا من هذه الخواطر والمشاعر معاني، فان جانبا منها لا تشمله هذه التسمية،
ولا تدل عليه، وذلك هو جانب الجو الشعوري الذي عاشت فيه هذه المعاني، واكتسبت منه
ألوانها، ودرجة حرارتها ومقدار اندفاعها، ومدى ما ترمز إليه في النفس من انفعال
مبهم ليست الألفاظ الا رموزا له؛ تشير إليه ولا تعبر عنه، إنما يعبر عنه ذلك
الايقاع الموسيقي العام، كما تعبر عنه الألفاظ بجرسها او بالظلال التي تلقبها،
والتي هي زائدة في الحقيقة عن معناها اللغوي الذي يفهمه الذهن منها.
مما تقدم نستطيع
ان نحدد – على وجه التقريب-عمل الوعي وما وراء الوعي في الشعر، فنستطيع ان نقول:
ان الشعر يستمد معظم مؤثراته وانفعالاته من وراء الوعي، وان الوعي إنما يبدأ عمله
عند مرحلة النظم التي لا بد فيها من اختيار الفاظ خاصة، تعبر عن معاني خاصة،
وتنسيقها على نحوين معين، لتنشئ وزنا معينا، وقافية معينة.
ولكن هذا القول لا
يمضي على اطلاقه. ففي حالات شعورية خاصة يبلغ التأثر والانفعال درجة عالية، قد تتم
عملية النظم ذاته بلا وعي، او بلا وعي كامل، لان الانفعال يستدعي الألفاظ
والعبارات بطريقة شبه تلقائية. هذه هي أجمل لحظات الشعر بلا جدال.
ولا معنى لان ينكر
أحد هذه الحالة الواقعة لمجرد بناء نظريات منسقة، ولدينا من التجارب العملية عند
الشعراء المعاصرين ما نستطيع الإرتكان إليه، (فالصنعة) على النحو الذي يفسره بها
بعض من كتبوا في الموضوع، تكاد تلغي حالات شعورية كثيرة. وإغفال هذه الحالات لا
يكون إلا مجرد انسياق وراء رأي مفتعل لا يتفق مع حقائق التجارب العملية.
ثم ان الايقاع
الموسيقي الذي يتألف جانبه الظاهري من الوزن الخاص – وهو البحر – وجانبه الباطني
من جرس الألفاظ، ومن الايقاع الناشئ من تواليها على نحو معين، يستقي في حالات
كثيرة من وراء الوعي، فكثيراً ما يجد الشاعر نفسه ينظم من بحر معين، وينسق ألفاظه
في تعبير معين، دون وعي كامل، لان هذا كله يتسق مع الحالة الشعورية للقصيدة.
وهذا يجعلنا نعيد
تقديرنا على اساس جديد لقيمة الايقاع الموسيقى في الشعر. بوصفه جزءا من العمل
الفني يصور أجمل جانب فيه وأصدقه. وهو تصوير الجو الشعوري الذي عاشه الشاعر حين
كان ينظم قصيدته، ونقل القارئ او المستمع الى هذا الجو بعد انقضائه بعشرات السنين
او بآلافها.
ولا شك ان هذه
النظرة الى الايقاع الموسيقي تختلف عن نظرة المدرسة العقلية في الشعر العربي، كما
تختلف عن نظرة المدرسة الاسلوبية على السواء. فالمدرسة العقلية اصغرت من قيمة
الايقاع الموسيقي جملة، في سبيل تحقيق المعاني ودقة الأداء. والمدرسة الاسلوبية
عنيت بحلاوة الإيقاع وسهولته وفحولته، دون ان تلقي بالها الى التناسق بين لون
الايقاع والجو الشعوري العالم للقصيدة. وهو الجو الذي نحدس انه كان يحيط بنفس
الشاعر وهو ينظمها، والذي صاحب الانفعالات التي دفعته الى النظم للتعبير عنها.
ثم إن لما وراء
الوعي دخلا كذلك في اختيار الألفاظ، فكثيرا ما يجد الشاعر الملهم كلمات وعبارات
تقفز الى منطقة الوعي في نفسه من حيث لا يدري. وقد لا يكون واعيا لمعانيها بدقة
وهو ينظمها. وقد يعجب بعد انتهائه من النظم وعودته الى الحالة الشعورية العادية
كيف انثالت هذه الألفاظ والعبارات عليه إنثيالا – كما يقول الجاحظ بحق – ثم يدرك
ان لهذه الألفاظ او لهذه العبارات ظلالا في نفسه، تتسق مع الجور الشعوري الذي نظم
فيه قصيدته، سواء كان هذا الجو من صنع مؤثر خارج عن إرادته، او سبب استحضاره له.
وحقيقة ان للوعي في الاخير نصيبا او في، ولكن الوعي قد يقف عمله نهائيا عند
استحضار الجو وتخيل المؤثر. لأن نفس الشاعر سريعة التأثر والتخيل. حتى لتنقلب
المؤثرات الصناعية فيها الى مؤثرات حقيقية في كثير من الاحيان، وبذلك يتحقق الصدق
الفني، ولو لم يتحقق الصدق الواقعي.
وهذا يفسر لنا عمل
الشاعر في الملحمة والمسرحية والقصة، فهو استحضار للمؤثر وتخيل للجو، ينقلبان – في
حسه –الى مؤثر حقيقي لا إرادة له في دفعه!
وهذه الظلال
المصاحبة للألفاظ والتعبيرات كامنة فيما وراء الوعي لملابسات خاصة بالشاعر او خاصة
بهذه الألفاظ والعبارات ذاتها. فللألفاظ أرواح، ولكل لفظة تاريخ، وليست الألفاظ
الا رموزا لملابسات شتى متشابكة فيما وراء الوعي، وقد يختلف هذا بين شاعر واخر
ولكن تبقى اللفظة رمزا على الظلال والمعاني التي حملتها في تاريخها الطويل والشاعر
الملهم هو الذي يستوحي الألفاظ رموزها العميقة، ويستدعيها في اللحظة المناسبة. وان
يكن هذا العمل يتم غالبا في غيبة عن الوعي عند الشعراء الملهمين.
وهذه الحقيقة
تعجلنا نعيد تقديرنا على اساس جديد لقيمة الألفاظ والعبارات، فنرد إليها اعتبارها
الذي أهدرته المدرسة العقلية والمدرسة الأسلوبية على السواء.
فالأولى كان
رائدها دقة الأداء المعني دون نظر الى الظلال التي تلقيها الألفاظ بجرسها او
بتاريخ في عالم اللغة وعالم الاحساس، مما يفسد الجو الشعري الذي تعيش فيه القصيدة
في بعض الاحيان، ويحدث نوعا من (النشاز) الموسيقي او التصويري في السياق. والمدرسة
الثانية كان همها عذوبة اللفظ وجزالة العبارة بدون نظر الى هذه الملبسات التي
تختلف في قصيدة عن قصيدة، وفي حالة شعورية عن حالة ..).
وهكذا نجد من
استعراض هذه النماذج ان (المنهج النفسي) نما نمواً ظاهرا في النقد المعاصر. ولكننا
نلاحظ ان هناك تعويضا ورد فعل بينه وبين النقد القديم. فقد اتجه بقوة الى الطائف
الثانية من الاسئلة التي يثيرها المنهج النفسي. نعني عناية فائقة بالربط بين
الاديب وادبه، وبيان أثر العوامل النفسية للأديب في انتاجه ودلالة هذا الانتاج على
نفسيته ومزاجه، بينما أهمل او كاد الطائفتين الأولى والثانية اللتين عنى بهما
النقد القديم، وفيما عدا النموذج الاخير من هذه النماذج الستة، لا نجد عناية
بتحليل نشأة العمل الأدبي، والعلاقة بين الشعور والتعبير وطريقة ظهور العمل في
الوجود. وهذا الجانب قليل الى اليوم في مباحثنا النقدية، ولذلك عنينا في الفصول
الأولى من هذا الكتاب به، وهو ينال عناية كبرى من مدرسة التحليل النفسي بصفة خاصة.
والآن لعلنا
أوضحنا هذا المنهج بما ضربنا عليه من أمثلة، وبما عرضناه من نماذج في النقد القديم
والنقد الحديث.
_________________
(1)
مقال عن (التحليل
النفسي والفنان) بقلم مصطفى اسماعيل سويف ص282 بالجزء الثاني من المجلد الثاني من
مجلة علم النفس.
(2)
الأمراض العصابية
هي التي تنشأ عن اختلال وظيفة الاعصاب بدون ان يظهر مرض عضوي في الاعصاب ذاتها.
(3)
، (4) المصدر
السابق.
(5)
المصدر السابق.
(6)
المصدر السابق.
(7)
المصدر نفسه.
(8)
المصدر نفسه.
(9)
مستقى من المصدر نفسه.
(10)
المصدر السابق.
(11)
راجع (بعض التيارات التي اثرت في دراسة الأدب) بحيث مستخرج من كلية الآداب بجامعة
الاسكندرية المجلد الأول سنة 1943 للدكتور محمد خلف الله.
(12)
المصدر السابق لخلف الله.
(13)
المصدر نفسه.
(14)
لعل هذا ادخل في المنهجين: الفن التاريخي. فبشار لم يكن يعني هنا الا طرازا
تعبيريا خاصا، لا طرازا مزاجيا (وحقيقة ان هناك صلة بين المزاج والتعبير ولكن هذه
الصلة موجودة في كل ما يختص بعمل ادبي على المعنى الواسع للصلات النفسية الادبية،
غير ان السمة التعبيرية هنا واضحة، مما يجعل المسألة مسألة تعبيرية. أو أقرب ما
تكون الى هذا الوصف.
(15)
في هذا ما يخالف (المنهج التاريخي) ويبطل قاعدة اساسية من قواعد (المؤلف).
(16)
سبق ان أبدينا رأينا في إغفال عبد القاهر لقيمة الايقاع الموسيقي في العبارة وهو
جزء لا يتجزأ من دلالتها النفسية وجمالها الفني .. (المؤلف).
(17)
في هذه لمحة (جمالية) ترى سمات الجمال الموحد في مظاهر مختلفة من المشاهد ..
(المؤلف).
(19)
هذا فهم صحيح للشعر يقابل الفهم الشكلي لقدامة!
(20)
راجع تعليل الدكتور طه حسين لاستطراد ابن الرومي في كتاب (من حديث الشعر والنثر).
 الاكثر قراءة في النقد الحديث
الاكثر قراءة في النقد الحديث
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












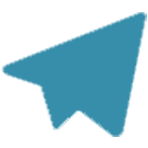
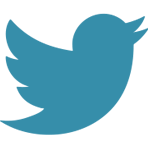

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)