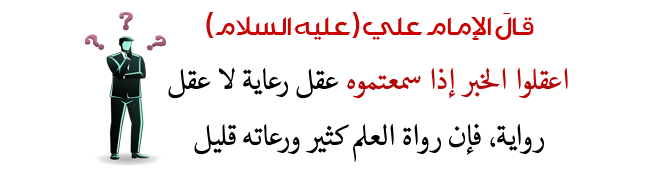
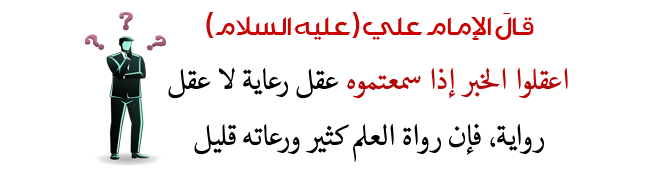

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
التاريخ: 1-8-2016
التاريخ: 23-8-2016
التاريخ: 1-8-2016
|
فهنا نذكر حكمه بحسب العقل والنقل بجميع أقسامه، فإنّ الكلام في كلّ الأقسام من الإيجابي والتحريمي، والإيجابي مع التحريمي بحسب ملاك حكم العقل أو النقل واحد، فلا داعي إلى تشقيق الكلام على حسب الأقسام وجعل الكلام في كلّ قسم في باب على حده.
نعم لا بدّ من التفرقة بين هذه الصور مع إمكان الاحتياط ولا معه لاختلاف حكم العقل فيهما فلا بدّ من جعل الباب المستقلّ للثاني، ومن قبيله دوران أمر الشيء الواحد بين الوجوب والحرمة، وهذا التشقيق موافق مع التقسيم الذي ذكرناه في أوّل مبحث القطع فلاحظ.
وكيف كان، فالشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف وإمكان الاحتياط له صور.
الاولى: أن يعلم جنس الإلزام ويعلم نوعه وأنّه الوجوب، وشكّ في تعلّقه بهذا الموضوع أو بذاك كما لو يعلم أنّ الواجب هو الظهر أو الجمعة.
والثانية: هذا مع العلم بكونه الحرمة وتردّد متعلّقه بين الموضوعين، كما لو لم يعلم أنّ هذا حرام أو ذاك.
والثالثة: أن يعلم أصل الإلزام وشكّ في نوعه وفي متعلّقه أيضا، كما لو علم أنّ هذا واجب أو ذاك حرام، ثمّ الكلام فيها مع قطع النظر عن القانون الذي أعطاه الأخبار العلاجيّة لتعارض الخبرين في أنّ مقتضى الأصل الأوّلي بحسب العقل والنقل ما ذا.
وحينئذ فنقول: لا إشكال أنّه بعد العلم بأصل الإلزام كما هو المفروض في هذه الصور لا فرق لدى العقل بين المخالفة التفصيليّة والإجماليّة في الحكم بالقبح، فكما أنّه لو علم أنّ المولى عطشان مشرف بالموت من شدّة العطش وأنّ هذا الإناء المعيّن يرفع عطشه، فترك إعطائه هذا المعيّن، فعل قبيحا، كذلك لو علم عطشه، وعلم أنّ هذا الإناء أو ذاك الإناء يرفع عطشه، فترك إعطاء الجميع وترك المولى على حالة العطش كان كالأوّل بلا فرق.
ثمّ إذا ثبت حكم العقل بقبح المخالفة يثبت وجوب الموافقة القطعيّة أيضا، ولا يعقل التفكيك بينهما؛ إذ لا يخلو الحال من قسمين، إمّا أن يكون هذا العلم الذي تعلّق بالإلزام حجّة على هذا الإلزام، وإمّا لا يكون حجّة، فإن كان حجّة فكما يحرم المخالفة القطعيّة بسببه، يجب الموافقة القطعيّة أيضا بسببه، وإن لم يكن حجّة فلا يثبت شيء من الأمرين، فإنّ التفكيك في الحجيّة لا يتصوّر عقلا فيصير الحاصل أنّ الواقع المعلوم قد قام عليه الحجّة، فيحرم مخالفته القطعيّة ويجب موافقته القطعيّة، وهي موقوفة على الاحتياط بإتيان جميع الأطراف، فيكون مقتضى القاعدة الأوّليّة العقليّة وجوب الاحتياط وعدم البراءة، من غير فرق بين صورة العلم بنوع التكليف والشكّ فيه.
[ما يستفاد من النقل مثل حديث الرفع وغيره]
هذا هو تمام الكلام في مقتضى الحكم العقلى، فيقع حينئذ الكلام في ما يستفاد من النقل مثل حديث الرفع وغيره.
فنقول أوّلا: يمكن ورود الترخيص في بعض أطراف هذه الشبهة (1)، وبه يرتفع موضوع حكم العقل؛ فإنّ العقل لا يحكم بالاشتغال ووجوب الاحتياط بإتيان جميع الأطراف إلّا لأجل الخوف وعدم الأمن بدونه من العقاب والأمن معه منه، فموضوع حكمه إنّما هو الخوف وعدم الأمن، فإذا ورد التأمين من الشارع فلا يبقى للعقل حكم بالاحتياط؛ إذ لا يعقل زيادة الفرع على الأصل، والترخيص في بعض الأطراف أيضا تأمين، بمعنى أنّه لو كان في الواقع التكليف في هذا البعض لما كان للمولى المؤاخذة عليه، لمنافاة ذلك مع ترخيصه، فمجيء الترخيص علّة لرفع الخوف الذي هو موضوع حكم العقل وجدانا، فله الورود على حكم العقل، فإذا تقرّر إمكان ورود الترخيص الشرعي على إتيان البعض وترك البعض يقع الكلام ثانيا في وقوعه وعدم وقوعه واستفادة ذلك من الأدلّة أعني أخبار البراءة الشرعيّة وعدم الاستفادة.
فربّما يقال: حيث جعل حكم الرفع والإطلاق والسعة معلّقا ومغيّا في هذه الأخبار على حصول العلم، وهو بحسب اللفظ أعمّ من التفصيلي والإجمالي، وتخصيصه بالأوّل من غير مخصّص لا وجه له، فلا عموم لها للمقام، فإنّ الشك وإن كان حاصلا وغير مناف مع العلم الإجمالي فكلّ من الأطراف بخصوصه مشكوك كونه موردا للتكليف والالزام، لكنّ الفرض مقارنة هذا الشكّ مع العلم بأصل الإلزام، فهنا علم بالإلزام وجهل بمورده، فقد حصل الموضوع وهو الشكّ مع غاية الحكم، فلا محالة لا يشمل الحكم للمقام.
وفيه أنّ ظاهر «رفع ما لا يعلمون» والحليّة حتى يعلم الحرمة، والسعة ما لا يعلم ثبوت الحكم، ما دام المشكوك مشكوكا وكون الغاية زوال الشكّ بالمرّة وتبدّله بالعلم، لا مجرّد ثبوت العلم مع ارتباط له بالشكّ، وبعبارة اخرى: المستفاد من الأخبار أنّ المشكوك محكوم بالحليّة حتى يصير معلوما، لا أنّ المشكوك محكوم بالحليّة حتّى يحصل علم مرتبط به ولو مع بقاء حالة الشكّ.
وربّما يقال أيضا: سلّمنا عموم الأخبار للشكّ المقرون بالعلم الإجمالي لعدم حصول الغاية فيه، ولكن مقتضى الأخبار كما أنّ كون المكلّف في سعة المشكوك، كونه أيضا في غير سعة من المعلوم، وفي هذه الصور كما أنّ لنا مشكوكا، لنا معلوم، فالأوّل بمقتضى صدر هذه الأخبار محكوم بالإطلاق، والثاني بمقتضى ذيلها بعدمه، ولا شكّ في أنّ المعلوم الموجود هنا المحكوم عليه بعدم الإطلاق ليس إلّا في ضمن المشكوك المحكوم عليه بالسعة.
مثلا الإناءان اللّذان علم بوجود الخمر فيهما كلّ منهما باعتبار الخصوصيّة مشكوك الحرمة، فيندرج تحت حكم الإطلاق، وأصل الخمر معلوم الوجود في البين محكوم بعدم الإطلاق، وهو ليس إلّا في ضمن الإنائين، فيلزم محكوميتهما بعدم الإطلاق من هذه الجهة، وقد فرض كونهما محكومين بالإطلاق باعتبار أنفسهما، فيتحقّق التعارض بين صدر الرواية وذيلها، فتسقط بذلك عن الحجيّة.
والفرق بين هذا وسابقه أنّ مبنى الأول منع عموم الأخبار للمقام، والثاني تسليم عمومها مع السقوط عن الحجيّة، لتعارض الصدر مع الذيل، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى حكم العقل من الاشتغال ووجوب الاحتياط.
وهذا الوجه الثاني أعني التعارض بين الصدر والذيل من الرواية مبنيّ على القول في الأحكام الواقعيّة بثبوت المراتب من الإنشائي والفعلي وأنّ المرتبة الإنشائيّة لا يكون العلم بها موردا لحكم العقل بوجوب الامتثال ما لم يضمّ من الشرع جعل للمرتبة الفعليّة كما ذهب إليه الاستاد الخراساني طاب ثراه؛ إذ حينئذ يكون الحكم في تلك الأخبار بأنّ المشكوك إذا صار معلوم الحرمة يصير حراما بمنزلة جعل الفعليّة للحكم التحريمي الذي تعلّق به العلم، فيكون العلم حينئذ موضوعا للحكم الشرعي، غاية الأمر بمرتبته الفعليّة دون الشأنيّة الإنشائيّة.
فيكون مفاد الأخبار قضيّتين شرعيتين، الاولى: أنّ المشكوك ما دام مشكوكا محكوم ظاهرا بالحليّة، والاخرى: أنّ الحرام الواقعي إذا تعلق به العلم صار حراما فعليّا، فيكون من الأثر الشرعي للعلم الحرمة الفعليّة بوصف الفعليّة، كما يكون من الأثر الشرعي للشكّ الحليّة الفعليّة، فبعد تحقّق العلم يكون موضوع حكم العقل متحقّقا بكلا جزئيه، فإنّ أحدهما العلم، وقد حصل وجدانا، والأخر فعليّة الحكم وقد حصلت بحكم هذه الأخبار أيضا، فيكون التنجيز الذي هو حكم العقل حاصلا.
وبالجملة، يقع التعارض في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف بين هاتين القضيّتين من حكم الرخصة المجعولة في مورد الشكّ ومن حكم عدم الرخصة المجعول في موضوع العلم، لأنّ المفروض تحقّق الشكّ والعلم معا، وكون متعلّق الثاني محصورا في متعلّق الأوّل، فيلزم كون الشيء الواحد وهو كلّ واحد من الأطراف محكوما بالرخصة فعلا وبعدمها كذلك بالاعتبارين، وهذا معنى التعارض.
و أمّا على القول بأنّ الأحكام الواقعيّة بعد جعل نفسها، فلا يتصوّر فيها سوى المرتبة الواحدة وهي الفعليّة، ولا يتصوّر لها مرتبتان انفكّتا في الجعل وكان كلّ منهما محتاجا إلى جعل مستقلّ، بل هي بعد الجعل أبدا فعليّة- كما هو المختار ويأتي في محلّه تحقيقه إن شاء اللّه تعالى- فلا تعارض بين الصدر والذيل لهذه الروايات أصلا، وذلك لأنّ الحكم في ذيلها بعدم الرخصة والسعة في صورة العلم بالتكليف ليس حكما تعبديّا شرعيّا مثل ما اشتمله الصدر من حكم الشكّ، بل إنّما هو تقرير لحكم العقل، وذلك لأنّ الفرض تماميّة الحكم الواقعي من حيث الجعل ومن ناحية المولى، والنقص لو كان إنّما هو من قبل عدم علم المكلّف به، فإذا حصل له العلم تمّ بسببه موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة، فوجوب اجتناب معلوم الحرمة ليس إلّا حكما استقلّ به العقل سواء كان إجماليّا أم تفصيليّا، وليس مع ذلك قابلا للحكم المولوي الشرعي كما تقدّم تفصيله في محلّه، فوجود هذا الحكم في تلك الأخبار مثل عدمه، فلا بدّ أن نفرض الكلام في ما لو لم يكن في الأخبار ذكر لحكم صورة العلم، بل كان المذكور فيها حكم الشكّ فقط.
فحينئذ نقول قوله: كلّ مشكوك مرخّص فيه، يشمل بعمومه أطراف العلم الإجمالي؛ لصدق المشكوك على كلّ منها، فيكون المكلّف مرخّصا في مخالفتها بحكم هذا الإذن الشرعي، وليس هذا معارضا مع الحكم العقلي الذي تقدّم من عدم تجويز العقل للاقتحام في شيء من الأطراف وإيجابه الموافقة القطعيّة، وذلك لسبق وجود الحكم الشرعي على العقلي رتبة، فإنّ موضوع حكم العقل إنّما هو تماميّة أسباب صحّة عقوبة المولى في هذا لو كان الحرام أو الواجب فيه، وفي ذاك كذلك، فيجب إخراج النفس عن هذه العقوبة.
وبعبارة اخرى: موضوع إلزام العقل فعل هذا المعيّن أو تركه إنّما هو الخوف من الوقوع في العقوبة بسبب المخالفة، فإذا ورد الترخيص من الشرع في هذا المعيّن بطل هذا الإلزام ببطلان موضوعه؛ إذ لم يبق مع هذا الترخيص خوف من العقوبة؛ إذ لا حقّ للمولى معه أن يعاقب العبد على تقدير مخالفته الواقع في ضمن هذا المعيّن، فالترخيص بمنزلة تأمين من الشرع، بل هو هو حقيقة؛ إذ معناه أنّه لا بأس بارتكابه وإن كان مصادفا مع الحرام الواقعي أو الواجب الواقعي، وبالجملة، بعد وجود هذا الحكم الترخيصي من الشرع لا مجال لحكم العقل بالاحتياط أصلا حتّى يفرض التعارض بينهما.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ حكم الشكّ المذكور في الروايات يشمل عمومه أطراف العلم الإجمالي، ولا قصور في عمومها أصلا، ولا معارض لهذا العموم بالنسبة إلى الأطراف أيضا في حدّ ذاتها لا من حكم الشرع ولا من العقل، فيقع الكلام حينئذ في كيفيّة شمول هذا العموم للأطراف، بمعنى أنّه يشمل جميعها أو البعض المعيّن أو بعضا لا بعينه.
[كيفية شمول حديث الرفع لاطراف العلم الاجمالى]
تفصيل الكلام أنّ شموله للجميع غير ممكن؛ إذ يلزم من دخول تمام الأطراف تحت هذا العموم ومحكوميّة الجميع بالرخصة محذور عقلي، وهو ترخيص الشارع الحكيم في الأمر القبيح وهو المخالفة القطعيّة للتكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال؛ إذ بعض من الأشياء غير قابل للترخيص الشرعي عقلا مثل الظلم، فلا يصدر من الحكيم الترخيص فيه أبدا، ومخالفة التكليف المعلوم تفصيلا أو إجمالا أيضا من أفراد الظلم، بل وأبدهها، فكيف يجوز للحكيم أن يرخّص فيه، وإذن فيجب تخصيص هذه القاعدة الشرعيّة أعني: كلّ مشكوك مرخّص فيه، بالنسبة إلى جميع الأطراف بحكم العقل.
وأمّا شمولها للبعض فإن كان بعضا معيّنا بأن يحكم أنّ هذا المعيّن داخل تحت العموم دون ذلك، فهذا يحتاج إلى معيّن كان في الأوّل دون الثاني، وهو مفقود؛ إذ المفروض أنّه لم يعتبر في موضوع القاعدة سوى الشكّ، والطرفان سيّان من هذه الجهة.
وبالجملة، ظهور العموم بالنسبة إلى كلّ منهما في عرض واحد وعلى حدّ سواء، فشموله لهذا دون ذاك ترجيح بلا مرجّح، بمعنى أنّ إعمالنا أصالة العموم في هذا المعيّن دون ذاك ترجيح بلا مرجّح في عملنا لا أنّه ليس للشارع ذلك ولو بأن يصرّح بالرخصة في معيّن منهما دون الآخر، فإنّه بمكان من الإمكان، غاية الأمر عدم علمنا حينئذ بالملاك الذي صار مرجّحا بنظره.
وإن كان بعض لا بعينه فلتقريب الدلالة فيه ثلاثة وجوه:
الأوّل:
أن يقال: إنّه بعد العلم بعدم إمكان دخول الجمع تحت العموم لما ذكر من المحذور العقلي يدور الأمر بين إلغاء الحكم بالنسبة إلى أحدهما أيضا، وبين حفظ الحكم بالنسبة إلى أحدهما حتّى يكون الخارج هو الجمع بوصف الجمعيّة، فمقتضى حفظ العموم والعمل بأصالته مهما أمكن هو اختيار الثاني؛ إذ هو حفظ للعموم بالنسبة إلى أحدهما، والأوّل طرح له بالنسبة إليه أيضا، فالثاني هو المتعيّن وهذا الوجه كما ترى متوقّف على كون إعمال الحكم في أحدهما عملا بالعموم وحفظا لظهوره.
وأمّا إن كان وجوده وعدمه على السواء بالنسبة إلى العموم، ولم يكن الأوّل حفظا، ولا الثاني تخصيصا زائدا فلا شبهة في عدم إمكان إثباته بأصالة العموم؛ إذ هو فرع دخول مجراه تحت العموم وكونه من مصاديقه، والحقّ عدم كون أحدهما من مصاديق العام، فإنّ العام إنّما يكون مرآتا للمصاديق المعيّنة القابلة للإشارة الخارجيّة مثل هذا وهذا، والمفروض ورود التخصيص بالنسبة إلى هذا المعنى التعييني القابل للإشارة الحسيّة؛ إذ الفرض أنّه لم يمكن إدخال هذا المعين ولا إدخال ذاك، للزوم الترجيح بلا مرجّح.
وبعد ورود التخصيص بالنسبة إلى كلّ من المعنيين فلا يمكن القول حينئذ بأنّ كلّا منهما بحسب التحليل العقلي ينحلّ إلى تعيين والأحد المعرّى عن التعيين، فمقتضى المحذور المذكور ليس بأزيد من رفع اليد عن التعيين، فيكون الأحد الذي في ضمنه باقيا بحاله تحت العموم، وذلك لأنّ هذا الأحد لم يكن له وجود مستقلّ، بل هو تبع للتعيين ومندكّ فيه، كيف وإلّا لزم أن يكون كلّ فرد فردين، فإذا فرض رفع اليد عن التعيين فليس للأحد وجود بعد ارتفاعه.
وبالجملة، فإدخال الأحد ليس عملا بأصالة العموم؛ إذ الداخل تحت العموم لم يكن إلّا المعيّن، والأحد أيضا وإن كان داخلا بدخوله، لكن على نحو التبعيّة، وما نحتاج إليه لإجراء أصالة العموم هو الدخول المستقلّ كما هو واضح.
لا يقال: نحن نمثّل مثالا له واقع وفيه لا محيص عن إجراء العموم في أحدهما بعد عدم إمكان التعيين وهو قوله تعالى: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ» فإنّه عام وقد خرج منه الجمع بين الاختين، ومع ذلك نقول بجواز نكاح أحدهما، وليس ذلك إلّا لأنّه بعد ما رفع اليد عن العام الأوّل بالنسبة إلى كلتا الأختين وعلم بعدم دخول جميعهما تحته وعدم إمكان كلّ بعينها للزوم الترجيح بلا مرجّح يدور الأمر بين العمل بالعموم في الواحدة لا بعينها وبين طرحه بالنسبة إليها أيضا، فقضيّة أصالة العموم يعيّن الأوّل.
فعلم أنّه يصحّ إجراء أصالة العموم في الأحد لا بعينه بعد عدم إمكانها في كلّ من الخصوصيّات المعيّنة، وإذا صحّ تعيّن في المقام أيضا؛ لأنّه أيضا مثل الآية، غاية الأمر أنّ المخصّص في الآية لفظي وفي المقام عقلي، ولا يوجب هذا فرقا كما هو واضح، فيكون المرخّص فيه هو الأحد لا بعينه، واختيار تعيينه موكول إلى المكلّف.
لأنّا نقول: إجراء حكم جواز النكاح في إحدى الاختين لا بعينها بعد رفعه عن المجموع ليس بواسطة عموم العام المذكور، بل إنّما عليه دليل مستقلّ وهو نفس الدليل اللفظي الذي تصدّى لحرمة الجمع بين الأختين، فإنّه بمدلوله اللفظي المفهومي يدلّ على جواز نكاح الأحد، حيث إنّه في مقام الحصر لمحرّمات النكاح من النساء، كما يظهر من ملاحظة الآية الدالّة على ذلك، حيث إنّ فيها حصر محرّمات التزويج في الأفراد التي عدّ فيها التي من جملتها الجمع بين الاختين، وهذا بخلاف المقام، فإنّ المخصّص هنا لبيّ وهو حكم العقل بقبح الترخيص في كلا المشتبهين وعدم إمكان الترجيح بلا مرجّح من دون تعرّض فيه لجواز الترخيص في الأحد لا بعينه، فينحصر الأمر فيه في التمسّك بأصالة العموم وإدراج الأحد لا بعينه في العموم، وقد عرفت أنّه فرع دخوله في العموم ومصداقيّته له، والحال أنّه لم يكن قطّ كذلك، فعلم أنّ قياس المقام بالمثال المذكور مع الفارق.
والحاصل أنّ المخصّص كلّما كان لفظيّا ومتعرّضا لحال الأحد وبقاء حكم العام فيه كان هو الدليل عليه دون عموم العام وإن كان لبيّا، فلا يمكن التمسّك لثبوت الحكم فيه بالعام، والمفروض عدم دليل آخر، فتحصّل أنّ الظهور اللفظي قاصر عن إثبات هذا المقصد.
وحاصل تقريب هذا الوجه (2) أنّ حفظ ظهور العموم في هذا متعيّنا أو في ذاك كذلك ترجيح بلا مرجّح، وفي كليهما ترخيص في المعصية، وبعد رفع اليد عن المتعيّنين لنا أن نحفظ العموم في الأحد التخييرى.
فلا يقال هنا بمثل ما سنورد على الوجه الثالث الذي هو التمسّك بالإطلاق من دوران الأمر بين التخصيص والتقييد، فلا يقال هنا أيضا يدور الأمر بين ارتكاب أحد المخالفتين للظاهر إمّا الالتزام بالتخصيص، وإمّا رفع اليد عن ظهور الترخيص في المعيّن.
فإنّا نقول: ما ندّعيه في المقام هو أنّ ذلك حفظ مرتبة من ظهور العموم، فلو أمكن حفظ الظهور في التعيينيّة وجب حفظ العموم بالمرتبة الأقوى، وحيث تعذّر ذلك كان الواجب حفظه بالمرتبة الأضعف، فلا نرفع اليد عن تمام الظهور بمحض تعذّر حفظ مرتبة منه، وبالجملة، ليس ظهور الترخيص في المعيّن إلّا ظهور العموم في المعيّنات، فإن كان حفظ الأحد التخييري حفظا لمرتبة من العموم فرفع اليد عنه تخصيص زائد بغير جهة، وإن لم يكن في العموم من الأحد التخييري عين ولا أثر وكان مفاده المعيّنات ليس إلّا فرفع اليد عن الأحد التخييري لا يكون زيادة تخصيص، ولا حفظه حفظ مرتبة من العموم، بل هو شيء مسكوت عنه في القضيّة اللفظيّة بالمرّة، فعلى كلّ حال لا شباهة لمقامنا بذلك المقام.
ثمّ الدليل على ما ادّعينا- من كون مدلول العموم أمرين التعيينية والأحد المعرّى- ملاحظة نظائر المقام، ألا ترى أنّ عموم «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» إذا خصّص بآية {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } [النساء: 23] فلا يتأمّل الإنسان في بقاء إحداهما تحت العموم مع أنّ لسانه أيضا هو الأفراد المتعيّنات من النساء، ولا نحتاج في ذلك إلى التماس دليل آخر من إجماع ونحوه.
وكذلك لو ورد خطاب «أنقذ الغريق» وعجز العبد عن إنقاذ فردين بوصف الاجتماع فهل ترى الوجدان متأمّلا في شمول القضيّة المذكورة للأحد التخييري المقدور؟ وبعد مسلميّة هذا الارتكاز في هذين المثالين وأمثالهما نقول بمثله في المقام.
وإن شئت فقل: نستكشف من هذا الارتكاز أحد أمرين، إمّا أولويّة التقييد على التخصيص كما هو الوجه الثالث وعدم ورود ما سنورد عليه، وإمّا كون الأحد التخييري داخلا في مفاد العام كما هو هذا الوجه، فيدلّ على صحّة أحد الوجهين،(3) وهذا المقدار يكفينا أيضا، هذا.
ولكن يمكن الفرق بين مقامنا وتلك الأمثلة، وبيانه أنّه كلّما كان في البين عام أو مطلق شامل بعمومه أو إطلاقه للأفراد التعيينيّة ثمّ ورد مخصّص أو مقيّد لفظي أو عقلي علم تعلّقه بعنوان الجمع كان الارتكاز المذكور فيه موجودا، وحينئذ فلعلّ السرّ في ذلك أنّ التخيير مستفاد من وجود المقتضي في كلّ فرد فرد المحرز من إطلاق المادّة في القضيّة، ومن انحصار المانع عن جريان هذا المقتضي في عنوان الجمع، فإنّ لازم ذلك تأثير المقتضي في صورة الانفراد، لخلوّه عن المانع.
وبالجملة، قد استفيد التخيير من العقل بعد إحراز مقدّمتين من اللفظ، إحداهما:
وجود الاقتضاء المستفاد من إطلاق مادّة العام، والثانية: انحصار المانع في عنوان الجمع المستفاد من المخصّص، وبعد ذلك فالحاكم بالتخيير هو العقل دون أن يكون مستندا إلى اللفظ، ويكون من باب حفظ ظهوره بمرتبة بعد عدم التمكّن من حفظه بالمرتبة العليا، أو من باب ترجيح التقييد على التخصيص.
وحينئذ فنقول: بعد اشتراك مقامنا مع المثالين في أنّ في الجميع لفظ العام متعرّض للمتعيّنات وموجب بحكم إطلاق المادّة لكون مقتضى الحكم موجودا في كلّ واحد واحد من المتعيّنات يفترقان عن مقامنا بأنّ الخارج في المثال الأوّل عنوان الجمع بدلالة لفظ المخصّص، وفي الثاني أيضا هو الجمع، لأنّ المخصّص حكم العقل بقبح التكليف مع العجز، وليس وراء ذلك مانع، والعجز إنّما هو في الجمع، فاللازم كما ذكرنا أن يؤثّر المقتضى في كليهما أثره في أحدهما المخيّر.
وأمّا في مقامنا فليس المخصّص لفظيّا حتّى ننظر إلى العنوان المأخوذ فيه أنّه خصوص الجمع أو غيره، بل المخصّص العقل، وله أيضا حكمان، أحدهما بتّي تنجيزيّ وهو حرمة المخالفة القطعيّة وعدم إمكان شمول العام المرخّص لها، والآخر تعليقي وهو وجوب الموافقة القطعيّة لو لم يكن مزاحمة بالغرض الأهمّ، والّا جاز الترخيص في تركها رعاية للمزاحم الأهمّ.
وإذن فالعقل في حال الانفراد غير جازم بعدم المانع عن المقتضي الذي استفيد من عموم الترخيص؛ إذ يحتمل أن يكون المقتضي للموافقة القطعيّة الذي هو العلم الإجمالي أقوى وأهمّ بالرعاية في نظر الشارع من اقتضاء الشك للترخيص.
نعم لو احرز غلبة مقتضى الترخيص على مقتضى العدم كان مستقلّا بالتخيير، لكن هذا شيء لا يستفاد من إطلاق المادّة، إذ غاية ما يستفاد منها أن لا دخل في حصول الغرض الباعث على الحكم لشيء آخر غير ما ذكر في اللفظ، وأمّا الموازنة بين هذا الغرض وأغراضه الآخر الباعثة على أحكام أخر عند التزاحم فليست على عهدة إطلاق المادّة ولا يستفاد منه أنّ أيّا منهما أقوى، وبالجملة، فمع الاحتمال المذكور كيف يجزم العقل في المقام بالتخيير كما في المثالين.
والحاصل قد نقول: إنّ حفظ الهيئة في كلّ من التعيينين ممكن، غاية الأمر مع التزام التقييد، أو أنّ رفع اليد عن خصوص التعيين لا يوجب رفعها عن الأحد المخيّر، وحينئذ كان التخيير بدلالة اللفظ، ولا محالة نستكشف منه أقوائيّة ملاك الترخيص على ملاك الموافقة القطعيّة، لكنّ المفروض أنّا أنكرنا ذلك وقلنا بعدم إمكان حفظ ظهور الهيئة في المتعيّنين، لمعارضة أصالة العموم بأصالة الإطلاق كما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، وبعد عدم حفظ التعيين ليس الأحد المردّد فردا ثالثا للعام.
وإذن فالحكم الفعلي والترخيص الفعلي من الشارع في الأحد التخييري غير موجود حتّى نستكشف الغلبة منه، وبالجملة، الذي نستكشف منه الغلبة هو الهيئة، وقد فرضنا سقوطها بواسطة عدم إمكان حفظها في المعيّنين.
نعم الذي يمكن دعواه أن يقال: لا نسلّم سقوطها رأسا بمجرّد عدم حفظها في المعيّنين، بل الأحد المردّد أيضا فرد، وأمّا مع تسليم أنّ الهيئة إمّا تجري في المعيّنين، وإمّا تسقط رأسا فلا محيص عمّا ذكرنا؛ إذ المادّة ليست إلّا دالّة على مجرّد الاقتضاء، والهيئة الدالّة على الغلبة بالفرض ساقطة عن شمول المقام؛ لأنّ حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة مانع عن شمولها لكلا المعيّنين، والحكم الفعلي غير قابل للتبعيض حتى يقال بعدم وجوده بمقدار الحكم البتّي للعقل ووجوده بمقدار حكمه التعليقي حتى يقال باستكشاف الغلبة منه، فإنّ الترخيص الفعلي متعلقا بكلا المتعيّنين إمّا موجود وإمّا لا، ولا معنى لكونه موجودا من جهة وغير موجود من جهة.
وبعبارة اخرى: الظهور الهيئي لو اجري محالا أصله الجهتي كان كاشفا عن أمرين، أحدهما جواز المخالفة الاحتماليّة، والآخر جواز المخالفة القطعيّة، ولكن إذا فرضنا عدم إجرائه لعدم إمكان ترخيص المخالفة القطعيّة، فلا كاشف في البين، فإنّ هذا استكشاف عقلي من جريان الأصل اللفظي، وليس من المدلول اللفظي حتّى يمكن التفكيك في أصله الجهتي بين الأمرين، فإنّ مدلول الهيئة هو الترخيص في هذا وفي هذا، فإن لم يمكن التفكيك في هذا المدلول بطرحه من جهة التعيين وأخذه من جهة الأحد المردّد فلا بدّ من رفع اليد عنه في كلا الموردين رأسا، وبعد ذلك فلا معنى للأخذ بإحدى الحكايتين الثابتتين للترخيص، ولا للقول بأخذ الجامع بين الترخيصين، إذا الحكاية فرع وجود الحاكي، وأخذ الجامع فرع وجود الفرد، والمفروض عدم إمكان أصل الترخيصين، فمن أين تحصل الحكاية، ومن أين ينتزع الجامع؟
ثمّ ممّا ذكرنا في هذا الوجه يظهر الكلام في الوجه الثاني وكونه مخدوشا، فلا يحتاج إلى الإعادة.
الوجه الثاني [التمسك باطلاق المادة]:
ضمّ مقدّمة عقليّة إلى مقدّمة لفظيّة، وحاصله أنّ غاية ما ثبت إلى هنا قصور هيئة الكلام الدالّة على حكم الرخصة في ما لا يعلمون وعنوان المشكوك عن إفادة الحكم، لما ذكرنا من المحاذير، ولكن هنا شيء آخر يستفاد من المادّة وهو كون الشكّ في حدّ ذاته مقتضيا تامّا للترخيص والإباحة بحيث لا نقص فيه من حيث الاقتضاء، فالشكّ في التكليف بناء على هذا شيء يكون في جميع الأحوال مقتضيا للترخيص بمقتضى ما استفيد من تلك الأخبار باعتبار هذا الجزء الذي قد سمّيناه في بحث المقدّمة بإطلاق المادّة، فنحن نعلم بإطلاق مادّة هذه الأخبار بأنّ كلّا من المشتبهين يكون المقتضي لترخيص نفسه وإباحته في نفسه تامّا، غاية الأمر لم يمكننا جرّ الهيئة إليهما ومشموليّتهما للإذن والترخيص الفعليين بحكم العقل.
وبعد الاستفادة المذكورة من اللفظ نقول: لا شبهة أنّه لو وقع التزاحم والتعارض في مقام فعليّة التأثير بين سببين ومقتضيين عقليين بحيث لم يمكن الجمع بينهما، بل دار الأمر بين تأثير أحدهما ولغويّة الآخر، فحكم العقل أوّلا ملاحظة الأهميّة، فإن كان أحدهما أهمّ كان مرجّحا ومقدّما على الآخر، وعلى تقدير التساوي كما هو الحال في المقام- حيث إنّ المتعارضين كلّ منهما شكّ في التكليف- كان حكم العقل التخيير بينهما وأن لا يسقط أحدهما عن التأثير بعد عدم إمكان تأثير كليهما.
مثلا لو قال المولى: أنقذ الغريق، فابتلى المكلّف بغريقين لا يقدر على إنقاذ كليهما فلا شكّ أنّه يلزم بحكم العقل تخصيص هيئة «أنقذ» الدالّة على الإيجاب بالنسبة إلى المجموع؛ إذ لا إيجاب مع العجز، وإذا علم أنّ جمع الغريقين تحت حكم العام غير معقول فأصالة عمومه بالنسبة إلى هذا بعينه أو ذاك بعينه أيضا لا يمكن لنا إجرائها، للترجيح بلا مرجّح، لأنّ كلا منهما مصداق للعام، فلا وجه لتخصيص أحدهما بالدخول تحته، والحاصل: لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الهيئة في كليهما.
وحينئذ نقول إطلاق مادّة «أنقذ» يدلّ على وجود مقتضي المطلوبيّة في نفس إنقاذ الغريق ولو في المورد الذي لا يحسن التكليف والإلزام به، لأجل عدم قدرة المكلّف، وبعد هذا فيحصل لنا مقتضيان للطلب متزاحمان لا يمكن الجمع بينهما، فيتمحّض الحكم حينئذ للعقل بعد انقطاع اليد عن ظهور اللفظ، فإن كان أحد الغريقين فيه جهة أهميّة بنظر الشارع كالعالميّة أو الهاشميّة ونحو ذلك نحكم بتعيّن اختياره وتقديمه على الآخر، لوضوح أنّ الغرض الأقوى أولى بالإدراك والأضعف بالفوت عند الدوران بينهما.
وإن لم يكن في أحدهما جهة مزيّة كانت مرجّحة له بنظر الشرع، فالعقل يستقلّ بوجوب المبادرة إلى درك أحدهما مخيّرا في التعيين بينهما وعدم جواز تفويت كليهما، لوضوح أنّ رفع اليد عن الغرضين المستقلّين كليهما بمحض عدم إمكان الجمع بينهما لا يرتضيه عاقل، فكيف بالشارع الحكيم، فالعبد يقطع بعد ملاحظة ذلك بأنّ لفظ المولى وإن كان قاصرا عن شمول شيء من الأمرين، ولكن نفسه غير راض بإهمال الجميع؛ إذ فيه تفويت الغرض منه بلا جهة بحيث لو كان المولى الظاهري حاضرا لأمر بدرك أحدهما على التخيير، فلهذا يكون العقل باعثا ومحرّكا إلى درك الأحد التخييري، فالتخيير حكم استقلّ به العقل من دون دخل للشرع فيه، ولكن بعد حفظ مقدّمة من ظهور اللفظ وهو تماميّة الاقتضاء في كلّ من الامور كما فرضنا استفادته من إطلاق المادّة.
وبالجملة فنقول في المقام بعد حفظ هذه المقدّمة اللفظيّة التي هي مسلّمة، ضرورة أنّ قوله: كلّ مشكوك مباح له ظهور في أنّ نفس الشكّ له اقتضاء الإباحة ويكون الحكم بالإباحة من جهة اقتضاء الشكّ إيّاها، لا من جهة اللااقتضاء كما في إباحة بعض الأشياء: بأنّ إجراء كلّ من هذين المقتضيين على اقتضائهما إذا لم يمكن عقلا فلا وجه لإهمال الجميع، بل اللازم إعمال هذا الاقتضاء في أحدهما تخييرا بمقتضى المقدّمة العقليّة من أنّه إذا لم يمكن الجمع بين الغرضين فلا وجه لرفع اليد عن الجميع، فبظهور اللفظ أعني إطلاق المادّة يتحقّق موضوع هذه المقدّمة العقليّة، وبعد إجراء المقدمتين تكون النتيجة تخيير المكلّف في ترتيب أثر الإباحة على أحد المشتبهين، هذا.
والحقّ مخدوشيّة هذا الطريق أيضا وعدم تماميّته وإن كان تامّا في مثال إنقاذ الغريقين ونحوه.
بيان ذلك: أمّا من حيث تماميّة هذا الطريق في نحو المثال، فلأنّ المقتضي الذي احرز وجوده في كلّ من المتزاحمين فيه من إطلاق المادّة لم يكن له مانع ومزاحم من جهة من الجهات، وكان المزاحم والمانع عن جريانه على اقتضائه منحصرا في عجز المكلّف وعدم قدرته على العمل بالمقتضي في هذا وفي ذاك معا، فلا جرم كان المقتضى المذكور مؤثّرا أثره على مقدار قوّة المكلّف وقدرته، وكان إهماله مقصورا على قدر عجزه.
وأمّا عدم التماميّة في المقام فلأنّا وإن سلّمنا ظهور الإطلاق للمادّة في ثبوت اقتضاء الترخيص في الشكّ، ولكن نقول: لو كان المقتضي هنا منحصرا في الشكّ وكان مجرّد لزوم المحذور العقلي مانعا عن إجرائه في كلا الموردين ولم يكن في البين شيء آخر مقتضيا للضدّ أي لعدم الترخيص والإباحة فحينئذ سلّمنا استقلال العقل بالاقتصار في إهمال المقتضي السليم عن المعارض على مقدار منع المحذور العقلي مع لزوم إعماله على قدر لم يلزم المحذور.
ولكن ليس الأمر كذلك، بل الشكّ معارض بما يقتضي عدم الترخيص وهو العلم الإجمالي بالتكليف، فكما أنّ لنا في كلّ من الأمرين أو الامور شكّا في التكليف قد أحرزنا أنّ اقتضائه الترخيص، كذلك لنا علم إجمالي أيضا بثبوت التكليف، إمّا في هذا أو في ذاك، ولا شكّ أنّه مقتض تام للاحتياط وعدم الرخصة في شيء من أطرافه.
نعم لو فرض تحقّق الإذن الفعلي من الشارع في أحد الأطراف كان له الورود على هذا، ولكنّ المفروض عدم التّمكن من إثبات الإذن الفعلي بأدلّته اللفظيّة ورفع المحاكمة إلى العقل، وحينئذ فيرى العقل أن الشكّ مقتض للترخيص في الأطراف، والعلم مقتض لعدمه فيها، ولا نعلم أنّ الأوّل أقوى عند الشرع من الثاني حتّى يكون هو المقدّم في التأثير، أو تكون الأقوائيّة للعلم المقتضي لعدم الترخيص، أو يكونان متساويين حتى يرجع الامر بعد تساقطهما إلى التخيير.
ومقتضى عدم العلم بشيء من هذه الثلاثة واحتمال كلّ منها هو حكم العقل بالاحتياط وعدم جواز الارتكاب حتّى في أحدهما على التخيير؛ لاحتمال كون مقتضى عدم الترخيص أقوى، ومن المعلوم أنّ الحجّة حينئذ موجودة، فيكون العقاب على هذا الذي يرتكبه على تقدير مصادفته مع مخالفة التكليف عقابا مع الحجّة.
نعم يحتمل أيضا أن تكون الأقوائيّة مع مقتضى الترخيص، فلا تكون الحجّة الواقعيّة موجودة بالنسبة إلى مخالفة التكليف في أحد الطرفين، فيكون العقاب بلا حجّة، ولكن مجرّد احتمال هذا لا يكفي في حكم العقل بالبراءة، فإنّ موضوعه الجزم بعدم الحجّة، ولا يكفي احتماله، وليس هذا ترجيحا لمقتضى عدم الترخيص على مقتضى الترخيص، بل هذا قضيّة حكم العقل عند انجرار مآل الأمر إلى ذلك أعني التحيّر في حال المقتضيين ودورانه بين ثلاثة احتمالات.
ألا ترى أنّا لو قصر عقلنا في الشكوك البدويّة بعد إعمال الوسع والفحص عن الدليل بقدر الطاقة وعدم الظفر به عن إدراك عدم إمكان كون نفس احتمال التكليف بيانا وحجّة يصحّ مؤاخذة المولى باعتباره، ولم يحصل لنا الجزم بأحد الطرفين، لا بالحجيّة ولا بعدمها، بل تردّدنا بينهما، كان مع ذلك ومع وجود هذا التردّد حكم العقل في حقّنا وجوب الاحتياط؛ إذ لم ندخل بعد في موضوع حكم العقل بالبراءة وهو الجزم بكون عقاب المولى بلا حجّة، ولا سبيل إلى البراءة مع التردّد وعدم الجزم.
الوجه الثالث لإثبات الرخصة في أحدهما هو التمسّك بالإطلاق والعموم الحالي،
وهو أن يقال: إنّ قوله: كلّ مشكوك مرخّص فيه، يشمل بعمومه الأفرادي هذا المعيّن وذاك المعيّن، فكأنّه قيل: هذا مرخّص فيه وذاك مرخّص فيه، وكلّ من هذين الحكمين له إطلاق بالنسبة إلى فعل متعلّق الآخر وتركه، فكأنه قيل:
أنت مرخّص في هذا سواء تركت ذاك أم فعلته، ومرخّص في ذاك سواء تركت هذا أم فعلته، ولا إشكال أنّ الأخذ بهذا الإطلاق يوجب المحذور العقلي وهو الترخيص في المعصية والمخالفة القطعيّة كما هو واضح.
فلا محيص عن رفع اليد عنه على قدر هذا المحذور وإبقائه في غيره، فيصير المتحصّل من هذا هو الترخيص في أحدهما؛ لأنّ الكلام بعد التقييد العقلي يصير بمنزلة أن يقال في الشبهة التحريميّة: أنت مرخّص في فعل هذا إن تركت ذاك، وفي فعل ذاك إن تركت هذا، وفي الشبهة الوجوبيّة: أنت مرخّص في ترك هذا إن فعلت ذاك وبالعكس، ويكون المحصّل في الأوّل هو الرخصة في فعل أحدهما، وفي الثاني في ترك أحدهما كما هو واضح.
ثمّ هذا الشرط من الشروط المقارنة التي يحدث عند أوّل وجودها المشروط، ولا إشكال في إمكانه كالشرط السابق واللاحق، ألا ترى أن لو طلب العدو حين عدو الزيد فيكون عدو الزيد مقدّمة مقارنة لمطلوبيّة العدو، بحيث يجب أن لا يؤخّر الفعل حتّى تحصل المقارنة، ومن هذا القبيل أيضا الواجبات المعلّقة بالوقت الخاص مثل: إذا دخل الظهر فافعل كذا، حيث إنّ الوجوب يحدث مقارنا لدخول الوقت لا متأخّرا عنه، ومثل ذلك المقام، حيث إنّ حكم الترخيص في فعل هذا يحدث مقارنا لترك ذاك وبالعكس، أو في تركه مقارنا لفعل ذاك وبالعكس.
فإن قلت: لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق رأسا للمحذور المذكور، والتقييد المذكور لا يوجب التفصّي عن المحذور، للزومه معه في بعض الصور؛ إذ يلزم في الشبهة التحريميّة ثبوت الترخيص في فعل كليهما في ظرف كون المكلّف تاركا لكليهما إلى الأبد، وفي الوجوبيّة كونه مرخّصا في ترك الجميع على تقدير فعل الجميع، لوضوح أنّ شرط كلا الترخيصين أعني ترخيص هذا وترخيص ذاك حاصل في هذا التقدير، فيلزم المحذور في هذا التقدير، فلهذا يجب رفع اليد عن الإطلاق رأسا.
قلت: لا يلزم هذا المحذور، فيصحّ التمسّك بالإطلاق، بيان ذلك قصور الإطلاق عن شموله هذا التقدير، أعني تقدير ترك الجميع أو فعل الجميع، فإنّ حاصل ثبوته في هذا التقدير يصير هكذا: إن كنت تفعل هذا وهذا فأنت مرخّص في تركهما. أو إن كنت تاركا لهذا وذاك للتالي وإلى الأبد فأنت مرخّص في فعلهما، وهذا ترخيص للشيء معلّقا على فعله أو تركه، وهو أمر غير ممكن في شيء من الأحكام.
بيان ذلك أنّ الحكم المستفاد من الأدلّة اللفظيّة أمرا كان أم نهيا أم ترخيصا في أيّ درجة من الإطلاق كان، فغايته الإطلاق بالنسبة إلى وجود الأشياء الأخر في العالم وعدمها، وأمّا بالنسبة إلى وجود نفس المتعلّق وعدمه فلا يثبت لها أبدا إطلاق، بل لا بدّ من تعرية المطلب عن لحاظ الوجود والعدم إطلاقا وتقييدا.
وسرّ ذلك أنّ الأمر مثلا يقتضي انقلاب العدم إلى الوجود، ومع حفظ العدم أو حفظ الوجود لا اقتضاء له للوجود، لكون الأوّل جمعا بين النقيضين، والثاني جمعا بين المثلين، وكذا النهي مقتضاه إمساك العدم، وفي تقدير فرض العدم أو فرض الوجود فهو لا اقتضاء.
وبعبارة اخرى: الأوامر والنواهي كالعلل التامّة المقتضية للامتثال، فكما أنّ العلّة التامّة لوجود الشيء يكون من أثرها الوجود المنقلب من العدم- لا أنّه في ظرف اتّصاف الشيء بالعدم له اقتضاء الوجود، أو في ظرف اتّصافه بالوجود له اقتضاء الوجود، بل في هذين الظرفين هو لا اقتضاء كما هو واضح- كذلك الأمر علّة لإيجاد المتعلّق، يعني يقتضي قلب عدمه بالوجود، فمع فرض العدم فيه أو الوجود فيه سقط عن الاقتضاء.
وكذلك النهي علّة لإبقاء العدم، فلو فرض تحقّق العدم أو تحقّق الوجود فقد مضى الأمر ولم يبق محل للاقتضاء.
وكذلك الترخيص علّة لإطلاق طرفي الوجود والعدم ورفع الإلزام عنهما، فلو فرض العدم أو فرض الوجود فلا حكم؛ إذ في الأوّل يصير المحصّل أنّ هذا الذي هو معدوم أبقه على العدم أو أوجده، ولا معنى لإبقاء المعدوم على العدم ثانيا، ولا لإيجاده مع كونه معدوما، وكذا الحال في طرف الموجود، وإذن فلا بدّ من عدم النظر في الأحكام بأسرها إلى حالتي وجود المتعلّقات وعدمها.
والحاصل أنّ بناء هذا الإشكال على أخذ الإطلاق للحكم بالنسبة إلى فعل وترك موضوعه وقياسهما بغيرهما من سائر الطواري والعوارض، وتخيّل أنّ قولنا: إن تركت هذا فأنت مرخّص في فعل ذاك وإن تركت ذاك فأنت مرخّص في فعل هذا بمنزلة قولنا: إن جاء زيد أكرم عمرا وإن جاء عمرو أكرم زيدا، فكما أنّ المعنى في الثاني أنّه: إن جاء زيد فسواء جاء عمرو أم لم يجيء أكرم عمرا، وإن جاء عمرو فسواء جاء زيد أم لم يجيء أكرم زيدا، ففي تقدير مجيئي عمرو في الأوّل ومجيئي زيد في الثاني يحصل الحكم بإكرام الجميع يعني أنّ العمرو الجائي والزيد الجائي يجب إكرامهما معا، كذلك المعنى في الثاني، أنّه إن تركت هذا فسواء تركت ذاك أم فعلته فأنت مرخّص في فعل ذاك، وإن تركت ذاك فسواء تركت هذا أم فعلته، أنت مرخّص في فعل هذا، فيلزم في تقدير ترك ذاك في الأوّل وترك هذا في الثاني الرخصة في الجمع.
ومحصّل الجواب أنّ التكليف لا يمكن سوقه على وجه وقع حالتا فعل متعلّقه وتركه تحته، لا إطلاقا ولا تقييدا، نعم هو موجود في حالهما، والأحوال المأخوذة في الموضوع على أحد الوجهين معنى أخذها أنّه لو اخذ الموضوع مقترنا بكلّ من تلك الأحوال، فالحكم يشمله إمّا بدلا وإمّا تعيينا.
مثلا قولنا: أعتق رقبة، يصدق عليه أنّه حكم شمل الرقبة المقرونة بالإيمان والمقرونة بالكفر على البدل، وهذا لا يمكن في الفعل والترك للموضوع، مثلا لا يمكن «أن يقال»: إنّ الفعل المقرون بالترك محكوم بحكم كذا، أو الفعل المقرون بالفعل محكوم بحكم كذا، لا على وجه الإطلاق ولا التقييد، بل لا بدّ أن يقال: إنّ ذات الفعل مطلوب نقض عدمه بالوجود أو إمساك عدمه.
وحينئذ نقول: إذا قال: إن تركت هذا، فحينئذ قد لاحظ شرط الرخصة في ذاك ولكن حين يقول: فأنت مرخّص في ذاك، ليس معنى هذا أنّ ذاك إن كان منتركا في علم اللّه فلك الرخصة في ضمّ ما شئت من الفعل أو الترك إلى انتراكه، وإن كان مقرونا بالفعل في علمه تعالى فلك الرخصة في ضمّ فعل أو ترك إلى فعله حتّى يقال: إنّ في الفرض الأوّل قد لوحظ شرط الرخصة في هذا وهو ترك ذاك أيضا، فلزم الرخصة في الجمع، بل المعنى أنّه: إن تركت هذا فأنت مرخّص في تبديل ترك ذاك بالفعل وإبقاء تركه وبالعكس، ففي كلّ لحاظ يكون شرط الرخصة في أحدهما موجودا دون الجميع؛ إذا الفرض أنّه أيّا منهما يجعل تحت الترخيص لا يلاحظ له تركا مفروغا عنه، بل يجعل محفوظيّة تركه مبدّلا بأن كان الأمر إلى المكلّف.
وإن شئت قلت: إنّ الحاكم عند لحاظ الموضوع حيث لاحظ الذات المجرّدة عن قيد الفعل والترك ولم يلحظ الإطلاق بالنسبة إليهما فهو أبدا يكون شرط ترخيص أحدهما في لحاظه غير موجود، ففي صورة كون الطرفين في علم اللّه ممّا يتركه المكلّف في ما يستقبل، فالمكلّف في هذا الحال ليس خارجا عن تحت التكليف، بل هو مكلّف، ولكن على وجه أنّه إن ترك هذا فهو مرخّص في ذاك وبالعكس.
ومعنى هذا أنّه على تقدير يجعل ترك هذا محفوظا فهو مرخّص في نقض ترك ذاك بالفعل، وعلى تقدير جعله ترك ذاك محفوظا، فهو مرخّص في نقض ترك هذا بالوجود، ومن الواضح أنّه على الأوّل لم يبق شرط الرخصة في هذا وهو محفوظيّة ترك ذاك محفوظا، بل رخّص في نقضه بالوجود، نعم لو كان المعنى هو الرخصة في جعل ترك ذاك مقرونا بالفعل وضمّ الفعل إلى حالة تركه كان شرط رخصة هذا محفوظا، ولكنّه غير واقع.
والتحقيق في الجواب عن هذا الوجه(4)أنّ الأمر دائر بين حفظ أصالة العموم في «كلّ شيء لك حلال» بالنسبة إلى كلّ من الطرفين معيّنا والالتزام بمخالفة أصالة الإطلاق في كلا الموردين، وبين حفظ أصالة الإطلاق بالالتزام بمخالفة أصالة العموم في هذين الشيئين.
لا يقال: إذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد فالثاني أولى، وسرّه أنّ الثاني رفع اليد عن العموم الأحوالي فقط، والأوّل رفع اليد عن الأفرادي والأحوالي كليهما.
لأنّا نقول: العموم الأحوالي موضوعه الأفراد بعد الفراغ عن شمول العموم الأفرادي لها، فخروج الفرد عن العموم الأحوالي بعد خروجه عن الأفرادي ليس مخالفة لأصالة الإطلاق، بل هو من باب السلب بانتفاء الموضوع.
لا يقال: التمسّك بالأصل فرع إحراز الموضوع، وإذا فرضنا أنّ موضوع أصالة الإطلاق هو الفرد بعد إجراء أصالة العموم فيه، ففي مرتبة أصالة العموم لا مجرى لأصالة الإطلاق حتّى يعارضها، لعدم إحراز موضوعها، وبعد إجراء أصالة العموم لا يبقى شكّ في التقييد.
لأنّا نقول: توقّف إجراء أصالة الإطلاق كأصالة العموم على إحراز الموضوع محلّ منع- كما حقّق في محلّه- ومحصّل الكلام فيه أنّ إجراء الأصل هل يكون مقصورا بصورة إحراز الموضوع والشكّ في أنّه مراد جدّا أو لا، فلا يعمّ صورة القطع بالخروج عن الإرادة الجديّة والشكّ في أنّه داخل في الموضوع أو خارج عنه، فلا يجري في هذه الصورة، لإحراز أنّه خارج عنه، أو أنّه عام للصورتين، وقد ثبت في محلّه أنّ التحقيق هو الثاني.
وعلى هذا فنقول: بعد القطع بعدم شمول قوله: «حلال» لكلّ من المشتبهين بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في حال ارتكاب المشتبه الآخر نشكّ في أنّه من باب الخروج الحالي مع كون المتكلّم بمقام البيان وعدم ذكر القيد في الكلام، ولا دليل عليه في المقام، أو من باب الخروج الموضوعي؟ فأصالة الإطلاق يعيّن الثاني، فيكون معارضة لأصالة العموم النافية له.
وإن شئت قلت: الأمر دائر بين الخروج الفردي الذي هو نفس المحذور وبين الدخول الفردي الذي هو مستلزم للمحذور، والمستلزم للمحذور أيضا كنفس المحذور.
لا يقال: الدليل على التقييد موجود وهو حكم العقل بعدم جواز الترخيص في المخالفة القطعيّة، لكونه ترخيصا في الظلم، بل في أقبح أفراده.
لأنّا نقول: الحكم العقلي المنافي مع انعقاد أصالة الإطلاق هو الارتكاز الذي يصلح الاتكال عليه في صرف الكلام عن ظاهره، لكونه حاضرا في ذهن الطرفين، بحيث كان كلّ من سمعه يفهم منه خلاف ظاهره، لوجود القرينة الارتكازيّة في ذهنه وحضوره لدى استماعه، وليس هكذا الحكم العقلي في المقام كما هو واضح.
ثمّ من الأمثلة العرفية الشاهدة للمقام ما إذا قام أمارة معتبرة على أنّ هذا الطفل مثلا ابن زيد، وقامت اخرى على أنّ الزيد لا يقتل ابنه، فرأيناه قتل ذلك الطفل، فنرى من انفسنا الشكّ والتردّد في نقض الأمارة الاولى والحكم بأنّه ليس ابنا لزيد، أو نقض الثانية والحكم بأنّه يقتل ابنه، مع أنّ مورد الأمارة الثانية متأخّر رتبة عن مورد الاولى، ومجرّد ذلك لا يوجب حكمنا بأنّه ابنه وإيراد النقض على الثانية ورفع اليد عن أنّه لا يقتل ابنه.
فإن قلت: فما وجه تسالمهم على تقديم الأصل الموضوعي على الحكمي؟
قلت: الوجه كون الأصل الموضوعي مزيلا للشكّ في الموضوع للحكمي ولا عكس، فالأوّل حاكم والثاني محكوم، نعم لازم ما ذكرنا عدم تماميّة ما ذكروا بناء على حجيّة الأصل المثبت، إذ يشترك الحكومة حينئذ بينهما، وينحصر الوجه في التقدّم الرتبي كما لا يتمّ في الأمارتين.
وفي هذا الجواب نظر، بل منع بملاحظة أنّ التخصيصين فيها طرح الظهور أزيد من التقييدين كما هو واضح، نعم لو قلنا بأنّ الأحد المخيّر من أفراد العام فللترديد وجه، لكن لا ثمرة بينهما عمليّة، وأمّا إذا قلنا بأنّ الأحد المخيّر ليس من أفراده كما هو الحقّ فلا دوران في البين أصلا، فإنّ أصالة العموم تسدّ باب احتمال التخصيصين كما هو واضح.
فتحصّل أنّ الرخصة في الجمع لا يحصل أبدا، فالإشكال غير وارد، والحاصل أنّه لا إشكال في إمكان أخذ الإطلاق على الوجه المتقدّم المتحصّل منه الرخصة في أحدهما، وإنّما الكلام في وقوعه واستفادته من الكلام أعني أدلّة الرخصة في المشكوكات مثل قوله: «رفع ما لا يعلمون».
فربّما يقال: إنّه لا يمكن استفادة الإطلاق المذكور منها، أعنى إطلاق الرخصة في كلّ مشكوك سواء وجد شيء في الدنيا أم لا، إذ يلزم على تقديره كون الإنشاء على وجه الإطلاق وعلى وجه الاشتراط في إطلاق واح، فإنّه لا إشكال في شمول هذه الأدلّة للشكوك البدويّة، وبالنسبة إليها لا شبهة في ثبوت الإنشاء على وجه الإطلاق، فإذا اقتضى حكم العقل تقييدا في الحكم بالنسبة إلى الشكوك المقرونة بالعلم على حسب ما فصّل لزم اجتماع لحاظ الإطلاق والتقييد في إطلاق واحد.
فهذا نظير ما لو قال: أعتق رقبة وعلمنا باختصاص الحكم بخصوص المتّصف بالإيمان من بين صنف خاص من الرقبة مع محفوظيّة الإطلاق بالنسبة إلى باقي الأصناف، ولكن فيه أنّا إن بنينا في القيود المنفصلة اللاحقة بالكلام أعمّ من اللبيّة واللفظيّة على أنّها كاشفة عن كون المتكلّم في مقام الاستعمال مريدا من اللفظ المعنى المقيّد، كان ما ذكر إشكالا واردا على أخذ الإطلاق من تلك الأدلّة، ولكنّ الحقّ خلافه وأنّ تلك القيود لا يورث تغييرا في الإرادة الصوريّة، بل نقول: إنّ المراد الاستعمالي والصوري هو المعنى المطلق لمصلحة، من ضرب القاعدة ونحوه، ولكن نحكم بأنّ المراد الجدّي أضيق منه، فنرفع اليد عن التطابق بين الإرادتين في مقدار يتكفّله المقيّد ويؤخذ به في الزائد، فعلى هذا لا يلزم الإشكال أصلا كما لا يخفي.
ثمّ لا يخفي أنّ مجرّد كون المقيّد في المقام حكم العقل لا يوجب كونه من القيود المتّصلة بالكلام، لكون إدراك العقل موجودا حين التكلّم به، فإنّ مجرّد هذا لا يوجب صرف ظهور الكلام ما لم يكن الحكم العقلي من المرتكزات العرفية التي يصحّ أن يتّكل عليه في تفهيم المرادات، فحينئذ يكون من قبيل القرائن المقاميّة وبدون ذلك فمجرّد الإدراك العقلي لا يكون صارفا، فلهذا يحمل معه الكلام الصادر من غير الحكيم على الكذب، ومنه على تضييق المراد الجدّي وكون الاستعمالي واسعا لمصلحة، ولو كان من القرائن لكان الأمر في كلا المقامين على خلاف ذلك، هذا.
ولكنّ التمسّك بالإطلاق لإثبات الرخصة في أحد طرفي العلم الإجمالي لا على التعيين بعد محلّ إشكال؛ (5) إذ لا يبعد أن يقال: إنّ حكم الرخصة في الأدلّة معلّق على عنوان المشكوك وما بمعناه من حيث هذا العنوان من غير تعرّض للطواري، فهى متعرّضة للأمن والاستراحة من العقوبة من ناحية ارتكاب المشكوك، ومن هذه الجهة هو حكم عام يشمل كلّ مشكوك حتّى المقترن بالعلم الإجمالي، ولكن ليس له نظر وتعرّض للعنوان الآخر العارض، وأنّ المكلّف من حيث العناوين الأخر المجتمعة مع هذا العنوان المشكوك هل هو في راحة أو لا؟
وحينئذ ففي الشكوك البدويّة يكون عموم الأدلّة جاريا ومعمولا به؛ إذ لا مانع فيها عن فعليّة هذا الحكم الحيثيّتي، وأمّا في أطراف العلم فالمانع موجود وهو المعلوم الإيجاب أو التحريم الإجمالي الموجود بين الأطراف، فهذا العنوان له اقتضاء التحريم من حيث هو وما لم يرد عليه الإذن الفعلي الشرعي، فلو ارتكب المكلّف أحد أطراف الشبهة واتّفق مصادفته مع الحرام المعلوم، فهو وإن لم يكن بمقتضى عموم هذه الأدلّة مأخوذا ومسئولا من جهة أنّه أتى بمشكوك الحرمة، ولكن لا ينافي أن يكون مأخوذا ومسئولا من جهة أنّه أتى بالمعلوم الحرمة إجمالا.
ألا ترى أنّ من أكل لحم الغنم المغصوب فهو من حيث إنّه أكل لحم الغنم ليس في مضيقة، يعني لا يقال له: لم أكلت لحم الغنم، كما لو كان أكل لحم الخنزير يؤاخذ من جهة أكل لحمه، ولكن عدم مؤاخذته من هذه الجهة لا ينافي أبدا مع مؤاخذته ومسئوليّته من حيث إنّه أكل مال الغير بغير رضاه.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا عدم جريان البراءة النقليّة في أطراف الشبهة بوجه كالعقليّة، وإذن فلا محيص عن الاحتياط في جميع الأطراف.
هذا كلّه بناء على ما نختاره في الأحكام الواقعيّة من أنّها فعليّة من قبل المولى، يعنى ليس لها من قبله نقص وحالة منتظرة، ويتمحّض المانع في ما يكون من قبل المكلّف من اجتماعه شرائط التكليف، وبعبارة اخرى: الأحكام المذكورة تكون بحيث إذا علم بها من استكمل الشرائط كانت فعليّة بمجرّد ذلك، وهذا ظاهر دعاوي الإجماعات وظاهر الأدلّة المثبتة للتكاليف أيضا، وإنّما صرفها عن ظاهرها من قال للأحكام بمراتب، لزعمه عدم إمكان الجمع بين الأحكام الظاهريّة مع فعليّة الأحكام الواقعيّة، ونحن حيث قد بيّنا في محلّه إمكانه باختلاف رتبة الحكمين، فلا مانع عن إبقاء الأدلّة على ظواهرها من الفعليّة.
وكيف كان فربّما يقال: إنّه على القول بثبوت المراتب للحكم الواقعي نجمع بين هذه الأدلّة المرخّصة مع ما يدلّ على حرمة العنوان الواقعي بحمل الثاني على الحكم الشأني، وحينئذ تجري البراءة في كلّ من المشتبهين؛ إذ غاية ما يلزم مخالفة الحكم الشأني، ولا ضير فيها ولو علم تفصيلا.
والحاصل: لا فرق عند هذا القائل بين الشبهة البدويّة والمقرونة بالعلم، فكما يصرف دليل الحرام الواقعي عن ظاهره بواسطة دليل الرخصة في الاولى فلا بدّ أن يفعل ذلك في الثانية، فلا فرق بين ما لو شكّ أنّ هذا المائع خمر أو ماء، وبين ما لو علم بكون أحد الإنائين خمرا، فإنّ المقامين مشتركان في كبرى معلومة وهو العلم بأنّ الخمر حرام، نعم يزداد الثاني على الأوّل بانضمام صغرى معلومة وهو العلم بوجود الخمر إجمالا إلى تلك الكبرى، ولكنّ العمدة هى الكبرى بمعنى أنّ العلم بالحرمة إن كان بمعناها الفعلي كان العلم بالخمر موجبا للتنجيز، وأمّا لو كان بالمعنى الإنشائي فلا يكون العلم بالصغرى منشئا لأثر أصلا كما هو واضح.
وإذن فنقول كما يقول هذا القائل في المقام الأوّل بأنّ ظاهر «لا تشرب الخمر» الذي هو الفعليّة يجب رفع اليد عنه بواسطة دليل الرخصة في المشكوك، فكذا في المقام الثاني أيضا يجب أن يقول بذلك، فيكون العلم بالخمريّة لغوا غير منجّز، فيرتفع المانع عن إجراء البراءة في كلا الطرفين، نعم لا بدّ أن يستثنى من هذا ما لو علم من إلهام أو جفر أو نحو ذلك بأنّ الحكم المعلّق على الواقع فعليّ.
وفيه أنّ ما ذكر حقّ لو لا ما يشتمل عليه هذه الأدلّة المرخّصة من جعل الغاية هو العلم الشامل للإجمالي، فهي متعرّضة عند هذا القائل لحكمين شرعيين، أحدهما الرخصة في المشكوك، والآخر عدم الرخصة في المعلوم، والثاني وإن كان على مبنانا تقريرا لحكم العقل، ولكن على مذاق هذا القائل يكون حكما شرعيّا؛ إذ كما أنّ الأوّل شارح لأدلّة الواقعيّات بعدم الفعليّة، فالثاني شارح لها بالفعليّة، ومن المعلوم أنّ جعل الفعليّة عند العلم من وظيفة الشرع ليس إلّا.
وعلى هذا ففي مورد العلم الإجمالي يقع التعارض بين صدر الروايات مع ذيلها، حيث إنّ قضيّة الأوّل هو الرخصة في الأطراف، ومقتضي الثاني عدم الرخصة فيها، فيتساقطان، فيكون المرجع بعد تساقطهما هو الاحتياط؛ إذ يدور الأمر بين فعليّة الخطاب الواقعي كما هو قضيّة الذيل، وبين عدم فعليّته كما هو قضيّة الصدر، فيكون ظاهر دليله من مثل لا تشرب الخمر ونحوه مأخوذا بسلامته عن الحاكم والشارح، وقد عرفت أنّ ظاهره الفعليّة، فإذا صار فعليّا بقضيّة هذا الظاهر كان الاحتياط بحكم العقل لازما فتدبّر.
ثمّ إنّك عرفت عدم جواز التمسّك بالعمومات والإطلاقات المرخّصة، بقي الكلام في الصحيحة الّتي رجّحنا سابقا ورودها في مورد العلم الإجمالي أعني قوله: «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» ولا يرد عليها ما ورد على غيرها؛ لكونها ناظرة إلى خصوص مورد العلم بناء على ما فسّرناها من أنّ المراد الشيء الخارجي المشتمل على الحلال والحرام خارجا ولم يتميّزا، والقرينة على عدم التمييز والاختلاط قوله في الذيل: بعينه.
ثمّ إطلاق الخبر شامل لما إذا ارتكب الجميع، لكن يجب تقييده بغير هذا وهو الارتكاب بمقدار لا يلزم المخالفة القطعيّة، ويمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الخبر هو الشيء الخارجي المشتمل على القسمين مع تعارف اختلاط أحد قسميه بالآخر، كما هو الحال في النقود والأجناس السوقيّة، فإنّ اللحم مثلا له المذكّى والميتة هما مختلطان نوعا، والجبن مثلا له الطاهر والنجس، ولا يتميّزان حسب العادة، وهكذا كلّ جنس فيه السرقة وغيرها مثلا ولم يتميّزا نوعا.
والحاصل: اريد من «الشيء» العنوان الأوّلي الذاتي من مثل الدهن والجبن والنقد وغير ذلك، واعتبر على نحو الكلّي في المعيّن، فيشمل كلّ نوع يشار به إلى أفراده في الخارج وكان اختلاط القسمين فيها متداولا، فيخرج ما لم يكن الاختلاط فيه كذلك، مثلا الماء حلال والخمر حرام، فيصحّ أن يقال: المائع- ويشار به إلى الأفراد الخارجيّة على نحو الكلّي في المعيّن- فيه حلال وحرام، ولكنّ القسمين منه في الخارج متمايزان، فإنّ مياه الدنيا ممتازة عن خمورها، فإذا صار بالاتفاق ماء مشتبها بخمر فلا يشمله الحديث الشريف، والدليل على ما ذكرنا هو التبادر والانصراف.
ثمّ لا فرق حسب إطلاق الخبر بين ما إذا كان الاشتباه المتعارف من قبيل المحصور أعني اشتباه القليل في القليل، والكثير في الكثير، وبين أن يكون من غير المحصور أعني اشتباه القليل في الكثير، بل نقول مضافا إلى دلالة الخبر على ما ذكر: إنّا نرى العمل الخارجي والسيرة من المتديّنين على المعاملة مع الأجناس السوقيّة وما يشابهما مع حصول العلم بأنّ فيما بينها النجس والحرام معاملة الطهارة والحليّة ما لم يعلموا النجس والحرام بشخصها.
والقول بأنّ ذلك لا ينفكّ إمّا عن عدم انحصار الشبهة، وإمّا عن لزوم الحرج في الاجتناب، أو عن خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، مدفوع بأنّ الاشتباه في هذه الامور من اشتباه الكثير في الكثير وهو من المحصور، ولو كان الملاك هو الحرج كان الواجب الاقتصار على مقداره، ونراهم يتعدّون منه، وأجناس البلد الواحد لا يعدّ بالنسبة إلى أهله خارجة عن محلّ الابتلاء، لعدم استهجان التكليف كما لا يخفي.
فإن قلت: إنّا نرى العلماء في كتبهم يكونون بصدد بيان الضابط للمحصور وغيره، فيعلم منهم أنّ كون المحصور لازم الاجتناب من المسلّمات، فتكون الأخبار المذكورة معرضا عنها، وهو يوجب وهنها سندا، بل كلّما ازداد صحّة يزداد بذلك وهنا.
قلت: لو فرض استفادة ذلك من الكلمات، لكن عمل الطائفة من العلماء وغيرهم استقرّ في الخارج على خلافه، فلاحظ.
ومن هنا يعلم أنّ السوق واليد أيضا لا اعتبار بهما بواسطة هذا العلم الإجمالي، ويدلّ على ما ذكرنا الأخبار الناهية عن السؤال مثل قوله عليه السلام: «ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك» وقوله في بعض الروايات: «و اللّه إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، واللّه ما أظنّ كلّهم يسمّون، هذه البربر وهذه السودان».
وبالجملة، ما ذكرناه من المعنى يمكن استظهاره من الخبر وأمثاله من هذه الأخبار، ويمكن دعوى السيرة أيضا عليه، فافهم وتدبّر.
_______________
(1) محصّل القول في إمكان الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالى أنّه كما يمكن أن يحدث المزاحم في خصوص مورد التكليف كأن يتوقّف حفظ حياة العبد على شرب الخمر، كذلك من الممكن أن يحدث في الاحتياط بمراعاة جميع الأطراف التي يكون الواقع فيها مشتبها، كأن يكون هذا الاشتغال مفوّتا لتكميل آخر عن العبد ففي الأوّل لا محالة يتقيّد الغرض الباعث على التكليف بغير هذه الصورة، و في الثاني لا يجوز رفع اليد عن ذلك الغرض، كما لا يجوز عن مزاحمه، بل يجب الجمع بينهما بقدر الإمكان، و هو يمكن بأحد أنحاء ثلاثة، إمّا بالإذن في البعض الغير المعيّن، و إمّا في البعض المعيّن، لاختصاص غيرة بأولويّة المراعاة، و إمّا بالإذن في كلّ مقيّدا بترك الآخر.
ولا فرق في ما ذكرنا بين أن نختار في وجه الجمع بين هذا الترخيص و التكليف الواقعى القول بثبوت المراتب للأحكام و هبوطها حينئذ عن درجة الفعليّة إلى الشأنيّة بواسطة الكسر و الانكسار، أو القول ببقائها على الفعليّة و رفع المنافاة بدخالة لحاظ التجريد عن الشكّ في عروضها على متعلّقاتها، كدخالة لحاظ التجريد عن الخصوصيات في عروض الكليّة على الطبائع، و ذلك لأنّ الغرض الواقعي على كلّ حال فعلي مطلق لا دخالة للعلم و الجهل فيه، و إلّا يلزم التصويب الباطل، فالهبوط عن الفعليّة على الأوّل و دخالة صفة التجريد لحاظا لا قيدا على الثاني إنّما هما بالنسبة إلى التكليف دون الغرض الباعث عليه.
وممّا ذكرنا تبيّن أنّه لا يقاس الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي بالترخيص في جميعها أو بالترخيص في مخالفة العلم التفصيلي، و ذلك لأنّه مع حدوث المزاحم في الأخيرين فلا محالة يزاحم نفس مورد التكليف، فيوجب تقييد الغرض الباعث على التكليف، وهو تصويب في الأوّل منهما، و مع عدمه يكون ترخيصا في القبيح، بخلاف الترخيص في البعض، فإنّه ممكن مع سلامته عن المحذورين.
نعم يمكن حدوث المزاحم في جميع الأطراف أيضا، لكن من غير جهة الشكّ، كما توقّف حفظ الحياة على مناولة الجميع، فيوجب تقييد الواقع، كما أنّ ذلك في العلم التفصيلي أيضا واضح الإمكان و الوقوع. منه قدّس سرّه الشريف
(2) هذا تقريب آخر للوجه الأوّل كتبه قدّس سرّه في الدورة الثانية من الاصول. فجعلناه فى المتن.
(3) لا يخفي أنّ المثال العرفي الآتي في الوجه الثالث يوجب شهادة الارتكاز على المقام فلاحظ. منه قدّس سرّه الشريف.
(4) أي الوجه الثالث أورده قدّس سرّه في الهامش و أثبتناه في المتن.
(5) هذا الإشكال وارد على التقريب الأوّل أيضا على تقدير تماميّته و عدم ورود ما أوردنا عليه سابقا. منه قدّس سرّه الشريف.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|