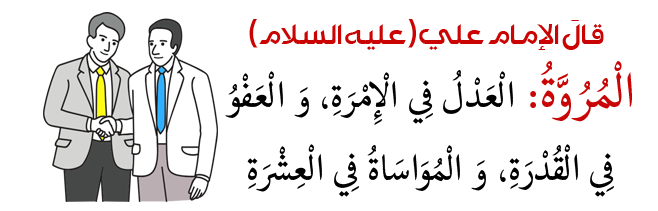
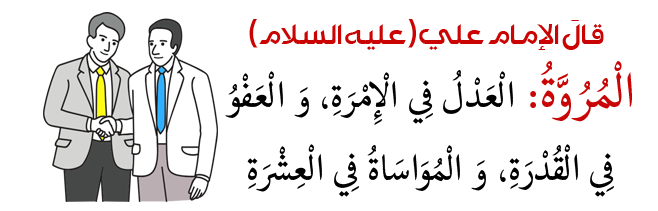

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-01
التاريخ: 2023-04-01
التاريخ: 2023-04-01
التاريخ: 10-4-2022
|
هي: (لم-لما-لام الأمر-لا الناهية).
ولاتجزم إلا فعلا مضارعا واحدا
لقد سبق أن تعرضنا إلى معاني حركات الفتحة والضمة والكسرة وأصول استعمالاتها دون التعرض لمدلول حركة (الجزم) في التسكين. انظر (الحرف العربي والشخصية العربية ص128-130)
فلقد ذكرنا في حينه بمعرض الحديث عن تحريك (عين) الفعل الثلاثي: أن (الضمة) مخفف الواو تشير إلى الفعاليات الذاتية، نحو (كرُم). وأن الكسرة مخفف (الياء) تشير إلى الحالات الذاتية، نحو (حزن). وأن (الفتحة) مخفف (الألف اللينة تشير إلى الاستكانة والاستقرار: (ذهبَ).
ولكن ما معنى (الجزم) المعجمي ومدلوله النحوي؟
(الجزم) لغة معناه (القطع). جزم الشيء(قطعه). وجزم اليمين (أمضاها قاطعة لا رجعة فيها). و(الجزم) في النحو، هو تسكين الحرف أو حذفه، يلحق الأفعال المضارعة المجزومة بأحرف الجزم، كما في (لم يذهبْ)، أو أفعال الأمر، كما في (اعلمْ- أكرِمْ). وهو غير مخفف عن حرف، والسكون بحكم طريقة النطق بصوته في نهايتي فعلي المضارع والأمر المجزومين، إنما هو أوحى حركات الشكل بالجزم والقطع والبت والحتم والحسم، بما يتوافق مع واقعتي النهي أو الأمر((حزماً وجزماً وبتاً..)) سواء أَكان الأمر مباشراً (اذهبْ) أو غير مباشر (لِتذهبْ، لا تذهبْ).
1-(اللام) للإلصاق والالتصاق والإلزام.
2-(الميم)- للجمع والضم والانغلاق، ولا سيما في نهاية الكلمة، بما يتوافق مع حركة انطباق- الشفة على الشفة عند الوقوف على صوتها في هذا الموقع الأخير من (لَمْ).
وهكذا تتآزر معاني هذين الحرفين للتعبير عن معاني الجمع والضم بمزيد من الإلصاق كما في (لمَّ، يلمُّ)، نحو: ((لمّ شتاتَ قومِه)، أي جمعهم جمعاً شديداً.
ولكن ما علاقة (لَمْ) النافية بمعنى (لمَّ) للجمع والضم؟.
لو أن العربي أجاز دخول (لَمْ) على الأسماء لما خرجت من معاني (جمْعِ وضمِّ) ما بعدها. ولكن باقتصار دخولها على الأفعال المضارعة، فإن وظيفة لمْ تتحول عن جمع الأشياء وضمها، إلى تجميع مضامين الأفعال فتجمدها وتوقف فعالياتها.
ففي قولنا (لم يذهبْ زيد) أي توقف عن الذهاب وتجمع على نفسه في موقعه، فلم يقم بفعل (الذهاب).
ونظراً لشدة النفي في (لمْ)، أشد أحرف الجزم نفياً، لتآزر خصائص حرفيها في (الجمع والضم)، لم يُجز العربي تعليق مجزومها المنفي على شرط. فلا يقال: ((لم يذهبْ زيدٌ إلا إذا جاء عمرو)).
بينما يصح ذلك مع (لن)، للفارق الكبير بين خصائص (الميم) في نهاية المصادر لمعاني (الجمع والضم)، وبين خصائص (النون) في نهاية المصادر لمعاني (الرقة والخفاء والاستكانة والاستقرار) كما أسلفنا في دراستها. فكان النفي معها أقل حزماً وجزماً مما في (لَمْ).
(لمْ) حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً كقوله تعالى ((لم يلدْ ولم يولدْ))(63). ولم يذكروا لها معنى آخر ولا استعمالاً.
وهذا الفقر المدقع في معاني (لمْ) واستعمالاتها يرجع فيما نرى إلى أمرين اثنين:
1-أن طريقة النطق بصوتي حرفيها: (اللام) من حيث (التصاق) طرف اللسان بسقف الحنك و(الميم) من حيث (ضم الشفة إلى الشفة) قد حدَّت من حرية العربي في التكيف بنطقهما في (لم) فظل معناها بذلك ملتزماً بمحصلة الخصائص الايمائية لحرفيها حصراً. وذلك على العكس من حرفي (لا-ما..) كما سنرى.
2-أن التوافق بين الخصائص الإيمائية لحرفي (اللام والميم) ومعانيهما في (الإلصاق والجمع والضم) قد حدّ من حرية العربي في الخروج من حصار هذه المعاني.
وهكذا يمكن اعتبار (لَمْ) واحدة من المستحاثات اللغوية التي يتوافق معناها التراثي في النفي والجزم مع الخصائص الفطرية لحرفيها في الجمع والضم. شاهد إثبات آخر على بداءة اللغة العربية وفطرتها.
لا حاجة بنا إلى تقصي الخصائص الفطرية لأحرفها ومعانيها، فقد سبق أن استعرضناها جميعاً مما لا يخرج عن معاني (الإلصاق والجمع والضم والامتداد).
ونرى أنه يمكن اعتبارها مؤلفة من كلمتين: (لم+ما)، بما لا يخرج عن محصلة معاني أحرفهما. فلقد سبق الحديث عن خاصية النفي في (لم)، أما (ما) فمن معانيها النفي أيضاً، كما سيأتي.
ولكن (الألف اللينة)) في نهاية (لمّا) تشكل امتداداً صوتيّاً يترجم إلى فاصل زماني أو مكاني. بينهما وبين منفيّها، على مثال ما لحظنا دور (الألف اللينة) في معاني (إلى) لانتهاء الغاية.
فما مدى تأثير هذه (الألف اللينة) في معانيها التراثية؟
هي لدى (ابن هشام والأنطاكي) على ثلاثة أوجه:
1-حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً مثل (لمْ)، نحو: ((لمّا يأتِ زيد)). ولكنها تختلف عن (لمْ) في خمسة أمور.
أ-لا تقترن بأداة شرط. فلا يقال: ((إن لمّا تقم)) على العكس من (لم). إذ قال تعالى ((وإن لم تنتهوا)).
ب-إن منفيَّها مستمر النفي إلى الحال، نحو: ((لمّا يأت زيد))، أي حتى الآن. ولكنه قد يأتي. أمّا (لمْ) فيحتمل نفيها (الاتصال)، أي الاستمرار مثل (لمّا)، كقوله تعالى: ((ولم أكن بدعائك ربّ شقيا))(64)، بمعنى ولا أزال كذلك. كما يحتمل نفيها (الانقطاع)، أي عدم الاستمرار، كقوله تعالى: ((هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً))، ولكنه صار (شيئاً مذكوراً). ولهذا جاز القول: ((لم يكن، ثم كان)). ولا يجوز (لمّا يكن ثم كان). بل يقال ((لمَّا يكن وقد يكون)).
واستمرار النفي في (لمّا) يعود إلى (الألف اللينة) الفاصلة بين (لم) والفعل المضارع المقلوب إلى ماضي فصارت (لمّا)، وأعطت النفي فسحة في الزمن استمرَّ من الماضي إلى اللحظة الحاضرة.
ج-يغلب على منفي (لمّا) أن يكون قريباً من الحال، وعلى منفي (لمْ) أن يكون بعيداً في الماضي. فبما إن منفيَّ (لمّا: يستمرّ إلى الحاضر، فلقد رأى العربي أن يستعمله لنفي الماضي القريب توخياً للتصديق. أما مع (لم) فليس ثمة من داع لهذا التحفظ.
د-إنّ منفي (لمّا) متوقع ثبوته، بخلاف منفي (لمْ). فإذا قلنا: ((لمّا تثمر الشجرة)) فمعناه أن إثمارها متوقع. أما إذا قلنا: (لم تثمر الشجرة)، فإثمارها غيرُ متوقع، لبُعد (عدم إثمارها) في الماضي، على العكس من (لمّا) للماضي القريب.
هـ-إنّ منفي (لمّا) جائز الحذف، نحو: ((اشتريت الكتاب لاقرأه، ولمّا). أي ((ولما أقرأه)). ولا يجوز ذلك في (لم).
وهكذا فإن الاختلاف بين استعمالات (لمْ) و(لمَّا) ومعانيهما ترجع جميعاً إلى الامتداد الصوتي في (الألف اللينة) في (لمّا). وهذا الاختلاف هو من أقوى الأدلة على أن العربي استعمل (الألف اللينة) للفاصل الزماني في (لمّا) وللفاصل المكاني في (إلى)، وإن كان استعملها في أماكن أخرى للحجز والنفي كما سيأتي.
وبذلك تكون (لمّا) مثل (لمْ) إحدى المستحاثات اللغوية، شاهد إثبات على أصالة اللغة العربية وفطرتها.
لقد سبق أن تحدثنا عن (اللام) الجارة، وأرجأنا الحديث عن (اللام) الجازمة إلى أن ترد في زمرتها مع الأحرف الجازمة. وسنرى أن الخصائص الفطرية لـ (اللام) في الإلصاق والالتصاق ستظل ترافقها هنا وأينما وقعت، كما مر معنا في حروف العطف والجر، وكما سيأتي في حروف المعاني التي تشارك في تراكيبها. وثبات معنى الإلصاق في (اللام) وما يماثله من معاني التوصيل والضم والإلزام والالتزام يعود إلى أن هذه الخاصية فيها (إيمائية تمثيلية) لم تتبدل ولم تتغير منذ أبدعت في المرحلة الزراعية إلى يومنا هذا. فكان الأمر مع (اللام) بمعنى الإلزام يتوافق مع خصائص (الإيمائية التمثيلية) الفطرية على الإلصاق.
هي حرف جزم: ((لِيذهبْ زيدٌ إلى الدار)). ولها في المحيط (7) أحكام.
1-هي مكسورة في اللغة المشهورة، مما يزيد من فعاليتها الذاتية. أما بنو سليم فيفتحونها، مما يحدُّ من مغاليظها.
2-يكثر أن تُسكَّن إذا جاءت بعد (الفاء والواو). ونرى أن التسكين أوحى بفعاليتها الذاتية من (الكسرة)، كقوله تعالى: ((فلْيستجيبوا لي ولْيؤمنوا بي))(65).
3-وتسكينها بعد (ثمّ) قليل، نحو: (ثم لْيقضوا) في قراءة الكوفيين، رداً على من قال أنه خاص بالشعر.
4-يجب استعمالها للطلب في موضعين.
أ-إذا كان الفعل مبنياً للمجهول، نحو: ((لِيُعنَ زيدٌ بحاجتي)).
ب-اذا كان الطلب موجهاً لغائب، نحو: ((ليكتبْ زيدٌ درسَه))، إذ ليس للغائب صيغة أمرية.
5-استعمالها للطلب من المخاطب قليل، لأن المخاطب له صيغة أمرية تغني عنها، نحو: ((اكتبْ يا زيد)). فهو أبلغ وأشد حزماً من قولنا: (فلتكتبْ يا زيد)).
6-استعمالها لأمر المتكلم نفسِه قليلٌ لأنه لا حاجة لأن يأمر الإنسان نفسه، كقوله تعالى ((وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اتبعوا سبيلنا ولْنحمِلْ خطاياكم)).
7-وقد تحذف في الشعر ويبقى عملها على ما جاء في (مغني اللبيب)) كقول الشاعر:
|
ولكنْ (يكنْ) للخيرِ منكَ نصيبُ)). |
|
فلا تستطلْ مِني بقائي ومدَّتي |
أي (ليكنْ للخير..)، ومنَعَ المبرِّد حذف (اللام) مع إبقاء عملها حتى في الشعر. ونحن أميل للأخذ برأيه، لأن الفعالية في الأمر تعود إلى (اللام) الظاهرة، وليس الى المقدرة تقديراً.
وبقي أن نلفت الانتباه إلى أن (لام) الطلب، قد تكون (للأمر) كما سبق بيانه. وقد تكون(للدعاء)، نحو: ((ليقضِ علينا ربك))، و(للالتماس))، نحو: ((ليفعلْ فلان كذا)) إذا- لم يرد الاستعلاء عليه، وقد تكون للتهديد كقوله تعالى: ((ومن شاء فليكفرْ))(66).
وهكذا يكون الإنسان العربي قد أفاد من خاصية الإلصاق في (اللام) ليلزم الفاعلُ غيرَه بأمرٍ ما عندما لا يجد لـه صيغة معينة للإلزام، كما إذا كان هذا الأمر يتعلق بغائب، أو كان الفعل مبنياً للمجهول. لتأخذ (اللام) هنا وظيفتها الفطرية في الإلزام ضرباً من ضروب الإلصاق، فتحافظ على معانيها الفطرية في (لام الأمر) أيضاً.
وبذلك تكون (لام الأمر)، هي إحدى المستحاثات اللغوية شاهد إثبات على أصالة اللغة العربية وفطرتها وبداءتها.
لقد سبق أن تحدثنا عن (لا) في فئة أحرف العطف. وذكرنا أن لها سبعة أوجه، منها خمسة للنفي وواحدة (ناهية جازمة)، والسابعة زائدة لا عمل لها.
كما عرضنا أن وظيفتها (النافية- العاطفة) قد تأتَّت من محصلة الخصائص الفطرية لحرفيها- (اللام) للإلصاق، و(الألف اللينة) حاجز صوتي فاصل مانع. ففي قولنا: ((جاء زيد لاعمرو)) قد عملت (اللام) في (لا) النافية، على ربط زيد وعمرو بموضوع المجيء دون سواه من سائر الأعمال والحالات الأخرى. أما (الألف اللينة) فيها، فقد فصَلت حكم ما قبلها عما بعدها. فاقتصر حكم المجيء، على ما قبلها (زيد) فحسب، لجهة اللام منها.
أما في (لا) الناهية فالأمر يختلف قليلاً. فاللام هنا لإلزام الفاعل بفعل معين، ولكن (الألف اللينة) فاصل صوتي يمنع وقوع هذا الفعل. ففي قولنا ((لا تضرب زيداً))، ألزمنا المخاطب بعدم ضرب زيد فحسب. وأطلقنا له الحرية في ضرب من يشاء غيره أو في معاقبة زيد بأية عقوبة أخرى، أو في مكافأته.
تختص (لا) الناهية بالدخول على المضارع، وتقتضي جزمه واستقباله، سواء أَكان المنهيُّ مخاطباً كقوله تعالى: ((لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء))
(67)، أو كان غائباً، كقوله تعالى ((لا يتخذْ المؤمنون الكافرين أولياء))(68)، أو متكلماً، نحو: ((لا رأينّك هنا)).
والنهي هنا ضرب من النفي، لا يفّرق بين المعنيين في حال دخولها على الفعل المضارع إلاّ سياق الحديث ومآل الغرض.
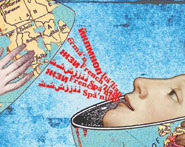
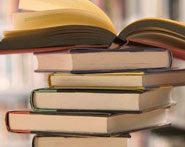

|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|