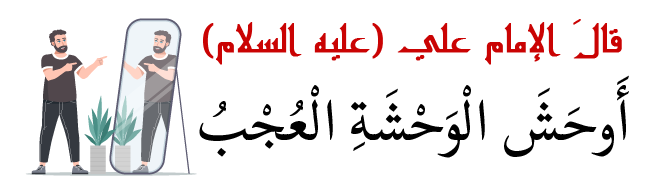
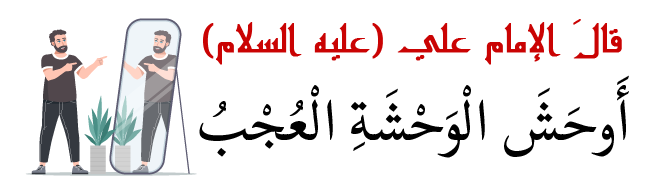

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2018
التاريخ: 28-11-2018
التاريخ: 1-12-2018
التاريخ: 13-11-2018
|
المعجم قائمة لا نظام
وليس المعجم نظامًا من أنظمة اللغة, فهو لا يشتمل على شبكة من العلاقات العضوية والقيم الخلافية, ولا يمكن لمحتوياته أن تقع في جدول يمثل احتباك هذه العلاقات على نحو ما سنرى في أنظمة الأصوات والصرف والنحو. فالمعجم بحكم طابعه, والغاية منه ليس إلّا قائمة من الكلمات التي تسمَّى تجارب المجتمع أو تصفها أو تشير إليها. ومن شأن هذه الكلمات أن تحمل كل واحدة إلى جانب دلالتها بالأصالة والوضع "الحقيقة" على تجربة من تجارب المجتمع, أن تدل بواسطة التحويل "المجاز" على عدد آخر من التجارب, فإذا وضعنا كلمة "المعاني" بدل "التجارب" صحّ لنا أن نقول: إن الكلمة المفردة "وهي موضوع المعجم" يمكن أن تدل على أكثر من معنى وهي مفردة, ولكنها إذا وضعت في "مقال" يفهم في ضوء "مقام" انتفى هذا التعدد عن معناها, ولم يعد لها في السياق إلّا معنى واحد؛ لأن الكلام وهو مجلى السياق لا بُدَّ أن يحمل من القرائن المقالية "اللفظية" والمقامية "الحالية" ما يعيِّن معنًى واحدًا لكل كلمة. فالمعنى بدون المقام "سواء أكان وظيفيًّا أم معجميًّا" متعدد ومحتمل؛ لأن المقام هو كبرى القرائن، ولا يتعيّن المعنى إلّا بالقرينة, ولقد سبق أن أشرت إلى أن علم البيان "وهو علم دلالات المفردات"
يمكن أن يمثل الجانب النظري من "علم المعجم", فيبين كيف تخرج الكلمة عن معناها الحقيقي الوضعي إلى معانٍ أخرى مجازية, ويستمد مادته من تاريخ الاستعمال في اللغة العربية, بل يحسن في هذا الجانب النظري للمعجم أيضًا دراسة أصل الدلالة الحقيقية نفسها بواسطة النظر في طرق العرف والوضع بالارتجال والاقتراض والتعريب ونحوها, مع العناية بوجهة النظر التاريخية التي تبحث في أصول الكلمات المستعملة فعلًا من ناحية البنية, وفي تطور دلالتها على مر العصور. ذلك هو الجانب النظري للمعجم, وهو موزع بين علم البيان وعلم الصرف وعلم المتن وبحوث فقه اللغة وتاريخ الأدب, ولكنه قد آن له الأوان أن يتوحد في علم واحد يسمَّى "علم المعجم", ويتخذ موضوعًا أساسيًّا له طرق المعاجم ومادتها, والمعنى المعجمي -ذلك المتعدد المحتمل. المعجم إذًا جزء من اللغة, ولكنه ليس نظامًا من أنظمة اللغة. هو من اللغة لأنه سجّل لكلماتها ولمعاني هذه الكلمات, وهذه الكلمات ساكنة صامتة بالفعل ولكنها صالحة بالقوة لأن تصير ألفاظًا مسموعة, أو خطوطًا مكتوبة مقروءة في سياق كلام, فالمعجم إذن معين صامت ساكن هادي مستعمل بالقوة لا بالفعل, شأنه في ذلك شأن اللغة كلها؛ حيث عبر عنها أحد العلماء بقوله: إنها(1) Silent reservoire وهذا المعين الاستاتيكي إذا وضع في حالة استعمال وحركة وديناميكية أصبحت النتيجة كلامًا لا لغة. فكلمة "رجل" مثلًا موجودة مختزنة في تجربة الجماعة صامتة صالحة لأن يستعملها الفرد عند الإرادة, فإذا لم يستعملها ظلت صامتة ساكنة هادئة, وهي في هذه الحالة جزء من اللغة لا من الكلام, فإذا نطقها الفرد أو كتبها أخرجها من مجال القوة إلى مجال الفعل, وجعلها جزءًا من الكلام الذي هو نشاط وسلوك.
واللغة العربية بهذا مكونة من ثلاثة أنظمة, وقائمة من الكلمات التي لا تنتظم في جهاز واحد, وهذه الأنظمة والقائمة تكون معينًا صامتًا, فإذا أردنا أن نتكلم أو أن نكتب نظرنا في هذا المعين الصامت فوضعنا محتوياته في حالة عمل وحركة, فأخذنا منه الكلمات ورصفناها على شروط الأنظمة, أي: بحسب قواعد اللغة, وخرجنا من دائرة الصمت اللغوي إلى دائرة النطق الكلامي, أي: من حيز السكون إلى حيز الحركة, ومن حيز الإمكان إلى حيز التطبيق. وحاصل جمع "المعنى الوظيفي" التحليلي, و"المعنى المعجمي" الذي للكلمات, لا يساوي أكثر من "معنى المقال" أو "المعنى اللفظي" للسياق, أو معنى ظاهر النص كما يقول الأصوليون, ولا يزال السياق حتى بعد الوصول إلى هذا المعنى اللفظي بحاجة إلى "معنى المقام" أي: المعنى الاجتماعي الذي يضم القرائن الحالية إلى ما في السياق من قرائن مقالية, وبهذا يتمّ الوصول إلى "المعنى الدلالي".
وسنرى فيما بعد أن "المقام" هو حصيلة الظروف الواردة relevant طبيعية كانت أو اجتماعية أو غير ذلك, في الوقت الذي تَمَّ فيه أداء المقال speech event, أما الظروف غير الواردة irrelevant فلا ضرورة لإرباك خطة تحليل المعنى بذكرها وشرحها, وما دام المعنى على إطلاقه مركبًا على هذا النحو الذي يبدو من تشقيقه, فإنَّ أيّ شق من المعنى لا يكفي بمفرده للإفادة والفهم, فلا يكفي مجرد فهم النظام الصوتي للغة ما لأن نفهم مقالّا بهذه اللغة, بل لا يكفي لذلك حتى فهمنا للنظام الصرفي أو النحوي للغة المذكورة، بل لا يكفي أيضًا أن نفهم المعنى المعجمي لحشدٍ كبير من كلمات هذه اللغة أيضًا لأن نفهم المعنى فهمًا كاملًا ما دام "المقام" غير مفهوم.
ويقع في تجاربنا أحيانًا أن نرى اثنين يعمدان إلى التخصص في لغة أجنبية, فيتخصص أحدهما في اللغة ذاتها, ويتخصص الثاني في أدبها, فأما الذي تخصّص في اللغة فقد طلب موضوعًا يخضع للتقعيد, ومن ثمَّ للفهم السريع وللتحصيل السريع أيضًا, فينجح في مهمته بيسر نسبي, وأما الذي تخصَّص في الأدب فسيجد نفسه وجهًا لوجهٍ مع التحدي الهائل الذي يفرضه فهم المقامات المختلفة التي تقع في إطار ثقافة أجنبية عنه بما تشتمل عليه هذه المقامات من علاقات اجتماعية وعقلية وذوقية وعاطفية دقيقة متشعبة لا يفهمها وينفعل بها إلّا أبناء البيئة ذاتها, ولا يمكن الحصول على بعضها من مجرد قراءة تاريخ هذا المجتمع ولا أدبه، ذلك بأن إطار الثقافة الاجتماعية لكلِّ أمة يفرض من تلك العلاقات والارتباطات بالمواقف وبالموضوعات ما لا يفهمه تمامًا إلّا الناشئون في المجتمع ذاته والثقافة ذاتها, ولو أن المتخصص الأجنبي تمكّن من تحصيل فهم الارتباطات العقلية أو حتى الاجتماعية بالموضوعات والمواقف, فكيف يتسنَّى له مهما حاول أن يفهم الارتباطات الذوقية والعاطفية في المجتمع. وهل يجد غير المسلم وغير العربي في نفسه ما يجده العربي المسلم من فهمٍ وانفعالٍ وارتباطٍ بالقرآن أو الحديث عند قراءتهما مثلًا, فلا شكَّ أن المعنى دون ملاحظة هذه الارتباطات التي يتضح بها المقام ناقص كل النقص.
وهذه المقامات الاجتماعية هي نسيج الثقافة بمعناها الأنثربولوجي الأعمِّ لا بمعناها التربوي الأخص, أي: إنها هي نسيج العادات والتقاليد والأعمال اليومية والفولكلور الشعبي والذاكرة الشعبية, ثم الإحساسات والعواطف الشعبية, ومن ثمَّ لا تخضع هذه المقامات للتقعيد والضبط كما يخضع تقعيد الأنظمة اللغوية, ولكن الباحث مع ذلك يستطيع أن يصل إلى أنواع منها, وأن يرصد ما يستعمل من "مقال" في كل "مقام" بحسب العادة دون أن يدعى لارتباط هذا المقال بما نسب إليه من مقام أي نوع من أنواع الحتمية؛ لأن المقامات والمقالات جميعًا من عمل الإنسان, والإنسان أكثر شيء استعصاء على الضبط والتقعيد, ويكفي للدلالة على ذلك ما ورد في الأثر من قوله: "اتق شر من أحسنت إليه", فلو خضع الإنسان لقاعدة لتوقع المحسن ممن أحسن إليه الخير, ولم يتق منه الشر.
بقي أن نشير إلى أن النظر في المعنى الدلالي نظر في معنى الكلام "لفظًا أو كتابة" بواسطة علمي اللغة والاجتماع, ذلك بأن المعنى الذي ننظر فيه هنا معنى مقالٍ جرى استعماله فعلًا في مقام ما, بالنطق أو بالكتابة, والاستعمال هو الأداء, وهو الكلام بنوعية السمعي النطقي والبصري الكتابي. هذا هو تشقيق المعنى, وقد رأينا أنه ينبني على تشقيق اللغة نفسها, وعلى النظر إلى كل شقٍّ منها باعتباره فرعًا من فروع البحث في المعنى, مما يؤدي في النهاية إلى أن تكون اللغة في عمومها نظامًا عرفيًّا يشرح العلاقة الاعتباطية بين الرمز وبين المعنى من حيث عرفيتها واطرادها. أما تحليل المعنى على المستويات المختلفة فإنه يشغل كل ما يتلو ذلك من صفحات هذا الكتاب, فسننظر أولًا في الطبيعة العملية للدراسة الصوتية, وفي الصلة بين علم الأصوات وبين الدراسات اللغوية, مقدِّمين بذلك لدراسة الفروع التي تتناول المعنى على مستوياته المختلفة؛ كالصوتيات والصرف والنحو, وهي الفروع التي تدرس المعنى الوظيفي, موضحين بعد ذلك طبيعة المعنى المعجمي, ثم معنى المقام, واصلين من كل ذلك إلى المعنى الدلالي.
__________
(1) انظر كتاب دي سو سير.
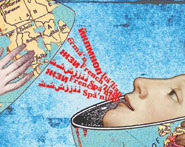
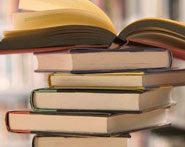

|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|