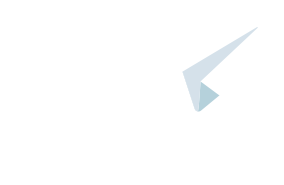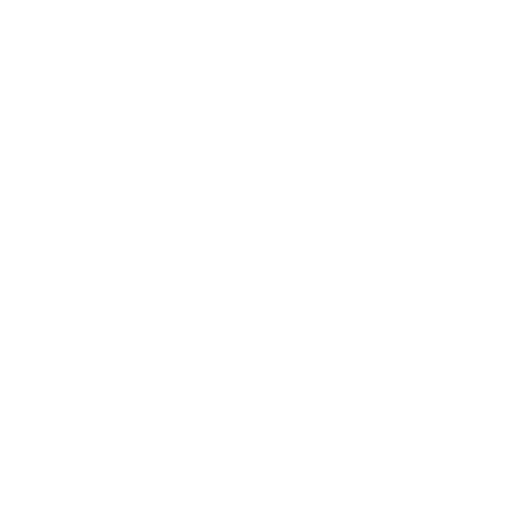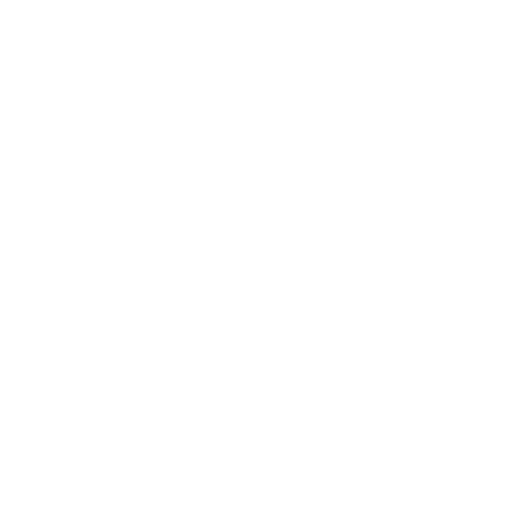تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
أدلة اسقاط حجية ظواهر الكتاب
المؤلف:
السيد ابو القاسم الخوئي
المصدر:
البيان في تفسير القران
الجزء والصفحة:
ص265-271.
17-10-2014
2850
قد خالف جماعة من المحدثين ، فأنكروا حجية ظواهر الكتاب ومنعوا عن العمل به. واستدلوا على ذلك بأمور :
1 ـ اختصاص فهم القرآن :
إن فهم القرآن مختص بمن خوطب به ، وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدة روايات واردة في هذا الموضوع ، كمرسلة شعيب بن أنس ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لابي حنيفة :
« أنت فقيه أهل العراق؟ قال : نعم. قال (عليه السلام) : فبأي شيء تفتيهم؟ قال : بكتاب الله وسنة نبيه. قال (عليه السلام) يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته ، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : نعم. قال (عليه السلام) : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ـ ويلك ـ ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، ويلك ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا (صلى الله عليه واله وسلم ) وما ورثك الله تعالى من كتابه حرفا ».
وفي رواية زيد الشحام ، قال : « دخل قتادة على أبي جعفر (عليه السلام) فقال له : أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال : هكذا يزعمون. فقال (عليه السلام) بلغني أنك تفسر القرآن. قال : نعم. إلى أن قال : يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، يا قتادة ـ ويحك ـ إنما يعرف القرآن من خوطب به ».
والجواب :
إن المراد من هذه الروايات وأمثالها أن فهم القرآن حق فهمه ، ومعرفة ظاهره وباطنه ، وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به. والرواية الاولى صريحة في ذلك ، فقد كان السؤال فيها عن معرفة كتاب الله حق معرفته ، وتمييز الناسخ من المنسوخ ، وكان توبيخ الامام (عليه السلام) لابي حنيفة على دعوى معرفة ذلك. وأما الرواية الثانية فقد تضمنت لفظ التفسير ، وهو بمعنى كشف القناع ، فلا يشمل الاخذ بظاهر اللفظ ، لأنه غير مستور ليكشف عنه القناع ، ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الروايات الصريحة في أن فهم الكتاب لا يختص بالمعصومين : ويدل على ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في المرسلة : وما ورثك الله من كتابه حرفا فإن معنى ذلك أن الله قد خص أوصياء نبيه (صلى الله عليه واله وسلم ) بإرث الكتاب ، وهو معنى قوله تعالى :
{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا } [فاطر : 32] .
فهم المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته ، وليس لغيرهم في ذلك نصيب. هذا هو معنى المرسلة وإلا فكيف يعقل أن أبا حنيفة لا يعرف شيئا من كتاب الله حتى مثل قوله تعالى : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص : 1] .
وأمثال هذه الآية مما يكون صريحا في معناه ، والاخبار الدالة على الاختصاص المتقدم كثيرة جدا ، وقد تقدم بعضها.
2 ـ النهي عن التفسير بالرأي :
إن الاخذ بظاهر اللفظ من التفسير بالرأي ، وقد نهى عنه في روايات متواترة بين الفريقين.
والجواب :
إن التفسير هو كشف القناع كما قلنا ، فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره ، لأنه ليس بمستور حتى يكشف ، ولو فرضنا أنه تفسير فليس تفسيرا بالرأي ، لتشمله الروايات الناهية المتواترة ، وإنما هو تفسير بما تفهمه العرف من اللفظ ، فإن الذي يترجم خطبة من خطب نهج البلاغة ـ مثلا ـ بحسب ما يفهمه العرف من ألفاظها ، وبحسب ما تدل القرائن المتصلة والمنفصلة ، لا يعد عمله هذا من التفسير بالرأي ، وقد أشار إلى ذلك الامام الصادق (عليه السلام) بقوله : إنما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الاوصياء فيعرفونهم. ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الائمة : ، مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك ، ولزوم الانتهاء إليهم ، فإذا عمل الانسان بالعموم أو الاطلاق الوارد في الكتاب ، ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الائمة (عليهم السلام) كان هذا من التفسير بالرأي ، وعلى الجملة حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة والمنفصلة من الكتاب والسنة ، أو الدليل العقلي لا يعد من التفسير بالرأي بل ولا من التفسير نفسه ، وقد تقدم بيانه ، على أن الروايات المتقدمة دلت على الرجوع إلى الكتاب ، والعمل بما فيه. ومن البين أن المراد من ذلك الرجوع إلى ظواهره ، وحينئذ فلا بد وأن يراد من التفسير بالرأي غير العمل بالظواهر جمعا بين الادلة.
3 ـ غموض معاني القرآن :
إن في القران معاني شامخة ، ومطالب غامضة ، واشتماله على ذلك يكون مانعا عن فهم معانيه ، والاحاطة بما أريد منه ، فإنا نجد بعض كتب السلف لا يصل إلى معانيها إلا العلماء المطلعون ، فكيف بالكتاب المبين الذي جمع علم الاولين والاخرين.
والجواب :
أن القرآن وإن اشتمل على علم ما كان وما يكون ، وكانت معرفة هذا من القرآن مختصة بأهل بيت النبوة من دون ريب ، ولكن ذلك لا ينافي أن للقرآن ظواهر يفهمها العارف باللغة العربية وأساليبها ، ويتعبد بما يظهر له بعد الفحص عن القرائن.
4 ـ العلم بإرادة خلاف الظاهر :
إنا نعلم ـ إجمالا ـ بورود مخصصات لعمومات القرآن ، ومقيدات لإطلاقاته ، ونعلم بأن بعض ظواهر الكتاب غير مراد قطعا ، وهذه العمومات المخصصة ، والمطلقات المقيدة ، والظواهر غير المرادة ليست معلومة بعينها ، ليتوقف فيها بخصوصها. ونتيجة هذا أن جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون مجملة بالعرض ، وإن لم تكن مجملة بالأصالة ، فلا يجوز أن يعمل بها حذرا من الوقوع فيما يخالف الواقع.
والجواب :
أن هذا العلم الاجمالي إنما يكون سببا للمنع عن الاخذ بالظواهر ، إذا أريد العمل بها قبل الفحص عن المراد ، وأما بعد الفحص والحصول على المقدار الذي علم المكلف بوجوده إجمالا بين الظواهر ، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي ، ويسقط عن التأثير ، ويبقى العمل بالظواهر بلا مانع. ونظير هذا يجري في السنة أيضا ، فإنا نعلم بورود مخصصات لعموماتها ، ومقيدات لمطلقاتها ، فلو كان العلم الاجمالي مانعا عن التمسك بالظواهر حتى بعد انحلاله لكان مانعا عن العمل بظواهر السنة أيضا ، بل ولكان مانعا عن إجراء اصالة البراءة في الشبهات الحكمية ، الوجوبية منها والتحريمية ، فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة ، ولازم هذا العلم الاجمالي وجوب الاحتياط عليه في كل شبهة تحريمية ، أو وجوبية يقع فيها مع أن الاحتياط ليس بواجب فيها يقينا. نعم ذهب جمع كثير من المحدثين إلى وجوب الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية ، إلا أن ذلك نشأ من توهمهم أن الروايات الامرة بالتوقف أو الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط والتوقف في موارد تلك الشبهات. وليس قولهم هذا ناشئا من العلم الاجمالي بوجود التكاليف الالزامية في الشريعة المقدسة ، وإلا لكان اللازم عليهم القول بوجوب الاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية ، مع أنه لم يذهب إلى وجوبه فيها أحد فيما نعلم. والسر في عدم وجوب الاحتياط في هذه الموارد وفي أمثالها واحد ، وهو أن العلم الاجمالي قد انحل بسبب الظفر بالمقدار المعلوم ، وبعد انحلاله يسقط عن التأثير. ولتوضيح ذلك يراجع كتابنا أجود التقريرات.
5 ـ المنع عن اتباع المتشابه :
إن الآيات الكريمة قد منعت عن العمل بالمتشابه ، فقد قال الله تعالى :
{مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [آل عمران : 7] .
والمتشابه يشمل الظاهر أيضا ، ولا أقل من احتمال شموله للظاهر فيسقط عن الحجية.
الجواب :
إن لفظ المتشابه واضح المعنى ولا إجمال فيه ولا تشابه ، ومعناه أن يكون للفظ وجهان من المعاني أو أكثر ، وجميع هذه المعاني في درجة واحدة بالنسبة إلى ذلك اللفظ ، فإذا أطلق ذلك اللفظ احتمل في كل واحد من هذه المعاني أن يكون هو المراد ، ولذلك فيجب التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعيين ، وعلى ذلك فلا يكون اللفظ الظاهر من المتشابه.
ولو سلمنا أن لفظ المتشابه متشابه ، يحتمل شموله للظاهر ، فهذا لا يمنع عن العمل بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على اتباع الظهور من الكلام ، فإن الاحتمال بمجرده لا يكون رادعا عن العمل بالسيرة ، ولا بد في الردع عنها من دليل قطعي ، وإلا فهي متبعة من دون ريب ، ولذلك فإن المولى يحتج على عبده إذا خالف ظاهر كلامه ، ويصح له أن يعاقبه على المخالفة ، كما أن العبد نفسه يحتج على مولاه إذا وافق ظاهر كلام مولاه وكان هذا الظاهر مخالفا لمراده. وعلى الجملة فهذه السيرة متبعة في التمسك بالظهور حتى يقوم دليل قطعي على الردع.
6 ـ وقوع التحريف في القرآن :
إن وقوع التحريف في القرآن ، مانع من العمل بالظواهر ، لاحتمال كون هذه الظواهر مقرونة بقرائن تدل على المراد ، وقد سقطت بالتحريف.
والجواب :
منع وقوع التحريف في القرآن ، وقد قدمنا البحث عن ذلك ، وذكرنا أن الروايات الامرة بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهدة على عدم التحريف ، وإذا تنزلنا عن ذلك فإن مقتضى تلك الروايات هو وجوب العمل بالقرآن ، وإن فرض وقوع التحريف فيه. ونتيجة ما تقدم أنه لا بد من العمل بظواهر القرآن ، وأنه الاساس للشريعة ، وأن السنة المحكية لا يعمل بها إذا كانت مخالفة له.
 الاكثر قراءة في التحريف ونفيه عن القرآن
الاكثر قراءة في التحريف ونفيه عن القرآن
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












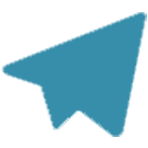
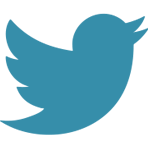

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)