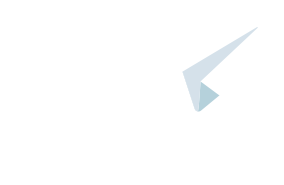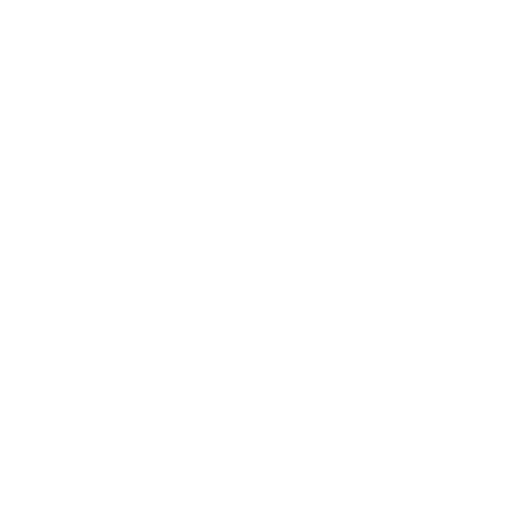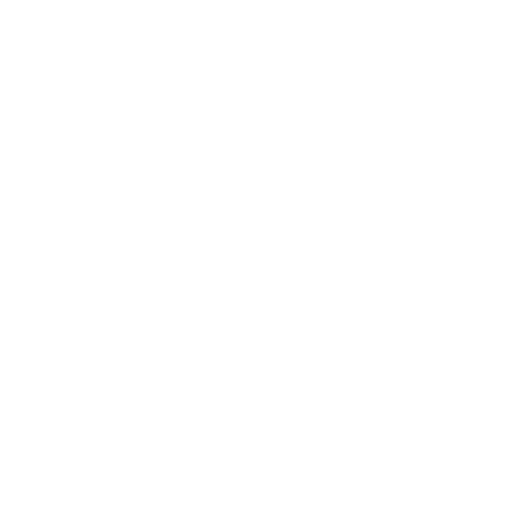الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
الجنوح عند الأحداث
المؤلف:
د. محمد أيوب شحيمي
المصدر:
مشاكل الاطفال...! كيف نفهمها؟
الجزء والصفحة:
ص197 ــ 207
2023-04-03
2877
يُعرف بعض العلماء أن جنوح الأحداث، هو ارتكاب الخطأ، أو الفشل في أداء الواجب، أو العمل السيء، أو خرق القانون، ويعرفه عالم النفس (انجلش)، بأنه (انتهاك بسيط نسبياً للقاعدة القانونية أو الأخلاقية)(1)، فيصار بعد ذلك إلى وضعهم في إصلاحيات أو في مدارس تابعة لها لتقويم اعوجاجهم وإرشادهم وإعادة تأهيلهم للمشاركة في الحياة الاجتماعية والأسرية.
ومن الملامح النفسية الدالة على الجنوح عند الأطفال، المظاهر التالية:
أ- الاستغراق في أحلام اليقظة والشرود الذهني، والسرحان.
ب- التجهم والعبوس وعدم الضحك، والإكثار من الأنين والشكوى.
ج- السقم واعتلال الصحة.
د- الانطوائية والبعد عن الرفاق، وعدم المشاركة في النشاطات.
ومشكلة الجنوح تزداد تعقيداً مع تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتمثل بالفقر. وتعود أحياناً إلى أسباب تربوية، حيث تعتمد أساليب القسوة بحق الطفل فيؤثر ذلك على نزعته العدوانية.
في الولايات المتحدة، رأت المحاكم أن علاج بعض الأحداث يفضل أن يكون عن طريق منازل التبني أفضل مما لو كان في المؤسسات الإصلاحية. ومنازل التبني هذه تكون في بيوت الطبقة الميسورة التي تؤمن للطفل أجواء أسرية سليمة فيحسن حاله، ويرتدع عن الجنوح ويمارس حياته بشكل ناضج فيما بعد.
وتسهم وسائل الإعلام على اختلافها، وعلى رأسها التلفزيون في تفشي ظاهرة الجنوح بين الأطفال، وإن كان بعض الباحثين الأميركيين يذهب إلى القول بعكس ذلك حيث يشير إلى (أن الطفل المتكيف تكيفاً حسنا سوف يتحمل التوتر المتراكم الناتج عن برامج التلفزيون العنيفة، لكن الطفل قليل التكيف الانفعالي سوف لا يتحمل ذلك التوتر)(2)، وهذا ما يقلل، في نظرهم من تأثير التلفزيون على الجنوح، ويعيد الكرة إلى الوسط العائلي، حيث تتشكل في المنزل النواة الأولى للتكيف الاجتماعي، التي تنمو شيئاً فشيئاً لتتحول إلى توافق عام مع المجتمع.
وهناك بعض الآراء التربوية والاجتماعية الحديثة التي تدعو صراحة إلى أن الطفل يجب أن يأخذ صورة حقيقية عن العالم بما فيه من العنف والجريمة، على أن تعرض هذه الحقائق بصورة معتدلة، وعلى ألا يقدم ذلك بصورة مغرية وجذابة، كما لا ينبغي أن تقدم الجريمة في كل ذلك بدون عقاب، لتبقى الخلاصة حية في نفس الطفل، إذ أن الأمور دائماً في خواتمها.
ويحتاج الأمر في نظرنا إلى تضافر الجهود من قبل الآباء والمدرسين، والمسؤولين عن الإعلام بجميع فروعه، لتكوين ورشة عمل تعمل، بتنسيق متكامل في نطاق المحلات الكبرى والصغرى، من خلال الندوات والمحاضرات، للتصدي لمسألة الجنوح وتسهيل إقامة أماكن النشاطات العامة كالملاعب والحدائق العامة، وإنشاء المكتبات وتسهيل العمل فيها، وتشجيع الهوايات الفنية على اختلافها.
ويلعب الإرشاد النفسي دوراً هاماً في هذا المجال، لناحية الوقاية والعلاج، ويرجع له الفضل في علاج وإعادة تأهيل وتكيف الغالبية العظمى من الجانحين، مع المجتمع.
- لا يكفي لإصلاح الخلل الاجتماعي الذي يؤدي إلى الجنوح، أن نلتفت إلى ناحية واحدة ـ فلابد - كما هو معروف، من تضافر جميع الجهود المعنية بهذا الأمر، والتي تشمل الكثير من المؤسسات من أن تتعاون في ما بينها من أجل تحقيق مجتمع لا يجد فيه الجنوح أرضاً خصبة.
- ولو حاولنا أن نستعرض هذه المؤسسات، لطالعتنا في الدرجة الأولى المؤسسة النواة الاجتماعية الأولى (الأسرة)، وقد كثر الحديث عن ضرورة تنظيم الأسرة، وخلق الأجواء الأسرية الصالحة لنمو الفرد نفسياً بطريقة تقيه الوقوع في التطرف والجنوح.
ورأينا من خلال دراسة أكثر من مشكلة تربوية أن السبب الجوهري الكامن وراءها هو الاضطرابات الأسرية الحادة.
تلي الأسرة في الأهمية، المدرسة، وهي المؤسسة التي تقوم بدور بالغ في تصدير الإنتاج البشري المثقف، فبين جدرانها وعلى مقاعدها تتكون مجتمعات المستقبل، وهي تبني معالم الحياة الاجتماعية المستقبلية
بعدها يأتي دور المستشفيات، والعيادات، والمستوصفات، أو ما يسمى بالجهاز الصحي فلا مجتمع سليم بدون صحة سليمة، فقيام هذه المؤسسات الطبية بدورها كاملاً في تخليص الأطفال من الأوبئة والأمراض الفتاكة، ووقايتهم وإرشادهم وإرشاد ذويهم، وتثقيفهم بالثقافة الصحية، كل ذلك يعمل على تحسين وتدعيم المجتمع السليم، الذي يمكن أن يفتك به المرض كما يفتك به الجهل، وكل من الجهل والمرض يؤديان إلى الجنوح بل وإلى الجرائم الكبرى أحياناً.
ـ ثم يأتي دور دُور العبادة، أو دور علماء الدين المشرف عليها، ولا يخفى ما للدين ولعلماء الدين من أثر في الإسهام في بناء المجتمع السليم والتصدي للآفات التي تهدد المجتمع. وهذه الآفات لا تتمكن من متابعة طريقها إلا في ظل التردي الأخلاقي والاستهتار القيمي بمبادئ الدين والابتعاد عن الله وتعاليمه.
وعلماء الدين، هنا ليسوا مجرد مبشرين للقيام بطقوس دينية معينة، وممارسة مهمات طقسية محضة، هم قادة روحيون، يزرعون الفضيلة وحب الخير والإيمان في نفوس الناشئة. ثم يسلطون الأضواء على الشر والحرية والرذيلة، ويشرحون نظرة الدين إليها، ثم وجوب الابتعاد عنها.
وفي هذا المجال لا يقل دور علماء الدين عن دور المدرسين والآباء، وقد يكون دورهم أكثر فعالية لما يحيطهم به المجتمع من احترام وتقدير وإجلال، لارتباط عملهم بكتاب الله وسنة رسوله، ثم لأنهم نذروا أنفسهم طائعين لهذه المهمة الانسانية الرفيعة.
وللوسط السكاني، تأثيره أيضاً، حيث ازدحام السكان، وخاصة في المدن، وحيث التصاق الأبنية ببعضها، وتقارب الشقق السكنية، حيث لا يوجد مجال حيوي يمارس الطفل فيه نشاطه، إذ ليس له سوى سلالم البنايات ومداخلها فلا حدائق، ولا ملاعب، وحيث الصداقات بين الأطفال محدودة ومفروضة بحكم التجاور والتساكن، فلا اختيار ولا إرادة للطفل، أو لأهله، إنه الأمر الواقع، وبذلك تنتشر العادات والعدوى الاجتماعية تتفاقم مع الاختلاط.
يضاف إلى ذلك البرامج التلفزيونية - التي أشرنا إليها - وهي المحرضة أحيانا وبطريقة لا مباشرة على أعمال التطرف والجنوح فيجد الأطفال أنفسهم مسوقين إلى ذلك على غير رغبة منهم.
ويزداد الأمر سوءاً إذا كان الواقع السكني في أحياء فقيرة، حيث تنتشر الأوبئة ومعها العادات السيئة، فإن جرثومة الجنوح تنمو بشكل سريع في هذه البيئات، ويمكن للمواصلات على أنواعها أن تخفف من حدة جنوح الأطفال، حيث يرتبط الحي والقرية بالأحياء والقرى الأخرى، حيث يسهل الانتقال وتبادل المعرفة والثقافة.
ولكن، لهذه المواصلات تأثيرات سلبية (وكأنها سلاح ذو حدين)، حيث إن الانفتاح على المدن وسهولة الاختلاط تنقل إلى الريف البريء الطاهر، بعض أشكال التطرف الذي تروج سوقه في المدينة، فتفسد طباع الأطفال في القرية، وتشوه براءتهم ببصمات المدينة وعاداتها السيئة التي تنتقل إليهم على أنها (أمور حضارية)، وهي في الواقع فسق وفجور، وبذور انحلال وتفكك تقود إلى الجريمة.
كذلك فإن لسياسة الدولة دوراً في تشجيع الانحراف والجنوح، وبطريقة غير مباشرة فالتساهل مع الجانحين وعدم الاهتمام بهم، وإهمال ضبط الأمن والاشراف التام على الممتلكات يشجع على القيام بالأعمال الانحرافية، فحين يتأكد الجانحون أن يد السلطة لن تصل إليهم وأنهم سيكونون بمنأى عن العقاب، لن يترددوا في القيام بأعمالهم الانحرافية. وباختصار فالسلطة الرادعة الحازمة تقلل من فرص الانحراف إلى حد بعيد.
وتقوم الدولة بدور هام في بث روح المواطنية الصحيحة والمفاهيم الواقعية المعاصرة وعدم اللجوء إلى التطرف من أي نوع كان، ومنع التلاعب بمشاعر وعواطف الناشئة، بقصد إبعادهم عن القيم الانسانية والوطنية والقومية، وسهر السلطة على راحة الناس، من شأنه أن يخفف من شعورهم بالقلق ويبعث في نفوسهم الاطمئنان حيث لا يعود هناك جنوح أو انحراف.
وأن العدالة في التعامل مع الجميع على قدم المساواة، وعدم تفضيل فئة على فئة أو تحكم فئة صغيرة بمصير باقي الفئات، كل ذلك من شأنه أن يخفف من الشعور بالنقمة التي تعتبر النواة النفسية الأولى أو (الجرثومة الأولى)، للجنوح ثم إنه بمناقشة الأمور بجدية وبروح ديمقراطية صحيحة يمكن لبذور التطرف والانحراف أن تزول لتحل محلها بذور الإبداع، وذلك عن طريق الحوار والنضال المشروع من أجل الأفضل.
هناك فئة من الناس متخصصة في زرع الفتنة وبذور الشقاق في المجتمع، والدعوة الضمنية إلى الجنوح، وتعتمد هذه الفئة على التيئيس وإحباط الهمم وإقناع الناس بأنه لا سبيل إلى الإصلاح، وأن الأمور لن تعود إلى جادة الصواب، فالآمال انتهت، والتشاؤم هو سيد الموقف، والحياة للأقوى، ويعبرون عنها بتعبيرات وحشية من مثل قولهم (إن لم تكن ذباً أكلتك الذئاب)، فتأمل في هذا التعبير، إنه دعوة علنية لأن تكون ذئباً أو كالذئب على الأقل(...).
إن هذه الصورة الاجتماعية المرعبة يراها الأطفال، فتسبب لديهم الإحباط القاتل، فيفكرون بالانحراف ويسهل عليهم تقبله في ظل هذه الأجواء ويبدأ التفكير بالثورة، وهي الثورة العشوائية هنا، الثورة المدمرة غير المنظمة غير الهادفة، الثورة المبطنة بالعدوانية والفوضى، تستميل الأطفال، فيرون فيها الخلاص من إحباطاتهم، ولكن متى كان الإصلاح يقوم على التدمير والفوضى والقضاء على المنجزات الحضارية؟!.
والحقيقة (أننا نقع فريسة للتضليل فتستثار مشاعرنا وعواطفنا، وتوجه توجيها مزيفاً نحو العنف الذي يرتكبه بعض الفقراء والبؤساء الذين لا حول لهم ولا قوة)(3).
هناك موجات من الانحراف والجنوح يعود سببها إلى الموجات الوافدة إلينا من الغرب، من أجل ذلك ينبغي أن تقوم رقابة على الأفلام المعروضة في السينما والتلفزيون وأشرطة الفيديو، والتي هي اليوم في متناول الجميع وكلها تحرض على العبثية، والفوضى الاجتماعية، والتحلل الخلقي والديني ونشر الفساد في المجتمع، وهذه كلها مجتمعة تحدث نوعاً من الانحراف عند الأحداث الذين لم تترسخ القيم في نفوسهم بعد.
إننا نسمع في كل يوم عن موجات جديدة من الأساليب المعتمدة في الغرب المفكك النظام الأسري، تغزو مجتمعاتنا. وأبوابنا - وبكل أسف - مفتوحة على مصراعيها، لاستقبال كل جديد، أياً كان نوع هذا الجديد، وذلك بتأثير عقدة النقص المتأصلة في داخلنا تجاه العالم الغربي وتفوقه. ويغيب عن بالنا ذلك الوضع المتردي الذي يعيشه الغرب اليوم اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً.
هذه الموجات الوافدة تأتينا بأشكال مختلفة، فتارة عن طريق الكتب الرخيصة أو الأفلام، وطوراً عن طريق (الموضة أو الموديل) وأحياناً أخرى عن طريق العادات والتقاليد التي لا تمت إلى تراثنا، وإلى تاريخنا العربي الشرقي بأية صلة.
والأخطر من ذلك، أن هذه الأدوات التدميرية، لم تصدر إلينا عبثاً، فهي ذات هدف مسبق. فبحجة التسويق التجاري العادي، فهي تفتك بالإنسان فتكاً ذريعاً فتحوله إلى آلة تعمل تحت سلطة وإمرة مصمم الأزياء في العواصم الغربية فالأزياء المستوردة الفاضحة التي ترتديها بعض الفتيات، تخدش الحياء تحت شعار - الحضارة والرقي- ليست سوى حضارة مزيفة.
الجميع مدعوون لمواجهة هذه الظواهر، وعلى رأسها الأسرة (فهي مسؤولة عن تكوين أخلاقيات الفرد بشكل عام، كاتجاهاته نحو الأمانة أو النزاهة أو الصدق، أو الوفاء، أو بقية قيمه الأخلاقية)(4)، ومن دراسة أجراها (هيلي)، في مدينة شيكاغو الأميركية يتبين (أن البيت غير الملائم كان يشكل نسبة 22%، من مجموع العوامل التي لها صلة بالجنوح عند الأحداث، وارتفعت النسبة إلى 46%، بعد ضعف الضبط عند الوالدين)(5)، وعلى ذلك فالبيوت المتصدعة أو المحطمة هي التي تتسبب بنسب كبيرة في الانحرافات، ومواصفات هذه البيوت أن الأب يغيب عنها أو الأم أو كليهما، أو التي ينعدم بها الضبط الاجتماعي نتيجة جهل الوالدين.
ويرى بعض الباحثين أنه (قد يكون للمدرسة نافذة أخرى يتسلل منها الانحراف وهي ظاهرة الهروب من المدرسة، فهي الخلفية التي تقوم وراء غالبية حالات الجنوح)(6). فللمدرسة دور كبير في حماية الأطفال من الجنوح، وبناء على ذلك، فعلى المدرسة أن تكون ذلك البيت الهادئ المريح الذي يقدم البرامج الممتعة والمشوقة وبين جدران هذا البيت تتفتح الطاقات والإمكانيات، ويجب أن تكون هذه المدرسة مزودة بمدرسين أخصائيين في شؤون الأحداث، ومن القادرين على التعامل معهم بروح أبوية تنفذ إلى أعماقهم وأحاسيسهم:
والعقوبة القاسية (غالباً ما تعزل الأطفال الذين تتم معاقبتهم وتجعلهم يضمرون العداء للمجتمع)(7)، وذلك يؤدي حتماً لدفعهم إلى الانحراف، لأنهم يجدون أنفسهم بين طريقين، فإما ارتكاب أنواع أخرى من الانحراف، أو أن يجدوا التقدير والتفهم لحالاتهم فيكفون عنه من تلقاء أنفسهم، والذي يؤكد ذلك أن الحدث الجانح يعتمد على قبول الأحداث الجانحين الآخرين له، لذلك يقع تحت تأثيرهم، لأنه يجد فيهم وبهم الملاذ الوحيد له في عزلته، وبذلك يصبح حدثاً جانحاً، على غير رغبة منه في ذلك.
والفعاليات التربوية والاجتماعية تعي تماماً أن البطالة أم الرذيلة، وإن رأس الكسلان معمل الشيطان، من أجل ذلك يقتضي إيجاد فرص العمل المنتج أمام الجميع من القادرين على العمل، فيمكن للمخيمات التطوعية والكشفية القيام بنشاطات مفيدة من شأنها أن تعود الأطفال على الانخراط في عمل منظم، ومنتج، وفي نفس الوقت، فإن الحياة الكشفية تساعد الطفل على الفهم، وبرمجة الحياة والحياة الكشفية هي الحياة العامة بصورتها المصغرة، فمن نجح فيها نجح في حياته فيما بعد. ولا بأس كذلك في إشراك الأطفال في أسبوع النظافة، ومساعدة شرطة المرور في مهمتهم لفترة من الوقت خلال العطل المدرسية، أو الاسهام في الأعمال الزراعية، كقطف الزيتون والعنب وغيرها، في عمل تطوعي يستمر لعدة أيام كل ذلك يقطع الطريق أمام الانحراف، الذي لا ينمو إلا في الأرض الخصبة، والارض الخصبة لنموه هي الفراغ واليأس، والفوضى، وعدم الإشراف المباشر على الطفل بالإضافة إلى ما ذكرناه من ترك الساحة خالية أمام (الحضارة)، الوافدة إلينا من الغربيين والتي تحمل السم في الدسم.
ثم إنه من المفيد أيضاً الإكثار من الندوات والمحاضرات واللقاءات، التي تطرح فيها موضوعات تربوية مفيدة تسلط الأضواء على بعض المشكلات الانحرافية وخطرها عل الفرد والمجتمع بغية تجنبها والابتعاد عنها.
وفي مواجهة الجنوح عند الأحداث (تتساعد التربية وعلم النفس في موضوع الولد الجانح كما في موضوع الولد العادي، وتتضافر الجهود مع الاستعانة بالتقنيات المستخدمة في علم نفس الطفل لتشكل ما يسمى بعلم النفس التربوي العلاجي)(8).
ولا نستطيع الفصل بين هذين القطبين الهامين اللذين ندرسهما معاً، وبشكل مواز، كما لا نستطيع أن نفصل بين عملية النمو الفسيولوجي للطفل، والقدرات والمواهب، والذكاء. والذي يجب أن نعرفه عن الطفل المنحرف (إن كل طفل منحرف يختلف بانحرافه عن الطفل الآخر، لناحية تاريخه، وتركته الماضية بيولوجياً واجتماعيا وفي طريقة بحثه عن إشباع رغباته وطريقة توجهها)(9).
وكل طفل يرغب بالانفلات، ولكن في مواقع مختلفة، وبدرجات مختلفة، وترتبط رغباته، أو تتجدد بصورة عامة بمفهوم الرغبة والألم. وفي كل ذلك يتأثر الطفل بأمه أو بمن ينوب عنها و (تختلف الأمهات في هذا المجال، بين أم ضالة، وأم متواكلة، وأم حاضنة عطوفة أو أم مفرطة في الرعاية الزائدة)(10)، والأم المتيقظة هي التي ليست بحاجة إلى ذكاء خارق، أو ثقافة عميقة لتكون جديرة بمعرفة كل شيء عن سوابق أطفالها.
والطفل بدوره لا يمكن أن يكون نموذجياً، فهو يعبر عن صيغة التعايش التي تحصل بين أبويه.
ويجب الاشارة إلى أن التربية ليست مجرد عملية تقليد، كما في حركات القردة والطفل فضلاً عن التقليد، فهو يشكل ذاته، ليجري في المجرى الاجتماعي الذي يقدم له، فهو يسمع، ويقلد في الحدود التي تسمح بها إمكانياته العضلية والتعبيرية - وهذا ما يميز الطفل عن القرد - في هذا المجال. من أجل ذلك يتأخر الطفل البشري عن طفل القردة في الاستجابة لمن يحيط به هو سيبقى (قرداً)، ولكن بتأثيرات ومشاعر إيجابية ليكتسب شخصية ناصعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ د. عبد الرحمن العيسوي، الارشاد النفسي، ص 275.
2ـ المصدر السابق، ص 277.
3ـ د. سامية محمد جابر، الانحراف والمجتمع، ص 64.
4ـ د. محمد سلامة محمد غباري، الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين، ص 121.
5ـ المصدر السابق، ص 122.
6ـ المصدر السابق، ص 159.
7ـ المصدر السابق، ص 235.
Andre Beley, Lenfant instable, p ‘27 (8)
Memeref p.28 (9)
Andre Beley Lenfant instable, page 30(10)
 الاكثر قراءة في مشاكل و حلول
الاكثر قراءة في مشاكل و حلول
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












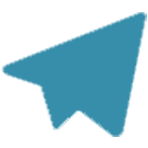
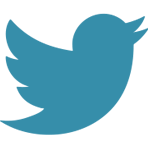

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)