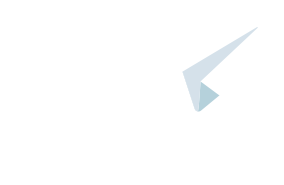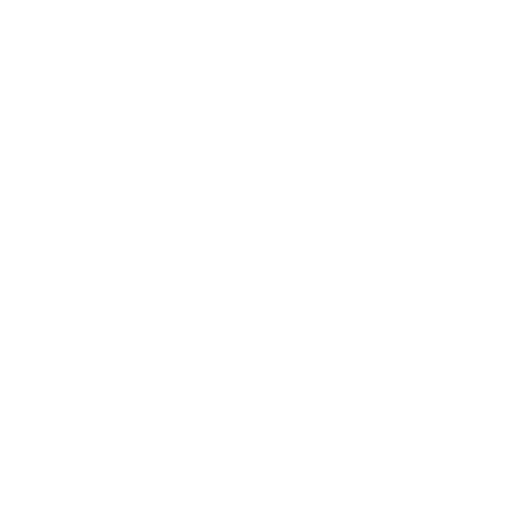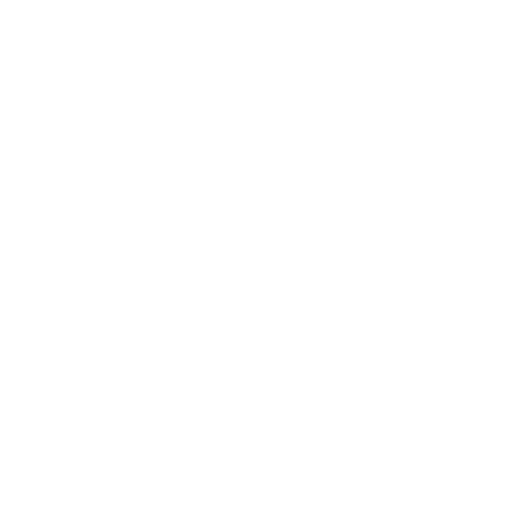تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
الظاهر والباطن عند الطباطبائي
المؤلف:
الشيخ عارف هنديجاني فرد
المصدر:
علوم القرآن عند العلامة آية الله السّيّد محمد حسين الطّباطبائيّ (قده) «دراسة مقارنة»
الجزء والصفحة:
ص 156 - 166 .
17-11-2020
14075
يقول الطباطبائي : «إن القرآن الكريم بألفاظه وبيانه ، يوضح الأغراض الدينية ، ويُعطي الأحكام اللازمة للناس في الإعتقادات والعمل بها ، ولكن لا تنحصر أغراض القرآن بهذه المرحلة ، فإن في كنه هذه الألفاظ وهذه الأغراض ، تستقر مرحلة معنوية ، وأغراضٌ أكثر عمقاً» . . فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في القرآن : ظاهره أنيق وباطنه عميق (1) ، ويقول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن القرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطن ، إلى سبعة أبطن» (2) ، فالأصل في هذه الروايات هو التشبيه الذي قد ذكره الله تعالى في سورة الرعد (3) ، والذي يشبه فيه الإفاضات السماوية بالمطر الذي يهطل من السماء . . .» (4) .
لا شك في أن ما يعرض له الطباطبائي في موضوع الظاهر والباطن ليس جديداً عنده ، وإنما هو حقيقة إسلامية أشار إليها القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد : 3] ، وقد اختلفت التأويلات بشأن هذه الآية ، فمن الفرق من ذهب إلى القول بالباطنية متجاوزاً للظاهر نهائياً ، ومن الفرق من ذهب إلى القول بالباطن والظاهر معاً ، وأنه ما من ظاهر إلاّ وله باطن . والمدرسة الإمامية التي ينتمي إليها المفسّر تقول بالباطن والظاهر معاً ، وتعمد إلى تأويل الآيات والأحاديث وفاقاً لما يتناسب مع ظاهر الشريعة ، ولا ترى أن للباطن طريقته للتعبير عنه ، كما فعلت الصوفية وأصحاب القطب وغيرهم ، ممن اعتبرهم الطباطبائي قد جانبوا الصواب ، وهذا ما أشار إليه في مقدمة كتابه الميزان (5) ، ثم عقب على كلامه موضحاً في تفسيره للآيات في المجلد الخامس من تفسيره (6) ، إذ هو يرى أن المتصوفة انشغلوا بالسير في باطن الخلقة دون عالم الظاهر ، خلافاً لقوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ . . . ﴾ [فصلت : 53] ، فهم ـ أي الصوفية ـ اهتموا بالتأويل ورفضوا التنزيل . . . حتى آل الأمر بهم إلى تفسير الآيات بحساب الجمل ، ورد الكلمات إلى الزبر والبينّات والحروف النورانية والظلمانية ، إلى غير ذلك (7) .
وإذا كان الطباطبائي لم يفرد بحوثاً خاصة في تفسيره للظاهر والباطن على طريقة أهل السير والأسرار ، فذلك لم يمنعه من وضوح الرأي والموقف فيما يتعلق بهذا الموضوع ، لكونه يشكل جانباً مهماً من الأحاديث النبوية ، كما في الحديث الذي عرض له الطباطبائي في مقدمة تفسيره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أن للقرآن ظهراً وبطناً ، وكما في الحديث عن علي (عليه السلام) : «ما من آية إلاّ ولها أربعة معان : ظاهر وباطن وحد ومطلع ، فالظاهر التلاوة ، والباطن الفهم ، والحد هو أحكام الحلال والحرام ، والمطلع هو مراد الله من العبد بها» (8) . فهناك أحاديث وروايات كثيرة يرويها الشيعة الإمامية ، ويفسّرها الطباطبائي ، ولكنه يُبقي عليها في الرؤية المعنوية التي تستقر عندها ، على اعتبار أن القرآن بألفاظه وبيانه يُعطي الأحكام اللازمة للناس في الاعتقاد والعمل بها ، ثم يتم العبور إلى الباطن من خلال الشريعة ، وهذا ما فهمه عنه المستشرق هنري كوربان (9) ، وكثير من الباحثين والمفسرين (10) . وكما نلاحظ في تفسير الميزان ، أن منهج الطباطبائي في تفسير القرآن بالقرآن عكس الظاهر على الباطن ، والباطن على الظاهر ، وميز بين من يعرف القرآن ويتحد معه ، وبين مَن عرف القرآن بالمشاهدة ، وبين فئة ثالثة تستدل بآيات الأنفس والآفاق ، ولكل فئة من هذه الفئات حركتها ومعناها في الباطن والظاهر ، وهذا ما لم يلتفت إليه بعض الباحثين في منهج الطباطبائي ، ولعل إشاراته إلى قوله تعالى : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا . . . ﴾ التماس لهذا المعنى في الظاهر والباطن ، ذلك أن الناس يختلفون فيما هم عليه من قدرات ، ويتفاوتون بما لديهم من استيعاب للمعارف السماوية ، فمن تجلى له الباطن لم يخرجه عن الظاهر ، ومن تجلى له الظاهر أدخله إلى الباطن . فهما ، كما يرى الطباطبائي ، كالروح والجسد ، فإذا ما تلى حكم وجوب الصلاة ، فإن الظاهر والباطن هما اللذان يؤديان هذا الواجب ، فيكون ظاهر الحكم هو إقامة هذه العبادة الخاصة ، لكن بحسب الباطن يدركون أن هذه الصلاة يجب أن تتحقق بقلوبهم وبكل وجودهم ، فيحدث لهم الفناء في عبادة الله وحده ، بعد أن يكون قد تحقق الإنتهاء عن الفحشاء والمنكر ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت : 45] .
إن المفسّر الطباطبائي ، لا يرى في الباطن طريقة إلى تجاوز الحياة ، كما فعل الصوفية ، أو أهل الباطنية ممن احتكروا الأسرار ، وغابوا عن الظواهر ، ظناً منهم أن الشريعة سرُ ، وسرها سر ، وظاهرها باطن ، وباطنها باطن ، كما وصّفها كوربان ، وإنما هو ، برأي الطباطبائي ، باطن يتكامل مع الظاهر ، لكون الإسلام دين كامل وشامل ، ولا بد أن يكون لظاهره معنى الحياة والإصلاح وغير ذلك مما لا تستقيم العبادة إلاّ به ، يقول الطباطبائي : «إن باطن القرآن لا يُلغي ولا يبطل ظاهره ، بل إنه بمنزلة الروح التي تمنح الجسم الحياة ، وبما أن الإسلام دين عام شامل وأبدي ، فهو يهتم أولاً وقبل كل شيء بإصلاح المجتمع البشري ، ولا يتخلى عن الأحكام الظاهرية التي مؤداها إصلاح المجتمع ، وكذا لا يتخلى عن الاعتقادات البسيطة التي تعتبر حارسة للأحكام المشار إليها» (11) .
والحق يقال : إنه لا يفهم من فلسفة الطباطبائي ، ولا من منهجه في التفسير والتأويل ، الذي تقدم الكلام فيه ، أنه يستغرق في الباطن والظاهر لدرجة أن يكونا سراً من الأسرار ، أو طريقة تتجافى بأهلها عن المجتمع والناس ، سواء أكان المخاطب بهذه الشريعة المتحد معها كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) ، أم المشاهد لجمال الله وجلاله والمنجذب إليه فيما خصّه الله به ، أم كان ممن اقتصرت مرتبته على طريقة الإستدلال بالآثار وفيما رآه بالأنفس والآفاق . فالمفسّر يرى أن للقرآن مراتب من المعاني المرادة بحسب مراتب أهله ومقاماتهم (12) ، والكل له ظاهره وباطنه ، بحيث لا يستقل أحدهما عن الآخر فيما يكون في الحياة من سلوك ، وهذا ما جاء عن أبي جعفر (عليه السلام) حينما سأله عمران بن أعين عن ظهر القرآن وبطنه ، فقال : «ظهره الذين نزل فيهم القرآن ، وبطنه الذين عملوا بأعمالهم ، يجري فيهم ما نزل في أولئك» (13) . وطالما أن المفسّر لا يُعطي للباطن معنىً مستقلاً عن الظاهر ، ولا يرى مدخلية له إلاّ من خلال الأحكام النازلة للناس في الاعتقاد والعمل معاً ، وأن الباطن لا يُلغي الظاهر ولا يبطله ، فهذا يدلل على أن الطباطبائي قد فهم مدلول الآيات القرآنية جيداً لجهة ما تعطيه من أبعاد كما في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ ، على نحو يفهم منه أن الله تعالى هو الظاهر المطلق ، وهو الباطن المطلق الذي يتوجه إليه العباد في ظاهرهم وباطنهم ، بحيث يكون لهم من ذلك الظاهر النسبي والباطن النسبي ، هذا ما بينه الطباطبائي بوضوح لجهة قوله : «إن الظهر والبطن أمران نسبيان ، فكل ظهر بطن بالنسبة إلى ظهره ، وبالعكس كما جاء في رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) بقوله له : يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطن ، وظهراً وللظهر ظهر ، يا جابر وليس شيء أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن . إن الآية تكون أولها في شيء ، وأوسطها في شيء وآخرها في شيء» (14) . وهذا كلام متصل ، كما يرى المفسّر ، ينصرف إلى وجوه (15) . وكما جاء في معاني الأخبار عن الصدوق ، أنه لا ينحصر الظهر والباطن بما في الخبر ، فإن هناك أخباراً جمة تدل على أن للقرآن معاني طولية حسب اختلاف الأفهام ودرجات الإيمان والمعرفة ، وفي بعضها أن لبطنه بطناً إلى سبعة أبطن ، والظاهر أن المراد بالبطن في هذا الخبر التأويل ، كما أن المراد بالظاهر التنزيل . . . (16) .
إن مرتكز البحث والتفسير للباطن والظاهر عند الطباطبائي ، هو قوله تعالى : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا . . . ﴾ ، وطالما عرفنا أن للقرآن معاني طولية بحسب اختلاف الأفهام ودرجات ومراتب المعرفة ، فإن هذا يكشف عما يريد أن يذهب إليه الطباطبائي في تأويل معنى الظهر والبطن إذ هو يرى ، كما سبقه إلى ذلك صدر المتألهين ، أن الأودية هنا هي تشبيه لما هم عليه الناس من اختلاف في درجات اكتساب المعرفة ، ولعل المفسّر هنا تأثر بتفسير صدر الدين (الشيرازي) لهذه الآية ، فرأى أن العلم كبحر أُجري منه أودية ، ثم أخرجت الأودية الأنهار ، ثم أُجريت من الأنهار جداول ، ثم أُجريت من الجداول سواقي ، فالوادي لا يحتمل البحر والنهر لا يحتمل الوادي ، والجدول لا يحتمل النهر ، فبحور العلم عند الله ، فأعطى الرسل ومن يجري مجراهم منها أودية ، ثم أعطى الرسل من أوديتهم أنهاراً إلى العلماء ، ثم أعطى العلماء جداول صغار إلى عامة المتعلمين على قدر طاقتهم ، ثم أجرى هؤلاء إلى من يليهم بحسب طاقتهم (17) . والنتيجة ، كما يرى الطباطبائي ، هي أن العلم في دورته هو من الله تعالى إلى الله تعالى ، تماماً كما هي دورة الماء من البحر إلى البحر . وهكذا ، تختلف مراتب الناس ودرجاتهم في الباطن والظاهر ، وهذا ليس من التأويل في شيء ، وإنما هو من التفسير الذي يطاله الإنسان فيما لو تدبّر القرآن واستوى على شيء من الفهم منه . وبحق نقول أين هذا مما ذهبت إليه الباطنية ، أو أهل الصوفية ممن الهتهم التراكيب واستغرقتهم الإشارات إلى حد تعطيل الظاهر والباطن معاً!؟ وكما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب ، فجعل لكل شيء سبباً ، وجعل لكل سبباً شرحاً ، وجعل لكل شرح علماً ، وجعل لكل علم باباً ناطقاً عرفه من عرفه ، وجهله مَن جهله ، ذاك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله ونحن» (18) .
لقد تطرق بعض الباحثين عن الطباطبائي إلى موضوع الظاهر والباطن ، فكان رأيهم جمعاً لرأيه دونما توقف عند حقيقة الموقف ، الذي يتخذه الطباطبائي في حقيقة الظاهر والباطن ، وقد زعم هؤلاء أن المفسّر أحال الكثير من الروايات إلى الجري الذي لا يعتبره تفسيراً ، وإن كان يستبطن أحياناً ما عرف بالباطن الذي يقابل الظاهر ، وهذا ما أشار إليه الطباطبائي بقوله : «وقد يعتبر بطن القرآن مثل الجري أحياناً» (19) ، ولكن هؤلاء الباحثين سهوا عن أن الطباطبائي في منهجه وفيما يتخذه من مواقف ، سواء في التأويل ، أم في التفسير ، في الظاهر ، أم في الباطن ، هو لا يغادر القرآن ، وإنما يجوب في فضائه لفهم الآيات والروايات ، معولاً على جاذبية السياق ، وهذا ما يحتم على الباحثين ملاحظته جيداً كيما يتمكنوا من فهم الموقف الحقيقي للطباطبائي (20) ، فهذا الأخير لم يكن شيعياً في تفسيره ، وإنما كان قرآنياً بامتياز ، وقد قبل ظاهر الشريعة كسبيل إلى باطنها ، لأن الإنسان مكلف بالأعمال الظاهرية ، فإذا ما أحسن القيام بها ، فإنها تؤدي به إلى الاستقرار في المعنوية ، لقوله : «فإن في كنه هذه الأعمال والأغراض الدينية تستقر مرحلة معنوية ، وأغراض أكثر عمقاً» (21) . وعليه ، فإنه لا معنى لأن نفهم الظاهر والباطن عنده من خلال انتماء الرواية إلى هذه المدرسة أو تلك ، أو إلى هذه الفرقة أو تلك ، بل ينبغي فهم الطباطبائي في سياق ما اختاره من منهج ، الذي نرى أنه لم يتمكن من خلال السياق ، ولا من خلال تمييزه بين التأويل والتفسير ، أن يحسم الجدل والموقف في كثير من الآيات قبل الروايات ، كما في سكوت المفسّر على قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ . . . ﴾ ، إلى غيرها من الآيات ، التي أحالها إلى البطن دون أن يعرف ظاهراً لها . وهذا أمرٌ جد طبيعي فيما لو عرفنا أن الطباطبائي لم يكن طامحاً لأن يكون تفسيره مطلقاً ، ومحيطاً بكل ما هو متشابه ، سواء في الآية ، أم في الحديث . ولهذا ، قال : «إنه لا يوجد في كلامه تعالى ما يصلح لتفسير هذه الآية» (22) .
وكيف كان ، فإن أفهام المسلمين تعددت في الباطن وتباينت المسالك منذ عصر الرسالة إلى وقتنا الحاضر ، فمنهم من اعتبر أن باطن القرآن هو المقصود دون ظاهره ، ومنهم من رأى عكس ذلك ، ومنهم مَن اكتفى بالاشارة إلى لحن القول في غربة الأنانية . وبما أن القرآن أرشدنا إلى التدبر في آياته ، فإنه لا بد من النظر بعيداً عن الهوى والرأي ، بحيث يكون الاستنطاق للقرآن من أهله هو الحكم ، وهذا ما فعله الطباطبائي وغيره من المفسرين ، الذين أخلصوا لله في دينهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، فاعتبروا الباطن والظاهر معاً ، وحافظوا على أصول الإيمان والمعارف الحقة ، التي جعلها الله تعالى مسلكاً حقيقياً إليه ، ولهذا يقول الطباطبائي : «ولا نجد دليلاً على أنه يقصد من كلمات القرآن غير المعاني التي تدركها من ألفاظه وجمله ، وللكشف عن باطن القرآن اعتبر المفسّر أمرين هما : الأول : ظواهر الآيات نفسها ، والثاني : ظواهر الشريعة ، وبالتالي ، لا يكون الباطن مناقضاً لمعطيات ظواهر القرآن وحقائق الشريعة» (23) .
إن هذا ما قضت به الشريعة ، وما كلف به العباد ، فيما أمر به ونهى عنه ، وقد فسرت السنة النبوية القطعية هذا الأمر بما دعت إليه من اعتبار لظواهر القرآن والسنة . وكما بين المفسر أن هذا لا ينافي أنه تحت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها ، والطريق إليها حق ، ولكن الطريق إنما يكون باستعمال الظواهر الدينية على ما ينبغي من الاستعمال لا غير ، وهو في هذه العبارة يؤكد على المنهج ، الذي اعتمده بأن يكون التدبّر وفاقاً لقواعد الكتاب والسنة ، وقد عبر عن ذلك بقوله : «وحاشا أن يكون هناك باطن لا يهدي إليه ظاهر ، والظاهر عنوان الباطن وطريقه ، وحاشا أن يكون هناك شيء آخر أقرب مما دل عليه شارع الدين غفل عنه ، أو تساهل في أمره ، أو أضرب عنه لوجه من الوجوه بالمرة ، وهو القائل : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . . . فإن إرادة الظاهر لا تنفي إرادة الباطن ، وإرادة الباطن لا تزاحم إرادة الظاهر . . .» (24) . وإذا كان بعض المتصوفة ، قديماً وحديثاً ، أو من تسموا بأهل الباطن وليسوا به ، قد ادعوا أُموراً وكرامات نورانية ، وخرجوا عن ظواهر القرآن والسنة ، وعما يرشد إليه العقل القطعي ، الذي هو حجة كالوحي تماماً ، فإن هؤلاء قد جمدوا عند الحروف والرسوم ، وساعدهم على ذلك مَن التمسوا الحق من دون تأويل ولا تفسير ، خوفاً من أن يقولوا على الله غير الحق ، كما زعموا أن مَن فسّر فقد أوّل ، هذا فضلاً عما سلكوه من سبل في نفي التجسيم دون أن يُثبتوا ، فقالوا : الاستواء معروف بلا كيف . . . إلى غير ذلك مما عرض له الطباطبائي في تفسيره ، فهؤلاء جميعاً تاهوا عن الباطن والظاهر معاً ، فأدى بهم ذلك إلى التلهي بأسرار زعموا أنها من فيوضات الرحمة ، وبركات النور ، وكما يقول الطباطبائي : «ولو كان الأمر على ما يدّعون وكان ما يزعمونه هو لب الحقيقة ، وكانت الظواهر قشوراً لأسرارهم ، لكان مشرّع الشرع أحق برعاية حالها وإعلان أمرها ، كما يعلنون ، وإن لم تكن هي الحق ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ (25) .
يظهر مما تقدم ، أن المفسّر يقدم الظاهر المتبادر من ألفاظ الآية بالنظرة الأولية ، وما يقف عليه من باطن لا يسميه تفسيراً ، لأن التفسير يكشف عن ظاهر اللفظ . وبناء عليه ، فالمراد لديه هو الظاهر وليس الباطن ، ولعله بذلك يؤسس لرؤية جديدة في التفسير ، قد تكون مخالفة لما ذهب إليه أكثر مفسري الشيعة الإمامية ، حيث إن الرؤية الشيعية اضطربت فيما نسميه بالتأويل والتفسير ، فكان لا بد أن تأخذ بالآيات والروايات على أساس التأويل للمتشابه ، والتفسير بالمأثور : وأكثر ما نجد هذا عند العياشي في تفسيره (26) ، وفي تفسير القمي (27) ، من قبيل ما روي عن الفضيل بن يسار ، قال سألت أبا جعفر عن هذه الرؤية : «ما في القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن ؟ قال : ظهره تنزيله وبطنه تأويله» (28) ، ولعل الطباطبائي التفت إلى ما تتضمنه الرواية من تأويل وتفسير ، فحملها على الجري والانطباق انسجاماً مع موقفه بأن ما يأتي من خارج السياق والتفسير يكون جرياً وانطباقاً ، أما حقيقة التأويل فلا يعلمها إلاّ الله تعالى ، ولا بد من سلوك طريق الظواهر القرآنية ، وكشف الإبهام عن الآية من خلال التعرف إلى سبب النزول أولاً . ولهذا ، تجد المفسّر يعقّب على جري القرآن في حياة البشر ، في كونه ينطبق في التنزيل على الجري وعد المصاديق ، والجري عنده هو عين القاعدة الأصولية المعروفة ، بأن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ، وبهذا يجري القرآن على الماضي والحاضر والمستقبل ، ولا يقف عند المناسبات الأولى لنزول آياته . . .
إن ما تميز به الطباطبائي ، هو أنه فصل بين ما هو متشابه وما هو تأويل من جهة ، وأعطى الأولوية للظاهر من جهة ثانية ، حيث قدم المتبادر من ألفاظ الآية بالنظرة البدائية ، على اعتبار أن التفسير وحده هو الذي يكشف عن ظاهر اللفظ ، وعليه فإن المراد لديه هو الظاهر وليس الباطن (29) . . .
وهنا يمكن أن نشير إلى خلاصة نؤكد فيها على أن منهج الطباطبائي في تفسير القرآن بالقرآن ، حتّم عليه الاستغراق فيه لجهة أن يكون القرآن هو المبين والكاشف عما يمكن أن يلتبس على الباحث والمتدبر والمفسّر ، باعتباره تبياناً لنفسه ، كما هو تبيان لكل شيء . ومقتضى هذا المنهج أن لا يخرج إلى التفسير بالرواية على نحو ما جاء في المأثور عن الشيعة الإمامية من تفسير بالمأثور ، أو بالعقل والنقل معاً ، كما ظهر الأمر في تفسير كل من الطبرسي والطوسي ، ولهذا نجد الطباطبائي يقر قسماً مما روي في تفسيره ، على أنها ليست من التفسير ، وإنما من المصاديق الباطنية للألفاظ القرآنية ، وأحياناً نراه يسكت عن قسم آخر منها لسكوت القرآن عنها ، وأحياناً يكتفي بالبحث الروائي دون أن يكون له رأي أو موقف . وهذا كله يعود ، كما سبق القول ، إلى أن مقتضى التفسير أن يلحظ السياق تأكيداً على الظاهر من الألفاظ . أما ما عدا ذلك ، فإنه يدخله في دائرة الجري ، والإنطباق ، أو يكتفي بالقول : إنه من الباطن ، كما فعل في تفسير قوله تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾ ، فعلق على ذلك بقوله : «وهو من البطن» (30) .
__________________________________
- انظر الكليني محمد بن يعقوب ، أصول الكافي ، موسوعة روائية ، (ت : 329) ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 1365هـ ، ج2 ، ص599 .
- انظر : الإحسائي ، ابن أبي جمهور ، عوالي اللألي (840 هـ) ، دار سيد الشهداء ، قم ، 1405 هـ ، ج4 ، ص107 .
- قال تعالى : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد : 17] .
- الطباطبائي ، الشيعة في الإسلام ، م .س ، ص83 .
- الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج1 ، ص13 .
- م .ع ، الميزان ، ج5 ، ص287 .
- الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج1 ، ص10 .
- الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج3 ، ص85 . وقا : مع صدر الدين الشيرازي ، مفاتيح الغيب ، صححه محمد خواجوي مؤسسة مطالعات ، إيران ، (لا ـ ت) ، ص485 .
- يقول كوربان في تاريخ الفلسفة الإسلامية : «إن الذين زعموا أو يزعمون وقف تعاليم الأئمة على الظاهر ، أي على بعض مسائل الفقه والطقوس يعرضون عما هو جوهر التشيع ويتجاهلونه . إن التوكيد على الباطن لا يعني مطلقاً النسخ الخالص للشريعة ولحرفية النص وظاهره . . .» انظر : هنري كوربان ، تاريخ الفلسفة الإسلامية ، منشورات عويدات ، بيروت . ط3 ، 1983 ، ص85 .
- را : دراسات في فكر الطباطبائي ومنهجه ، مجموعة مؤلفين ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ، تعريب عباس صافي ، بيروت ، 2012م ، ص111 .
- الطباطبائي ، الشيعة في الإسلام ، م .س ، ص83 .
- الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج3 ، ص84 .
- م .ع ، الميزان ، م .س ، ج3 ، ص85 .
- م .ع ، ج3 ، ص85 .
- م .ع ، ص85 .
- انظر : الصدوق ، الحسين بن موسى بن بابويه ، معاني الأخبار(ت : 381هـ) ، تحقيق على أكبر الغفاري ، انتشارات اسلامي ، ط 1361هـ ، ص259 .
- را : صدر الدين الشيرازي ، شرح أصول الكافي ، تحقيق عمر خواجوي ، مؤسسة مطالعات ، إيران ، (لا .ت) ، كتاب الحجّة ص547 .
- م .ع ، ص545 .
- الطباطبائي ، القرآن في الإسلام ، م .س ، ص52 .
- م .ع ، ص53 .
- الطباطبائي ، الشيعة في الإسلام ، م .س ، ص83 .
- الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج15 ، ص389 .
- الطباطبائي ، القرآن في الإسلام ، م .س ، ص24 .
- م .ع ، ص25 .
- م .ع ، الميزان ، ج5 ، ص288 .
- را : محمد بن مسعود العياشي ، (320 هـ) ، تفسير العياشي ، تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي ، المكتبة العلمية الإسلامية ، طهران (لا ـ ت) .
- القمي ، علي بن إبراهيم ، تفسير القرآن ، صححه وعلق عليه طيب الموسوي ، دار الكتاب ، قم ، إيران ، (لا ـ ت) .
- الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج3 ، ص83 .
- الطباطبائي ، القرآن في الإسلام ، م .س ، ص52 .
- م .ع ، الميزان ، م .س ، ج19 ، ص103 .
 الاكثر قراءة في مقالات قرآنية
الاكثر قراءة في مقالات قرآنية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












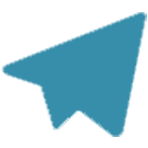
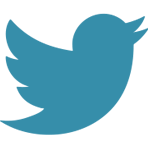

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)