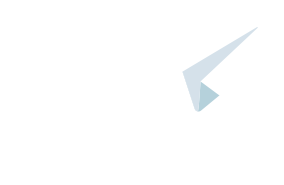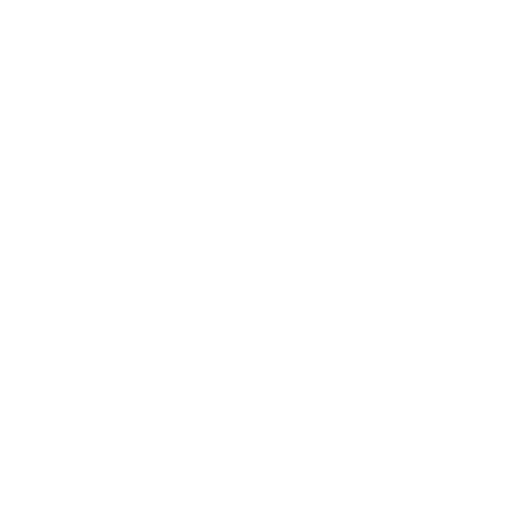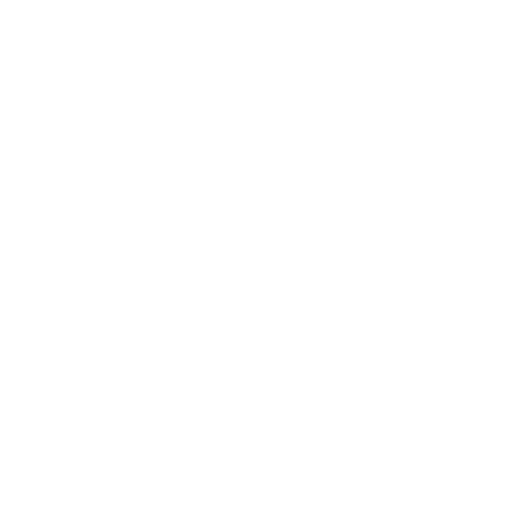التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
الشعر الجاهلي
المؤلف:
لطفي عبد الوهاب
المصدر:
العرب في العصور القديمة
الجزء والصفحة:
ص239- 280
26-8-2018
9336
1- الشعر كمصدر تاريخي:
الحديث عن العلاقة بين التاريخ والشعر ينسحب في الواقع على العلاقة بين التاريخ وكل ألوان الأدب، سواء أكانت هذه قصة أو رواية أو مسرحية أو أي عمل أدبي آخر. وإنما قصرت الحديث هنا على الشعر فحسب لسبب بسيط هو أن الشعر يشكل اللون الأدبي الغالب، أو لعلة اللون الوحيد الذي تبقى لنا بشكل واضح ومباشر، من ألوان الأدب العربي في الفترة السابقة لظهور الإسلام. والسؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة في بداية الحديث هو: كيف نعتمد على الشعر كمصدر من مصادر التاريخ؟ وهو سؤال منطقي، فالتاريخ في جوهره هو الكشف عن حقائق الماضي تمهيدًا لتحليلها وتفسيرها وتقويمها "أعني تقييمها حسب الخطأ الشائع في صياغة الكلمة" والأسلوب الذي يصطنعه المؤرخ في الكشف عن هذه الحقائق هو تمحيص أو تحقيق المادة التي يحصل عليها من مصدر أو آخر من المصادر المتاحة له سواء أكانت هذه المادة تتعلق بأحداث أم مواقف أم اتجاهات أم تيارات، وهذا يبدو لأول وهلة مختلفًا، إن لم يكن مناقضًا لطبيعة الشعر "والأدب بوجه عام". وهي طبيعة تدخل فيها بالضرورة عوامل العاطفة والانفعال والتصور والخيال والانطباع الفردي الذي يختلف من شاعر أو أديب لشاعر أو أديب آخر بدرجات متفاوتة قد تصل إلى التعارض أو حتى إلى التناقض في بعض الأحيان.
وتكمن الإجابة على هذا السؤال في أن دراسة التاريخ الآن قد أصبحت في المقام الأول دراسة مجتمعات ولم تعد تقتصر على التعرف على حياة الأفراد في ذاتهم لتتخذ من هذه الحياة محورا أو هدفا أساسيا، سواء أكان هؤلاء الأفراد حكاما أم زعماء أم قوادا أم مصلحين أم مفكرين أم متآمرين أم كانت لهم أية صفة أخرى. فالأفراد وحدهم، إذا جاز لنا أن نتصورهم بمعزل عن المجتمع والعصر الذي يوجدون فيه -وهو تصور مستحيل- لا يستطيعون أن يسيِّروا أو يغيروا مجتمعا، مهما كانت شخصيتهم أو قدراتهم الذاتية، وإنما يتم هذا التسيير أو التغيير عندما يتجاوبون، تأثرا وتأثيرا، مع ظروف المجتمعات التي يعيشون فيها بما تضمه من موارد وأفكار وتقاليد وترسبات وتفاعلات وطبقات وتناقضات، ومع ظروف العصر الذي يعيشون فيه بما في ذلك من تيارات واتجاهات وتطورات.
وما دام الأمر كذلك فلا بد أن تدور الدراسة التاريخية في نطاق المجتمع، وأن تتناول كل جوانبه: ظروفه الاقتصادية، تكويناته الطبقية، فئاته الاجتماعية، القيم التي تسوده، معتقداته، مثله العليا، علاقاته الداخلية فيما بين طبقاته وفئاته، مواقفه الخارجية من المجتمعات الأخرى، بل أكثر من هذا يصبح من واجبنا أن نتعرف على هذا المجتمع في حياته اليومية في حله وترحاله، بيئته الجغرافية بتضاريسها ومناخها، الجفاف الذي يعاني منه والمطر الذي ينتظره، النباتات التي تقدمها أرضه أو التي يقوم بزراعتها في هذه الأرض، الدواب التي يعتمد عليها والدروب التي يسلكها، وحتى الملابس التي يرتديها وأدوات العمل والقتال والزينة التي يستخدمها، فهذه كلها احتياجات تؤثر على مسلك أفراد هذا المجتمع. وهم في سبيل تأمينها أو الحصول عليها ينهجون هذا النهج أو ذاك أو يتصلون بهذا الشعب أو ذاك، وقد يكون اتصالهم هذا وديا سليما، وقد يكون عنيفا يتخذ درجات متفاوتة من التصادم قد تصل إلى الحرب السافرة. كذلك فإن هوية المجتمع أو شخصيته تصبح، في هذا الصدد، قسمًا من أقسام الدراسة التاريخية لا يمكن تجاهله، متى بدأ هذا المجتمع في الظهور؛ فكرته عن الأصل الذي انحدر منه، الأساطير التي تحيط بهذا الأصل ومدى اقتناعه بها، تطلعاته وتصوراته وقدرته على المواءمة بينها وبين العالم الذي يعيش فيه ويحتك به، ومن ثم مدى استعداده لاستيعاب الحركة التاريخية والتطورات الحضارية أو مسايرتها أو حتى التخلف عنها.
وإذن فالباحث أمام وضع لا يجوز له فيه أن يقتصر على السجلات الحكومية التي تعبر عن أحوال فرد أو أفراد أو فئة أو طبقة حاكمة وما اختارت أن تسجله بطريقة أو أخرى عن أعمالها وعلاقاتها، وإنما لا بد له أن يضم إلى هذا المصدر مصادر أخرى من نوع آخر. وما دمنا نتحدث عن ذلك فليس أمامنا إلا ما تركه المجتمع بكل أفراده وطبقاته وطوائفه ليعبر به، في شكل أو في آخر، عن كل هذه الصور والظروف والمعاملات والعلاقات -وهنا يبرز دور الأدب كواحد من هذه المصادر الرئيسية، فمن خلاله يستطيع الفرد الذي أوتي مقدرة التعبير الأدبي، أن يرسم ملامح المجتمع الذي يحيط به، ومواقفه ومعاناته وآماله في صورة أو أخرى من الصور العديدة التي يتخذها الأدب لنفسه- وقد كان الشعر هو الصورة البارزة التي اتخذها الأدب العربي في عصر ما قبل الإسلام.
ولا يجوز لنا في هذا الصدد أن ننظر إلى تعبير الشاعر على أنه تعبير ذاتي فرد، مهما كانت الاعتبارات التي تغرينا، للوهلة الأولى، بهذه النظرة، فالشاعر جزء من المجتمع بكل ظروفه وتفاعلاته، وإذا كان التعبير الشعري طبيعة تدخل فيها بالضرورة عوامل العاطفة والانفعال والتصور والخيال والانطباع الفردي الذي يختلف من شاعر أو أديب لشاعر أو أديب آخر بدرجات متفاوتة قد تصل إلى التعارض أو حتى إلى التناقض في بعض الأحيان.
وتكمن الإجابة على هذا السؤال في أن دراسة التاريخ الآن قد أصبحت في المقام الأول دراسة مجتمعات ولم تعد تقتصر على التعرف على حياة الأفراد في ذاتهم لتتخذ من هذه الحياة محورا أو هدفا أساسيا، سواء أكان هؤلاء الأفراد حكاما أم زعماء أم قوادا أم مصلحين أم مفكرين أم متآمرين أم كانت لهم أية صفة أخرى. فالأفراد وحدهم، إذا جاز لنا أن نتصورهم بمعزل عن المجتمع والعصر الذي يوجدون فيه -وهو تصور مستحيل- لا يستطيعون أن يسيِّروا أو يغيروا مجتمعا، مهما كانت شخصيتهم أو قدراتهم الذاتية، وإنما يتم هذا التسيير أو التغيير عندما يتجاوبون، تأثرا وتأثيرا، مع ظروف المجتمعات التي يعيشون فيها بما تضمه من موارد وأفكار وتقاليد وترسبات وتفاعلات وطبقات وتناقضات، ومع ظروف العصر الذي يعيشون فيه بما في ذلك من تيارات واتجاهات وتطورات.
وما دام الأمر كذلك فلا بد أن تدور الدراسة التاريخية في نطاق المجتمع، وأن تتناول كل جوانبه: ظروفه الاقتصادية، تكويناته الطبقية، فئاته الاجتماعية، القيم التي تسوده، معتقداته، مثله العليا، علاقاته الداخلية فيما بين طبقاته وفئاته، مواقفه الخارجية من المجتمعات الأخرى، بل أكثر من هذا يصبح من واجبنا أن نتعرف على هذا المجتمع في حياته اليومية في حله وترحاله، بيئته الجغرافية بتضاريسها ومناخها، الجفاف الذي يعاني منه والمطر الذي ينتظره، النباتات التي تقدمها أرضه أو التي يقوم بزراعتها في هذه الأرض، الدواب التي يعتمد عليها والدروب التي يسلكها، وحتى الملابس التي يرتديها وأدوات العمل والقتال والزينة التي يستخدمها، فهذه كلها احتياجات تؤثر على مسلك أفراد هذا المجتمع. وهم في سبيل تأمينها أو الحصول عليها ينهجون هذا النهج أو ذاك أو يتصلون بهذا الشعب أو ذاك، وقد يكون اتصالهم هذا وديا سليما، وقد يكون عنيفا يتخذ درجات متفاوتة من التصادم قد تصل إلى الحرب السافرة. كذلك فإن هوية المجتمع أو شخصيته تصبح، في هذا الصدد، قسمًا من أقسام الدراسة التاريخية لا يمكن تجاهله، متى بدأ هذا المجتمع في الظهور؛ فكرته عن الأصل الذي انحدر منه، الأساطير التي تحيط بهذا الأصل ومدى اقتناعه بها، تطلعاته وتصوراته وقدرته على المواءمة بينها وبين العالم الذي يعيش فيه ويحتك به، ومن ثم مدى استعداده لاستيعاب الحركة التاريخية والتطورات الحضارية أو مسايرتها أو حتى التخلف عنها.
وإذن فالباحث أمام وضع لا يجوز له فيه أن يقتصر على السجلات الحكومية التي تعبر عن أحوال فرد أو أفراد أو فئة أو طبقة حاكمة وما اختارت أن تسجله بطريقة أو أخرى عن أعمالها وعلاقاتها، وإنما لا بد له أن يضم إلى هذا المصدر مصادر أخرى من نوع آخر. وما دمنا نتحدث عن ذلك فليس أمامنا إلا ما تركه المجتمع بكل أفراده وطبقاته وطوائفه ليعبر به، في شكل أو في آخر، عن كل هذه الصور والظروف والمعاملات والعلاقات -وهنا يبرز دور الأدب كواحد من هذه المصادر الرئيسية، فمن خلاله يستطيع الفرد الذي أوتي مقدرة التعبير الأدبي، أن يرسم ملامح المجتمع الذي يحيط به، ومواقفه ومعاناته وآماله في صورة أو أخرى من الصور العديدة التي يتخذها الأدب لنفسه- وقد كان الشعر هو الصورة البارزة التي اتخذها الأدب العربي في عصر ما قبل الإسلام.
ولا يجوز لنا في هذا الصدد أن ننظر إلى تعبير الشاعر على أنه تعبير ذاتي فرد، مهما كانت الاعتبارات التي تغرينا، للوهلة الأولى، بهذه النظرة، فالشاعر جزء من المجتمع بكل ظروفه وتفاعلاته، وإذا كان التعبير الشعري يصل إلينا من خلال الانطباع الذاتي أو المعاناة الشخصية للشاعر، فإن هذا الانطباع أو هذه المعاناة تتم في إطار التجربة التي يعيشها ويمارسها المجتمع الذي يوجد فيه الشاعر، ولا يملك الشاعر في هذه الحال إلا أن يكون جزءًا منها مهما اختلفت طريقة التعبير عنها من شاعر لآخر. على أننا ونحن بصدد التأريخ للمجتمع، لا نأخذ، ولا ينبغي أن نأخذ، الشعر كما هو على أنه حقائق تاريخية أو حضارية؛ فالشاعر قد يبالغ وقد يتخيل وهو حتى إذا تحدث عن حقائق فهو يبرزها لنا من خلال انفعاله الخاص بها. ولكن رغم ذلك فهناك عدد من الحقائق الثابتة نستطيع أن نستخلصه من الشعر عن أحوال المجتمع، إذا تخطينا المبالغات والتخيلات والانفعالات الخاصة.
ومن بين هذه الحقائق، الاتجاهات العامة التي تسود المجتمع مثل القيم التي تحكمه وطبيعة تصوره لها ومن ثم الدوافع التي تعيننا على تفسير عدد من تصرفات هذا المجتمع. وفي هذا المجال فنحن قد لا نفهم عددا من العلاقات القبلية قبل الإسلام أو على الأقل لا نفهم كل الأبعاد التي وصلت إليها دون أن نعرف تصور مجتمع ما قبل الإسلام لمعنى الشرف أو الرابطة العصبية أو لممارسة الثأر -وكلها معانٍ تبرز في وضوح من خلال الشعر الجاهلي. كذلك نستطيع أن نفهم اضطرار عرب البادية إلى الارتحال المستمرِّ نتيجة لظروف الجفاف التي سيطرت على شبه الجزيرة العربية من خلال وصف الأطلال والبكاء عليها والحنين إلى العلاقات التي تمت في ظل ما كان بها من جوار ولقاءات يجد البدوي نفسه مضطرًّا إلى التضحية بها أمام واقع الوضع الاقتصادي الذي يدفعه إلى السعي وراء الكلأ وانتجاعه حيثما كان. كذلك نحن نستطيع أن ندرك في وضوح كثير مدى ما تتركه ندرة المطر في شبه الجزيرة على تصرفات القبائل وعلاقاتها فيما بينها إذا عرفنا أن شاعرًا مثل عمرو بن كلثوم يجد من بين دواعي فخره أن قبيلته ترد عين الماء أولًا فتنعم بالماء الصافي ولا تترك لغيرها من القبائل إلا ما تبقى من الكدر والطين وهكذا.
وليست الاتجاهات العامة هي كل ما نستخلصه من الشعر، وإنما نعرف منه إلى جانب ذلك أشياء أخرى لا يملك الشاعر أن يغير فيها شيئا ولا يوجد ما يدعوه إلى ذلك؛ لأنها من صميم بيئته، مثل الحيوانات التي يعتمد عليها في تنقله رعيا أو تجارة أو حربا، ومثل الملابس التي يتخذها الرجال والنساء ومثل البيوت "أو الخيام" وطريقة بنائها أو إقامتها، ومثل الآلهة والمعتقدات والشعائر والطقوس، ومثل أسماء الأماكن التي يقيمون فيها أو يرتحلون إليها، سواء أكانت مدنا أم قرى أم مواضع، ومثل الطرق التي كانوا يسلكونها في تنقلاتهم والمعالم التي تحيط بها أو تطل عليها، ومثل الأسواق التي كانوا يلتقون فيها لقضاء معاملاتهم، ومثل المواقع أو الأيام التي تركت أثرًا في حياتهم، وفيض آخر إلى جانب كل هذا عن تفاصيل حياتهم وممارستهم اليومية تعيننا مرة أخرى على تفهم تصرفاتهم وعلاقاتهم.
هذه هي قيمة الشعر كمصدر أساسي من مصادر التاريخ، نترك منه ما يشوبه الخيال، وما يعبر من خلاله الشاعر عن الانفعال المؤقت أو عن الانطباع الشخصي، أو ما نرى فيه شيئا من المبالغة التي تنتج عن المثالية والميل الطبيعي نحو البطولة وهو ميل من الطبيعي أن ننتظره في الشعر، ونستطيع أن نتحقق منه عن طريق المقارنة بما تصل إليه أيدينا من مصادر أخرى مثل النقوش والآثار وكتابات المؤرخين والرحالة والجغرافيين حتى نصل إلى أقرب نقطة ممكنة من الحقيقة التاريخية. وفي هذا المجال، فإن تصوير أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام اعتمادًا على ما تركه لنا شعراء الجاهلية، ليس بدعا أو أمرا غير عادي؛ فقد اعتمد مؤرخو الحضارة اليونانية وتاريخها على ما جاء في ملحمتي الإلياذة والأوديسية المنسوبتين إلى الشاعر اليوناني هوميروس Homeros بعد تمحيصه ومقارنته بالمصادر الأثرية والتاريخية الأخرى (1) . بل لعل الشعر الجاهلي كان أوفر حظًَّا من شعر هوميروس فيما يخص إمكانات التمحيص عن طريق المقارنة، فلم يكن هناك في العصر الذي تغطيه أشعار هوميروس في العصر المبكر من ظهور المجتمع اليوناني مؤرخون معاصرون يمكن الاعتماد في المقارنة على ما تركوه لنا من كتابات، وما وجد من نقوش قليلة لم يمكن التوصل إلى مدلول حروفها إلا خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل غير مستقر (2). وهكذا لم يكن أمام مؤرخي الحضارة اليونانية إلا الاعتماد على الآثار بشكل أساسي في هذه المقارنة. أما الشعر الجاهلي فلدينا للتحقق مما أشار إليه أو جاء فيه مصادر أخرى إلى جانب الآثار، من بينها النقوش وكتابات المؤرخين والجغرافيين والرحالة والموسوعيين اليونان والرومان ومن بينها القرآن الكريم والحديث الشريف والتوراة والتلمود على سبيل المثال. وكلها تعيننا على تمحيص هذا الشعر وتحقيقه والتأكد من المعلومات التي يقدمها لنا.
ورغم ما بين شعر هوميروس، وبين الشعر الجاهلي من مواطن الخلاف في التركيب أو التكوين الفني، إلا أن أوجه الشبه كثيرة إذا ما نظرنا إلى كل منهما على أنه مصدر تاريخي وحضاري، فالإلياذة والأوديسية مكونتان من أناشيد ومقطوعات شعرية تماثل المقطوعات التي يمكن أن نقسم إليها المعلقات أو القصائد الجاهلية من حيث إن كلًّا منها يرسم منظرا أو موقفا يصور جانبا من جوانب الحياة في المجتمع الذي ينتمي إليه. فوصف هوميروس في النشيد الثامن عشر من ملحمة الإلياذة لعدد من الثيران وبعض كلاب الرعي وقطيع من الغنم في أحد المناظر المرسومة على درع أخيليوس Achileus، يقابله وصف الحصان وسرب من بقر الوحش في معلقة امرئ القيس أو وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد، والمنظر الذي يتعلق بدفع الدية لأهل القتيل في النشيد نفسه من الإلياذة يقابله وصف لدفع الدية بين بني عبس وبني ذبيان في معلقة زهير بن أبي سلمى (3). وإلى جانب هذه المناظر المتقابلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بين شعر هوميروس والشعر الجاهلي توجد عشرات من المناظر تصور طريقة كل من المجتمع اليوناني المبكر والمجتمع اليوناني في شتى مناحي الحياة وممارستها.
2- اعتراضات على الشعر الجاهلي كمصدر تاريخي:
الشعر إذن، في حد ذاته، مصدر من مصادر الكتابة التاريخية لا يقل شأنًا عن غيره من المصادر، فإذا كانت السجلات الحكومية هي وثيقة الطبقة الحاكمة، فإن الشعر هو وثيقة الشعب والمجتمع بأكمله، على أن الشعر الجاهلي تعرض لقضية ينبغي أن نتوقف عندها لأنها تمسه من الأساس وتتعرض لقيمته كمصدر لمعرفة أحوال شبه الجزيرة العربية في الفترة السابقة للإسلام. فقد أثار بعض الباحثين اعتراضًا مؤداه أن أغلب هذا الشعر، إن لم يكن كله، لا ينتمي إلى العصر الجاهلي بحال، وإنما هو موضوع أو منحول، نحله الرواة في القرنين الثاني والثالث الهجريَّيْنِ ثم نسبوه إلى الشعراء الجاهليين، وقد دار حول هذه القضية جدل طويل، أخذًا وردًّا، امتد على القسم الأكبر من النصف الأول للقرن الحالي، وكان أول من أثار الاعتراض منذ أوائل القرن هو المستشرق د. س. مارجوليوث D. S. Margoliouth.
والدعوى التي يقدمها مارجوليوث هي أن الشعر بالصورة التي عرفها العرب بعد ظهور الإسلام لم يكن معروفًا في الجاهلية، وحقيقة إن أشخاصا وجدوا في الجاهلية وأطلق عليهم اسم "الشعراء" وقد جاءت في القرآن الكريم سورة كاملة بهذا الاسم، ولكن الإشارات القرآنية إلى هذه الفئة تفيد أن هؤلاء كانوا فئة من الكهان يتنبئون بالغيب ويعبِّرون عن ذلك بألفاظ مبهمة، ومن ثم يصبح المقصود بالشعر هو هذه الصفة أو المهنة الدينية وليس الموهبة أو الصنعة الفنية التي تدخل ضمن أبواب الأدب. ويقدم المستشرق لتأكيد دعواه هذه مجموعتين من الأدلة (4).
وقد تعرض في المجموعة الأولى من هذه الأدلة إلى الطرق التي يفترض أن الشعر الجاهلي انتقل من خلالها إلى علماء العرب من الإخباريين والرواة في القرنين الثاني والثالث للهجرة، كما تعرض لهؤلاء الإخباريين والرواة أنفسهم. ففيما يخص طرق انتقال الشعر الجاهلي يذكر أن هذا لا يكون إلا بالكتابة أو بالرواية. أما الكتابة فهو يشك فيها، فالقرآن الكريم يذكر أن الجاهليين لم يكن لهم كتاب "سماوي" يقرءونه كما كان الحال عند اليهود والنصارى، ولو كان الشعر الجاهلي مكتوبا لكان لهم كتاب أو أكثر من الكتب السماوية. وأما الرواية فهناك أكثر من سبب يؤدي إلى الشك فيها فالشعر الجاهلي فيه عدد كبير من القصائد الطويلة، ومثل هذه القصائد تفترض وجود رواة محترفين حتى يستوعبوها، ويعوها في ذاكرتهم وينقلها جيل منهم إلى الجيل الذي يليه -وليس هناك ما يثبت وجود هؤلاء الرواة المحترفين. كذلك فإن موقف القرآن الكريم الذي اتسم بالقسوة على الشعراء واتهام أتباعهم بالغواية واتهامهم هم أنفسهم بالكذب من حيث إنهم يقولون ما لا يفعلون -كل هذا يدعو إلى نسيان الشعر الجاهلي حتى إذا افترضنا وجود مثل هذا الشعر. وأخيرًا فإن الشعر الجاهلي "المفترض في رأي مارجوليوث" يخلد الروح القبلية بما يضمه من قصائد تفتخر فيها القبائل بانتصاراتها على غيرها، ومن ثَمَّ فإن الإسلام الذي كان يدعو إلى الوحدة ويعمل على تحقيقها بكافة الوسائل لا يمكن أن يشجع التغني بهذا الشعر أو العمل على إبقائه متداولًا في المجتمع الإسلامي الأول. وهذا سبب آخر يدعو إلى نسيانه أو الإعراض عنه (5).
أما عن علماء العرب في القرنين الثاني والثالث الهجريين ممن ذكروا الشعر الجاهلي أو قاموا على روايته فهم إما الإخباريون وهؤلاء لا يعتمد على ما ذكروه من شعر؛ إذ إن بعضهم أورد شعرًا لآدم بينما عزا البعض الآخر شعرًا غنائيًّا لإسماعيل وكلا الأمرين غير معقول، وإما الرواة من أمثال حمَّاد وجناد وخلف الأحمر وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وابن إسحاق "صاحب السيرة" والمبرِّد، وهؤلاء لا يطمئن المستشرق إليهم لسببين رئيسيين: أولهما أن هؤلاء العلماء كان بعضهم يشكك في أمانة البعض الآخر في الرواية، ومثل هذه الاتهامات لا تجعلنا نعرف أين الشعر المنحول وأين الشعر الصحيح "إذا كان ثمة شعر جاهلي". والسبب الثاني هو أنه على فرض أن بعض ما رواه هؤلاء الرواة شعر صحيح أو يعتقدون أنه شعر صحيح فأين مصدره؟ لقد كان الإسلام متشددًا مع الوثنية تشددًا لا يعرف التهاون أو الكَلَل وقد ناصبها العداء بشكل انتهى إلى حروب أهلية سافرة سواء في أثناء الدعوة "غزوات الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو بعد الدعوة "حرب الردة" داخل شبه الجزيرة، فمن غير المعقول أن يشجع الشعر الجاهلي الذي يتغنى بأمجاد المجتمع الوثني. كذلك فإن أعدادا كبيرة من سكان شبه الجزيرة قد تركوها في فترة الفتوح الإسلامية ليستقروا في مواطن جديدة أدخلتهم في أجواء جديدة استوعبت اهتماماتهم وانشغلوا بالمواءمة بين أنفسهم وبين ظروفها، الأمر الذي يشجع اندثار ما كان قد علق بأذهانهم من الشعر الجاهلي على افتراض وجوده أصلا (6).
أما المجموعة الثانية من الأدلة فيتعرض فيها المستشرق إلى الشعر الجاهلي على أكثر من صعيد. فعلى صعيد الوزن الذي تجده فيما بين أيدينا من الشعر المنسوب إلى الجاهلية، فإن هذا الوزن يفترض مقدمًا أن يكون الشعر الجاهلي تاليًا لنزول القرآن وليس سابقا له كما يجب أن يكون. والسبب في ذلك أن تطور الفن الأدبي يسير من غير المنتظم إلى المنتظم، أي: يسير من النثر العادي، إلى نثر يظهر فيه السجع وشيء من الوزن ثم إلى الشعر الموزون وزنا كاملا. ونحن نرى أن القرآن الكريم فيه كثير من السجع وفيه قدر ظاهر من الوزن، ولكنه لا يصل إلى مرحلة الوزن الكامل، ومن هنا يصبح في افتراض وجود شعر جاهلي قبل نزول القرآن الكريم تناقضٌ مع تطور الفن الأدبي. ويدعم المستشرق دليله هذا بدليل آخر من حيث إن الوزن يمثل الموسيقى الشعرية فيذكر أن القرآن لم يذكر الموسيقى من مستحدثات العصر الأموي، ومن ثم فمن الصعب أن نتصور وجود شعر جاهلي بهذا الانتظام والتنوع في إيقاعه الموسيقي الذي يمثله وزن الشعر (7).
وعلى صعيد المعاني التي تناولها الشعر الجاهلي، فإن في بعض قصائده إشارات إلى القصص الديني مثل وصف نوح بالأمانة، واستعمالات لغوية إسلامية مثل: الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم الحشر والركوع والسجود ومثل هذه الإشارات لم تكن معروفة بين الجاهليين، كما أن مثل هذه الاستعمالات لم تكن شائعة أو ربما لم يكن بعضها معروفا في مجتمعهم. كذلك لا توجد في أشعار المسيحيين من شعراء الجاهلية أو من كانوا على صلة ببلاط الملوك المسيحيين "مثل ملوك الغساسنة" إشارات إلى الكتاب المقدس عند المسيحيين أو إلى تعاليم المسيحية إلا فيما ندر. وأخيرًا فإن القَسَم الذي يرد في هذه الأشعار هو دائما بالله على نمط ما جاء في القرآن الكريم، كما أن ترديد أي صدى من جانب هؤلاء الشعراء لكتاب مقدس، إنما هو ترديد لصدى القرآن الكريم، وليس مصدرا آخر غيره، وإذن فهو شعر وضع بعد الإسلام وليس شعرا قيل قبل الإسلام (8) .
أما على صعيد اللغة التي صِيغ بها الشعر الذي يفترض أن يكون جاهليا، فإن مارجوليوث يذكر أن الشعر الجاهلي كله ورد بلغة واحدة هي لغة القرآن الكريم وهو يجد صعوبة في التوفيق بين هذه الظاهرة وبين ظاهرة أخرى وهي الاختلاف بين لغة القبائل الشمالية في مجموعها وبين اللغة الحِمْيَرِيَّة في الجنوب، ثم الاختلاف بين لهجات القبائل فيما بينها، كذلك يجد من الصعب أن نتصور وجود لغة واحدة مشتركة بين العرب في الجاهلية، فظهور الإسلام ونزول كتابه باللهجة التي نزل بها من لهجات الشمال العربي هو الذي وَحَّد العرب وكان أحد مظاهر هذه الوحدة هو الالتفاف حول لغة القرآن الكريم ويدعم المستشرق دعواه في هذا المجال فيقول: إنه لو كنا نبحث في وثائق نثرية "وليس في قصائد شعر" جاءت بلغة عربية واحدة "رغم اختلاف اللغات واللهجات في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام" لقلنا: إنها إما ترجمت إلى اللغة الجديدة الموحدة أو إنها تدرجت من طور إلى طور آخر. ولكن الشعر فيه من الوزن والصنعة الفنية المعقدة ما يجعل ترجمته إلى لغة جديدة أو انتقاله من طور لغوي إلى طور آخر، مع محافظته على وزنه وعلى صنعته الفنية، أمرا مستحيلا (9) .
هذه هي الدلائل التي ساقها مارجوليوث في كتاباته ليخلص منها إلى أن الشعر الجاهلي الذي بين أيدينا لا ينتمي في الحقيقة إلى العصر الجاهلي، وإنما نحله الرواة في القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة ثم نسبوه إلى أسماء جاهلية. وقد عضد هذا الافتراض عالم عربي هو الدكتور طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي" الذي أعاد طبعه تحت عنوان "في الأدب الجاهلي". ويوافق الدكتور طه حسين على ما قدمه الأستاذ مارجوليوث من أدلة واستنتاجات ويساندها بمزيد من التفصيلات ثم يضيف إليها شواهد جديدة تدعم شكه في وجود شعر جاهلي، وهو شك يكاد يصل عنده إلى نفي وجود هذا الشعر الجاهلي.
وأهم هذه الشواهد الجديدة أن الشعر الجاهلي "المفترض في رأيه" لا يمثل الحياة الدينية أو العقلية أو السياسية أو الاقتصادية عند عرب الجاهلية. فمن الناحية الدينية يلاحظ الكاتب الكبير أن الشعر الجاهلي لا يكاد يتطرق إلى حياة دينية تبين عقائد الجاهليين واعتزازهم أو تمسكهم بها، ومع ذلك فالقرآن الكريم يشير إلى حياة دينية قوية عند هؤلاء القوم، وهي حياة يتشبثون بها، ويدعوهم تشبثهم هذا، حسبما نقرأ في عديد من الآيات القرآنية، إلى أن يجادلوا عنها، فإذا لم يغنهم الجدل لجئوا إلى الكيد للرسول -صلى الله عليه [وأله] وسلم- وأتباعه ثم إلى اضطهادهم، وقريش لا يمكن أن تفعل هذا بأبنائها لو لم يكن لها من الدين إلا ما يمثله هذا الشعر الذي ينسب إلى الجاهليين (10).
كذلك فإن هذا الجدل ذاته التي تفننت فيه قريش إبرازًا لحججها وتحدياتها الفكرية يمثل ذكاء وحياة عقلية متقدمة لا يمكن أن توجد لديهم إذا كانوا على ما يظهره لنا الشعر الجاهلي من غلظة وجفاء (11). والتناقض ذاته نجده فيما يتصل بالحياة السياسية عند الجاهليين، لقد كانت العلاقات الدولية بين الفرس والبيزنطيين "الروم" تحيط بهم وتؤثر عليهم ويهمهم تتبعها فيما يتعلق بتجارتهم مع بلاد الشام التي كانت تحت حكم البيزنطيين ومن ثم كان انتصار أو انكسار واحدة أو الأخرى من هاتين القوتين أمرًا له قيمة في حياة قريش. وقد جاءت في القرآن إشارة تفيد هذا المعنى وتشير إلى العلاقة بين الفرس والروم وإلى رحلة الشتاء والصيف. وإحدى هاتين الرحلتين كانت إلى الشام حيث الروم والأخرى إلى اليمن حيث الحبش، ومع ذلك فإن شيئا من هذه الحياة التي يظهر فيها الاهتمام بمجريات الأمور السياسة لا يظهر في الشعر الجاهلي (12).
أما عن الحياة الاقتصادية فيلاحظ الدكتور طه أن القرآن يقسم عرب الجاهلية إلى قسمين: هما الأثرياء المتعنتون الذين روجوا الربا ومنعوا الصدقة جشعًا وبخلًا، والمعدمون المستضعفون الذين لا يملكون أمام هؤلاء شيئًا، والصراع بين هاتين الطبقتين يصبح من ثم شيئا واردا أو على الأقل تصبح المعاناة من الطبقة المعدمة تصبح ظاهرة محسوسة، ومع ذلك فالشعر الجاهلي يقف من كل هذا موقفا صامتًا مع أن المعاناة التي يتمخض عنها مثل هذا الصراع هي موضوع الشاعر في المقام الأول. ومع ذلك فإننا لا نرى شيئا من هذا في الشعر الجاهلي (13)، بل لا نرى إلا حديثًا عن الكرم لدرجة التبذير مع أن البخل كان موجودًا وهو وارد على الأقل إلى جانب الكرم. وأخيرًا فموقف الشعر الجاهلي يكرر نفسه فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية للعرب في الجاهلية. وهنا يلاحظ الكاتب أن هذا الشعر لا يعني إلا بحياة البادية وعلاقاتها ولا يكاد يذكر حياة البحر، فإذا ذكرها فهو ذكر الجاهل الذي لا يكاد يعرف عنها شيئًا. ومع ذلك فإن القرآن يمنُّ على العرب بأن سخر لهم البحر وجعل لهم فيه منافع كثيرة (14).
وهكذا يؤكد طه حسين أن الشعر الجاهلي لم يكن له وجود وأنه من وضع الرواة أو من نقل عنهم الرواة في القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة. ثم يقدم السبب الذي يعتقد أنه دفع هؤلاء الرواة إلى ما أقدموا عليه، فيرد ذلك إلى حركة الشعوبية التي ظهرت آنذاك وهي حركة حاول فيها الشعوبيون أن يحطوا من شأن العرب والعروبة فنحلوا شعرا يصف العرب بالبداوة والغلظة والتخلف نسبوه إلى العصر الجاهلي، وقابل ذلك أنصار العروبة بأن نحلوا بدورهم شعرًا يمجد العرب وصفاتهم ونسبوه هم الآخرون إلى الجاهليين وهكذا تكوَّن رصيد الشعر الجاهلي (15).
3- ردود على هذه الاعتراضات:
هذه هي جملة الآراء التي يحاول أصحابها أن ينكروا وجود شعر لدى العرب في العصر الجاهلي، وأن يثبتوا أن ما وصل إلينا عن طريق الرواة في هذا الصدد لم يكن شعرا جاهليا وإنما كان شعرا منحولا وضعه هؤلاء الرواة أو من نقل عنهم هؤلاء الرواية في عصر لاحق للعصر الجاهلي بعدة قرون. على أن الأدلة والشواهد التي ساقوها هي أدلة مردود عليها، سواء فيما يتصل باللغة التي قيل بها الشعر الجاهلي أو بالشعر نفسه أو بالطريقة التي انتقل بها إلى الرواة من علماء القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة أو بهؤلاء العلماء الرواة أنفسهم. ولكن قبل مناقشة هذه الأدلة والشواهد أجد من اللازم أن أشير إلى بديهية مؤداها أن أية مجموعة من الشعر في أي مجتمع وفي أي عصر، حتى في العصور التي أصبحت فيها الكتابة هي الوسيلة الأساسية لجمع الآثار الأدبية وحفظها، معرضة بسبب التداول لقدر من التغيير في بعض الكلمات أو العبارات أو الأبيات، بل إلى النقصان والزيادة ليس في أبيات فحسب وإنما في قصائد كاملة. وهذا التغيير أو النقصان أو الزيادة يكون واردا بشكل أكثر في العصور التي تعتمد أساسًا على الرواية الشفهية في نقل الشعر من جيل لجيل، أو التي تطغى فيها الرواية على التدوين الكتابي للشعر، أو حتى إذا سارت جنبا إلى جنب مع هذا التدوين.
وأسوق على هذا مثالين، أحدهما هو الإلياذة والأوديسية المنسوبتان إلى هوميروس، وهما ترجعان إلى أواسط القرن التاسع ق. م. ومع ذلك فقد انتقلتا عن طريق الرواية عبر ما يقرب من قرنين أو ربما أكثر من ذلك قبل أن يتم تدوينهما بصورة نهائية. بل إن الملحمتين ذاتهما حين تمت صياغتهما في أواسط القرن التاسع ق. م. كانت هذه الصياغة لا تزيد كثيرا على إعطاء حبكة فنية وأدبية لمقطوعات شعرية قيلت على مدى ثلاثة قرون أخرى قبل ذلك (16). أما المثل الثاني فهو قصائد شكسبير التي لا تزال نسبة عدد مما تضمه من مقطوعات وقصائد إلى الشاعر موضع نقاش حتى الآن، رغم أن الفترة التي كتب فيها شكسبير "الشطر الأخير من القرن السادس عشر وأوائل القرن الذي يليه" كان التسجيل الكتابي هو الوسيلة الأساسية للتدوين دون منازع.
وأنتقل الآن إلى مناقشة الأدلة والشواهد التي ينكر أصحابها وجود الشعر الجاهلي مبتدئًا بتلك التي تتعلق باللغة من حيث إنه كان في الجزيرة العربية قبل الإسلام لغتان أساسيتان هما: لغة القبائل الشمالية بلهجاتها في الشمال واللغة الحِمْيَرية في الجنوب، وهو أمر يستغرب معه ورود الشعر الجاهلي بلغة قبائل الشمال فحسب، بل بلهجة واحدة من لهجاتها هي التي نزل بها القرآن الكريم، وفي الرد على هذا يقول أحد الباحثين: إن توحد اللغتين: القحطانية أو الحميرية في الجنوب، والعدنانية في الشمال -بعد ظهور الإسلام ببضع عشرات من السنين- لا يمكن أن يتيسر في الحقيقة إلا إذا كان هناك تقارب شديد بين اللغتين في الفترة السابقة للإسلام، كان أحد مظاهره وجود لغة أدبية مشتركة بين شعراء الجزيرة العربية في العصر الجاهلي (17).
وأود أن أدعم هذا الرأي بشاهدين يجعلان وجود مثل هذه اللغة المشتركة أمرًا واردًا إلى حد كبير، والشاهد الأول هو أن الاتصال المباشر كان اتصالا نشطا وكثيفا بين أقسام شبه الجزيرة العربية وبخاصة بين شماليها وجنوبيها عن طريق القوافل التجارية المستمرة على مدار السنة، وقد كانت مكة بالذات هي الموقع الذي تلتقي عنده أهم طريقين من هذه الطرق التجارية، وهما الطريق المؤدية من اليمن في الجنوب إلى سورية في الشمال، والطريق التي تبدأ من مكة وتتجه اتجاها شرقيا وشماليا شرقيا لتصل إلى رأس الخليج ومن ثم إلى وادي الرافدين. وقد كانت أولى هاتين الطريقين بالذات، وهي الطريق القادمة من الجنوب، على نشاط غير عادي، فهي لا تقتصر على حمل البخور -أهم سلعة في ذلك العصر- إلى سورية وإلى موانئها على البحر المتوسط ومن ثم إلى الشواطئ الأوروبية لهذا البحر، بل كانت تزيد على ذلك حمل السلع الآتية من الهند إلى هذه الشواطئ والتي كانت تصل إلى عدن بحرا ثم يُنقل قسم قليل منها بهذه الطريق البرية إلى الشمال (18). ومثل هذا النشاط التجاري الكثيف المستمر كان معناه اتصالًا دائمًا بين التجار وتجمعًا حول لغة وسيطة مشتركة للتعامل والتفاهم، وفي هذا الصدد تكون لهجة قريش في مكة هي المرشحة لأن تكون هذه اللغة طالما أن مكة هي نقطة التوقف والمحط التجاري الأساسي للقوافل الآتية من الشمال والجنوب والشرق، وهي التي تتم فيها الصفقات والمعاملات والخدمات وما يستتبعه كل هذا من بعض الشعائر الدينية أو الابتهالات أو التضحيات التي يقوم بها هؤلاء التجار تقربا من معبوداتهم والتماسًا لمباركة هذه الآلهة عند الكعبة التي كانت تقوم بساحة هذه المدينة لا تفرق بين واحد أو آخر من هذه المعبودات.
أما الشاهد الثاني، فهو أن انتشار لغة عن طريق التجارة أمر له سابقة قوية في تاريخ منطقة الشرق الأدنى، وأشير هنا إلى اللغة الآرامية التي حملها التجار الآراميون من دمشق منذ أواسط القرن الثامن الميلادي لتنتشر حتى تصبح اللغة السائدة في منطقة الهلال الخصيب. لقد دخلت هذه اللغة منطقة آشور ليصبح المتحدثون بها من الآشوريين أكثر من المتحدثين باللغة الآشورية نفسها، واستمرت كذلك بعد سقوط الدولة الآشورية "612 ق. م" وقيام الدولة البابلية الحديثة على أنقاضها. كذلك بلغ من انتشار هذه اللغة في منطقة الهلال الخصيب أن اتخذها الفرس لغة رسمية للمعاملات الإدارية في أثناء سيطرة الإمبراطورية الفارسية على هذه المنطقة ابتداء من أوائل القرن السادس ق. م "530 ق. م. وما بعدها". بل لقد بلغت كثافة هذا الانتشار أن حلت بين العبرانيين كلغة للتداول والتفاهم محل لغتهم العبرية. ويكفي دليلًا على ذلك أنها كانت اللغة التي اتخذها السيد المسيح للتبشير بدعوته بين قومه من العبرانيين (19). وقد كان أحد الأسباب الرئيسية في انتشار اللغة الآرامية بين شعوب منطقة الهلال الخصيب أن لغات هذه الشعوب كانت سامية ومن ثم من فصيلة هذه اللغة. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يصبح واردا بشكل أكثر وأقوى أن يطغى قسم من اللغة العربية على قسم آخر من اللغة نفسها إذا توفر العنصر أو العامل التجاري النشط كما كانت الحال عند الآراميين الذين انتشرت لغتهم نتيجة لنشاطهم التجاري فحسب رغم أن السيادة العسكرية والسياسية كانت في أيدي حكومات لشعوب أخرى سواء من الآشوريين أو البابليين أو الفرس.
وأنقل الحديث الآن إلى مناقشة المنكرين لوجود الشعر الجاهلي فيما يخص الشعر ذاته، وأول نقطة في هذا الصدد تتصل بالرأي القائل: إن الشعر العربي لا يمكن أن يسبق نزول القرآن الكريم بل لا بد أن يكون لاحقًا له طالما أن القرآن قد تضمنت بعض عباراته شيئًا من الإيقاع أو الوزن، بينما الشعر كله موزون، وذلك تمشيا مع افتراض مؤداه أن تطور الفن الأدبي يسير من غير المنتظم إلى المنتظم. والرد الذي أقدمه هو أن هذا الافتراض لا يتمشى مع الظواهر الأدبية أو الاجتماعية المؤكدة. فمن ناحية الظواهر الأدبية نجد أن الشعر أسبق في الظهور في المجتمعات من النثر، ودليلنا على ذلك هو ملحمتا الإلياذة والأوديسية التي أسلفت الإشارة إليهما، فقد كانت هذه الأشعار هي أول بادرة في أدب اليونان، وكانت ثاني هذه البوادر ملحمتان شعريتان أخريان هما "الأعمال والأيام" و"سلالة الآلهة" للشاعر هزيودوس (20)، ولم ينضج النثر الفني عند اليونان إلا بعد ذلك بعدة قرون. والسبب في سبق الشعر على النثر هو أن الشعر بوزنه "أو إيقاعه" وقافيته أقرب إلى الالتصاق بالذاكرة من النثر إذ هو يساعدها على استيعابه أكثر مما يفعل الكلام المنثور، والسبب الثاني هو أن الإيقاع أقرب إلى الفطرة. ودليلنا الاجتماعي على ذلك هو أن المجتمعات البدائية كانت ولا تزال تعبر عن نفسها برقصات إيقاعية، والإيقاع الذي تمثله الدقة والحركة في الرقص هو ذات الإيقاع الذي يمثله الوزن في الشعر.
أما النقطة الثانية في هذا المجال فهي ما أورده المنكرون للشعر الجاهلي من أن به بعض المعاني أو الألفاظ والإشارات الدينية التي وردت في القرآن الكريم ومثل هذه المعاني والألفاظ أو الإشارات تفترض في رأيهم أن يكون ما وصلنا من الشعر الجاهلي قد وضع في فترة لاحقة لنزول القرآن الكريم. وفي هذا المجال رد أحد الباحثين على ورود بعض المعاني القرآنية في الشعر الجاهلي بأنه من الجائز أن ينطق العرب بحكمة ثم يأتي القرآن بهذه الحكمة ويبرزها على وجه أبلغ وأرقى (21). وهو أمر أراه واردًا فالقرآن الكريم نزل إصلاحا للمجتمع بما فيه من أفكار وممارسات، وإذا كان من الطبيعي أن يقف في وجه الفكرة أو الممارسة الخاطئة، فمن الطبيعي كذلك أن يدعم الفكرة أو الممارسة السليمة. وأود أن أضيف هنا، فيما يخص ورود بعض استعمالات الألفاظ القرآنية مثل الركوع والسجود وغيرهما في الشعر الجاهلي أن القرآن الكريم نزل لكي يفهمه ويقتنع به الجاهليون، ومن ثم لا بد أن يستخدم ألفاظًا يعرفون ويمارسون استعمالها ومضمونها ومن غير الوارد أن ينزل بألفاظ غريبة عليهم، وفي هذا المجال فإن القرآن يحرص في مناسبات عديدة على أن يذكر بهذه الحقيقة وهي أنه نزل بلسان عربي يعقله أو يفهمه سامعوه أو أنه نزل بلسان عربي "مبين"، أي: إن هدفه هو الإيضاح والإبانة، وما كان لهذا الإيضاح أن يتم لو كانت ألفاظ القرآن غريبة على الجاهليين (22). وأما عن إشارة مثل وصف نوح بالأمانة التي وردت في شعر النابغة، فإن النابغة إن لم يكن نصرانيا فقد كان على صلة دائمة ببلاط الغساسنة وهم نصارى، ومن ثم يعرفون أسفار "العهد القديم" أو التوراة التي يرد فيها ذكر لنوح ووصف له بالأمانة (23)، والشيء ذاته يقال عن بقية الإشارات أو الألفاظ الدينية التي يوردها أصحاب هذا الرأي، ولعل أهم إشارة بينها هي الإشارة إلى "الله" عند عدد من شعراء الجاهلية. والحقيقة الثابتة في هذا الصدد هي أن "الله" كمعبود لم يكن غريبًا عن شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، فقد ورد "الله" بهذه الصفة في جنوبي شبه الجزيرة وشماليها ووسطها في نقوش لحيانية وثمودية وصفوية ومعينية ترجع أول مجموعة منها إلى القرن الخامس ق. م. أي: قبل ظهور الإسلام بأكثر من ألف سنة، وتشير بعض هذه النصوص التي ترجع إلى هذه الفترة المبكرة إلى أن "الله" قد احتل مركز الصدارة بين المعبودات الأخرى، كما تشير آيات القرآن الكريم إلى أن أهل مكة الذين جادلوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يتحولوا إلى الإسلام كانوا يعرفون "الله" بصفته أكبر الآلهة، وأنهم كانوا يتشفعون لديه ويتزلفون إليه ببقية الآلهة الأخرى "الصغيرة" "أ".
ثم أنتقل إلى نقطة ثالثة فيما يخص مضمون الشعر الجاهلي الذي رأى منكرو وجوده أن ما بين أيدينا منه لا يصور الحياة في المجتمع الجاهلي في جوانبها المتعددة، ومن ثم فهو لا يمكن أن يكون أصيلًا، ولكنه منحول. وفيما يخص أحد هذه الجوانب، حسبما يرون، فإن ما وصلنا من الشعر الجاهلي خالٍ من الإشارة إلى المعتقدات والممارسات الدينية الوثنية، وإن هذا أمر لا يتصل إزاء ما نعرفه من القرآن الكريم من أن أهل قريش كانوا حريصين على عقيدتهم وأنهم جادلوا عنها ووصل تشبثهم بها إلى درجة الكيد للرسول -صلى الله عليه [وآله] وسلم- ثم إلى اضطهاده هو وأتباعه. وأود أن أذكر هنا أن هذه الملاحظة من جانب المعارضين لأصالة الشعر الجاهلي الموجود بين أيدينا صادقة في عمومها من حيث ندرة الإشارة إلى العقائد والممارسات الوثنية على الأقل إن لم يكن من خلوه منها تمامًا، "ب"، ولكن في مقابل ذلك ينبغي أن ندخل في اعتبارنا موقف الإسلام الذي كان من المنطقي أن يتخذ موقفا متشددا إزاء كل ما يتصل بالوثنية أو يذكر بها أو يغري بالعودة إليها، ومن بين ذلك مواضع الشعر التي تمجِّد الوثنية وتتغنى بها، ومن ثم فلنا أن نتصور أن أي أبيات وردت فيها إشارات واضحة إلى العقائد أو الممارسات الدينية الجاهلية كان من الطبيعي أن تُسقَط من رواية الشعر الجاهلي بعد ظهور الإسلام، وهو موقف يمكن أن نجد له شبيها في ابتعاد الفن العربي في العصر الإسلامي عن النحت خشية أن تذكِّر التماثيل المنحوتة بأوثان الجاهلية، مع أن هذا الفن كان موجودا ومزدهرا في عدد من أقسام شبه الجزيرة العربية لفترات طويلة في المرحلة السابقة للإسلام "ج".
على أن الأمر لا يقف عند هذا في الرد على منكري أصالة الشعر الجاهلي من هذا الجانب، فاختفاء الإشارة الظاهرة المباشرة إلى العقائد والممارسات الوثنية في الشعر الجاهلي ليس دليلا على خلو هذا الشعر منها. وفي هذا الصدد فإن الشعر، أي شعر، لا يمكن تفسيره على أنه تعبير حسي مباشر عن الأشياء والكائنات والمشاعر، فالشاعر ابن بيئته بكل ما لها من أبعاد، سواء في ذلك البعد المادي أو الحسي الذي يتمثل في العالم المحسوس المباشر أو البعد السيكولوجي الذي يتمثل في التركيب النفسي للفرد والمجتمع نتيجة للظروف الخاصة التي تحيط بهما، أو البعد الميثولوجي الذي يتمثل في المعتقدات الأسطورية التي عبَّرت مجتمعات العصور القديمة من خلالها عن تصورها لعلاقاتها بالعالم المحيط بها بكل ما فيه من مظاهر طبيعية وكونية ومن قوى إلهية تحكم كل هذه المظاهر وتحركها وتوجهها. وقد تمثلت هذه المعتقدات في قدر غزير من الأساطير التي شكلت قسمًا أساسيًّا من تراث المجتمعات القديمة، وبوجه خاص قبل نزول الأديان السماوية التي حددت للأفراد والمجتمعات الأصول التي تلتزم بها في تصورها للقوى الإلهية. وقد شكل الشعر مجالا أساسيا ظهرت فيه هذه الأساطير في هيئة صور عبَّر المجتمع من خلالها عن القوى الإلهية التي تتحكم في مظاهر الخلق والحياة والموت والبعث والأمومة والخصوبة وغيرها من المظاهر التي تحيط به، "د".
والمجتمع الجاهلي لم يكن، ويصبح من المناقض لطبيعة الأشياء أن نتصور أنه كان، بدعًا في هذا المجال، فقد كان مجتمعا له تصوراته الميثولوجية التي يعبر من خلالها عن القوى الإلهية التي يؤمن بها، والشعر الذي وصلنا من هذا المجتمع فيه قدر كبير من هذا التصوير، بل إن الصورة غلبت على التعبير اللغوي في هذا الشعر بحيث أصبحت ركنا أساسيا أو أصلًا من أصول التعبير الشعري الجاهلي. وحقيقة إن الشراح الذين تناولوا الشعر الجاهلي بالتفسير في العصر الإسلامي "ولا يزال يتبعهم عدد من الباحثين في الوقت الحاضر" قد قصروا جهودهم في تفسير هذه الصور والتشبيهات أو المجازات والاستعارات التي تضمنتها على البعد الحسي المباشر، فإذا قال شاعر: إن المرأة تشبه الشمس كان تفسيرهم أن الشبه بين الاثنين هو البهاء، وإذا شبهت بالظبي فإن ذلك لطول جيدها وهذه علامة جمال، فإذا كان التشبيه بالمهاة فإن ذلك سببه الحور في العينين وهكذا، "هـ". ولكن يبقى هذا التفسير قاصرًا على بعد واحد من أبعاد الشعر، ويبقى هناك البعدان الآخران لتفسير هذا الشعر حتى نفهمه على وجهه الكامل، وهما البعد السيكولوجي والبعد الميثولوجي -ومن خلال التفسير الذي يتصل بهذا الأخير "الميثولوجي" يجب أن نبحث عن الأساطير التي تضم المعتقدات الدينية للمجتمع الجاهلي من خلال الصور التي يزخر بها شعر هذا المجتمع، ومن خلال التفسير الذي يتصل بالبعد السيكولوجي يجب أن نستكمل صورة هذه المعتقدات.
وقد قدم باحث معاصر تفسيرًا ميثولوجيًّا مقنعًا لعدد من الصور التي ترمز إلى الشمس وإلى الزهرة كمعبودين من الثالوث الكواكبي الذي شاعت عبادته في مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، "و". وابتدأ الباحث من أمر ثابت هو أن الشمس صورت في النقوش السامية الشمالية في صورة امرأة عارية تعبيرًا عن الأنوثة والخصوبة وأن عديدا من الدمى أو التماثيل الصغيرة التي عثر عليها المنقبون الأثريون في عدد من المناطق "من بينها مناطق تسكنها شعوب سامية" تمثل الآلهة الأم في هيئة امرأة لا تتضح معالم وجهها وإنما تتضخم أعضاء جسمها التي تتصل بالخصوبة والأمومة، "ز". وانتهى إلى أن الشعر الجاهلي يضم قدرًا كبيرًا من الصور التي تمثل المرأة والتشبيهات التي شبهت بها في صورة مثالية ترمز إلى الشمس الآلهة الأم من جهة، وإلى الزهرة الآلهة البنت التي تقابل إنانا في وادي الرافدين وعشتار في سورية وأفروديتي عند اليونان وفينوس عند الرومان من جهة أخرى، بكل ما يرتبط بصورها هذه من مواقف الحب الجسدي التي تزخر بها أساطير هذه المجتمعات.
وأول ما يلاحظه الباحث في هذا المجال هو أن الأوصاف التي يقدمها الشعراء الجاهليون لصاحباتهم أو محبوباتهم يجمعون فيها كل الصفات المثالية للمرأة الجميلة "وفي بعض الأحيان يجمع الشاعر منهم كل هذه الصفات في قصيدة واحدة كما فعل امرؤ القيس في وصف صاحبته فاطمة، وقيس بن الحطيم في وصف صاحبته عمرة": قدها، شعرها، وجهها، نظرتها، فمها، لعابها، ترائبها، خصرها، سيقانها، رائحتها، مشيتها، وهكذا. وفي هذا الصدد نلاحظ أمرين: أحدهما هو أن كل تفاصيل الجمال الواردة نمطية لا تختلف من شاعر لشاعر وهو أمر غير معقول؛ إذ لا يتصور أن تكون كل صاحبات الشعراء نسخة مكررة، والأمر الثاني هو أنه من غير المعقول أن تجتمع كل تفاصيل الجمال "حتى بصرف النظر عن نمطيته" في امرأة واحدة، وهكذا لا يمكن أن تكون الأوصاف التي يقدمها هذا الشاعر أو ذاك هي أوصاف صاحبته بالذات، وأزيد على هذين الأمرين أمرًا ثالثًا متصلًا بهذا الأمر الثاني، وهو أن الشاعر غير مجبر على وصف كل تفصيلة من تفاصيل جسم صاحبته أو صفاتها، إذا لم تكن كل هذه التفاصيل جميلة "وهو الأمر الطبيعي" ولكن الشعراء دأبوا مع ذلك على وصف كل هذه التفاصيل"، ومن ثم فإن المعقول والممكن هو أن تكون الصورة المقدمة هي صورة "المرأة المثال" التي لا يمكن أن تكون إلا صورة مجسدة من الآلهة المعبودة بكل ما في هذه الآلهة من أوصاف وصفات مثالية، وكأن الشاعر يقول: إن صاحبتي آلهة في جمالها.
ويدعم هذا الافتراض صور التقديس التي تحيط بالمرأة، بشكل أو بآخر، عند ذكرها في عديد من المناسبات عند شعراء الجاهلية، فهي عند امرئ القيس تضيء الظلام كأنها "منارة ممسي راهب متبتل"، وعند ابن الخطيم "تمشي كمشى الزهراء" كما أنها قد "نمتها اليهود إلى قبة دوين السماء بمحرابها"، وعمرو بن معد يكرب يمشي "حولها ويطوف فيها" وحتى الأعشى الذي يتهكم بالمرأة، "ح"، يتحدث عن "محرابها" وعن قومها الذين "يمشون حول قبابها" درءًا للمتطفلين وحذرًا من أن "يطاف ببابها" وهكذا.
كذلك يدعم ربط صورة المرأة المثالية بالشمس المعبودة الأوصاف التي ترد في الشعر الجاهلي والتي تربط بين لون الشمس ولون المرأة، فطرفة بن العبد يرى أن فم صاحبته قد "سقته إياه الشمس" كما يرى أن وجهها "نقي اللون" "كأن الشمس ألقت رداءها عليه". كذلك نجد الشعراء في هذا الصدد يرون من علامات الجمال فيمن يتغزلون فيهن أن يميل لونهن إلى الصفرة "التي هي لون الشمس" سواء أكانت هذه الصفرة طبيعية أم نتيجة لاستخدام طيوب التجميل، فصاحبة امرئ القيس "كبكر مقاناة البياض بصفرة" وصاحبة ابن الخطيم تبدو "كأنما شفَّ وجهها نزف" فبدا شاحبا مصفرا، يتغزل في فتاة لا تزال "غريرة" في عنفوان صباها فيذكر أنها "كالحقة الصفراء".
كذلك نجد وصفًا من أوصاف المرأة يتردد كثيرا فيما وصل إلينا من الشعر الجاهلي، ويصل بين المرأة والشمس من جهة، والزهرة من جهة أخرى، وهو النور الذي يبرز مقترنًا بالندى "والإشارة واضحة إلى الفجر حيث مقدمات الشروق" حين يتحدث طرفة عن فم صاحبته عند ابتسامها فيخيل إليه "كأن منوّرًا تخلل حد الرمل دعص له ندى"، كما نجد أن صاحبة امرئ القيس "تضيء الظلام بالعشاء"، كما "يضيء الفراشَ وجهُها لضجيعها" وهكذا.
ثم يخلص الأستاذ الباحث بعد ذلك إلى الصفة الموضوعية الأساسية، وهي صفة الخصوبة التي تمثلها أشعة الشمس وأمومة المرأة. وهنا نجد الشعراء الجاهليين يشبهون المرأة بالغزالة والمهاة والنخلة والظبية وهي في حالات الأمومة وما يتصل بذلك من فكرة الإخصاب، فهم يقدمون المرأة في عدد من الصور من بينها "الظبية الخذول" "أي: التي خذلت صواحبها وأقامت على رعاية ولدها"، والمهاة المطفلة "أي: كثيرة الأولاد"، والنخلة الموسقة "أي: التي نضج ثمرها ونضج حملها" وبيضة الخدر، "ط"، وكلها معانٍ تتردد، على سبيل المثال، في معلقة امرئ القيس وفي قصيدته التي يبدؤها بقوله: ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي، وأود أن أضيف في صدد الحديث عن المرأة رمزًا للأمومة أن امرأ القيس لا ينسى هذه الصفة حتى وهو يستمتع حسيا بصاحبته، وكأنه يريد أن يقرن "المرأة المثال" بالشمس آلهةً للأمومة، وبالزهرة آلهةً للحب الحسي حين يقول، والإشارة هنا إلى ابن صاحبته:
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له *** بشق وتحتي شقها لم يحوَّلِ
ثم يختم الباحث حديثه بتدعيم استنتاجه بأن صور المرأة التي يعرضها الشعراء الجاهليون هي في حقيقتها صور للمرأة المثالية التي ترمز لعبادة الشمس، فيذكر أن المرأة شبهت بالغزالة "وهي ترد كحيوان مقدس في عدد من الروايات والأشعار" وأن اللغويين جعلوا الغزالة اسما من أسماء الشمس "القاموس المحيط، مادة: غزل"، وأن قرون الغزالة تظهر في الشعر الجاهلي متصلة بالشمس في بعض أبيات "ي"، بداية واحد منها هي "حتى إذا ذَرَّ قرن الشمس" وبداية آخر هي "حتى إذا ظن في قرن شمس غالبة" كما تظهر أحيانا كوصف لشعر المرأة حين يصف المرقش أبكارًا في الحي بأنها "لم تعقر قرونها لشجو" وحين يقول سويد بن أبي كاهل والإشارة إلى صاحبته: "وقرونًا سابغًا أطرافها". وأخيرا، فقد يكون من خير ما يجمع بين المرأة والغزالة والشمس هذا البيت:
تمنح المرأة وجهًا ضاحكًا *** مثل قرن الشمس في الصحو ارتفع
هذا عن التفسير الميثولوجي الذي يربط بين المرأة في صورتها المثالية وبين الشمس المعبودة الأم والزهرة المبعودة الأنثى. وهو تفسير أراه مقنعًا في دلالته على أن الشعر الجاهلي لم يكن خلوًّا من الحديث عن المعتقدات الدينية في مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، ومن ثم تسقط حجة المعارضين لأصالة هذا الشعر التي أقاموها على أساس أنه خلو من الإشارة إلى هذه المعتقدات. ولعل خير ما أختم به التدليل على أصالة الشعر الجاهلي، فيما يخص هذا الجانب من حياة المجتمع العربي الجاهلي، هو التفسير السيكولوجي الذي قدمه باحث معاصر آخر عن شعر امرئ القيس "ك". ومن خلال هذا التفسير يرى الباحث، بعد استقرائه لما نعرف عن حياة امرئ القيس، أنه افتقر إلى حنان الأمومة في طفولته بشكل واضح، ومن ثم فهو "يفتقد دفء الأمومة، ويحن إلى المرأة الأم" ل" وهو يفصح عن هذا المعنى الذي يتلمسه حين يتحدث عن محبوبته فيدخل في وصفه فكرة الأمومة والطفولة حين يقول:
تصد وتبدي عن أسيل وتتَّقي *** بناظرة من وحش وجرة مُطفل
وهو يعود مرة أخرى إلى هذا المعنى بتحديد أكثر وأعمق من حيث الدلالة النفسية عندما يقول:
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعًا *** فألهيتها عن ذي تمائم مُغْيَل
وهو بيت يرى فيه الباحث إشارة واضحة إلى أن الشاعر كان يتوق إلى التعبير عن أنه كان يخيل موقع الطفولة من حبيبته، وذلك بعد أن يلهيها عن طفلها وحملها ورضاعها إلهاء، فنحن هنا أمام شاعر يبحث عن دفء الأمومة في المرأة أكثر مما يبحث عن أي شيء آخر "م".
على أن الباحث يرى أن معنى الأمومة لا يقتصر ذكره في شعر امرئ القيس على هذا السياق العام، وإنما يقرنه الشاعر في شكل واضح ومحدد بإضفاء القدسية الدينية على المرأة كأنثى وكأم في الوقت ذاته* ن* حين يقول في وصف فتاتين:
هما نعجتان من نعاج تبالة *** لدى جؤذرين أو كبعض دُمى هَكِرْ
فهنا معنى الأمومة واضح من تشبيه تعلق الفتاتين بمن يحبانهما بتعلق البقرتين بجؤذريهما. ولكن المغزى الديني للأمومة يبدو كذلك واضحا من تشبيههما بالدمى، والدمية هي الصنم، وهكر مدينة باليمن "حيث شاعت عبادة الشمس كواحدة من الثالوث الكواكبي" وفي بعض الروايات اسم لدير بها "لسان العرب، مادة: هكر". وهكذا يتطابق التفسير السيكولوجي لموقف امرئ القيس من المرأة الذي يرى الباحث أنه "يجمع بين الاشتهاء الجسدي والشعور الروحي العميق بقدسية الأمومة في نسق واحد" وبين التفسير الميثولوجي الذي ظهر منه أن الصور التي ظهرت فيها المرأة في الشعر الجاهلي كانت فيها في حقيقة الأمر رمزا لأمومة مقدسة على المستوى الديني للإلهتين المعبودتين: الشمس في أمومتها من جهة، والزهرة في أنوثتها من جهة أخرى، لتصبح هذه الصور إشارات إلى المعتقدات الدينية التي وردت في الشعر الجاهلي.
وأنقل الحديث الآن، بعد معالجة الجانب الديني في الشعر الجاهلي، إلى الجانب الثاني الذي افتقده منكرو أصالة ما وصل إلينا من هذا الشعر، وهو الحياة العقلية؛ فغياب هذا المظهر، حسبما ذكروا، يتناقض مع قدرة الجاهليين على مجادلة الرسول -صلى الله عليه [وآله] وسلم- وهو جدال ظهر فيه شيء كثير من الوعي والذكاء. وهنا يرد أحد الباحثين بأن الشعر الجاهلي ليس في الحقيقة خلوا من هذه الحياة العقلية (24) ونحن في الواقع نجد في عدد من مواضع الشعر الجاهلي ما يؤكد هذا الرد. ويكفي أن ننظر، على سبيل المثال، في الأبيات الأخيرة من معلقة زهير بن أبي سلمى أو في بعض الأبيات التي جاءت في قصيدة النابغة الذبياني التي يتحدث فيها عن وشاية ضده لدى النعمان بن المنذر أمير الحيرة لكي نتأكد من هذا الرد (25). كما أضيف إلى هذا التأييد أننا يجب ألا ننتظر من الشعر أن يغلب عليه الطابع العقلاني وإلا نكون قد أخرجناه عن طبيعته.
والحديث عن الجوانب الأخرى للحياة في العصر الجاهلي، وهي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينكر المعارضون وجوده، أو على الأقل وجوده بشكل واعٍ، هو الآخر حديث مردود عليه. ففي الجانب السياسي نجد العلاقة مع الروم "البيزنطيين" واضحة ومفصلة في شعر امرئ القيس وهو يصف رحلته إلى بلاد الروم ليلتقي بالقيصر، ويعرفنا بالسبب الذي دعاه إلى هذه الرحلة ويصف لنا الطريق التي قطعها إلى هناك عبر سورية، ويحدد لنا الأماكن التي مر بها على هذه الطريق وما الذي ينتظره من قيصر، بل يزيد على ذلك ليذكر احتمال نجاحه أو فشله بعد هذه الرحلة. والأعشى يحدثنا عن جانب آخر من علاقات شبه جزيرة العرب بالقوى الدولية الموجودة آنذاك؛ فيشير، على سبيل المثال، إلى الصراع بين الحبشة والإمبراطورية الفارسية على اليمن وهكذا (26).
والشيء ذاته يقال عن الجانب الاقتصادي من الحياة الجاهلية، فالشعر الجاهلي لم يقتصر على تصوير الجود والكرم والإسراف الذي يشير إلى الثروة، ولم يتجاهل المعاناة من الحرمان والتعبير عن هذه المعاناة وعن الهوة السحيقة التي تفصل بين الطبقات، وأمامنا في هذا المجال مجموعة من الشعر الجاهلي الذي يعرف بشعر الصعاليك وفيها تظهر المرارة التي أحستها هذه الطبقة المحرومة في شعر الشّنْفَرى أحد هؤلاء الشعراء، وفيها كذلك ما كان يلجأ إليه أفراد هذ الطبقة من ممارسات من بينها السرقة من أجل سد الرمق، واللجوء للحيلة لتحقيق الهرب من ملاحقة الطبقة المسيطرة التي لم تكن تتورع عن التصفية الجسدية في سبيل إحكام سيطرتها على موارد الإنتاج، وهو موقف يصوره تأبط شرًّا "شاعر آخر من شعراء الصعاليك" تصويرًا يعبر، رغم ما يشيع فيه من روح مرحة ساخرة، عن هذه الهوة الساحقة بين طبقات المجتمع الجاهلي (27).
ولا يقصِّر شعر الجاهليين في تصوير الحياة الاجتماعية إلى جانب النواحي الأخرى من حياة المجتمع الجاهلي. فرغم أن الأغلبية الساحقة من الصور التي يقدمها لنا هذا السفر هي عن حياة البادية، إلا أن حياة البحر تظهر في عدد من الصور، وإن كان هذا العدد ضئيلًًا، ولا غرابة في هذا الإقلال من صور الحياة البحرية في الشعر الجاهلي، فابتداء من القرن السادس الميلادي، وهو القرن الذي ترجع إليه أغلب قصائد الشعراء الجاهليين كان هناك ركود في النشاط البحري لعرب شبه الجزيرة، أمام سيطرة اليونان على الخطوط الملاحية بين البحر المتوسط والمحيط الهندي (28). ومع هذه الظروف التي أدت إلى الإقلال من الشعر البحري، فإن ما قدمه لنا هذا الشعر من الصور لا يكتفي بالنظرة العامة أو التشبيه العابر، ولكنه يتجاوز ذلك إلى عدد من التفاصيل نجدها في شعر طرفة بن العبد والمثقب العبدي، وهي تفاصيل تتناول أسماء بعض أجزاء السفينة وطريقة سيرها وتحديد الطرق المائية التي تتخذها والمرافئ التي تتوقف عندها أو تمر بها، بل نحن نجد اسمًا لأحد الملاحين العرب، يبدو أنه كان مشهورًا آنذاك، ضمن هذه التفاصيل (29).
ثم أنقل الحديث الآن إلى مناقشة ما أورده أصحاب الرأي المعارض لوجود الشعر الجاهلي فيما يخص صحة روايته ومدى أمانة العلماء من رواة القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة. وفي هذا الصدد أشير إلى ما أسلفت ذكره من أن الرواية قد تؤدي إلى تغيير أو تحوير أو زيادة أو نقصان، ولكنها لا تصل إلى أن يندثر الشعر اندثارًا كاملًا، بل لا تصل إلى أن تتغير الأفكار أو المواضيع الأساسية للشعر تغيرا كاملا. وقد رأينا أن الإلياذة والأوديسية قد تداولها اليونان على هيئة مقطوعات وأناشيد متفرقة منذ القرن الثاني عشر ق. م. قبل أن يتم إخراجها في صورة معلقتين في أواسط القرن التاسع ق. م. ثم ظلت تنتقل بالرواية الشفهية حتى دونت بعد ذلك بقرنين أو أكثر، ومع ذلك فلم تندثر ولم تتغير مواضيعها وأفكارها. وأزيد هنا أن كل كشف أثري قام به المنقبون الأثريون منذ القرن الماضي حتى الآن كان يؤكد جانبا آو آخر مما جاء في هاتين الملحمتين، بل إن كشوفا أثرية أخرى في مناطق غير يونانية وتخص حضارات غير يونانية لا تفتأ تؤكد علاقات بين اليونان وبين هذه الحضارات أشارت إليها بعض مقطوعات الملحمتين -وهكذا يبقى الشعر اليوناني الذي ضمته الملحمتان حتى الآن مصدرا أساسيا لحياة اليونان في العصر الذي يمتد عبره هذا الشعر(30) .
والشيء ذاته ينطبق، بالقياس، على الشعر الجاهلي الذي لم تستمر روايته مدة تضاهي في طولها المدة التي استمرت فيها رواية أشعار الملحمتين اليونانيتين -قد يتغير فيه شيء من هنا أو يزاد عليه أو ينقص منه شيء من هناك ولكن يظل محوره كما هو وتظل خطوطه الأساسية كما هي دون تغيير، ونحن إذا نظرنا في الواقع إلى عدد من القصائد الجاهلية ولتكن بعض القصائد الطوال التي اشتهرت باسم المعلقات سنجد فيها مصداقًا لهذا الحكم، فكل منها تظهر فيها شخصية الشاعر الخاصة به، المستقلة عن غيره، بكل محورها وملامحها. فرغم أن أغلب الشعراء اشتركوا في بكاء الأطلال والتغزل في المحبوبة، ووصف البادية والناقة والفرس، إلا أن كل شاعر كانت له نقطة اهتمامه واتجاهه الذي يميزه عن الآخرين، فامرؤ القيس هو شاعر اللهو والسعي وراء مُلْك يريد أن يحصل عليه ولكنه لا يعطي ذلك من الجد ما هو جدير به ويكاد يقدم اليأس من تحقيق بغيته على الإصرار على الوصول إليها. والنابغة هو شاعر البلاط والاعتذاريات الذي ينتقل من بلاط إلى البلاط الذي يناصبه العداء، ثم يعود إلى أمير البلاط الأول ليعتذر ويقدم خضوعه وولاءه من جديد، وعمرو بن كلثوم هو شاعر الانفعال الغاضب والعصبية القبلية التي لا تعرف للآخرين حقوقًا، وزهير بن أبي سلمى هو شاعر التعقل والسلام والمصالحة بين المتحاربين "من عبس وذبيان" والتحذير من الحقد ومن ويلات الحرب وأهوالها والحكمة المتأنية الهادئة، والحارث بن حلزة هو شاعر المهاترة والتشهير بخصومه والتزلف إلى صاحب السلطان والدس لديه ضد القبيلة المعادية لقبيلته. ونستطيع أن نذكر الشيء ذاته عن الفرق بين الشعراء الذين كانوا يتغنون بالإسراف والإفراط في الشراب مثل طرفة وزهير، والشعراء الصعاليك الذين كانوا يئنون من شظف العيش ويفضلون صحبة وحوش البادية على بني قومهم مثل الشنفرى وتأبط شرًّا، وهكذا (31).
كذلك فيما يخص الحديث عن رواية العصر الجاهلي فإن هناك أكثر من سبب يدعونا إلى تصديقها في جملتها بغض النظر عن أية تفصيلات جانبية فيها. فالقبائل العربية في العصر الجاهلي كانت حريصة كل الحرص على القصائد التي تسجل انتصاراتها وكانت تعتبرها أغلى ما تملك وترويها جيلًا بعد جيل. بل لقد كان لكل قبيلة راويتها الذي يعني بالاحتفاظ في ذاكرته بهذه القصائد وبخاصة في البادية التي لم يكن شيوع الكتابة فيها بمثل ما كان عليه في الحضر. ونحن نستطيع في الواقع أن نرى أثر ما تميزت به رواية الشعر الجاهلي من قوة واستمرار فيما نراه من أشعار القرن الأول الهجري مثل جرير والفرزدق وذي الرمة. لقد استخدم هؤلاء ذخيرة الشعراء الجاهليين مرارا متكررة متناولين الموضوعات ذاتها والأسلوب ذاته. حقيقة إنهم قد يقدمون على تحوير هنا أو تحسين هناك، ولكن يبقى التزامهم بهذه التقاليد الشعرية الجاهلية دون تغيير. وقد كان هذا في الواقع منتظرًا، إذ لم توجد فجوة زمنية بين شعراء الجاهلية وشعراء القرن الأول الهجري، وما دمنا قد وصلنا إلى شعراء القرن الأول ورواية الشعر الجاهلي على قوتها، فقد أصبحنا إذن على عتبة القرن الثاني، وهو عصر العلماء الرواة الذين وصل إلينا عن طريقهم الشعر الجاهلي (32).
ومع ذلك فإن الدلائل تشير إلى أن الرواية لم تكن وحدها هي وسيلة حفظ الشعر، فقد عرف الجاهليون الكتابة. ولا أشير هنا إلى النقوش التي اكتشفت في شبه الجزيرة العربية والتي كتبت بخط مغاير للخط العربي الذي استمرت الكتابة به بعد ظهور الإسلام، وهي نقوش موغلة في القدم بعض الشيء. وإنما أشير إلى النقوش التي كتبت بهذا الخط الأخير الذي أخذ يتدرج في شكله ابتداء من القرن الثالث الميلادي حيث نجد بعض كلمات هذه النقوش مماثلة للخط العربي المعروف في العصر الإسلامي، ومرورا بالقرن الرابع حيث تزيد نسبة هذه الكلمات بشكل غالب، إلى القرن السادس حيث يطغى استعمال هذا الخط على النقوش لكي يظهر بعد ذلك وحده في النقوش التي ترجع إلى عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم (33).
وقد يوجد من يقول: إن النقوش وحدها لا تنهض دليلًا على انتشار الكتابة فيما قبل الإسلام على نطاق واسع أو حتى على نطاق محسوس، فالنقوش التي عثر عليها تشير كلها تقريبا إلى ملوك "قد لا تعني كلمة ملك هنا أكثر من رئيس قبيلة" وقد نفذت لتخليد مناسبات مهمة، ومن ثم فهي لا تشير إلى ممارسة يومية على المستوى الشعبي، وفي الواقع فقد أشار القرآن الكريم إلى العرب إشارة مباشرة على أنهم أميون { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } [الجمعة: 2] . وقد شاع معنى الأمية منذ العصر الإسلامي على أنه عدم الإلمام بالقراءة والكتابة ومن ثم أصبح التصاق هذا الوصف بعرب الجاهلية أمرا واردًا (34). ومع ذلك فالأمية التي تذكرها الآية الكريمة لا تعني الجهل بالقراءة والكتابة وإنما تعني الجهل بما جاء في الكتب السماوية من قيم روحية وأخلاقية واجتماعية، والنصف الثاني من الآية يشير إلى هذا المعنى بشكل واضح، وهو معنى يؤكده القرآن في ثلاث آيات أخرى يفرق فيها بين أهل الكتاب وبين الأميين، وفي إحدى هذه الآيات يزيد على هذه التفرقة إشارة مباشرة إلى أن بعض هؤلاء "الأميين" كانوا يكتبون {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: 78، 79] (35) وفي الواقع فإن ممارسة الكتابة في المجتمع الجاهلي أمر يؤكده القرآن بشكل متكرر متواتر، والقرآن الكريم إلى جانب وصفه ككتاب من عند الله لا يرقى الشك إلى ما جاء فيه، هو كذلك وثيقة ظهرت في هذا المجتمع الجاهلي وكانت آياته تدون في عهد الرسول أي: في وقت نزولها كما جمعت هذه الآيات المدونة في عهد الخليفة عثمان بن عفان بعد سنوات من موت الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يقتصر القرآن على الإشارة إلى الكتابة ولكنه يشير إلى الكتب والكتاب وما كانوا يتخذونه من أدوات الكتابة. وفي هذا الصدد يرد ذكر الكتابة 51 مرة، وسطور الكتابة ثلاث مرات، والكتاب 261 مرة، والكتَّاب مرتين، والقلم ثلاث مرات؛ منها مرة يقسم فيها به وتسمى سورة باسمه، والصحف ثماني مرات والرق الذي يكتب عليه مرة واحدة (36).
وأبادر هنا فأقول: إننا لا نستطيع أن نقول: إن هذه الممارسة للكتابة في العصر الجاهلي كانت أمرا شائعا في كل أقسام المجتمع. ففي مجال المعاملات التجارية يذكر القرآن {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] وهي إشارة تدل على أن قلة من القوم هم الذين كانوا يعرفون الكتابة. وهو قول تؤكده آية أخرى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] (37) وهي إشارة تفيد كذلك أن الكتابة كانت منتشرة بين أهل الحضر في المدن حيث يقيم التجار أكثر منها في البادية التي تمر بها القوافل التجارية في أثناء سفرها. ولكن مع ذلك تبقى ممارسة الكتابة في المجتمع الجاهلي قائمة ويبقى عدد الذين يعرفون الكتابة كافيًا لتدوين العقود والديون وبقية المعاملات بين التجار في مجتمع كانت التجارة تشغل فيه حيزًا أساسيًّا بين الموارد الاقتصادية.
وهنا أعود إلى حفظ الشعر عن طريق الكتابة فأقول: إنه إذا كان العرب حريصين على تسجيل معاملاتهم التجارية عن طريق الكتابة، فإن حرصهم لن يقل عن ذلك، إن لم يزد عليه في الواقع، على تدوين أشعارهم. فالقبائل، كما أسلفت، كانت تنظر إلى القصائد التي تعدد أمجادها على أنها سجل لتخليد هذه الأمجاد، وهو أمر يتضح لنا من فخر القبائل بانتصاراتها وتمييز الأيام التي حدثت فيها هذه الانتصارات على غيرها من الأيام على أنها أيام مشهودة ومشهورة يعرفها الجميع دون حاجة إلى استيضاح أو تفصيل (38)، وما دام الكتاب أو من يعرفون الكتابة موجودين فيبدو أمرا طبيعيا ومنطقيا أن تلجأ إليهم هذه القبائل لتسجل القصائد التي يرد فيها ذكر هذه الانتصارات -وهو أمر يصبح واردا بشكل أكثر إذا أدخلنا في اعتبارنا أن بعض هذه القصائد كان يكتب على امتداد أكثر من مناسبة كما هو واضح، على سبيل المثال، في معلقة عمرو بن كلثوم، وما دام الأمر كذلك فإنه يصبح طبيعيا أن يحرص الشعراء الكبار، على الأقل، على تدوين قصائدهم التي نجدها مليئة بما يفخرون به من فروسية وبطولة وكرم وإباء، يتشبثون بذكر ذلك كله بمناسبة وبغير مناسبة ويصلون في حرصهم هذا إلى قدر كبير من المبالغة كأنما يريدون أن يسمعوا كل قبائل العرب بهذه الأمجاد.
ويبقى الحديث في نهاية هذا الموضوع عن الرواة من علماء القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة وما دار بينهم من اتهامات يشكك من خلالها كل فريق في رواية الفريق الآخر. وعلى سبيل مثال واحد من هذه الاتهامات فقد نُسب إلى المفضل بن محمد الضبي، صاحب "المفضليات" أنه قال عن حماد الراوية: إنه "رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ثم يدخله في شعره، ويحمل ذلك عنه في الآفاق، فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد، وأين ذلك؟! ". ويرد أحد النقاد من المستشرقين وهو تشارلز لايال charles lyail على هذا الحديث المنسوب إلى المفضل، أنه على افتراض أن المفضل قال ذلك فعلًا -حسبما يروي صاحب الأغاني- وحتى لو سلمنا بأن حمادًا كان ينحل الشعر فيشبه شعر الشاعر الحقيقي بحيث يستحيل التمييز بين الأصيل والمنحول، فكيف أمكن أن يعرف أنه منحول إذا لم يكن هناك من يعرف القصيدة في صورتها الأولى من غير ما أضيف إليها من زيادات موضوعة؟!. فإذا أدخلنا في اعتبارنا أن المفضل كان من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على تمييز صحيحه من منحوله يصبح الاستنتاج السليم هو أن المفضل نفسه كان يعرف الشعر الصحيح. ثم يستطرد المستشرق في رده ليقول: إن حمادًا إذا كان يحاكي الشعر القديم فإن ذلك يدل على وجود أصل يحاكيه حماد، فإذا قلنا: إن ما بين أيدينا ليس سوى الصور المنحولة، وإنه لم يتبق شيء من الأصل نفسه فإن ذلك أمر لا يقره الفهم السليم للأمور (39).
ومما يمكن أن نضيفه في هذا الصدد إلى رأي المستشرق، رأي نادى به أحد العلماء العرب وهو ابن جني في كتابه "الخصائص" يشير فيه إلى الخصومة بين العلماء الرواة من أهل البصرة وأهل الكوفة، وهي الخصومة التي أدت إلى تبادل قدر كبير من الاتهامات فيما بينهم، ومؤدى هذا الرأي هو أن هذه الاتهامات المتبادلة في حد ذاتها أمر يدعو إلى حرص هؤلاء العلماء والرواة على تحري الدقة فيما ينسبونه إلى الشعراء من شعر. والسبب في ذلك هو أنه "إذا سبق إلى أحدهم ظنه، أو توجهت نحوه شبهة سُبَّ بها وبُرئ إلى الله منه لمكانها" (40).
وفي الواقع فإنه لا ينبغي لنا أن نبالغ في صحة هذه الاتهامات المتبادلة بين العلماء الرواة من أهل الكوفة وأهل البصرة. فإن سبب هذه الاتهامات يمكن أن نفهمه بسهولة إذا عرفنا أن علماء كل من المدينتين كانوا يشكلون منهجا أو مذهبا خاصا بهم في معالجتهم لرواية الشعر ومن ثم لقبول بعض القصائد واستبعاد البعض الآخر. فمنهج علماء البصرة كان فيه اتجاه نحو استخراج القواعد والقوانين التي يرون أنها تصلح قاعدة تقاس عليها صحة الشعر أو زيفه ومن ثم كانوا ميالين بالضرورة إلى التضييق في اختيارهم، التزامًا بما وضعوه من قواعد لا يمكن الخروج عنها، أما الكوفيون فقد كان منهجهم قائما على فهم روح اللغة واستبطان طبيعتها، ومن ثم فقد كانوا يقبلون صحة القصيدة طالما لم تخالف هذه الروح أو تغاير هذه الطبيعة دون التقيد بقواعد تعليمية مقننة، ومن هنا فقد كانوا يميلون نحو التوسيع. وطبيعي أن يؤدي هذا الاختلاف العلمي بين المدرستين الفكريتين إلى شيء من الاتهامات المتبادلة من حين إلى حين (41).
وفي ضوء هذا الاعتبار، وفي ضوء ما أسلفت الإشارة إليه من أن تدوين الشعر الجاهلي أو تدوين بعض منه على الأقل، ومن أن الرواية "أو الرواية والتدوين" كانت مستمرة بين العصر الجاهلي والقرن الأول الهجري كما سبق أن رأينا ذلك لدى شعراء هذا القرن الذين أسلموه إلى العلماء والرواة ابتداء من القرن الثاني، فإني أؤيد ما ذهب إليه أحد الباحثين العرب المعاصرين المتخصصين في الشعر الجاهلي من "أن بعض ... المدونات الشعرية الأولى قد وصلت إلى علماء الطبقة الأولى من الرواة، وأنهم اعتمدوها مصدرًا من مصادر تدوينهم لهذه الدواوين التي رواها عنهم تلاميذهم، وأن هؤلاء العلماء الرواة في القرن الثاني الهجري كانوا يعتمدون -هم وتلاميذهم- نسخًا مكتوبة من هذه الدواوين في مجالس علمهم وحلقات دروسهم، وأن الشيخ منهم كان يقرأ شعر الشاعر من نسخته، أو يقرؤها أحد تلاميذه، ثم يعقب الشيخ على الشعر بالشرح والنقد والتحقيق والتمحيص" (42).
ويستطرد الباحث ليذكر أنه إلى جانب هذه المدونات كانت هناك الرواية بطبيعة الحال، يحصل عليها العالم من شعراء من قبيلة الشاعر تناقلوها جيلًا بعد جيل، كما كان هناك تداول العلماء الرواة فيما بينهم يعرف الواحد منهم من الآخر ما قد يكون على علم به من قصائد أخرى أو يعرف منه أن شعرا قد نسب إلى أحد الشعراء خطأ أو نحله هذا الشاعر عمدا، ثم يقرأ هذا على تلاميذه ويتناقشون فيه وينتهي إلى أن يزيد أو ينقص في مدونته من شعر في ضوء كل هذا. "ثم جاء علماء الطبقة الثالثة ومن تلاهم من العلماء -بين منتصف القرن الثالث ونهاية القرن الخامس الهجري- فوجدوا بين أيديهم نسخا متعددة لديوان واحد، رويت كل نسخة عن واحد من علماء الطبقة الأولى في البصرة أو الكوفة، فصنع هؤلاء العلماء المتأخرون نسخا جديدة أفرغوا فيها جميع روايات العلماء السابقين، وأشاروا في مواطن كثيرة إلى أن هذه القصيدة من رواية فلان أو فلان، أو أن هذه الأبيات لم يروها فلان، أو أن فلانًا قال: إن هذه القصيدة أو تلك الأبيات ليست لهذا الشاعر وتنسب إلى شاعر غيره يسميه" (43).
__________
(1) شعر أو أشعار هوميروس تسمية تطلق على مجموعة من الأشعار اليونانية قيلت عبر فترة تزيد على ثلاثة قرون تمتد من الربع الأول للقرن الثاني عشر ق. م. إلى أواسط القرن التاسع ق. م. وقد جمع هذه الأشعار في هذا التاريخ الأخير شاعر يحيط به الغموض "وربما شاعران" -حسبما تدلنا مجموعة قرائن تاريخية وأثرية- وصاغها في صورة ملحمتين هما الإلياذة التي تروي قصة هجوم على مدينة اليون بمنطقة طروادة في القسم الشمالي الغربي من آسيا الصغرى، والأوديسية التي تروي مغامرات أحد القادة اليونانيين "وهو أوديسيوس" خلال عودته من طروادة إلى مدينة أثاكة على الشاطئ الغربي لبلاد اليونان. ولكن اليونان القدامى درجوا على أن ينسبوا هذه الأشعار إلى شاعر أطلقوا عليه اسم هوميروس. وبهذا المفهوم ستكون إشاراتي إلى أشعار هوميروس في هذا الحديث. راجع: لطفي عبد الوهاب يحيى: هوميروس، تاريخ حياة عصر، الأسكندرية، 1968، صفحات 1-40.
(2) تعرف هذه الكتابة باسم Linear B وهي الكتابة التي عرفتها بعض مناطق العالم اليوناني في الفترة المبكرة قبل أن يتعرفوا في أواسط القرن التاسع ق. م. بشكل ضيق على الكتابة الجديدة التي بدأت تشيع تدريجيًّا ابتداء من القرن التالي لتصبح فيما بعد هي الكتابة المستخدمة في العصر الكلاسيكي.
(3) منظر قطيع الغنم والثيران وكلاب الرعي عند هوميروس في الإلياذة: نشيد 18، سطور 541-578. وصف امرئ القيس وسرب بقر الوحش في شيخو والبستاني: المجاني الحديثة "بيروت 1960"، امرؤ القيس، المعلقة، أبيات 51-65. وصف الناقة عند طرفة في شيخو والبستاني: ذاته، المعلقة، أبيات 18-38. وصف منظر الدية عند هوميروس في الإلياذة: نشيد 18، سطور 497-506. وصف دفع الدية عند زهير في شيخو والبستاني: ذاته، المعلقة، أبيات 20-25.
(4) عرض هذه الآراء في مقالة Margoliouth: The Origins of Arabic Poetry، JRAS، July، 1925، صفحات 417-449. الإشارة إلى اقتران الكهانة بالشعر في العصر الجاهلي في صفحات 417-420 من المقالة، الإشارة القرآنية إلى اقتران الشعر بالكهانة وإبهام القول الذي يعادل الجنون في سورة الطور: 29-30، سورة الصافات: 36، سورة الحاقة: س 40-42. راجع عرضا بالعربية لآراء المستشرق عند، ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، القاهرة، 1956، صفحات 352-367.
(5) Margoliouth: المرجع ذاته، صفحات 423-426. الآيات القرآنية التي يستشهد بها على عدم معرفة الجاهليين بالكتابة، يستنتجها من سورة القلم: 37 و47، عن عدم نزول كتب سماوية على الجاهليين مثل كتب اليهود والنصارى، سورة السجدة: 30، القصص: 46، الأنعام: 156، عن القسوة في القرآن الكريم على الشعراء، سورة الشعراء: 224، الصافات: 36.
(6) المرجع ذاته: صفحات 428-434. الإشارة إلى شعر قاله آدم -عليه السلام- في المسعودي: مروج الذهب، المكتبة التجارية، القاهرة 1948، ج1 ص65، الإشارة إلى شعر قاله إسماعيل -عليه السلام- في الأغاني، ط دار الكتب. جسس13، ص 104.
(7) المرجع ذاته: 426 و446-447.
(8) المرجع ذاته: صفحات 434-437، عن الإشارة القرآنية إلى أمانة نوح -عليه السلام- راجع حاشية 23 أدناه.
(9) المرجع ذاته: 440-442.
(10) طه حسين: في الأدب الجاهلي، ط. دار المعارف، القاهرة، ط4، ص80.
(11) المرجع ذاته: ص81.
(12) المرجع ذاته: صفحات 82-83.
(13) المرجع ذاته: صفحات 84-85.
(14) المرجع ذاته: ص87.
(15) المرجع ذاته:176، 178.
(16) تمت صياغة الملحمتين في أواسط القرن التاسع ق. م. ولم تنتشر الكتابة في بلاد اليونان بشكل مبدئي إلا في أواسط القرن الذي يليه، راجع حاشيتي 1 و2 أعلاه، ولنا أن نفترض مرور قرن آخر قبل أن نتصور انتشارًا في الكتابة واهتمامًا بالقراءة يسوِّغ تدوين الملحمتين. راجع مسألة تدوينهما في أواسط القرن السادس ق. م. على عهد الطاغية الأثيني بيزستراتوس في، j.b. bury: a hIstory of greece لندن، 1945، ط2، ص198. عن صياغة الملحمتين من مقطوعات شعرية تُدُووِلت شفاهًا عبر ثلاثة قرون سابقة لذلك، راجع حاشية 1 أعلاه.
(17) محمد الخضر حسين: نقض كتاب في الشعر الجاهلي، القاهرة، صفحات 100.
(18) راجع الجزء الخاص بالحياة الاقتصادية في شبه جزيرة العرب، في القسم الثالث من هذه الدراسة.
(19) j.h. breasied: ancient times، بوستن، 1935، صفحات 186، 205، 207، 234، 265، 788.
(20) يعود نظم ملحمتي هزيودوس إلى ما بعد ملحمتي هوميروس بنحو قرن على الأكثر. راجع حاشية 1 في الباب السادس من هذه الدراسة.
(21) محمد الخضر حسين: المرجع ذاته، ص212.
(22) من الآيات القرآنية التي أشارت إلى ذلك، سورة النحل: 103، سورة الشعراء: 195، يوسف: 21، طه: 113، الزمر: 28، فصلت: 3، الشورى: 7، الزخرف: 3، الأحقاف: 12.
(23) بيت النابغة الذي يشير إليه المستشرق مارجوليوث: المرجع ذاته، ص436، هو:
فألفيت الأمانة لم تخنها ... كذلك كان نوح لا يخون
وإشارة وصف نوح بالأمانة ترد في سورة الشعراء: 107، ولكن إضفاء الأمانة على أي شخص يثق فيه قومه كان أمرًا واردًا ولا غرابة فيه، فاللفظة عربية، والصفة واردة في التعامل اليومي، وقد وصف شيوخ قريش محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالأمين وهو صبي في أثناء حادثة الحجر الأسود عند ترميم الكعبة، قبل أن ينزل القرآن الكريم، ولا أرى في الواقع وجهًا للغرابة في أن يوصف رسول بالأمانة، فالصفة الأساسية لحامل الرسالة هي الأمانة في تأديتها وتبليغها سواء قبل نزول القرآن الكريم أو في آياته. والقرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي كي يعقله ويفهمه العرب يستخدم هذه الصفة لعدد آخر من الأنبياء والرسل في سورة الشعراء: هود في آية 125، صالح 143، لوط 162، شعيب 178. وواضح أن صفة الأمانة التي تتردد في وصف الرسل في سورة الشعراء هي مقابلة مع صفة عدم الأمانة التي يوصف بها الشعراء في السورة ذاتها: 226 {وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ} . وفيما يخص ما يرى مارجوليوث أنه عدم معرفة من جانب مجتمع الجاهلية بنوح وأمانته، يستشهد المستشرق بعدم معرفة محمد -صلى الله عليه وسلم- وقومه بذلك كما يظهر من سورة هود: 49 {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} . ولكن الإشارة هنا هي إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- وقريش، أو على أوسع تقدير إلى الجاهليين من غير أهل الكتاب، ولكنها ليست إشارة إلى اليهود والنصارى من أهل الكتاب كما هو واضح من الآية. وقد كان وصف نوح في التوراة التي تعرفها هاتان الطائفتان الدينيتان بأنه رجل بار، وهو وصف يحمل معنى الأمانة، راجع: التوراة، سفر التكوين، إصحاح 6، وإصحاح 7: 1.
أ- راجع الحديث عن الوضع الديني في الباب التاسع من هذه الدراسة.
ب- وردت بعض أبيات في الشعر الجاهلي من بينها الإشارة إلى ذي دوار في معلقة امرئ القيس "المجاني، المعلقة، بيت62":
فعَنَّ لنا سرب كأن نعاجه ... عذارى دوار في ملاء مذيل
وعند عامر بن الطفيل "المجاني، قصيدة يوم فيف الريح، بيت 9":
وقد علموا أني أكرُّ عليهمو ... عشية فيف الريح كر المدور
وعند ميَّة بنت أم عتبة في وصف الشمس بالآلهة "ونسب كذلك لواحدة من ثلاث نساء غيرها"، لسان العرب، مادة: لاه، تاج العروس، 374:9:
تروحنا من اللعباء عصرا ... فأعجلنا الآلهة أن تئوبا
ج- راجع الحديث عن النحت في الباب الرابع من هذه الدراسة.
د- من بين هذه الملاحم الشعرية على سبيل المثال: ملحمة الطوفان السومرية، وملحمة الطوفان البابلية، وملحمة جلجامش، وملحمة إينوما أبليش وكلها من وادي الرافدين، ثم ملحمة الإلياذة وملحمة الأوديسية المنسوبتان إلى الشاعر هوميروس، وملحمة سلالة الآلهة للشاعر هزيودوس وكلها ملاحم يونانية.
هـ- السبب المرجح لهذا المنهج هو أن شرَّاح أو مفسري الشعر في العصر الإسلامي كانوا قد ضربوا صفحًا عن أية إشارة ميثولوجية من العصر الجاهلي، فالصور الميثولوجية المتصلة بالضرورة بالعقائد الوثنية كان قد أُلقي دونها الستار بالضرورة منذ ظهور العقيدة الإسلامية التي وضعت حدا نهائيا لأساطير الأولين وحددت للمسلمين التصور الوحيد المقبول للعلاقة بين الإنسان والقوة الإلهية -وهو أمر يزداد ترجيحه إذا أدخلنا في اعبتارنا أن مفسري القرآن والحديث كانوا كثيرًا ما يستشهدون بالشعر الجاهلي سواء في تحديد المعنى المقصود من بعض الألفاظ أو في قضايا جانبية أخرى.
و- إبراهيم عبد الرحمن محمد: الشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية "القاهرة، نشر مكتبة الشباب، 1979" 234-259.
ز- المرجع ذاته، ص240، ومراجعه في حاشية 9 وكذلك ص 249 ومراجعه في حاشية 28. ولتأييد مراجع الباحث أضيف أن عددًا كبيرًا من تماثيل الآلهة الأم قد وجد في وادي الرافدين في المناطق التي عثر فيها على مخلفات مرحلة حضارة تل حلف ومرحلة حضارة العبيد "وهي تماثيل نجد مثيلًا لها في مخلفات الحضارة المينوية في كريت ومخلفات الحضارة الحيثية في الأناضول بآسيا الصغرى" راجع:
G. Roux: Ancient Iraq "Pelican ed. 1946" PP.65،67،69-70.
ح- يرد الباحث تهكم الأعشى بالمرأة مع بقاء مظاهر التقديس متصلة بصورتها إلى ما بدأ يصيب عبادة الكواكب من شك على أيدي الشعراء الذين أخذوا يتصلون في أواخر العصر الجاهلي بأصحاب الديانات السماوية التي عرفت في شبه الجزيرة العربية آنذاك "المسيحية واليهودية" والحنيفية. المرجع ذاته، ص 243.
"ط" المرجع ذاته، ص250.
ى- المرجع ذاته، صفحات 253-258.
ك- عفت الشرقاوي: دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهلي "بيروت، دار النهضة العربية، 1979"، صفحات 242-258.
ل- ذاته: المرجع ذاته، ص253.
م- المرجع ذاته: ص254.
ن- المرجع ذاته: الصفحة ذاتها.
(24) محمد الخضر حسين: المرجع ذاته، ص51.
(25) أبيات زهير في شيخو والبستاني: ذاته، المعلقة، أبيات 49-64. أبيات النابغة، ذاته، قصيدة اعتذار، أبيات 5-7، 11.
(26) أبيات امرئ القيس، ذاته: قصيدة في طريق بيزنطة، أبيات 29-35. الأعشى، ذاته، المعلقة، بيت 29.
(27) عن الشنفرى، ذاته: لامية العرب، 1-28. عن تأبط شرا، ذاته: قصيدة غار العسل، 1-9.
(28) كان هذا أحد جوانب التدهور الاقتصادي في العربية الجنوبية في القرن السادس الميلادي. ونلاحظ أنه في خلال هذا القرن بدأ التدهور السياسي الذي اتخذ مظهر احتلال قوات غير عربية لهذه المنطقة ابتداء من 525/524م. راجع القسم الثالث من هذه الدراسة.
(29) شيخو والبستاني: ذاته، معلقة طرفة بن العبد، أبيات 3-5. أبيات المثقب العبدي في ذاته: قصيدة مدح عمرو بن هند، أبيات 21-32.
(30) مثال ذلك آثار قصر أجاممنون "قائد الحملة اليونانية إلى طروادة في ملحمة الإلياذة" في مدينة ميكيني بمنطقة أرجوس في شبه جزيرة البلوبونيسوس "المورة" في جنوبي بلاد اليونان، وآثار قصر نسطور "أحد قواد الحملة ذاتها" في مدينة بيلوس كذلك في جنوبي بلاد اليونان، وآثار مدينة أليون "بمنطقة طروادة" عند تل حصارلك تتركيه، ونقوش على جدران معبد الكرنك تتفق وما جاء في الأوديسية، راجع عن هذه النقوش: breasted: ancient egyptian records المجلد الثالث، فقرة 588.
(31) عن طرفة، شيخو والبتساني: ذاته، المعلقة، أبيات 47-53 و62-70. عن زهير، ذاته: قصيدة هجر آل حصن، أبيات 1-4.
(32) charies james Lyall: مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص، ط دار المعارف، القاهرة،
(33) ناصر الدين الأسد: المرجع ذاته، صفحات 23-33.
(34) الآية في سورة الجمعة: 2. من كتاب العصر الإسلامي الذين وصفوا عرب الجاهلية بعدم معرفة الكتابة، الجاحظ: البيان والتبيين، القاهرة، 1948، ج3، ص28، ابن عبد ربه: العقد الفريد، القاهرة، 1940، ج4، ص 242، ابن قتيبة: مختلط الحديث، القاهرة، 1326هـ، صفحات 365-366.
(35) سورة البقرة: 78-79، والآيتان الأخريان في سورة آل عمران: 20 و75.
(36) راجع بعض هذه الإشارات في الباب الخاص بالمصادر الدينية من هذه الدراسة، وحاشية 22 من الباب ذاته.
(37) الآيتان بالترتيب في البقرة: 283-283.
(38) راجع الأبيات في شيخو والبستاني: المرجع ذاته، على سبيل المثال، يوم الجفار بين تميم وبكر، شعر النابغة، قصيدة الرد على عيينة، بيت 16، يوم بارق بين شيبان وتغلب، شعر الأسود بن يعفر، قصيدة ذكرى، بيت 9، كذلك يوم فطيمة بين هاتين القبيلتين، شعر الأعشى، المعلقة، بيت60.
(39) اتهام الضبي لحماد يرد في الأغاني، طبعة دار الكتب، القاهرة، ج6، ص89، الدفاع عن الرواة في المفضليات، تحقيق ليال، ج2، المقدمة، صفحات 19-21.
(40) ابن جني: الخصائص، ط دار الهلال، القاهرة، 1913، باب "في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة" مقتبس في ناصر الدين الأسد: المرجع ذاته، صفحات 464-465.
(41) ناصر الدين الأسد: المرجع ذاته، ص 436.
(42) المؤلف ذاته: المرجع ذاته، ص482.
(43) المؤلف ذاته: المرجع ذاته، ص 483.
 الاكثر قراءة في عرب قبل الاسلام
الاكثر قراءة في عرب قبل الاسلام
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












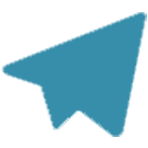
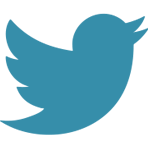

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)