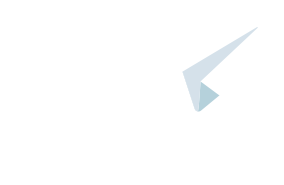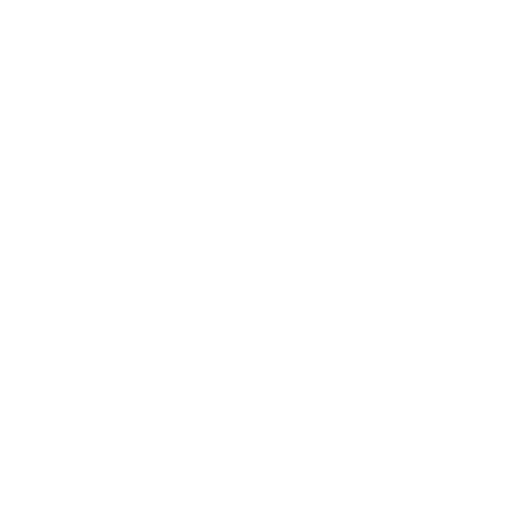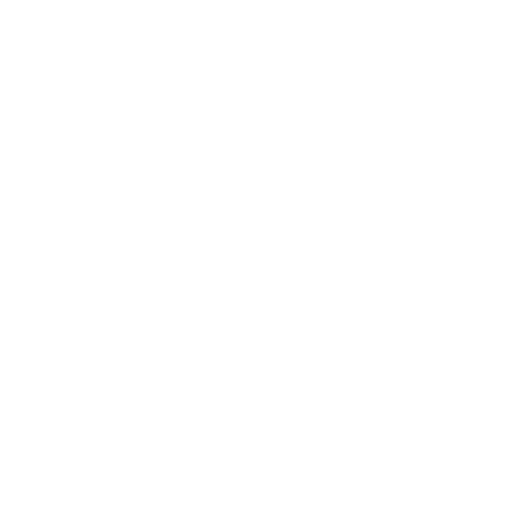تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير آية (38-39) من سورة الانعام
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
4-4-2021
9292
قال تعالى : {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يشأ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الأنعام : 38 ، 39].
لما بين سبحانه أنه قادر أن ينزل آية ، عقبه بذكر ما يدال على كمال قدرته ، وحسن تدبيره وحكمته ، فقال : {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ} أي : ما من حيوان يمشي على وجه الأرض {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات لأنها لا تخلو إما أن تكون مما يطير بجناحيه ، أو يدب .
ومما يسأل عنه أن يقال : لم قال {يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} ، وقد علم أن الطير لا يطير إلا بالجناح ؟ فالجواب : إن هذا إنما جاء للتوكيد ، ورفع اللبس ، لأن القائل قد يقول : طر في حاجتي أي : أسرع فيها ، وقال الشاعر :
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم * طاروا إليه زرافات ووحدانا (2)
وأنشد سيبويه :
فطرت بمنصلي في يعملات * ودوامي الأيد يخبطن السريحا (3)
وقيل : إنما قال {بِجَنَاحَيْهِ} لأن السمك تطير في الماء ، ولا أجنحة لها ، وإنما خرج السمك عن الطائر ، لأنه من دواب البحر ، وإنما أراد سبحانه ما في الأرض وما في الجو . {إِلَّا أُمَمٌ} أي : أصناف مصنفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صنف على العدد الكثير ، عن مجاهد {أَمْثَالُكُمْ} قيل : إنه يريد أشباهكم في إبداع الله إياها ، وخلقه لها ، ودلالتها على أ ن لها صانعا . وقيل : إنما مثلت الأمم من غير الناس بالناس ، في الحاجة إلى مدبر يدبرهم ، في أغذيتهم ، وأكلهم ولباسهم ، ونومهم ، ويقظتهم ، وهدايتهم إلى مراشدهم ، إلى ما لا يحصى كثرة من أحوالهم ، ومصالحهم ، وأنهم يموتون ، ويحشرون . وبين بهذه الآية أنه لا يجوز للعباد أن يتعدوا في ظلم شيء منها ، فإن الله خالقها وا المنتصف لها .
{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} أي : ما تركنا . وقيل : معناه ما قصرنا واختلف في معنى الكتاب على أقوال أحدها : إنه يريد بالكتاب القرآن ، لأنه ذكر جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا ، إما مجملا ، وإما مفصلا . والمجمل قد بينه على لسان نبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، وأمرنا باتباعه في قوله : {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : 7] . وهذا مثل قوله تعالى : {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل : 89] .
ويروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : (مالي لا ألعن من لعنه الله في كتابه ، يعني الواشمة والمستوشمة ، والواصلة والمستوصلة - فقرأت المرأة التي سمعت ذلك منه جميع القرآن ، ثم أتته وقالت : يا ابن أم عبد! تلوت البارحة ما بين الدفتين ، فلم أجد فيه لعن الواشمة ! فقال : لو تلوتيه لوجدتيه قال الله تعالى {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : 7] وإن مما أتانا رسول الله أن قال : (لعن الله الواشمة والمستوشمة) . وهو قول ، أكثر المفسرين ، وهذا القول اختيار البلخي .
وثانيها : إن المراد بالكتاب ههنا الكتاب الذي هو عند الله ، عز وجل ، المشتمل على ما كان ويكون ، وهو اللوح المحفوظ ، وفيه آجال الحيوان ، وأرزاقه ، وآثاره ، ليعلم ابن آدم أن عمله أولى بالإحصاء والاستقصاء ، عن الحسن .
وثالثها : إن المراد بالكتاب الأجل أي : ما تركنا شيئا إلا وقد أوحينا له أجلا ، ثم يحشرون جميعا ، عن أبي مسلم وهذا الوجه بعيد .
{ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} معناه : يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة ، كما يحشر العباد ، فيعوض الله تعالى ما يستحق العوض منها ، وينتصف لبعضها من بعض ، وفيما رووه عن أبي هريرة أنه قال : يحشر الله الخلق يوم القيامة : البهائم والدواب والطير ، وكل شيء ، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء (4) من القرناء ، ثم يقول . كوني ترابا ، فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا .
وعن أبي ذر قال : بينا أنا عند رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) إذ انتطحت عنزان (5) ، فقال النبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) : أتدرون فيما انتطحا ؟ فقالوا : لا ندري . قال : لكن الله يدري وسيقضي بينهما .
وعلى هذا فإنما جعلت أمثالنا في الحشر والاقتصاص ، واختاره الزجاج ، فقال : يعني {أَمْثَالُكُمْ} في أنهم يبعثون ويؤيده قوله : {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} [التكوير : 5] ومعنى {إِلَى رَبِّهِمْ} إلى حيث لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى ، إذ لم يمكن منه كما مكن في الدنيا .
واستدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أن البهائم والطيور مكلفة لقوله {أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} : وهذا باطل ، لأنا قد بينا أنها من أي وجه تكون أمثالنا ، ولو وجب حمل ذلك على العموم ، لوجب أن تكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا وهيآتنا وخلقتنا وأخلاقنا ، وكيف يصح تكليف البهائم ، وهي غير عاقلة ، والتكليف لا يصح إلا مع العقل .
{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} أي : بالقرآن . وقيل : بسائر الحجج والبينات {صُمٌّ وَبُكْمٌ} قد بينا معناهما في سورة البقرة {فِي الظُّلُمَاتِ} أي : في ظلمات الكفر والجهل لا يهتدون إلى شيء من منافع الدين ، وقيل : أراد صم وبكم في الظلمات الآخرة على الحقيقة ، عقابا لهم على كفرهم ، لأنه ذكرهم عند ذكر الحشر ، عن أبي علي الجبائي {مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ} هذا مجمل قد بينه في قوله {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} [البقرة : 26] {وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم : 27] {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} [محمد : 17] {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ} [المائدة : 16] والمعنى : من يشأ الله يخذله بأن يمنعه ألطافه وفوائده ، وذلك إذا واتر عليه الأدلة ، وأوضح له الحجج ، فأعرض عنها ، ولم ينعم النظر فيها ، ويجوز أن يريد : من يشأ الله إضلاله عن طريق الجنة ، ونيل ثوابها ، يضلله عنه {وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} أي : ومن يشأ أن يرحمه ويهديه إلى الجنة ، يجعله على الصراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة .
____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 48-50 .
2 . الزرافات : الجماعات .
3 . المنصل : السيف . اليعملات جمع اليعملة : الناقة النجيبة الطبوعة على العمل والدوامي جمع الدامية : التي تسيل دمها . والخبط في الدواب : الضرب بالأيدي دون الأرجل . والسريح : جلود تشدد على أخفاف النوق .
4 . الجماء : التي لا قرن لها .
5 . انتطح الكبشان : نطح أحدهما الآخر أي : أ صابه بقرنه .
{وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ ولا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ} . بيّن سبحانه في هذه الآية ان بيننا وبين الدواب والطيور نوعا من الشبه ، ولكنه لم يصرح بهذا النوع : هل تشبهنا الدواب والطيور في أنها مخلوقة للَّه ، أو في إيمانها به ، وتسبيحها بحمده ، أو في أنها أصناف مصنفة تعرف بأسمائها ، كما تعرف الأسر والقبائل ، أو في تدبير معاشها ، وتصريف الأمور وفقا لمصالحها ؟
وعلى أية حال ، فقد تفرغ كثير من العلماء لدرس طبائع الحيوانات والحشرات والطيور ، وغرائزها وأعمالها ، ووقفوا على أسرار غريبة تشهد بوجود مدبر حكيم ، نذكر منها على سبيل المثال ان الفيلة تعقد المحاكم للمخالفات التي تقع من بعضها ، وتصدر المحكمة حكمها على الفيل المذنب بالنفي عن الجماعة ليعيش وحيدا في عزلته .
والغراب إذا أحس بالخطر على الغربان أنذرها بصوت خاص ، أما في حال المرح فإنه يخرج صوتا قريبا من القهقهة .
وتسأل : ما هي الفائدة في قوله تعالى : {يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ} مع ان كلمة طائر بذاتها تدل على ذلك ؟ .
الجواب : لا فائدة - فيما نعلم - سوى فصاحة الكلام .
{ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} . قيل : المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ المشتمل على ما كان ويكون ، وقول ثان : انه كناية عن علم اللَّه بنوايا الإنسان وأقواله وأفعاله ، وثالث : انه القرآن ، وان اللَّه سبحانه بيّن فيه كل ما يجب بيانه للناس من أصول الدين وفروعه ، وما يتعلق بهما ، واخترنا هذا القول في ج 1 ص 38 فقرة القرآن والعلم الحديث .
{ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} . ظاهر الكلام يدل على ان اللَّه يحشر الدواب والطيور يوم القيامة ، تماما كما يحشر الناس ، وكذلك الآية 5 من التكوير : {وإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} . وقال كثير من العلماء بذلك استنادا إلى ظاهر الآيتين ، وإلى حديث : « ان اللَّه يقتص غدا للجماء من القرناء » .
ونحن مع ابن عباس الذي قال : المراد بحشر البهائم موتها ، كما ورد في حديث : « من مات فقد قامت قيامته » لأن الحساب والعقاب إنما يكون بعد التكليف ، ومخالفته ، ولا تكليف إلا مع العقل ، ولا عقل للدواب والطيور فلا تكليف ، وبالتالي فلا حشر للحساب ، ولو حوسب الدواب لحوسب الأطفال بطريق أولى .
أما حديث « يقتص للجماء » فهو كناية عن عدل اللَّه تعالى ، وانه لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها . . وإذا كان اللَّه يعاقب القرناء إذا نطحت الجماء فبالأولى أن يحرم علينا ذبح الحيوان . . أما قول من قال : ان اللَّه يعوض غدا الحيوان عن آلامه فهو قول على اللَّه بغير علم .
{والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ} . أي انهم كالصم ، لأنهم لا يستمعون إلى دعوة الحق ، وهم كالبكم ، لأنهم لا ينطقون بما عرفوا من الحق ، وهم في ظلمات التقليد ، وظلمات الشرك والكفر والفسق والآثام . {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ومَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} . تقدم الكلام عن الضلال والهداية عند تفسير الآية 26 من البقرة ، فقرة « الهدى والضلال » ج 1 ص 70 ، والآية 88 من النساء فقرة « الإضلال من اللَّه سلبي لا إيجابي » .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 185-186 .
قوله تعالى : {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ} إلى آخر الآية ، الدابة كل حيوان يدب على الأرض وقد كثر استعماله في الفرس ، والدب بالفتح والدبيب هو المشي الخفيف .
والطائر ما يسبح في الهواء بجناحيه ، وجمعه الطير كالراكب ، والركب والأمة هي الجماعة من الناس يجمعهم مقصد واحد يقصدونه كدين واحد أو سنة واحدة أو زمان واحد أو مكان واحد ، والأصل في معناها ، القصد يقال : أم يؤم إذا قصد ، والحشر جمع الناس بإزعاج إلى الحرب أو جلاء ونحوه من الأمور الاجتماعية .
والظاهر أن توصيف الطائر بقوله : {يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ} محاذاة لتوصيف الدابة بقوله : {فِي الْأَرْضِ} فهو بمنزلة قولنا : ما من حيوان أرضي ولا هوائي ، مع ما في هذا التوصيف من نفي شبهة التجوز فإن الطيران كثيرا ما يستعمل بمعنى سرعة الحركة كما أن الدبيب هو الحركة الخفيفة فكان من المحتمل أن يراد بالطيران حيث ذكر مع الدبيب الحركة السريعة فدفع ذلك بقوله : {يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ} .
( كلام في المجتمعات الحيوانية )
والخطاب في الآية للناس ، وقد ذكر فيها أن الحيوانات أرضية كانت أو هوائية هي أمم أمثال الناس ، وليس المراد بذلك كونها جماعات ذوات كثرة وعدد فإن الأمة لا تطلق على مجرد العدد الكثير بل إذا جمع ذلك الكثير جامع واحد من مقصد اضطراري أو اختياري يقصده أفراده ، ولا أن المراد مجرد كونها أنواعا شتى كل نوع منها يشترك أفراده في نوع خاص من الحياة والرزق والسفاد والنسل والمأوى وسائر الشئون الحيوية فإن هذا المقدار من الاشتراك وإن صحح الحكم بمماثلتها الإنسان لكن قوله في ذيل الآية : {ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} يدل على أن المراد بالمماثلة ليس مجرد التشابه في الغذاء والسفاد والإواء بل هناك جهة اشتراك أخرى تجعلها كالإنسان في ملاك الحشر إلى الله ، وليس ملاك الحشر إلى الله في الإنسان إلا نوعا من الحياة الشعورية التي تخد للإنسان خدا إلى سعادته وشقائه ، فإن الفرد من الإنسان يمكن أن ينال في الدنيا ألذ الغذاء وأوفق النكاح وأنضر المسكن ولا يكون مع ذلك سعيدا في حياته لما ينكب عليه من الظلم والفجور أو أن يحيط به جماع المحن والشدائد والبلايا وهو سعيد في حياته مبتهج بكمال الإنسانية ونور العبودية .
بل حياة الإنسان الشعورية وإن شئت فقل : الفطرة الإنسانية وما يؤيدها من دعوة النبوة تسن للإنسان سنة مشروعة من الاعتقاد والعمل إن أخذ بها وجرى عليها ووافقه المجتمع عليه سعد في الحياتين : الدنيا والآخرة ، وإن استن بها وحده سعد بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة معا ، وإن لم يعمل بها وتخلف عن الأخذ ببعضها أو كلها كان في ذلك شقاؤه في الدنيا والآخرة .
وهذه السنة المكتوبة له تجمعها كلمتان : البعث إلى الخير والطاعة ، والزجر عن الشر والمعصية ، وإن شئت قلت : الدعوة إلى العدل والاستقامة ، والنهي عن الظلم والانحراف عن الحق فإن الإنسان بفطرته السليمة يستحسن أمورا هي العدل في نفسه أو غيره ، ويستقبح أمورا هي الظلم على نفسه أو غيره ثم الدين الإلهي يؤيدها ويشرح له تفاصيلها .
وهذا محصل ما تبين لنا في كثير من الأبحاث السابقة ، وكثير من الآيات القرآنية تفيد ذلك وتؤيده كقوله تعالى : {وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها} [الشمس : 10] ، وقوله تعالى : {كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة : 213] .
والإمعان في التفكر في أطوار الحيوانات العجم التي تزامل الإنسان في كثير من شئون الحياة ، وأحوال نوع منها في مسير حياتها وتعيشها يدلنا على أن لها كالإنسان عقائد وآراء فردية واجتماعية تبني عليها حركاتها وسكناتها في ابتغاء البقاء نظيره ما يبني الإنسان تقلباته في أطوار الحياة الدنيا على سلسلة من العقائد والآراء .
فالواحد منا يشتهي الغذاء والنكاح أو الولد أو غير ذلك ، أو يكره الضيم أو الفقر أو غير ذلك فيلوح له من الرأي أن من الواجب أن يطلب الغذاء أو يأكله أو يدخره في ملكه ، وأن يتزوج وأن ينسل وهكذا ، وأن من الممنوع المحرم عليه أن يصبر على ضيم أو يتحمل مصيبة الفقر وهكذا فيتحرك ويسكن على طبق ما تخدّ له هذه الآراء اللائحة لنفسه من الطريق .
كذلك الواحد من الحيوان ـ على ما نشاهده ـ يأتي في مبتغيات حياته من الحركات المنظمة التي يحتال بها إلى رفع حوائج نفسه في الغذاء والسفاد والمأوى بما لا نشك به في أن له شعورا بحوائجه وما يرتفع به حاجته ، وآراء وعقائد ينبعث بها إلى جلب المنافع ودفع المضار كما في الإنسان ، وربما عثرنا فيها من أنواع الحيل والمكائد للحصول على الصيد والنجاة من العدو من الطرق الاجتماعية والفردية ما لم يتنبه إليه الإنسان إلا بعد طي قرون وأحقاب من عمره النوعي .
وقد عثر العلماء الباحثون عن الحيوان في كثير من أنواعه ، كالنمل والنحل والأرضة على عجائب من آثار المدنية والاجتماع ، ودقائق من الصنعة ولطائف من السنن والسياسات لا تكاد توجد نظائرها إلا في الأمم ذوي الحضارة والمدنية من الإنسان .
وقد حث القرآن الكريم على معرفة الحيوان والتفكر في خلقها وأعمالها عامة كقوله تعالى : {وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [الجاثية : 4] ودعا إلى الاعتبار بأمر كثير منها كالأنعام والطير والنحل والنمل .
وهذه الآراء والعقائد التي نرى أن الحيوان على اختلاف أنواعها في شئون الحياة ومقاصدها تبنى عليها أعمالها إذا لم تخل عن الأحكام الباعثة والزاجرة لم تخل عن استحسان أمور واستقباح أمور ، ولم تخل عن معنى العدل أو الظلم .
وهو الذي يؤيده ما نشاهده من بعض الاختلاف في أفراد أي نوع من الحيوان في أخلاقها ، فكم بين الفرس والفرس وبين الكبش والكبش وبين الديك والديك مثلا من الفرق الواضح في حدة الخلق أو سهولة الجانب ولين العريكة .
وكذا يؤيده جزئيات أخرى من حب وبغض وعطوفة ورحمة أو قسوة أو تعد وغير ذلك مما نجدها بين الأفراد من نوع وقد وجدنا نظائرها بين أفراد الإنسان ، ووجدناها مؤثرة في الاعتقاد بالحسن والقبح في الأفعال ، والعدل والظلم في الأعمال ثم إنها مؤثرة أيضا في حياة الإنسان الأخروية ، وملاكا لحشره ومحاسبة أعماله والجزاء عليها بنعمة أو نقمة أخروية .
وببلوغ البحث هذا المبلغ ربما لاح لنا أن للحيوان حشرا كما أن للإنسان حشرا فإن الله سبحانه يعد انطباق العدل والظلم والتقوى والفجور على أعمال الإنسان ملاكا للحشر ويستدل به عليه كما في قوله تعالى : {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ـ ص : 28] بل يعد بطلان الحشر في ما خلقه من السماء والأرض وما بينهما بطلانا لفعله وصيرورته لعبا أو جزافا كما في الآية السابقة على هذه الآية : {وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص : 27] .
فهل للحيوان غير الإنسان حشر إلى الله سبحانه كما أن للإنسان حشرا إليه ؟ ثم إذا كان له حشر فهل يماثل حشره حشر الإنسان فيحاسب على أعماله وتوزن وينعم بعد ذلك في جنة أو نار على حسب ما له من التكليف في الدنيا ؟ وهل استقرار التكليف الدنيوي عليه ببعث الرسل وإنزال الأحكام ؟ وهل الرسول المبعوث إلى الحيوان من نوع نفسه أو أنه إنسان ؟ .
هذه وجوه من السؤال تسبق إلى ذهن الباحث في هذا الموقف :
أما السؤال الأول ( هل للحيوان غير الإنسان حشر ؟ ) فقوله تعالى في الآية : {ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} يتكفل الجواب عنه ، ويقرب منه قوله تعالى : {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} [كورت : 5] .
بل هناك آيات كثيرة جدا دالة على إعادة السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجن والحجارة والأصنام وسائر الشركاء المعبودين من دون الله ، والذهب والفضة حيث يحمى عليهما في نار جهنم فتكوى بها جباه مانعي الزكاة وجنوبهم إلى غير ذلك في آيات كثيرة لا حاجة إلى إيرادها ، والروايات في هذه المعاني لا تحصى كثرة .
وأما السؤال الثاني ، وهو أنه هل يماثل حشره حشر الإنسان فيبعث وتحضر أعماله ويحاسب عليها فينعم أو يعذب بها فجوابه أن ذلك لازم الحشر بمعنى الجمع بين الأفراد وسوقهم إلى أمر بالإزعاج ، وأما مثل السماء والأرض وما يشابههما من شمس وقمر وحجارة وغيرها فلم يطلق في موردها لفظ الحشر كما في قوله تعالى : {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ} [إبراهيم : 48] وقوله : {وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر : 67] وقوله : {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} [القيامة : 9} وقوله : {إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ ، لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها} [الأنبياء : 99] .
على أن الملاك الذي يعطيه كلامه تعالى في حشر الناس هو القضاء الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق قال تعالى : {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [السجدة : 25] وقوله : {ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [آل عمران : 55] وغير ذلك من الآيات .
ومرجع الجميع إلى إنعام المحسن والانتقام من الظالم بظلمه كما ذكره في قوله : {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة : 22] وقوله : {فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ ، يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ} [إبراهيم : 48] وهذان الوصفان أعني الإحسان والظلم موجودان في أعمال الحيوانات في الجملة .
ويؤيده ظاهر قوله تعالى : {وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى} فاطر 35 فإن ظاهره أن ظلم الناس لو استوجب المؤاخذة الإلهية كان ذلك لأنه ظلم والظلم شائع بين كل ما يسمى دابة : الإنسان وسائر الحيوانات فكان ذلك مستعقبا لأن يهلك الله تعالى كل دابة على ظهرها هذا وإن ذكر بعضهم : أن المراد بالدابة في الآية خصوص الإنسان .
ولا يلزم من شمول الأخذ والانتقام يوم القيامة لسائر الحيوان أن يساوي الإنسان في الشعور والإرادة ، ويرقى الحيوان العجم إلى درجة الإنسان في نفسياته وروحياته ، والضرورة تدفع ذلك ، والآثار البارزة منها ومن الإنسان تبطله .
وذلك أن مجرد الاشتراك في الأخذ والانتقام والحساب والأجر بين الإنسان وغيره لا يقضي بالمعادلة والمساواة من جميع الجهات كما لا يقتضي الاشتراك في ما هو أقرب من ذلك بين أفراد الإنسان أنفسهم أن يجري حساب أعمالهم من حيث المداقة والمناقشة مجرى واحدا فيوقف العاقل والسفيه والرشيد والمستضعف في موقف واحد .
على أنه تعالى ذكر من بعض الحيوان من لطائف الفهم ودقائق النباهة ما ليس بكل البعيد من مستوى الإنسان المتوسط الحال في الفقه والتعقل كالذي حكى عن نملة سليمان بقوله : {حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} [النمل : 18] وما حكاه من قول هدهد له عليه السلام في قصة غيبته عنه : {فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ، إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ ، وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ} إلى آخر الآيات : [النمل : 24] فإن الباحث النبيه إذا تدبر هذا الآيات بما يظهر منها من آثار الفهم والشعور لها ثم قدر زنته لم يشك في أن تحقق هذا المقدار من الفهم والشعور يتوقف على معارف جمة وإدراكات متنوعة كثيرة من بساط المعاني ومركباتها .
وربما أيد ذلك ما حصله أصحاب معرفة الحيوان بعميق مطالعاتهم وتربياتهم لأنواع الحيوان المختلفة من عجائب الأحوال التي لا تكاد تظهر إلا من موجود ذي إرادة لطيفة وفكر عميق وشعور حاد .
وأما السؤال الثالث والرابع أعني أنه : هل الحيوان يتلقى تكليفه في الدنيا برسول يبعث إليه ووحي ينزل عليه ؟ وهل هذا الرسول المبعوث إلى نوع من أنواع الحيوان من أفراد ذلك النوع بعينه ؟ فعالم الحيوان إلى هذا الحين مجهول لنا مضروب دونه بحجاب فالاشتغال بهذا النوع من البحث مما لا فائدة فيه ولا نتيجة له إلا الرجم بالغيب ، والكلام الإلهي على ما يظهر لنا من ظواهره غير متعرض لبيان شيء من ذلك ، ولا يوجد في الروايات المأثورة عن النبي والأئمة من أهل بيته صلى الله عليه وآله ما يعتمد عليه في ذلك .
فقد تحصل أن المجتمعات الحيوانية كالمجتمع الإنساني فيها مادة الدين الإلهي ترتضع من فطرتها نحو ما يرتضع الدين من الفطرة الإنسانية ويمهدها للحشر إلى الله سبحانه كما يمهد دين الفطرة الإنسان للحشر والجزاء ، وإن كان المشاهد من حال الحيوان بالقياس إلى الإنسان ـ وتؤيده الآيات القرآنية الناطقة بتسخير الأشياء للإنسان وأفضليته من عامة الحيوان ـ أن الحيوان لم يؤت تفاصيل المعارف الإنسانية ولا كلف بدقائق التكاليف الإلهية التي كلف بها الإنسان .
ولنرجع إلى متن الآية فقوله تعالى : {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ} يدل على أن المجتمعات الحيوانية التي توجد بين كل نوع من أنواع الحيوان إنما تأسست على مقاصد نوعية شعورية يقصدها كل نوع من الحيوان على اختلافها بالشعور والإرادة كالإنسان .
وليس ذلك مقصورا على المقاصد الطبيعية أعني مقاصد التغذي والنمو وتوليد المثل المحدودة بهذه الحياة الدنيا بل ينبسط ذيله على ما بعد الموت ويتهيأ به إلى حياة أخرى ترتبط بالسعادة والشقاوة المرتضعتين من ثدي الشعور والإرادة .
وربما اعترض عليه أن القوم تسلموا أن غير الإنسان من أنواع الحيوان محروم من موهبة الاختيار ، ولذلك يعد أفعال الحيوان كأفعال النبات طبيعية غير اختيارية لما يشاهد من حالها أنها لا تملك نفسها من الإقدام على الفعل إذا صادف ما فيه نفعها المطلوب كالهرة إذا رأت فأرة أو الأسد إذا رأى فريسته ، والهرب إذا صادف ما يخافه من عدو غالب كالفأرة إذا رأت هرة أو الغزالة إذا شاهدت أسدا فلا معنى للسعادة والشقاوة الاختياريتين في الحيوان غير الإنسان .
لكن التأمل في معنى الاختيار والحالات النفسية التي يتوسل بها الإنسان إلى إتيان أفعاله الاختيارية يدفع هذه الشبهة وذلك أن الشعور والإرادة الذين يتم بهما فعل الإنسان الاختياري بالحقيقة إنما أودعا في الإنسان مثلا لأنه نوع شعوري يتصرف في المادة الخارجية للانتفاع بها في بقاء وجوده بتمييز ما ينفعه مما يضره ، ولذلك جهزته العناية الإلهية بالشعور والإرادة فهو يميز بشعوره الحي ما يضره مما ينفعه فإذا تحقق النفع أراد ففعل فما كان من الأمور بين النفع ولا يحتاج في الحكم بكونه مما ينتفع به إلى أزيد من وجدانه وحصول العلم به إرادة من فوره وفعله وتصرف فيه من غير توقف كما في موارد الملكات الراسخة غالبا مثل التنفس ، وأما ما كان من الأمور غير بين النفع موسوما بنقص من الأسباب أو محفوفا بشيء من الموانع الخارجية أو الاعتقادية لم يكف مجرد العلم بتحققه في إرادته وفعله لعدم الجزم بالانتفاع به .
فهذه الأمور هي التي يتوقف الانبعاث إليها إلى التفكر مثلا فيها من جهة ما معها من النواقص والموانع والتروي فيها ليميز بذلك إنما هل هي من قبيل النافع أو الضار ؟ فإن أنتج التروي كونها نافعة ظهرت الإرادة متعلقة بها وفعلت كما لو كانت بينة النفع غير محتاجة إلى التروي فيها ، وذلك كالإنسان الجائع إذا وجد غذاء يمكنه أن يسد به خلة الجوع فربما شك في أمره أنه هل هو غذاء طيب صالح لأن يتغذى به أو أنه غير صالح فاسد أو مسموم أو مشتمل على مواد مضرة ؟ وأنه هل هو ماله نفسه ولا مانع من التصرف فيه كاحتياج مبرم مستقبل أو صوم ونحوه أو مال غيره ولا يجوز التصرف فيه ؟ وحينئذ يتوقف عن المبادرة إلى التصرف فيه ، ولا يزال يتروى حتى يقطع بأحد الطرفين فإن حكم بالجواز كان مصداقا لما ينتفع فلا يتوقع بعد ذلك دون أن يريد فيتصرف فيه .
وإن لم يشك في أمره وكان بينا عنده من أول الأمر أنه طيب صالح للتغذي إرادة إذا علم بوجوده من غير ترو أو تفكر ، ولم ينفك العلم به عن إرادة التصرف فيه قطعا .
فمحصل حديث الاختيار أن الإنسان إذا لم يتميز عنده بعض الأمور التي يتصرف فيها أنها نافعة أو ضارة ميز ذلك بالتروي والتفكر فاختار أحد الجانبين أو الجوانب ، وأما لو تميز من أول الأمر إرادة ففعله من غير مهل ولم يحتج إلى ترو أصلا فالإنسان يختار ما يرى نفعه بترو أو من غير ترو ولا تروي إلا لرفع الموانع عن الحكم .
ثم إنك إذا تأملت حال أفراد الإنسان المختارين في أفعالهم وجدتهم ذوي اختلاف شديد في مبادئ اختيارهم أعني الصفات الروحية والأحوال الباطنية من شجاعة وجبن وعفة وشره ونشاط وكسل ووقار وخفة ، وكذا في قوة التعقل وضعفه وإصابة النظر وخطائه فكثيرا ما يرى الشره نفسه مضطرة مسلوبة الاختيار في موارد يشتهي الانهماك فيها لا يعبأ بأمرها العفيف المتطهر ، وربما يرى الجبان أدنى أذى يصيبه في مهمة أو مقتلة عذرا لنفسه ينفي عنه الاختيار ، ولا يرى الشجاع الباسل الآبي عن الضيم الموت الأحمر وأي زجر بدني أمرا فوق الطاقة ، ولا يرى لأي مصيبة هائلة في سبيل مقاصده من بأس ، وربما اختار السفيه خفيف العقل بأدنى تصور ، واه ولا يرى العاقل اللبيب ترجيح الفعل بأمثال تلك المرجحات إلا تلهيا ولعبا ، وأفعال الصبيان غير المميزين اختيارية معها بعض التروي ولا يعبأ بها وبأمرها البالغ الرشيد ، وكثيرا ما نعد في محاوراتنا فعلا من أفعالنا اضطراريا أو إجباريا إذا قارن أعذارا اجتماعية غير ملزمة بحسب الحقيقة كشارب الدخان يعتذر بالعادة ، والنومة يعتذر بالكسل والسارق أو الخائن يعتذر بالفقر .
وهذا الاختلاف الفاحش في مبادئ الاختيار وأسبابه والعرض العريض في مستوى الأفعال الاختيارية هو الذي بعث الدين وسائر السنن الاجتماعية أن يحدوا الفعل الاختياري بما يراه المتوسط من أفراد المجتمع الإنساني اختياريا ، ويبنوا على ذلك صحة تعلق الأمر والنهي والعقاب والثواب ونفوذ التصرف وغير ذلك ، ويعذروا من لم يتحقق فيه ما يتحقق في الفعل الاختياري الذي يأتي به الإنسان المتوسط من المبادي والأسباب ، وهو المتوسط من الاستطاعة والفهم .
فهذا الوسط المعدود اختيارا النافي لاختيارية ما دونه إنما هو كذلك بحسب الحكم الديني أو الاجتماعي المراعى فيه مصلحة الدين أو الاجتماع وإن كان الأمر بحسب النظر التكويني أوسع من ذلك .
والإمعان فيما تقدم يعطي أن يجزم بأن الحيوان غير الإنسان غير محروم من موهبة الاختيار في الجملة وإن كان أضعف مما نجده في المتوسط من الناس من معنى الاختيار وذلك لما نشاهده في كثير من الحيوانات وخاصة الحيوانات الأهلية من آثار التردد في بعض الموارد المقرونة بالموانع من الفعل وكذا الكف عن الفعل بزجر أو إخافة أو تربية ، فجميع ذلك يدل على أن في نفوسها صلاحية الحكم بلزوم الفعل والترك ، وهو الملاك في أصل الاختيار وإن كان التروي ضعيفا فيها جدا غير بالغ حد ما نجده في الإنسان المتوسط .
وإذا صح أن الحيوان غير الإنسان لا يخلو عن معنى الاختيار في الجملة وإن كان ضعيفا فمن الجائز أن يجعل الله سبحانه المتوسط من مراتب الاختيار الموجودة فيها ملاكا لتكاليف مناسبة لها خاصة بها لا نحيط بها ، أو يعاملها بما لها من موهبة الاختيار بنحو آخر لا معرفة لنا به إلا أنه فيها بنحو يصحح الإنعام عليها عند الموافقة ، ومؤاخذتها والانتقام منها عند المخالفة بما الله سبحانه أعلم به .
وقوله تعالى : {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} جملة معترضة ، وظاهرها أن المفرط فيه هو الكتاب ، ولفظ {مِنْ شَيْءٍ} بيان للفرط الذي يقع التفريط به ، والمعنى لا يوجد شيء تجب رعاية حاله والقيام بواجب حقه وبيان نعته في الكتاب إلا وقد فعل من غير تفريط ، فالكتاب تام كامل .
والمراد بالكتاب إن كان هو اللوح المحفوظ الذي يسميه الله سبحانه في موارد من كلامه كتابا مكتوبا فيه كل شيء مما كان وما يكون وما هو كائن ، كان المعنى أن هذه النظامات الأممية المماثلة لنظام الإنسانية كان من الواجب في عناية الله سبحانه أن يبني عليها خلقة الأنواع الحيوانية فلا يعود خلقها عبثا ولا يذهب وجودها سدى ، ولا تكون هذه الأنواع بمقدار ما لها من لياقة القبول ممنوعة من موهبة الكمال .
فالآية على هذا تفيد بنحو الخصوص ما يفيده بنحو العموم ، قوله تعالى : {وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً} [الإسراء : 20] وقوله : {ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} [هود : 56] .
وإن كان هو القرآن الكريم وقد سماه الله كتابا في مواضع من كلامه ، كان المعنى أن القرآن المجيد لما كان كتاب هداية يهدي إلى صراط مستقيم على أساس بيان حقائق المعارف التي لا غنى عن بيانها في الإرشاد إلى صريح الحق ومحض الحقيقة لم يفرط فيه في بيان كل ما يتوقف على معرفته سعادة الناس في دنياهم وآخرتهم كما قال تعالى : {وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل : 89] .
ومما يجب أن يعرفه الناس في سبيل تفقه أمر المعاد أن يتبينوا كيفية ارتباط الحشر وهو البعث يوم القيامة على نهج الاجتماع بالتشكل الأممي في الدنيا ، وأن ذلك هو الذي يجدونه بين أنفسهم ويجدونه بين سائر الأنواع الحيوانية ، ويترتب عليه دون ذلك فوائد أخرى كالتبصر في توحيد الله تعالى ولطيف قدرته وعنايته بأمر الخليقة والنظام العام الجاري في العالم ، ومن أهم فوائده معرفة أن الموجود آخذ في سلسلته من النقص إلى الكمال ، وبعض قطعاتها المشتملة على حلقات الحيوان الشامل للإنسان وما دونه مراتب مختلفة مترتبة آخذة من المراتب القاطنة في أفق النبات إلى المراتب المجاورة لمرتبة الإنسان ثم الإنسان .
وقد ندب الله سبحانه الناس إلى معرفة الحيوان والنظر في الآيات المودعة في وجوده أبلغ الندب ، وعد ذلك موصلا إلى أفضل النتائج العلمية الملازمة للسعادة الإنسانية وهو اليقين بالله سبحانه حيث قال : {وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [الجاثية : 4] والآيات في الحث على النظر في أمر الحيوان كثيرة في القرآن الكريم .
ومن الممكن أن يشار في الآية إلى كلا المعنيين فيراد في الكتاب مطلق الكتاب ، ويكون المعنى أن الله سبحانه لا يفرط فيما يكتب من شيء ، أما في كتاب التكوين فإنه يقضي ويقدر لكل نوع ما في استحقاقه أن يناله من كمال الوجود كالأنواع الحيوانية هيأ لكل منها من سعادة الحياة الأممية الاجتماعية ما هيأه للإنسان لما رأى من صلوحها لذلك فلم يفرط في أمرها ، وأما في كتابه الذي هو كلامه الموحى إلى الناس فإنه يبين فيه ما في معرفته خير الناس وسعادة عاجلهم وآجلهم ولا يفرط في ذلك ، ومن ذلك أنه لم يفرط في أمر الأمم الحيوانية ، وبين في هذه الآية حقيقة ما وهبه لها من نوع السعادة الوجودية التي جعلتهم أمما حية سائرة بوجودها إلى الله سبحانه محشورة إليه كالإنسان .
وقوله تعالى : {ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} بيان لعموم الحشر لهم وأن حياتهم الموهوبة نوع حياة تستتبع الحشر إلى الله كما أن الحياة الإنسانية كذلك ، ولذلك أرجع الضمير المستعمل في أولي الشعور والعقل ، فقال : {إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} إشارة إلى أن أصل الملاك وهو الأمر الذي يدور عليه الرضا والسخط والإثابة والمؤاخذة موجود فيهم .
وقد وقع في الآية التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير ثم إلى الغيبة بالنسبة إليه تعالى ، والتدبر فيها يعطي أن الأصل في السياق الغيبة وإنما تحول السياق في قوله : {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} إلى التكلم مع الغير لكون المعترضة خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ منه رجع إلى أصل السياق .
ومن عجيب ما قيل في الآية استدلال بعضهم بها على التناسخ وهو أن تتعلق نفس الإنسان بعد مفارقتها البدن بالموت ببدن واحد من الحيوان يناسبها في الخلق الرذيل الذي رسخ فيها كأن تتعلق نفس المكار بدن ثعلب ، ونفس المفسد الحقود ببدن الذئب ، ونفس من يتبع سقطات الناس وعوراتهم ببدن خنزير ، ونفس الشره الأكول ببدن البقر ، وهكذا ولا تزال تنتقل من بدن إلى بدن وتعذب بذلك هذا إن كانت شقية ذات أخلاق رذيلة ، وإن كانت سعيدة تعلقت بعد الموت ببدن سعيد منعم بسعادته من أفاضل أفراد الإنسان ومعنى الآية على هذا : ما من حيوان من الحيوانات إلا أمم إنسانية أمثالكم انتقلت بعد الموت إلى صور الحيوانات .
وقد ظهر مما تقدم أن الآية في معزل من هذا المعنى ، على أن ذيل الآية : {ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} لا يلائم هذا المعنى ، على أن أمثال هذه الأقاويل من وضوح الفساد بحيث لا طائل في التعرض لها والبحث عن صحتها وسقمها .
ومن عجيب ما قيل فيها أيضا : إن المراد بحشر الحيوان موتها فلا بعث بعد ذلك أو مجموع الموت والبعث . أما الأول فينفيه ظاهر قوله : {إِلى رَبِّهِمْ} إذ لا معنى للموت إلى الله ، وأما الثاني فهو من الالتزام بما لا يلزم إذ لا موجب لضم الموت إلى البعث في المعنى ، ولا أن في الآية ما يستوجبه .
قوله تعالى : {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ} إلى آخر الآية يريد تعالى أن المكذبين لآياته محرومون من نعمة السمع والتكلم والبصر لكونهم في ظلمات لا يعمل فيها البصر فهم لصممهم لا يقدرون على أن يسمعوا الكلام الحق وأن يستجيبوا له ، ولبكمهم لا يستطيعون أن يتكلموا بالقول الحق ويشهدوا بالتوحيد والرسالة ، ولإحاطة الظلمات بهم لا يسعهم أن يبصروا طريق الحق فيتخذوه طريقا .
وفي قوله تعالى : {مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ} إلخ ، دلالة على أن هذا الصمم والبكم والوقوع في الظلمات إنما هي رجز وقع عليهم منه تعالى جزاء لتكذيبهم بآيات الله فإن الله سبحانه جعل إضلاله المنسوب إليه من قبيل الجزاء ، كما في قوله : {وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ} [البقرة : 26] .
فتكذيب آيات الله غير مسبب عن كونهم صما بكما في الظلمات بل الأمر بالعكس وعلى هذا فالمراد بالإضلال بحسب الانطباق على المورد هو جعلهم صما بكما في الظلمات والمراد بمن شاء الله ضلاله هم الذين كذبوا بآياته .
وبالمقابلة يظهر أن المراد بالجعل على صراط مستقيم هو أن يعطيه سمعا يسمع به فيجيب داعي الله بلسانه ويتبصر بالحق ببصره ، وأن هذا جزاء من لا يكذب بآيات الله سبحانه فمن يشأ الله يضلله ولا يشاء إلا إضلال من يستحقه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ولا يشاء ذلك إلا لمن تعرض لرحمته .
وقد تقدم البحث عن حقيقة معنى ما يصفهم الله تعالى به من الصمم والبكم والعمى وما يشابه ذلك من الصفات ، وقد عني في الآية بنكتة أخرى ، وهي ما يفيده الوصل والفصل في قوله : {صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ} حيث ذكر الصمم وهو من أوصافهم ثم ذكر البكم وعطفه عليه وهو صفة ثانية ، ثم ذكر كونهم في الظلمات ولم يعطفها وهي صفة ثالثة ، وبالجملة وصل بعض الصفات وفصل بعضها ، وقد أتى في مثل الآية بحسب المعنى بالفصل أعني قوله في المنافقين : {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ} [البقرة : 18] وفي آية أخرى يماثلها بالعطف وهي قوله في الكفار : {خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ} [البقرة : 7] .
ولعل النكتة في الآية التي نحن فيها أعني قوله : {صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ} ، الإشارة إلى كون من هم صم غير الذين هم بكم فالصم هم الجهلاء المقلدون الذين يتبعون كبراءهم فلا يدع لهم ذلك سمعا يسمعون به الدعوة الحقة ، والبكم هم العظماء المتبوعون الذين لهم علم بصحة الدعوة إلى التوحيد وبطلان الشرك ، غير أنهم لعنادهم وبغيهم بكم لا تنطلق ألسنتهم إلى الاعتراف بكلمة الحق والشهادة بها ، والطائفتان جميعا تشتركان في أنهما واقعتان في ظلمة لا يتبصر فيها إلى الحق ، ولا يسع غيرهما أن يبصرهما بشيء من الإشارات لمكان وقوعهما في الظلمات فلا تنجح فيها الإشارة .
ويؤيد ذلك أن الكلام المسرود في الآيات يعم الطائفتين جميعا كما يشير إليه قوله تعالى في الآيات السابقة : {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ} [آية : 26] ، وكذا قوله : {وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [آية : 37] .
هذا في الآية التي نحن فيها ، وأما آية المنافقين : {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ} ، فالعناية فيها باجتماع جميع هذه الصفات فيهم في زمان واحد لانقطاعهم عن رحمة الله من كل جهة ، وأما آية الكفار : {خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ} فقد تعلقت العناية فيها بكون ختم السمع من غير جنس ختم القلوب كما حكاه عنهم في قوله : {وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ} [حم السجدة : 5] وربما وجهت الآية بغير ذلك من الوجوه .
__________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 61-72 .
قال تعالى : {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [الانعام : 38] .
«الدّابة» من «دبّ» والدبيب المشي الخفيف ، ويستعمل ذلك في الحيوان والحشرات أكثر ، وقد ورد في الحديث «لا يدخل الجنّة ديبوب» وهو النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة .
«الطائر» كل ذي جناح يسبح في الهواء ، وقد يوصف بها بعض الأمور المعنوية التي تتقدم بسرعة واندفاع ، والآية تقصد الطائر الذي يطير بجناحيه .
«أمم» جمع أمّة ، وهي كل جماعة يجمعهم أمر ما ، كالدين الواحد أو الزمان الواحد أو المكان الواحد .
«يحشرون» من «حشر» بمعنى «الجمع» ، والمعنى الوارد في القرآن يقصد به يوم القيامة ، وخاصة لأنّه يقول : {إِلى رَبِّهِمْ} .
هذه الآية تستأنف ما جاء في الآيات السابقة من الكلام مع المشركين وتحذيرهم من مصيرهم يوم القيامة ، فتتحدث عن «الحشر» وبعث عام يشمل جميع الكائنات الحية والحيوانات ، فتقول أولا : {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُم} .
يتّضح من هذا أنّ فصائل الحيوان والطيور أمم مثل البشر ، غير أنّ للمفسّرين أقوالا مختلفة بشأن وجه الشبه في هذا التمثيل .
بعض يقول : إنّ التشابه يختص بأسرار خلقتها العجيبة التي تدل على عظمة الخالق سبحانه .
وبعض آخر يرى التشابه في حاجاتها الحياتية المختلفة وفي طرق سد تلك الحاجات وإشباعها .
ومنهم من يعتقد أنّ التشابه كائن في تشابه الإدراك والفهم والمشاعر ، أي أنّ للحيوان والطير أيضا ـ إدراكه ومشاعره في عالمه الخاص ، ويعرف الله ويسبح له ويقدسه بحسب طاقته ، وإن تكن قوّة إدراكه أدنى ممّا في الإنسان ، ثمّ إنّ ذيل هذه الآية ـ كما سيأتي بيانه ـ يؤيد هذا الرأي الأخير .
ثمّ تقول الآية : {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} .
لعل المقصود بالكتاب هو القرآن الذي يضم كل شيء (ممّا يتعلق بتربية الإنسان وهدايته وتكامله) يبيّنه مرّة بيانا عاما ، كالحث على طلب العلم مطلقا ، ومرّة بيانا تفصيليا كالكثير من الأحكام الإسلامية والقضايا الأخلاقية .
ثمّة احتمال آخر يقول : إنّ المقصود بالكتاب هو «عالم الوجود» إذ أنّ عالم الخليقة مثل الكتاب الضخم ، يضم كلّ شيء ولا ينسى شيئا .
ليس ثمّة ما يمنع من أن تشمل الآية كلا التّفسيرين ، فالقرآن لم يترك شيئا تربويا إلّا وذكره بين دفتيه ، كما أنّ عالم الخليقة يخلو من كل نقص وعوز .
وتختم الآية بالقول : {ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} .
يظهر أنّ ضمير (هم) يعود إلى الدواب والطير على اختلاف أنواعها وأصنافها ، أي أنّ لها ـ أيضا بعثا ونشورا ، وثوابا وعقابا ، وهذا ما يقول به معظم المفسّرين ، إلّا أنّ بعض المفسّرين ينكرون هذا ، ويفسّرون هذه الآية والآيات المشابهة تفسيرا آخر ، كقولهم : إنّ معنى «الحشر إلى الله» هو الموت والرجوع إلى نهاية الحياة (2) .
ظاهر الآية يشير ـ كما قلنا ـ إلى البعث والحشر يوم القيامة .
من هنا تنذر الآية المشركين وتقول لهم : إنّ الله الذي خلق جميع الحيوانات ووفر لها ما تحتاجه ، ورعى كل أفعالها ، وجعل لها حشرا ونشورا ، قد أوجد لكم دون شك بعثا وقيامة ، وليس الأمر كما تقول تلك الفئة من المشركين من أنّه ليس ثمّة شيء سوى الحياة الدنيا والممات .
{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الأنعام :39] .
الصّم والبكم :
مرّة أخرى يعود القرآن ليتطرق إلى المنكرين المعاندين ، فيقول : {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ} فهم لا يملكون آذانا صاغية لكي يستمعوا إلى الحقائق ، ولا ألسنا ناطقة بالحقّ توصل إلى الآخرين ما يدركه الإنسان من الحقائق ، ولمّا كانت ظلمات الأنانية وعباده الذات والمعاندة والجهل تحيط بهم من كل جانب ، فهم لا يستطيعون رؤية وجه الحقيقة ، ولذلك فهم محرومون من النعم الثلاث التي تربط الإنسان بالعالم الخارجي أي السمع والبصر والنطق) .
يرى بعض المفسّرين أنّ المقصود بالصمّ هم المقلّدون الذين يتبعون قادتهم الضالين دون اعتراض ، ويصمون آذانهم عن سماع دعوات الهداة الإلهيين ، وإنّ المقصود بالبكم هم أولئك القادة الضالون الذين يدركون الحقائق جيدا ، ولكنّهم حفاظا على مصالحهم ومراكزهم الدنيوية ـ يكمون أفواههم ، ولا ينطقون بالحقّ ، فكلا الفريقين غريقان في ظلمات الجهل وعبادة الذات (3) .
وبعد ذلك يقول القرآن الكريم : {مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} .
سبق أن قلنا إنّ نسبة الهداية والضلالة إلى مشيئة الله وإرادته نسبة تفسرها آيات أخرى في القرآن يقول سبحانه : {يُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ} ويقول : {وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ} وفي موضع آخر يقول : {وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا} يتّضح من هذه الآيات وغيرها من الآيات القرآنية أنّ الهداية والضلالة اللتين تنسبان في هذه الحالات إلى مشيئة الله إنّما هما في الحقيقة ثواب الله وعقابه لعباده على أفعالهم الحسنة أو السيئة .
وبعبارة أخرى : قد يرتكب الإنسان أحيانا إثما كبيرا يؤدي به إلى أن يحيط بروحه ظلام مخيف ، فتفقد عينه القدرة على رؤية الحقّ ، وتفقد أذنه القدرة على سماع صوت الحقّ ، ويفقد لسانه القدرة على قول الحقّ .
وقد يكون الأمر على عكس ذلك ، أي قد يعمل الإنسان أعمالا صالحات كثيرة بحيث أن عالما من النّور والضوء يشع في روحه ، فيتسع بصره وبصيرته ، وتزداد أفكاره إشعاعا ، ويكون لسانه ابلغ في إعلان الحقّ ، ذلكم هو مفهوم الهداية والضلالة اللتين تنسبان إلى إرادة الله ومشيئته .
________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 65-71 .
2. نقل هذا الاحتمال صاحب المنار عن ابن عباس .
3. «الميزان» ج 7 ، ص 84 .
 الاكثر قراءة في سورة الأنعام
الاكثر قراءة في سورة الأنعام
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












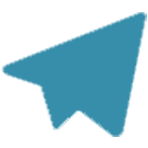
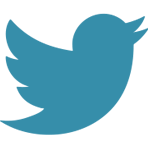

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)