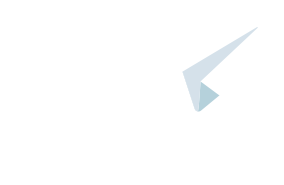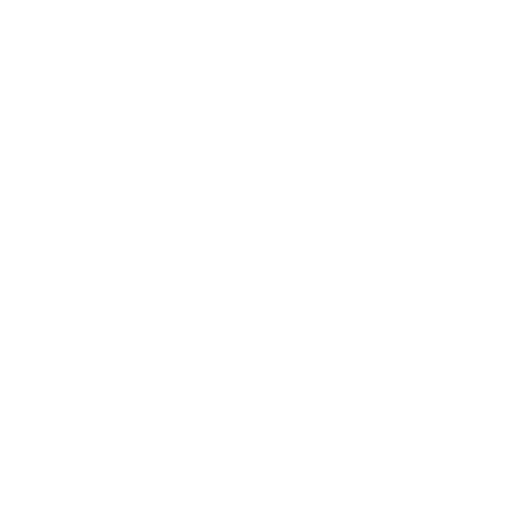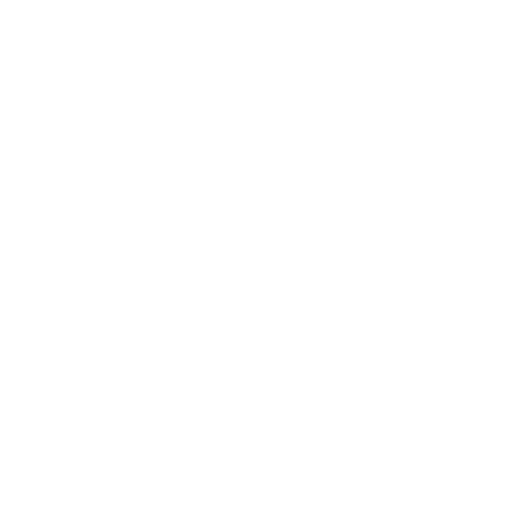تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الاية (213) من سورة البقرة
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
1-3-2017
7016
قال تعالى : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [البقرة: 213]
بين سبحانه أحوال من تقدم من الكفار تسلية للنبي فقال {كان الناس أمة واحدة} أي ذوي أمة واحدة أي أهل ملة واحدة وعلى دين واحد فحذف المضاف واختلف في أنهم على أي دين كانوا فقال قوم أنهم كانوا على الكفر وهو المروي عن ابن عباس في إحدى الروايتين والحسن واختاره الجبائي ثم اختلفوا في أي وقت كانوا كفارا فقال الحسن كانوا كفارا بين آدم ونوح وقال بعضهم كانوا كفارا بعد نوح إلى أن بعث الله إبراهيم والنبيين بعده وقال بعضهم كانوا كفارا عند مبعث كل نبي وهذا غير صحيح لأن الله بعث كثيرا من الأنبياء إلى المؤمنين .
فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الناس كلهم كفارا والله تعالى لا يجوز أن يخلي الأرض من حجة له على خلقه؟ قلنا: يجوز أن يكون الحق هناك في واحد، أو جماعة قليلة لم يمكنهم إظهار الدين خوفا وتقية فلم يعتد بهم إذا كانت الغلبة للكفار وقال آخرون إنهم كانوا على الحق وهو المروي عن قتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن عباس في الرواية الأخرى ثم اختلفوا فقال ابن عباس وقتادة هم كانوا بين آدم ونوح وهم عشر فرق كانوا على شريعة من الحق فاختلفوا بعد ذلك وقال الواقدي والكلبي هم أهل سفينة نوح حين غرق الله الخلق ثم اختلفوا بعد ذلك فالتقدير على قول هؤلاء {كان الناس أمة واحدة} فاختلفوا.
{فبعث الله النبيين} وقال مجاهد المراد به آدم كان على الحق إماما لذريته فبعث الله النبيين في ولده وروى أصحابنا عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنه قال كانوا قبل نوح أمة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالا فبعث الله النبيين وعلى هذا فالمعنى أنهم كانوا متعبدين بما في عقولهم غير مهتدين إلى نبوة ولا شريعة ثم بعث الله النبيين بالشرائع لما علم أن مصالحهم فيها {فبعث الله} أي أرسل الله النبيين.
{مبشرين} لمن أطاعهم بالجنة {ومنذرين} لمن عصاهم بالنار {وأنزل معهم الكتاب} أي أنزل مع كل واحد منهم الكتاب وقيل معناه وأنزل مع بعثهم الكتاب إذ الأنبياء لم يكونوا منزلين حتى ينزل الكتاب معهم وأراد به مع بعضهم لأنه لم ينزل مع كل نبي كتاب وقيل المراد به الكتب لأن الكتاب اسم جنس فمعناه الجمع قوله {بالحق} أي بالصدق والعدل وقيل معناه وأنزل الكتاب بأنه حق وأنه من عند الله وقيل معناه وأنزل الكتاب بما فيه من بيان الحق وقوله {ليحكم بين الناس} الضمير في يحكم يرجع إلى الله أي ليحكم الله منزل الكتاب وقيل يرجع إلى الكتاب أي ليحكم الكتاب فأضاف الحكم إلى الكتاب وإن كان الله هو الذي يحكم على جهة التفخيم لأمر الكتاب.
{فيما اختلفوا فيه} من الحق قبل إنزال الكتاب ومتى سئل عن هذا فقيل إذا كانوا مختلفين في الحق فكيف عمهم الكفر في قول من قال أنهم كانوا كلهم كفارا فجوابه أنه لا يمتنع أن يكونوا كفارا وبعضهم يكفر من جهة الغلو وبعضهم يكفر من جهة التقصير كما كفرت اليهود والنصارى في المسيح فقالت النصارى هورب وقالت اليهود هو كاذب.
وقوله {وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه} معناه وما اختلف في الحق إلا الذين أعطوا العلم به كاليهود فإنهم كتموا صفة النبي بعد ما أعطوا العلم به {من بعد ما جاءتهم البينات} أي الأدلة والحجج الواضحة وقيل التوراة والإنجيل وقيل معجزات محمد {بغيا بينهم} أي ظلما وحسدا وطلبا للرئاسة وقوله {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} معناه فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه بعلمه والأذن بمعنى العلم مشهور في اللغة قال الحارث بن حلزة :
آذنتنا ببينها أسماء أي أعلمتنا وإنما خص المؤمنين لأنهم اختصوا بالاهتداء وقيل إن معنى بإذنه بلطفه فعلى هذا يكون في الكلام محذوف أي فاهتدوا بإذنه وإنما قال هداهم لما اختلفوا فيه من الحق ولم يقل هداهم للحق فيما اختلفوا فيه لأنه لما كانت العناية بذكر الاختلاف كان أولى بالتقديم فقدمه ثم فسره بِمِن.
{والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} فيه أقوال ( أحدها ) أن المراد به البيان والدلالة والصراط المستقيم هو الإسلام وخص به المكلفين دون غيرهم ممن لا يحتمل التكليف عن الجبائي ( وثانيها ) أن المراد به يهديهم باللطف فيكون خاصا بمن علم من حاله أنه يصلح به عن البلخي وابن الإخشيد ( وثالثها ) أن المراد به يهديهم إلى صراط الجنة ويأخذ بهم على طريقها فتكون مخصوصا بالمؤمنين .
_________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج2، ص65-67.
تضاربت أقوال المفسرين في معنى هذه الآية ، وشرحها الرازي بحوالي سبع صفحات بالقطع الكبير ، أما صاحب المنار فشرحها باثنتين وعشرين صفحة ، وترك القارئ العادي في متاهة لا يهتدي إلى شيء . . ونحن على منهجنا من الرفق بالقراء مهتمين بأضعفهم ما أمكن واقفين معه عند مداليل الألفاظ ، نشرحها بأوضح وأخصر بيان ، كي يتدبر آيات اللَّه بسهولة ، وتؤثر أثرها في نفسه ، فان كان هناك موضوع هام أشرنا إليه بفقرة مستقلة .
{كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً} . أي كانوا على الفطرة التي فطر اللَّه الناس عليها ، والتي أشار إليها النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) بقوله : كل مولود يولد على الفطرة .
قال صاحب مجمع البيان : (روى أصحابنا عن الإمام أبي جعفر الباقر : انهم كانوا قبل نوح (2) أمة واحدة على فطرة اللَّه لا مهتدين ولا ضالين ، فبعث اللَّه النبيين . وعلى هذا فالمعنى انهم كانوا متعبدين بما في عقولهم غير مهتدين إلى نبوة ، ولا شريعة) .
ثم عرض على فطرتهم التخيلات والأوهام ، وجرتهم هذه الأوهام إلى الاختلاف في العقيدة والرأي ، وبالتالي إلى اعتداء بعضهم على بعض ، فتفرقوا شيعا بعد أن كانوا أمة واحدة ، فأرسل اللَّه الأنبياء ، ومعهم الكتاب ينطق بالحق ، ويحكم بالعدل ، ليحتكموا إليه في خلافاتهم ومنازعاتهم . . وهذا هو المعنى الظاهر من قوله تعالى :
{فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ وأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } . . وبهذا يتبين ان في الكلام جملة محذوفة ، والتقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ، بدليل قوله تعالى {لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} ، وتؤكد ذلك الآية 19 من سورة يونس : {وما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} .
{ومَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} .
أي ان الناس الذين كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا فأرسل اللَّه إليهم الأنبياء ، ان أولئك الناس أيضا اختلفوا فيما أرسل به الأنبياء ، فمنهم من آمن وصدق ، ومنهم من كفر وكذّب بعد أن قامت الأدلة والبراهين ، والحجة القاطعة على
الكافرين والمكذبين للأنبياء ورسالتهم ، ولا سبب لهذا التكذيب الا البغي والخوف على منافعهم ومصالحهم الشخصية ، ومكاسبهم العدوانية .
{فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ} . أي ان اللَّه سبحانه وفق أرباب النوايا الصالحة إلى الايمان بالحق الذي جاء به الأنبياء ، وهذا الايمان كان بأمره تعالى . . فالمراد بالإذن الأمر .
{واللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} . في تفسير الآية 26 من هذه السورة (فقرة الهدى والضلال) ذكرنا معاني الهداية ، ومنها أن يتقبل الإنسان النصيحة ويعمل بها ، وهذا المعنى هو المراد بها هنا ، وان اللَّه سبحانه يوفق الطيبين إلى تقبل النصح والعمل بالحق والخير .
الاختلاف بين الناس :
وجد الاختلاف بين الناس منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل ، واستمر حتى اليوم ، وسيبقى إلى آخر يوم . . ولا يختص الاختلاف بأهل الأديان ، كما يحلو للمستهترين ان ينتقدوا ، أو يتحذلقوا . . فان اختلاف غيرهم قد بلغ النهاية ، وتجاوز الكلام إلى الحروب الطاحنة ، فالتناقضات بين الدول الرأسمالية أدت إلى حرب نووية ، فقنبلة هيروشيما ألقتها على النساء والأطفال دولة رأسمالية ضد دولة مثلها . . وانقسام الجبهة الاشتراكية لم يخف على أحد ، كما مهد السبيل للسياسة العدوانية على الشعوب المستضعفة ، وشتات كل من الدول الإفريقية والاسيوية ضمن النجاح لكل من أراد استغلالها والسيطرة على مقدراتها ، أما اختلاف الدول العربية فكان من نتائجه وجود إسرائيل في قلب بلادهم ، وبالتالي نكسة 5 حزيران 1967 .
ومهما يكن ، فان للاختلاف أسبابا كثيرة ، منها التباين في الثقافة والتربية ، ومنها التغاير في الاستعداد والموهبة ، ومنها الاختلاف في الطبع والمزاج ، ومنها التصادم بين المصالح والمنفعة الخاصة . والاختلاف الناشئ من تباين الثقافة ، أو الموهبة ، أو المزاج يمكن علاجه بالاحتكام إلى مبادئ أثبتها العلم والتجربة ، أما الاختلاف الناشئ من تصادم المنافع الشخصية فلا علاج له إلا ردع المعتدي بالقوة ، وكلامنا
في هذه الفقرة متمم لما قلناه في فقرة (كل يعزز دينه) عند تفسير الآية 113 .
_______________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1، ص316-319.
2- جاء في تفسير روح البيان عن الأكثر ان بين آدم ومبعث نوح ثماني مائة سنة .
قوله تعالى: {كان الناس أمة واحدة} ، الناس معروف وهو الأفراد المجتمعون من الإنسان، والأمة هي الجماعة من الناس، وربما يطلق على الواحد كما في قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ } [النحل: 120] ، وربما يطلق على زمان معتد به كقوله تعالى: {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} [يوسف: 45] ، أي بعد سنين وقوله تعالى: {وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ} [هود: 8] ، وربما يطلق على الملة والدين كما قال بعضهم في قوله تعالى: { وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون: 52] ، وفي قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92] ، وأصل الكلمة من أم يأم إذا قصد فأطلق لذلك على الجماعة لكن لا على كل جماعة، بل على جماعة كانت ذات مقصد واحد وبغية واحدة هي رابطة الوحدة بينها، وهو المصحح لإطلاقها على الواحد وعلى سائر معانيها إذا أطلقت.
وكيف كان فظاهر الآية يدل على أن هذا النوع قد مر عليهم في حياتهم زمان كانوا على الاتحاد والاتفاق، وعلى السذاجة والبساطة، لا اختلاف بينهم بالمشاجرة والمدافعة في أمور الحياة، ولا اختلاف في المذاهب والآراء، والدليل على نفي الاختلاف قوله تعالى:{فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه}، فقد رتب بعثة الأنبياء وحكم الكتاب في مورد الاختلاف على كونهم أمة واحدة فالاختلاف في أمور الحياة ناش بعد الاتحاد والوحدة، والدليل على نفي الاختلاف الثاني قوله تعالى: {وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم} فالاختلاف في الدين إنما نشأ من قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغي.
وهذا هو الذي يساعد عليه الاعتبار، فإنا نشاهد النوع الإنساني لا يزال يرقى في العلم والفكر، ويتقدم في طريق المعرفة والثقافة، عاما بعد عام، وجيلا بعد جيل، وبذلك يستحكم أركان اجتماعه يوما بعد يوم، ويقوم على رفع دقائق الاحتياج، والمقاومة قبال مزاحمات الطبيعة، والاستفادة من مزايا الحياة، وكلما رجعنا في ذلك القهقرى وجدناه أقل عرفانا برموز الحياة، وأسرار الطبيعة، وينتهي بنا هذا السلوك إلى الإنسان الأولي الذي لا يوجد عنده إلا النزر القليل من المعرفة بشئون الحياة وحدود العيش، كأنهم ليس عندهم إلا البديهيات ويسير من النظريات الفكرية التي تهيئ لهم وسائل البقاء بأبسط ما يكون، كالتغذي بالنبات أو شيء من الصيد والإيواء إلى الكهوف والدفاع بالحجارة والأخشاب ونحو ذلك، فهذا حال الإنسان في أقدم عهوده، ومن المعلوم أن قوما حالهم هذا الحال لا يظهر فيهم الاختلاف ظهورا يعتد به، ولا يبدو فيهم الفساد بدوا مؤثرا، كالقطيع من الغنم لا هم لأفراده إلا الاهتداء لبعض ما اهتدى إليه بعض آخر، والتجمع في المسكن والمعلف والمشرب.
غير أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه كما أشرنا إليه فيما مر لا يحبسه هذا الاجتماع القهري من حيث التعاون على رفع البعض حوائج البعض عن الاختلاف والتغالب والتغلب، وهو كل يوم يزداد علما وقوة على طرق الاستفادة، ويتنبه بمزايا جديدة، ويتيقظ لطرق دقيقة في الانتفاع، وفيهم الأقوياء وأولوا السطوة وأرباب القدرة، وفيهم الضعفاء ومن في رتبتهم، وهو منشأ ظهور الاختلاف، الاختلاف الفطري الذي دعت إليه قريحة الاستخدام، كما دعت هذه القريحة بعينها إلى الاجتماع والمدنية.
ولا ضير في تزاحم حكمين فطريين، إذا كان فوقهما ثالث يحكم بينهما، ويعدل أمرهما، ويصلح شأنهما، وذلك كالإنسان تتسابق قواه في أفعالها، ويؤدي ذلك إلى التزاحم، كما أن جاذبة التغذي تقضي بأكل ما لا تطيق هضمه الهاضمة ولا تسعه المعدة، وهناك عقل يعدل بينهما، ويقضي لكل بما يناسبه، ويقدر فعل كل واحدة من هذه القوى الفعالة بما لا يزاحم الأخرى في فعلها.
والتنافي بين حكمين فطريين فما نحن فيه من هذا القبيل، فسلوك فطرة الإنسان إلى المدنية ثم سلوكها إلى الاختلاف يؤديان إلى التنافي، ولكن الله يرفع التنافي برفع الاختلاف الموجود ببعث الأنبياء بالتبشير والإنذار، وإنزال الكتاب الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
وبهذا البيان يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بالآية أن الناس كانوا أمة واحدة على الهداية، لأن الاختلاف إنما ظهر بعد نزول الكتاب بغيا بينهم، والبغي من حملة الكتاب، وقد غفل هذا القائل عن أن الآية تثبت اختلافين اثنين لا اختلافا واحدا، وقد مر بيانه، وعن أن الناس لو كانوا على الهداية فإنها واحدة من غير اختلاف، فما هو الموجب بل ما هو المجوز لبعث الأنبياء وإنزال الكتاب وحملهم على البغي بالاختلاف، وإشاعة الفساد، وإثارة غرائز الكفر والفجور ومهلكات الأخلاق مع استبطانها؟.
ويظهر به أيضا: فساد ما ذكره آخرون أن المراد بها أن الناس كانوا أمة واحدة على الضلالة، إذ لولاها لم يكن وجه لترتب قوله تعالى: {فبعث الله النبيين} "إلخ"، وقد غفل هذا القائل عن أن الله سبحانه يذكر أن هذا الضلال الذي ذكره وهو الذي أشار إليه بقوله سبحانه: {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} ، إنما نشأ عن سوء سريرة حملة الكتاب وعلماء الدين بعد نزول الكتاب، وبيان آياته للناس، فلو كانوا على الضلالة قبل البعث والإنزال وهي ضلالة الكفر والنفاق والفجور والمعاصي فما المصحح لنسبة ذلك إلى حملة الكتاب وعلماء الدين؟.
ويظهر به أيضا ما في قول آخرين إن المراد بالناس بنو إسرائيل حيث إن الله يذكر أنهم اختلفوا في الكتاب بغيا بينهم، قال تعالى: {فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [الجاثية: 17] ، وذلك أنه تفسير من غير دليل، ومجرد اتصاف قوم بصفة لا يوجب انحصارها فيهم.
وأفسد من ذلك قول من قال: إن المراد بالناس في الآية هو آدم (عليه السلام)، والمعنى أن آدم (عليه السلام) كان أمة واحدة على الهداية ثم اختلف ذريته، فبعث الله النبيين "إلخ"، والآية بجملها لا تطابق هذا القول لا كله ولا بعضه.
ويظهر به أيضا فساد قول بعضهم: إن كان في الآية منسلخ عن الدلالة على الزمان كما في قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } [الفتح: 7] ، فهو دال على الثبوت، والمعنى: أن الناس أمة واحدة من حيث كونهم مدنيين طبعا فإن الإنسان مدني بالطبع لا يتم حياة الفرد الواحد منه وحده، لكثرة حوائجه الوجودية، واتساع دائرة لوازم حياته، بحيث لا يتم له الكمال إلا بالاجتماع والتعاون بين الأفراد والمبادلة في المساعي، فيأخذ كل من نتائج عمله ما يستحقه من هذه النتيجة ويعطي الباقي غيره، ويأخذ بدله بقية ما يحتاج إليه ويستحقه في وجوده، فهذا حال الإنسان لا يستغني عن الاجتماع والتعاون وقتا من الأوقات، يدل عليه ما وصل إلينا من تاريخ هذا النوع الاجتماعي المدني وكونه اجتماعيا مدنيا لم يزل على ذلك فهو مقتضى فطرته وخلقته غير أن ذلك يؤدي إلى الاختلاف، واختلال نظام الاجتماع، فشرع الله سبحانه بعنايته البالغة شرائع ترفع هذا الاختلاف، وبلغها إليهم ببعث النبيين مبشرين ومنذرين، وإنزال الكتاب الحاكم معهم للحكم في موارد الاختلاف.
فمحصل المعنى أن الناس أمة واحدة مدنية بالطبع لا غنى لهم عن الاجتماع وهو يوجب الاختلاف فلذلك بعث الله الأنبياء وأنزل الكتاب.
ويرد عليه أولا: أنه أخذ المدنية طبعا أوليا للإنسان، والاجتماع والاشتراك في الحياة لازما ذاتيا لهذا النوع، وقد عرفت فيما مر أن الأمر ليس كذلك، بل أمر تصالحي اضطراري، وأن القرآن أيضا يدل على خلافه.
وثانيا: أن تفريع بعث الأنبياء وإنزال الكتب على مجرد كون الإنسان مدنيا بالطبع غير مستقيم إلا بعد تقييد هذه المدنية بالطبع بكونها مؤدية إلى الاختلاف، وظهور الفساد، فيحتاج الكلام إلى التقدير وهو خلاف الظاهر، والقائل مع ذلك لا يرضى بتقدير الاختلاف في الكلام.
وثالثا: أنه مبني على أخذ الاختلاف الذي تذكره الآية وتتعرض به اختلافا واحدا، والآية كالنص في كون الاختلاف اختلافين اثنين، حيث تقول: {وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} ، فهو اختلاف سابق على الكتاب والمختلفون بهذا الاختلاف هم الناس، ثم تقول وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي علموا الكتاب وحملوه بغيا بينهم، وهذا الاختلاف لاحق بالكتاب متأخر عن نزوله، والمختلفون بهذا الاختلاف علماء الكتاب وحملته دون جميع الناس، فأحد الاختلافين غير الآخر: أحدهما اختلاف عن بغي وعلم، والآخر بخلافه.
قوله تعالى: {فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين} "إلخ"، عبر تعالى بالبعث دون الإرسال وما في معناه لأن هذه الوحدة المخبر عنها من حال الإنسان الأولي حال خمود وسكوت، وهو يناسب البعث الذي هو الإقامة عن نوم أو قطون ونحو ذلك، وهذه النكتة لعلها هي الموجبة للتعبير عن هؤلاء المبعوثين بالنبيين دون أن يعبر بالمرسلين أو الرسل، على أن البعث وإنزال الكتاب كما تقدم بيانه حقيقتهما بيان الحق للناس وتنبيههم بحقيقة أمر وجودهم وحياتهم، وإنبائهم أنهم مخلوقون لربهم، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وأنهم سالكون كادحون إلى الله مبعوثون ليوم عظيم، واقفون في منزل من منازل السير، لا حقيقة له إلا اللعب والغرور، فيجب أن يراعوا ذلك في هذه الحياة وأفعالها، وأن يجعلوا نصب أعينهم أنهم من أين، وفي أين، وإلى أين، وهذا المعنى أنسب بلفظ النبي الذي معناه: من استقر عنده النبأ دون الرسول، ولذلك عبر بالنبيين، وفي إسناد بعث النبيين إلى الله سبحانه دلالة على عصمة الأنبياء في تلقيهم الوحي وتبليغهم الرسالة إلى الناس وسيجيء زيادة توضيح لهذا في آخر البيان، وأما التبشير والإنذار أي الوعد برحمة الله من رضوانه والجنة لمن آمن واتقى، والوعيد بعذاب الله سبحانه من سخطه والنار لمن كذب وعصى فهما أمس مراتب الدعوة بحال الإنسان المتوسط الحال، وإن كان بعض الصالحين من عباده وأوليائه لا تتعلق نفوسهم بغير ربهم من ثواب أو عقاب.
قوله تعالى: {وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه}، الكتاب فعال بمعنى المكتوب، والكتاب بحسب المتعارف من إطلاقه وإن استلزم كتابه بالقلم لكن لكون العهود والفرامين المفترضة إنما يبرم بالكتابة غالبا شاع إطلاقه على كل حكم مفروض واجب الاتباع أوكل بيان بل كل معنى لا يقبل النقض في إبرامه، وقد كثر استعماله بهذا المعنى في القرآن، وبهذا المعنى سمي القرآن كتابا وهو كلام إلهي، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ} [ص: 29] ، وقال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } [النساء: 103] ، وفي قوله تعالى {فيما اختلفوا فيه}، دلالة على أن المعنى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله "إلخ"، كما مر.
واللام في الكتاب إما للجنس وإما للعهد الذهني والمراد به كتاب نوح (عليه السلام) لقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى } [الشورى: 13] ، فإن الآية في مقام الامتنان وتبين أن الشريعة النازلة على هذه الأمة جامعة لمتفرقات جميع الشرائع السابقة النازلة على الأنبياء السالفين مع ما يختص بوحيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فالشريعة مختصة بهؤلاء الأنبياء العظام: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولما كان قوله تعالى: {وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} الآية يدل على أن الشرع إنما كان بالكتاب دلت الآيتان بالانضمام أولا: على أن لنوح (عليه السلام) كتابا متضمنا لشريعة، وأنه المراد بقوله تعالى: {وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} ، إما وحده أو مع غيره من الكتب بناء على كون اللام للعهد أو الجنس.
وثانيا: أن كتاب نوح أول كتاب سماوي متضمن للشريعة، إذ لوكان قبله كتاب لكان قبله شريعة حاكمة ولذكرها الله تعالى في قوله: {شرع لكم} الآية.
وثالثا: أن هذا العهد الذي يشير تعالى إليه بقوله: {كان الناس أمة واحدة } الآية كان قبل بعثة نوح (عليه السلام) وقد حكم فيه كتابه (عليه السلام).
قوله تعالى: {وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم}، قد مر أن المراد به الاختلاف الواقع في نفس الدين من حملته، وحيث كان الدين من الفطرة كما يدل عليه قوله تعالى: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] ، نسب الله سبحانه الاختلاف الواقع فيه إلى البغي.
وفي قوله تعالى: {إلا الذين أوتوه} ، دلالة على أن المراد بالجملة هو الإشارة إلى الأصل في ظهور الاختلاف الديني في الكتاب لا أن كل من انحرف عن الصراط المستقيم أو تدين بغير الدين يكون باغيا وإن كان ضالا عن الصراط السوي، فإن الله سبحانه لا يعذر الباغي، وقد عذر من اشتبه عليه الأمر ولم يجد حيلة ولم يهتد سبيلا، قال تعالى: { إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [الشورى: 42] ، وقال تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 102] - إلى أن قال -: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 106] ، وقال تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا } [النساء: 98، 99].
على أن الفطرة لا تنافي الغفلة والشبهة، ولكن تنافي التعمد والبغي، ولذلك خص البغي بالعلماء ومن استبانت له الآيات الإلهية، قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة: 39] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد قيد الكفر في جميعها بتكذيب آيات الله ثم أوقع عليه الوعيد، وبالجملة فالمراد بالآية أن هذا الاختلاف ينتهي إلى بغي حملة الكتاب من بعد علم.
قوله تعالى: {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق} بيان لما اختلف فيه وهو الحق الذي كان الكتاب نزل بمصاحبته، كما دل عليه قوله تعالى: {وأنزل معهم الكتاب بالحق} ، وعند ذلك عنت الهداية الإلهية بشأن الاختلافين معا: الاختلاف في شأن الحياة، والاختلاف في الحق والمعارف الإلهية الذي كان عامله الأصلي بغي حملة الكتاب، وفي تقييد الهداية بقوله تعالى: {بإذنه} دلالة على أن هداية الله تعالى لهؤلاء المؤمنين لم تكن إلزاما منهم، وإيجابا على الله تعالى أن يهديهم لإيمانهم، فإن الله سبحانه لا يحكم عليه حاكم، ولا يوجب عليه موجب إلا ما أوجبه على نفسه، بل كانت الهداية بإذنه تعالى ولوشاء لم يأذن ولم يهد، وعلى هذا فقوله تعالى: {والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} بمنزلة التعليل لقوله بإذنه، والمعنى إنما هداهم الله بإذنه لأن له أن يهديهم وليس مضطرا موجبا على الهداية في مورد أحد، بل يهدي من يشاء، وقد شاء أن يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
وقد تبين من الآية أولا: حد الدين ومعرفه، وهو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي، والحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه، فلا بد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج.
وثانيا: أن الدين أول ما ظهر ظهر رافعا للاختلاف الناشئ عن الفطرة ثم استكمل رافعا للاختلاف الفطري وغير الفطري معا.
وثالثا: أن الدين لا يزال يستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات الاحتياج في الحياة، فإذا استوعبها ختم ختما فلا دين بعده، وبالعكس إذا كان دين من الأديان خاتما كان مستوعبا لرفع جميع جهات الاحتياج، قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40] ، وقال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وقال تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ } [فصلت: 41، 42].
ورابعا: أن كل شريعة لاحقة أكمل من سابقتها.
وخامسا: السبب في بعث الأنبياء وإنزال الكتب، وبعبارة أخرى العلة في الدعوة الدينية، وهو أن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الاختلاف كما أنه سالك نحو الاجتماع المدني، وإذا كانت الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف لم تتمكن من رفع الاختلاف، وكيف يدفع شيء ما يجذبه إليه نفسه، فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوة والتشريع بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالهم المصلح لشأنهم، وهذا الكمال كمال حقيقي داخل في الصنع والإيجاد فما هو مقدمته كذلك، وقد قال تعالى: {الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى } [طه: 50] ، فبين أن من شأنه وأمره تعالى أن يهدي كل شيء إلى ما يتم به خلقه، ومن تمام خلقه الإنسان أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا والآخرة، وقد قال تعالى أيضا: {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا } [الإسراء: 20]، وهذه الآية تفيد أن شأنه تعالى هو الإمداد بالعطاء: يمد كل من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته ووجوده، ويعطيه ما يستحقه، وأن عطاءه غير محظور ولا ممنوع من قبله تعالى إلا أن يمتنع ممتنع بسوء حظ نفسه، من قبل نفسه لا من قبله تعالى.
ومن المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تتميم هذه النقيصة من قبل نفسه فإن فطرته هي المؤدية إلى هذه النقيصة فكيف يقدر على تتميمها وتسوية طريق السعادة والكمال في حياته الاجتماعية؟.
وإذا كانت الطبيعة الإنسانية هي المؤدية إلى هذا الاختلاف العائق للإنسان عن الوصول إلى كماله الحري به وهي قاصرة عن تدارك ما أدت إليه وإصلاح ما أفسدته، فالإصلاح لوكان يجب أن يكون من جهة غير جهة الطبيعة، وهي الجهة الإلهية التي هي النبوة بالوحي، ولذا عبر تعالى عن قيام الأنبياء بهذا الإصلاح ورفع الاختلاف بالبعث ولم ينسبه في القرآن كله إلا إلى نفسه مع أن قيام الأنبياء كسائر الأمور له ارتباطات بالمادة بالروابط الزمانية والمكانية.
فالنبوة حالة إلهية وإن شئت قل غيبية نسبتها إلى هذه الحالة العمومية من الإدراك والفعل نسبة اليقظة إلى النوم بها يدرك الإنسان المعارف التي بها يرتفع الاختلاف والتناقض في حياة الإنسان، وهذا الإدراك والتلقي من الغيب هو المسمى في لسان القرآن بالوحي، والحالة التي يتخذها الإنسان منه لنفسه بالنبوة.
ومن هناك يظهر أن هذا أعني تأدية الفطرة إلى الاجتماع المدني من جهة وإلى الاختلاف من جهة أخرى، وعنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة مبدأ حجة على وجود النبوة، وبعبارة أخرى دليل النبوة العامة.
تقريره: أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع، وهذا الاستخدام الفطري يؤديه إلى الاجتماع المدني وإلى الاختلاف والفساد في جميع شئون حياته الذي يقضي التكوين والإيجاد برفعه ولا يرتفع إلا بقوانين تصلح الحياة الاجتماعية برفع الاختلاف عنها، وهداية الإنسان إلى كماله وسعادته بأحد أمرين: إما بفطرته وإما بأمر وراءه لكن الفطرة غير كافية فإنها هي المؤدية إلى الاختلاف فكيف ترفعها؟ فوجب أن يكون بهداية من غير طريق الفطرة والطبيعة، وهو التفهيم الإلهي غير الطبيعي المسمى بالنبوة والوحي، وهذه الحجة مؤلفة من مقدمات مصرح بها في كتاب الله تعالى كما عرفت فيما تقدم، وكل واحدة من هذه المقدمات تجربية، بينتها التجربة للإنسان في تاريخ حياته واجتماعاته المتنوعة التي ظهرت وانقرضت في طي القرون المتراكمة الماضية، إلى أقدم أعصار الحياة الإنسانية التي يذكرها التاريخ.
فلا الإنسان انصرف في حين من أحيان حياته عن حكم الاستخدام، ولا استخدامه لم يؤد إلى الاجتماع وقضى بحياة فردية، ولا اجتماعه المكون خلا عن الاختلاف، ولا الاختلاف ارتفع بغير قوانين اجتماعية، ولا أن فطرته وعقله الذي يعده عقلا سليما قدرت على وضع قوانين تقطع منابت الاختلاف وتقلع مادة الفساد، وناهيك في ذلك: ما تشاهده من جريان الحوادث الاجتماعية، وما هو نصب عينيك من انحطاط الأخلاق وفساد عالم الإنسانية، والحروب المهلكة للحرث والنسل، والمقاتل المبيدة للملايين بعد الملايين من الناس، وسلطان التحكم ونفوذ الاستعباد في نفوس البشر وأعراضهم وأموالهم في هذا القرن الذي يسمى عصر المدنية والرقى والثقافة والعلم، فما ظنك بالقرون الخالية، أعصار الجهل والظلمة؟.
وأما إن الصنع والإيجاد يسوق كل موجود إلى كماله اللائق به فأمر جار في كل موجود بحسب التجربة والبحث، وكذا كون الخلقة والتكوين إذا اقتضى أثرا لم يقتض خلافه بعينه أمر مسلم تثبته التجربة والبحث، وأما إن التعليم والتربية الدينيين الصادرين من مصدر النبوة والوحي يقدران على دفع هذا الاختلاف والفساد فأمر يصدقه البحث والتجربة معا: أما البحث: فلأن الدين يدعو إلى حقائق المعارف وفواضل الأخلاق ومحاسن الأفعال فصلاح العالم الإنساني مفروض فيه، وأما التجربة: فالإسلام أثبت ذلك في اليسير من الزمان الذي كان الحاكم فيه على الاجتماع بين المسلمين هو الدين، وأثبت ذلك بتربية أفراد من الإنسان صلحت نفوسهم، وأصلحوا نفوس غيرهم من الناس، على أن جهات الكمال والعروق النابضة في هيكل الاجتماع المدني اليوم التي تضمن حياة الحضارة والرقي مرهونة التقدم الإسلامي وسريانه في العالم الدنيوي على ما يعطيه التجزية والتحليل من غير شك، وسنستوفي البحث عنه إن شاء الله في محل آخر أليق به.
وسادسا: أن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكمال الإنساني، قضاء القرآن بختم النبوة وعدم نسخ الدين وثبات الشريعة يستوجب أن الاستكمال الفردي والاجتماعي للإنسان هو هذا المقدار الذي اعتبره القرآن في بيانه وتشريعه.
وهذا من ملاحم القرآن التي صدقها جريان تاريخ الإنسان منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا في زمان يقارب أربعة عشر قرنا تقدم فيها النوع في الجهات الطبيعي من اجتماعه تقدما باهرا، وقطع بعدا شاسعا غير أنه وقف من جهة معارفه الحقيقية، وأخلاقه الفاضلة موقفه الذي كان عليه، ولم يتقدم حتى قدما واحدا، أو رجع أقداما خلفه القهقرى، فلم يتكامل في مجموع كماله من حيث المجموع أعني الكمال الروحي والجسمي معا.
وقد اشتبه الأمر على من يقول: إن جعل القوانين العامة لما كان لصلاح حال البشر وإصلاح شأنه وجب أن تتبدل بتبدل الاجتماعيات في نفسها وارتقائها وصعودها مدارج الكمال، ولا شك أن النسبة بيننا وبين عصر نزول القرآن، وتشريع قوانين الإسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر وعصر بعثة عيسى (عليه السلام) وموسى (عليه السلام) فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر وعصر النبي موجبا لنسخ شرائع الإسلام ووضع قوانين أخر قابلة الانطباق على مقتضيات العصر الحاضر.
والجواب عنه: أن الدين كما مر لم يعتبر في تشريعه مجرد الكمال المادي الطبيعي للإنسان، بل اعتبر حقيقة الوجود الإنساني، وبنى أساسه على الكمال الروحي والجسمي معا، وابتغى السعادة المادية والمعنوية جميعا، ولازم ذلك أن يعتبر فيه حال الفرد الاجتماعي المتكامل بالتكامل الديني دون الفرد الاجتماعي المتكامل بالصنعة والسياسة، وقد اختلط الأمر على هؤلاء الباحثين فإنهم لولوعهم في الأبحاث الاجتماعية المادية والمادة متحولة متكاملة كالاجتماع المبني عليها حسبوا أن الاجتماع الذي اعتبره الدين نظير الاجتماع الذي اعتبروه اجتماع مادي جسماني، فحكموا عليه بالتغير والنسخ حسب تحول الاجتماع المادي، وقد عرفت أن الدين لا يبني تشريعه على أساس الجسم فقط، بل الجسم والروح جميعا، وعلى هذا يجب أن يفرض فرد ديني أو اجتماع ديني جامع للتربية الدينية والحياة المادية التي سمحت به دنيا اليوم ثم لينظر هل يوجد عنده شيء من النقص المفتقر إلى التتميم، والوهن المحتاج إلى التقوية؟.
وسابعا: أن الأنبياء (عليهم السلام) معصومون عن الخطأ.
__________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج2، ص104-113.
طريق الوصول إلى الوحدة :
بعد بيان حال المؤمنين والمنافقين والكفّار في الآيات السّابقة شرع القرآن الكريم في هذه الآية في بحث اُصوليّ كلّي وجامع بالنسبة لظهور الدّين وأهدافه والمراحل المختلفة الّتي مرّ بها.
في البداية تقول الآية {كان النّاس اُمّة واحدة}(2).
فتبدأ هذه الآية ببيان مراحل الحياة البشريّة وكيفيّة ظهور الدّين لإصلاح المجتمع بواسطة الأنبياء وذلك على مراحل :
المرحلة الاُولى : مرحلة حياة الإنسان الابتدائية حيث لم يكن للإنسان قد ألف الحياة الإجتماعية، ولم تبرز في حياته التناقضات والاختلافات، وكان يعبد الله تعالى استجابةً لنداء الفطرة ويؤدّي له فرائضه البسيطة، وهذه المرحلة يحتمل أن تكون في الفترة الفاصلة بين آدم ونوح (عليهما السلام).
المرحلة الثانية : وفيها اتّخذت حياة الإنسان شكلاً اجتماعيّاً، ولابدّ أن يحدث ذلك لأنّه مفطور على التكامل، وهذا لا يتحقّق إلاّ في الحياة الإجتماعيّة.
المرحلة الثالثة : هي مرحلة التناقضات والاصطدامات الحتميّة بين أفراد المجتمع البشري بعد استحكام وظهور الحياة الإجتماعيّة، وهذه الإختلافات سواء كانت من حيث الإيمان والعقيدة، أومن حيث العمل وتعيين حقوق الأفراد والجماعات تحتّم وجود قوانين لرعاية وحل هذه الإختلافات، ومن هنا نشأت الحاجة الماسّة إلى تعاليم الأنبياء وهدايتهم.
المرحلة الرابعة : وتتميّز ببعث الله تعالى الأنبياء لإنقاذ الناس، حيث تقول الآية {فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين}.
فمع الإلتفات إلى تبشير الأنبياء وإنذارهم يتوجّه الإنسان إلى المبدأ والمعاد ويشعر أنّ وراءه جزاءً على أعماله فيحس أنّ مصيره مرتبط مباشرةً بتعاليم الأنبياء وما ورد في الكتب السّماويّة من الأحكام والقوانين الإلهيّة لحل التناقضات والنّزاعات المختلفة بين أفراد البشر، لذلك تقول الآية {وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه}.
المرحلة الخامسة : هي التمسّك بتعاليم الأنبياء وما ورد في كتبهم السماويّة لإطفاء نار الخلافات والنزاعات المتنوعة (الإختلافات الفكريّة والعقائديّة والإجتماعيّة والأخلاقيّة).
المرحلة السادسة : واستمر الوضع على هذا الحال حتّى نفذت فيهم الوساوس الشيطانيّة وتحرّكت في أنفسهم الأهواء النفسانيّة، فأخذت طائفة منهم بتفسير تعليمات الأنبياء والكتب السماويّة بشكل خاطيء وتطبيقها على مرادهم، وبذلك رفعوا علم الاختلاف مرّة ثانية. ولكن هذا الاختلاف يختلف عن الاختلاف السابق، لأنّ الأوّل كان ناشئاً عن الجهل وعدم الإطّلاع حيث زال وانتهى ببعث الأنبياء ونزول الكتب السماويّة، في حين أنّ منبع الإختلافات الثانية هو العناد والإنحراف عن الحقّ مع سبق الإصرار والعلم، وبكلمة : (البغي)، وبهذا تقول الآية بعد ذلك (وما اختلف فيه إلاّ الّذين أُوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم).
المرحلة السابعة : الآية الكريمة بعد ذلك تُقسّم الناس إلى قسمين، القسم الأوّل المؤمنون الّذين ينتهجون طريق الحقّ والهداية ويتغلّبون على كلّ الإختلافات بالاستنارة بالكتب السماويّة وتعليم الأنبياء، فتقول الآية : {فهدى الله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} في حين أنّ الفاسقين والمعاندين ماكثون في الضلالة والاختلاف.
وختام الآية تقول {والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} وهذه الفقرة إشارة إلى حقيقة ارتباط مشيئة الله تعالى بأعمال الأفراد، فجميع الأفراد الرّاغبون في الوصول إلى الحقيقة يهديهم الله تعالى إلى صراط مستقيم ويزيد في وعيهم وهدايتهم وتوفيقهم في الخلاص من الإختلافات والمشاجرات الدنيويّة مع الكفّار وأهل الدنيا ويرزقهم السكينة والإطمئنان، ويبيّن لهم طريق النجاة والإستقامة.
___________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1، ص512-514.
2ـ «اُمّة» بمعنى الجماعة التي ترتبط بنوع من الرابطة الموحدة لأفرادها سواء كانت وحدة دينية أو زمانية أو مكانية.
 الاكثر قراءة في سورة البقرة
الاكثر قراءة في سورة البقرة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












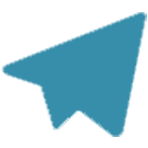
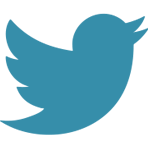

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)