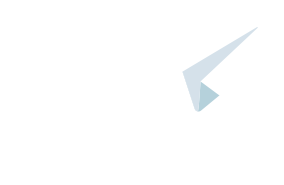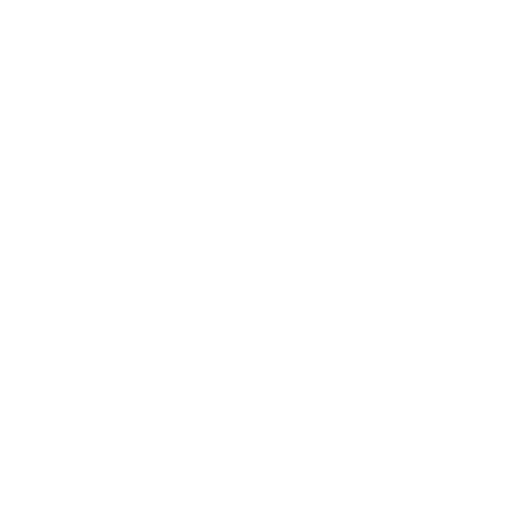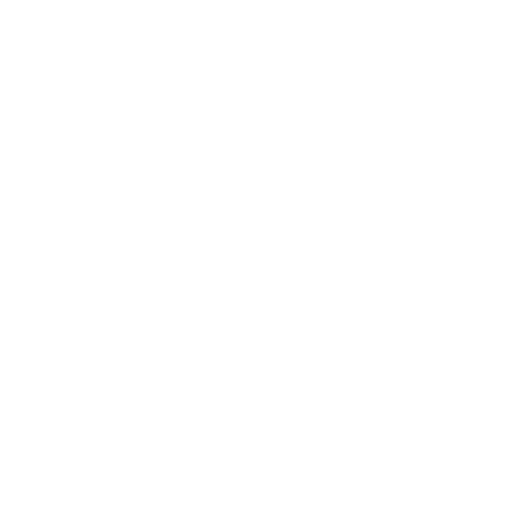المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
قاعدة « ضمان اليد »
المؤلف:
آية اللَّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
المصدر:
القواعد الفقهية
الجزء والصفحة:
ص87 - 167.
19-9-2016
3460
وهي أيضاً من القواعد الفقهيّة المشهورة المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ، وقبل الخوض في مباحثها لابدّ من التنبيه على أمر؛ وهو الفرق بين هذه القاعدة، وبين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية وشبهها ، فنقول:
أمّا الفرق من جهة الحكم فواضح؛ ضرورة أنّ المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعيّ ثابت- على تقديره- بضرر صاحب اليد وعقوبة له، فهو حكم ضرريّ عليه، والمبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكيّة لصاحب اليد، كالبيّنة التي تثبت الملكية، أو السوق التي هي أمارة عليها، وقد تكون نتيجتها شيئاً آخر بنفع ذي اليد، كما إذا كانت امرأة تحت يده واستيلائه؛ فإنّه يحكم بكونها زوجة له، وكما إذا كانت العين الموقوفة تحت يده؛ فإنّه يحكم بكونه متولّياً عليها مثلًا، فاختلاف القاعدتين من جهة الحكم واضح.
وأمّا من جهة الموضوع، فالموضوع هنا هي اليد التي تكون معلومة من جهة كونها يد غير المالك وغير المأذون من قبله أو من قبل الشارع، فيعلم بكونها يد الغاصب مثلًا، وأمّا الموضوع هناك فهي اليد المشكوكة التي لا يعلم كونها يد المالك، أو يد غيره وغير المأذون من قبله أو من قبل الشارع ... فالاختلاف بين القاعدتين من جهة الموضوع أيضاً ثابت.
إذا عرفت ذلك، فالكلام في القاعدة يقع من جهات:
الجهة الاولى: في مدرك القاعدة:
فنقول: مدركها هو الحديث النبويّ المعروف الذي رواه الفريقان واشتهر بين علماء الإسلام نقلًا واستناداً، بحيث صار الاشتهار موجباً للوثوق بصدوره إن لم يبلغ مرتبة القطع بالصّدور، وبالجملة: بلغ مرتبة لا مجال معها للمناقشة فيه من حيث السند أو الحكم بضعفه، وهو قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي، أو تؤدّيه، رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود السجستاني عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، عنه صلى الله عليه وآله.
هذا، وقد استشكل سيّدنا العلّامة الاستاذ الخميني- دام ظلّه العالي- في كتابه في البيع في انجبار سند الرّواية بعمل قدماء الأصحاب، قال ما ملخّصه: الظاهر من السيّد علم الهدى وشيخ الطائفة والسيّد ابن زهرة هو إيراده رواية واحتجاجاً على العامّة، لا استناداً إليه للحكم.
قال السيّد في الانتصار في مسألة ضمان الصنّاع: وممّا يمكن أن يعارضوا به- لأنّه موجود في رواياتهم وكتبهم- ما يروونه عن النبيّ صلى الله عليه وآله من قوله: على اليد ما جنت حتى تؤدّيه (1) .
وذكر الشيخ قدس سره في غصب الخلاف بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة: دليلنا أنّه ثبت أنّ هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه، فمن ادّعى أنّه زال ملكه بعد التغيير فعليه الدلالة، وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» (2) ، ولو كان استناده إلى قوله صلى الله عليه وآله لما كان وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه، فإيراد الرواية لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة (3) .
وأورد في اوّل غصب المبسوط عدّة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية (4) .
والظاهر من نقل خصوص رواياتهم هو الاحتجاج عليهم لا الاستناد إليها.
وفي غصب الغنية: «ويحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي (5) ، وهو ظاهر في عدم الاعتماد عليه، ولم يقع الاستدلال به في نكت النهاية للمحقّق، بل الظاهر عدم وجوده في المقنع والهداية والمراسم والوسيلة وجواهر الفقه، وقد استشكل الأردبيلي في سنده (6) .
نعم، إنّ ابن إدريس تمسّك به في السرائر في موارد (7) ، ونسبه جزماً إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله، مع عدم عمله بالخبر الواحد، ثمّ شاع الاستدلال به بين المتأخّرين عن زمن العلّامة (8) ، وكأنّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى عصرنا؛ ففي عصر السيّد والشيخ كان خبراً مرويّاً عنهم على سبيل الاحتجاج عليهم، ثمّ صار مورد التمسّك في العصر المتأخر، ثمّ صار من المشهورات في عصر آخر، ومن المشهورات المقبولات في هذه الاعصار، حتى يقال: لا ينبغي التكلّم في سنده (9) ، فالبناء على الاعتماد عليه مشكل.
ثمّ قال- دام ظلّه- ما ملخّصه أيضاً: وترك العمل به- مع جزم ابن إدريس بصدوره عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مع طريقته في العمل بالأخبار، وإن أمكن أن يكون ذلك باجتهاد منه، وقيام قرائن عنده ربّما لا تفيدنا علماً ولا عملًا، واختلاف عبارات الحديث بحيث ربما يكشف عن تكرّره وتظافره، واعتماد محقّقي أصحابنا من بعد ابن إدريس إلى عصرنا، مع تورّعهم والتفاتهم إلى ضعفه، ولابدّ من الجبر في مثله، وهو لا يمكن إلّا باعتماد قدماء الأصحاب عليه، ولعلّه شهادة منهم على اتّكال الأصحاب عليه- مشكل آخر.
ولعلّ من مجموع ذلك، ومن اشتهاره بين العامّة قديماً، ومن إتقان متنه وفصاحته ربّما يحصل الوثوق بصدوره، ولعلّ بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة.
ثمّ قال- دام ظلّه- بعد ذلك ما خلاصته أيضاً: في النفس تردّد؛ لأنّ ابن إدريس مع ما عرفت منه، تمسّك في كتاب الغصب من السرائر في المسألة بالأصل وعدم الدليل، ثمّ قال: ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله: «على اليد...» (10) وهذا يوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم لا التمسّك به، ولم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلّامة تمسّكه به لإثبات حكم، وإنّما نقل عن ابن جنيد وابن إدريس التمسّك به (11) ، وحدوث الاشتهار بعده لا يفيد شيئاً (12) .
ويمكن الإيراد عليه بظهور عبارة السيّد في الانتصار في أنّه في مقام الاحتجاج عليهم بما هو مقبول عنده وعندهم، لا بما هو مورد لقبولهم فقط، حتى يكون من باب الجدل، وأظهر منها عبارة الشيخ في الخلاف؛ حيث إنّه في مقام الاستدلال لما هو المختار عند الإماميّة، والجمع بين الاستدلال بالرواية والاستدلال بالأصل إنّما هو كالجمع في مقام الاستدلال في كثير من المسائل الخلافيّة بين الفريقين بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أنّه مع وجود الرواية في المسألة، واحتمال استناد المجمعين إليها، لا يبقى للإجماع أصالة، بل الدليل هي الرواية الموجودة فيها، ولعلّ الوجه فيه عدم كون مرتبة الأصل في مقابل الأمارة منقحة بالكيفيّة المقرّرة في هذه الأزمنة التي بلغت التحقيقات الأصولية فيها كمالها بحيث ربّما يوصف علم الاصول فيه بالتورّم ونحوه، خصوصاً بالإضافة إلى الأمارة الموافقة للأصل، كما في هذا المقام.
وبالجملة: حمل استدلال الشيخ في الخلاف في المسألة المذكورة على كونها في مقام الاحتجاج عليهم دون الاستناد والاستدلال، لا مجال لأن يصار إليه بوجه، وأظهر من الجميع عبارة الغنية؛ حيث تسند الرواية إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وقوله، من دون أن تسند إلى الرواية وأن تعبر بمثل روى، أو يروونه كما في كلام السيّد في الانتصار؛ فإنّ التعبير عنها بقوله صلى الله عليه وآله لا يكاد يجتمع مع عدم ثبوته وعدم حجيّة روايته، وقد ذكر سيّدنا العلّامة الاستاذ- دام ظلّه- في مباحثه الفقهية مكرّراً أنّ الإرسال إذا كان بنحو الإسناد إلى المعصوم دون الرواية لكان حجّة قابلًا للاعتماد، وعبارة الغنية من هذا القبيل.
ولعلّ جميع ما ذكر صار منشأً لجزم ابن إدريس، مع عدم قوله بحجّية خبر الواحد ولو بلغ في الوثاقة والعدالة المرتبة العليا (13) ؛ فإنّه من المستبعد غاية الاستبعاد أن يكون عنده قرائن خارجية لم تكن عند السابقين، مع تقدّم زمانهم وشدّة ارتباطهم بالأحاديث، واختلاطهم بفقهاء العامّة ومحدّثيهم وقرب عصرهم، وما ذكرنا- مضافاً إلى الشواهد المذكورة في كلامه دام ظلّه، وإلى الجواب عمّا أوجب التردّد له، بما ذكرنا عن عبارة الغنية- يوجب الوثوق الكامل بصدور الرّواية، بحيث لا يبقى مجال للمناقشة في اعتبارها وحجيّتها.
وأمّا عدم تعرّض جمع من كتب القدماء والمتوسطين له، فلعلّه لأجل أنّه لا يكون مفاد الرواية مخالفاً للقاعدة الثابتة عند العقلاء؛ لأنّ بناءهم أيضاً على ضمان يد الغاصب والرجوع إليه لأخذ العين أو المثل أو القيمة كما لا يخفى، ولأجل عدم المخالفة ربما لا يرى احتياج إلى إيرادها والتمسّك بها، خصوصاً مع وجود الروايات الخاصّة نوعاً في بعض مواردها، مثل صحيحة أبي ولّاد المعروفة الآتية إن شاء اللَّه تعالى، فتدبّر، فالإنصاف أنّ الرواية معتبرة قابلة للاستناد.
وأمّا مفادها ودلالتها التي هي عمدة البحث في الحديث، فنقول:
لا خفاء في أنّ مفاد الحديث لا يكون هو الإخبار بحيث تكون الجملة خبريّة حاكية، وإن لم يذكر في شيء من كتب الأحاديث المشتملة على هذه الرواية مورد وشأن نزول لهذا القول، بخلاف حديث «لا ضرر» (14) حيث كان مورده قصّة سمرة ابن جندب المعروفة في مورد النخلة التي كانت له، ولكنّه مع ذلك لا مجال لاحتمال الإخبار في المقام؛ لأنّه- مضافاً إلى أنّ نفس النقل والضبط في كتب الأحاديث قرينة على كون مفادها حكماً إلهيّاً وضعيّاً أو تكليفيّاً، وليس مفادها الإخبار كسائر إخبارات النبيّ صلى الله عليه وآله المتعارفة- لا وجه للحمل على الإخبار؛ لأنّه على هذا التقدير لابدّ وأن يقال بكونه إخباراً عن أمر كلّي؛ لظهور أنّ اللّام في «اليد» لا تكون إشارة إلى العهد الذكري أو الذهني، بل هو للجنس، ومفاده الطّبيعة.
وعليه: فيصير المعنى بناءً على الإخبار: أنّ ما وقع في اليد يبقى فيها حتّى تؤدّيه إلى صاحبه، وهذا المعنى- مضافاً إلى كونه توضيحاً للواضح؛ لوضوح ثبوت البقاء إلى أن يتحقّق الأداء- يكون مخالفاً للواقع في بعض الموارد؛ لأنّه ربما لا يكون السبب لزوال البقاء هو الأداء، بل الإيقاع في البحر أو إحراقه أو أمثال ذلك، فهذا الاحتمال في غاية السقوط، إذا عرفت ذلك فنقول:
لا خفاء في أنّ كلمة «على اليد» خبر مقدّم ومبتدأه الموصول في قوله: «ما أخذت»، ومعناه: أنّ المال المأخوذ يكون على اليد وعلى عهدتها، وبما أنّه ليس في الحديث فعل أو شبه فعل يكون قابلًا لأن يتعلّق به الظرف، فلابدّ من تقديره، والمقدّر إن كان من أفعال العموم؛ أي الأفعال التي تنطبق على كلّ فعل وحدث صدر عن الفاعل، كاستقرّ أو ثبت أو حصل، فالظرف ظرف مستقرّ، وإن كان من أفعال الخصوص، أي الأفعال الخاصّة التي لا ينطبق بعضها على بعض، للتقابل أو التخالف المتحقّق بينهما، فالظرف ظرف لغو.
إذا عرفت ذلك، يقع الكلام في أنّ الظرف في الحديث الشريف- بعد خلوّه عن الفعل وشبهه- هل يكون ظرفاً مستقرّاً متعلّقاً بمقدّر هو من أفعال العموم، أو ظرفاً لغواً متعلّقاً بمقدّر هو من أفعال الخصوص؟ لا خفاء في أ نّ تقدير فعل من أفعال الخصوص مع فرض خصوصيته وعدم انطباقه على غيره لأجل التقابل أو التخالف، لا يكاد يصار إليه إلّا مع ضرورة مقتضية لتقديره، ومع فرض عدم الضرورة واستقامة الكلام بدونه لا مجال لتقديره، وهذا بخلاف تقدير فعل من أفعال العموم؛ فإنّ تقديره مع فرض انطباقه على جميع الأفعال والأحداث ولزوم تعلّق الظرف به، لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، فعند دوران الأمر بين التقديرين يكون الترجيح للتقدير الثاني، أي: تقدير فعل من أفعال العموم لما عرفت.
وحينئذ نقول في المقام: إنّ جعل الظرف متعلّقاً بمثل «استقرّ» مع كون المبتدأ نفس المال الذي أخذته اليد في كمال الاستقامة والملاءَمة؛ لأنّ معناه أنّ المال المأخوذ ثابت ومستقرّ على اليد حتى تتحقّق الغاية، وهي أداء المال المأخوذ وردّه إلى صاحبه.
وبالجملة: لا يرى فرق بين المقام، وبين ما إذا قيل: زيد على السّطح، فكما أنّه لا مجال لدعوى الإجمال فيه بلحاظ احتمال كون المتعلّق هو «كائن» أو «مستقرّ» أو أشباههما من أفعال العموم، واحتمال كون المتعلّق هو «قائم» أو «ضارب» أو أشباههما من أفعال الخصوص؛ لتحقّق ملاك الحمل في القضية الحملية، وهو الاتّحاد والهوهوية في كلا الأمرين؛ لاتحاد زيد مع الكائن على السطح، كاتّحاده مع القائم عليه أو الضارب عليه.
والوجه في بطلان دعوى الإجمال الرجوع إلى العرف والعقلاء في محاوراتهم؛ فإنّهم لا يرون للقول المزبور إجمالًا أصلًا، ولا يعاملون معه معاملة المجمل؛ نظراً إلى الاحتمالين، كذلك لا مجال لدعوى الإجمال في المقام؛ لعدم الفرق بينه وبين القول المزبور إلّا فيما لا يكون فارقاً بوجه، كما ستأتي الإشارة إليه.
وكما أنّه لا مجال للتشكيك في كون المتعلّق في القول المزبور هو الفعل الّذي هو من أفعال العموم؛ لأنّه المتفاهم عند العرف، فإنّ تقدير مثل القيام والضرب يحتاج إلى مؤونة زائدة، وليس كذلك تقدير شيء من أفعال العموم، كذلك لا ينبغي التشكيك في المقام في أنّ المتعلّق المحذوف أيضاً شيء من أفعال العموم؛ لعدم الفرق بين المقامين إلّافي كون القول المزبور جملة خبرية حاكية، والمقام بصدد إفادة الحكم وفي مقام الإنشاء، ومرجعه إلى كون الاستعلاء الذي هو مفاد كلمة «على» في القول المزبور استعلاءً خارجيّاً مشاهداً، وفي المقام استعلاءً اعتباريّاً مقبولًا عند العقلاء أيضاً؛ فإنّهم يعبّرون في باب الدين بأنّ لزيد على عمرو كذا وكذا، ومرجعه إلى أنّ الدّين ثقل على العهدة ومستعل عليه كاستعلاء زيد على السّطح، على ما في المثال.
نعم، الفرق بين المقام، وبين مثال الدين، إنّما هو في كون الثابت على الذمّة والمستقرّ على العهدة في باب الدّين هو الأمر الكلّي، وفي المقام يكون الثابت والمستقرّ هو نفس المال المأخوذ الذي هو عين من الأعيان الخارجية لا محالة، بلحاظ تعلّق الأخذ بها، وهذا لا يكون موجباً للإفتراق من جهة ما هو المقصود في المقام، من إثبات حكم وضعيّ بمقتضى حديث «على اليد» ... كان، لا ينبغي الإشكال في أنّ الظرف في المقام ظرف مستقرّ، والمحذوف هو فعل من أفعال العموم.
وأمّا جعل الظرف لغواً متعلّقاً بمقدّر من أفعال الخصوص، مثل: «يجب»، فيدفعه- مضافاً إلى ما عرفت من أنّ تقدير فعل من أفعال الخصوص خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلّا مع انحصار الطريق به، وهذا بخلاف تقدير فعل من أفعال العموم، ومضافاً إلى أنّه لا معنى لتقدير مثل «يجب» في المقام؛ بعد أنّه لا معنى لتعلّق الحكم التكليفي بذات المال المأخوذ، بل لابدّ من تعلّقه بفعل من أفعال المكلّفين متعلّق بالمال المأخوذ- أنّ فاعل «يجب» في المقام هل هو ردّ المال المأخوذ إلى صاحبه، أو حفظه من الضياع والتلف حتّى يتحقّق الردّ والأداء؟
فعلى الأوّل: يصير معنى الرواية ومفاد الحديث أنّه يجب أداء مال الغير المأخوذ منه، وهذا الوجوب يستمرّ إلى أن يتحقّق الأداء، وهذا ركيك في الغاية؛ لأنّه مثل قوله: تجب الصلاة حتّى يصلّي.
وعلى الثاني: يصير معنى الرواية أنّه يجب حفظ مال الغير المأخوذ منه حتّى يتحقّق الردّ والأداء، وهذا المعنى- الذي استظهره صاحب العوائد (15) - وإن كان خالياً عن الركاكة، إلّاأنّ الظاهر كونه مخالفاً لما تكون الرواية في مقام بيانه وإفادته؛ لأنّ المتفاهم العرفي من الحديث كونه في مقام بيان أمر أشدّ وأصعب من مجرّد وجوب الحفظ، وبعبارة اخرى: وجوب حفظ مال الغير- بعد كون المفروض أنّ الأخذ منه وقع بالقهر والقوّة وبدون إذنه ورضاه- كأنّه لا يحتاج إلى البيان بمثل هذا التعبير، ضرورة أنّ الأخذ الكذائي لا يستلزم جواز المعاملة معه معاملة مال نفسه، فالعبارة إنّما هي في مقام بيان أمر كأنّه عقوبة على الآخذ قهراً، وهو اشتغال الذمّة وكون المال على عهدته، وضمانه له بنحو الحكم الوضعي، خصوصاً مع ملاحظة وقوع مثل هذه العبارة في مقام افادة اشتغال الذمة، فيقال: لزيد على عهدتي كذا وكذا.
وهذه الاستفادة ليست لأجل مجرّد استعمال كلمة «على» التي هي موضوعة للنسبة الاستعلائية بين الشيء وبين مدخول هذه الكلمة- ضرورة أنّ استعمالها في الأحكام التكليفيّة في غاية الكثرة، فيقال: يجب على زيد الصلاة والصيام والحج وأشباهها. وقد ورد في آية الحج قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97] فأفادت الآية الإلزام بذكر كلمة «على» خاليةً عن ذكر الوجوب ونحوه- بل لأجل كون المبتدأ هو المال المأخوذ، فملاحظة المبتدأ تقتضي استظهار كون المراد هو الثبوت الوضعي، وكون المال ثابتاً ومستقراً على العهدة حتّى يتحقّق أداؤه، وهذا أمر اعتباري لا يكون مورداً لإنكار العقلاء أيضاً.
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الظرف في الحديث ظرف مستقرّ، ومرجعه إلى استقرار وثبوت نفس المال المأخوذ على عهدة ذي اليد حتى تؤدّيه، وهذا مع أنّه لا يحتاج إلى إضمار ما هو خلاف الأصل- كما عرفت- معنى في غاية اللطافة والاستقامة والملاءَمة، ولا محيص من حمل الرواية عليه.
ثمّ إنّه من الواضح أنّه ليس المراد من اليد هي الجارحة المخصوصة؛ لأنّه ربما لا يكون للغاصب تلك الجارحة المخصوصة، كما أنّ الشيء المأخوذ ربما لا يكون قابلًا لأن يؤخذ باليد كالدار مثلًا، فاللازم أن يقال بأنّ المراد منه هو الاستيلاء والتسلّط على شيء؛ سواء كان في عالم الخارج والتكوين، أو في عالم الاعتبار.
واستعمال اليد بهذا المعنى شائع في المحاورات العرفية، بل في الكتاب والسنّة، فيقال: الأمر بيدي أفعل ما أشاء، كناية عن ثبوت القدرة والاستيلاء على ذلك، وفي الكتاب حكى اللَّه- تعالى- عن اليهود قولهم : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64] والنكتة في العدول عن تعبير اليهود باليد بنحو المفرد بقوله: بَلْ يَدَاهُ بصورة التثنية هي الإشارة إلى أنّه كما أنّ مجموع القدرة في مثل الإنسان متحقّق في مجموع اليدين؛ لأنّ اليد الواحدة لها بعض الاقتدار وسهم من القدرة، كذلك قدرة اللَّه- تبارك وتعالى- على الإنفاق إنّما هي بنحو الكمال لا في خصوص مرتبة منه، فالمراد ثبوت الاستيلاء الكامل والقدرة المطلقة له- تعالى- على الإنفاق، غاية الأمر أنّ ثبوته وتحقّق الإنفاق توسعة وتضييقاً إنّما يرتبط بمشيئة اللَّه وإرادته حسب المصالح التي يراها.
فانقدح أنّ المراد باليد في الحديث الشريف هو الاستيلاء، وهل المراد منه نفس الاستيلاء الذي هو معنى الإسم المصدري، أو أنّ المراد به هو المستولى المتصف بصفة الاستيلاء؟ الظاهر والمتفاهم عرفاً من تعبير الحديث هو الثاني؛ من جهة الحكم بثبوت المال المأخوذ واستقراره عليه، ومن الواضح أنّ الحكم الشرعي إنّما يكون ثابتاً على المكلّف، من دون فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. نعم، بعض الأحكام الوضعية يكون موضوعه الأعيان الخارجية، كالنجاسة الثابتة للدّم، والطهارة الثابتة للماء، ولكنّ المقام لا يشبه ذلك.
ومن جهة إسناد الأخذ إلى نفس ما يكون المال على عهدته، ومن الواضح أنّ الآخذ هو المستولي، ولا معنى لأخذ الاستيلاء، وحتّى لو كان المراد باليد هي الجارحة المخصوصة لكان الآخذ حقيقة هو الإنسان، واليد آلة للأخذ ووسيلة له، وإسناد الأخذ اليها لعلّه لا يكون بنحو الحقيقة.
هذا كلّه لو كانت اليد كنايةً عن الاستيلاء والسّلطة، وكان الاستعمال استعمالًا كنائيّاً ، مثل استعمال كثير الرّماد وإرادة الجود والسّخاء والكرامة.
ويمكن أن يكون المراد من اليد في الحديث هو «ذا اليد»، نظير استعمال العين في الربيئة الذي يكون استعمالًا استعاريّاً مرجعه إلى أنّ الربيئة بلحاظ وصفه كأنّه يكون بجميع أعضائه وجوارحه عيناً باصرة ناظرة، وقد حققنا في الاصول (16) أنّ المجازات بأجمعها- من دون فرق بين الاستعارة وغيرها- لا يكون الاستعمال فيها استعمالًا للّفظ في غير ما وضع له، خلافاً لما هو المشهور بين أهل الأدب؛ لعدم تحقّق اللّطافة والظّرافة في استبدال لفظ مكان لفظ، من دون التصرف في دائرة المعنى، وثبوت نحو ادّعاء في البين، فالمجازات بأجمعها شبيه ما يقول السكّاكي في باب الاستعارة من أنّ إطلاق لفظ الأسد وإرادة الرجل الشجاع لا يرجع إلى استبدال لفظ الرجل الشجاع بلفظ الأسد، فإنّ قيام لفظ مكان آخر- مع قطع النظر عن المعنى- يكون خالياً عن الحسن، ففي قول الشاعر:
قامت تظلّلني ومن عجب شمس تظلّلني من الشمس (17) .
يكون التعجّب من أن تكون الشمس بمعناها مظلّلة من الشمس، وإلّا فالشمس التي يراد منها من أراده الشاعر من محبوبه ومعشوقه، لا عجب في كونها مظلّلة، فتحقّق التعجّب لا محالة لا يكاد أن يحصل بدون التصرّف في المعنى، من جعل المشبّه فرداً ادّعائياً لماهية المشبّه به وحقيقته، أو أمراً شبيه ذلك، كما حقّقنا في محلّه من ثبوت الفرق بين ما نقول به، وبين ما ذهب إليه السكّاكي وإن كان الفرق غير مهمّ .
وبالجملة: كما أنّ استعمال العين في الربيئة يكون استعمالًا استعاريّاً، والمراد بها هو الشخص الكذائي، يمكن أن يكون استعمال اليد في المقام بهذا النحو، بأن يكون المراد بها هو ذا اليد، بادّعاء كونه بأجمعه يداً.
وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى تقدير ذي اليد؛ لكون المراد منها هو ذا اليد، بخلاف الاستعمال الكنائي على ما عرفت.
وبالجملة: فمعنى الحديث الشريف: أنّ المال الذي استولى عليه إنسان يكون على عهدة المستولي وثابتاً ومستقرّاً عليه، وهذا يستمرّ إلى أن يتحقّق أداؤه ولا يرتفع إلّا به، وهذه عبارة اخرى عن ضمان المستولي للمال؛ إذ ليس معنى الضمان عرفاً إلّا استقرار الشيء وثبوته في عهدة الضامن في عالم الاعتبار الشرعي أو العقلائي.
إن قلت: ظاهر الحديث- على ما ذكرت- أنّ المال الذي يتعلّق به الأخذ هو الثابت على عهدة ذي اليد، ففي الحقيقة تعلّق بالمال الخارجي على ما هو المفروض أمران: الأوّل: الأخذ، والثاني: الثبوت في العهدة والاستقرار في الذمّة، مع أنّ الموجود الخارجي الذي تعلّق الأخذ به لا يمكن أن يكون في الذمّة والعهدة؛ لانّ الموجود الخارجي وعاء وجوده عالم الخارج لا عالم الاعتبار؛ إذ ليس عالم الاعتبار إلّا عبارة عن الموجودات الاعتبارية التي لا وجود لها إلّافي عالم الاعتبار، فلا يمكن أن يكون الموجود الخارجي موجوداً في عالم الاعتبار، وإلّا يلزم انقلاب الخارج اعتباراً؛ وذلك كما أنّ الموجود الخارجي لا يمكن أن يكون موجوداً في الذهن، وإلّا يلزم انقلاب الخارج ذهناً وهو محال.
قلت: لابدّ أوّلًا في مقام الجواب من التعرّض لبيان ماهية الضّمان وحقيقته.
فنقول: الأقوال في تعريف الضمان وبيان معناه ثلاثة:
الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (18) في قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» من أنّ الضمان عبارة عن كون درك الشيء وخسارته عليه، فإذا تلف يقع نقصان في ماله الأصلي للزوم تداركه منه.
ويستفاد من كلامه قدس سره بلحاظ عنوان الدرك والخسارة، وبلحاظ تفريع التلف: أنّ الضمان أمر تعليقي مرجعه إلى اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة عند تحقّق التلف، وعليه، فلا يتعلّق الضمان بالعين بصورة التنجيز قبل عروض التلف، وما دامت العين باقية موجودة، وسيأتي أنّه غير تامّ.
الثاني: ما حكاه الشيخ قدس سره وزيّفه، من أنّ الضمان عبارة عن أن يتلف المال مملوكاً له، ومرجعه إلى أنّه في مثل الغصب تعتبر ملكية الغاصب قبل التلف قهراً عليه وعلى المالك، وملكية المالك للمثل أو القيمة، ثمّ يتحقّق تلف العين المغصوبة في ملك الغاصب.
وضعّفه الشيخ قدس سره بأنّ لازمه أن يكون كلّ مالك ضامناً لمال نفسه؛ لأنّه يصدق تلف المال مملوكاً له، بل هو في هذه الجهة أولى من الغاصب، مع أنّه لا يقال للمالك:
أنّه ضامن لمال نفسه.
ويرد على هذا القول أيضاً: أنّ تحقّق المعاوضة القهرية على الطرفين من دون أن تكون تجارة عن تراض في البين، لا يكاد يصار إليه إلّا مع وجود دليل قويّ؛ لأنّه مخالف للقواعد الأوّلية والضوابط الثابتة في باب المعاملات وأدلّة الضمان، مثل حديث «على اليد» التي لا دلالة لها على ذلك، إلّا على فرض عدم تصوّر معنى للضمان غير ذلك، مع أنّه ممنوع جدّاً كما سيأتي.
الثالث: ما أشار إليه الأعاظم والمحقّقون، مثل المحقّق الخراساني قدس سره في حاشية المكاسب (19) من أنّه اعتبار، أي اعتبار عقلائي وشرعي. ومثل تلميذه الكبير المحقّق الإصفهاني في حاشية المكاسب (20) .
وقد أوضحه تلميذه الكبير الآخر سيّدنا الاستاذ العلّامة البروجردي (21) على ما في تقريرات مباحثه فيما يتعلّق بكتاب الغصب، وتوضيحه وتقريبه: أنّ بحث الضمان يغاير بحث اشتغال الذمّة، فالضمان أمر والاشتغال أمر آخر، والدليل عليه:
أنّ المديون ذمّته مشغولة للدائن، مع أنّه لا يقال: إنّه ضامن له، فالمقترض مع اشتغال ذمّته للمقرض لا يكون ضامناً له، والسرّ فيه: أنّ اشتغال الذمّة لابدّ وأن يكون بأمر كلّي وهو المثل أو القيمة، فالذمة تكون بمنزلة الذهن الذي توجد فيها الماهية، فالماهية الكلّية تتشخّص بوجودها في الذهن، فالموجود فيه أمر كلّي، وهكذا الذمّة؛ فإنّ اشتغالها إنّما هو بأمر كلّي.
وأمّا العهدة، فهي متعلّقة بالموجود في الخارج مع وصف وجوده في الخارج، فالعين المأخوذة في الحديث قد تعلّقت بنفسها العهدة، ويعبّرون عن العهدة والضمان في الفارسيّة بـ «عهده دارى»، كما في الكفالة التي هي التّعهد بالإضافة إلى إنسان خاصّ وشخص معيّن، ويترتّب على هذا الضمان الذي هو حكم وضعي اعتباري حكمان تكليفيان: أحدهما: وجوب ردّ العين ما دامت باقية، ثانيهما : وجوب ردّ بدلها- مثلًا أو قيمة- بعد تلفها وانعدامها، ومجموع هذين الحكمين لا يكون في غير مورد الضمان.
وعليه: فلا مجال للتفكيك بينهما وجعل وجوب ردّ العين مع بقائها في مورد غير الضمان أيضاً كالأمانة- حيث يجب على الأمين ردّها إلى صاحبها- دليلًا على عدم ثبوت الضمان مع بقاء العين، كما يظهر من سيّدنا العلّامة الاستاذ الإمام الخميني- دام ظلّه العالي- في كتابه في البيع (22) .
فإنّ اللازم- كما عرفت- ملاحظة مجموع الحكمين، ألا ترى أنّ جواز التصرّف في مورد الإباحة لا يكون دليلًا على عدم ثبوت الملكية التي يترتّب عليها جواز التصرّف أيضاً؛ فانّ امتياز الملكية إنّما هو بمجموع الآثار التي لا يوجد في غيرها، فإنّ منها الانتقال إلى الوارث بعد الموت، وتعلّق مثل الخمس ببعض مواردها، وشبههما ممّا لا يوجد في غيرها حتّى الإباحة المطلقة التي يجوز معها التصرف مطلقاً حتّى التصرفات النّاقلة.
وبالجملة: فما يترتّب على الضمان مجموع الحكمين الذي لا يكون في غير مورد الضمان أصلًا.
وعليه: فالاتّحاد والهوهوية المعتبرة في القضية الحملية في قوله: «ما أخذت اليد عليها» إنّما هو باعتبار كون الموجود الخارجي نفس ما تعلّق به هذا الأمر الاعتباري الّذي هو الضمان، فلم يتحقّق اتّحاد الأمر الخارجي مع الأمر الاعتباري، بل الاتحاد بين الأمر الخارجي وبين كونه متعلّقاً للأمر الاعتباري، فالمقام نظير قوله: «هذه الدار مستأجرة»؛ فإنّه لا خفاء في تحقّق ملاك الحمل فيها مع كون الاستئجار أمراً اعتبارياً؛ لأنّ الاتّحاد إنّما هو بين الدار، وبين كونها متعلّقة للاستئجار المتعلّق بالدار الخارجية، كما هو واضح.
ثمّ إنّه ذكر سيّدنا الاستاذ (23) قدس سره أنّه قد يتعلّق الضمان بالكلّي الذي له موطن آخر غير ذمّة الضّامن، وأثره حينئذ جواز مطالبة المضمون له من الضامن بذلك الكلّي إن لم يقدر على استيفائه وأخذه من المضمون عنه «المديون»، وليس أثره عند العقلاء والعرف مجرّد اشتغال ذمّة الضامن للمضمون، ولكن استقرّ مذهب الإماميّة في كتاب «الضمان» على أنّ المراد به هناك هو انتقال الذمّة وتحقّق الاشتغال للضّامن في ظرف خاصّ (24) ، ومنشؤه دلالة الأدلّة الخاصّة والروايات المعتبرة عليه (25) ، وعليه: فما هو مذهبنا في باب الضمان مخالف لما هو مقتضاه بنظر العقلاء.
أمّا فقهاء العامّة، فحيث لا يرون اعتباراً للروايات التي اشير إليها، فلا محالة ذهبوا إلى أنّ المراد بالضمان في كتاب الضمان هو ما عليه العقلاء، فقالوا: إنّه عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة اخرى (26) ، ولا يكون مرادهم بذلك ثبوت المال في ذمّة شخصين؛ كما إذا كان له دين على رجلين؛ ضرورة عدم استحقاق الدائن أكثر من مال واحد ودين فارد، فلا يمكن ثبوته في ظرفين، وإنّما مرادهم من الذمّة التي أُضيف إليها الضمّ، هو العهدة التي هي معنى الضمان حقيقة، ومرجعه إلى ضمّ العهدة إلى اشتغال الذمّة وعدم تحقّق البراءة للمديون بمجرّد تحقّق الضمان، ففي الحقيقة يكون في البين اشتغال وعهدة قد تعلّق الأوّل بالكلّي؛ لأنّ الثابت في الذمّة لا يكون إلّا كلّياً، والثاني بما اشتغلت به ذمة المديون مع وصف اشتغال الذمّة به؛ لأنّه يصير حينئذ متشخّصاً، لأنّ الاشتغال وإن كان بأمر كلّي، لكن الكلّي المشتغل به ذمّة المديون لا يكون كليّاً، فهو نظير الماهية الموجودة في الذهن؛ فإنّ الماهية وإن كانت كليّة إلّا أنّها بوصف وجودها في الذهن لا تكون إلّا جزئية.
ثم إنّ الظاهر عدم تحقّق الضمان بالمعنى الذي ذكرناه في العقد الصّحيح، خلافاً للشيخ الأعظم قدس سره؛ فإنّه حين فسّر الضمان بالنحو الذي عرفت ذكر أنّ العقد الصحيح فيه الضمان، غاية الأمر أنّ الضمان الثابت فيه هو الضمان بالمسمّى، ومرجعه إلى أنّه على تقدير تلف المبيع في يد المشتري الضامن يكون دركه وخسارته عليه، غاية الأمر ثبوت الخسارة بمقدار الثمن؛ سواء كان مساوياً للقيمة الواقعية أو مخالفاً لها (27) .
وخلافاً للمحقّق الإصفهاني قدس سره؛ فإنّه مع تفسيره الضمان بالنحو الذي ذكرناه، أفاد أنّه قد يكون بتسبيب من الشخص، كما في مطلق المعاوضات، لتعهد كلّ منهما والتزامه بأخذ المال ببدله، ولذا عبّر عنه بضمان المعاوضة، فليس مجرّد كونه ذا عوض أو مملوكاً بعوض مناط الضمان، بل تعهّد أخذه ببدله هو المناسب للضمان (28) .
هذا، ولكنّ الظاهر عدم إطلاقه بنحو الحقيقة في المعاوضات الصحيحة، وإطلاقه عليها في قاعدة «ما يضمن» لا دلالة له على ذلك؛ لعدم كون القاعدة بالعبارة المعروفة ممّا دلّ عليه آية أو رواية أو إجماع، ولذا اعترض أكثر محشّى المكاسب (29) على الشيخ الأعظم قدس سره بلحاظ جعل البحث في مفردات القاعدة مهمّاً ، نظراً إلى ما ذكرنا، وعدم كون الإطلاق فيها- على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا- حقيقيّاً؛ لأنّه يحتمل أن يكون من باب المشاكلة، كما في آية الاعتداء : {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194] ، وقد صرّح بذلك المحقّق الخراساني قدس سره في تعليقة المكاسب (30) .
هذا ، مضافاً إلى أنّ لازم ذلك التفصيل في أموال المالك من جهة إطلاق الضمان، فإن كان منتقلًا إليه بالإرث ونحوه لا يقال: إنّه ضامن له، وإن كان منتقلًا إليه بالبيع ونحوه من المعاوضات يقال : هو ضامن له، مع أنّ التفصيل بهذا النحو خلاف ما عليه العقلاء، كما لا يخفى.
ثم إنّه ذكر سيّدنا العلّامة الاستاذ الخميني- دام ظلّه العالي- في تحقيق معنى الضمان كلاماً ملخّصه: أنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء، هو عهدة الغرامة والخسارة، ففي المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف، وأنّ ضمان العين - بمعنى أنّ نفس العين على عهدة الضامن في المثليات والقيميات - خلاف المتعارف والمعهود عندهم ، وفي مثله لابدّ من ورود دليل صريح مخالف لبنائهم وديدنهم.
وأمّا مثل ما ورد في باب الضمانات- كضمان اليد والإتلاف- كحديث اليد وغيره، فلا ينقدح في ذهن العرف والعقلاء منه ما يخالف بناءهم في الضمانات، فلا يفهم من «على اليد ما أخذت» أنّ نفس المأخوذ حال التلف في العهدة، فضلًا عن سائر الروايات، وفي قوله عليه السلام: «فعليه ما أصابت- الدابّة- بيدها ورجلها» (31) إذا بني على وقوع ما أصابت الدابّة على العهدة، يكون ذلك أمراً مستنكراً عند العرف، فحمل تلك الروايات على كثرتها على الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء حمل قريب جدّاً، موافق لفهم العرف والعقلاء.
قال: بل الظاهر من حديث اليد غير ما أفاده المحقّقون، ممّا لازمه التعرّض لأداء التالف حتّى يلتزم بأنّ أداء المثل والقيمة أداء للشيء بنحو، كما أشرنا إليه.
والتحقيق: أنّ الغاية المذكورة فيه غاية للضمان، والعهدة في زمان وجود العين؛ فإنّ قوله صلى الله عليه وآله: «على اليد ما أخذت» يراد منه أنّ الآخذ ضامن للمأخوذ؛ بمعنى أنّه لو تلف تكون خسارته عليه، وغاية هذا الأمر التعليقي- أي عهدة الخسارة على فرض التلف- هو أداء نفس العين ليس إلّا (32) .
أقول: يرد عليه- مضافاً إلى ما عرفت من الفرق بين الثبوت على العهدة الذي هو معنى الضمان، وبين اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة، وإلى أنّ الظّاهر أنّه لا فرق عند العقلاء والعرف فيما يرجع إلى معنى الضمان بين صورة وجود العين، وصورة تلفها وانعدامها بحيث يكون معنى الضمان في صورة البقاء ثبوت نفس العين على العهدة، وفي صورة التلف ثبوت المثل أو القيمة على العهدة بحيث يكون ثبوت نفس العين في هذه الصورة مخالفاً لنظر العرف- أنّ ظاهر قوله: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» (33) فرض الضمان في صورة التلف مع إضافته إلى المتلف- بالفتح - ولا معنى له إلّا كون العين بوجودها الاعتباري بعد التلف ثابتة على عهدة المتلف- بالكسر-.
فالتعبير بالضمان في قاعدة الإتلاف يرشدنا إلى عدم كون ضمان العين محدوداً ببقائها وعدم تلفها، بل هو ثابت بعد التلف أيضاً، ولا يجتمع ذلك إلّا مع اعتبار بقاء العين وثبوتها على العهدة بعد التلف أيضاً، وجعل الأداء في حديث «على اليد» غاية للضمان في زمان وجود العين فقط، يوجب حمل الحديث على التعرّض لبعض ما يتعلّق بضمان العين المأخوذة، وهو خلاف الظاهر جدّاً، كما لا يخفى.
وخلاصة ما يرد على سيّدنا الاستاذ- دام ظلّه العالي أنّ الضمان بالمعنى الذي أفاده- وهو عهدة الخسارة- هل هو أمر تعليقي وهو عهدة الخسارة لو تلف، بحيث تكون التعليقية دخلية في ماهيّته وحقيقته، حتى لو فرض تحقّق المعلّق عليه لا تبقى ماهية الضمان، كالواجب المشروط مثل الحجّ، فإنّ اتصافه بكونه واجباً مشروطاً إنّما هو فيما إذا لم يتحقّق شرطه؛ وهو الاستطاعة في المثال، فإذا تحقّق الشرط يصير واجباً مطلقاً فعليّاً، وفي المقام لابدّ أن يقال بالضمان مادام لم يتحقّق التلف، فإذا تحقّق وصارت العهدة منجّزة يخرج عن الضمان.
وعليه: فاللازم أن يقال بأنّه لا مجال للحكم بالضمان في صورة التلف، مع أنّ قاعدة الإتلاف صريحة في إثبات الحكم بالضمان بعد تحقّق التلف بسبب الإتلاف؛ فإنّ الإتلاف في رتبة السبب، والضمان في رتبة المسبّب ومتفرّع عليه، مضافاً إلى ما عرفت من أنّه لا فرق عند العقلاء والعرف بين صورة وجود العين وصورة تلفها في الحكم بالضمان، بل في كون الضمان بعد التلف نفس الضمان قبله وبمعناه، من دون تغيّر في معناه أصلًا.
وإن كان مراده من الضمان نفس عهدة الخسارة من دون التعليق على التّلف، وعليه فهو ثابت بعد التلف أيضاً، فنقول: لابدّ على هذا الاحتمال من حمل الضمان في قاعدة الإتلاف المفروضة بعد التلف على كون المراد به مجرّد عهدة الخسارة، مع أنّه من الواضح أنّ عهدة الخسارة حينئذ لا تكون معنى مغايراً لاشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة؛ لعدم الفرق بين الأمرين إلّافي مجرّد التعبير واللفظ؛ إذ لا معنى لعهدة الخسارة غير الاشتغال المزبور.
وعليه: فاللازم إطلاق الضمان في موارد اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة، كما في القرض ونحوه، مع أنّك عرفت مغايرة الضمان للاشتغال عند العقلاء؛ فإنّ ما على الذمة إنّما هو أمر كلّي، والضمان متعلّق بالأمر الجزئي، ولا يطلق أحد العنوانين على الآخر، فلا يقال للمديون: إنّه ضامن، ولا يقال للضامن: إنّه مديون ومشغول الذمّة ولو بعد تحقّق التلف، كما في مورد قاعدة الإتلاف ومجريها، إذن فلا محيص عن أن يقال في مفاد حديث «على اليد» بعد فرض دلالته على الضمان، بكون العين المأخوذة متعلّقة للعهدة في كلتا الحالتين: حالة الوجود وحالة التلف.
غاية الأمر أنّه بعد التلف يعتبر بقاء العين عند العقلاء وكونها متعلّقة للعهدة، ولا مانع من كون الموضوع للأمر الاعتباري- وهو الضمان- أمراً اعتباريّاً آخر، كالأحكام التكليفيّة الثابتة في موارد الأحكام الوضعية، مع اشتراكهما في الاعتبار والجعليّة.
ومنه يظهر أنّ أداء العين المجعول غاية للضمان- في الحديث- مطلقاً، إنّما يتحقّق بأدائها بنفسها مع بقائها، وبالمثل أو القيمة مع التلف، فإنّه بعد فرض ثبوتها على العهدة، وتعلّق الضمان بنفسها بعد التلف أيضاً، لا يفرض له أداء إلّا أداء مثلها أو قيمتها كما هو كذلك عند العقلاء، فإنّه مع عدم إمكان أدائها بجميع جهاتها من المزايا الشخصية والنوعية والمالية، ينتقل إلى المراتب النازلة مرتبة بعد مرتبة، إلى أن يتحقّق أداؤها بخصوص المرتبة المالية التي هي العمدة في أغراض العقلاء في باب الأموال.
ومما ذكرنا ظهر الجواب عن النراقي- في عوائده (34) - حيث استظهر أنّ الغاية هي أداء نفس العين، وهو لا يتحقّق إلّا بحمل الحديث على وجوب الحفظ دون الضمان، فتدبّر.
إذا ظهر ذلك يظهر أنّ تفسير الحديث بالمعنى الذي عرفت؛ وهو إفادة الضمان والثبوت على العهدة لا يتوقّف على تقدير كلمة «الضمان» كما تخيّله النراقي قدس سره في عوائده؛ حيث جعل الضمان في رديف الحفظ أو الردّ على تقدير كون المقدّر هو الوجوب الذي هو من أفعال الخصوص، فاستشكل في ترجيحه؛ حيث قال ما ملخّصه: إنّ الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف إنّما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لردّ العين مع البقاء، والمثل أو القيمة مع التلف، ولا دليل على تعيينه أصلًا.
واستدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفاً بعد سلف وفهمهم ذلك، لا يدلّ على أنّه كان لهم قرينة على تقديره وإن خفيت علينا؛ لأنّه- مضافاً إلى أنّه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا أكثرهم وإن علم من كثير منهم- لا يدلّ على أنّه لقرينة تقدير الضمان، بل لعلّه لاجتهادهم تقدير جميع المحتملات عند عدم تعيّن المقدّر، أو لمظنّة شيوع تقديره، أو لدليل اجتهادي آخر. ونمنع كون المتبادر من هذا التركيب إثبات الضمان، كما يظهر بالرجوع إلى أمثال هذا التركيب التي ليس الذهن فيها مسبوقاً بالشبهة، مع أنّه على فرض التسليم لا يفيد؛ لأصالة تأخّر حدوث التبادر بعد عدم كون ذلك من مقتضى الوضع اللغوي لهذا التركيب (35) .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ حمل الحديث على الضمان وتفسيره به لا يحتاج إلى تقدير الضمان؛ لأنّ معنى الضمان هو نفس الثبوت على العهدة والاستقرار في الذمّة، الذي هو وجود وثبوت في عالم الاعتبار ووعائه، وهذا بخلاف ما لو كان المتعلّق للظرف هو «يجب» الذي هو من أفعال الخصوص؛ فإنّه حينئذ يلزم تقدير الردّ أو الحفظ؛ لعدم إمكان تعلّق الوجوب بالأعيان الخارجيّة.
كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر بطلان ما أفاده في ذيل كلامه أيضاً، من أنّ أداء المثل أو القيمة ليس أداء ما أخذت، بل أداء شيء آخر، وإطلاق الأداء على أداء غير ما أخذت غير صحيح، فلا يكون «حتّى تؤدّي» غاية للضمان في صورة التّلف.
والوجه فيه ما ذكرنا من أنّه كما أنّ ثبوت المال على العهدة يكون في وعاء الاعتبار الذي يتفق فيه العقلاء والشارع، كذلك غاية هذا الأمر الاعتباري هو الأداء الذي له مراتب، فإن كانت العين موجودة غير تالفة، فالأداء لا يتحقّق إلّا بأدائها نفسها، وإن صارت تالفة فأداؤها بأداء مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيميّة.
وبالجملة: أداء المثل مرتبة من أداء ما على العهدة؛ وهي العين الخارجية.
غاية الأمر أنّه لا ينتقل إلى هذه المرتبة إلّا بعد تعذّر أداء العين بنفسها، كما أنّ أداء القيمة أيضاً مرتبة من أداء العين ينتقل إليها بعد تعذّر أدائها بنفسها وبخصوصياتها النوعية، فدعوى خروج المرتبتين الأخيرتين عن دائرة أداء العين ممنوعة جدّاً، وعليه: تكون كلمة «حتّى تؤدّي» شاملة لجميع المراتب.
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من كون مفاد الحديث هو مجرّد الحكم الوضعي- وهو الضمان الذي يستمرّ إلى أن يتحقّق الأداء- أنّه لا دلالة لهذا الحديث على لزوم حفظ المال المأخوذ، كما أنّه لا دلالة له على لزوم ردّه ووجوبه بعنوان الحكم التكليفي؛ لأنّ هذا الوجوب وإن كان ثابتاً إلّاأنّ الدليل عليه كونه أثراً للضمان كما عرفت، وجعل الأداء غاية للضمان لا دلالة له على وجوبه بعنوان الحكم التكليفي ابتداءً، بل غايته ارتفاع الضمان بسببه، فيرتفع الحكم التكليفي المترتّب عليه لا محالة.
الجهة الثانية: في محدودة الحكم بالضمان المستفاد من القاعدة:
والبحث في هذه الجهة تارة : من جهة أنّ اليد المحكوم عليها بالضمان- بعد وضوح عدم شمولها ليد المالك؛ لأنّه لا معنى لكونه ضامناً لمال نفسه- هل هي مطلق اليد ولو كانت مأذونة من قبل المالك، كيد الوكيل مثلًا، أو المستأجر في باب الإجارة، أو من قبل الشارع كما في اللقطة مثلًا، غاية الأمر خروج هذه الموارد عن القاعدة بالتخصيص، أو تختصّ بما إذا لم تكن مأذونة لا من قبل المالك، ولا من طرف الشارع؟
واخرى: من جهة شمول الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة بل غير المستوفاة أيضاً، وعدمه واختصاصه بالأعيان.
وثالثة: من جهة شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه.
ورابعة: من جهة الشمول للأوقات وعدمه.
وخامسة: من جهة المراد من الأداء المجعول غاية، فنقول:
أمّا من الجهة الاولى: فالظاهر الاختصاص، وذلك لانّ كلمة «اليد» وإن كان المراد بها مطلق الاستيلاء، إلّا أنّ تقييد المضمون ووصفه بالأخذ، يخرج اليد المأذونة؛ لظهور كلمة «الأخذ» في الأخذ بالقوّة وبالقهر؛ أي: الأخذ من دون رضا، وقد مرّت الإشارة إلى الفرق بين كلمة «الأخذ» وبين كلمة «القبض»؛ فإنّ الظاهر كون الثانية أعمّ من الاولى، والشاهد ملاحظة موارد الاستعمالات العرفية؛ كعدم تعاهد استعمال كلمة «الأخذ» في قبض المبيع من البائع مثلًا حتى في المقبوض بالعقد الفاسد، فاستعمال هذه الكلمة يشعر بل يدلّ على انحصار الحكم بالضمان بما إذا صدق الأخذ؛ وهو ما إذا لم يشتمل على رضا المالك أو إذن الشارع.
ولو اغمض النظر عمّا ذكرنا، وقلنا بإطلاق كلمة «الأخذ» وشمولها للأخذ بالرّضا أيضاً، فلا شبهة في انصراف الحديث عن مثل هذا الأخذ؛ لأنّه لا يفهم منه الحكم بضمان مثل الوكيل والمستأجر والملتقط أيضاً، وليس الانصراف بدويّاً حتى لا يكون معتبراً، وعليه فخروج الأمين الذي لا يكون ضامناً إلّا مع التعدّي أو التفريط، لا يكون بنحو التخصيص حتى يستشكل فيه بإباء القاعدة عن التخصيص، مع أنّه في هذا الاستشكال أيضاً نظر، كما عرفت سابقاً في قاعدة عدم ضمان الأمين، فراجع .
نعم، يبقى في المقام أنّه على فرض التخصيص أو التخصّص، هل يكون الباقي تحت الحديث؟ والمقدار الذي تدلّ القاعدة على الضمان فيه، هل هو خصوص اليد العادية؛ أي اليد التي حكم عليها بالحرمة لأجل العدوان، وهي اليد الموجودة في باب الغصب؛ لأنّه عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً، وعليه: فتنطبق القاعدة على الغصب، ولا مجال للاستناد بها في غير كتاب الغصب.
أو أنّ الباقي تحت القاعدة مطلق اليد غير المأذونة من قبل المالك والشارع؟
فتدلّ على الضمان في غير مورد الغصب أيضاً، كما في المقبوض بالبيع الفاسد، سيّما مع جهل الطرفين بفساد البيع؛ فإنّ اليد فيه لا تكون عادية بوجه، ومع ذلك لا تكون مأذونة من قبل المالك أو الشارع، ودفع البائع للمبيع مع رضاه وطيب النفس لا دلالة فيه على إذن المالك؛ لأنّ الدفع إنّما هو بعنوان كون المشتري مالكاً له، لا بعنوان أنّ البائع مالك، وهو يأذن للمشتري في التصرّف، كما لا يخفى.
وكما فيما إذا اعتقد أنّ مال الغير مال نفسه اشتباهاً؛ فإنّ اليد عليه لا تكون يداً عادية ولا مأذونة أصلًا.
والتحقيق: أنّه إن قلنا في الحديث بالتخصّص الناشئ من الانصراف، فهو تابع لدعوى الانصراف، وأنّ مدّعيه هل يقول بالانصراف إلى خصوص اليد العادية، أو إلى الأعمّ منها، ومن اليد غير العادية وغير المأذونة؟
وأمّا إن قلنا بالتخصيص، فاللازم إقامة الدليل عليه في مقابل عموم القاعدة أو إطلاقها، وقد ورد الدليل في موارد ثبوت الإذن من المالك، كما في الموارد المتقدّمة، أو من الشارع كما في الموارد التي اشير إليها، وقد ورد في مورد الأمين روايات تدلّ على عدم ضمانه مع عدم التعدّي أو التفريط .
وأمّا في مورد المقبوض بالبيع الفاسد ومثله، وفي المورد الآخر الذي ذكرنا، فلم يرد دليل على التخصيص والتقييد، واللازم الرجوع إلى أصالة العموم أو الإطلاق.
ولو فرض أن يكون المخصّص واحداً عنواناً بحسب الواقع، ودار أمره بين الأقلّ والأكثر، وأنّه هل هو عنوان اليد غير العادية، أو عنوان اليد المأذونة؟
فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن والرجوع في الزائد إلى الأصل المذكور، كما إذا تردّد أمر الفاسق الخارج عن عموم وجوب إكرام العلماء، بين أن يكون خصوص مرتكب الكبيرة، أو أعمّ منه ومن مرتكب الصغيرة، والفرق بكون عنوان الخارج معلوماً في المثال- غاية الأمر الشكّ في معناه وثبوت الشبهة في مفهومه، بخلاف المقام؛ حيث لا يعلم الخارج بعنوانه كما ذكرنا- لا يكون فارقاً في الحكم وفي لزوم الرجوع في الزائد المشكوك إلى أصالة العموم أو الإطلاق، فانقدح أنّه لو بلغت النوبة إلى التخصيص، لا دليل على أزيد من خروج اليد المأذونة، ويبقى الباقي تحت القاعدة، وعليه: فيجوز التمسّك بها في باب المقبوض بالبيع الفاسد أيضاً، كما فعله الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في المكاسب (36) .
وأمّا من الجهة الثانية: فنقول: أمّا المنافع المستوفاة، فالظاهر أنّه لا إشكال في ضمانها، لا لشمول قاعدة حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وأنّ مال المسلم لا يحلّ إلّا بطيب نفسه؛ لأنّ البحث إنّما هو في ضمانها بملاحظة قاعدة ضمان اليد، لا بملاحظة مطلق القواعد، مع أنّه في دلالة مثل قوله عليه السلام: لا يحلّ مال امري مسلم... (37) على الضمان تأمّل وإشكال، بل لأجل أنّها أيضاً مال مأخوذ، أمّا كونها مالًا، فلأنّه يبذل بإزائها المال في باب الإجارة، وقد شاع تفسير الإجارة بأنّها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، فالعوض يقع في مقابل نفس المنفعة.
وأمّا اتّصافها بكونها مالًا مأخوذاً، فلأجل تحقّق الاستيلاء عليها، غاية الأمر أنّ وقوعها تحت اليد إنّما هو بتبع وقوع العين تحتها. ولذا يقولون بأنّ قبض المنفعة في باب الإجارة بناءً على التفسير المزبور- وإن كان على خلاف التحقيق- إنّما هو بقبض العين، فهي أيضاً مأخوذة ومقبوضة، غاية الأمر بتبع أخذ العين وقبضها، فالقاعدة تشمل المنافع المستوفاة.
وممّا ذكرنا تظهر دلالة القاعدة على ضمان المنافع غير المستوفاة أيضاً؛ لأنّ الاستيفاء لا دخل له في صدق الأخذ؛ فإنّ الأخذ تعلّق بالمنافع بتبع تعلّقه بالعين؛ سواء استوفاها كما إذا سكن في الدار المأخوذة، أم لم يستوفها كما إذا لم يستفد من الدار المأخوذة شيئاً.
نعم، ذكر المحقّق الإصفهاني قدس سره في حاشية المكاسب إشكالًا في شمول القاعدة للمنافع، وهو: أنّه لا تصدق التأدية في المنافع مطلقاً، وظاهر قوله عليه السلام: «حتّى تؤدّي» كون عهدة المأخوذ مغيّاةً بأداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرّجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حدّ ذاتها، لا كالعين التي لها أداء في حدّ ذاتها وإن عرضها الامتناع ابتداءً أو بقاءً، وفرض اتحاد الموجود التدريجي مع المنفعة- فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد، والأداء بأداء طرفه الآخر- لا يكاد يفيد شيئاً؛ لأنّ المراد ضمان الفائت أو المستوفى، فأداء ما لم يفت ولم يستوف غير مجد في ارتفاع ضمان المأخوذ باستيفائه، أو بالاستيلاء عليه مع فواته (38).
ويمكن الجواب عنه بأنّه تصدق التأدية في المنافع مطلقاً، أمّا ابتداءً فكما أنّ أخذها إنّما هو بتبع أخذ العين، كذلك أداؤها إنّما هو بأداء العين، ولذا يصدق في باب الإجارة أنّ المالك أقبض المنفعة بإقباض العين، فإقباضها إنّما هو بالتبع.
وأمّا استدامة فلابدّ من تنزيله منزلة تلف العين، فكما أنّ الأداء في صورة التلف إنّما يتحقّق باداء المثل أو القيمة، فكذلك أداء المنافع إنّما يتحقّق بأداء عوضها، ولا دلالة في الحديث على اختصاص الحكم بما إذا أمكن تحقّق الغاية، وهو الأداء بقاءً بالإضافة إلى نفس المال المأخوذ، حتّى يقال بخروج المنافع عن ذلك؛ لعدم إمكان صدق الغاية بالإضافة إلى نفسها بقاءً، بل يكفي إمكان تحقّق الغاية كذلك ولو ابتداءً.
مضافاً إلى أنّ بعض الأعيان أيضاً لا تجرى فيه الغاية بقاءً، كالعين التي تتلف تدريجاً، كالثلج في الصيف؛ فإنّه لا يمكن أداؤها بقاءً بعد فرض كونها في حال الذوب والانعدام، ودعوى خروج مثلها عن القاعدة ممنوعة جدّاً كما لا يخفى، فالإنصاف أنّه لا مجال لإخراج المنافع مطلقاً عن مورد القاعدة.
وربما يستدلّ لضمان هذه المنافع- أي المنافع غير المستوفاة- بقاعدة التفويت التي هي قاعدة عقلائية، وهي: أنّ من فوّت مال الغير عليه فهو له ضامن، بناءً على اعتبارها في الشرع أيضاً، ولكن حيث إنّ الكلام ليس في الحكم بضمان هذه المنافع مطلقاً، بل من جهة اقتضاء قاعدة ضمان اليد له وعدمه، فلا مجال للبحث في غيرها، مع أنّ شمول قاعدة التفويت لجميع أقسام المنافع غير المستوفاة محلّ نظر، بل منع.
ثمّ إنّه لو كانت للعين منافع متضادّة غير قابلة للاجتماع في زمان واحد، كما إذا كان العبد المغصوب عارفاً بالكتابة والخياطة معاً، فهل يضمن المستولى له الجميع، أو يضمن الأكثر مالية، أو أحدها بنحو التخيير، والتخيير للمالك أو الضامن؟ فيه وجوه واحتمالات: لا يبعد أن يقال بالتفصيل بين ما لو كان المدرك للحكم بالضمان هي قاعدة اليد التي يبحث عنها في المقام، وبين ما لو كان المدرك له مثل قاعدة التفويت.
فعلى الأوّل: يحكم بضمان جميع المنافع ولو كانت متضادّة، لأنّ الملاك هو تحقّق الاستيلاء وصدقه، وقد عرفت أنّ الاستيلاء على المنافع إنّما هو بتبع الاستيلاء على العين، فإذا كانت للعين منافع يصدق الاستيلاء على الجميع، والتضادّ بين بعضها الراجع إلى عدم إمكان الاجتماع في الوجود وفي مقام الاستيفاء، لا يرتبط بمقام الاستيلاء الذي هو الملاك للضمان. وبعبارة اخرى: التضاد راجع إلى مقام الاستيفاء، وهو غير دخيل في الضمان أصلًا، مع أنّ ترجيح بعض المنافع على بعض ترجيح من غير مرجّح.
وعلى الثاني: يحكم بضمان خصوص المنفعة التي هي أكثر مالية من غيرها؛ لعدم صدق التفويت بالإضافة إلى الجميع، بعد فرض التضادّ وعدم إمكان الاجتماع؛ لأنّ فوت الجميع حينئذ يستند إلى التضادّ، غاية الأمر أنّه حيث كانت المنفعة التي هي أكثر مالية ممكنة التحقّق والحصول، فيصدق تحقّق التفويت بالنسبة إليها ويقال بأنّ الاستيلاء صار سبباً لفوتها، ولولاه لكان للمالك استيفاؤها، كما لا يخفى.
وأمّا من الجهة الثالثة: وهي شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه.
فنقول: ربما يناقش في الشمول؛ نظراً إلى أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد، كما أنّه ربما يجاب عنه بأنّ اليد عبارة عن التصرّف على وجه الاستيلاء والقهر، وهو أمر عرفي موجود في غصب الحرّ أيضاً؛ إذ العرف لا يفرّق من حيث اليد بين كون المغصوب عبداً أو حرّاً، ولكن منع الشمول المحقّق الرشتي قدس سره (39) في كتابه في الغصب، وملخّص كلامه الطويل في وجه المنع امور ثلاثة :
الأوّل: أنّ اليد الموجبة للضمان هي اليد الكاشفة عن الملكية، وإذا كان الشيء غير واجد لصفة المملوكية، امتنع تعلّق اليد به على الوجه المزبور كما في الحرّ، لأنّه لا يكون قابلًا لصفة المملوكية؛ لكونه مالكاً والمالك لا يكون مملوكاً؛ لتحقّق التضاد بينهما، وعليه: فلا يدخل تحت اليد المبحوث عنها، ومن هنا حكم العلّامة (40) بأنّ لباس الصغير الحرّ المغصوب غير مضمون كنفسه.
ووجهه: أنّ الصغير وإن كان مقهوراً في يد الغاصب، مع كونه ممّن لا يقدر على نفسه نفعاً ولا ضرراً، إلّا أنّ صفة الاختصاص الملكي المأخوذ في معنى اليد عرفاً، لمّا لم تكن موجودة فيه، لم يصدق على ذلك القهر اليد، وإذا لم تتحقّق اليد على الصغير نفسه، فلا تتحقّق أيضاً بالنسبة إلى لباسه الذي هو لابسه؛ لأنّه باعتبار استقلاله الذاتي ومالكيّته يكون صاحب اليد على لباسه.
أقول: يرد على هذا الأمر- بعد وضوح بطلان ظاهر صدر كلامه، من أنّ اليد الموجبة للضمان هي اليد الكاشفة عن الملكية، ضرورة أنّ اليد الموجبة للضمان هي اليد التي احرز كونها عادية أو غير مأذونة على الاحتمالين المتقدّمين، واليد الكاشفة عن الملكيّة هي اليد المشكوكة المقرونة باحتمال ثبوت الملكيّة، واحتمال عدمها، فكيف يعقل اتّحادهما؟ أنّه لابدّ من توجيه كلامه، ويجري في هذا المجال احتمالان:
أحدهما: أن يكون مراده قدس سره أنّه وإن كانت اليد في القاعدتين:- قاعدة ضمان اليد، وقاعدة أمارية اليد- مختلفة لا محالة، إلّا أنّ الاختلاف إنّما هو بالإضافة إلى صفة اليد وقيدها، فاليد في قاعدة الضمان موصوفة بوصف العادية أو غير المأذونة، وفي قاعدة الأمارية موصوفة بوصف المشكوكية ، إلّا أنّ الظاهر وحدة المراد من نفس اليد التي هي الذات الموصوفة في القاعدتين، فإذا كان المراد من اليد في قاعدة الأمارية ظاهرة في اليد على الشيء، القابل لصفة المملوكية؛ ضرورة أنّه لا تكون أمارة على الملكية، فاليد على الخمر والخنزير لا تكون أمارة على ملكيّتهما، كذلك اليد في قاعدة الضمان المبحوث عنها في المقام؛ لظهور وحدة المراد في اليد التي هي الموضوع في القاعدتين، وعليه: فلا تشتمل القاعدة الحرّ؛ لعدم شمول قاعدة الأماريّة له.
ثانيهما: ما يشعر به ذيل كلامه، بل يظهر منه من أنّ الاختصاص الملكي الذي يعتبر في القاعدة مأخوذ في معنى اليد عرفاً، بحيث لا تصدق اليد بدونه كذلك.
والجواب عن الاحتمال الأوّل: أنّه لا دليل على اتّحاد القاعدتين في المراد من اليد المأخوذة فيهما؛ فإنّ اليد في قاعدة الأمارية باعتبار كونها مجعولة أمارة على الملكية، فمقتضى تناسب الحكم والموضوع أن يكون المراد بها هي اليد على ما يكون قابلًا لتعلّق وصف الملكيّة به وثبوت المملوكيّة له؛ لأنّه لا معنى لكون اليد على غير الملك كالحرّ ونحوه كاشفة عن الملكية وأمارة لها.
وأمّا في قاعدة الضمان المستفادة من حديث «على اليد» فالحكم المجعول فيها هو الضّمان، ولا دليل على اختصاص موضوعه بخصوص اليد على المملوك، بعد عموم الموصول وشموله لمثل الحرّ، وعدم منافاة الحكم بالضمان له أصلًا، فلا مجال لرفع اليد عن العموم.
هذا، مضافاً إلى ما عرفت في أوّل البحث عن القاعدة، من عدم اختصاص قاعدة أمارية اليد بما إذا كان هناك شك في الملكية وكون ذي اليد مالكاً، بل تجري في مثل ما إذا كانت امرأة تحت رجل وهو مستولٍ عليها ويعامل معها معاملة الزوجة، ولكن نشكّ في أنّها هل تكون زوجة له شرعاً أم لا؟ فإنّ مقتضى قاعدة الأمارية كون اليد بالنحو المذكور كاشفة عن ثبوت الزوجية، وكون المستولي زوجاً لها، فلا اختصاص لليد في القاعدة بما إذا كانت متعلّقة بالملك.
والجواب عن الاحتمال الثاني: وضوح عدم دخالة المملوكية في صدق اليد والاستيلاء بحسب نظر العرف والعقلاء، فنرى في زماننا شيوع الاختطاف بالإضافة إلى الأفراد، ويقال له بالفارسية «آدم ربائي»، فهل يمكن منع تحقّق الاستيلاء في مثله عند العقلاء؟ أو هل تكون اليد في قاعدة ضمان اليد لها معنى غير معناها العرفي، مع لزوم الرجوع إلى العرف في تشخيص معاني الألفاظ المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية في الأدلّة من الكتاب والسنّة؟ فالإنصاف أنّ المنع في المقام واضح المنع.
الأمر الثاني: من الامور التي اعتمد عليها المحقّق الرّشتي قدس سره (41) ما أفاده ممّا ملخّصه: أنّه على تقدير تسليم صدق اليد في الحرّ يكون قوله عليه السلام: «حتّى تؤدّي» قرينة على تخصيص الموصول؛ لعدم صدق الأداء على دفع دية الحرّ؛ لأنّ دفع القيمة أو المثل في الماليّات دفع للعين المغصوبة عرفاً؛ لقيام العوض فيها مقام المعوّض في جلّ الفوائد لو لم يكن في كلّها، بخلاف الدية؛ فإنّها ليست عوضاً عن النفس لا حقيقة ولا حكماً، وإنّما هي حكم شرعي شبه الجريمة.
هذا إذا قلنا بأنّ دفع القيمة أو المثل في الماليّات مستفاد من نفس الغاية. وأمّا لو قلنا بأنّه حكم شرعيّ، أو عرفي بعد تعذّر الفائتة؛ وهو الأداء، فقد يقال بدلالته على ضمان الحرّ الصغير ووجوب دفع ديته.
ودعوى عدم شمول لفظ الضمان لوجوب دفع الدية؛ لعدم كونها عوضاً، يدفعها عدم كون لفظ الضمان مذكوراً في الرواية، بل هو مستفاد من كلمة «على»، ولا فرق في طريق الاستفادة بينه وبين الماليّات، مع أنّ اختصاص الضمان بالماليّات أوّل الكلام، ولذا يقال: إنّ الطبيب ضامن، وبالجملة: لو سلّم كون الضمان ظاهراً في الماليّات فلا نسلّم أنّ العهدة ترادفه في ذلك.
ولكن يرد على أصل القول أنّ دفع البدل إذا كان حكماً شرعياً مستفاداً من غير الأمر بالأداء، يحتاج ثبوته إلى دليل شرعيّ، وهو مفقود في المقام غير ما رواه وهب بن وهب أبو البختري، عن الصادق عليه السلام: من استعار عبداً لقوم آخرين، فهو له ضامن، ومن استعار حرّاً، صغيراً ضمن (42) . وهذا مع ضعف سنده؛ لكون وهب من أكذب البريّة وعامّياً، غير معمول به، بل غير ظاهر المراد؛ لمنافاته للإجماع على عدم ثبوت الضمان في العارية (43) .
والجواب عن هذا الأمر: أنّه- بعد تسليم صدق اليد والاستيلاء على الحرّ، وصدق الضمان بالإضافة إلى الإنسان أيضاً كالأمور الماليّة، ويدلّ عليه ضمان الطبيب المفروض في الروايات (44) ، وفي الفقه في أواخر كتاب الإجارة (45) ، وكذا تدلّ عليه رواية وهب وإن لم تكن معتبرة بالإضافة إلى الحكم المذكور فيها، وهو ثبوت الضمان في الفقرتين، لكن أصل التعبير بالضمان فيها مع كون الراوي عارفاً بلغة العرب، يدلّ على صحّة هذا الاستعمال- لابدّ وأن يكون هناك رافع للضمان وموجب لخروج الضامن عن العهدة.
ودعوى مغايرة العهدة للضمان كما في كلامه، مدفوعة بعدم المغايرة، بناءً على ما ذكرنا في معنى الضمان، والرافع للضمان على ما يستفاد من حديث «على اليد» ليس إلّا الأداء، فكما أنّ أداء المثل أو القيمة رافع لضمان العين وإن لم يكونا أداءً للعين، كذلك أداء الدية في ضمان الإنسان.
وبالجملة: الذي تدلّ عليه رواية وهب هو نفس ثبوت الضمان. وأمّا أنّه بماذا يتحقّق الأداء، فلا دلالة لها عليه، ولا حاجة إلى الدلالة أصلًا؛ فإنّه في كلّ مورد يتحقّق الضمان لا يكون الرافع إلّا الأداء الحقيقي أو الحكمي، واشتمال حديث «على اليد» على الغاية وتعرّضه لها، لا يدلّ على خروج بعض موارد الضمان، كما لا يخفى.
فالإنصاف أنّه على تقدير تسليم صدق الاستيلاء واليد في الحرّ لا يكون التعرّض لغائيّة الأداء موجباً لقصر الحكم بالضمان على غير الحرّ.
الأمر الثالث من الامور المذكورة: أنّ المتبادر من الموصول هو المال بنفسه أو بقرينة قوله: «تؤدّي»؛ لأنّ الأداء إذا نسب إلى الأفعال كالصلاة تمّ معناه بدون المفعول بواسطة الجارّ، وأمّا إذا اضيف إلى الأعيان والامور التي ليست بأموال، فيحتاج إلى المفعول الثاني بواسطة «إلى»، ومن الواضح أنّ المؤدّى إليه في المغصوب هو الذي يكون مالكاً للمؤدّى أو مستحقّاً له، وشيء من الأمرين لا يتصوّر في مثل الحرّ؛ إذ ليس له مالك ولا مستحقّ حتّى يؤدّي إليه، فلا يتصوّر القول بأنّه يجب ردّ الحرّ المغصوب- خصوصاً إذا كان كبيراً- إلى مالكه أو مستحقّه؛ إذ لا مستحقّ له شرعاً، وإن كان له وارث؛ إذ الوارث وارث لمورّثه لا مستحق له.
ويرد عليه: أنّه مع فرض موت الحرّ في يد الآخذ لا مجال للإشكال المذكور؛ لأنّه يصير كتلف المال المغصوب، حيث إنّه يجب أداء قيمته إلى من يستحقّها؛ وهو الوارث في المقام، فالدّية يؤدّيها إلى الوارث كأداء القيمة إلى المالك في المقيس عليه.
كما أنّه لو فرض كون الحرّ اجيراً للغير بمنفعته الخاصّة، أو بجميع منافعه- بحيث كان الغير مالكاً لمنفعته أو منافعه بسبب الإجارة- لا مجال للإشكال في عدم تحقّق المؤدّى إليه في هذه الصورة، فإنّها تصير كالدار المستأجرة المغصوبة من المستأجر، حيث إنّه يجب ردّها إلى المستأجر المالك لمنفعتها؛ إنّما الإشكال في خصوص صورة الحياة وعدم كونه أجيراً للغير بالنحو المذكور، وفي هذه الصورة إذا كان الحرّ صغيراً غير مستقلّ في الإرادة والتعيّش يكون المتفاهم العرفي من الأداء بالإضافة إليه هو أداؤه إلى وليّه، ومن يكون متبوعاً له في الإرادة والتعيّش، ولا مجال للزوم كون المؤدّى إليه مالكاً أو مستحقّاً، بل اللازم ثبوت المؤدّى إليه، وإن كان بالنحو الذي ذكرنا.
وأمّا إذا كان الحرّ كبيراً، فمضافاً إلى أنّه لا مجال للتفصيل في الحرّ المأخوذ بين الصّور التي ذكرناها، وبين هذه الصورة، وهو يكفي في الحكم بالضمان هنا؛ لعدم الفصل، نقول: لا مانع من كون المراد من الأداء هو الإرجاع إلى ما كان عليه من المحلّ والشرائط الخاصّة، ولا ملازمة بين افتقار الأداء في الحديث إلى المؤدّى إليه، وبين كون المؤدّى إليه هو الشخص، فضلًا عن أن يكون مالكاً أو مستحقّاً، فتدبّر.
وبالجملة: لا نرى في مقابل إطلاق الحديث الشامل للحرّ ما يوجب تقييده بغيره وإخراجه منه، فهو بمقتضى الحديث مضمون، ويترتّب على الاستيلاء عليه، الضمان الذي لازمه وجوب أداء ديته إلى الوارث في صورة التلف، وأداء نفسه في صورة العدم.
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا شمول الرواية لمثل الخمر والخنزير- مع عدم ثبوت المالية والملكية بالنسبة إليهما- إذا قلنا بثبوت حقّ الاختصاص والأولوية شرعاً فيهما، فيصير مثل العين المرهونة المتعلّقة لحقّ المرتهن، هذا كلّه بالنسبة إلى عين الحرّ.
وأمّا منافعها، فإن استوفاها الآخذ، فلا إشكال في ضمانها عليه، وإن لم يستوفها فكذلك، بناءً على ما اخترناه من شمول الحديث لأخذ الحرّ؛ لأنّ المنافع حينئذ تكون مأخوذة بتبع العين، ولازمه الضمان فيها، والاستيفاء لا دخالة له في الحكم بالضمان، كما ذكرنا في مثل منافع العبد والدار ونحوهما من الماليّات، وقد عرفت أنّه في المنافع المتضادّة غير القابلة للاجتماع في الوجود- كالكتابة والخياطة- يكون الضمان متعلقاً بالجميع، وعدم مساعدة العرف على ذلك لا يمنع عن اقتضاء الدليل وشموله لجميع المنافع، كما لا يخفى.
وأمّا من الجهة الرابعة: وهي شمول الموصول للأوقاف وعدمه، فنقول: لا ينبغي الإشكال في الشمول بالنسبة إلى الوقف الخاصّ، من دون فرق بين أن نقول ببقاء العين الموقوفة بعد الوقف على ملك مالكها، غاية الأمر صيرورتها متعلّقة لحقّ الموقوف عليهم، وبين أن نقول بدخولها في ملك الموقوف عليهم وخروجها عن ملك الواقف، وبين أن نقول بما اختاره سيّدنا المحقّق الاستاذ البروجردي (46) - قدّس سرّه الشريف- من خروجها عن ملك الواقف وصيرورتها على رؤوس الموقوف عليهم، بحيث قدّر منافعها عليهم من دون دخول أصلها في ملكهم، ويؤيّده تعدّي الوقف ب «على» فيقال: وقف عليه، فكأنّ المال الموقوف «سحاب» جعله المالك على رؤوس الموقوف عليهم، حتى يمطر عليهم.
وكيف كان، فلا فرق في شمول الموصول بين الأقوال المختلفة في باب حقيقة الوقف، فإنّه لا أقلّ من كونها متعلّقة لحقّ الموقوف عليهم، وهو يكفي في الشمول.
هذا في الوقف الخاصّ.
وأمّا الأوقاف العامّة، كالمساجد والمشاعر والرباط والمدارس والطرق، فقد ذكر المحقّق الرّشتي- بعد أن حكى عن الدروس قوله: لو ثبت يده على مثل المساجد والمشاعر والرباط والمدارس ضمن العين والمنفعة (47) ، وقال: لم نظفر بمتعرّض لحكمها غيره- في تحقيق المسألة كلاماً ملخّصه (48) : أنّها- أي الأوقاف العامّة- على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما لم تتطرّق إليه أيدي الملّاك منذ خلق، ولا يكون له اختصاص بآدميّ بوجه من وجوه الاختصاص الملكي، بل طرأ الحبس الشرعي على إباحته الأصلية، كأرض عرفات ومكّة والمشاعر، والظاهر أنّ حكمه حكم الحرّ في عدم كون اليد عليه موجبة للضمان.
الثاني: ما تطرّقت إليه يد التملّك ثم عرض المخرج عن الملكية، وهذا أيضاً على قسمين: قسم ترجع منافعه إلى بعض الانتفاعات الدنيوية، كالسكنى والركوب والتطرّق ونحوها، وقسم ترجع منافعه إلى الانتفاعات الاخرويّة ، كالصلاة والذكر وأمثالهما من العبادات في مثل المساجد. ثمّ ذكر ثبوت الضمان في القسم الأوّل بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً، بل نفى الإشكال عن الضمان فيه بالنسبة إليهما، ولم يتعرّض للقسم الثاني أصلًا، بل طوّل البحث في أنّ المنفعة المضمونة في القسم الأوّل هل ترجع إلى الموقوف عليهم، أو تصرف على نفس العين؟
أقول: أمّا كون حكم القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة هو حكم الحرّ، فلا ينبغي الإشكال فيه، غاية الأمر أنّه حيث إنّ المختار شمول الحديث له، فاللازم شموله له أيضاً، واقتضاؤه الضمان بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً.
كما أنّ ثبوت الضمان في القسم الثاني مطلقاً ممّا لا إشكال فيه أصلًا، والظاهر فيه رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم؛ لأنّهم هم المستحقون لها، فتردّ عليهم.
وأمّا القسم الثالث: الذي لم يتعرّض له من جهة ثبوت الضمان وعدمه، فالظاهر أنّه إن كان المأخوذ مثل فرش المسجد وحصيره وسائر ما يتعلّق به، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في ضمان العين والمنفعة معاً؛ لأنّه مال مأخوذ وله مالك وهو المسجد، بناءً على صحة اعتبار الملكية له، كما هو الظاهر، فلا يرتفع الضمان إلّا بالأداء إليه عيناً أو مثلًا أو قيمة.
وإن كان المأخوذ نفس المسجد، فالظاهر شمول الحديث له أيضاً، كما قلنا في الحرّ، فيترتب عليه ضمان العين، فإذا انهدم بمثل السيل يجب على الضامن تعميره وتجديد بنائه. نعم، لا مجال للحكم بضمان المنافع بعد كون المنفعة من الامور الاخرويّة مثل الصلاة والذكر، وهل الحكم كذلك فيما إذا اتخذ المسجد المستولى عليه مسكناً ومحلًا لسكناه وسكنى أهله مثلًا، فلا يضمن ما يقابله من المالية، أو يضمن؟ الظاهر هو الأوّل، فتدبّر.
وأمّا من الجهة الخامسة: وهي المراد من الأداء المأخوذ غاية للضمان ورافعاً له، وأنّه في الماليّات عبارة عن الأداء إلى من؟
فنقول: لا شبهة في تحقّقه وصدقه فيما إذا أدّى العين المأخوذة من المالك إليه، فيما إذا لم تكن العين متعلّقة لحق الغير بالإجارة أو الرهن أو غيرهما؛ بأن كانت منافعها غير خارجة عن ملكه، ولم يتعلّق بها مثل حق الرّهانة، ويكفي في هذه الصورة الأداء إلى وكيل المالك إذا كانت وكالته شاملة لمثله أيضاً.
كما أنّ الظاهر عدم تحقّق الأداء فيما إذا غصبها غاصب من الغاصب الأوّل مثلًا وأدّاها إليه دون المالك، فإنّه وإن كان يصدق الأداء إلى من أخذ العين منه وهو الغاصب الأوّل، إلّا أنّه لا يحتمل الحديث الحكم برفع الضّمان مع الأداء إليه، كما لا يخفى.
وأمّا إذا غصبها من المستأجر الذي كانت العين المستأجرة بيده، فهل يتحقّق الأداء الرافع للضمان إذا أدّاها إلى مالك العين، أو لا يتحقّق إلّا إذا أدّاها إلى المستأجر؟ الحقّ أنّه هنا ضمانان: ضمان العين بالنسبة إلى المالك، وضمان المنفعة بالنسبة إلى المستأجر، فإذا أدّاها إلى المستأجر يرتفع كلاهما؛ لأنّه أدّى المنفعة إلى صاحبها، وأدّى العين إلى من يكون أميناً من قبل المالك عليها؛ وهو المستأجر، فهو يكون كالأداء إلى الوكيل في المثال المتقدم، وأمّا إذا أدّاها إلى مالك العين، فضمان العين وإن كان يرتفع بذلك، إلّا أنّ ضمان المنفعة لا مجال لتوهّم ارتفاعه به.
ومن هنا يتّجه أن يقال: إذا غصب العين المستأجرة من المستأجر مالكها- بناءً على عدم انفساخ الإجارة بذلك- يصير مالك العين ضامناً لمنافعها، ولا يرتفع ضمانه إلّا بأداء العين الذي يستتبع أداء المنفعة إلى المستأجر، ومع عدم الأداء وفوت المنافع بيده يلزم عليه أداء قيمتها، كما لا يخفى.
ومن قبيل الإجارة الرّهن، فإذا أخذ العين من يد المرتهن، فإن أدّاها إليه يرتفع الضمان كلًاّ، وأمّا إذا أدّاها إلى المالك يبقى الضمان بالنسبة إلى المرتهن بحاله، فإذا تلفت في يده يلزم عليه أداء المثل أو القيمة إلى المرتهن، ليبقى عنده وثيقة لدينه، ثمّ يردّها المرتهن إلى الرّاهن، أو يأخذ منه دينه.
وأمّا إذا أخذ العين من يد الودعي، فالظاهر تحقّق الأداء الرافع للضمان بالردّ إلىكلّ من المالك والودعي، والفرق عدم تعلّق حقّ الغير بها في هذه الصورة. وعلى ما ذكرنا يتّجه أن يقال: إنّ الأداء المأخوذ غاية هو الأداء إلى من هو ضامن بالنسبة إليه أو وكيله أو أمينه، لا الأداء إلى خصوص المالك ولا الأداء إلى من أخذ منه.
الجهة الثالثة: قد عرفت أنّ الضمان في صورة تلف العين إنّما يستفاد من نفس دليل القاعدة، وأنّ الأداء الذي يكون غاية للحكم بالضمان ورافعاً له، يكون له مراتب على ما هو المتفاهم عند العرف منه، وأنّ أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي من مراتب الأداء، ويرتفع به الضمان أيضاً، وقد وقع البحث مفصّلًا في المعيار في المثلي والقيمي، وبيان الضابطة لهما، ونحن نحيل هذا البحث إلى محلّه. وقد وقع في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد في كتاب مكاسبه (49) .
إنّما المهمّ في المقام البحث في أنّ القيمي الذي يجب أداء قيمته بعد التلف، هل الواجب رعاية قيمته حال الاستيلاء والأخذ، أو قيمته في حال التلف والانعدام، أو القيمة حال الأداء الذي هو الغاية للحكم بالضمان، أو أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف، أو إلى زمان الأداء؟ فيه وجوه واحتمالات.
وقد ذكروا لهذه الوجوه والاحتمالات أدلّة ووجوهاً، والمهمّ هو النظر في القاعدة، وأنّها تقتضي أيّ وجه، فنقول :
ربما يقال- كما قال به المحقّق البجنوردي- بأنّ مقتضى القاعدة هي قيمة يوم الأخذ والاستيلاء، الذي هو في باب الغصب يكون يوم الغصب، وتقريبه بنحو الاختصار: أنّ ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: «وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» هو أنّ نفس ما وقع تحت اليد يثبت ويستقرّ على عهدة الآخذ، ولا شك في أنّ هذا المعنى حكم شرعيّ وضعيّ في عالم الاعتبار التشريعي؛ لأنّه حيث إنّ المال المأخوذ مال وعين خارجية، والموجود الخارجي يمتنع أن ينتقل بوجوده الخارجي إلى عالم الاعتبار، كما أنّه يستحيل أن ينتقل إلى الذهن للزوم الانقلاب، فاللازم أن يقال بأنّ ثبوته ووجوده في العهدة إنّما هو في عالم الاعتبار الذي هو أيضاً وجود، كالوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتبي، ومرجعه إلى اعتبار ذلك الوجود الذي وقع تحت اليد فوق اليد وعلى عهدتها.
وذلك الوجود المأخوذ له جهات ثلاث: الخصوصيات الشخصيّة، والجهات الصنفيّة الطبيعيّة، وماليّته التي هي العمدة في أبواب الضمانات والغرامات، وهذه الجهات مأخوذة في عالم الاعتبار ومعتبرة فيه، فإذا أمكن أداؤها بأجمعها، فالواجب هو الأداء بهذه الكيفية، وإذا تلفت العين تسقط الخصوصيات الشخصية؛ لأنّه مع عدم إمكان أدائها يكون اعتبارها لغواً، وتبقى الجهتان الاخريان، وإذا لم تكن مثلية كما هو المفروض، تسقط الجهات الصنفيّة أيضاً، ويبقى خصوص الجهة الماليّة، فاللازم أداء تلك الجهة؛ وهي التي كان ضامناً لها ابتداءً ومن حين الأخذ؛ لأن ظرف الضمان هو وقت الأخذ، فاللازم هي القيمة في وقت الأخذ الذي هو وقت الضمان بحسب الحديث الشريف (50) .
ولكنّ الظاهر أنّ مفاد الحديث هي القيمة يوم الأداء والدفع، وذلك لظهوره في ثبوت نفس العين المأخوذة على العهدة. وأمّا ما في كلامه من أنّ العين الخارجيّة يمتنع أن تنتقل بوجودها الخارجي إلى عالم الاعتبار، فيردّه أنّ العين الخارجية إنّما هي طرف الاعتبار ومتعلّق له، فهي بوجودها الخارجي ثابتة على العهدة، لكنّ الثبوت إنّما هو أمر اعتباري لا واقعي.
وعليه: فقياس المقام بالموجود الخارجي الذي يمتنع أن يوجد في الذهن بوصف وجوده في الخارج قياس مع الفارق؛ ضرورة أنّ الوجود الذهني قسيم للوجود الخارجي، وكل منهما له واقعية، ويمتنع انتقال أحدهما إلى الآخر مع وصف ثبوت واقعيّته ووجوده. وهذا بخلاف المقام؛ فإنّ الأمر الاعتباري الذي هو الضمان والثبوت على العهدة، إنّما يكون متعلّقه الوجود الخارجي الذي تعلّق الأخذ به، ولابدّ أن يكون كذلك؛ لما في الفرق بين الضمان واشتغال الذمّة؛ من أ نّ الأوّل يتعلّق بالجزئي والثاني بالكلّي، وعليه: فالثابت على العهدة في المقام نفس المأخوذ الذي هو العين الخارجيّة من دون استلزام الانتقال.
هذا إنّما هو بالإضافة إلى العين مادام كونها موجودة باقية، وأمّا مع التلف والانعدام، فالمستفاد من الحكم بالضمان في قاعدة الإتلاف المفروضة بعد التلف، ومن الحكم ببقاء الضمان في قاعدة «على اليد» بعد تلف العين المأخوذة؛ لعدم تحقّق الغاية الرافعة وهي الأداء- ولا مجال لتوهّم عدم ثبوت الغاية للضمان؛ لامتناع تحقّق الأداء، كما أنّه لا مجال لدعوى عدم دلالتها على الضمان بعد التلف- أنّه لابدّ وأن يعتبر وجود العين في قاعدة الإتلاف وبقاؤها في قاعدتنا. غاية الأمر كونه بنحو الاعتبار؛ لأنّه لا يعقل عدم ثبوت الطرف للضمان؛ فإنّه كما يحتاج إلى وجود الضامن كذلك يحتاج إلى وجود المضمون، فلا محالة يكون ثبوت الحكم بالضمان بعد إعدام العين أو انعدامها مستلزماً لفرض وجود العين واعتبار بقائها.
وعلى ما ذكرنا فالثابت على العهدة إنّما هو نفس العين المأخوذة، من دون فرق بين زمان قبل التلف، وبين زمان عروض التلف لها، فكما أنّ العين بجميع جهاتها الثلاث المذكورة في كلام القائل ثابتة على اليد قبل التلف، غاية الأمر في عالم الاعتبار الذي هو طور من الوجود في قبال سائر أطواره وأنواعه، كذلك هو ثابت على اليد مع جميع الجهات بعد التلف، ولا مجال للتفكيك في مفاد الحديث الذي هو الحكم بالضمان بين الزّمانين: قبل التلف وبعده، والحكم بأنّ الثابت قبل التلف إنّما هي العين مع جميع الجهات الثلاث، والثابت بعده إنّما هي العين مع بعض تلك الجهات، فالعين المأخوذة على اليد وعهدتها مستمرّاً إلى زمان الأداء، ولا فرق في هذا الثبوت بين ما قبل التلف وما بعده، فبعده أيضاً تكون العين على العهدة كقبله.
غاية الأمر أنّ التلف إنّما يؤثّر في الغاية وهي الأداء؛ حيث إنّه قبل التلف كان أداء العين بجميع الخصوصيات ممكناً، وبعده امتنع ذلك وصار محالًا، وحينئذ ينتقل إلى المرتبة الثانية؛ وهي أداء المثل مع فرض مثليّته، وبعدها إلى المرتبة الثالثة؛ وهي أداء القيمة مع كونه قيميّاً، ولكنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو في ما يرتبط بالاداء وبالغاية، ولا ارتباط له بأصل الضمان، فمادام لم يؤدّ القيمة تكون العين المأخوذة باقية على العهدة وثابتة على اليد، فإذا أراد ردّها ليرتفع الضمان، فحيث لا يكون قادراً على ردّ العين لفرض التلف، ولا على ردّ مثلها لعدم كونها مثليّة، فاللازم ردّ قيمتها، ومن الواضح أنّ القيمة التي يجب ردّها حينئذ هي القيمة للعين في حال الأداء والدّفع.
وبعبارة اخرى: الواجب عليه ردّ العين في هذه الحالة أيضاً، وحيث إنّه ممتنع، فتصل النوبة إلى ماليتها القائمة مقامها، وهي الماليّة في حال الردّ والأداء.
والظاهر وقوع الخلط في كلام القائل بين الضمان المغيّى ، وبين الأداء الذي هي الغاية، فرأى أنّه حيث لا يمكن ردّ العين مع جميع الجهات، واللازم ردّها ببعضها، فيكون الضمان أيضاً مرتبطاً بذلك البعض، مع أنّ الضمان إنّما هو بالإضافة إلى العين في جميع الحالات، والغاية له مراتب ودرجات، ونتيجته لزوم أداء قيمة يوم الأداء؛ لامتناع أداء العين بجميع الخصوصيات.
ويؤيّد ما ذكرنا الحكم بضمان النماءات التي تحصل للعين المغصوبة بعد الغصب، وإن تلفت تلك النماءات بعد حصولها، كما لو سمنت الشاة مثلًا في يد الغاصب، ثمّ زال عنها السمن وعادت حالتها الاولى؛ فإنّ منشأ الحكم بضمانها هو كون المضمون هي العين بجميع الخصوصيات، وهي الثابتة على العهدة وعلى اليد.
ودعوى كون هذه النماءات واقعة تحت اليد جديداً بتبع بقاء العين، فتكون غصباً آخر غير مربوط بالغصب الأوّل، مدفوعة بوضوح خلافها؛ فإنّ تعدّد الغصب في مثله ممّا لا يقبله العقلاء والعرف أصلًا.
وبالجملة لا فرق في أصل الحكم بالضمان المستفاد من المغيّى في الحديث الشريف، وهو ضمان العين وثبوتها على العهدة بجميع الخصوصيات، بين الفروض المختلفة والحالات المتعددة: من التلف وغيره، والمثلى وغيره، وإنّما الاختلاف بينها يرجع إلى الغاية الرافعة للضمان، ومقتضى ما ذكر في القيمي ردّ قيمته يوم الردّ والدفع، فتدبّر جيّداً.
ثمّ إنّ في دلالة القاعدة احتمالًا ثالثاً اختاره سيدنا المحقّق الاستاذ البروجردي قدس سره على ما في تقريراته في مباحث الغصب (51) ، فإنّه بعد أن ذكر أنّ مختاره في السابق كان ما عليه المحقّق الخراساني (52) قدس سره ممّا يرجع إلى لزوم قيمة يوم الأداء والدفع، وقد رجع عنه بعداً، ذكر أنّ القيمة التي يقال لها بالفارسيّة:
«أرزش» لا تعتبر للمعدوم الصّرف، فالعين الشخصية الخارجيّة وإن كانت في زمن بقائها تعتبر لها في كلّ يوم قيمة، ولكنّها إذا تلفت لا تعتبر لها عند العقلاء قيمة، بأن يقولوا: إنّ هذه العين في هذا اليوم تساوي كذا وكذا؛ لانتفاء الهذيّة والشخصيّة، فكيف تعتبر لها قيمة؟
نعم، تعتبر عند العقلاء لمثلها قيمة، ولكن أين هذا من قيمة شخص العين التالفة التي جعلت من المراتب النازلة لنفس العين، فالعين لمّا لم يكن لها قيمة بعد تلفها، كان الواجب على الضامن أداؤها بقيمتها حينما تعتبر لها قيمة؛ وهو حال الوجود، فزمان الانتقال إلى القيمة وإن كان هو يوم التأدية، لكنّ العين لمّا لم تكن لها قيمة إلّا حال الوجود، فاللازم قيمة ذلك الحال، ولكن لا دلالة للقاعدة حينئذ على أنّ الاعتبار بخصوص يوم التلف، أو يوم الغصب، أو أعلى القيم منه إليه.
ويرد عليه ما عرفت سابقاً : من أنّ المستفاد من الحكم بالضمان في قاعدة الإتلاف- التي مرجعها إلى كون الضمان مترتّباً على الإتلاف، وأنّ الإتلاف سبب للضمان ومتقدّم عليه ولو رتبة- أنّه لا يعتبر في الحكم بالضمان مطلقاً بدواً واستمراراً وجود العين وعدم عروض التلف لها، فالعين وإن كانت تالفة تكون معروضة لوصف المضمونيّة ومتعلّقه للضمان، وحينئذ نقول: إنّ لازم اعتبار قيمتها حال الوجود لعدم اعتبار القيمة حال التلف أن يكون اللازم القيمة في حال عدم تحقّق الضمان؛ وهو حال الوجود، فيصير مثل ما إذا قيل في الغصب باعتبار قيمة قبل الغصب، مع أنّه لم يقل به أحد ولا يحتمله القاعدة بوجه.
والحقّ أنّ القيمة اللازمة هي قيمة العين التي اعتبر وجودها في عالم التشريع وثبوتها وبقاؤها على العهدة، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدتين- قاعدة الإتلاف وقاعدة التلف التي هي المبحوث عنها في المقام- بقاء نفس العين على العهدة وثبوتها على اليد، وأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو في مرحلة الأداء الذي له مراتب متعدّدة ودرجات مختلفة، واللازم حينئذ أن يؤدّي قيمة يوم الأداء؛ لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة والبدل، والذي تضاف إليه القيمة هي نفس العين الثابتة على العهدة وإن كانت غير موجودة في الخارج، فالإنصاف أنّه لا مجال للرجوع عمّا أفاده المحقّق الخراساني قدس سره واختاره جملة من أجلّاء تلامذته من كون اللازم بمقتضى القاعدة هي قيمة يوم الأداء والدّفع.
ثم إنّه ورد في هذا المجال رواية صحيحة في باب الغصب- الذي هو أظهر مصاديق القاعدة المبحوث عنها في المقام- لابدّ من ملاحظتها، وأنّه هل يستفاد منها غير ما تفيده القاعدة من القيمة يوم الأداء على ما استظهرنا منها أم لا؟ وأنّه على التقدير الأوّل كيف يجمع بينهما؟
فنقول: هي صحيحة أبي ولّاد قال: اكتريت بغلًا إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل، فتوجّهت نحو النيل، فلمّا أتيت النّيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلّل منه فيما صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت لبغل؟ فقلت: قد رجّعته سليماً، قال: نعم، بعد خمسة عشر يوماً، قال فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كراء بغلي، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً، فقال: إنّي ما أرى لك حقّاً؛ لأنّه اكتراه إلى قصر بني هبيرة، فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء.
قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئاً وتحلّلت منه، وحججت تلك السّنة فأخبرت أبا عبد اللَّه عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السّماء ماءها وتمنع الأرض بركتها.
قال: فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام فما ترى أنت؟ فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفّيه إيّاه.
قال: قلت: جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا، لأنّك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك.
فقلت: إنّي أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني، فقال: إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك (53) .
وتنكير البغل في قوله عليه السلام: «قيمة بغل يوم خالفته، إنّما هو في نسخة الوسائل، والمحكي عن بعض نسخ الكافي والتهذيب هو «البغل» معرّفاً، وهو الظّاهر، كما أنّ المحكيّ عن صاحب الجواهر أنّه قال: إنّ الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشّاة «تردّه عليه» من دون لفظ «يوم» (54) .
وربّما يقال بدلالة الصحيحة على أ نّ المدار في القيمة هي قيمة يوم الغصب والأخذ والاستيلاء، وذلك في موضعين منها:
أحدهما: قوله عليه السلام: «نعم قيمة بغل يوم خالفته» وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في وجه دلالة هذه الفقرة على كون المدار هي القمية يوم الغصب وجهين:
الأوّل: إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى يوم خالفته ثانياً، فيكون المضاف واحداً والمضاف إليه متعدّداً في عرض واحد، ويصير المعنى قيمة بغل قيمة يوم خالفته، ومن الواضح أنّ المراد بالمضاف إليه الثاني هو يوم الغصب والأخذ (55) .
واورد عليه تارة: بأنّ المضاف إلى شيء لا يضاف إلى شيء آخر ثانياً، وأنهّ محال من جهة استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال ولحاظ واحد وهو مستحيل. ذكر ذلك المحقّق الخراساني قدس سره في حاشية المكاسب، حيث قال: فيه إشكال؛ فإنّ إضافة المضاف بما هو مضاف ثانياً يستلزم أن يكون الإضافة بما هي إضافة ملحوظة باللحاظ الآلي طرفاً لها وملحوظة على الاستقلال، فإنّها من مقوّماته في الإضافة الثانية، ولو كان المراد إضافته ثانياً، لا بما هو كذلك، أي مضاف يلزم أن يكون حين التلفظ به طرفاً لهذا على حدة، ولذاك كذلك، وهذا يستلزم أن ينظر إليه ذلك الحين بالنظرين المتبائنين (56) .
واخرى: بأنّه على فرض الجواز لا يكون ذلك معهوداً في تراكيب الكلام والجمل العربية، خصوصاً في مقام الإفتاء الذي يناسبه التعبير المتداول والاستعمال المتعارف، وخصوصاً إذا كان في مقابل إفتاء آخر غير مطابق للواقع، وهو إفتاء أبي حنيفة بغير ما أنزل اللَّه تعالى. نعم، لا مانع من تتابع الاضافات الذي مرجعه إلى إضافة المضاف إليه إلى المضاف إليه الآخر، واضافته أيضاً إلى ثالث وهكذا، كما ورد في الكتاب: {مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ } [غافر: 31] ولكنّه غير ما أفاده قدس سره (57) .
وقد وجّهه السيّد الطّباطبائي في حاشيته على المكاسب: أ نّ قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمر إلّا بجعله قيداً للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد، وفي المقام كذلك، فإنّ تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له، فلابدّ أن يكون الغرض من ذلك كونه قيداً للقيمة؛ يعني يوم المخالفة للبغل، وذلك كما إذا قيل: «ضرب زيد يوم الجمعة» فإنّ إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له إلّا أن يكون الغرض منه تقييد الضرب به (58).
ويرد عليه: وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ فإنّ تقييد زيد بيوم الجمعة وإن كان لا معنى له، إلّا أنّ تقييد البغل بيوم المخالفة لا مانع منه؛ لاختلاف حالاته من جهة السمن والهزال والصحة والمرض وغيرهما، ومن جهة تفاوت القيمة السوقية والاختلاف من هذه الناحية، مع أنّ هذا التوجيه يرجع إلى الوجه الثاني المذكور في كلام الشيخ الذي يجيء، وعليه: فلا يبقى فرق بين الوجهين.
الثاني: كون الظرف قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل (59) ، فيكون المعنى قيمة مختصّة بالبغل يوم المخالفة، بحيث كان يوم المخالفة متعلقاً بمختّصة، ولا مانع منه بعد كونه شبه فعل، ويجوز أن يكون عاملًا في الظرف، وحينئذ يكون الظرف مفتوحاً، كما أنّه في الصورة الاولى يكون مجروراً، ومن المعلوم أنّ القيمة المختصة بالبغل يوم المخالفة هي قيمة يوم الغصب والأخذ.
واورد عليه: بأنّ اختصاص الحاصل من الإضافة معنى حرفي وملحوظ آليّ، فلا يمكن أن يرد عليه القيد؛ لأنّ المعاني الحرفية ليست قابلة للتقييد؛ للزوم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي واحد ولحاظ فارد.
ولكنّا قد حقّقنا في البحث عن الحروف في علم الاصول أنّه لا مانع من ذلك وأنّ أكثر التقييدات الواقعة في الاستعمالات والمحاورات إنّما يرجع إلى تقييد المعاني الحرفية، فقولك: «ضرب زيد يوم الجمعة عند الأمير» يكون القيدان فيه راجعين إلى وقوع الضرب على زيد، وهو من المعاني الحرفية غير المستقلّة، بخلاف نفس الضرب الذي هو معنى مستقل، وكذا زيد الذي يكون كذلك، ولا مجال لدعوى تعلّق القيدين بنفس الضرب من دون ملاحظة خصوصية وقوعه على زيد، وفي الحقيقة متعلق القيدين هو الاختصاص الحاصل من اضافة الضرب إلى زيد، ولذا أوردنا على المحشّي برجوع توجيهه للوجه الأوّل إلى الوجه الثاني.
وبالجملة: لا مانع من تقييد ما هو الملحوظ باللحاظ الآلي وإن كان مستلزماً لللحاظ الاستقلالي، والشاهد هو الاستعمالات المتداولة والمحاورات العرفيّة.
ويمكن أن يقال برجوع القيد إلى البغل بحيث يكون المقام من تتابع الإضافات، وذلك بملاحظة ما ذكرنا من اختلاف حالات البغل من جهة السمن والهزال والصحة والمرض ومثلهما، ومن جهة القيمة السّوقية، ولكنّه حيث لا يكون الاختلاف من الجهة الاولى متحقّقاً في مورد الرواية؛ لأنّ البغل لا يختلف في الأيّام القليلة المفروضة في مورد الرواية من جهة السّمن والهزال غالباً، والمفروض عدم عروض عيب عليه؛ لأنّ فرض العيب واقع في الأسئلة الواقعة بعد هذا الجواب.
فالظاهر حينئذ أنّ الاختلاف الذي هو محطّ نظر الرواية هو الاختلاف من جهة القيمة السوقيّة، وعليه: يكون الظرف قيداً للبغل بنحو الإضافة، كما أنّه يمكن أن يقال بكون الظرف متعلّقاً بنعم، كما استظهره السيد قدس سره في الحاشية، نظراً إلى أنّه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلّقاً للظرف، والقيمة بمعنى العوض ليس فعلًا ولا شبهه، بخلاف «نعم»، فإنّه في قوّة قوله: «يلزمك» أو يكون لفظ «يلزمك» مقدّراً بعده (60) .
وعلى هذا الاحتمال الأخير لا دلالة لهذه الفقرة من الرواية على تعيين قيمة أيّ يوم؛ لأنّ غاية مفادها هو اشتغال الذمّة بالقيمة وثبوتها على العهدة في يوم الأخذ، وأمّا أنّ القيمة المضمونة والثابتة على العهدة قيمة أيّ يوم، فلا دلالة للرواية عليه أصلًا. نعم، ظاهرها حينئذ أنّ الثابت على العهدة في غصب القيمي بمجرّد تحقّق الأخذ هي القيمة، مع أنّ ظاهر قاعدة ضمان اليد كما عرفت هو ثبوت نفس العين المأخوذة على اليد، فيقع بينهما التنافي من هذه الجهة، ولكن لابدّ من توجيه الرواية؛ لأنّه لا معنى لثبوت القيمة على العهدة مع وجود العين وعدم تلفها، بحيث يكون مجرّد غصب القيمي موجباً لثبوت القيمة على عهدة الغاصب، فلابدّ من توجيهها بما يرجع إلى مفاد القاعدة، كما لا يخفى.
وبالجملة: إذا كان «يوم خالفته» قيداً للقيمة ومتعلقاً بها، فبلحاظ كون الجواب إنّما هو عن السؤال عن صورة وقوع التلف، وفرض أنّ البغل عطب أو نفق، يكون مرجع قوله: «نعم» إلى لزوم القيمة المقيّدة بالقيد المذكور بعد فرض التلف، فلا دلالة للجواب حينئذ على ما يلزمه بمجرّد الأخذ والمخالفة أصلًا.
وأمّا لو كان القيد راجعاً إلى «نعم» أو الفعل المقدّر بعده، فالجواب وإن كان عن السؤال المذكور المفروض فيه صورة التّلف، إلّا أنّ ظاهره ثبوت القيمة ولزومها عليه بمجرّد الأخذ والمخالفة مطلقاً، من دون فرق بين ما إذا تحقّق التلف بعده، وما إذا لم يتحقّق؛ لأنّه لا مجال للتفكيك بين الصورتين، والحكم بأنّه في صورة التلف يكون اللازم عليه يوم الغصب هي القيمة، فلا ينافي كون اللازم في صورة العدم من حين الأخذ هي غير القيمة، بل الظاهر أنّ المستفاد من الرّواية حينئذ كون اللازم هي القيمة مطلقاً، وعليه : فلابدّ من توجيه الرواية بما يرجع إلى مفاد قاعدة اليد، فتدبّر.
وبذلك يجاب عمّا عن بعض الأعاظم قدس سره (61) : من أنّ ضمان القيمة لو كان يوم المخالفة- أي يوم الغصب- بمعنى تعلّق القيمة بالعهدة واشتغال الذمّة بها في ذلك اليوم، فلازمه كون المضمون هي قيمة يوم المخالفة أيضاً؛ لأنّه لا معنى لأن تكون قيمة اليوم المتأخّر عن يوم المخالفة- وهو يوم التلف أو يوم الردّ- ثابتة على العهدة في يوم المخالفة.
وعليه: فلو كان الظرف راجعاً إلى «نعم» أو الفعل المقدّر بعده، تكون هذه الفقرة دالّة أيضاً على كون المعتبر هي قيمة يوم المخالفة. وقد ذكرنا أنّه حيث لا معنى لتعلّق القيمة بالعهدة واشتغال الذمّة بها، مع فرض وجود العين بحيث كان الحكم المغيّى راجعاً إلى ثبوت القيمة، والغاية دالّة على أداء العين، ضرورة أنّه لا معنى لأدائها- أي القيمة- مع فرض وجود العين وإمكان ردّها، فلابدّ من التوجيه بما يرجع إلى مفاد القاعدة؛ وهو ثبوت العين على العهدة في عالم الاعتبار الذي يتّفق فيه العقلاء والشارع، غاية الأمر أنّه مع فرض التلف وكون العين قيمية، لا يمكن أن يتحقّق الأداء إلّا بأداء القيمة التي هي الجهة المهمّة في باب الماليّات، والملحوظة في أبواب الضمانات والغرامات.
وقد انقدح بما ذكرنا أنّه لم تثبت دلالة هذه الفقرة من الرواية على خلاف ما استظهرنا من القاعدة من ثبوت القيمة يوم الدفع والأداء.
ثانيهما: قوله عليه السلام «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك». والظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام: «حين اكترى» هو يوم الغصب؛ لأنّه لا وجه لضمان يوم الاكتراء بعنوانه أصلًا، والعدول عن التعبير بيوم الغصب إلى يوم الاكتراء- مضافاً إلى اتّحاد اليومين في مورد الرواية؛ لأنّ الظاهر أنّ اكتراء الدابّة خصوصاً في تلك الأزمنة إنّما كان يقع في نفس اليوم الذي يريد ركوبها والاستفادة منها، والمفروض في الرواية تحقّق الغصب في الساعة الاولى من الحركة والركوب؛ لأنّه وقع الاكتراء في الكوفة التي هي ساحل الشطّ، ووقع الغصب والمخالفة قرب قنطرة الكوفة حين ما خبّر بتوجّه غريمه إلى النيل، وعدم كونه في قصر ابن هبيرة- إنّما هو لأجل أنّ تحصيل الشهود حين الاكتراء أسهل من حال الغصب؛ لأنّ محلّ الاكتراء غالباً محلّ اجتماع المكارين العارفين بقيمة البغال.
وأمّا حين الغصب الواقع في أثناء الطريق لا طريق نوعاً إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمته في ذلك الوقت، وعليه: تكون هذه الفقرة صريحة في أنّ المدار في ضمان القيمي هو قيمة يوم الغصب والمخالفة.
هذا، ويمكن منع دلالة هذه الفقرة أيضاً؛ نظراً إلى أنّه يمكن أن يكون التعبير بيوم الاكتراء الذي يراد به يوم الغصب على ما مرّ إنّما هو لأجل عدم تفاوت قيمة البغل في الأيّام القليلة المفروضة في مورد الرواية، التي لا تتجاوز عن خمسة عشر يوماً؛ فإنّه كما لا يختلف البغل في هذا المقدار من الزمان من جهة السمن والهزال نوعاً، كذلك لا يختلف من جهة القيمة السّوقية خصوصاً في تلك الأزمنة، والتعبير به بدلًا عن يوم الدفع والأداء إنّما هو لأجل ما ذكر من أنّه لا طريق غالباً إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمة يوم الدفع، خصوصاً بعد عدم وجود العين، ولا مجال لتعيين القيمة مع التلف.
ومن الواضح أنّ الخصوصيات التي عليها الدابّة لها دخل في القيمة جدّاً، وذكرها لا يكفي في مقام التقويم، بل لابدّ من المشاهدة وإن كان التوصيف يكفي في مقام البيع والمعاملة، إلّا أنّ للتقويم مقاماً غير مقام المعاملة، فتدبّر.
ويؤيّد ما ذكرنا من عدم دلالة الرواية على ضمان القيمة يوم الغصب قوله عليه السلام في الذيل: «عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه» بناءً على وجود كلمة اليوم؛ لما عرفت من الجواهر من عدم وجودها في النسخة المصحّحة من التهذيب الموجودة عنده، وعلى أن يكون الظرف متعلّقاً بالقيمة؛ بمعنى أنّه يجب عليك قيمة يوم الردّ بالإضافة إلى ما بين الصحة والعيب.
وأمّا بناءً على تعلّق الظرف بـ «عليك» بلحاظ كون معناه الفعل؛ وهو: أنّه يلزم عليك، فمعناه أنّ الثابت على العهدة في يوم الردّ والأداء هي القيمة، فيمكن أن يقال بظهوره أيضاً في كون الثابت هي القيمة في ذلك اليوم وإن كان يمكن المناقشة فيه بأنّ غاية ما تدلّ عليه حينئذ هو كون الثابت في يوم الردّ هي القيمة، وأمّا أنّ القيمة قيمة أيّ يوم فالرواية ساكتة عنه.
ولكنّ الظاهر عدم تعلّق الظرف ب «عليك» وإن كان متضمّناً لمعنى الفعل؛ لأنّه إن كان المراد باللزوم هو لزوم الأداء والدفع فلا فائدة في ذكر الظرف أصلًا؛ لأنّه يصير حينئذ أمراً واضحاً لا حاجة إلى بيانه؛ لوضوح أنّ أداء القيمة إنّما يقترن مع أداء العين، وردّها مع وصف كونها معيوبة. وإن كان المراد باللزوم هو الثبوت على العهدة، فلا خفاء في أنّ الثبوت الكذائي إنّما يتحقّق بنفس عروض العيب، وصيرورة الدابّة معيبة في يد الغاصب، فلا وجه لجعل الظرف متعلقاً به حتى يصير معناه أنّ الثبوت إنّما يكون زمانه يوم الردّ والأداء.
ويحتمل أن يكون الظرف متعلّقاً بالعيب؛ بمعنى أنّه لابدّ في العيب من ملاحظة يوم الأداء؛ إذ ربما يمكن أن يكون العيب في أوّل عروضه قليلًا ثمّ ازداد بعده، وفي هذه الصّورة لابدّ من ملاحظة ما عليه العيب من الكثرة والشدّة في يوم ردّ العين معيبة، ولازم ذلك أنّه لو فرض العكس وصيرورة العيب قليلة أو خفيفة لكان اللازم ملاحظة وقت الأداء دون وقت العروض.
وبالجملة: فالرواية على التقدير الأوّل الذي يكون الظرف متعلّقاً بالقيمة تؤيّد عدم دلالتها في الجملات السابقة على هذه الجملة على كون المراد هي القيمة يوم الغصب.
ثمّ إنّه ربما يستشكل الأخذ بهذه الصحيحة بأنّها مخالفة للقواعد العامّة والضوابط القطعية المقرّرة في كتاب القضاء للمدّعي والمنكر؛ وهي أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر، والتفصيل قاطع للشركة، فالمدّعي وظيفته إقامة البيّنة والمنكر اليمين. نعم، يمكن له ردّ اليمين إلى المدّعي في فرض عدم ثبوت البيّنة له، مع أنّ الصحيحة ظاهرها تخيير المالك ابتداءً بين الحلف وبين إقامة البيّنة، غاية الأمر أنّه مع عدم الحلف وعدم البيّنة تصل النوبة إلى حلف الغاصب. وهذا لا ينطبق على قواعد باب القضاء وفصل الخصومات بوجه.
وربما يوجّه ذلك؛ بأنّ الاختلاف يمكن أن يكون باختلاف كيفية انشاء دعويهما، وبعبارة اخرى: لا يجتمع الأمران في مورد واحد وفي مصبّ دعوى كذلك، بل لهما موردان، فإنّه إن كان مصبّ الدعوى تنزّل القيمة التي يجب عليه أداؤها من القيمة السّابقة بحيث كان الغاصب مدّعياً للتنزّل والمالك منكراً له، تكون وظيفة المالك حينئذ اليمين مع عدم ثبوت البيّنة للمنكر على التنزّل لأنّ الأصل عدم التنزل.
وإن كان مصبّ الدعوى نفس القيمة الثابتة من غير اتفاق على القيمة السّابقة، بل ومن دون اطّلاع عليها، بل كان النزاع في مجرّد القيمة من حيث الزيادة وعدمها، فالقول قول الغاصب؛ لإنكاره الاشتغال بالزائد عمّا يدّعيه من القيمة، وعلى المالك إقامة البيّنة لكونه مدّعياً في هذه الصورة فلم يجتمع الأمران في مورد واحد.
وهذا التوجيه وإن كان يؤيّد عدم دلالة الرواية على كون المدار هي القيمة يوم المخالفة؛ لأنّ لازمه الإتّفاق في المورد الأوّل على القيمة قبل الغصب الذي لا تكون العين بيد الغاصب وتحت استيلائه، وهذا في غاية البعد، بخلاف ما لو كان مدلول الرواية هي القيمة يوم الدفع؛ فإنّ الإتّفاق على القيمة قبل يوم الدفع كيوم الأخذ والغصب أمر عاديّ لا بعد فيه أصلًا، إلّا أنّه في نفسه مستبعد.
وأبعد منه حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدّقه فيه من دون محاكمة، والتعبير بردّه اليمين على الغاصب من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة بغله، فكان الحلف حقّاً له ابتداءً، ولكن ذلك لا يقدح في أصل دلالة الرواية على تعيين القيمة وأنّ الملاك قيمة أيّ يوم.
ثمّ إنّه بناءً على ما قلنا من عدم ظهور الرواية في شيء من فقراتها في خلاف ما تدلّ عليه القاعدة المستفادة من «على اليد ما أخذت» من كون المدار هي قيمة يوم الدفع، لابدّ من حملها عليها؛ لعدم التعارض بينهما بعد فرض ظهور القاعدة، وعدم ظهور الرواية في خلافها.
وأمّا إن قلنا بظهور الرواية في كون المناط هي القيمة يوم الغصب كما عليه بعض الأعاظم قدس سره (62) ، فالظاهر لزوم الأخذ بالرواية؛ لعدم بلوغ ظهور القاعدة مرتبة ظهور الرّواية، خصوصاً بعد الاختلاف فيه وإنكار بعض ظهور القاعدة في لزوم دفع قيمة يوم الدفع كما نقلناه عنه ، فالإنصاف أنّه على هذا التقدير لا محيص عن الالتزام بقيمة يوم الغصب.
ثمّ إنّه بقي في بحث القاعدة امور ينبغي التنبيه عليها :
الأوّل: ما لو تعذّر أو تعسّر ردّ العين من دون أن يعرض لها التلف، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق، وأنّه هل يجب بمقتضاها إعطاء بدل الحيلولة للمالك أم لا؟ واللازم قبل البحث في هذا الأمر من التنبيه على أمرين:
أحدهما: أنّ محطّ البحث في لزوم إعطاء بدل الحيلولة وعدمه هو مجرّد القاعدة المستندة إلى قوله صلى الله عليه وآله «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».
وأمّا الأدلّة الاخرى التي يمكن استفادة الحكم بالضمان منها فهو خارج عن محلّ البحث هنا؛ مثل ما ورد في باب الأمانات المضمونة ممّا يدلّ على تحقّق الضمان بالأمور المذكورة كالسرقة ومثلها، ومثل قاعدة الضرر وفوت سلطنة المالك وأشباههما، فإنّ الجميع خارج عن محلّ البحث هنا وإن كان يجب البحث عنها في مسألة بدل الحيلولة بعنوان عام.
ثانيهما: أنّ التعذّر والتعسّر وعدم إمكان الردّ له مراتب مختلفة؛ فإنّه :
تارة: يكون في مدّة قصيرة يعلم بإمكان ردّ العين بعد انقضائها.
واخرى: يكون في مدّة طويلة مقرونة باليأس من الوصول إليها؛ كما إذا وقعت العين في قعر البحر مثلًا.
وثالثة: في تلك المدّة مع رجاء الوصول إليهما ووجدانها.
أمّا الصورة الاولى: فالظاهر أنّه لا مجال لدعوى الانتقال إلى بدل الحيلولة في تلك المدّة القصيرة مستنداً إلى «على اليد» لوضوح أنّه لا دلالة له على لزوم أداء المثل أو القيمة في هذه الصورة، وبعبارة اخرى: لا يكون أداء المثل أو القيمة في هذا الفرض من مراتب أداء العين الذي هو غاية للحكم بالضمان.
وأمّا الصورة الثانية: فهي ملحقة بالتلف عند العرف والعقلاء، حيث إنّهم لا يفرّقون بينها وبين التلف الحقيقي بوجه، وعليه: فأداء المثل أو القيمة ليس لأجل الحيلولة، بل لأجل حصول التلف العرفي، فالعمدة في البحث هي الصورة الثالثة، فنقول:
ربما يقال بأنّ مقتضى القاعدة لزوم ردّ المثل أو القيمة في هذه الصورة، نظراً إلى أنّ مقتضاها كون العين المأخوذة بدون إذن المالك والشارع، ثابتة ومستقرّة في عالم الاعتبار التشريعي على عهدة المالك بجميع خصوصياتها الشخصية وصفاتها النوعية وماليّتها، كما أنّ الأمر كذلك عند العقلاء، فيجب تكليفاً ووضعاً ردّ الجهات الثلاث مع الإمكان، وعند تلف العين يجب ردّ الجهتين الأخيرتين.
وأمّا مع التعذّر أو التعسّر على ما هو المفروض في المقام، فحيث يسقط التكليف بردّ العين للتعذّر أو التعسّر، فيدور الأمر بين أن يسقط عن ردّ جميع الجهات الثلاث، أو يبقى بالنسبة إلى الجهتين الباقيتين إن كانت مثليّة، والجهة الواحدة الباقية إن كانت قيميّة، ولا وجه للأوّل؛ لأنّه بلا دليل بل الدليل على عدمه؛ وهو قوله صلى الله عليه وآله: «على اليد...»؛ لدلالته على استقرار الجهات الثلاث في العهدة، وبارتفاع الاولى لا ترتفع الاخريان، فيجب عليه إعطاء المثل إن كانت مثليّة والقيمة إن كانت قيميّة.
ولكن بملاحظة ما عرفت في معنى «على اليد» ومفاده من كونه عبارة عن مجرّد الحكم الوضعي الشرعي مغيّى بتحقّق الأداء، تعرف أنّه لا دلالة له على الحكم التكليفي بوجه، بل مرجعه إلى أنّ الأداء رافع للضمان وغاية له، وأمّا أنّه واجب فهو مستفاد من دليل آخر، فاللازم حينئذ ملاحظة أنّ الأداء المجعول غاية للحكم بثبوت ضمان العين المأخوذة، واستقرارها على عهدة المستولي وذي اليد، هل يكون من مراتبه أداء المثل أو القيمة في المقام، كما في صورة التلف الحقيقي أو العرفي، أو أنّه لا يكون من مراتبه؛ لثبوت الفرق بين المقام وبين صورة التّلف، فالغاية لا تتحقّق إلّا بأداء نفس العين بعد رفع التعذّر والتعسّر؟
لا يبعد أن يقال بالثاني؛ لأنّ كلّما فرض أن يكون أداءً ومن مراتبه، فلابدّ من فرض كونه غاية ورافعاً للضمان المستفاد من «على اليد». وبعبارة اخرى: بعد كون الأداء في الحديث متصفاً بأنّه غاية رافعة للضمان، فكلّما فرض من مراتبه لابدّ وأن يكون متّصفاً بهذا الوصف، فلا مجال لدعوى تحقّق الأداء في مورد مع فرض عدم ارتفاع الضمان بسببه، وعليه: فالانتقال إلى المثل أو القيمة في المقام إن كان متّصفا بهذه الصّفة فلازمه الالتزام بارتفاع ضمان العين بسببه، مع أنّه لا مجال للالتزام به، وإن لم يكن متّصفاً بهذه الصفة فهو خارج عن الحديث وشموله، وعليه: فلا دلالة للحديث على الانتقال المزبور بوجه.
الأمر الثاني: لا شبهة في تحقّق الضمان بمقتضى القاعدة فيما إذا كانت اليد التي عليها ما أخذت واحدة لا تعدّد فيها. وأمّا لو تعاقبت الأيدي العادية أو غير المأذونة على مال الغير، فهل يستفاد من دليل القاعدة تعدّد الضمان بحيث كان للمالك الرجوع إلى أيّة واحدة منها شاء أم لا؟
ربما يقال: نعم؛ لأنّ مفاد الحديث الشريف جعل الضمان لكلّ يد عادية بطور القضية الحقيقيّة، فكما أنّه يشمل وقوع الأيدي المتعدّدة على الأموال المتعدّدة، كذلك يشمل الأيدي المتعدّدة إن وقعت على مال واحد؛ لأنّ المناط في تعدّد الضمان تعدّد اليد؛ إذ هو موضوع الحكم بالضمان على نحو القضية الحقيقيّة، فتنحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد أفراد موضوعها الذي هي اليد، كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية، ولا دخل في تعدّد ما تقع عليه في الحكم بالضمان، ومن آثار ذلك أي تعدّد الضمان، جواز رجوع المالك إلى كلّ واحدة منها.
ونحن نضيف إليه أنّ تقييد المضمون بكونه مأخوذاً لليد لا ينافي تعدّد الضمان بوجه، نظراً إلى أنّ الضامن الثاني لم يأخذ العين المضمونة من مالكها، بل من الضامن الأوّل، وربما لا يكون الأخذ من الضامن الأوّل بصورة القهر والغلبة، بل بإذنه ورضاه.
وجه عدم المنافاة ما أشرنا إليه من كون الأخذ في الحديث الشريف كناية عن عدم الإذن، وكون الاستيلاء على العين غير مرضيّ للمالك، وفي هذه الجهة لا فرق بين الضامن الأوّل والثاني- وهكذا- أصلًا، لأنّه كما أنّ يد الأوّل يد غير مأذونة وغير مرضية، كذلك يد الثاني والثالث وهكذا، فلا فرق بين الأيدي من هذه الجهة.
وعليه: فمقتضى الحديث الشريف تعدّد الضمان وإن كانت العين المضمونة واحدة، كما إذا كانت اليد واحدة والعين المأخوذة متعدّدة؛ فإنّه يكون ضامناً بالإضافة إلى الجميع؛ لتعدّد ما عليه اليد.
نعم، في مسألة تعدّد الضمان بالإضافة إلى مال واحد إشكال من جهة مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الإثبات؛ وهو أنّ المال الواحد كيف يمكن أن يكون مضموناً بضمانات متعدّدة في عرض واحد؛ لأنّه كما أنّ وجود مال واحد في الخارج بتمامه عند شخص، وكذلك بتمامه عند شخص آخر في نفس ذلك الزمان مستحيل، وإلّا يلزم أن يكون الواحد اثنين، كذلك وجوده في عهدة اثنين في عالم الاعتبار بحيث يتحقّق بالأداء تفريغ ما في الذمّة ويرتفع به الضمان كذلك؛ لأنّه لا يمكن أن يكون للشيء الواحد أدائين في عرض واحد، وحيث إنّه غير ممكن، فلو كان في عهدة شخصين، وفرضنا أنّ أحدهما أدّاه، فلا يرتفع الضمان عن عهدة الآخر إلى يوم القيامة؛ لأنّ أداءه ثانياً غير ممكن.
وبعد ثبوت الإشكال من جهة مقام الثبوت فلابدّ من التصرف فيما يدلّ عليه في مقام الإثبات، إمّا بالحمل على الاشتراك في ضمان واحد؛ بمعنى أنّ مثل ذلك المال أو قيمته في عهدة الشخصين بالشركة، فيجب عليهما أداء المثل أو القيمة بهذا النحو؛ أي بنحو الشركة. وإمّا بالحمل على الطولية، والمراد بها كون اللّاحق ضامناً لما يؤدّي السابق، فالمالك له الرّجوع إلى أيّ واحد من العادين. وإذا رجع إلى بعضهم، فإن كان هو اللّاحق فليس له الرجوع إلى السابق؛ لأنّ السابق ليس ضامناً لللاحق، وإن كان هو السابق فله الرجوع إلى اللّاحق؛ لأنّه ضامن لما يؤدّيه السابق كما هو المفروض.
هذا، وقد أجاب عن أصل الإشكال المحقّق الخراساني صاحب الكفاية في محكيّ حاشيته على المكاسب للشيخ الأعظم الأنصارى بأنّه يمكن بنحو الواجب الكفائي؛ بأن يكون كلّ واحد من الشخصين مكلّفاً بالأداء في ظرف عدم أداء الآخر، فليس تكليف بأدائين حتّى يكون ممتنعاً، بل امتثال مثل هذا التكليف لا يقتضى إلّا أداءً واحداً، والمقام أيضاً كذلك، فيكون على كلّ واحد منهما وجوب تدارك المال التالف وأدائه في ظرف عدم تدارك الآخر وأدائه (63) .
ويمكن الإيراد عليه بأنّه إن كان مراده ثبوت حكم تكليفيّ متعلّق بالأداء وتدارك المال التالف بالنسبة إلى شخصين كثبوته في الواجبات الكفائية، فيرد عليه- مضافاً إلى أنّه ليس المفروض خصوص صورة التلف، بل صورة بقاء العين أيضاً، ولا معنى للتدارك مع فرض البقاء-: أنّ الكلام في مفاد حديث «على اليد»، وقد عرفت أنّ مدلوله مجرّد الحكم الوضعي، وأنّ العين المأخوذة ثابتة على عهدة ذي اليد وذمّة المستولي حتى يتحقّق الأداء الرافع للضمان، فهو لا يدلّ إلّا على حكم وضعيّ مغيّى، ولا دلالة له على الحكم التكليفي بوجه.
وإن كان مراده تنظير المقام بالحكم التكليفي الثابت في الواجبات الكفائيّة، فيرد عليه وضوح بطلانه؛ لأنّ تقييد الوجوب هناك بما إذا لم تتحقّق الموافقة والامتثال من الآخر وإن كان ممكناً، إلّا أنّه لا معنى لتقييد الضمان المدلول عليه بالحديث بمثل ذلك، فالإشكال لا ينحلّ بذلك.
ثمّ إنّ حمل الحديث على الاشتراك مع أنّه مخالف لظاهره جدّاً خلاف ما استقرّ عليه الفتاوى؛ من ثبوت تمام المال على من تلف في يده، وأنّه إذا رجع المالك إلى السابق فهو يرجع بالجميع إلى اللّاحق، فلا مجال لهذا الحمل أصلًا.
وأمّا الحمل على الطوليّة، فغاية توضيحه أن يقال: إنّ اليد الاولى ضامنة لنفس المالك ابتداءً بنفس المال المغصوب؛ بمعنى أنّ نفس المال بوجوده الاعتباري في عهدة ذيها، وأمّا اليد الثانية فهي ضامنة للعين المضمونة بما هي مضمونة، وبعبارة اخرى :
المال الذي صار مغصوباً ووقع تحت اليد العادية يكون في ذمّة الغاصب بما له من الصفات والخصوصيات تكوينية أم اعتباريّة ، ولكن ما يقع تحت اليد الاولى ليس إلّا نفس العين بصفاتها التكوينية فقط؛ لعدم ثبوت صفة اعتباريّة لها في هذا الحال.
وأمّا اليد الثانية فتقع العين تحتها بما هي مضمونة، التي هي صفة اعتباريّة، ففي اليد الثانية تزيد هذه الصّفة، فكما أنّه لو كان للعين صفة خارجيّة تضمن اليد الواقعة عليها تلك الصّفة الخارجية، كذلك تضمن الصفة الاعتبارية لها، لو كانت لها ففي الغصب الثاني تكون ذات العين مع صفة كونها في ذمّة الغاصب الأوّل في ذمّة الغاصب الثاني، وهكذا الحال لو وقع المال تحت يد ألف غاصب، فضمان كلّ لاحق في طول ضمان سابقه؛ لأنّ ضمان السابق بمنزلة الموضوع لضمان اللّاحق، فلا يمكن أن يكونا في عرض واحد، بل لا يمكن أن يكونا في زمان واحد؛ لأنّ ضمان اللّاحق متأخّر عن السابق حتى زماناً، وهو الذي اختاره المحقّق النائيني على ما في تقريراته، حيث قال :
إنّ ذمّة اللّاحق مشغولة بما يجب خروجه عن ذمّة السّابق؛ أي ذمّته مخرج لما يضمنه الأوّل فما يؤدّيه الأوّل يؤخذ من الثاني؛ لاشتغال ذمّته للمالك بما له بدل؛ أي عهدة في ذمّة الأوّل، فإذا رجع المالك إليه فهو لا يرجع إلى السابق؛ لعدم كونه مغروراً منه بالفرض. وأمّا لو رجع المالك إلى السّابق فهو يرجع إلى الثاني؛ لأنّه ضمن شيئاً له بدل في ذمّة السّابق، والبدل يجب أن يخرج من الثاني، قال: وهذا هو المراد من البدل في كلام المصنف؛ يعني الشيخ الأعظم الأنصاري- إلى أن قال:- وليس المراد من البدل بدل أصل المال نظير المنافع حتى يقال: إنّ الثاني وإن ضمن ما له بدل، إلّا أنّ الأوّل كذلك أيضاً (64) .
والتحقيق أن يقال: إنّ مسألة تعدّد الضمان بالإضافة إلى مال واحد بنحو الاستقلال إن لوحظت بالنّسبة إلى أثره الذي هو جواز رجوع المالك إلى أيّ واحد من السابق واللّاحق، ويكون مخيّراً في ذلك من الابتداء، فتصويرها بمكان من الإمكان؛ لأنّه لا مانع في عالم الاعتبار من اعتبار ثبوت المال على عهدة شخصين، والحكم بضمان اليدين، وقياسه بالوجود الخارجي الذي لا يعقل فيه التعدّد مع فرض الوحدة ممنوع، بل هو أشبه بالوجود الذهني، من جهة أنّ زيداً الموجود في الخارج الذي يستحيل عروض التعدّد له بلحاظ هذا الوجود يمكن إيجاده في الذهن مرّة بعد اخرى، وكذلك لا مانع من اعتبار العين الشخصية الخارجية المتصفة بالوحدة لا محالة في ذمّة شخصين وعلى عهدة يدين، ونحن لا نرى وجهاً للاستحالة في عالم الاعتبار بوجه.
ودعوى عدم إمكان تحقّق الغاية وهو الأداء من كليهما، فإذا فرض أداء واحد منهما يكون الضمان باقياً بالإضافة إلى الآخر؛ لاستحالة تحقّق الغاية منه، مدفوعة بأنّ الغاية هي طبيعة الأداء لا خصوص أداء ذي اليد، ولذا لو فرض وصول العين إلى المغصوب منه من غير طريق الغاصب يرتفع ضمان الغصب بذلك، فالغاية هي الطبيعة، وهي في الصورة المفروضة في الدعوى متحققة، فأداء أحدهما كما هو رافع لضمانه رافع لضمان الآخر أيضاً وهذا في غاية الوضوح لو فرض كون الغاية مذكورة في الحديث بصورة «حتّى تؤدّي» الظاهر في أنّها عبارة عن أداء العين لا أداء ذي اليد لها، حيث إنّها حينئذ بصيغة المبني للمفعول والنائب للفاعل هو العين.
نعم، لو كان المذكور فيه بصورة «حتى تؤدّيه» بصيغة المبني للفاعل والفاعل هو اليد لا يكون فيه هذا الوضوح، وبالجملة: لا مجال للإشكال من جهة أصل تعدّد الضمان لا من جهة المغيّى ولا من جهة الغاية أصلًا. هذا كلّه بالإضافة إلى جواز رجوع المالك إلى أيّ واحد منهما شاء، ومنه ينقدح أنّه مع الرجوع إلى واحد منهما واستيفاء حقّه منه لا مجال له للرجوع إلى الآخر؛ لارتفاع الضمان رأساً بتحقّق غايته، فلا يجوز له الرجوع إلى الآخر أصلًا.
وأمّا جواز رجوع السابق إلى اللّاحق إذا رجع المالك إلى السابق واستوفى حقّه منه، والمفروض عدم تحقّق التلف في يده وعدم كونه غارّاً بالنسبة إلى اللّاحق، فقد عرفت توجيهه من طريق الطولية الراجعة إلى كون الثاني ضامناً للعين بوصف كونها مضمونة التي هي صفة اعتبارية، ومعنى ضمان الضمان كون اللّاحق ضامناً للخسارة والبدل الذي يعطيه السّابق ويدفعه إلى المالك، وقد اختاره سيّدنا الاستاذ الإمام الخميني- أدام اللَّه ظلّه الشريف- في كتابه في البيع، حيث قال:
إنّ وصف «كونه مضموناً» أمر قابل لوقوع اليد عليه كسائر الأوصاف تبعاً للعين، وتصحّ فيه العهدة وكونه على الآخذ، وعهدة وصف المضمون على الضامن الثاني للضامن الأوّل، ترجع عرفاً إلى ضمان الخسارة الواقعة عليه من قبل ضمانه، وليس معنى ذلك أنّ المضمون له هو المالك، بل المضمون له هو الضامن لما ضمنه للمالك. ثمّ قال: وبالجملة: إطلاق «على اليد...» يقتضى شموله لكلّ ما يصدق فيه «أنّها عليه» بوجه، والمضمون له غير مذكور ومحوّل إلى فهم العرف والعقلاء.
وفي المقام يكون الضامن مضموناً له بالنسبة إلى ضمانه، ولا يوجب ذلك الضمان رفع ضمان الضامن الأوّل ونقله إلى الضامن الثاني؛ لأنّ موضوع ضمان الثاني هو ضمان الأوّل، ولا يعقل رفع الموضوع بالحكم، وليس الضمان بالنسبة إلى المالك حتى يقال: معناه النقل أو الأداء عند عدم أداء الأوّل، بل لازم ضمان الثاني للأوّل ليس إلّا جبر خسارته، وغاية هذا الضمان إرجاع المال المضمون إلى الضامن الأوّل، فإنّه أداء للوصف المأخوذ. قال: ولعلّ كلام الشيخ الأعظم قدس سره يرجع إلى ذلك وإن كان بعيداً من ظاهره (65) ، إنتهى موضع الحاجة.
ويرد على الطولية أوّلًا: أنّ محذور تعدّد الضمان لمال واحد عرضاً كما هو المفروض في أصل الإشكال يأتي في الطولية أيضاً، لأنّ زمان الضمان الثاني وإن كان متأخّراً عن زمان الضمان الأوّل، إلّا أنّه يجتمع في الزمان الثاني ضمانان لا محالة.
ودعوى تغاير المتعلقين لأنّ ضمان اليد الاولى متعلّق بنفس العين، وضمان الثانية متعلّق بضمان العين في ذمّة اليد الأولى وهكذا، مدفوعة بأنّه إن اريد بالتغاير مجرّد كون العين مضمونة في اليد الاولى خالية عن الصفة الاعتبارية وهي المضمونية، وفي اليد الثانية مشتملة عليها، فلا محالة قد اجتمع في العين ضمانان وإن كان المضمون في الثاني واجداً لخصوصية زائدة أيضاً، وإن اريد بالتغاير اختلاف المضمونين بالمرّة، كما هو ظاهر تعبير الدعوى، فيردّه- مضافاً إلى منعه- أنّ مقتضاه عدم جواز رجوع المالك إلى اللّاحق أصلًا، كما لا يخفى.
وثانياً: منع كون صفة المضمونية صفة اعتبارية داخلة في دائرة الضمان، بحيث كان مرجع ضمانها إلى لزوم أداء المثل أو القيمة إلى الاولى مع رجوعه إلى الثانية، فإنّها ليست من الصّفات الرّاجعة إلى العين، وبعبارة اخرى: الضمان إنّما هو حكم ثابت على العهدة، واضافته إلى العين إنّما هو لمجرّد افتقاره إلى المضمون.
وامّا كون المضمونية صفة داخلة في دائرة الضمان، كسائر الصفات الدخيلة فيها لكونها مرهونة مثلًا، فممنوع والشاهد ملاحظة العقلاء، حيث إنّهم لا يفرّقون بين الغاصب الأوّل والغاصب الثاني فيما يرجع إلى غصب العين أصلًا، ولا يرون اختلافاً بينهما من جهة ما هو المضمون والثابت على العهدة بوجه، فكما أنّ المضمون في الغصب الأوّل إنّما هي نفس العين بسائر صفاتها، فكذلك المضمون في الغصب الثاني، ولا فرق بين المضمونين.
وثالثاً: أنّه لو سلّمنا كون المضمونيّة داخلة في دائرة ضمان العين، فهل المراد منه كون الغاصب الثاني ضامناً لشخصين: أحدهما: المالك، وثانيهما: الغاصب الأوّل، أو المراد منه كونه ضامناً للمالك فقط، غاية الأمر كون المضمون هي العين مع صفة المضمونيّة، فعلى الأوّل يكون لازمه جواز رجوع الغاصب الأوّل إلى الثاني وإن لم يرجع المالك إليه بعد أو بالكليّة؛ لكون الثاني ضامناً له على ما هو المفروض، وعلى الثاني لا يبقى مجال لجواز رجوع الأوّل إلى الثاني أصلًا، والتفكيك بين الموصوف والصفة في الضمان قد عرفت أنّ لازمه عدم جواز رجوع المالك إلى الغاصب الثاني، مع أنّه مخالف لقاعدة «على اليد» الحاكمة بتعدّد الضمان بنحو القضية الحقيقية، كما لا يخفى.
والعجب تصريحه- دام ظلّه- بأنّ أداء العين إلى الغاصب الأوّل يوجب رفع الضمان بالكلّية من الغاصب الثاني، كما لا يخفى.
وهنا وجوه اخر لهذه الجهة- التي هي من مشكلات مسائل الفقه؛ لأنّه لا يعرف لها وجه مع كون كلّ واحد من السابق واللّاحق عادياً غير مغرور كما هو المفروض :
منها: ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره في كتاب الغصب ممّا لفظه: أنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به، فيملك حينئذ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعية القهريّة، قال: وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده، وبين غيره الّذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّيّ، إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد ، فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو (66) .
وأورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره بقوله : وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده، وخطاب غيره بأنّ خطابه ذميّ وخطاب غيره شرعي؛ مع كون دلالة «على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السّواء، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره.
مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذميّ، مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلّ من ذوي الأيدي مشغول الذمّة بالمال فعلًا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك، نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله، وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء، ومصالحة المالك عنه مع آخر، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذّمة.
مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهريّ، بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف المال في يده بمجرّد أداء غيره؛ لعدم تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك.
مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في اليد العادية إلّا إلى من تلف في يده، مع أنّ الظاهر خلافه؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده.
نعم، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقرّ على من تلف في يده (67) .
ومنها: ما أفاده الشيخ الأعظم المتقدّم في ذيل مباحث الفضولي ممّا لفظه : أنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السّابق اشتغلت ذمّته له بالبدل قبل اللّاحق، فإذا حصل المال في يد اللّاحق فقد ضمن شيئاً له بدل، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل؛ إذ لا يُعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل، وإلّا خرج بدله عن كونه بدلًا، فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل، بخلاف ما يدفعه الأوّل؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّناً؛ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد، فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له.
ولا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك؛ لأنّه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل، فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه لا يستحق الدفع إليه إلّا بعد الأداء.
والحاصل: أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين، وإمّا بتدارك ما تُداركها، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد (68) .
واستشكل عليه السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب :
أوّلًا: بأنّ كون العين حين ضمان اللّاحق لها متصفة بكونها ذات بدل لا يوجب ضمانه للبدل أيضاً، فإنّ سبب الضمان لم يتحقّق بالنسبة إلى البدل الذي هو في ذمّة السابق؛ إذ لم يثبت البدل في يد اللّاحق كما ثبت نفس العين .
ودعوى كونه من توابع العين كما ترى؛ إذ ليس هذا من شؤون العين كالمنافع والنماءات حتى يكتفى بقبض نفس العين في قبضه.
وثانياً: بأنّا لو سلّمنا ذلك كان مقتضاه ضمان البدل أيضاً لمالك العين لا للسّابق؛ فإنّ البدل الذي في ذمّة السابق ملك لمالك العين، فمقتضى الضمان هو أن يكون بدل البدل أيضاً للمالك، ولا وجه لكونه لمن عليه البدل.
وثالثاً: بأنّه لو فرض أنّ العين بعد ما صارت في يد اللّاحق رجعت إلى السابق ثانياً وتلفت في يده، كان مقتضى ما ذكره هو جواز رجوع السابق إلى اللّاحق، مع أنّ العين قد تلفت في يده؛ وذلك لأنّه يصدق على اللّاحق أنّه ضمن شيئاً له بدل، فكان مقتضى ما ذكره هو ضمانه، إمّا للمالك بنفس العين أو للسابق ببدلها، مع أنّ المسلّم خلاف ذلك؛ فإنّ تلف العين قد كان بيد السابق، فكيف يجوز له الرجوع إلى اللّاحق، إلى آخر ما ذكره من الايرادات السّبعة (69) .
ولكن عمدة ما يرد على الشيخ قدس سره بملاحظة ما ذكرنا في معنى «على اليد» أنّ ما على اليد وعلى عهدتها هي نفس العين في جميع الحالات وبالإضافة إلى جميع الأيادي المتعاقبة، من دون فرق بين حال البقاء وبين حال التلف، وكذا بين اليد السابقة واليد اللاحقة، والانتقال إلى البدل إنّما هو في مرحلة الأداء الذي له مراتب، فالثابت على اليد بمقتضى حديثه هي نفس العين مطلقاً، وعليه: فالتفكيك بين ضمان السابق وبين ضمان اللّاحق لا وجه له، مع أنّ نسبة الحديث إليهما على السّواء، كما اعترف به في الإيراد على صاحب الجواهر قدس سره.
وإن كان نظره قدس سره إلى الطولية التي عرفتها، فقد مرّ الجواب عنها أيضاً، فراجع .
ومنها: ما أفاده المحقّق الخراساني قدس سره في حاشيته على المكاسب ممّا لفظه: وأمّا حديث جواز رجوع اليد السّابقة إلى اللّاحقة لو رجع إليها المالك، المستلزم لكون قرار ضمان التالف على من تلف عنده، مع المساوات فيما هو سبب الضمان، فهو أيضاً من آثار حدوث سبب ضمان ما كان في ضمان الآخر لواحد آخر، وأحكامه عند العرف، ويؤيّده الاعتبار، ولم يردع عنه في الأخبار، فلابدّ من الالتزام به شرعاً، كما هو الحال في جلّ أحكام الضّمان، حيث إنّه لا وجه له إلّا الثبوت عرفاً، وعدم الردع عنه شرعاً، وكشف ذلك عن إمضاء الشارع فيما إذا اطلق دليل الضمان، فتدبّر جيّداً» (70) .
وعبارته وإن كانت ظاهرة في الطولية، إلّا أنّ هذه الطولية غير الطوليّة المتقدّمة التي منعناها، فإنّ هذه الطولية مرجعها إلى السبق واللحوق فقط، لا إلى كون المضمونيّة للأوّل داخلة في دائرة ضمان الثاني، كما لا يخفى.
ومنها: ما أفاده سيّدنا العلّامة الاستاذ البروجردي قدس سره في مباحث كتاب الغصب على ما قرّره بعض الأعاظم من تلامذته؛ فإنّه بعد أن ذكر أنّ مفاد «على اليد» الضمان والتعهّد الذي يعبّر عنه بالفارسيّة ب «عهده دارى» وليس مفاده اشتغال الذمّة بشيء؛ فإنّ الضمان اعتبار من اعتبارات العقلاء يعتبرونه للعين حتى في حال وجودها، قال:
يمكن أن يكون الوجه في المسألة- أي مسألة جواز رجوع السابق إلى اللّاحق- أنّ السابق وإن حكم عليه بالضمان من جهة صدور الغصب منه، ولكن كان متمكّناً حين وجود العين من الخروج عن العهدة بأداء العين إلى مالكه، من دون أن يصير متضرّراً بسبب ذلك، وبعد أن أخذها منه اليد اللّاحقة لزمه المثل أو القيمة، فصارت هي الباعثة لتضرّره، فيستحق بذلك الرجوع عليها.
وبعبارة اخرى: العين المغصوبة وإن لم تكن ملكاً لليد السّابقة، ولكنّها كانت بحيث يستحقّ أن يستخلص من الضمان بسبب أدائها، فكأنّ العين كانت متعلّقة لحقّ السابق، وحديث «على اليد...» كما يدلّ على ضمان العين، كذلك يدلّ على ضمانها لمن كان هذه متعلّقة لحقّه، نظير العين المرهونة إذا غصبها غاصب، فإنّه يضمن للراهن نفس العين وللمرتهن متعلّق حقّه.
وبالجملة: فلو كانت العقلاء يحكمون باستحقاق السابق للرجوع إلى اللّاحق، فلعلّه كانت من جهة أنّهم يرون للسابق حقّاً متعلقاً بالعين، وهو عبارة عن استحقاقه لأن يخرج نفسه من الضمان بسبب هذه العين، من دون أن يرد عليه ضرر، والضرر المتوجّه عليه من المثل أو القيمة إنّما هو من جهة غصب اللّاحق، فيرجع عليه بذلك. قال: ولعلّ هذا مراد الشيخ قدس سره من عبارته المتقدّمة أيضاً ذلك (71) .
ويرد عليه أوّلًا : عدم جريانه في جميع فروض المسألة؛ لأنّ من جملتها ما إذا كان وقوع العين في يد اللّاحق بأذن من السّابق، مع الإعلام بكونه غصباً مأخوذاً عدواناً وعلى سبيل غير مشروع؛ فإنّه لا يكون الضرر المتوجّه عليه في هذه الصّورة إلّامن قبل نفسه؛ لأنّ وقوعه في يد اللّاحق كان بإذن منه.
وثانياً: عدم كون الغصب موجباً لتعلّق حق الغاصب بالعين المغصوبة، وكون أدائها الواجب موجباً لسقوط ضمانه لا يستلزم تعلّق حقّ بها أصلًا، والتنظير بالعين المرهونة إذا غصبها غاصب في غير محلّه.
ومنها: ما أفاده بعض الأعلام على ما في تقريراته في البيع؛ من أنّ الغاصب الأوّل يملك بأدائه التالف المعدوم كملك المعدوم في باب الخيارات، فكما أنّ في موارد الإتلاف إذا غصب مثلًا أحد مال الغير فأتلفه لا شبهة أنّ للمالك أن يرجع إلى المتلف إذا أراد ويأخذ منه بدل ماله، وما بقي من ماله من الرضاض والكسور فهو للضامن، وليس للمالك أن يدّعي كون الرضاض له، وإلّا يلزم الجمع بين العوض، والمعوّض، كما أ نّه لو كان للأجنبي فهو خلاف البداهة، فيكون للضامن، فكذلك في المقام يكون التالف للغاصب الأوّل بالمعاوضة القهرية، ونتيجتها جواز الرجوع ببدله إلى من تلف في يده.
نعم، قد يكون اعتبار الملكية لغواً، كما إذا كان الغاصب واحداً فتلف عنده المال فأخذ المالك منه، فاعتبار ملكية التالف هنا لغو، وليس التلف بمجرّده مانعاً عن اعتبار الملكية في المقام؛ لما عرفت نظيره في باب الخيارات، وبالجملة: رجوع السابق إلى اللّاحق، إنّما هو مقتضى السّيرة العقلائية القطعيّة كما هو واضح (72) .
وأنت خبير بأنّه إن كان مراده الإتكاء على نفس السيرة العقلائية فهو يرجع إلى كلام المحقّق الخراساني قدس سره؛ من كون رجوع السابق إلى اللّاحق من الآثار العقلائية للضمان، والأحكام العرفية الثابتة له (73) .
وإن كان مراده توجيه السّيرة وبيان الوجه لها كما هو ظاهر صدر العبارة، فيمكن المناقشة في ذلك بعدم كون اعتبار المعدوم ملكاً ممّا يساعده العقلاء مطلقاً، والمراد بملك المعدوم في باب الخيار إن كان هو: أنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له، فلا مجال له؛ لما قد اشتهر في وجهه من أنّه تنفسخ المعاملة آنّاً ما قبل التلف وتدخل العين في ملك من لا خيار له، ثمّ يقع التلف في ملكه لوجود الدليل عليه.
وإن كان المراد هو التلف في يد من ليس له الخيار، كما إذا كان تلف المبيع في يد المشتري في زمن خيار البائع، فإنّه بعد ما فسخ البائع ينتقل المبيع التالف إلى ملكه بمقتضى الفسخ، فيرجع إلى بدله من المثل أو القيمة لتعذّر ردّ عينه، فالأمر وإن كان كذلك من جهة الرجوع إلى البدل، إلّا أنّه لم يعلم كون وجهه اعتبار التالف ملكاً للبائع الفاسخ، بل من أحكام الفسخ عند العقلاء والشارع أنّه إذا كان الفسخ مع بقاء العين تنتقل العين إلى الفاسخ، وإذا كان مع تلفه ينتقل بدله إليه، فتدبّر جيّداً.
ومنها: ما اختاره المحقّق العراقي قدس سره في رسالة عثرت عليها بعد نقل الوجوه المتقدّمة؛ وهي رسالة في تعاقب الأيدي، وقد ألّفها في أواخر عمره الشريف؛ وهي مطبوعة في ذيل شرحه لكتاب القضاء لشيخه استاذ الكلّ المحقّق الخراساني قدس سره وملخّصه:
أنّ الظاهر من العامّ أنّ ما على اليد عين ما أخذت لا إضافته بالجملة، فلا قصور في اعتبار تعدّد وجود ما أخذت حسب تعدّد الأيدي بلحاظ تعدّد الأبدال القائمة عليها، وبملاحظة أنّ وجود البدل نحو وجود للمبدل، وهذه الجهة هي مصحّح العنايتين في وجودات العين على حسب تعدّد الأيدي.
وعليه: فمرجع «على اليد» في اليد الأولى إلى كون ما هو تحت يده واستيلائه باخذه على يده، فكأنّه قال: إنّ ما هو تحت يده على يده، ولازمه اعتبار وجود آخر لما تحت يده بجعله فوقها، ولازمه اعمال عناية في اعتبار العين فوق اليد وعليها.
وحينئذ يبقى الكلام في أنّ محلّ إعمال العناية تارة نفس وجود العين، ويقال:
إنّ الوجود بالعناية على اليد حقيقة بمعنى إبقاء مدلول «على» والاستعلاء على حقيقته بلا تصرّف فيه، واخرى محلّ إعمال العناية هو مدلول «على»، وأنّ الوجود الحقيقي للعين الذي هو تحت اليد كان على اليد بلا تصرّف في وجود العين أبداً، ويترتّب على كلّ واحد من العنايتين نتائج متعدّدة.
منها: أنّه على العناية الاولى كان الوجود الاعتباري للعين قبل أداء الضامن إيّاه ملك الضامن حقيقة؛ إذ هو حينئذ عين بدله الذي هو قبل أدائه ملك الضامن، غاية الأمر عناية كونه عين ما أخذت موجب لاستحقاق مطالبة المالك أيّاه، وهذا بخلاف العناية الثانية؛ إذ وجود العين بالحقيقة في أيّ مكان كان هو ملك المالك، فرجوع المالك إلى الضامن من جهة سلطنته على أخذ ماله، غاية الأمر حيث لا يتمكّن الضامن لا يجب عليه إلّا بدله. وحينئذ فما على اليد ليس ملك الضامن، وأنّ ما هو ملكه هو البدل المسقط للعين.
ومن تبعات هذه الجهة من الفرق بين العنايتين تتولّد نتيجة اخرى؛ وهي أنّ بمقتضى العناية الاولى يصدق أنّ اليد اللّاحقة واردة على وجودي العين اللذين هما في اليد وعلى اليد، ففي الحقيقة استيلاء الثاني على العين استيلاء على وجود العين لجميع أنحائه وشؤونه، فكأنّ اليد الثانية بمنزلة كأس آخر قائم على الكأس الأوّل الحاوي للعين بشؤونها، ولازمه إحداث ما أخذت عيناً اعتبارياً على يد الثاني للمالك، وعيناً اعتبارية اخرى على اليد الثانية للضامن.
وبهذه الملاحظة يقال: إنّ اليد الثانية أيضاً مشغولة بمال الضامن، غاية الأمر ليس للضامن السابق مطالبة اللّاحق إلّافي ظرف أدائه ما عليه من البدل؛ لأنّ أداءه موجب لتلف ماله، فله الرجوع إلى اللاحقة حينئذ، انتهى (74) .
وأنت خبير بأنّ كلامه هذا تقريب آخر للطوليّة؛ وهي مخالفة لظاهر «على اليد ما أخذت...» الذي نسبته إلى الأيادي على حدّ سواء، كما عرفت.
وأحسن الوجوه المتقدّمة ما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس سره من كون ذلك- أي رجوع السابق إلى اللّاحق بعد الأداء- من الأحكام العقلائية في موارد ثبوت الضمان، ولم يردع عنه الشارع، واللازم حمل الإطلاق عليه، وهذا المقدار يكفي في الحكم بالجواز، والبحث عن وجهه ليس بلازم كما لا يخفى.
الأمر الثالث: لو كانت العين المغصوبة متعلّقة لحقّ الغير، كما إذا كانت مرهونة عند المرتهن، وصارت مغصوبة في هذا الحال، فهل مقتضى حديث «على اليد...» الضمان في مقابل المالك الرّاهن فقط، نظراً إلى كونه مالكاً للعين، أو أنّ مقتضاه الضمان في مقابل المرتهن أيضاً؛ لكون العين متعلّقة لحقّه، ولابدّ وأن تكون عنده وثيقة للدين الذي له على عهدة الرّاهن؟ الظاهر هو الوجه الثاني؛ لأنّه كما يصدق الأخذ بالإضافة إلى ما للمالك من العين، كذلك يصدق بالنسبة إلى ما للمرتهن من الحقّ؛ فإنّه بالغصب قد تحققت الحيلولة بين المرتهن وبين وثيقة دينه، وقطعت يده عن العين المرهونة، ولا مجال لدعوى عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى الحقّ بعد كون أخذه بأخذ ما هو متعلّق له، كما لا يخفى.
ومنه يظهر أنّ الأداء الرافع للضمان في مثله هو الأداء إلى من تعلّق حقّه به، لا الأداء إلى المالك؛ لأنّ الأداء إلى المالك رافع لضمانه بالإضافة إليه فقط، ويبقى ضمانه في مقابل المرتهن، وهذا بخلاف الأداء إلى المرتهن، فإنّه رافع لكلا الضمانين ومسقط لكلتا العهدتين، ولم يؤخذ في الحديث خصوص الأداء إلى المالك مسقطاً ورافعاً للضمان، بل المأخوذ مطلق الأداء، وظاهره إرجاع العين إلى ما كانت عليه قبل الأخذ والاستيلاء. فإن كانت عند المالك أو وكيله فاللازم الأداء إليه أو إلى وكيله، وإن كانت عند من تعلّق حقّه بها فاللازم الإرجاع إلى مستحقّها، كما لا يخفى.
ومثل الرهن في تعلّق الحقّ ما لو كانت العين المغصوبة موقوفة، بناءً على القول بكون العين الموقوفة باقية في ملك الواقف، غاية الأمر صيرورتها متعلّقة لحقّ الموقوف عليهم، أمّا إذا قلنا بدخولها في ملك الموقوف عليهم، فهم حينئذ مالكون والردّ إليهم ردّ إلى المالك. كما أنّه لو قلنا بخروجها عن ملك المالك وصيرورتها على رؤوس الموقوف عليهم، أو الجهة الموقوف عليها بحيث تدرّ منافعها عليهم من دون دخول أصلها في ملكهم، كما اختاره سيّدنا العلّامة الاستاذ البروجردي قدس سره (75) ، مؤيّداً له بتعدّي الفعل ب «على»، فيقال: وقف عليه، فكأنّ المال الموقوف سحاب جعلها المالك على رؤوس الموقوف عليهم حتى تمطر لهم، فالظاهر أنّه أيضاً مثل الحقّ، فيجب الردّ إليهم عيناً أو بدلًا، وقد مرّ البحث في هذه الجهة فراجع.
الأمر الرابع: هل حديث «على اليد...» يشمل اليد المركّبة كما يشمل اليد المنفردة المستقلّة، أم لا؟ والمراد باليد المركبّة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرّة، بل يكون استيلاء كلّ منهما مرتبطاً بالآخر؛ بمعنى أنّ كلّا منهما لو لم يكن، لم يكن للآخر استيلاء بالمرّة، لا على الجزء ولا على الكلّ، فيكون استيلاء كلّ منهما بانضمام الآخر، ويكون المجموع المركّب مستولياً على المجموع المركّب. وربما يشكل في الشمول؛ نظراً إلى أنّ يد كلّ منهما عارضيّ خال عن الاستقلال، وإنّما المستقل هو المجموع المركّب، فلا يصدق على أحدهما الاستيلاء وإثبات اليد، فلا وجه للضمان.
هذا، ولكنّ الظاهر الشمول؛ لأنّ الملاك في الضمان هو الاستيلاء، وهو متحقّق هنا، غاية الأمر أنّ المستولى هو المجموع، فالضمان على المجموع، ومرجعه إلى ضمان كلّ واحد منهما النصف؛ لأنّه لازم ثبوت الضمان على اثنين وعدم ثبوت ترجيح في البين، فكلّ واحد منهما ضامن لنصف العين كما هو ظاهر.
الأمر الخامس: كما يجري الحديث في اليد غير المنضمّة، فهل يشمل اليد المنضمّة أم لا؟ والمراد باليد المنضمّة هي اليد المجتمعة مع المالك، بحيث يكون المجموع المركّب من المالك والغاصب مستولياً على العين، والمالك لو ارتفع لم يكن للغاصب التسلّط، كما أنّه لو ارتفع الغاصب لم يكن للمالك تسلّط، فيكون المركب منهما مسلّطاً على المجموع، وربما يشكل الحكم بالضمان هنا وإن قيل بثبوته في الفرض المتقدم في الأمر الرابع؛ لأنّه لا معنى لضمان المجموع المركب بعد كون المالك جزءاً من هذا المجموع وبعضاً له، ولا معنى لضمان المالك.
وبعبارة اخرى: لو كان مفاد الحديث الحكم بضمان كلّ واحد منهما مستقلّاً، فالمفروض أنّ كلّ واحد منهما لا يكون مستولياً على المال، وإنّما المستولي هو المجموع، ولو كان مفاده الحكم بضمان المجموع، فلا مجال للحكم بضمانه بعد كون بعضه هو المالك.
ولكنّ التحقيق شمول الحديث لهذا الفرض أيضاً، بتقريب أنّ مقتضاه هو الحكم بضمان المجموع المركب، غاية الأمر أنّ لازمه التبعّض على أجزاء المركّب والتبعّض على أجزاء المال، فإذا لم يكن بعض الأجزاء قابلًا لأن يكون ضامناً، فذلك لا يمنع عن ثبوت الضمان بالنسبة إلى الآخر القابل لأن يكون ضامناً، وليس المانع الابتدائي إلّا كالمسقط بحسب الاستدامة، فلو فرض أنّ المالك أبرأ إحدى اليدين في اليد المركّبة، فكما لا يوجب ذلك براءة اليد الاخرى أيضاً، بل يبقى ضمانها بحالها، فكذلك المقام؛ فإنّ عدم صحّة انطباق المجموع على المالك لا يوجب عدم صحة انطباقه على الغاصب أيضاً، فالحقّ شمول الحديث لليد المنضمّة كشموله لليد المركّبة.
الأمر السادس : الظاهر عدم اختصاص الحديث بما إذا كان الموصول عيناً معيّناً، بل يشمل ما إذ كان مشاعاً، فمن تسلّط على نصف دار بالإشاعة؛ كما إذا أخرج أحد الشريكين في الدار شريكه الآخر منها واستقلّ بالتصرف في الدار؛ فإنّه مع كونه مستولياً على النصف المشاع لفرض تحقّق الشركة يصدق الحديث بالإضافة إليه ويحكم بضمانه بمقتضاه.
ودعوى أنّ الإستيلاء لا يتحقّق إلّا على الشيء المعيّن، ممنوعة، بل هو أمر عرفيّ متحقّق في المشاع كالمعيّن، ولا ينافيه قوله: «حتى تؤدّي»؛ ضرورة إمكان تحقّق الأداء في مثل المشاع برفع المنع عن تصرّف الشريك، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في قاعدة ضمان اليد.
______________
(1) كذا في الانتصار ضمن الجوامع الفقهية: 192، ولكن لم نجد بهذا اللفظ في كتب الحديث على ما تتبّعنا، وفي الطبعة الحديثة: 468« على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه».
(2) الخلاف: 3/ 407- 408 مسألة 20.
(3) الفتاوى الهنديّة: 5/ 121.
(4) المبسوط: 3/ 59.
(5) غنية النزوع: 280.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: 8/ 192 وج 10/ 499.
(7) السرائر: 2/ 87، 425، 437، 463 و484.
(8) تذكرة الفقهاء: 2/ 383، طبع الحجري، الدروس الشرعية: 3/ 109، جامع المقاصد: 6/ 215، الروضة البهيّة: 7/ 25، مسالك الأفهام: 12/ 174- 175.
( 9) انظر عوائد الأيّام: 315، وغاية الآمال في حاشية المكاسب: 5/ 54، والقواعد الفقهية للمحقّق البجنوردي: 2/ 107 وج 4/ 54- 55.
( 10) السرائر: 2/ 481.
( 11) مختلف الشيعة: 6/ 32 مسألة 5 وص 39- 40 مسألة 18.
( 12) كتاب البيع للإمام الخميني قدس سره: 1/ 372- 376.
( 13) السرائر: 1/ 47( مقدّمة المؤلف).
( 14) وسائل الشيعة: 25/ 428- 429، كتاب إحياء الموات ب 12 ح 3- 5.
( 15) عوائد الأيّام: 318.
( 16) اصول فقه الشيعة: 1/ 413- 427.
( 17) مفتاح العلوم: 369- 372.
( 18) , ( 2) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 183.
( 19) حاشية المكاسب للمحقّق الخراساني: 30.
( 20) حاشية كتاب المكاسب للمحقّق الإصفهاني 1: 307- 308.
( 21) انظر كتاب الغصب للمحقق البروجردي: 128- 130 و136 و144.
( 22) كتاب البيع 1: 392- 394.
( 23) كتاب الغصب للمحقق البروجردي: 130- 131 و141- 147.
( 24) المقنعة: 814، النهاية: 314- 315، شرائع الإسلام: 2/ 108، قواعد الأحكام: 2/ 158، جواهر الكلام: 26/ 113.
( 25) وسائل الشيعة: 18/. 422- 424، كتاب الضمان ب 2 و3.
( 26) المغني لابن قدامة: 5/ 70، الشرح الكبير: 5/ 70، المجموع شرح المهذّب: 14/ 252.
( 27) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 183 و188- 189.
( 28) حاشية كتاب المكاسب للمحقق الإصفهاني: 1/ 307- 308.
( 29) المحقق الخراساني في حاشيته على المكاسب: 30، والسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: 1/ 454- 457، والمحقق الإيراواني في حاشيته على المكاسب: 2/ 112- 115.
( 30) حاشية المكاسب للمحقّق الخراساني: 30.
( 31) الكافي: 7/ 351 ح 2، تهذيب الأحكام: 10/ 225 ح 886، الاستبصار: 4/ 285 ح 1078، وعنها وسائل الشيعة: 29/ 247، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 2.
( 32) كتاب البيع: 1/ 506- 508.
( 33) لم نجده في كتب الحديث بهذا اللّفظ، فمن المحتمل قويّاً كونه من الروايات الواردة في موارد مختلفة، مثل ما ورد في وسائل الشيعة: 27/ 327، كتاب الشهادات ب 11.
( 34) عوائد الأيّام: 318.
( 35) عوائد الأيّام: 316- 317.
( 36) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 182.
( 37) الكافي: 7/ 273 ح 12 وص 274 ح 5، الفقيه: 4/ 66 ح 195، تفسير القمّي: 1/ 171، عنها وسائل الشيعة: 5/ 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 وج 29/ 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3.
( 38) حاشية كتاب المكاسب للمحقق الإصفهاني: 1/ 317- 318.
( 39) كتاب الغصب للمحقق الرشتي: 13.
( 40) تحرير الأحكام: 4/ 523.
( 41) كتاب الغصب للمحقّق الرشتى : 13- 14.
( 42) انظر الكافي: 5/ 302 ح 2، تهذيب الأحكام: 7/ 185 ح 814، الاستبصار: 3/ 125 ح 445، قرب الإسناد: 146 ح 527، وعنها وسائل الشيعة: 19/ 94، كتاب العارية ب 1 ح 11، وج 29/ 246، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 12 ح 2، وأخرجه في البحار: 104/ 259 ح 3 عن قرب الإسناد.
( 43) كتاب الغصب للمحقق الرشتي: 13- 14.
( 44) الكافي: 7/ 364 ح 1، تهذيب الأحكام: 10/ 234 ح 925، وعنهما وسائل الشيعة: 29/ 260، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.
( 45) راجع قواعد الأحكام: 2/ 305، جامع المقاصد: 7/ 268، مجمع الفائدة والبرهان: 10/ 72 وتفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 629- 630.
( 46) كتاب الغصب للمحقّق البروجردي: 163.
( 47) الدروس الشرعية: 3/ 106.
( 48) كتاب الغصب للمحقّق الرشتي: 116- 117.
( 49) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 209- 271.
( 50) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي: 4/ 75- 76.
( 51) انظر كتاب الغصب للبروجردي : 142- 143.
( 52) حاشية المكاسب للمحقّق الخراساني: 37.
( 53) الكافي: 5/ 290 ح 6، تهذيب الأحكام: 7/ 215 ح 943، الاستبصار: 3/ 134 ح 483، وعنها وسائل الشيعة: 19/ 119، كتاب الإجارة ب 17 ح 1 وج 25/ 390، كتاب الغصب ب 7 ح 1.
( 54) جواهر الكلام: 37/ 102.
( 55) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 247.
( 56) حاشية المكاسب للمحقق الخراساني: 41.
( 57) انظر القواعد الفقهيّة للبجنوردي: 4/ 80- 81 ومنية الطالب في شرح المكاسب: 1/ 311- 313.
( 58) حاشية المكاسب للسيد اليزدي: 1/ 504.
( 59) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 247.
( 60) حاشية المكاسب للسيد اليزدي: 1/ 504- 505.
( 61) المكاسب والبيع( تقريرات أبحاث الميرزا النائيني): 1/ 360- 361.
( 62) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 249، المكاسب والبيع( تقريرات أبحاث الميرزا النائيني): 1/ 362- 364.
( 63) حاشية المكاسب للمحقق الخراساني: 83.
( 64) منية الطالب في شرح المكاسب: 2/ 187- 188.
( 65) كتاب البيع للإمام الخميني: 2/ 502.
( 66) جواهر الكلام: 37/ 34.
( 67) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم) : 3/ 509- 511.
( 68) المكاسب( تراث الشيخ الأعظم): 3/ 508- 509.
( 69) حاشية المكاسب للسيد اليزدي: 2/ 311- 312.
( 70) حاشية المكاسب للمحقق الخراساني: 83.
( 71) انظر كتاب الغصب للمحقّق البروجردي: 151- 154.
( 72) مصباح الفقاهة: 4/ 383- 384.
( 73) حاشية المكاسب للمحقق الخراساني: 83.
( 74) رسالة في تعاقب الأيدي، المطبوع في آخر شرح كتاب القضاء: 222- 224.
( 75) كتاب الغصب للسيّد البروجردي: 163.
 الاكثر قراءة في على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
الاكثر قراءة في على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












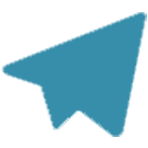
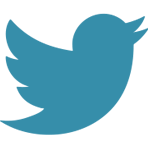

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)